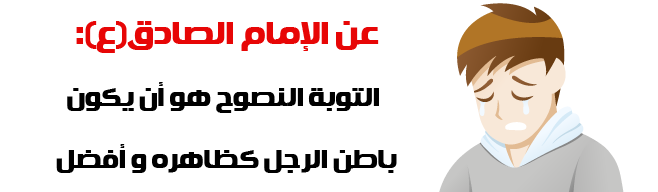
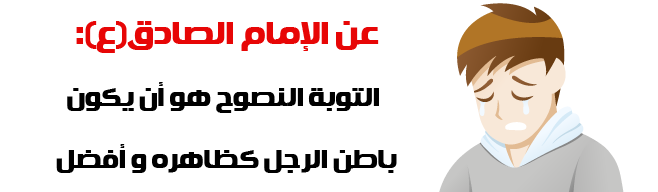

 التاريخ والحضارة
التاريخ والحضارة
 اقوام وادي الرافدين
اقوام وادي الرافدين 
 العصور الحجرية
العصور الحجرية 
 الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق 
 العهود الاجنبية القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق 
 احوال العرب قبل الاسلام
احوال العرب قبل الاسلام 
 مدن عربية قديمة
مدن عربية قديمة
 التاريخ الاسلامي
التاريخ الاسلامي 
 السيرة النبوية
السيرة النبوية 
 الخلفاء الاربعة
الخلفاء الاربعة
 علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
 الدولة الاموية
الدولة الاموية 
 الدولة الاموية في الشام
الدولة الاموية في الشام
 الدولة الاموية في الاندلس
الدولة الاموية في الاندلس
 الدولة العباسية
الدولة العباسية 
 خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
 خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
 عصر سيطرة العسكريين الترك
عصر سيطرة العسكريين الترك
 عصر السيطرة البويهية العسكرية
عصر السيطرة البويهية العسكرية
 عصر سيطرة السلاجقة
عصر سيطرة السلاجقة
 التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر
 التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
 تاريخ الحضارة الأوربية
تاريخ الحضارة الأوربية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-27
التاريخ: 2025-01-06
التاريخ: 2024-06-01
التاريخ: 2024-08-19
|
رأينا المجهود الذي بذله ملوك الأسرة الثانية عشرة في إخضاع القبائل الثائرة والأقوام التي كانت تُغِيرُ على التجارة المتبادلة بين القطرين، وكيف أن ملوك هذه الأسرة قد مهدوا السبيل لاستتباب الأمن بإقامة المعاقل والحصون في مختلف جهات بلاد النوبة من أول «الشلال الأول» حتى «الشلال الثالث». غير أن إقامة الحصون وتزويدها بالجنود المصريين ليدل دلالة واضحة على أن الأمن لم يكن مُسْتَتِبًّا في بلاد السودان على الوجه الأكمل، بل على العكس يدل على أن المصريين كانوا يخافون شر هجمات القبائل المُعادية، وتدل شواهد الأحوال على أنه كان بجوار هذه الحصون بعض المستعمرات ولكنها لم تُبْحَثْ حتى الآن بحثًا كافيًا يمكن به استنباط حقائق مقررة، هذا إلى أن مدن الدولة الحديثة التي أقيمت على أنقاض هذه المستعمرات مثل «عنيبة» و«بهين» قد خُرِّبَتْ كذلك ولم تُحْفَظْ لنا من هذه المؤسسات إلا بعض بيوت في حصون الشلالات وقد فحصت.
والواقع أن هذه المستعمرات أو المؤسسات لم تكن مراكز سكن مريحة بصورة مرضية، وذلك لأنه لم تكن هناك أراضٍ خصبة صالحة للزراعة بجوار هذه المؤسسات؛ وعلى ذلك فليس من السهل أن نستخلص نتيجة أكيدة من بقايا المباني التي حُفِظَتْ لنا حتى الآن عن استعمار المصريين لبلاد النوبة السفلى في عهد الدولة الوسطى، ومن المحتمل أن الإضافات التي عُمِلَتْ في حصن «عنيبة» إلى أن أصبحت مدينة صغيرة قد تكشف لنا الغطاء عن الحقيقة القائلة بأن المصري قد هاجر إلى بلاد النوبة السفلى واستوطن هناك، وأن الحال كانت مثل ذلك تمامًا في «بهين» إذ نجد غير حصن الدولة الوسطى مؤسسة كبيرة نسبيًّا يرجع تاريخها إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرة وتقع تحت مباني المعبد الذي أقامه «أحمس الأول» وتتفق اتجاهاتها مع اتجاهات الحصن القديم والطبقة التي وجدت فيها جدران هذه المؤسسة تقع على علو 70 سم من أساس حصن الدولة الوسطى، وعلى ذلك يظهر أنها أحدث من الأخيرة، وقد أقيم هذا الحصن القديم في أوائل الأسرة الثانية عشرة ويُحتمل في عهد الملك «سنوسرت الأول»، وعلى ذلك تنتسب هذه المؤسسة إلى الزمن الذي يلي الأسرة الثانية عشرة، ومن ثَمَّ لا توجد جدران حصون من عهد الدولة الوسطى، والظاهر أنها تقع خارج الأراضي التي يحجبها السور، ولا بد إذن أنها قد بُنِيَتْ في وقت كانت فيه العلاقات الودية على ما يرام، ولم يكن المصري يخاف وقتئذٍ شَرَّ أي هجوم من النوبي.
وقد لاحظنا أن نظام إقامة الحصون في عهد «سنوسرت الثالث» عند الشلال الثاني هو لتأمين الحدود الجنوبية من إغارة النوبيين، ولذلك فإنه عُدِّل تعديلًا تامًّا، وتدل شواهد الأحوال كما ذكرنا من قبل على أن العهد الذي تلا حكم «سنوسرت الثالث» كان على ما يظهرُ عهدَ سلام ووئام. ومن المحتمل إذن أن المباني التي نحن بصددها قد أقيمت في هذا العهد، وهذا يتفق تمامًا مع ما نشاهده من أن معظم المقابر القديمة في «بهين» تُنْسَبُ إلى هذا العهد وهذا يشير إلى ازدهار هذه المستعمرات.
ومما عُثِرَ عليه في المقابر المصرية التي أُقِيمَتْ في بلاد النوبة السفلى نستنبط أن المصري كان يكره لنفسه بدرجة عظيمة أن يُدْفَنَ جثمانه في بلاد أجنبية، وقد كان من نتائج ذلك أن أجسام موتى كل أصحاب اليسار كانت تُنْقَلُ إلى أرض الوطن، ولدينا أدلة على ذلك مدونة في عهد الدولة القديمة، وكذلك من عهد الدولة الوسطى، ونذكر على سبيل المثال قصة «سنوهيت»2 الذي كان جُلُّ ما يتمناه أن يعود إلى أرض الوطن ويُدفن جثمانه فيها. وفي عهد الدولة الوسطى كانت بلاد النوبة لا تزال محتفظة بطابعها الذي يدل على أنها كانت بلادًا أجنبية مخيفة، وأول مقابر هامة ظهرت فيها يرجع تاريخها إلى عهد نهاية الدولة الوسطى، ونجد مقابر الدولة الوسطى فيها فردية وفي جهات قليلة، وجميع أصحاب هذه المقابر على وجه عام نكرات فلا نعرف شيئًا عن مكانتهم أو ألقابهم، ومع ذلك نعرف شيئًا عن سلسلة أفراد من المصريين الذين استوطنوا بلاد النوبة السفلى من النقوش العديدة التي دُوِّنَتْ على صخور هذه البلاد، ومن الصعب تأريخ معظم هذه النقوش، ولا نعلم شيئًا عن الأسماء التي جاء ذكرها على هذه الصخور أكان أصحابها مجرد عابرين لبلاد النوبة أم مقيمين فيها، ويلحظ أن الكاتب الذي دَوَّنَ هذه النقوش كان يقصد ذكر اسم بلاده كما حدث ذلك في حالة كاتب جنود «إلفنتين».
ولدينا في مصر نفسها نقوش كثيرة تذكارية — خلافًا لما ذُكِرَ من قبل عند الكلام على السياسة الخارجية — تدل على أن كثيرًا من المصريين قد أُرْسِلُوا في مأموريات إلى بلاد النوبة، فمثلًا يقول رجل من مدينة «إلفنتين» كان قد قام بدور هامٍّ في سياسة البلاد الجنوبية كما كانت الحال في عهد الدولة القديمة: «لقد قمت بحملات عدة مصعدًا في النيل نحو «بلاد كوش» فلم تحدث مني غلطة، ولم يقع أي سوء». وكان يُلَقَّبُ فضلًا عن ذلك «حارس النوبيين» وقص علينا كذلك نائب حامل الخاتم على لوحة تذكارية من «العرابة المدفونة» أن الملك أرسله لفتح بلاد كوش،5 ومما له علاقة بهذا الموضوع ما جاء في مقدمة قصة الغريق وفي نهايتها يقول صاحب القصة إنه كان في رحلة إلى بلاد «واوات» غير أن ذلك فيه شك كبير.
ولدينا من عصر متأخر عن العصر الذي نحن بصدده الآن نقش وُجِدَ في «إدفو» يذكر فيه مشرف على المدينة أنه ذهب إلى «أورايس» في الشمال و«كوش» في الجنوب.
هذا ولدينا مشرف على الجنود آخر يُدْعَى «نيسو منتو» ولقبه هذا يدل على نشاطه في بلاد النوبة.
ولا بد أن نسلم هنا بأن كل المصريين الذين ذكروا على الآثار كانوا يقومون بتأدية مهام خاصة في بلاد النوبة وكان كثير منهم يتخذها موطنًا ويعمل فيها.
وقد كان من الطبعي أن نجد من نتائج استيلاء المصريين على بلاد النوبة نقوشًا كثيرة لرجال الحرب والموظفين هناك. فوُجِدَ في طوابع الأختام التي عُثِرَ عليها في جزيرة «ورنرتي» بعض تابعين كانوا يشغلون نفس المنصب الذي كان يشغله «سبك خو» الذي تحدَّثنا عنه من قبل، وأمثال هؤلاء التابعين نجد أسماءهم على النقوش الصخرية. هذا ولدينا كذلك لقب المشرف على التابعين، وهذا اللقب على حسب نقوش «سبك خو» الصخرية (وهي التي عُثِرَ عليها في «قمة» و«سمنة») يعد أعلى رتبة وكذلك لقب «المشرف على الجنود» قد وجد في أحد نقوش «سنوسرت الأوَّل» في «بهين»، هذا وفي المحاجر الواقعة في الشمال الغربي من «توشكى» نقش لقب «المشرف على المجندين» في عهد «أمنمحات الثاني». وكان حامل اللقب الأخير يُلَقَّبُ كذلك المشرف على بَيْتَيِ الفضة (= الخزانة) وعلى بَيْتَيِ الذهب. ومن المحتمل أن بعض الذين يحملون لقب «المشرف على السفينة» ينسبون إلى الدولة الوسطى أو الدولة القديمة كما يرى في النقوش المدوَّنة في «هنداو» وفي «الأمبر كاب» وفي «جزيرة سروس»، حيث نجد فضلًا عن ذلك منقوشًا لقب «كاتب السفينة». وأخيرًا وُجِدَ على طابع خاتم في «ورنرتي» اسم موظف يحمل لقب «المشرف على الرماة» ومن المحتمل أنه كان يشغل وظيفة قائد الجنود في بلاد النوبة.
ولا يمكن أن نستخلص شيئًا عن نظام الإدارة من النقوش السالفة الذكر لأننا لا نعلم مَنْ مِنْ هؤلاء الموظفين يُنْسَبُ إلى بلاد النوبة، فنعلم أنه كان يوجد في «سمنة» موظف يحمل لقب «حاكم المركز». وينبغي علينا أن نعلم أن بلاد النوبة كانت مُقَسَّمَةً من حيث المقاطعات قسمين أو أكثر، وكان لكل واحد من هذه الأقسام مشرف يحمل لقب «المشرف أو الحاكم على المركز». وقد وُجِدَ مذكورًا على نقوش المحاجر الواقعة في الشمال الغربي من «توشكى» لقب «المشرف على قسم قطع الأحجار» (؟).
ومن بين الوظائف العالية المصرية التي وجدناها في بلاد النوبة لقب أعظم العشرة للوجه القبلي وقد وُجِدَ منقوشًا في «أمدا»؛ وكذلك لقب «فم نخن» (نائب نخن) في «سمنة» ولقب «المشرف على مائدة الملك» في نقوش «جرف حسين» وفي «سمنة».
ومن المحتمل أن ألقابًا مثل «مدير البيت» و«موظف البيت» و«المشرف على المحكمة» و«مدير مكتب الإدارة» يمكن أن تكون من الألقاب الإدارية الخاصة بحصون بلاد النوبة ومركز الحكومة الاستعمارية.
وأخيرًا نعرف كذلك سلسلة من الأشخاص الذين يحملون ألقابًا تدل على أعمالهم مثل «الحاجب» و«قاطع الأحجار»، ووُجِدَ لقب «طبيب» في نقش «بباب كلبشة»، كما وُجِدَ أسماء موظفين كثيرين في جهات متفرقة في «جرف حسين» و«ورنرتي» و«باب كلبشة» و«مودنجار». (Mudinjar) وكذلك نجد أن صاحب القبر (k.8) في «بهين» يحمل لقب «بستاني». يُضَافُ إلى ذلك أسماء كُتَّابٍ عديدين جاء ذكرهم في نقوش الصخور، غير أنها لا تلقى أي ضوء كبير على علاقات مصر ببلاد النوبة من جهة النظام في عهد الدولة الوسطى، ومع ذلك نذكر بعضهم هنا. فقد وجدنا اسم كاتب لبيت المال في نقوش «جرف حسين». وهنا نجد كذلك اسم «كاتب للبلاط لقيادة العمل» (؟) وفي «البقع» نجد نقشًا لقاضٍ يحمل لقب «المشرف على الكتاب».
ومن كل ما سبق نفهم أن المصري كان يهاجر إلى بلاد النوبة السفلى على الأقل في نهاية الدولة الوسطى، غير أن ذلك لم يكن في نطاق واسع، هذا مع العلم بأن المصري كان لا يسكن إلا في الأماكن المحصنة، لأنه عثر في هذه الأماكن على مقابر مصرية الصبغة في عهد الدولة الوسطى، ولا بد أن نفهم أن هؤلاء المصريين النازحين كان معهم خدمهم. أما في الجهات الراقية في بلاد النوبة، وكذلك في القرى فكان النوبي يعيش عيشة خاصة كما تدل على ذلك الْجَبَّانَاتُ القومية ومستعمرات هذا العهد. أما إذا كانت قد حدثت حقيقة هجرة كبيرة من مصر إلى بلاد النوبة السفلى فإن ذلك كان هو السبب في القضاء على ثقافة النوبيين مما جعلهم يهاجرون إلى أماكن بعيدة، غير أن ذلك ليس هو الواقع بأية حال من الأحوال، وذلك لأن ثقافة مجموعة C كانت مزدهرة وليس هناك ما يدل على أي انحطاط ثقافي قَطُّ هناك.
والواقع أن ثقافة مجموعة C لم تتأثر بالثقافة المصرية العالية إلا تأثرًا سطحيًّا إذ قد بقيت الصبغة الأساسية الثقافية القومية لم تتغير، ففي الأواني الجنازية بقيت العناصر التي كانت على وجه عام قد نُقِلَتْ في بداية الاختلاط بالثقافة المصرية، هذا إلى آلات أخرى وأشياء فنية قد بقيت كما هي بصورة ما، ويمكن أن تكون مستوردة من مصر أو وطنية الأصل، ومن الجائز أنه منذ عهد الدولة الوسطى قد وجدت أشياء كمالية في القبور بكثرة بعض الشيء، إذ قد وُجِدَتْ مرايا من النحاس في مجموعة ثقافة C، وكذلك قبلها وبعدها، ولكن الخناجر المصرية البحتة المصنوعة من البرنز قد وُجِدَتْ في المقابر النوبية ببلدة «عنيبة» أولًا في بداية الدولة الوسطى. ومعظم الخناجر يرجع عهدها إلى العصر المتوسط الثاني، وتوجد كذلك أسلحة في مقابر مجموعة C ولكنها نادرة. وقد عُثِرَ في قبر من مقابر «عنيبة» على قطعة عاج مشغولة وتدل على أنها صناعة مصرية بحتة، غير أن تقليد لوحات المقابر المصرية وكذلك موائد القربان قد أُخِذَ عن مصر، كما حدث ذلك في عناصر أخرى في ثقافة مجموعة C على وجه عام في عصر متأخر.
والواقع أن ثقافة مجموعة C قد اختطت لنفسها حياة خاصة وكذلك العناصر التي ثقافتها من «كرمة» فإنها تابعة بوجه خاص لعهد كانت فيه الموانع الخاصة بالحدود عند «الشلال الثاني» قد أزيلت بين البلدين.



|
|
|
|
دليل التغذية الأولى للرضيع.. ماذا أنسب طعام بعد 6 شهور؟
|
|
|
|
|
|
|
ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟
|
|
|
|
|
|
|
جامعة العميد تنظّم ندوة عن مكتبتها المركزية لطلبة كلية الطب
|
|
|