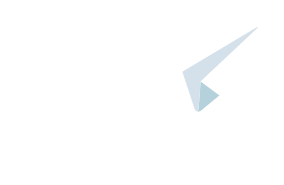علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
المعنعن والمؤنّن والمعلّق
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 222 ــ 225
2025-09-28
124
ب - 4 و5 و6 - المُعَنْعَنُ وَالمُؤَنَّنُ وَالمُعَلَّقُ:
الحديث المعنعن هو - كما يظهر من لفظه - ما يقال في سنده: «فلان عن فلان» من غير تصريح بالتحديث والسماع (1): وهو - على المعتمد - من قبيل الإسناد المتصل إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: عدالة الرواة، وثبوت لقاء الراوي لمن روى عنه، والبراءة من التدليس (2).
والمعنعن كثر في "الصحيحين"، وهو في "صحيح مسلم" أكثر؛ لأنّ مسلمًا لم يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي ومن عنعن عنه، بل أنكر في خطبة "صحيحه" هذا الشرط مع أنّه مذهب علي بن المديني والبخاري وغيرهما من أئمّة المحّدثين. وقد بنى مسلم رأيه على ما عليه أهل العلم قديمًا وحديثًا من أنّ الرواية بالعنعنة ثابتة والحجّة بها لازمة، وهي محمولة أبدًا على سماع الراوي للمروي عنه إذا كانا ثقتين متعاصرين(3).
ولم يتابع مسلمًا على رأيه أحد، بل انتقدوه فيه وأخذوه عليه، فقال ابن الصلاح: «وَفِيمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ نَظَرٌ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ القَوْلَ الذِي رَدَّهُ مُسْلِمٌ هُوَ الذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ هَذَا العِلْمِ: عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا» (4). وكانت عبارة النووي في الموضوع نفسه أصرح وأوضح حيث قال: «وَهَذَا الذِي صَارَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ قَدْ أَنْكَرَهُ المُحَقِّقُونَ، وَقَالُوا: هَذَا الذِي صَارَ إِلَيْهِ ضَعِيفٌ وَالذِي رَدَّهُ هُوَ المُخْتَارُ الصَّحِيحُ الذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ هَذَا الفَنِّ...» (5).
وذهب بعض النقّاد إلى أنّ الحديث المعنعن من قبيل المرسل، فلا يحتجّ به، وآثرت طائفة منهم الاحتجاج به رغم هذا، فقد رأوا ذلك أكثر ما يكون في مرسل الصحابي، إذا كان لا يعرف اصطلاحًا في الرواية، فتارة يقول: «سَمِعْتُ» وتارة «عَنْ رَسُولِ اللهِ» وتارة «قَالَ رَسُولُ اللهِ». لذلك استحسنوا التفصيل، فرواية الصحابي الذي لازم الرسول - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - محمولة على السماع بأيّ عبارة أدّيت، وإن كان من غير الملازمين احتمل الأمرين... (6). ولكن النووي يرى أنّ عَدَّ المعنعن من قبيل المرسل مردود بإجماع السلف (7).
وقد اعتذروا عن كثرة المعنعن في "الصحيحين"، ولا سيما في "صحيح مسلم"، بما ورد في المستخرجات عليهما من الطرق الكثيرة التي صرّح فيها بالتحديث والسماع(8)، ويشفع لمسلم فوق هذا كثرة طرق الحديث الواحد في "صحيحه" نفسه، وليست كلّها بالمعنعنة (9).
والقول الفصل للحافظ ابن حجر في شرح المواقع الثلاثة: أحدها أنّها بمنزلة «حَدَّثَنَا» و«أَخْبَرَنَا». الثاني أنّها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت من مُدَلِّسٍ. والثالث أنّها بمنزلة «أَخْبَرَنَا» المستعملة في الإجازة، فلا تخرج عن الاتصال، ولكنّها دون السماع كما أوضحنا في صور التحمّل (10).
أمّا الحَدِيثُ المُؤَنَّنُ فهو الذي يقال في سنده: «حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أَنَّ فُلاَنًا» وجعله مالك كالمعنعن، إذ سئل عن قول الراوي: «عَنْ فُلاَنٍ أَنَّهُ قَالَ كَذَا، أَوْ أَنَّ فُلاَنًا قَالَ كَذَا». فقال: «هُمَا سَوَاءٌ» (11).
وحمله البَرْدِيجِيُّ (12) على الانقطاع حتّى يتبيّن السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى (13). والحقّ ما سبق أن أشرنا إليه في بحث (السماع) من أنّ الألفاظ المختلفة التي يستعملها الراوي عبارة عن التحديث عند علماء اللسان. وإنّما الخلاف فيها بين نقّاد الحديث من جهة العرف والعادة (14).
وأمّا الحَدِيثُ المُعَلَّقُ فهو ما حذف من مبدأ إسناده واحدٌ فأكثر على التوالي، ويعزى الحديث إلى مَنْ فوق المحذوف من رواته (15). وهو في "البخاري" كثير جِدًّا. مثاله: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ...» الحديث (16).
والمعلق في "صحيح البخاري" على نوعين، أحدهما ما يكون في موضع آخر من كتابه موصولاً، فهو يتصرّف في إسناده بالاختصار مخافة التطويل، والآخر ما لا يكون إلّا معلّقًا، فهو يورده بصيغة الجزم ويستفاد منه الصّحة إلى من عَلَّقَ عنه. قال النووي: «فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَةِ الجَزْمِ كَقَالَ، وَفَعَلَ، وَأَمَرَ، وَرَوَى، [وَذَكَرَ فُلاَنٌ]، فَهُوَ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ عَنِ المُضَافِ إِلَيْهِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ مُشْعِرٌ بِصِحَّةِ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ بِهِ وَيُرْكَنُ إِلَيْهِ». وَعَلَى المُدَقِّقِ إذَا رَامَ الاِسْتِدْلاَلَ بِهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي رِجَالِهِ وَحَالِ سَنَدِهِ لِيَرَى صَلاَحِيَّتَهُ لِلْحُجَّةِ وَعَدَمِهَا (17).
ويستشعر بعض العلماء في «المُعَلَّقِ» أنّه ضرب من «المُنْقَطِعِ»، الذي سقط من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم، فقد لاحظ السيوطي أنّه «وَقَعَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" أَحَادِيثُ أُبْهِمَ بَعْضُ رِجَالِهَا» وذكر طائفة من هذه الأحاديث في بحث المنقطع (18)، مع أنّ النووي يُسمِّي نظائرها معلّقات، أو يجعل تسميتها مردّدة بين الانقطاع والتعليق، فهو يقول: «قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ...» وَيَذْكُرُ الحَدِيثَ ثُمَّ يَقُولُ: «هَكَذَا وَقَعَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِنْ جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ مُنْقَطِعًا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَاللَّيْثِ وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى مُعَلَّقًا» (19).
وأهمّ ما يعنينا في هذه الزمرة الثلاثيّة أنّ الحكم عليها بالضعف الخالص ليس من الدقّة في شيء، فهي قابلة لأن توصف بالصحّة والحسن والضعف، تَبَعًا لحال رواتها أيضًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) " التوضيح ": 1/ 330.
(2) انظر " شرح العراقي على علوم الحديث ": ص 67.
(3) قارن بـ " مقدمة صحيح مسلم ": 1/ 23.
(4) " علوم الحديث " لابن الصلاح: ص 72.
(5) " شرح صحيح مسلم " للنووي: 1/ 128.
(6) " التوضيح ": 1/ 335.
(7) " التوضيح ": 1/ 335.
(8) " قواعد التحديث ": ص 104.
(9) " شرح صحيح مسلم " للنووي: 1/ 14
(10) راجع هذه المواقع الثلاثة في " التوضيح ": 1/ 336.
(11) " التوضيح ": 1/ 337.
(12) سبقت ترجمته.
(13) " التوضيح ": 1/ 338.
(14) " الكفاية ": ص 288.
(15) " قواعد التحديث ": ص 105.
(16) " صحيح البخاري ": 3/ 64، كتاب الوكالة.
(17) ذكره في " قواعد التحديث ": ص 105.
(18) " التدريب ": ص 117، 118.
(19) " شرح صحيح مسلم ": 4/ 63
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)