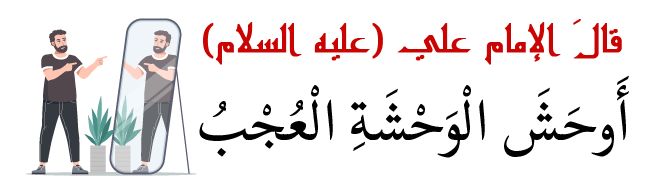
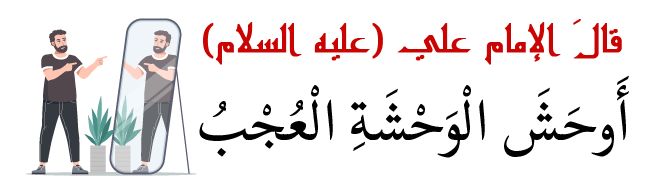

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-21
التاريخ: 2023-12-07
التاريخ: 17-10-2014
التاريخ: 2024-04-05
|
إن اختيار هذه الألفاظ إنما اتّجه بالخطاب إلى سكان الأرض الذين يهمهم أمرها ليتعرفوا على ما فيها عقليا ، ويتطلعوا إلى كشف أسرارها علميا ، بحسب الذائقة الفطرية الخالصة التي تبدو بأدنى تأمل وتلبث وترصد ، وهنا نضع أيدينا على جملة من التعابير القرآنية بألفاظ لها دلالتها الهامشية إن لم نقل المركزية في كثير من الأبعاد النقدية والبلاغية زائدا العلمية :
أ- ففي قوله تعالى :- {أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الأنبياء : 44].
يتجلى موقع «أطراف» «ننقصها» في التعبير ، ... فالأطراف توحي بنظرة شمولية لشكل الأرض ، و«ننقصها» توحي بفكرة آلية عن طبيعة انتقاص الأطراف وهاتان حقيقتان علميتان بنظرية دحو القطبين وحركتهما يوضحهما قوله تعالى :- {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس : 40].
ب- وفي قوله تعالى : {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [النور : 39].
«ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية- المنبسطة ، والخداع الوهمي للسراب ، فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع ، فأرض الصحراء وسماؤها قد طبعا عليه انعكاسهما ... حين نستخدم خداع السراب المغم ، لنؤكد بما تلقيه من خلال تبدد الوهم الهائل ، لدى إنسان مخدوع ، ينكشف في نهاية حياته غضب اللّه الشديد في موضوع السراب الكاذب ... سراب الحياة» (1) ، فلفظ «سراب» استقطب مركزيا دلالته من خلال البيئة العربية المشاهدة المحسوسة ، وكما يتلاشى هذا السراب فجأة ، وينطفي تلألؤه بغتة ، فكذلك ما أمله هؤلاء الكافرون بأعمالهم الخادعة ، متماثلة معه في خداع البصر وانطماس الأثر ، فلو عطفنا دلالة «الظمآن» الإيحائية ، لوجدنا الظمآن في تطلبه للماء ، ووصوله إلى السراب يقضي حسرة أشد ، وفاقة أعظم ، وحاجة متواصلة ، ولكنه يصطدم بالحقيقة الكبرى وهي اللّه تعالى ، فيوفّيه حسابه ، دون معادلات معروفة ، فلا المراد حقق ، ولا الحياة استبقى ولا الثواب استقصى ، وإنما هي حسرات في حسرات.
ح- ولو تتبعنا مآل هؤلاء الكافرين في خيبة آمالهم وخسران أعمالهم ، لوجدنا الصورة المتقابلة مع تلك الصورة بقوله تعالى :- {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور : 40] ، ليتضح في التصوير القرآني عظم الدلالة من خلال هيئتين متقابلتين ونموذجين مختلفين ، فبعد أن أوضحت الصورة الفنية الأولى الشعاع الكاذب في السراب والالتماع الخلب في البيداء ، عقبت ذلك بنقيض الشعاع والالتماع وبعد تصوير الخيبة من الظفر بالسناء ، عقبته بالظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض والفوقيات المتراكبة طبقا عن طبق فهي ظلمات في بحر لا قعر له ، عميق غزير المياه ، تحوطه الأمواج المتدافعة ، والسحب الثقال ، والظلمات المتعاقبة في ثلاثة مظاهر من ظلام الليل ، وظلام الغمام ، وظلام البحر حتى ليخطئوه تمييز يديه ، فلا يرى ذلك إلا بعد عسر وحرج ، أو لا يرى ذلك أصلا ، وأنى له الرؤية ، وقد انغمس في ظلمات الكفر وارتطم بمتاهات الضلال ، فانعدمت الرؤية ، وانطمست البصيرة ، فهو في شبهات لا نجاة معها ، ومن لم يقدر له الخلاص من اللّه فلا خلاص له» (2).
يقول الأستاذ مالك بن نبي عن هذه الآية :- «فهذا المجاز يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي للقرآن ، بل لا علاقة لها بالمستوى العقلي أو المعارف البحرية في العصر الجاهلي وإنما هي في مجموعها منتزعة من بعض البلدان الشمالية التي يلفها الضباب ، ولا يمكن للمرء أن يتصورها إلا في النواحي كثيفة الضباب في الدنيا الجديدة ، فلو افترضنا أن النبي رأى في شبابه منظر البحر فلن يعدو الأمر شواطئ البحر الأحمر أو الأبيض ومع تسليمنا بهذا الفرض فلسنا ندري كيف كان يمكن أن يرى الصورة المظلمة التي صورتها الآية المذكورة ؟ وفي الآية فضلا عن الوصف الخارجي الذي يعرض المجاز المذكور سطر خاص بل سطران : أولهما : الإشارة الشفافة إلى تراكب الأمواج ، والثاني : هو الإشارة إلى الظلمات المتكاثفة في أعماق البحار ، وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع البحر ، وهي معرفة لم تعرف للبشرية إلا بعد معرفة جغرافية المحيطات ، ودراسة البصريات الطبيعية ، وغني عن البيان أن نقول : إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج ، وظاهرة امتصاص الضوء واختفائه في عمق معين في الماء ، وعلى ذلك فما كان لنا أن ننسب هذا المجاز إلى عبقرية صنعتها الصحراء ولا إلى ذات إنسانية صاغتها بيئة قارّيّة» (3).
هذه الظواهر الثلاث في دلالة الألفاظ ، توصلنا إلى المنهج الدلالي الأم في استكناه أصول الدلالة وهذا المنهج الأصل هو القرآن الكريم بحق.
ومن هذا المنطلق فقد وجدنا الخطابي (ت : 388 هـ) بالذات عالما ودلاليا فيما أورده من افتراضات ، وما أثبته من تطبيقات بالنسبة لجملة من ألفاظ القرآن الكريم بتقرير أنها لم تقع- ما زعموا توهما- في أحسن وجوه البيان وأفصحها ، لمخالفتها لوضعي الجودة والموقع المناسب عند أصحاب اللغة ، وذلك كدعوى افتراضية ، يتعقبها بالرد والكشف والدفاع.
والألفاظ هي كما يلي نذكرها ونعقبها في آياتها في موارد اختيارها من قبل الخطابي نفسه ليرد عليها فيما بعد :- 1- فأكله ، من قوله تعالى : {فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ} [يوسف : 17].
2- كيل ، من قوله تعالى : {ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ} [يوسف : 65].
3- امشوا ، من قوله تعالى : {وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا } [ص : 6].
4- هلك ، من قوله تعالى : {هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة : 29].
5- لحب ، من قوله تعالى : {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ } [العاديات : 8].
6- فاعلون ، من قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [المؤمنون : 4].
7- سيجعل ، من قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا } [مريم : 96].
8- ردف ، من قوله تعالى : {قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ } [النمل : 72].
أ- {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} [الحج : 25].
ب- {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} [الأحقاف : 33].
هذه النماذج التي أبانها الخطابي تعقب عادة بالحجج المدعاة أولا فيوردها ، ولكنه يفندها واحدة كما سنرى (4).
فقد ذهبوا في فعل السباع خصوصا إلى الافتراس ، وأما الأكل فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان.
وقالوا ما اليسير والعسير من الكيل والاكتيال وما وجه اختصاصه به ؟
وقد زعموا بأن المشي في هذا ليس بأبلغ الكلام ، ولو قيل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لما كان أبلغ وأحسن وأدعوا إنما يستعمل لفظ الهلاك ، في الأعيان والأشخاص كقوله :
هلك زيد ، فأما الأمور التي هي معان وليست بأعيان ولا أشخاص فلا يكادون يستعملونه فيها ...
وأنت لا تسمع فصيحا يقول : أنا لحب زيد شديد وإنما وجه الكلام وصحته أن يقال : أنا شديد الحب لزيد وللمال.
ولا يقول أحد من الناس فعل زيد الزكاة ، وإنما يقل زكّى الرجل ماله.
ومن الذي يقول : جعلت لفلان ودا بمعنى أحببته؟ وإنما يقول : وددته وأحببته.
وفي ردف إنما هو يردفه من غير إدغام اللام ، والباء لا موضع لها في الحاد أو بظلم ، ولو قيل : قادر على أن يحيي الموتى كان كلاما صحيحا لا يشكل معناه ولا يشتبه (5).
وقد حررت للخطابي مقارنة سليمة في الإجابة عن هذه الافتراضات ردا ومناقشة وبيان حال ، وسأحاول أن ألخصها بشكل لا تفقد فيه جوهرها ، وأوردها بصورة تحكي عن هدف صاحبها ولعل في ذكرها تخليدا لذكراه ، ولكن فيها أيضا وأولا ، بيانا لطاقات بيانية مهمة واستعمالات بلاغية رائدة ، انفرد بها القرآن دون سائر النصوص الإلهية والبشرية ، مما يجعل الخطابي- رحمه اللّه- من أوائل أولئك الأفذاذ الذين يسروا الطريق أمام فهم القرآن بلاغيا ونقديا على الوجه التالي :- 1- فأما قوله تعالى : {فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ} [يوسف : 17] . ، فإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب ، واصل الفرس دق العنق ، والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلا ، وأتى على جميع أجزائه وأعضائه فلم يترك مفصلا ولا عظما ، وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه ، فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة ، والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى ، فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل على أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع.
وحكى ابن السكيت في ألفاظ العرب قولهم :- أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا.
2- وأما قوله تعالى : {وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ} [يوسف : 65].
فإن معنى الكيل المقرون بذكر البعير والمكيل ، والمصادر توضع موضع الأسماء كقولهم : هذا درهم ضرب الأمير ، هذا ثوب نسيج اليمن ، أي مضروب الأمير ، ونسيج اليمن والمعنى في الآية : أنا نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبنا أخونا حمل بعير ، فإنه كان لكل رأس منهم حمل واحد لا يزيد على ذلك لعزة الطعام ، فكان ذلك في السنين السبع المقحطة ، وكانوا لا يجدون الطعام إلا عنده ولا يشير لهم صراحة إلا من قبله ، فقيل على هذا المعنى ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ يوسف/ 65.
أي متيسر لنا إذا تسببنا إلى ذلك باستصحاب أخينا ، واليسير شائع الاستعمال فيما يسهل من الأمور كالعسير مما يتعذر منها ولذلك قيل : يسر الرجل.
وقد قيل : إن معنى الكيل هنا السعر ، أخبرني أبو عمرو عن أبي العباس قال : الكيل بمعنى السعر ، فكيف الكيل عندكم؟ بمعنى كيف السعر؟
3- وأما قوله سبحانه : {أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ} [ص : 6].
وقول من زعم أنه لو قيل بدله : امضوا وانطلقوا كان أبلغ فليس الأمر على ما زعمه ، بل امشوا في هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى وذلك لأنه إنما قصد به الاستمرار على العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة في غير انزعاج منهم ، ولا انتقال عن الأمر الأول ، وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور به في قوله : {وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ} [ص : 6].
والمعنى كأنهم قالوا : امشوا على هينتكم وإلى مهوى أموركم ، ولا تعرجوا على قوله ولا تبالوا به ... وقيل بل المشي هاهنا معناه التوفر في العدد والاجتماع للنصرة دون المشي الذي هو نقل الأقدام.
4- وأما قوله سبحانه : {هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ } [الحاقة : 29] ، وزعمهم أن الهلاك لا يستعمل إلا في تلف الأعيان فإنهم ما زادوا أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه ، وقد تكون الاستعارة في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة كقوله عزّ وجلّ : {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ } [يس : 37].
والسلخ هاهنا مستعار هو ابلغ منه لو قال نخرج منه النهار وإن كان هو الحقيقة ، وكذلك قوله : {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} [الحجر : 94] ، وهو أبلغ قوله فأعمل بما تؤمر وإن كان هو الحقيقة ، والصدع مستعار ، وكذلك قوله :
{هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة : 29] ، وذلك أن الذهاب قد يكون على مراصده العودة ، وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعى ، وقد قيل إن معنى السلطان هاهنا الحجة والبرهان.
5- وأما قوله سبحانه : {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات : 8] ، وأن الشديد معناه هاهنا البخيل ، واللام في قوله (لحب الخير) بمعنى لأجل حب الخير وهو المال لبخيل.
6- وأما قوله عزّ وجلّ : {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [المؤمنون : 4] ، وقولهم إن المستعمل في الزكاة المعروف من الألفاظ ، كالأداء ، والإيتاء ، والإعطاء ... فالجواب إن هذه العبارات لا تستوي في مراد هذه الآية ، وإنما تفيد حصول الاسم فقط ، ولا تزيد على أكثر من الأخبار على أدائها فحسب ، ومعنى الكلام ومراده المبالغة في أدائها والمواظبة عليه حتى يكون ذلك صفة لازمة لهم فيصير في أداء الزكاة فعلا لهم مضافا إليهم يعرفون به ، فهم له فاعلون ، وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا بهذه العبارة ، فهي إذن أولى العبارات وأبلغها في هذا المعنى.
7- وأما قوله عزّ وجلّ : {سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} [مريم : 96] ، وإنكارهم قول من يقول : جعلت لفلان ودّاً ، بمعنى وددته فإنهم قد غلطوا في تأويل هذا الكلام ، وذهبوا عن المراد منه ، وإنما المعنى أن اللّه سيجعل لهم في قلوب المؤمنين ، أي يخلق لهم في صدور المؤمنين ، ويغرس لهم فيها محبة كقوله عزّ وجلّ : {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ...} [النحل : 72] ، أي خلق.
8- وأما قوله سبحانه : رَدِفَ لَكُمْ النمل/ 72 ، فإنهما لغتان فصيحتان : ردفته وردفت له كما نقول نصحته ، ونصحت له.
9- وأما قوله : {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ } [الحج : 25] ، ودخول الباء فيه فإن هذا الحرف كثيرا ما يوجد في كلام العرب الأول الذي نزل القرآن به ، وإن كان يعز وروده في كلام المتأخرين ، قال أبو عمرو بن العلاء : اللسان الذي نزل به القرآن ، وتكلمت به العرب على عهد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم عربية أخرى (6) عن كلامنا هذا.
نقول : قد قيل إن الباء زائدة ، والمعنى : ومن يرد فيه إلحاداً والباء قد تزاد في مواضع من الكلام ، ولا يتغير به المعنى ، وعليه شواهد من كلام العرب.
لقد كان الخطابي دقيقا فيما أورده من إفاضات في هذا المجال استند فيها إلى المتبادر في العرف العربي العام واستشهد على صحة ذلك بالموروث الأدبي عند العرب شعرا ومثلا وكلمة وقولا مصداقا على ما يريد ، وقلّب كل لفظ في وجوهه المحتملة فضلا عن استنارته بآراء علماء العربية وأهل اللغة وأئمة البيان مستوفيا بذلك موقع اللفظ في دلالته على المعنى ، وصحة اختياره في استيفاء المؤشر الدلالي ، مؤكدا على العرف العربي والاستعمال البياني ، والأصالة اللغوية ، في كشف الدلالات التي ينطوي عليها اللفظ المختار في الآيات المشار إليها اللفظ ذاته دون سواه ، ومعللا بفطرة نافذة التركيب من خلال وضع الألفاظ بأماكنها المحددة لها ، بحيث لو استبدلت بالمرادف أو المساوي لفقدت مميزات لا تتوافر باللفظ البديل ، ولو جرت على سنن ما يفترض المدعون لافتقرت إلى عبارات إضافية من أجل أن يخلص إلى المعنى الذي يريده القرآن في ألفاظه المنتقاة إزاء الدلالات المقصودة بالذات.
أما أنواع الدلالات وأقسامها في كل من البحث الدلالي والقرآن فهو معلم مستفيض ينهض بعمل فني مستقل يشمل مدارك الدلالات كافة.
_________________________
(1) مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية : 355.
(2) ظ : المؤلف ، الصورة الفنية في المثل القرآني : 281- 282.
(3) مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية : 356.
(4) الخطابي ، بيان إعجاز القرآن : 38 وما بعدها.
(5) الخطابي ، بيان إعجاز القرآن : 38 ، وما بعدها بتصرف واختصار.
(6) الخطابي ، بيان إعجاز القرآن : 41- 48.

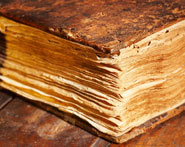
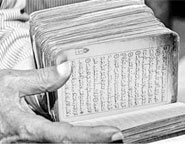
|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يحتفي بذكرى عيد الغدير في بغداد
|
|
|