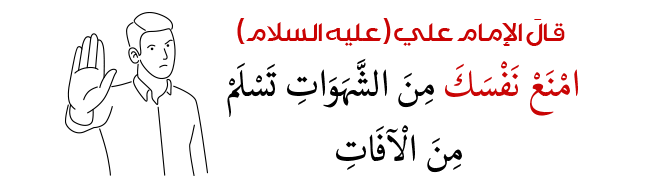
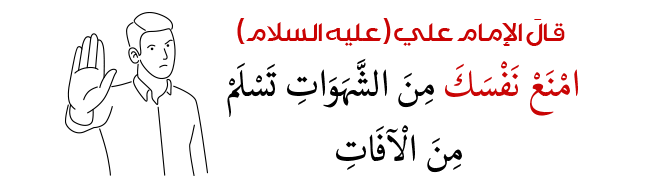

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 14-2-2017
التاريخ: 3-2-2017
التاريخ: 10-2-2017
|
قال تعالى : {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً} [النساء : 42] .
[قال تعالى ] : {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ} معناه : لو تجعلون والأرض سواء كما قال تعالى : {ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا} ، ومن التسوية قوله : {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} : أي نجعلها صفيحة واحدة ، لا يفصل بعضها عن بعض ، فيكون كالكف ، فيعجز لذلك عما يستعان عليه من الأعمال بالبنان . وروي عن ابن عباس إن معناه يودون أن يمشي عليهم أهل الجمع ، يطؤونهم بأقدامهم ، كما يطأون الأرض .
وعلى القول الأول : فالمراد به أن الكفار يوم القيامة يودون أنهم لم يبعثوا ، وأنهم كانوا والأرض سواء ، لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب ، والخلود في النار .
وروي أيضا أن البهائم يوم القيامة تصير ترابا ، فيتمنى عند ذلك الكفار أنهم صاروا كذلك ترابا . وهذا لا يجيزه إلا من قال : إن العوض منقطع ، وهو الصحيح . ومن قال : إن العوض دائم لم يصحح هذا الخبر . وقوله ﴿ولا يكتمون الله حديثا﴾ قيل فيه أقوال أحدها : إنه عطف على قوله ﴿لو تسوى﴾ : أي ويودون أن لو لم يكتموا الله حديثا ، لأنهم إذا سئلوا قالوا : {والله ربنا ما كنا مشركين} فتشهد عليهم جوارحهم ، بما عملوا فيقولون يا ليتنا كنا ترابا ، ويا ليتنا لم نكتم الله شيئا ، وليس ذلك بحقيقة الكتمان ، فإنه لا يكتم شيء عن الله ، لكنه في صورة الكتمان ، وهذا قول ابن عباس . وثانيها : إنه كلام مستأنف ، والمراد به أنهم لا يكتمون الله شيئا من أمور دنياهم وكفرهم ، بل يعترفون به ، فيدخلون النار باعترافهم ، وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا ينفعهم الكتمان ، وإنما يقولون : {والله ربنا ما كنا مشركين} في بعض الأحوال ، فإن للقيامة مواطن وأحوالا ، ففي موطن لا يسمع كلامهم إلا همسا ، كما أخبر تعالى عنهم ، وفي موطن ينكرون ما فعلوه من الكفر والمعاصي ، ظنا منهم أن ذلك ينفعهم ، وفي موطن يعترفون بما فعلوه ، عن الحسن وثالثها : إن المراد أنهم لا يقدرون على كتمان شيء من الله ، لان جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه ، فالتقدير لا تكتمه جوارحهم ، وإن كتموه . ورابعها : إن المراد ودوا لو تسوى بهم الأرض ، وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد ، وبعثه ، عن عطا وخامسها : إن الآية على ظاهرها ، فالمراد ولا يكتمون الله شيئا ، لأنهم ملجأون إلى ترك القبائح والكذب ، وقولهم {والله ربنا ما كنا مشركين} ، أي ما كنا مشركين عند أنفسنا ، لأنهم كانوا يظنون في الدنيا أن ذلك ليس بشرك من حيث تقربهم إلى الله ، عن أبي القاسم البلخي .
________________
1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 89-90 .
{يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ} . المعنى ان الكفار يتمنون يوم القيامة ، حيث ينكشف لهم الغطاء لو انهم لم يخلقوا ، وانهم كانوا والأرض سواء ، أي ترابا ، كما في الآية 40 من سورة النبأ : {يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ ويَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً} .
{ولا يَكْتُمُونَ اللَّهً حَدِيثاً} . هذا كلام مستأنف ، ومعناه انهم لا يستطيعون كتمان ذنب من ذنوبهم التي اقترفوها ، وأخفوها عن أعين الناس في الدنيا ، لأن اللَّه سبحانه محيط بهم وبأعمالهم ، ولأن الملائكة وسمعهم وأبصارهم وألسنتهم وجلودهم وأيديهم وأرجلهم ، كل هؤلاء تشهد عليهم بما كانوا يفعلون : {حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وأَبْصارُهُمْ وجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ - 20 فصلت} . . {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وأَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ - 25 النور} .
اللهم رحمة بمن لا طاقة له بعدلك ، وغوثا لمن لا نجاة له دون عفوك .
وتسأل : كيف تجمع بين قوله تعالى : {ولا يَكْتُمُونَ اللَّهً حَدِيثاً} وبين قوله : {ويَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا واللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ - 23 - 24 الأنعام}.
الجواب : من الجائز أن يكون مرادهم انهم لم يكونوا مشركين في اعتقادهم ، حتى تحقق لهم الآن شركهم وخطأهم .
_______________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 328 .
قوله تعالى : { يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ } الآية . نسبة المعصية إلى الرسول يشهد أن المراد بها معصية أوامره صلى الله عليه وآله الصادرة عن مقام ولايته لا معصية الله تعالى في أحكام الشريعة ، وقوله : { لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ } كناية عن الموت بمعنى بطلان الوجود نظير قوله تعالى : { وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً } : [ النبأ : 40 ]
وقوله : { وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً } ظاهر السياق أنه معطوف على موضع قوله : { يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا } وفائدته الدلالة بوجه على ما يعلل به تمنيهم الموت ، وهو أنهم بارزون يومئذ لله لا يخفى عليه منهم شيء لظهور حالهم عليه تعالى بحضور أعمالهم ، وشهادة أعضائهم وشهادة الأنبياء والملائكة وغيرهم عليهم ، والله من ورائهم محيط فيودون عند ذلك أن لو لم يكونوا وليس لهم أن يكتموه تعالى حديثا مع ما يشاهدون من ظهور مساوي أعمالهم وقبائح أفعالهم.
وأما قوله تعالى : { يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ } : [ المجادلة : 18 ] فسيجيء إن شاء الله تعالى أن ذلك إنما هو لإيجاب ملكة الكذب التي حصلوها في الدنيا لا للإخفاء وكتمان الحديث يوم لا يخفى على الله منهم شيء .
_____________________
1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 302 .
يقول سبحانه : {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ} .
وقد ورد مثل هذا التعبير في آخر سورة النبأ إذ يقول تعالى : {وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً} .
ولكن لفظة {لَوْ تُسَوَّى} تشير إلى مطلب آخر أيضا ، وهو : إنّ الكفار مضافا إلى أنّهم يتمنون أن يصيروا ترابا ، يحبّون أن تضيع معالم قبورهم في الأرض أيضا وتسوى بالأرض حتى ينسوا بالمرّة ، ولا يبقى لهم ذكر ولا خبر ولا أثر.
إنّهم في هذه الحالة لا يمكنهم أن ينكروا أية حقيقة واقعة ولا أن يكتموا شيئا : {وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً} لأنّه لا سبيل إلى الإنكار أو الكتمان مع كل تلكم الشهود .
نعم ، لا ينافي هذا الكلام ما جاء في الآيات الأخر التي تقول : هناك من الكفار من يكتم الحقائق يوم القيامة أيضا ويكذبون (2) لأنّ كذبهم وكتمانهم واقع قبل إقامة الشهود وقيام الشهادة ، وأمّا بعد ذلك فلا مجال لأي كتمان ، ولا سبيل إلى أي إنكار ، بل لا بدّ من الاعتراف بجميع الحقائق.
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه أنّه قال عن يوم القيامة «ختم على الأفواه فلا تكلم وتكلمت الأيدي وشهدت الأرجل ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا» . (3)
هذا ويحتمل بعض المفسرين أن يكون المراد من {لا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً} أنّهم يتمنون لو أنّهم لم يكتموا في الدنيا أية حقيقة ، خصوصا في ما يتعلق برسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى هذا تكون هذه العبارة عطفا على جملة {لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ} .
ولكن هذا التّفسير لا ينسجم مع ظاهر «لا يكتمون» الذي هو فعل مضارع ، ولو كان المراد ما ذكره هذا الفريق من المفسرين لوجب أن يقول : «لم يكتموا».
__________________
(1) تفسير الأمثل ، ج3 ، ص139 .
(2) (٢٢) و (٢٣) من سورة الأنعام ، والآية (8) من سورة المجادلة.
(3) تفسير نور الثّقلين ، ج ١ ، ص ٤٨٢ ؛ تفسير العياشي ، ج1 ، ص 242 ، ح 132 .

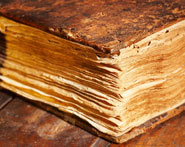
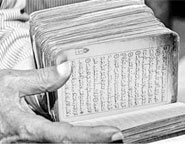
|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تقيم حفلاً بذكرى عيد الغدير الأغر
|
|
|