

| تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ جعفر بن محمد بن مسرور. |
|
|
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24/9/2022
التاريخ: 2023-07-28
التاريخ: 2024-02-28
التاريخ: 2024-05-02
|
جعفر بن محمد بن مسرور (1):
جعفر بن محمد بن مسرور شيخ الصدوق (قده) الذي روى عنه في مواضع كثيرة ليس له توثيق في كتب الرجال بناء على عدم اتحاده مع جعفر بن محمد بن قولويه الثقة الجليل، ولكن بالرغم من ذلك فإنّ المختار قبول روايته؛ لأنّه ممّن ترضّى عليه الصدوق (قده) في شتّى كتبه ولا سيما في مشيخة الفقيه، والترضّي - كما مرّ مراراً - آية الجلالة عند المتقدّمين.
وبذلك يظهر أنّ البحث عن اتحاده مع ابن قولويه قليل الجدوى وفق المسلك المختار، لاعتبار روايته على كل تقدير، إلا أنّه مع ذلك لا بأس بالتطرّق إلى هذا البحث، فإنّه يجدي على المسلك الآخر في موارد شتّى، إذ وقوع ابن مسرور منفرداً في طريق الصدوق في المشيخة إلى غير واحد من الرواة، كما أنّه روى عن طريقه في كتبه الأخرى من العلل والعيون والمعاني وغيرها عشرات الروايات، فينبغي التحقّق من اعتبار هذه الروايات بناء على عدم ثبوت وثاقة ابن مسرور بعنوانه..
فأقول: إنّ أول مَن احتمل اتحاد ابن مسرور مع ابن قولويه هو المحقّق الوحيد البهبهاني (قده) (2)، قائلاً في جعفر بن محمد بن مسرور: (يحتمل كونه جعفر بن محمد بن قولويه؛ لأنّ قولويه اسمه مسرور).
وقد جزم بالاتحاد جمع من الأعلام منهم السيّد البروجرديّ (قده) (3)، ولكن أنكره جمع آخر منهم المحدّث النوري والمحقّق التستري والسيّد الأستاذ (قده) (4).
وينبغي التعرّض لأهم ما يمكن أن يستشهد به لكلّ من الوجهين:
أ - أمّا الاتّحاد فيمكن أن يستشهد له بأمرين:
الأمر الأول: أنّ النجاشي ذكر ابن قولويه بهذا العنوان: (جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم وكان أبوه يلقّب مسلمة) وذكر علياً أخا ابن مسرور بهذا العنوان: (علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، وأبوه يلقّب مملة). ويظهر من بعض الأسانيد الآتية أنّ ابن مسرور كان يكنّى أيضاً بأبي القاسم، وهما من طبقة واحدة كما سيأتي.
فقد يقال: إنّه يستبعد وجود شخصين في طبقة واحدة يسمّيان بجعفر ووالدهما يسمّى بمحمد وجدّهما يسمّى بجعفر، وهما يكنّيان بأبي القاسم، فيمكن البناء على اتحادهما لذلك.
ولكن هذا الكلام ليس بشيء، فإنّه قد وقع نظير ما ذكر بالنسبة إلى بعض الرواة، كمحمد بن علي بن إبراهيم الهمداني ومحمد بن علي بن إبراهيم القرشي، فإنّهما رجلان ذكرهما ابن الغضائري في رجاله واستثنى ابن الوليد رواياتهما من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، ويكنّى كلّ واحد منهما بأبي جعفر ويشتركان في الاسم واسم الأب واسم الجد، كما أنّهما من طبقة واحدة، حتّى ظن البعض أنّهما عنوانان لشخص واحد مع وضوح التغاير بينهما.
وبالجملة: مجرّد الاشتراك بالمقدار المذكور لا يقتضي الاتّحاد، ولكن يمكن أن يقوى احتمال الاتحاد باشتراكهما في جوانب أخرى أيضاً:
الأول: أنّ جدهما الأعلى أي جد والدهما يسمّى بـ(موسى).
الثاني: أنّ لكل منهما أخاً يسمّى بـ(علي)، أمّا جعفر بن محمد بن مسرور فأخوه علي مترجم في كتاب النجاشي - كما تقدّم - وأمّا جعفر بن محمد بن قولويه فأخوه على مذكور في كتاب كامل الزيارات حيث روى عنه في موارد شتّى.
الثالث: أنّ معظم من روى عنه ابن مسرور قد روى عنه ابن قولويه كالحسين بن محمد بن عامر ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري والحسن بن عبد الله بن عيسى.
الرابع - ولعلّه الأهم: أنّ والد كلّ منهما يلقّب بما هو قريب في رسم الخط من لقب الآخر، حيث تقدّم عن النجاشي أنّه قال في جعفر بن محمد بن قولويه: (كان أبوه يلقّب مسلمة)، وقال بشأن علي بن محمد بن مسرور: (أبوه يلقّب مملة)، ولفظتا (مسلمة) و(مملة) قريبتان في رسم الخط، ومن القريب جداً أن تكون إحداهما مصحّفة عن الأخرى، فإنّه يبعد اتفاق وجود رجلين في طبقة واحدة يشتركان في كلّ ما تقدّم بالإضافة إلى تلقّب أبيهما بلقبين متقاربين جداً في رسم الخط.
والملاحظ أنّه لم يرد ذكر للقبهما في أيّ مصدر آخر غير رجال النجاشي، ولذلك لا يتيسّر تمييز الصحيح منهما عن المصحّف.
علماً أنّ (مسلمة) من الأسماء المتعارفة، وقد ذكروا تسمية العديد من الصحابة به (5)، وأمّا (مملة) فلم أجده في شيء من الأسماء أو الألقاب، نعم ذكر بعض اللغويّين (6) أنّه يقال: (ناقة مملة إذا كانت متعبة من كثرة الركوب)، ولعلّ هذا يناسب ما ذكره الشيخ (7) في ترجمة محمد بن قولويه من تلقيبه بـ(الجمّال) كما في بعض النسخ، ولكن في بعضها الآخر (الحمّال)، فليتدبّر.
الخامس: أنّ أخا كلّ منهما المسمّى بـ(علي) - كما تقدّم ـ لم يطل به العمر بل مات وهو حدث السن. أمّا علي بن محمد بن جعفر بن مسرور فقد صرّح النجاشي بأنّه مات حدث السن لم يسمع منه. وأمّا علي بن محمد بن جعفر بن قولويه فيشهد لوفاته وهو حدث السن لم يسمع منه الأصحاب أنّه لا توجد له روايات في كتب الأحاديث إلا ما أورده عنه أخوه جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات ولو كان ممّن طال به العمر لكان له بحسب المتعارف تلامذة ورواة كأخيه جعفر، ولورد ذكره في كتب الفهارس وأسانيد الأحاديث، فليتدبّر.
الأمر الثاني: ما استند إليه السيّد البروجرديّ (قده) (8) وغيره من أنّ النجاشي قد ترجم (9) لعلي بن محمد بن جعفر بن مسرور قائلاً: (أبو الحسين يلقّب أبوه مملة، روى الحديث ومات حدث السن لم يسمع منه، له كتاب فضل العلم وآدابه. أخبرنا محمد والحسن بن هدية: قالا حدّثنا جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدّثنا أخي به).
فإنّ هذا الكلام يدل على أنّ علي بن محمد بن موسى بن مسرور هو أخو جعفر بن محمد بن قولويه، إذ السند ينتهي إلى ابن قولويه وصاحب الترجمة والكتاب هو ابن، مسرور ويعبّر عنه في روايته عنه بـ(أخي)، فهل يوجد شاهد أوضح من هذا على اتّحاد جعفر بن قولويه وجعفر بن مسرور؟
ولكن ناقش السيّد الأستاذ (قده) في هذا الاستشهاد بوجه ذكره مختصراً في كتاب المعجم (10)، وفصّله في بحوثه الفقهيّة (11) قائلاً: (إنّ النجاشي لم يقل: إنّ علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور روى كتابه أخوه جعفر بن محمد بن قولويه، ليدل على أنّ علياً وجعفراً أخوان كي يقتضي الاتحاد المزبور، بل قال بعد أن ذكر أنّ علياً له كتاب فضل العلم وآدابه: إنّ جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدّثنا أخي به، أي بالكتاب. وأمّا أنّ أخاه مَن هو، هل هو على ـ أي علي بن مسرور ـ أم غيره؟ فلا دلالة في العبارة عليه أصلاً.
وبعبارة أخرى: فرق واضح بين أن يقول - بعد ذكر علي بن مسرور وأنّ له كتاباً - روى جعفر بن قولويه عن أخيه بكتابه وبين أن يقول روى جعفر بن قولويه عن أخيه بالكتاب، فإنّ الأول يدل على أخوّة جعفر وعلي وأنّ أخاه هو علي صاحب الكتاب بخلاف الثاني، إذ مفاده أنّ أخاه هو الراوي لذلك الكتاب من دون أي دلالة على أنّه هو صاحب الكتاب كي يثبت به أخوّته مع علي حتّى ينتج الاتّحاد المزبور).
أقول: يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنّه لو لم يكن صاحب الترجمة أخاً لجعفر بن محمد بن قولويه لكانت العبارة ناقصة، إذ كان ينبغي أن تكون هكذا (حدّثنا أخي به عنه)، فإنّ الكتاب إنّما يروى عن صاحبه، فلو كان المراد بأخيه هو صاحب الترجمة فلا نقصان في العبارة وإلا فتنقصها لفظة (عنه)، وحيث إنّ النقصان خلاف الظاهر فلا بدّ من البناء على أنّ المراد بأخيه هو صاحب الترجمة، لا غيره.
ولكن الملاحظ أنّه قد وقع نظير هذا في مواضع شتّى من رجال النجاشي، ففي ترجمة إبراهيم بن أبي بكر (12): (له كتاب نوادر، أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن حسان به)، ولم يقل: عن محمد بن حسان به عنه. وفي ترجمة الحسين بن أبي سعيد المكاري (13): (له كتاب نوادر كبير، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن حبشي عن حميد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة به) ولم يقل: به عنه. وفي ترجمة الحسن بن ظريف (14): (له نوادر، والرواة عنه كثيرون، أخبرنا إجازة محمد بن محمد عن الحسن بن حمزة قال: حدثنا ابن بطّة عن محمد بن علي) ولم يقل: عنه. وفي ترجمة خالد بن ماد (15): (له كتاب.. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان وغيره عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار عن الحميريّ قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار عن النضر بكتاب خلّاد ولم يقل: بكتاب خلّاد عنه.. إلى غير ذلك من الموارد.
نعم، الغالب في رواية الكتب في الفهارس الإتيان بلفظ (عنه) في آخر السند، ولكن بالنظر إلى شيوع خلافه في كتاب النجاشي يصعب الاطمئنان بكون المقصود في المورد المبحوث عنه هو ما ذكره السيّد البروجرديّ (قده).
لا يقال: إنّ حذف لفظ (عنه) في الموارد المتقدّمة وما ماثلها غير ضائر؛ لوجود القرينة على أنّ المقصود هو رواية الكتاب عن صاحب الترجمة، وأمّا هنا فلو كان المقصود رواية ابن قولويه للكتاب بواسطة أخيه عن صاحبه لكان ينبغي أن يأتي بلفظ (عنه) دفعاً للالتباس.
فإنّه يقال: لعلّ النجاشي اعتمد في إفادة ذلك على وضوح مغايرة ابن قولويه مع ابن مسرور صاحب الترجمة في عصره فلم يجد حاجة إلى ذكر لفظ (عنه)، فليتأمّل (16).
لا يقال: لو كان المراد بقول ابن قولويه (حدّثنا أخي) غير صاحب الترجمة لكان من المناسب جداً أن يذكره بالاسم، فإنّ الإبهام على هذا النحو ليس متعارفاً في الأسانيد.
فإنّه يقال: بل يوجد مثله في موارد شتّى، ومنها في كتاب كامل الزيارات حيث يلاحظ أنّ جعفر بن محمد بن قولويه يصرح في بعض الموارد باسم أخيه فيقول (17): (حدّثني أخي علي بن محمد بن قولويه) وفي معظم الموارد يقول (18): (حدثني أبي وأخي) ولا يصرّح باسم أخيه، ولعلّ النجاشي وجد في كتاب جعفر بن محمد بن قولويه أنّه ذكر كتاب علي بن محمد بن جعفر بن مسرور قائلا: (حدثني أخي به) غير مصرّح باسم أخيه، فأورده كما وجده فيه.
والحاصل: أنّ الأمر الثاني الذي استشهد به لاتحاد ابن مسرور وابن قولویه ليس بذلك الوضوح، والعمدة هي الأمر الأول.
ب - وأمّا المغايرة فيمكن أن يستشهد لها بأمور:
الأمر الأول - وهو الأهم: أنّ أبا الفتح محمد بن علي الكراجكي المتوفّى سنة (449 هـ) قد أورد في كتابه كنز الفوائد (19) حديثاً من أحاديث المناقب ثم قال: (حدثني به من طريق العامّة الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمي، ونقلته من كتابه المعروف بإيضاح دفائن النواصب (20) وقرأته عليه بمكّة في المسجد الحرام سنة (412 هـ) قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن مسرور اللجّام (21) قال: حدثنا الحسين بن محمد..).
وهذا الحديث موجود في كتاب (مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنينـ عليه السلام ـ) لابن شاذان (22) مروياً عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن مسرور اللحّام.
وفيه أيضاً حديث آخر نحوه (23) عن اللحّام نفسه.
وذكر الكراجكيّ في موضع آخر من كنز الفوائد (24) ما لفظه: (حدثنا الشيخ أبو الحسن بن شاذان قال: حدثني خال أمي أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن الحسين..)، وفي موضع غيره (25) هكذا: (أخبرني الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي (رضي الله عنه) عن خال أمه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) عن محمد بن يعقوب الكليني)، وفي موضع آخر (26) أورد رواية عن ابن شاذان عن جعفر بن محمد بن قولويه، ولكن لا تشتمل الطبعة الحديثة هنا على التعبير عنه بخال أمه، إلا أنّه يوجد بدله في الطبعة الحجريّة (27) التعبير عنه بـ (خالي)، ولعلّ الصحيح (خال أمي).
وأيضاً أورد الشيخ في كتاب الأمالي رواية عن ابن شاذان عبّر فيها عن ابن قولويه بالخال هكذا (28): (أخبرنا أبو الحسن - أي ابن شاذان ـ قال: حدثني الخال أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه)، وفي موضع آخر من الأمالي أورد عنه رواية عن ابن جعفر بن محمد بن قولويه عبر عنه فيها بابن الخال هكذا (29): (أخبرنا أبو الحسن قال: حدثني ابن الخال أبو أحمد عبد العزيز بن جعفر بن قولويه).
فالملاحظ أنّ ابن شاذان عند روايته عن جعفر بن محمد بن سرور ر لا يشير إلى أنّه كان خالاً له أو خالاً لأمّه ويلقّبه باللحّام في حين أنّه عند روايته عن جعفر بن محمد بن قولويه لا يلقّبه باللحّام ويصرّح بأنّه كان خالاً له أو خالاً لأمّه، وإذا روى عن ابنه يذكر أنّه كان ابن خاله. ويبعد أن يكون هذا كله منه من غير عناية بل على سبيل الصدفة والاتفاق، أي أنّ أستاذاً واحداً له تارة يذكره بعنوان ابن مسرور ويلقّبه باللحّام وتارة يذكره بعنوان ابن قولويه ولا يورد لقبه بل يذكر أنّه خاله أو خال أمّه وكذلك إذا روى عن ابنه هذا مستغرب، وينبغي أن يعدّ التفريق المذكور مؤشّراً واضحاً إلى مغايرة ابن مسرور لابن قولويه.
الأمر الثاني: أنّ جعفر بن محمد بن قولويه توفّي في عام (368 هـ) كما نصّ على ذلك الشيخ (قده) (30) وابن حجر (31) وحكاه الذهبي (32) والصفدي (33) عن ابن أبي طي، ولكن ذكر العلّامة (قده) (34) أنّه توفّي سنة (369 هـ) وقد حكاه عنه ابن داود (35) وقال: إنّ ما ذكره الشيخ أظهر.
ومهما يكن، فلا إشكال في أنه كان حياً إلى عام (368 هـ).
والملاحظ أنّ الشيخ الصدوق (قده) قد أملى ما ورد في كتابه الأمالي من رجب عام سنة (367 هـ) إلى شعبان سنة (368 هـ) (36)، ونقل فيه موارد كثيرة عن جعفر بن محمد بن مسرور مقروناً بالدعاء له بالرحمة أو الرضوان، فيمكن أن يعدّ هذا مؤشّراً إلى مغايرة ابن مسرور لابن قولويه، وإلّا كان ينبغي أن يدعو له بالحفظ ونحوه في أوائل الكتاب بل إلى آخره، إلّا إذا كان قد مات قبل شعبان (118 هـ) فيدعو له بالرحمة والرضوان في أواخره، كما نجد أنّ الشيخ الطوسي لمّا بدأ بشرح المقنعة المسمّى بتهذيب الأحكام كان يدعو لأستاذه المفيد (قده) بالتأييد في أوائل الكتاب ولمّا توفّي قبل أن يتمّه صار يدعو له بالرحمة.
وبالجملة: دعاء الصدوق لابن مسرور بالرحمة والرضوان في كتاب الأمالي الذي شرع في تأليفه في حياة ابن قولويه وربّما أنهاه أيضاً في حياته شاهد على أنّ ابن مسرور غير ابن قولويه؛ لأنّه قد مات قبله.
ولكن يلاحظ على هذا الكلام: أنّ المتعارف لدى المؤلفين السابقين أن يدعو صاحب الكتاب لمن يذكره فيه من أساتذته في حال حياته بالحفظ والتأييد ثم إذا قرأ عليه الكتاب من قبل تلامذته بعد وفاة ذلك الأستاذ استبدله بالدعاء له بالرحمة والرضوان ومن نماذج ذلك ما يلاحظ في فهرست الشيخ الطوسي (قده)، فإنّه ذكر أستاذه السيد المرتضى في ترجمة إبراهيم بن محمد الثقفي (37) بقوله: (أخبرنا به الأجل المرتضى علي بن الحسين الموسوي (أدام الله تأييده)) ثم ذكر الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان مترضياً عليه.
ولكن الدعاء للمرتضى بدوام التأييد قد حذف من بعض النسخ اللاحقة واستبدل بالدعاء له وللمفيد بالرحمة كما ورد في الطبعة الأخيرة المحقّقة (38).
وأيضاً يوجد في هذه الطبعة (39) في ترجمة السيد المرتضى الدعاء له بقوله: (طوّل الله عمره وعضد الإسلام وأهله ببقائه وامتداد أيامه)، ولكن في الطبعة الأخرى(40) بدّل إلى قوله: (رضي الله عنه).
والحاصل: أنّ تغيير الدعاء بالحفظ في حياة الأستاذ إلى الرحمة له بعد وفاته: أمر متعارف في كتب السابقين، فلا سبيل إلى أن يجعل اشتمال أمالي الصدوق على الدعاء لابن مسرور بالرحمة شاهداً على أنّه توفي قبل عام (367 هـ) ليدل ذلك على مغايرته لابن قولويه المتوفى عام (368) أو (369 هـ).
الأمر الثالث: ما أفاده السيّد الأستاذ (رضوان الله عليه) (41) قائلاً: (إنّ ممّا يكشف كشفاً قطعياً عن أنّ علي بن مسرور لم يكن أخاً لابن قولويه ـ حتّى يكون جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولويه - أنّ النجاشي قد ذكر في ترجمة علي، أنّه مات حدث السن لم يسمع منه، وإنّما له كتاب.. مع أنّ جعفر بن قولويه روى في الكامل عن أخيه كثيراً فكيف يقال: إنّه لم يسمع منه؟!).
ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ الذي نفاه النجاشي بشأن علي بن محمد بن مسرور هو سماع الحديث منه من جهة أنّه مات حدث السن (42)، ومقصوده أنّه لم يطل به العمر حتّى تكثر تلامذته، إذ كان المتداول في ذلك العصر - كما في الأزمنة اللاحقة ـ أنّ الغالب يرجّحون التلمذة لدى كبار السن من المشايخ، لا سيما في رواية الأحاديث وتلقّي الأخبار، دون من يكون حدث السن.
ومن هنا يلاحظ أنّ علي بن جعفر بن قولويه لمّا لم تطل أيامه انحصر الراوي عنه - فيما بأيدينا من المصادر - في أخيه الأصغر منه جعفر بن محمد بن قولويه، وأمّا جعفر هذا فلمّا طال به العمر كثر الذين رووا عنه.
وبالجملة: ما ذكره النجاشي لا يقتضي أزيد ممّا تقدّم ولا يعني أنّ علي بن محمد بن مسرور لم يسمع منه حتّى أخوه الأصغر منه جعفر ليشكّل ذلك قرينة على أنّ جعفر بن محمد بن قولويه لم يكن أخاً له؛ لأنّه روى في الكامل عن أخيه على مراراً وعده من مشايخه (43).
الأمر الرابع: ما أفاده المحقّق التستري (قده) (44) قائلا: (إنّ ابن قولويه في طبقة الصدوق وكلّ منهما شيخ المفيد ولم يروِ أحدهما عن الآخر، وهذا ـ أي ابن مسرور - روى عنه الصدوق في تلك المواضع الكثيرة.
وهذا الكلام قد أجاب عنه السيّد الأستاذ (رضوان الله عليه) (45) قائلاً: إن ابن قولويه أقدم من الصدوق فيصلح أن يكون شيخاً له، كما يتّضح ذلك من قرينتين بعد معلوميّة تاريخ ولادة الصدوق وأنّه في سنة (305 هـ) (46) وإن لم يضبط تاريخ الآخر:
إحداهما: أنّ ابن قولويه قد روى عن محمد بن جعفر الرزّاز المتوفّى سنة (312 هـ) كثيراً فبطبيعة الحال يقتضي أن يكون سنّه عندئذٍ عشرين أو خمس عشرة على الأقل، فيكون أسبق من الصدوق المتولد سنة (305 هـ) كما عرفت.
الثانية: أنّه قد روى عن سعد بن عبد الله القمي الاشعري روايتين أو أربعاً كما ذكره النجاشي، وقد توفّي سعد في سنة (299 هـ) أو سنة (301 هـ) فلا بدّ أن يكون سن ابن قولويه عندئذٍ خمس عشرة سنة على الأقل، فيكون متولّداً في سنة (285 هـ) فيكون أسبق من الصدوق.
أقول: هذا البيان تامّ في أصله. وأمّا ما ذكره المحقّق التستري (قده) من أنّ ابن قولويه في طبقة الصدوق وكلّ منهما شيخ المفيد فغير تام، فإنّ كون ابن قولويه والصدوق شيخين للمفيد لا يقتضي كونهما في طبقة واحدة، إذ إن من المتعارف أنّ يتلمذ أحداث طبقة عند كبار تلك الطبقة ويتلمذون جميعاً عند الطبقة السابقة، ومن يتتبّع أحوال الرواة يجد أمثلة كثيرة لذلك.
وأمّا ما أفاده (قده) من أنّ الصدوق لم يروِ عن ابن قولويه فهو مبني على ألا يكون ابن مسرور هو ابن قولويه نفسه، غير أنّ الصدوق يذكره منسوباً إلى جدّه مسرور لا قولويه، وهذا أول الكلام فكيف يستشهد به على المغايرة؟!
الأمر الخامس: ما ذكره المحقّق التستري (قده) (47) أيضاً من أنّ (جعفر بن محمد بن قولويه) لو لم يذكر اسم آبائه بل اسم أبيه بل اسمه فلا بدّ أن يذكر فيه قولويه فيقال له: (ابن قولويه) حتّى يعرف، وأين منه جعفر بن محمد بن مسرور؟!).
وحاصله: أنّ ابن قولويه إنّما يذكر منتسباً إلى قولويه ليكون ذلك معرّفاً له سواء مع ذكر اسمه فقط فيقال: (جعفر بن قولويه)، أو مع اسم أبيه فيقال: (جعفر بن محمد بن قولويه)، أو بإضافة اسم جدّه فيقال: (جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه)، أو مع حذف الجميع فيقال: (ابن قولويه). ولا يصح أن يذكر (مسرور) بدلاً عن (قولويه) حتّى لو فرض كونه اسماً له، كما احتمله المحقّق الوحيد البهبهاني.
وعلى ذلك، فلا وجه للقول: بأنّ المراد بجعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولويه.
أقول: كون جعفر بن قولويه معروفاً عند أصحابنا البغداديّين بهذه النسبة لا يقتضي كونه معروفاً بها أيضاً عند أصحابنا القميّين، فلعلّهم كانوا يعرفونه بابن مسرور، فإنّه كان قمياً قبل أن يأتي إلى بغداد ويصبح من شيوخ الأصحاب فيها.
وكون الراوي معروفاً بنسبة معيّنة لدى جمع وبنسبة أخرى لدى جمع آخر أمر متداول بين الرواة، فهذا محمد بن أبي عمير يتعارف التعبير عنه عند أصحابنا منسوباً إلى كنية أبيه (أبي عمير)، في حين أنه يتعارف التعبير عنه لدى الواقفة ولا سيما الحسن بن محمد بن سماعة منسوباً إلى اسم أبيه (زياد) فيعبر عنه بـ(محمد بن زياد)، ولم أجد التعبير عنه بمحمد بن أبي عمير في أسانيده إلا في موضعين، ولعلّه من تصرّفات بعض الرواة عنه.
وبالجملة: كون الانتساب إلى قولويه هو المعرّف لجعفر بن محمد بن قولويه عند جميع أصحابنا حتّى غير البغداديّين ليس أمراً مسلّماً لتبنى عليه مغايرته لجعفر بن محمد بن مسرور الذي ذكره الشيخ الصدوق.
هذا، ولكن الإنصاف أنّه يبعد تعبير الصدوق عن ابن قولویه بابن مسرور؛ لأنّ ابن قولويه ورد بغداد في طريقه إلى الحج عام (339 هـ) كما ذكره الراوندي (48)، ويبدو أنّه استقر بها إلى آخر عمره.
والصدوق زار بغداد عام (355 هـ) فلا يخلو إمّا أنّه التقى به وأخذ منه الحديث فيها أو قبل ذلك حينما كان ساكناً في قم، وعلى الأول كان الأجدر أن يعبّر عنه بجعفر بن محمد بن قولويه كما عرف به في أوساط أصحابنا في بغداد. وأمّا على الثاني فيتّجه التعبير عنه بغير ذلك لو لم يكن معروفاً به في قم وغيرها من أماكن سكنى أصحابنا.
ولكن الملاحظ أنّ أسرة ابن قولويه كانت معروفة بهذا الانتساب حتّى في قم، ولا يزال قبر محمد بن قولويه والد جعفر بن محمد بن قولويه شاخصاً في هذه المدينة بالرغم من مضي ألف عام على وفاته، ممّا يشير إلى مكانة هذه الأسرة في قم القديمة.
وأيضاً الملاحظ أنّ الكشي يروي في رجاله عن محمد بن قولويه كثيراً ويعبّر عنه بهذا العنوان ولم يعبّر عنه بمحمد بن مسرور في شيء من الموارد، فيبعد القول بتفرّد الصدوق بالتعبير عنه بذلك.
ومهما يكن، فقد اتّضح بما تقدّم: أنّه يصعب البناء على اتّحاد ابن قولويه وابن مسرور، كما يصعب البناء على المغايرة لتضارب الشواهد والقرائن من الجانبين، والله العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 18 ص: 628.
(2) تعليقة على منهج المقال ج 3 ص 239.
(3) الموسوعة الرجاليّة ج: 5 ص: 205.
(4) مستدرك وسائل الشيعة (الخاتمة) ج: 5 ص: 470. قاموس الرجال ج: 2 ص 684. معجم رجال الحديث ج: 4 ص: 122 ط: النجف الأشرف.
(5) لاحظ تاج العروس ج: 16 ص: 359.
(6) لاحظ أساس البلاغة ص: 915، والمحيط ج: 10 ص: 319.
(7) رجال الطوسي ص: 439.
(8) الموسوعة الرجاليّة ج: 5 ص: 205.
(9) رجال النجاشي ص: 262.
(10) معجم رجال الحديث ج: 4 ص: 122 ط: النجف الأشرف.
(11) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج: 4 ص: 236 - 237 ط: النجف الأشرف.
(12) رجال النجاشي ص: 21.
(13) رجال النجاشي ص: 38.
(14) رجال النجاشي ص: 61 .
(15) رجال النجاشي ص: 149.
(16) يمكن أن يقال: إنّ مرجع هذا إلى احتمال اتكال النجاشي على قرينة متصلة في زمانه لم تصل إلينا، ولكن هذا الاحتمال منفي بأصالة عدم القرينة فيلزم الأخذ بالظهور إلا على ما سلكه بعض الأعلام (طاب ثراه) من عدم جريان أصالة عدم القرينة المتّصلة اللبيّة المرتكزة في الأذهان، فإنّ القرينة المحتملة في المقام تشبهها.
(17) کامل الزيارات ص: 29.
(18) كامل الزيارات ص: 33، 92، 98، 112، 121.
(19) كنز الفوائد ج 2 ص: 142.
(20) في المطبوع (دقائق النواصب) وهو تصحيف.
(21) في المطبوع (اللجّام) وهو تصحيف (اللحّام)، وقد وقع نظير هذا التصحيف في كتاب (التحصين لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين) (ص: 546) نقلاً عن كتاب (نور الهدى)، فإنّ فيه لفظة (الخادم) بدل (اللحّام)، فليلاحظ.
(22) مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة من ولده (عليهم السلام) ص:32.
(23) مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة من ولده (عليهم السلام) ص: 137.
(24) كنز الفوائد ج 2 ص: 13.
(25) كنز الفوائد ج 2 ص: 75.
(26) كنز الفوائد ج 2 ص 37.
(27) كنز الفوائد ص: 196.
(28) أمالي الطوسي ص: 682.
(29) أمالي الطوسي ص: 688.
(30) رجال الطوسي ص: 418.
(31) لسان الميزان ج 2 ص 125.
(32) تاريخ الإسلام ج: 26 ص 393.
(33) الوافي بالوفيات ج: 11 ص: 117.
(34) خلاصة الأقوال ص: 88.
(35) رجال ابن داود ص: 65.
(36) أمالي الصدوق ص: 49، 773.
(37) الفهرست للطوسي ص: 38 ط: مؤسسة النشر الإسلاميّ، وحكاه عنه كذلك في مجمع الرجال ج:1 ص: 66، وهكذا حكاه في منهج المقال ج:1 ص: 352، ونقد الرجال ج:1 ص:82، ومنتهى المقال ج:1 ص: 195.
(38) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 14.
(39) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 288. وهكذا حكاه في مجمع الرجال ج: 4 ص: 189.
(40) الفهرست للطوسي ص 164 ط: مؤسسة النشر الإسلامي، وهكذا حكاه في منهج المقال ج: 7 ص: 385، ومنتهى المقال ج: 4 ص: 397.
(41) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج: 4 ص: 237 ط: النجف الأشرف.
(42) تجدر الإشارة إلى أنّ التعبير بـ(مات حدث السن) ربّما لا يعني أنّه مات في سن الشباب، فقد ذكر النجاشي في ترجمة الصدوق أنّه ورد بغداد سنة (355) هـ): وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن (رجال النجاشي ص: 389) مع أنّه كان له من العمر آنذاك حوالي خمس وخمسين سنة!
(43) کامل الزيارات ص: 270.
(44) قاموس الرجال ج 2 ص: 684.
(45) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج: 4 ص: 236 ط: النجف الأشرف.
(46) هذا غير مؤكّد، ولعلّه ولد في حدود سنة (306 هـ) أو (307 هـ).
(47) قاموس الرجال ج 2 ص: 684.
(48) الخرائج والجرائح ج:1 ص: 475.

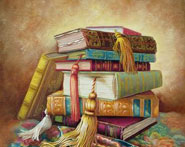
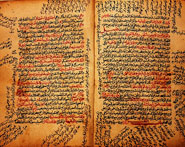
|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|