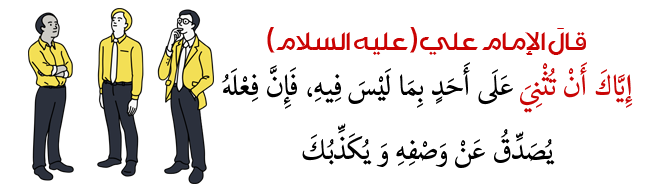
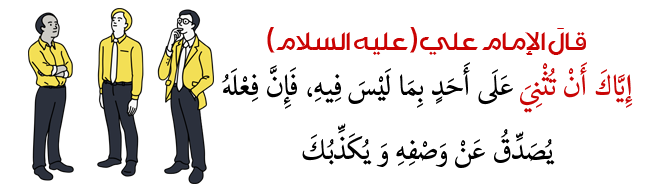

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-2-2017
التاريخ: 13-2-2017
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 13-2-2017
|
قال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء : 64] .
لأمهم سبحانه على ردهم أمره ، وذكر أن غرضه من البعثة الطاعة ، فقال : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ } : أي لم نرسل رسولا من رسلنا { إِلَّا لِيُطَاعَ } عني به أن الغرض من الإرسال أن يطاع الرسول ، ويمتثل بما يأمر به ، وإنما اقتضى ذكر طاعة الرسول هنا أن هؤلاء المنافقين الذين يتحاكمون إلى الطاغوت ، زعموا أنهم يؤمنون به ، وأعرضوا عن طاعته ، فبين الله أنه لم يرسل رسولا إلا ليطاع . وقوله :
{ بِإِذْنِ اللَّهِ } : أي بأمر الله الذي دل به على وجوب طاعتهم ، والإذن على وجوه أحدها : يكون بمعنى اللطف كقوله {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [يونس : 100].
وثانيها : بمعنى التخلية كقوله تعالى : {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة : 102] .
وثالثها : بمعنى الأمر كما في الآية { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ } : أي بخسوها حقها بإدخال الضرر عليها بفعل المعصية ، من استحقاق العقاب ، وتفويت الثواب ، بفعل الطاعة . وقيل : ظلموا أنفسهم بالكفر والنفاق . { جَاءُوكَ } تائبين مقبلين عليك ، مؤمنين بك ، { فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ } لذنوبهم ، ونزعوا عما هم عليه ، { وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ } رجع من لفظ الخطاب في قوله { جَاءُوكَ } إلى لفظ الغيبة ، جريا على عادة العرب المألوفة ، واستغفرت لهم يا محمد ذنوبهم : أي سألت الله أن يغفر لهم ذنوبهم .
{ لَوَجَدُوا اللَّهَ } هذا يحتمل معنيين : أحدهما : لوجدوا مغفرة الله لذنوبهم ، ورحمته إياهم . والثاني : لعلموا الله توابا رحيما ، والوجدان يكون بمعنى العلم ، وبمعنى الإدراك ، فلا يجوز أن يكون على ظاهره هنا بمعنى الإدراك ، لأنه سبحانه غير مدرك في نفسه { تَوَّابًا } : أي قابلا لتوبتهم { رَحِيمًا } بهم في التجاوز عما قد سلف منهم . وفي قوله { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ } أوكد دلالة على بطلان مذهب المجبرة ، والقائلين بأن الله يريد أن يعصي أنبياءه قوم ، ويطيعهم آخرون .
وذكر الحسن في هذه الآية أن اثني عشر رجلا من المنافقين ، ائتمروا فيما بينهم ، واجتمعوا على أمر مكيدة لرسول الله ، فأتاه جبرائيل ، فأخبره بها ، فقال عليه السلام : " إن قوما دخلوا يريدون أمرا لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا الله وليعترفوا بذلك حتى أشفع لهم " ، فلم يقوموا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرارا : ألا تقومون؟ فلم يقم أحد منهم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : قم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى عد اثني عشر رجلا . فقاموا وقالوا : كنا عزمنا على ما قلت ، ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا ، فاشفع لنا . فقال : الآن أخرجوا عني ، أنا كنت في أول أمركم أطيب نفسا بالشفاعة ، وكان الله أسرع إلى الإجابة . فخرجوا عنه حتى لم يرهم .
وفي الآية دلالة على أن مرتكب الكبيرة ، يجب عليه الاستغفار ، فإن الله سيتوب عليه بأن يقبل توبته . ويدل أيضا على أن مجرد الاستغفار لا يكفي مع كونه مصرا على المعصية ، لأنه لم يكن ليستغفر لهم الرسول ، ما لم يتوبوا ، بل ينبغي أن يتوب ويندم على ما فعله ، ويعزم في القلب على أن لا يعود أبدا إلى مثله ، ثم يستغفر الله باللسان ، ليتوب الله عليه .
_________________________
1. مجمع البيان ، ج3 ، ص 119-120 .
{ وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ } . المراد بإذن اللَّه أمره جل وعلا ، وتسأل : ان هذا الأخبار أشبه بتوضيح الواضح ، لأن إضافة الرسول إلى اللَّه تدل بذاتها على انه أرسل كي يطاع ، وإلا لم يكن للإضافة معنى ، فما هو القصد ، اذن من هذا البيان ؟ .
الجواب : القصد إلقاء الحجة على المنافقين الذين عصوا الرسول ، ورفضوا التحاكم إليه . . ووجه الحجة ان اللَّه سبحانه بيّن للمنافقين وغيرهم في هذه الآية ان معصية الرسول ليست معصية له بالذات ، وإنما هي معصية للَّه ، حيث أبى إلا ان يجري الأمور على سننها : ومن هذه السنن أن يبلغ أحكامه لعباده بواسطة رسول منهم ، وعلى هذا فمن عاند الرسول فيما يبلغه من أحكام اللَّه فقد عاند اللَّه ، والى هذا المعنى يشير قوله تعالى : { بِإِذْنِ اللَّهِ } . والنتيجة ان المنافقين ، وكل من يعصي اللَّه مستحقون للعقاب لأنهم عصوا اللَّه وخالفوه .
{ ولَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهً واسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهً تَوَّاباً رَحِيماً } . ظلموا أنفسهم ، حيث عرضوها للعذاب والهلكة بما اقترفوا من ذنوب ، وظلموا اللَّه أيضا بتجاوز حدوده ، وعصيان أوامره ، وظلموا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لأنهم رفضوا حكمه ، وارتضوا حكم الطاغوت ، وأظهروا له خلاف ما يضمرون .
وبالرغم من هذا كله فان اللَّه قد فتح لهم باب التوبة ، وما عليهم إلا أن يلجوه ، ويطلبوا المغفرة ، فان فعلوا أدخلهم في رحمته ، وان استنكفوا فلا يجدون من دونه وليا ولا نصيرا .
وتسأل : ان قوله تعالى : { واسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ } يتنافى مع مبدأ الإسلام الذي يرفض فكرة الوسطاء بين اللَّه والناس ؟ .
الجواب : أجل ، لا واسطة بين اللَّه وعباده ، ولكن فيما يعود إلى حقوقه تعالى ، والتعدي عليها ، أما التعدي على حقوق الناس فالأمر إليهم ، والصفح عنها يطلب منهم ، لا من غيرهم . . والمنافقون قد آذوا الرسول ، وتعدوا على حقه فكان لا بد في توبتهم ان يظهروا الندم له ، ويطلبوا الصفح منه ، وكل من أظهرت له خلاف ما تضمر فقد ظلمته ، وتعديت على حقه ، بل لو علمت ان ( فلانا ) ظن بك وصفا حسنا ، وما هو فيك ، وعاملك وائتمنك على أساسه ، ثم تجاهلت وأغضيت ولم تلفت نظره ، وعلى الأقل تتهرب منه ، إذا كان كذلك فأنت ظالم له .
_________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 368-369 .
قوله تعالى : { وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ } ، رد مطلق لجميع ما تقدمت حكايته من هؤلاء المنافقين من التحاكم إلى الطاغوت ، والإعراض عن الرسول ، والحلف والاعتذار بالإحسان والتوفيق . فكل ذلك مخالفة للرسول بوجه سواء كانت مصاحبة لعذر يعتذر به أم لا ، وقد أوجب الله طاعته من غير قيد وشرط فإنه لم يرسله إلا ليطاع بإذن الله ، وليس لأحد أن يتخيل أن المتبع من الطاعة طاعة الله ، وإنما الرسول بشر ممن خلق إنما يطاع لحيازة الصلاح فإذا أحرز صلاح من دون طاعته فلا بأس بالاستبداد في إحرازه ، وترك الرسول في جانب ، وإلا كان إشراكا بالله ، وعبادة لرسوله معه ، وربما كان يلوح ذلك في أمور يكلمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قائلهم له إذا عزم عليهم في مهمة : أبأمر من الله أم منك ؟
فذكر الله سبحانه أن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وجوب مطلق ، وليست إلا طاعة الله فإنها بإذنه نظير ما يفيده قوله تعالى : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ} الآية : [ النساء : 80 ] .
ثم ذكر أنهم لو رجعوا إلى الله ورسوله بالتوبة حين ما خالفوا الرسول بالإعراض لكان خيرا لهم من أن يحلفوا بالله ، ويلفقوا أعذارا غير موجهة لا تنفع ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الله سبحانه يخبره بحقيقة الأمر ، وذلك قوله : { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ } إلى آخر الآية .
___________________________
1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 343 – 344 .
في الآيات السابقة شجب القرآن الكريم التحاكم إلى حكّام الجور ، وفي هذه الآية يقول سبحانه مؤكدا : {وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ} أي أنّنا بعثنا الأنبياء ليطاعوا بإذن الله وأمره ولا يخالفهم أحد ، لأنّهم كانوا رسل الله وسفراءه كما كانوا رؤساء الحكومة الإلهية أيضا ، وعلى هذا يجب على الناس أن يطيعوهم من جهة بيان أحكام الله ومن جهة طريقة تطبيقها ، ولا يكتفوا بمجرّد ادعاء الإيمان.
ومن هذه العبارة يستفاد أنّ الهدف من إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو إطاعة جميع الناس لهم ، فإذا أساء بعض الناس استخدام حريتهم ولم يطيعوا الأنبياء كان اللوم متوجها إلى أنفسهم لا إلى أحد. وبهذا تنفي الآية الحاضرة عقيدة الجبريين الذين يقولون : الناس صنفان : صنف كلّف بالطاعة من البدء ، وصنف كلّف بالمعصية من البدء .
كما أنّه يستفاد من عبارة {بِإِذْنِ اللهِ} أن كل ما عند الأنبياء من الله ، أو بعبارة أخرى : إن وجوب طاعتهم ليس بالذات ، بل هي ـ أيضا ـ بأمر الله ومن ناحيته.
ثمّ إنّه سبحانه يترك باب التوبة والإنابة ـ عقيب تلك الآية ـ مفتوحا على العصاة والمذنبين ، وعلى الذين يراجعون الطواغيت ويتحاكمون إليهم أو يرتكبون معصية بنحو من الأنحاء ، ويقول : {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً} .
والجدير بالتأمل والانتباه إنّ القرآن يقول بدل : عصوا أمر الله وتحاكموا إلى الطاغوت : {إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} وهو إشارة إلى أنّ فائدة الطاعة لأمر الله وأمر الرّسول تعود إليكم أنفسكم ، وإن مخالفة ذلك نوع من الظلم توقعونه على أنفسكم ، لأنّها تحطم حياتكم المادية ، وتوجب تخلفكم وانحطاطكم من الناحية المعنوية .
إنّ هذه الآية تجيب ضمنا على كل الذين يعتبرون التوسل برسول الله أو بالإمام نوعا من الشرك ، لأنّ الآية تصرح بأن التوسل بالنّبي والاستشفاع به إلى الله ، وطلب الاستغفار منه لمغفرة المعاصي ، مؤثر وموجب لقبول التوبة وشمول الرحمة الإلهية.
فلو كانت وساطة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاؤه للعصاة المتوسلين به ، والاستشفاع به وطلب الاستغفار منه شركا ، فكيف يمكن أن يأمر القرآن العصاة والمذنبين بمثل هذا الأمر ؟
نعم ، غاية ما في الباب أنّ على العصاة والمذنبين أنفسهم أن يتوبوا هم ويرجعوا عن طريق الخطأ ، ثمّ يستفيدوا ـ لقبول توبتهم ـ من استغفار النّبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن البديهي أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من شأنه أن يغفر الذنوب ، بل شأنه في المقام أن يطلب من الله المغفرة خاصّة ، وهذه الآية إجابة مفحمة للذين ينكرون مشروعية أو فائدة هذه الوساطات .
هذا والمفلت للنظر أنّ القرآن الكريم لم يقل : استغفر لهم يا رسول الله ، بل قال : {وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} وهذا التعبير ـ لعلّه ـ إشارة إلى أن يستفيد النّبي من مقامه ومكانته ويستغفر للعصاة التائبين.
إنّ هذا الموضوع (أي تأثير استغفار النّبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين) ورد في آيات أخرى من القرآن الكريم أيضا مثل الآية (١٩) من سورة محمّد والآية (٥) من سورة المنافقون والآية (١١٤) من سورة التوبة التي تشير إلى استغفار إبراهيم لأبيه (عمّه) ، والآيات الاخرى التي تنهي عن الاستغفار للمشركين ، ومفهومها جواز الاستغفار للمؤمنين ، كما يستفاد من بعض الروايات إن الملائكة تستغفر لجماعة من المؤمنين المذنبين عند الله (سورة غافر الآية ٧٧ ، وسورة الشورى الآية ٥) .
وخلاصة القول ، إنّ هناك آيات كثيرة تكشف عن هذه الحقيقة وهي إنّ الأنبياء ، أو الملائكة ، أو المؤمنين الصادقين الطيبين بإمكانهم أن يستغفروا لبعض العصاة ، وإن استغفارهم مؤثر عند الله ، وهذا هو أحد معاني شفاعة النّبي أو الملائكة أو المؤمنين الطيبين للعصاة والخاطئين ، ولكن الشّفاعة كما قلنا تحتاج إلى أرضية وصلاحية وأهلية في العصاة أنفسهم.
والعجيب أنّه يستفاد من بعض ما قاله جماعة من المفسّرين أنّهم أرادوا اعتبار استغفار النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ في الآية الحاضرة ـ مرتبطا بالتجاوزات الواقعة في شؤون النّبي خاصّة لا مطلق المعاصي والذنوب ، وكأنّهم أرادوا أن يقولوا : لو أنّ أحدا ظلم النّبي أو أساء إليه وجب استحلاله واسترضاؤه ليغفر الله تلك الإساءة ويتوب على ذلك التجاوز.
ولكن من الواضح البيّن أن إرجاع التحاكم إلى غير النّبي ليس ظلما شخصيا يهدف به شخص النّبي ، بل هي مخالفة لمنصبه الإلهي الخاص (أو بعبارة أخرى) إنّها مخالفة للأمر الإلهي ، وحتى إذا كان ذلك ظلما شخصيا موجها إلى شخص النّبي ـ افتراضا ـ فإن القرآن لم يقصده ولم يركز عليه ، بل ركز القرآن على هذا الموضوع وهو أن ذلك التحاكم مخالفة لأمر الله وتجاهل لإرادته .
هذا مضافا إلى أنّنا لو ظلمنا أحدا كفانا رضاه ، فما الحاجة إلى طلب استغفاره ، ودعائه للمسيء ؟ بل وفوق ذلك كلّه ، لو أننا فسّرنا الآية بمثل هذا التّفسير ـ فرضا ـ فما الذي نقوله في تلك المجموعة الكبيرة من الآيات التي تشير إلى استغفار الأنبياء ، والملائكة والمؤمنين للعصاة والخاطئين ؟
فهل المقام فيها مقام الحقوق الشخصية أيضا ؟
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 188-190 .

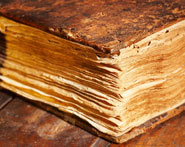
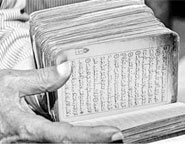
|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|