


 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-03-2015
التاريخ: 3-03-2015
التاريخ: 3-03-2015
التاريخ: 3-03-2015
|
رابع هؤلاء الأربعة، هو أبو الحسن علي بن عيسى الأخشيدي الرمّاني لقد كان من أئمة اللغة و النحو، أخذ العربية عن أبي بكر بن دريد، و النحو عن أبي اسحق الزجاج، و أبي بكر ابن السراج، و تلقى مذهب الكلام عن ابن الأخشيد المعتزلي (ت 326 ه) و لازم هذا الأخير و تأثر بآرائه حتى نسب إليه. كما أنه كان متشيعا(1). و لقد ألف رسالة في فضل الإمام علي بن أبي طالب، كرّم اللّه وجهه، دون أن يكون على مذهب الإمامية، بدليل أن السري الرفاء الشاعر كان يعرض به حين يقول:
ومعتزلي رام عزل ولايتي عن الشرف العالي بهم و ارتفاعه
ص180
المبارك دراسة وافية (4). مع أنه أيضا كتب في الحدود النحوية، و التصريف، و الاشتقاق و معاني الحروف، و شرح مسائل الأخفش، و مقتضب المبرد، و مختصر الجرمي، و معاني الزجاج، و الجمل لابن السراج (5).
فمعارف الرماني الموسوعية، و تنوع إنتاجه، و ميوله المذهبية كل هذا جعله يمثل عصره تمثيلا شاملا، إذ كان جامعا في علمه، بصريا في منزعه، منطقيا في منهجه، مستقلا في رأيه.
يعتقد بعض المؤرخين أن الرماني كان يرمى بعدم الوضوح في مذهبه، مما جعل كل أهل فنّ يرون أنه غريب عنهم، فيقول المتكلمون «ليس فنه في الكلام فننا» ، و يقول المنطقيون ليس ما يزعم أنه منطق عندنا (6)، كما شاع قول أبي علي الفارسي عنه (إن كان النحو ما يقوله الرماني، فليس عندنا منه شيء، و إن كان النحو هو ما نقوله فليس عند الرماني منه شيء) (7)، و يقال إن بعض أهل الأدب يقولون إنهم يحضرون مجلس ثلاثة من المشايخ، و يفهمون كل ما يقول السيرافي، و بعض ما يقول الفارسي و لا يفهمون شيئا مما يقول الرماني (8).
و لقد رد الدكتور مازن المبارك كل هذه الانتقادات و بيّن ضعفها و دوافعها، كما أوضح أن الرماني في مجال النحو، كان إماما بارعا، و خبيرا ماهرا(9)، و استجلى الدكتور مازن من خلال دراسته لشرح كتاب سيبويه، أصول مذهب الرماني، مبينا نظرته العامة إلى النحو، و منحاه في السماع و القياس و موقفه من آراء سيبويه، و مدى انتمائه للمدارس النحوية الموجودة في عصره.
ينظر الرماني إلى النحو بصفته صناعة مستقلة بنفسها، و صار يتكلف العذر لسيبويه الذي أدخل تفسير الغريب في كتابه، و هو ليس من النحو. فقال الرماني إنه أورد ذلك لكشف الوجه الذي يقع عليه الإعراب فجاز أن يدخل في الصناعة ما ليس منها.
و كشف أوجه الإعراب هو المحور الأساسي للنحو عند الرماني، فهو يقول:
و لا تنظر إلى ظاهر الإعراب، و تغفل المعنى الذي يقع عليه الإعراب، لتكون قد ميزت فيما تجيزه، أو تمتنع منه و صاب الكلام من خطئه. فإن صناعة النحو مبنية على تمييز صواب الكلام من خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح. و يعطي المثال على قوله في نحو: مررت برجل حسن أبوه، فإذا كان «حسن» علما فلا يجوز إلا الرفع، و إذا كان صفة غالبة فالرفع أولى، و إن كان صفة محضة فيكون الوجه فيه الجر (10).
و يقتدي أبو الحسن الرماني بإمامه سيبويه في تقدير أهمية العامل و جعله المحور الذي يدور حوله البحث النحوي، و من ذلك أنه يركز على ترتيب العمل في التوابع مانعا حذف المتبوع أو تقديم التابع عليه (11).
و نظرية الرماني في السماع تبع لرأي سيبويه، فيلتزم بالتقيد باختيارات صاحب الكتاب في القراءات، و المعروف أن سيبويه يقول إن القراءة لا تخالف لأنها سنة، مع أنه في بعض الأحيان يعلق عليها مثل ما هو في المثال التالي: و لو قرئت (وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ) (الجن-الآية 18) كان جيدا، دون أن يذهب بعيدا في البحث عن القراءات الشاذة (12). و هذا ما سار عليه الرماني الذي أعطى للقياس النحوي صورة أوضح من حيث تعريفه وصلته بالسماع، فيقول إن القياس الصحيح هو الجمع بين شيئين بما يوجب اجتماعهما في الحكم، كالجمع بين الاسم و الفعل بالرفع، بعامل الرفع. فالقياس الصحيح هو المطرد، و المستند على السماع، لأنه بناء على حكم المشبه به، و القياس على المطرد الذي استعمل في أصله. و لا يقاس على النادر لأنه لو قيس عليه لخرج من حد النادر إلى الأصل.
و يتضح رأيه في العلاقة بين السماع و القياس في هذا المثال:
يقول سيبويه في بيت الأحوص:
ص182
طال بالإضافة و الصلة، و لهذا أجازه سيبويه بالقياس و إن كانت العرب لا تتكلم إلا بالرفع (14).
و يتحدث الرماني عن العلة، و يقسمها إلى ستة أنواع: هي العقلة القياسية و هي التي يطرد الحكم بها في النظائر مثل الرفع في الفاعل. العلة الحكمية كأحقية الفاعل بالرفع، لأن علامته، و هي الضم، أقوى الحركات. و العلة الضرورية و هي التي يجب بها الحكم بمتحرك من غير جعل جاعل، و لم يعط الرماني لها مثالا، و يفهم معناها من المقابلة مع العلة الوضعية، و هي التي يجب بها الحكم بجعل جاعل، نحو وجوب الحركة للحرف الذي يمكن أن يكون ساكنا. و العلة الصحيحة و هي التي تقتضي الحكم الجاري في النظائر مما تدعو إليه الحكمة. و ضدها العلة الفاسدة (15).
و إن أهم ما قام به الرماني في شرح الكتاب، هو بيان الموضوع الأساسي لكل باب من أبوابه و ذلك بمراجعة العناوين التي وضعها سيبويه، فاستطاع أن يسهم في توضيحها، ذلك أن عناوين هذه الأبواب في الكتاب اتسمت بالطول و الغموض، فاهتم الرماني أن يستبدل بها عناوين أكثر اختصارا و أوضح معاني، و أقرب من صيغتها إلى محتوى الباب. فحينما يقول سيبويه «هذا باب مجرى النعت على المنعوت و الشريك على الشريك» يقول الرماني «هذا باب التوابع» ثم بين أن الغرض منه تبيين ما يجوز في الباب و ما لا يجوز، و اعتاد أن يقدم بين يدي الموضوع أسئلة عن العلة في الحكم، و عن الأدلة و الشواهد. ثم يأتي بالشرح في شكل أجوبة عن الأسئلة التي وضعها مسبقا. فجاء شرحه و كأنه حوار جدلي يبحث عن ما في نفس الباحث من استطلاع أو اعتراض، بطريقة تذكر بما كان يروى عن منهجية سقراط في إيقاظ الفكر بالحوار.
لقد سبق أن ذكرنا أن الرماني كان بصري النزعة، سيبويهي الانتماء و مع ذلك فإنه كان يعرب بحرية عن آرائه الخاصة و اختياراته الاجتهادية و لو كانت مخالفة لرأي الإمام سيبويه. فاستيعابه لثقافة عصره و اتساع آفاقه الفكرية أبعدت عنه نوازع التعصب
ص183
المذهبي، فسمع من أعلام النحاة البصريين، و اطلع على مسائل الأخفش و تناولها بالشرح، و عرف آراء الكوفيين، و وافقهم في بعض المسائل.
أما المسائل التي عدل فيها عن رأي سيبويه، فمنها ما كان مرجحا فيه لقول الخليل أو الأخفش أو المبرد، و منها ما وافق الكوفيين.
فلقد أيد رأي الخليل في وجوب الرفع في قولهم: هذان جحرا ضب خربان، بينما يرى سيبويه جواز «خربين» قياسا على حكمه في الإفراد.
و في قول الأعشى:
و القضايا التي وافق فيها الكوفيين، لا تتجاوز خمس مسائل فيما ذكره الدكتور مازن المبارك، لكن ثلاثا منها تابع فيها شيوخه أكثر مما كان منتصرا فيها للكوفيين، فقال إن «كي» تنصب بنفسها دون اللجوء إلى إضمار «أن» و هذا أيضا رأي شيخه ابن السراج، و قال إن المفرد المنفي ب (لا) معرب، و أن فتحته علامة للنصب، لا على البناء، و هو في ذلك يوافق الزجاج و الجرمي.
و بقي أنه يؤيد الكوفيين في أن الخبر يتضمن ضمير المبتدإ و لو كان اسما محضا، و أن «سوى» قد تكون اسما و تكون ظرفا، و البصريون يقولون بظرفيتها على كل حال (18).
ص184
و المقارنة بين الرماني و معاصريه تدعو إلى ملاحظة كثير من أوجه الشبه بينه و بين الزجاجي، فكلاهما اهتم بكتاب سيبويه و جعله مرتكزه في البحوث النحوية، و كتب كل منهما عن حروف المعاني، إلا أن كتاب الرماني اقتصر على الأدوات المجمع على حرفيتها، و ترتيبها بحسب عدد الحروف، و تابعه المبرادي بن أم قاسم في الترتيب، و تابع الزجاجي في إيراد الأدوات الاسمية، ثم نرى أيضا كلا منهما يستثمر ثقافته الفلسفية في تطبيق منهج منطقي في تنظير الأصول النحوية. و لقد أوليا في هذا المنهج عناية خاصة للعلل، فأوضح الزجاجي أقسامها، و بسط الرماني فروعها. فكانا بذلك مع السيرافي من دعائم منهج التأصيل النحوي.
ص185
___________________
(1) معجم الأدباء:1826.
(2) الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه:54-55.
(3) إنباه الرواة:2 / 295.
(4) كتاب الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: الذي طبعته دار الكتاب اللبناني، بيروت سنة 1974.
(5) الرماني النحوي: 244.
(6) معجم الأدباء:1826، نزهة الألباء:234.
(7) معجم الأدباء:1826، نزهة الألباء:234.
(8)) الرماني النحوي:73.
(9) الرماني النحوي:248-250.
(10) الرماني النحوي:250-252.
(11) المصدر نفسه، ص 272.
(12) المصدر نفسه، ص 268.
(13) كتاب سيبويه:2 /203.
(14) الرماني النحوي: (عازيا لشرح الرماني) ، ص 262.
(15) المصدر نفسه، ص 269.
(16) راجع لهذه المناقشات «الرماني النحوي» :282-290.
(17) الرماني النحوي:300-302.
(18) الرماني النحوي:317-321.
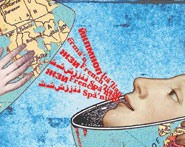
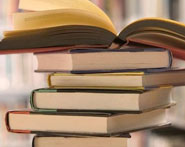

|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يحتفي بذكرى عيد الغدير في بغداد
|
|
|