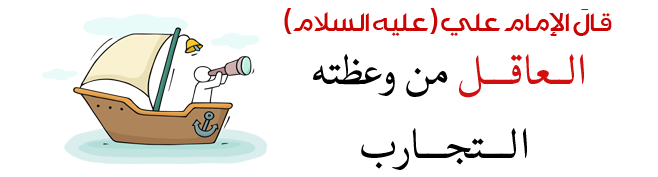
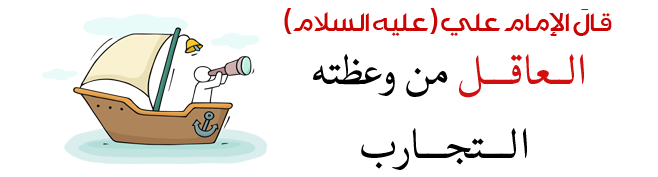

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-03-2015
التاريخ: 3-03-2015
التاريخ: 15-07-2015
التاريخ: 29-03-2015
|
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبا، أما أمه فعربية سدوسية من سدوس شيبان(1) ، ولد لها بفسا من أرض فارس بالقرب من شيراز حوالي سنة 288 للهجرة. وكان فطنا ذكيا فأكب على التعلم منذ نعومة أظفاره، وما تقبل سنة 307 حتى يرحل إلى بغداد، ويعكف على حلقات البصريين مثل ابن السراج والأخفش الصغير والزجاج وابن دريد ونفطويه ومبرمان، كما يعكف على حلقات البغداديين الأولين وخاصة حلقة ابن الخياط، وأكب على حلقة أبي بكر بن
ص255
مجاهد تلميذ ثعلب وشيخ القراء في عصره. ولم يخالط الكوفيين والبغداديين والبصريين في حلقات من استظهروا مذاهبهم فحسب، فقد مضى يخالط سابقيهم في كتاباتهم متمثلا ما كتبه سيبويه وغير سيبويه من مصنفات مختلفة. ويظهر أنه اتسع بثقافته، فشملت كتابات المتكلمين، إذ يقول مترجموه: إنه كان يعتنق مذهب المعتزلة، والاعتزال من قديم يجر إلى قراءة المنطق والفلسفة، وأغلب الظن أنه كان شيعيا؛ لغلبة التشيع حينئذ على أهل العراق وفارس.
ونظن ظنا أنه قعد للتدريس والإملاء في مساجد بغداد مبكرا، وكان فيه حب للرحلة، فتنقل يملي ويدرس للطلاب في "عسكر مكرم" وبعض مدن الموصل، ويدخل حلب في سنة 341 ومعه تلميذه ابن جني الذي شُغف به حبا، ويتحول إلى بعض مدن الشام، ويعود إلى بغداد سنة 346 وتطير شهرته، فيستدعيه إلى شيراز عضد الدولة البويهي، ويأخذ عنه هو وبعض أفراد أسرته، ويفتخر عضد الدولة بذلك حتى ليقول: إنه غلامه. ويظل عنده، حتى إذا دخلت بغداد في حوزته عاد إليها ثانية وظل بها إلى وفاته سنة 377 للهجرة. واتبع عادة هي أن ينسب إملاءاته في كل بلدة إليها، وهي نسبة تعين رحلاته وأماكن دراساته، فمن ذلك المسائل العسكرية نسبة إلى عسكر مكرم، والمسائل القصرية نسبة إلى "قصر ابن هبيرة" بنواحي الكوفة، والمسائل الحلبية، والمسائل الدمشقية, والمسائل البصرية, والمسائل البغدادية, والمسائل الكرمانية نسبة إلى كرمان في إيران, والمسائل الشيرازية. ومن مصنفاته: الإيضاح والتكملة والعوامل المائة والمقصور والممدود، ومن أهمها كتاب الحجة في القراءات السبع، وفيه يحتج لكل قراءة من تلك القراءات من اللغة والشعر, ناثرا آراء النحاة البصريين والكوفيين، منتصرا تارة للأولين وتارة للأخيرين مع نزعة قوية فيه إلى الأخذ بالآراء البصرية مما جعل الزبيدي في طبقاته وابن النديم في فهرسته يسلكانه في البصريين، ويقول أبو حيان فيه: "أبو علي أشد تفردا بالكتاب "كتاب سيبويه" وأشد إكبابا عليه وأبعد من كل ما عداه من علم الكوفيين" (2). وسنرى أنه كان ممن خلط بين آراء المدرستين في
ص256
وضوح. وهو بذلك بغدادي ينتخب من المدرستين ما يراه أولى بالاتباع، وإن غلب عليه النزوع إلى المذهب البصري؛ لأنه كان المذهب الذي حُرِّرت أصوله وفروعه وعلله.
وكان عقل أبي علي من الخصب بحيث ملأ نفس ابن جني تلميذه، حين ألم بالموصل، من جميع أقطارها، وهو يكثر من ذكر آرائه في كتابه الخصائص وغيره، حتى ليبدو كأنه كان كنزا سائلا بمسائل اللغة والنحو وما يجري فيها من ضبط الأصول وضبط الأقيسة والعلل، وقد استضاء به في كثير من الأصول الكلية التي حررها في كتابه الخصائص، فمن ذلك "السلب" يقول: "نبهنا أبو علي -رحمه الله- من هذا الموضع على ما أذكره وأبسطه؛ لتتعجب من حسن الصنعة فيه"(3). ويأخذ في بيان أن الأصل في الفعل الإثبات مثل: قام فهي لإثبات القيام، ثم يقول: إنهم قد استعملوا ألفاظا في السلب ابتداء مثل مادة "عجم" فهي للإبهام، ولتوضيح ذلك يعرضها في استعمالاتها المختلفة، ثم يبين أنهم قد يدخلون الهمزة على الفعل لإفادة السلب مثل: أشكيت الرجل, إذا زُلت له عما يشكوه، وقد يضعفون ثانيه لنفس الغاية مثل: مرضت الرجل أي: داويته من مرضه، وقد يأتي السلب بدون زيادة. ويفيض ابن جني نقلا عن أستاذه في أمثلة كثيرة. ونراه ينقل عنه في باب تعارض القياس والسماع أمثلة خالف فيها العرب القياس, مبينا أن ما استقر على لسانهم هو الأساس(4). وبالمثل ينقل عنه في باب الاستحسان وهو ما تكون علته ضعيفة غير مستحكمة مثل قولهم: رجل غديان والقياس: غدوان لأنه من قولهم: عدوت(5) ومن ذلك باب نقض المراتب إذا عرض عارض كتقديم المفعول به على الفاعل(6). ومن ذلك باب تلاقي اللغة، يقول: "هذا موضع لم أسمع فيه لأحد شيئا إلا لأبي علي رحمه الله"(7)، ويذكر مما جاء على لسانه منه: أجمع وجمعاء وأكتع وكتعاء وأخواتهما, فإن هذه الصيغة لا تأتي إلا صفة، بينما هي في تلك الأمثلة معارف.
ص257
ومن ذلك باب ما قِيس على كلام العرب فإنه يصبح من كلامهم(8) ، وباب الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع(9). ومما نقله عنه باب الاشتقاق الأكبر، يقول: "هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي -رحمه الله- كان يستعين به ويخلد إليه" (10) ويريد به "أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُد بلطف الصنعة والتأويل إليه ... نحو: ك ل م، ك م ل، م ل ك، م ك ل، ل ك م، ل م ك". ومن ذلك باب مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر، إذ يقول: "نبهنا أبو علي -رحمه الله- من هذا الموضع على أغراض حسنة"(11). ويقول في باب تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان: "هذا باب من العربية, غريب الحديث أراناه أبو علي"(12). وقد بنى باب محل حركات الإعراب من الحروف على كلام لأبي علي(13) واكتفى في حديثه عن الحرف المبتدأ به أيمكن أن يكون ساكنا على توجيه أستاذه؟(14) ويقول في باب إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى إلى الاسم: "هذا موضع كان يعتاده أبو علي -رحمه الله- كثيرا ويألفه ويأنق له ويرتاح لسماعه"(15) ويعقد بابا للاكتفاء بالسبب دون المسبب وبالمسبب من السبب قائلا: "هذا موضع من العربية شريف لطيف وواسع لمتأمله كثير، وكان أبو علي -رحمه الله- يستحسنه ويعنى به"(16) ومن ذلك قوله في فاتحة باب نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها: "رأيت أبا علي -رحمه الله- معتمدا هذا الفصل من العربية, ملما به, دائم التطرق له والفزع فيما يحدث إليه"(17) . ويقول في باب تجاذب المعاني والإعراب: "هذا موضع كان أبو علي -رحمه الله- يعتاده، ويلم كثيرا به، ويبعث على المراجعة له، وإلطاف النظر فيه" (18) .
ص258
ولعلنا لا نغلو إذا قلنا بعد ذلك: إن أكثر الأصول التي اعتمدها ابن جني في كتابه الخصائص إنما استمدها من إملاءات أبي علي أستاذه وملاحظاته. وإذا رجعنا إلى آرائه النحوية وجدناه في طائفة منها ينصر الخليل وسيبويه، وغيرهما من البصريين، وفي طائفة أخرى ينتصر للكوفيين، ويكفي أن ندل على ذلك ببعض الأمثلة، فمما انتصر فيه للخليل أن لا النافية قد تأتي زائدة كما في قوله تعالى: {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ}(19). وانتصر له ولسيبويه في تحليل {وَيْكَأَنَّهُ} في قوله جل شأنه: {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} إذ كانا يذهبان إلى أن "ويْ" مفصولة بمعنى أعجب, وذهب الأخفش إلى أنها موصولة بالكاف, أي: "ويك أنه لا يفلح الكافرون" وويك عنده بمعنى أعجب، وعلق أن وما بعدها بما في ويك من معنى الفعل. ووقف أبو علي مع الخليل وسيبويه مؤكدا أن "كأن" قد تأتي كالزائدة، وأنشد في ذلك بيت عمر بن أبي ربيعة:
كأنني حين أمسي لا تكلمني ... ذو بغية يشتهي ما ليس موجودا
أي: أنا كذلك (20). وكان سيبويه يذهب إلى أن "إذ ما" حرف شرط مثل إن، وذهب المبرد وابن السراج -وتابعهما أبو علي- إلى أنها ظرف مثل إذ (21) وقد أجاز مع الأخفش والكوفيين ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر(22).
وعلى نحو ما كان ينتخب لنفسه من الآراء البصرية كان ينتخب من الآراء الكوفية ما صح في قياسه، من ذلك أنه كان يقف مع الكوفيين في إعمال الفعل الأول في باب التنازع, مستدلا بقول امرئ القيس:
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال(23)
وكان يتابعهم في إعمال إِنِ النافية عمل ليس لما رووا عن بعض أهل العالية في نجد من قولهم: "إن أحدٌ خيرا من أحد إلا بالعافية"(24). وتابعهم في أن
ص259
عطف البيان ومتبوعه قد يكونان نكرتين، وقد استدلوا بمثل قوله جل شأنه: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} وقوله: {مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} وكان البصريون يؤولون مثل ذلك على أنه بدل ذاهبين إلى أن عطف البيان ينبغي أن يكون دائما معرفة(25). وذهب البصريون إلى أن لو شرطية دائما، بينما ذهب الفراء -وتابعه أبو علي- إلى أنها قد تكون حرفا مصدريا بمنزلة أنْ إلا أنها لا تنصب، وأكثر وقوع ذلك بعد ود ويود مثل: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ} و {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} وقال البصريون: إنها في مثل ذلك شرطية وإن مفعول {يَوَدُّ} وجواب {لَوْ} محذوف، والتقدير: يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. ويقول ابن هشام: لا خفاء بما في هذا التقدير من التكلف(26). وكان يجيز -مثل الكوفيين- إعمال الضمير العائد على المصدر في الظرف مثل: "قيامك أمسِ حسن وهو اليوم قبيح" فهو عنده تعمل في اليوم عمل المصدر العائدة عليه(27) وتابعهم في أن "أو" تأتي للإضراب مطلقا بدون اشتراط تقدم نفي أو نهي كما اشترط سيبويه، محتجا بقول جرير:
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم ... لم أُحْصِ عدتهم إلا بعداد؟
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ... لولا رجاؤك قد قتلت أولادي(28)
ومما تابعهم فيه أن الباء الجارَّة قد تأتي بمعنى التبعيض مثل قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} , وقوله: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ}(29). وكان سيبويه يذهب إلى أن خلا إذا تقدمتها ما كانت فعلا، وذهب الكسائي وتبعه أبو علي الفارسي، إلى أنها قد تكون حرف جر وما زائدة (30).
وليس كل ما يشكِّل بغدادية أبي علي أنه كان ينتخب لنفسه من المذهبين
ص260
الكوفي والبصري، بل يشكلها أيضا أنه كان يجتهد وينفرد بآراء لم يسبق إليها، من ذلك أن سيبويه وجمهور البصريين كانوا يذهبون إلى أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه, فمثل: كلمت محمدا وعليا انتصب محمد وعلي جميعا بكلمت. وذهب ابن السراج إلى أن حرف العطف هو العامل، أما أبو علي فرأى أن العامل في المعطوف فعل محذوف بعد أداة العطف؛ لأن الأصل في مثل: كلمت محمد وعليا: كلمت محمدا وكلمت عليا، فحُذف الفعل بعد الواو لدلالة الأول عليه، بدليل أنه يجوز إظهاره (31). وكان سيبويه يذهب إلى أن ناصب المنادى فعل محذوف تقديره: أنادي أو أدعو، وذهب المبرد إلى أن ناصبه حرف النداء يا وأخواتها لنيابتها عن الفعل، وذهب أبو علي الفارسي إلى أن أدوات النداء ليست حروفا وإنما هي أسماء أفعال(32) ، وأن المنادى مشبه بالمفعول به(33) ومر بنا في غير هذا الموضع اختلاف النحاة في إعراب الأسماء الخمسة، فقد كان سيبويه يرى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف، وقال الكوفيون: إنها معربة بالحركات على ما قبل حروف العلة، ووافقهم المازني إلا أنه قال: إن تلك الحروف ناشئة عن إشباع الحركات، وقال قطرب من البصريين وهشام من الكوفيين: إن حروف العلة نابت عن الحركات، وقال الجرمي: انقلاب تلك الحروف هو الإعراب، وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها حروف إعراب دالة عليه (34). وكان سيبويه والجمهور يذهبون إلى أن الأفعال الخمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وقال الأخفش: هي معربة بحركات مقدرة على ما قبل الألف في مثل يكتبان, والواو في مثل يكتبون, والياء في مثل تكتبين، وقيل: إعراب هذه الأفعال بالألف والواو والنون، وقال أبو علي: هي معربة ولا يوجد بها حرف إعراب، لا النون لأنها تسقط في النصب من الجزم ولا الألف والواو والياء لأنها ليست في آخرها، ولأنها ضمائر متصلة بها (35). وكان سيبويه يذهب إلى أن "حتى" يتعين نصب المضارع بعدها إذا وليت فعلا غير موجب مثل: "ما سرت حتى أدخل
ص261
المدينة" وجوز الفارسي الرفع بعدها في جميع الأحوال بدون استثناء(36). وذهب البصريون إلى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا تعلق بفعل أو اسم فاعل محذوف هو الخبر، ومر بنا أن الكوفيين كانوا يرون أن الظرف في مثل: محمد عندك, منصوب بالخلاف، وذهب أبو علي الفارسي مستضيئا برأي ابن السراج الذي مر بنا إلى أن الجار والمجرور والظرف هما الخبر -وليس هناك عامل محذوف- معلقان به(37). وكان الجمهور يمنع العطف على محل المجرور في مثل: مررت بزيد وعمرو فلا يقال: عمرا بالنصب، وأجاز ذلك الفارسي(38) ومنع الجمهور إتباع فاعل نعم وبئس بالنعت مثل: لنعم الفتى المدعو للحرب علي، وأجازه الفارسي(39). وكان سيبويه يذهب إلى أن ما في مثل: غسلته غسلا نِعِمَّا معرفة بمعنى الشيء, فهي فاعل لنعم، وذهب الفارسي إلى أنها نكرة تامة بمعنى شيء وأنها تمييز لفاعل نعم المستتر(40) وكان يذهب إلى أن "مَنْ" أيضا في باب نعم نكرة تامة تمييز لفاعل نعم المستتر مثل: "نعم من هو في سر وإعلان" ولم يوافقه أحد من النحاة في هذا الرأي، إذ يجمعون على أنها موصولة فاعل لنعم(41). وذهب سيبويه والجمهور إلى أن أمّا في قول بعض الشعراء:
أبا خراشة أَمَّا أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع
مركبة من أن المصدرية وما المزيدة والأصل: لأن كنت، فحُذف الجار وكان للاختصار فانفصل الضمير لحذف ما يتصل به وزِيدت ما عوضا عن كان، وأدغمت النون في الميم للتقارب، وبذلك يكون المرفوع بعدها اسما لكان المحذوفة والمنصوب خبرها، وذهب أبو علي إلى أن ما الزائدة هي الرافعة الناصبة لكونها عوضا من الفعل فنابت منابه(42) ولم يثبت النحاة ما الزمانية وأثبتها أبو علي مستدلا بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم(43) وكان سيبويه والجمهور يذهبون إلى أن الدار والمسجد في مثل: دخلت الدار والمسجد منصوبان على الظرفية، وهذب الأخفش -كما مر بنا- إلى أنهما
ص262
مفعولان به، وتوسط الفارسي ذاهبا إلى أن "في" حُذفت، فنُصبا على المفعولية اتساعا وتجوزا (44). وذهب الجمهور إلى أن "غير" محمولة في الاستثناء على ما بعد إلا فحكمها حكمه، وذهب الفارسي إلى أنها منصوبة على الحال في مثل: جاء القوم غيرَ علي(45). والجمهور يذهب إلى أن لا في مثل: "لا سيما محمد" نافية للجنس وسي اسمها بمعنى مثل وما زائدة والخبر محذوف، وذهب الأخفش إلى أن ما خبر لا وذهب أبو علي في كتابه "الهيتيات" نسبة إلى هيت بلدة بالعراق إلى أن لا في مثل: قام القوم لا سيما محمد, مهملة وسي حال أي: قاموا غير مماثلين لزيد في القيام (46) وذهب الجمهور في مثل: لا أبا لك ولا أخا لك إلى أن أبا اسم لا النافية للجنس واللام في لك زائدة وأبا مضاف إلى الكاف ومثلها أخا والخبر محذوف، وذهب هشام من الكوفيين وابن كيسان من البغداديين إلى أن أبا وأخا غير مضافين ولكنهما عُوملا معاملة المضاف في الإعراب، ولك في موضع الصفة لهما والخبر محذوف، بينما ذهب الفارسي إلى أن أبا وأخا في العبارتين جاءتا على لغة القصر وإلزام الأب والأخ الألف، ولك هي الخبر(47). وكان سيبويه والجمهور يذهبون إلى أن لام الاستغاثة في مثل: "يا لزيد" متعلقة بفعل أنادي المحذوف في النداء، وذهب أبو علي إلى أنها متعلقة بيا (48). وذهب سيبويه والجمهور إلى أن اللام الداخلة على الخبر مع إن المهملة في مثل: إنْ محمد لقائم "وإن كانت لكبيرة" هي لام الابتداء، وذهب أبو علي إلى أنها ليست لام الابتداء وإنما هي لام فارقة بين إن المؤكدة وإن النافية، وكان يحتج بدخولها على الماضي في مثل: "إن زيد لقام" وعلى منصوب الفعل المؤخر في مثل: {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} وكلاهما لا يجوز دخول اللام عليه مع إن المشددة (49).
وكان أبو علي يسند آراءه دائما بالأدلة التي اصطلح عليها النحاة البصريون والكوفيون، وهي السماع والقياس والتعليل ومواد السماع عنده هي نفسها المواد المستخدمة قديما من القرآن وقراءاته والشعر ورواياته، وقد يتمثل بالحديث النبوي
ص263
أحيانا، لا لغرض استنباط القواعد وإنما للاستئناس. ويتعجب ابن جني كثيرا من مهارته في القياس حتى ليقول: "ما كان أقوى قياسه ... فكأنه كان مخلوقا له" (50). ويروي عنه أنه كان يقول: "أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس" (51) ويدل دلالة واضحة على اتساعه في القياس ما قاله عنه ابن جني في الإلحاق، إذ ذكر أنه قال: "لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع أن يبني بإلحاق اللام اسما وفعلا وصفة لجاز له, ولكان ذلك من كلام العرب، وذلك نحو قولك: خَرْجَج أكرمُ من دخلل، وضرببَ زيدٌ عمرا، ومررت برجل ضربب وكرمم ونحو ذلك. قال ابن جني: فقلت له: أفتُرتجل اللغة ارتجالا؟ قال: ليس بارتجال، ولكنه مقيس على كلامهم، فهو إذن من كلامهم" (52)
وعلى نحو ما يتعجب ابن جني من سداد أقيسته, يتعجب من قدرته على التعليل وكثرة ما كان يدلي به من تعليلات في مسائل النحو والتصريف حتى ليقول: "أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا" (53).
ويكفي أن نذكر مثالين من تعليلاته, أولهما: أن سيبويه كان يذهب إلى أن حركة الإعراب حادثة بعد الحروف النهائية في الكلمات، وذهب أبو علي إلى أنهما حدثتا معا مستدلا بأن النون الساكنة مخرجها من الأنف ومخرج النون المتحركة من الفم، ولو كانت الحركة حادثة بعد الحرف لوجب أن تكون النون المتحركة أيضا من الأنف(54). والتعليل الثاني ما رواه ابن جني من أنه سأله عن رد سيبويه كثيرا من أحكام التصغير إلى أحكام جمع التكسير وحمله إياها عليها، فقال: سُرَيْحين في تصغير سرحان لقولهم: سراحين, وعُثَيْمين في تصغير عثمان لقولهم: عثامين، فقال أبو علي: "إنما حُمل التحقير في هذا على التكسير من حيث كان التكسير بعيدا عن رتبة الآحاد، فاعتد ما يعرض فيه لاعتداده
ص264
بمعناه، والمحقَّر هو للمكبر، والتحقير فيه جارٍ مجرى الصفة فكأنْ لم يحدث بالتحقير أمر يحمل عليه غيره كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد"، ويعلق ابن جني على هذا التعليل بقوله: "هذا معقد معناه، وما أحسنه وأعلاه" (55). وواضح أن تعليلاته لم تكن تقف عند آرائه، بل كانت تمتد إلى آراء سيبويه وغيره من النحاة السابقين.
ص265
_______________
(1) انظر في ترجمة أبي علي: الفهرست ص64، والزبيدي ص130 , وتاريخ بغداد 7/ 275، ونزهة الألباء ص315, وإنباه الرواة 1/ 273، وطبقات القراء لابن الجزري 1/ 206, ومعجم البلدان 6/ 376, ولسان الميزان 2/ 195، وشذرات الذهب 3/ 88, والنجوم الزاهرة 4/ 151, والمزهر "طبعة الحلبي" 2/ 487، 606, وبغية الوعاة ص216, وأبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي, طبعة مكتبة نهضة مصر ومطبعتها.
(2) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان "طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر" 1/ 131.
(3) الخصائص لابن جني "طبعة دار الكتب المصرية" 3/ 75.
(4) الخصائص 1/ 135.
(5) الخصائص 1/ 143.
(6) الخصائص 1/ 293 وما بعدها.
(7) الخصائص 1/ 321.
(8) الخصائص 1/ 357.
(9) الخصائص 2/ 17.
(10) الخصائص 2/ 133.
(11) الخصائص 2/ 168.
(12) الخصائص 2/ 197.
(13) الخصائص 2/ 321.
(14) الخصائص 2/ 329.
(15) الخصائص 3/ 24.
(16) الخصائص 3/ 173.
(17) الخصائص 3/ 227.
(18) الخصائص 3/ 255.
(19) المغني ص278.
(20) الخصائص 3/ 170 .
(21) المغني ص92.
(22) ابن يعيش على المفصل 1/ 68.
(23) المغني ص563.
(24) همع الهوامع 1/ 124.
(25) الهمع 2/ 121.
(26) المغني ص294.
(27) الخصائص 2/ 19, وانظر الهامش.
(28) المغني ص67.
(29) المغني ص111.
(30) المغني ص142, ومما تابع فيه الكوفيين أن من حروف النصب للمضارع كما بمعنى كيما "الهمع 2/ 6, والمغني ص193" ومر بنا أن الكسائي كان يرى في مثل: قام وقعد محمد أن فاعل الفعل الأول محذوف ولا فاعل، وقد استضاء بذلك الفارسي فذهب إلى أن قلما في مثل: قلما ينظر محمد لا فاعل لها, وكأن الفعل أجري مجرى حرف النفي, ومثلها كان المزيدة في مثل: أنت تكون ماجد نبيل "المغني ص750 ، والهمع 1/ 120 ".
(31) ابن يعيش 8/ 89, والرضي 1/ 119.
(32) ابن يعيش 1/ 127, والرضي 1/ 129.
(33) الهمع 1/ 171.
(34) الرضي 1/ 24.
(35) الهمع 1/ 51.
(36) الهمع 2/ 9.
(37) الهمع 1/ 99.
(38) الخصائص 2/ 353، والهمع 2/ 141.
(39) الهمع 2/ 85.
(40) المغني ص328, والهمع 1/ 250 .
(41) المغني ص488، والهمع 1/ 92.
(42) المغني ص 489، والهمع 1/ 122.
(43) المغني ص335.
(44) الهمع 1/ 200 .
(45) المغني ص171, والهمع 1/ 231.
(46) المغني ص347.
(47) الخصائص 1/ 338، والهمع 1/ 145.
(48) المغني ص589، والهمع 1/ 180 .
(49) المغني ص256.
(50) الخصائص 1/ 277.
(51) الخصائص 2/ 88.
(52) الخصائص 1/ 358، وما بعدها.
(53) الخصائص 1/ 208.
(54) الخصائص 2/ 321 وما بعدها.
(55) الخصائص 1/ 354.
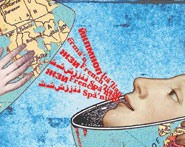
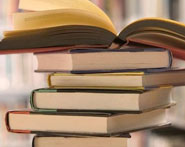

|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|