


 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة
الجهود الدلالية عند الجاحظ (160 هـ ـ 255هـ):
من خلال كتابيه (البيان والتبيين والحيوان):
إن الجاحظ في علم البلاغة والجمال، يضاهي مكانة الشافعي في علم أصول الفقه، فهو أول من فتق أبواب البيان، وأبان عن مكامن اللغة العربية الجمالية، آخذاً في ذلك جمع الصور اللفظية وغير اللفظية التي تحتضن الفكر و تعبر عن الدلالات والمعاني المختلفة. كما عكف على الدراسة الصوتية للحرف واللفظ لكون ذلك يفضي إلى استقامة البيان وحصول الإبلاغ، بحيث يراعي فيه حسن التأليف بين الحرف والكلمة، وقد أشار الجاحظ في هذا المجال إلى تلك الأمراض النطقية التي تؤدي إلى اختلال في آلة التعبير خاصة في مخارج الأصوات وعدّ منها الكثير(1). وقد أضحى ذلك في العصر الحديث فرعاً من اللسانيات وقد التمس له العلماء أسباباً فوجدوها عصبية نفسية تؤدي إلى اضطراب أساسي في بنى اللغة وأطلقوا على ذلك المبحث العصب السني (Neurolinguistique)(2) تناول الجاحظ في كتابيه: "البيان والتبيين" وكتاب "الحيوان". مباحث لها ارتباط وثيق بموضوع الدلالة، وعلاقتها بطرق تأديتها فلقد قسم العلاقة إلى أصناف، كما وقف على وظائف الكلام، لأن ذلك هو جوهر البيان وفي إطاره تناول الدلالة السياقية، واختيار المكان والمقام الملائمين لموقع اللفظ والمعنى، كما خاض الجاحظ في ذلك الجدل الذي دار حول نشأة اللغة: أتوفيقية هي أم اصطلاحية توفيقية؟… تلك بعض الأبحاث التي تناولها الجاحظ ضمن مباحث البيان، نحاول أن نعبر إليها بغية اقتناص ما نستطيع أن نعثر عليه من مفاهيم لسانية، ودلالية…
أ ـ حسن التأليف بين الحروف والألفاظ:
إن دراسة أصوات اللغة في الدرس اللساني الحديث تتم ضمن نمطين اثنين..
1 ـ الدراسة الصوتية النطقية Articulation التي تتوخى وصف كيفية إنتاج أصوات الكلام، ووصف مخارج الحروف التي تشكل الصوت
ص119
اللغوي الصحيح بحيث لا تتنافر الحروف مراعاة ليسر النطق وثبات الصوت في الاستعمال إذ تأكد لدى علماء اللغة أن الكلمات المندثرة كان أغلبها مؤلفاً من حروف صعبة التجاور.
2 ـ أما النمط الثاني فهي الدراسة الصوتية السمعية Acoustique التي تدرس الخصائص الفيزيائية للصوت اللغوي المنطوق، يقول الجاحظ وهو يعرض صفات الحروف التي تتوافق لتشكل لفظاً صحيحاً والحروف المتنافرة التي تجتمع ليس في لسان العرب فحسب، بل وفي ألسنة العجم من الفرس والأجناس غير العربية(3): "فأما في اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين، بتقديم ولا بتأخير، والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير"(4). إن الجاحظ بهذا التحليل لطبيعة الحروف يحاول وضع أسس للصوت بحسب قوته من الجهر أو الهمس، فالحروف التي تختلف في السمات الصوتية تكون أقرب إلى المجاورة من الحروف التي تتفق في ذلك، فالجيم صوت مجهور لا يقع مجاوراً لصوت الظاء أو القاف أو الطاء ولا الغين لكون هذه الحروف لها سمات الجهر كذلك، وهو ما استخلصته الألسنية الحديثة التي صنفت الحروف إلى مخارج وتأكد استحالة تأليف لفظ من حروف تنتمي لذات المخرج النطقي وإنما اللفظ الذي تتوفر فيه سمات النطق الصحيح هو المؤلف من حروف متباعدة المخارج مختلفة السمات الصوتية..
والبيان ـ عند الجاحظ ـ يقتضي عدم التنافر بين مجموع الألفاظ التي تؤلف الجملة حتى أنه ينقل قول الشاعر:
وقبر حرب بمكان قفر
وليس قرب قبر حرب قبر.
ولصعوبة إنشاده ثلاث مرات متتالية ظن البعض من اللغويين أنه من أشعار الجن، وذلك لما بين كلماته من تنافر يعسر نطقها مجتمعة في سياق واحد، ولما في إنشادها من الاستكراه والنبو، والبلاغة عند الجاحظ ليس إلا أن تؤلف في نسق صحيح بين كلمات أو بين حروف اللفظ ثم تراعي حسن موقع المعنى من ذلك لتقذفه إلى سمع المتكلم فإذا هو يعيَه ويستوعبه يقول الجاحظ: "لا يكون
ص120
الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"(5)، ثم إن القدر المساوي بين اللفظ والمعنى يقتضي أن يصرف المتكلم كلامه على وجه لا إطناب فيه، ولا حشو لأن تآليف الكلام سليمة واقتضاؤها للمعنى صحيح يقول الجاحظ: "وإنما الألفاظ على أقدار المعاني فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها، وسخيفها لسخيفها، والمعاني المصغرة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الألفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة"(6) فعلى قدر المعاني تأتي الألفاظ، فقد تكفي الإشارة الحقيقية للمعنى الظاهر البعيد عن اللبس وقد تتطلب المعاني الخفية التي تحتمل دلالات كثيرة إلى ألفاظ كثيرة قصد إجلاء الدلالات المشتركة والإبانة عن المعنى المراد. وإن إدراك الجاحظ إلى أن اللفظ هو عبارة عن مقاطع صوتية تنتج عنها حروف وأصوات، ليعبر عن القدرة التي أوتيها في معاينة اللغة يضاهي في ذلك ما أشار إليه أندري مارتينه في قوله بالتلفظ المزدوج Double articulation يقول الجاحظ: "الصوت وهو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف… ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف"(7)
ب ـ أصناف العلامة عند الجاحظ:
إن الدلالة كامنة مستترة لا ظهور لها دون العلامة التي تجسدها وتحققها في الواقع اللغوي، هذه العلامة عند الجاحظ تشمل كل الوسائل التعبيرية الممكنة، اللغوية وغير اللغوية، وبذلك يكون قد أوضح المسألة الدلالية في بعدها الكلي وهو ما أضحى يعرف بعلم الرموز (semiologie)، فقد عدَّ الجاحظ خمسة أصناف من العلامة هي: اللفظ والإشارة والعقد والخط والحال أو النصبة. يقول الجاحظ موضحاً أدوات البيان الخمس: "وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ. خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، التي تسمى نصبة(….)، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحيلة مخالفة لحيلة أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التفسير…"(8) وكان الجاحظ قد أشار إلى أن هذه التقسيم لأدوات البيان كان من الأحسن أن يكون في أول
ص121
الكتاب،(9)، وذلك لشمولية تلك الأدوات لكل مرامي البيان، ومستويات الكلام البليغ.
إن الأداة الأولى للبيان هو اللفظ اللغوي ـ كما ينص على ذلك الجاحظ ـ وذلك لأن اللغة تبقى في إمبراطورية العلامات، تهيمن على كل الأنظمة الإبلاغية، وقد خصَّ الجاحظ اللفظ الدال بجملة سمات تعني بنيته الدلالية وبنيته الصورية يقول الجاحظ: "ثم إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى غير نهاية وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة"(10). إن تصوراً لإنفصالية العلاقة بين اللفظ والمعنى يكرسه تعريف الجاحظ للفظ أو للمعنى فهما ـ كما أشار إلى ذلك دو سوسوسير ـ أشبه بوجهي الورقة الواحدة أو العملة الواحدة، فنرى الجاحظ في كتبه يبرزهما دائماً في شكل ثنائية تقابلية، إن الألفاظ ـ على نقيض المعاني ـ متناهية، محدودة، لأنها مشكلة من أصوات، والصوت محدود معدود، ولذلك كانت المعاني مما يتوصل إليها بأشكال مختلفة من الألفاظ، فاللغة قاصرة على أن تحيط بعالم المتكلم أو بالعوالم الدلالية كما سماها "غريماس".
أما الإشارة فهي علامة غير لغوية تشمل التعبير عن حالات نفسية وبيولوجية مختلفة، وتكون بأعضاء الإنسان كاليد والرأس أو بأشياء أخرى خارجة عن أعضائه كالثوب والسيف. والحقيقة أن الجاحظ قد استطاع أن يحصر الإشارة غير اللفظية حصراً يتجاوز به عصره الذي نشأ فيه إلى عصر انبثاق علم الرموز. يقول الجاحظ: "فأما الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان وبالثوب وبالسيف، وقد يتهدد رافع السيف أو السوط فيكون ذلك زاجراً ومانعاً رادعاً ويكون وعيداً وتحذيراً".(11) أما علاقة الإشارة باللفظ فهي تفصح عن مدلوله وقد تنوب عنه في الدلالة عليه، كما تعتبر الإشارة إيجازاً أو حذفاً أستغني فيه اللفظ في موضع لا يختل فيه البيان بالإشارة. يقول الجاحظ: "والإشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط… ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص:(12) إن للإشارة مجالها الوظيفي قد لا يلجه اللفظ، وهو الدلالة على
ص122
"معنى خاص الخاص"، ويقصد به الجاحظ المعنى الموجز إيجازاً، لا يكون إلا بالإشارة دون غيرها من أدوات البيان الخمس، وقد يكون اللفظ ناقصاً في الدلالة على المعنى لا يرفع عنه النقص إلا بمصاحبة الإشارة له. يوضح الجاحظ ذلك بقوله: "وحسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان"(13)، أما الدلالة بالعقد أو الحساب فهي كذلك من شمول أصناف البيان الخمس، فالرقم الحسابي الذي تضمنته آيات القرآن الكريم يحمل دلالات ومنافع جليلة، بل إن دلالة الرقم الرياضي هي من الدلالات المنطقية، فسواء كانت مفردة أو أضيفت لبعضها البعض فإنما هي دوال تهدي إلى مدلولات، إذ تُتخذ مدرجاً يُرتقى به من المعلوم فرضاً إلى المجهول تقديراً. يقول الجاحظ، مؤكداً على قيمة دلالة العقد ضمن أنظمة الإبلاغ الأخرى: ".. والحساب يشمل على معانٍ كثيرة، ومنافع جليلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله ـ عز وجلَّ ـ معنى الحساب في الآخرة، وفي عدم اللفظ وفساد الخط، والجهل بالعقد فساد جل النعم وفقدان جمهور المنافع واختلال كل ما جعله الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لنا قواماً ومصلحة ونظاماً"(14)..
أما الدلالة بالنصبة أو الحال، فهي في حقيقتها امتداد للدلالة بالإشارة لأنها دلالة كل صامت أو ماكان في حكمه من جماد أو إنسان أو حيوان، فصورته المرئية أو المسموعة تحمل مدلولات ترتبط بشكل علائقي مع دوالها. وبذلك يكون الجاحظ قد نظر إلى عالم الإشارة نظرة شاملة وهو في ذلك يستلهم أحكامه من القرآن الكريم، الذي جعل الله فيه كل شيء هو آية أو علامة من علامات الكون الفسيح ودليل من دلائلية ألوهيته وربوبيته ـ عزَّ وجلَّ ـ يقول الجاحظ: "وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض، وفي كل صامت وناطق، وجامد ونام ومقيم، وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموت الجامد. كالدلالة التي في الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان"(15). إن البلاغة عند الجاحظ ـ إذن ـ تهدف إلى تحقيق غاية من الكلام البشري تتلخص في حسن الإبلاغ بوسائل مختلفة ذات نسق تنظيمي محكم، وهو بذلك يؤسس لمفاهيم لسانية ودلالية تتوخى الشمولية في التناول، منطلقاتها شروط توصيل الدلالة كما
ص123
يقصد إليها المتكلم مع وعي دقيق بأوضاع المستمع المتلقي، وأجوائه النفسية والحالية العامة. يقول الجاحظ ملخصاً ذلك كله: "وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إطار المعنى"(16).. ويحصل ثمة الإبلاغ بتوافر سمات تعود إلى الإشارة وإلى طريق تأديتها من دقة الاختيار وتناسبها مع المعنى المؤدي، دون النظر إلى أداة ذلك من أدوات البيان الخمس. وقد أورد الجاحظ تلخيص هذه الأدوات في كتاب الحيوان إلا أنه لم يشر صراحة إلى أداة النصبة أو الحال وذلك لكون الكتاب كان قد ألفه قبل كتاب البيان والتبيين الذي وردت فيه الأدوات خمساً مفصلة ومحددة، يقول الجاحظ: "وجعل [الله] آلة البيان التي بها يتعارفون (الناس) معانيهم والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء، وفي خصلة خامسة وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتها، فقد نزل بجنسها الذي وضعت له، وصرفت إليه. وهذه الخصال هي: اللفظ والخط والإشارة والعقد، والخصلة الخامسة ما أوجد من صحة الدلالة، وصدق الشهادة ووضوح البرهان، في الأجرام الجامدة والصامتة والساكنة"(17)..
ج ـ وظائف الكلام عند الجاحظ:
لقد أوضح "رومان جاكبسون (R.Jackobson)" الوظائف التي يؤديها الخطاب اللغوي انطلاقاً من فحوى مضمونه الذي يحدد قصد المتكلم، وغايته من إعلام السامع، الذي بدوره يتخذ أشكالاً عدة من ردود الفعل تجاه الخطاب اللغوي الذي استفزَّه وأثاره، هذه الوظائف هي : الوظيفة المرجعية، والوظيفة الانفعالية، أو التعبيرية، والوظيفة الإنشائية، ووظيفة إقامة الاتصال، والوظيفة الشعرية، والوظيفة ما بعد الألسنية….(18) بعض هذه الوظائف يمكن مقاربتها بوظائف أشار إليها الجاحظ في معرض حديثه عن البيان. يقول: "لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه المعاون له على أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره، وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها"(19)… وذلك أن المعاني كامنة مستترة لا يمكن أن يعلمها
ص124
(الآخر) إلا إذا تمظهرت في أنماط مقولية، بها يطلع على ما في ضمير مخاطبه، ولا ينعقد الاتصال الإعلامي بينهما حتى يفصح أحدهما عما في نفسه من الحاجات للآخر، فكأن تلك المعاني كانت ميتة فأحييت بالذكر والأخبار والاستعمال، وهذا مايكاد (جاكبسون) يعنيه من الوظيفتين المرجعية (referentielle) والوظيفة التعبيرية أو الانفعالية (emotive) إذ الأولى تعني التخاطب بهدف الإشارة إلى محتوى معين نرغب في إيصاله إلى الآخرين وتبادل الآراء معهم، أما الثانية فهي تتمحور حول إبراز موقف المتكلم ـ خاصة ـ من مختلف القضايا موضوع حديثه.(20)
وكان الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين " يسوق نصوصاً وأخباراً تخص بعض البلغاء وبعض الذين استشهد بكلامهم، قصد تعليل رؤيته اللغوية حول قضية من قضايا اللغة، ويمكن أن نلتمس وظيفة الاتصال (Phatique) في حوار أقامه مع صديق له يقول الجاحظ: "فقلت له ـ أي للعتابي ـ قد عرفت الإعادة والحبسة [وهما من عيوب النطق] فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه: يا هناه، ويا هذا ويه هيه، واسمع مني واستمع إليَّ، وافهم عني أو لست تفهم أو لست تعقل…".(21) فالجاحظ يرصد هاهنا بعض "المداخل" اللغوية التي كانت توظف لإعادة إقامة الاتصال الذي قد يتعرض لاضطراب في قناته. فتأتي هذه "المداخل" لتضمن وتؤمن للاتصال استمراريته. هذه بعض الوظائف التي رصدناها من خلال معاينة ما أورده الجاحظ في كتابه، وهي تعبر بصدق عن امتلاك قوي وكبير لناصية اللغة وآلياتها في الإبلاغ والتواصل..
د ـ أصل اللغة عند الجاحظ :
يذهب الجاحظ في البحث عن أصل اللغة مذهب القائلين بالتوقيف لا التوفيق، ويقدم لصحة مذهبه أدلة وحجج منها كلام عيسى ـ عليه السلام ـ بالحكمة وهو صبي، كما أن آدم وحواء كانا محتاجين للغة، للتفاهم والتحاور والتشاور فأخذ الله بأيديهم وألهمهم لغة، وحياً من عنده، ثم إن القرآن الكريم قد أتى بألفاظ لم يعرفها العرب في جاهليتهم وذكر الجاحظ بعضاً منها كتسمية كتاب الله قرآن، والتيمم مسح على التراب، والقذف فسق، إن ذلك كله لم يكن في لغة أهل
ص125
الجاهلية.(22) ومع ذلك أقر الجاحظ بوجود ألفاظ جديدة كانت ثمرة للتواضع والاصطلاح بين أهل اللغة استدعتها ظروف مستجدة، وعلوم فرضت مصطلحات جديدة حتى غدا لجمهور الفقهاء وعلماء أصول الفقه وأهل اللغة والأدب، لكل معجمه الخاص، فكان ذلك اصطلاح على نظام علامي داخل نظام علامي عام. فالجاحظ كان يميل إلى القول بأن اللغة إلهام في الأصل إلا أنه يقول بالاصطلاح كذلك لأن المعاني غير متناهية، والعالم الدلالي غير محصور ولذلك قد يلجأ المتكلم إلى الاحتيال على نفسه وعلى اللغة، وذلك ليغطي عن قصوره وقصورها، لأنه لا يستطيع أن يحيط بعالم المعنى كما أن اللغة لا يمكنها أن تعبر عن كل ما يشكل عالمه الدلالي، فيلجأ عندئذٍ إلى اختراع أنظمة جديدة للتواصل يكون للاصطلاح فيها المحل الأول ولكنها ـ هذه الأنظمة الجديدة ـ تعيش داخل نظام كلي عام هو اللغة الأصلية الأولى.
هـ ـ الدلالة السياقية عند الجاحظ :
إن مفهوم الجاحظ للمعنى ينبني على رصد موقعه من جملة المعاني ومقابلته باللفظ، فيحدد المعنى بأنه مدلول الكلمة من الأشياء والأفكار والمشاعر(23)، كما أن طبيعة المعنى تخالف طبيعة اللفظ، فالمعنى مستتر خفي واللفظ هو المستخدم لبيانه وظهوره وعلى ذلك فالمعاني محلها النفس وصورتها في الذهن، كما أن الفكر هو الذي يشكلها ويحدثها. يقول الجاحظ : "قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم"(24) هذه هي مواصفات المعنى عند الجاحظ يضاف إليها لا محدوديتها ولا نهائيتها مقابل لمحدودية الألفاظ ونهائيتها. يقول الجاحظ في ذلك:"ثم إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة وممتدة إلى غير نهاية وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة"(25).
وبعد أن أوضح الجاحظ مقام المعاني بالنسبة للألفاظ ومقامها في ذهن المتكلم إذ هي أقدار وأحوال وليست على درجة واحدة من الاستعمال، فما يصلح لهذا المقام والحال قد لا يصلح لمقام وحال آخرين، وهذا ما عنته النظرية
ص126
المقامية، يقول الجاحظ كاشفاً عن الدلالة المقامية أنه ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وحالاتهم، فيجعل لكل طبقة منهم كلاماً يخصهم به حتى يقسم بالتساوي أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم المعاني على أقدار المقامات التي هم عليها المستمعون وحالاتهم(26). فالمعاني إذن تصنف وترتب بحسب أصناف الناس في المجتمع وتباين مقاماتهم وأحوالهم. وتلك رؤية علمية في غاية الدِّقة لطبيعة وجوهر العملية الإبلاغية، التي يراعى فيها الشروط الموضوعية (الخارجية) والشروط الذاتية التي يتصف بها الخطاب وصاحبه وهو ما تنادي به بعض المدارس اللسانية الحديثة التي تدعو إلى ضرورة الإحاطة بوضع المتلقي النفسي والاجتماعي حتى لا يقع المعنى في انسداد دلالي. وتلك إشارة إلى وجوب التوفيق عند المتكلم بين خطابه ومقام المستمع المتلقي، ويعني ذلك أن المتكلم كان قد قام بمطابقات تركيبية تشمل المطابقة النحوية (التأليف على سمت كلام العرب)، والمطابقة البلاغية (معرفية الفصل من الوصل) فضلاً على المطابقة بين اللفظ والمعنى وحسن موقع الكلمة من السياق، وهو ما تشير إليه نظرية الوقوع أو الرصف (collocational theory) حيث يعرف ستيفن أولمان الوقوع أو الرصف بقوله: "هو الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة".(27) ثم إن عرض الجاحظ لموضوع التنافر الحادث بين الكلمات يقدم التقدير الكافي لمنع الوقوع أو الرصف في بعض السياقات، وقد أكدت دراسات دلالية تالية في النظرية السياقية، أن الجملة لا تعتبر كاملة المعنى إلا إذا صيغت طبقاً لقواعد النحو، وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة وتقبلها أبناء اللغة بحيث يعطونها تفسيراً ملائماً وهو ما سمي باسم التقبلية(28) (Acceptability)، كما اتضح في الدرس الدلالي الحديث أنه كلما كان المتلقي على علم مسبق بفحوى الخطاب، كلما كان استيعابه للدلالة أكثر، واتخذ الخطاب نمط الإيجاز والاقتصاد، أما إذا كان المتلقي ممن لا يستوعب الخطاب إلا إذا كان كاملاً مفصلاً لاعتبارات شتى، فإنّ ذلك يقتضي التبسيط في بنيته ولذلك يقول الجاحظ: "رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام"(29). وقد يبلغ الحذف تمامه في
ص127
الإضراب حيث يزول كل شيء وتبقى المعاني عارية "غفلاً غير موسومة"(30).
إن المقام ومحدودية الدراسة، لا تسمح لنا أن نفيض في المباحث اللغوية التي أثارها الجاحظ، ولو استرسلنا في عرض عطاءات الجاحظ اللسانية والدلالية لضاق بنا المجال ولاحتاج ذلك لدراسة مستقلة، تحاول أن تقارب بين ما أبدعه الجاحظ وما قررته الدراسات اللغوية الحديثة. وحسب الجاحظ –من خلال ما قدمناه من عرض مقتضب- أنه كرّس رؤية علمية شاملة، إذ نظر إلى بنية اللغة نظرة كلية آخذاً في ذلك بمبدأ أن الدلالة لا تتحقق إلا بتفاعل الأنساق اللغوية المختلفة، منها ما يخص المرسل ومنها ما يخص المتلقي من أهل اللغة، كما لم يغفل نسق المحتوى والمضمون فضلاً على قناة الإرسال وعنى بها التركيب وسماته الصورية من تآلف الكلم وفق قواعد التركيب والنحو، وما أظهره الجاحظ هو مرونة النظام اللغوي، وقابلية الشكل والمحتوى إلى التغيير في ظل معطيات الإبلاغ والتواصل، وأقرب تمثيل لذلك هو الانزياح الدلالي المعبر عنه بالمجاز.
ص128
______________________
( ) من هذه الآفات التي تصيب النطق: التعتع، التمتمة ـ الحبسة ـ العقدة ـ العقلة… انظر البيان والتبيين باب عيوب البيان، ص 27.
(2) د.ميشال زكريا، انظر ذلك في كتاب: "الألسنة، علم اللغة الحديث ـ ص 70.
(3) البيان والتبيين، ج1، ص 51.
(4) المصدر السابق، ج1، ص 77.
(5) المصدر نفسه، ج1، ص 81.
(6) الحيوان، ج6، ص 08.
(7) البيان والتبيين، ج1 ص، 84.
(8) المصدر السابق، ج1، ص 82.
(9) المصدر نفسه، ج1، ص 82.
(10) المصدر نفسه، ج1، ص 81.
(1 ) المصدر نفسه، ج1، ص 83.
(2 ) المصدر نفسه، ج1، ص 83.
(3 ) المصدر نفسه، ج1، ص 84.
(4 ) المصدر نفسه، ج1، ص 85.
(5 ) المصدر نفسه، ص 86.
(6 ) المصدر نفسه، ص 89.
(7 ) الحيوان، ج1، ص 40.
(8 ) Essais de linguistique generale. p. 98. ـ وانظر شرح ذلك في الباب الأول: مبحث اللغة، ص 37.
(9 ) البيان والتبيين، ج1، ص 81.
(20) د.ميشال زكريا : "الألسنية، علم اللغة الحديث" ص 54.
(21) البيان والتبيين، ج1، ص 112.
(22) انظر الحيوان، ج1، ص 280-281.
(23) د.ميشال عاصي، مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، ص 166.
(24) البيان والتبيين، ج1، ص 81.
(25) المصدر نفسه، ج1، ص 131.
(26) المرجع السابق، ج1، ص81.
(27) Meaning and style… p.. 10
(28) انظر علم الدلالة،د.احمد مختار عمر، ص77.
(29) الحيوان،ج1،ص94.
(30) محمد الصغير بناني، النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ –من خلال البيان والتبيين، ص270.
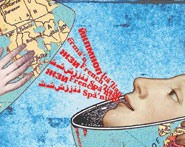
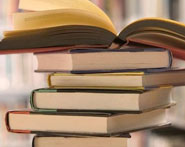

|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|