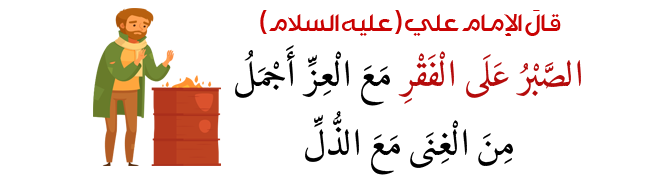
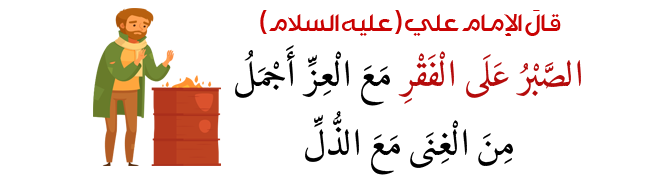

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-7-2019
التاريخ: 18-9-2016
التاريخ: 2024-08-13
التاريخ: 17-4-2022
|
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة « قاعدة الميسور ».
فنقول : المراد منها أنّ الشارع إذا أمر بمركب له أجزاء وشرائط وموانع ، فإذا تعذّر له إيجاد بعض الأجزاء أو بعض الشرائط أو تعسر عسرا يرفع التكليف عن المعسور ، أو تعذّر له ترك بعض الموانع ، أو تعسر فهل يسقط الوجوب بالمرّة ، ويرتفع عن جميع أجزاء ذلك المركّب مع شرائطه وموانعه ، المتعذّر منها وغير المتعذّر ، أم لا بل يرتفع عن خصوص ما هو المتعذّر منها ، وأمّا بالنسبة إلى الباقي فباق؟
ومعنى قاعدة الميسور هو أنّ الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من المركّب باق ، ولا يرتفع عن ذلك المقدار بواسطة ارتفاعه عن المقدار المتعذّر أو المعسور.
وهو أمور :
[ الأمر ] الأوّل : إطلاق دليل المركّب ، بمعنى أنّ دليل المركّب له إطلاق يشمل كلتا حالتي التمكّن من إيجاد الجزء وعدم التمكّن منه ، مثلا قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] لو فرض أنّه له إطلاق يشمل كلتا حالتي التمكّن من رمي الجمرة وعدم التمكّن منه ، فإذا لم يكن متمكّنا منه وسقط الأمر عنه بواسطة عدم القدرة ، يتمسك بإطلاق دليل وجوب الحجّ لوجوب الباقي وعدم سقوطه بسقوط وجوب ذلك الجزء أو ذلك الشرط.
ولكن التمسّك بإطلاق دليل المركّب يتوقّف على أمور :
الأوّل : أن تكون مقدّمات الإطلاق فيه موجودة.
الثاني : أن لا يكون لدليل ذلك الجزء أو الشرط المتعذّر إطلاق يدلّ على جزئيّته أو شرطيّته مطلقا ، سواء كان المكلّف متمكّنا من إيجاده أم لا ، إذ مع إطلاقه لا يبقى مجال للتمسّك بإطلاق دليل المركّب ، لحكومة إطلاق دليل الجزء على إطلاق دليل المركّب.
الثالث : أن لا يكون اللفظ الموضوع لذلك المركّب موضوعا للصحيح إذا كان من العبادات ، وذلك لأنّه بناء على أن يكون كذلك لا يمكن التمسّك بإطلاقه في رفع جزئيّة مشكوك الجزئيّة ، أو شرطيّته كذلك.
نعم لا بأس بالتمسّك بإطلاقها المقامي ، كما شرحنا كلّ ذلك مفصّلا في كتابنا « المنتهى ».
[ الأمر ] الثاني : الاستصحاب. ومعلوم أنّ بقاء الوجوب بالنسبة إلى البقيّة ـ أي ما عدى المتعذّر من الأجزاء والشرائط والموانع وجودا بالنسبة إلى الأولين ، وعدما بالنسبة إلى الأخير ـ الذي هو عبارة عن الاستصحاب حيث أنّه مفاد الأصل العملي ، فلا تصل النوبة إليه ، إلاّ بعد فقد إطلاق دليل المركّب وإطلاق دليل القيد ، أي الجزء والشرط وعدم المانع ، إذ مع فرض إطلاق دليل المركّب مع إجمال دليل القيد ، فبقاء الوجوب للبقيّة معلوم بواسطة الإطلاق.
فلا يبقى موضوع لجريان الاستصحاب ، لحكومة إطلاق دليل المركّب عليه ، ومع فرض إطلاق دليل القيد سواء كان إطلاق لدليل المركّب أو لم يكن ، يكون سقوط الوجوب بالنسبة إلى البقيّة معلوما.
أمّا في فرض إجمال دليل المركّب فواضح ، وأمّا في فرض إطلاقه فلحكومة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المركّب ، فلا مجال لوصول النوبة إلى الاستصحاب ، إلاّ فيما إذا كان دليل المركّب ودليل القيد كلاهما مجملين.
وأمّا إذا كان أحدهما مطلقا ، أو كان كلاهما مطلقين ، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، وذلك لحكومة الأمارات التي منها الإطلاقات على الأصول مطلقا ، محرزة كانت أو غير محرزة.
ثمَّ إنّ تقرير الاستصحاب ها هنا من وجوه :
الأوّل : استصحاب بقاء الجامع بين الوجوب النفسي المحتمل الوجود المتعلّق بما عدا القيد بعد تعذّره ، ووجوب الغيري الذي كان متعلّقا بما عدا القيد المتعذّر من باب المقدّمة.
ومعلوم أنّ هذا الوجه مبنيّ على وجوب المقدّمات الداخليّة بالوجوب الغيري ، مثل المقدّمات الخارجيّة.
بيان ذلك : أنّ وجود ذلك الجامع في ضمن الوجوب الغيري لما عدا قيد المتعذّر كان متيقّن الوجود ، وحيث أنّه من المحتمل وجوب النفسي المستقلّ لما عدا ذلك القيد المتعذّر بعد تعذّره ، فيكون بقاء ذلك الجامع مشكوكا بعد تيقّن وجوده ، فيكون مجرى الاستصحاب.
وفيه أوّلا : أنّ المقدّمات الداخليّة ـ أي أجزاء المركّب الواجب ـ ليست واجبة بالوجوب الغيري ، وقد حقّقنا ذلك في باب مقدّمة الواجب.
وثانيا : أنّ هذا الاستصحاب يكون من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، الذي قلنا بعدم جريانه وعدم تماميّة أركانه. وعمدة الإشكال فيه هو أنّ وجود الطبيعة في ضمن كلّ فرد غير وجوده في ضمن الفرد الآخر ، فوجود الجامع في ضمن الوجوب الغيري في المفروض متيقّن الارتفاع ، وفي ضمن الوجوب النفسي المحتمل مشكوك الحدوث ، فليس هناك وجود واحد متيقّن الحدوث ، ويكون هو مشكوك البقاء.
وثالثا : إثبات الوجوب النفسي المستقلّ لما عدى القيد المتعذّر بهذا الاستصحاب مثبت.
الثاني : استصحاب نفس الوجوب النفسي الذي كان متعلّقا بالمركّب قبل حدوث تعذّر القيد.
والإشكال : بأنّ موضوع ذلك الوجوب كان مجموع المركّب ، والمفروض ارتفاع ذلك الموضوع بواسطة تعذّر بعض أجزائه، والبقيّة على تقدير وجوبها تكون موضوعا آخر ، ولا يمكن بقاء الحكم مع ارتفاع موضوعه وتبدّله ، حتّى ولو كان الباقي واجبا لكان وجوبا آخر غير الوجوب الأوّل ، لما ذكرنا من تبدّل الموضوع من الأكثر إلى الأقلّ.
يجاب عنه : بأنّ وحدة القضيّة المشكوكة والمتيقّنة بحسب الموضوع عرفي ، ولا يجب أن يكون الموضوع فيهما واحدا بالدقّة العقليّة ، وإلاّ لا يجري الاستصحاب في الأحكام الكلّية أصلا إلاّ من جهة احتمال النسخ ، فيستصحب عدمه. وقد حقّقنا هذه المسألة في كتابنا « المنتهى ».
ولكن فيه : أنّ هذا الوجه من تقرير الاستصحاب لا يفي إلاّ بالموارد التي يكون موضوع القضيتين ـ المتيقّنة والمشكوكة ـ واحدا بنظر العرف ، وأمّا فيما لا يكون كذلك ، كما هو الأكثر في أبواب العبادات ، فإنّ حكم العرف بوحدة الحجّ المتعذّر فيه الوقوف في الموقفين ـ العرفات والمشعر ، الوقوف الاضطراري والاختياري ـ مع الحجّ المتمكّن فيه الوقوفان ، أو حكمه بوحدة صلاة فاقد الطهورين مع واجدهما أو أحدهما لا أثر له بعد العلم بأنّ الشارع يراهما متباينين حقيقة ، بل الواحدة العرفيّة ليست إلاّ بحسب الشكل فقط.
فليس للعرف طريق إلى تشخيص الوحدة بين المركّب التامّ الأجزاء والناقص في أغلب العبادات ، لعدم طريق له إلى معرفة الأركان ، وتميّزها عن غيرها إلاّ بما صرّح الشارع بركنيّتها.
وهذا الإشكال يأتي في إجراء قاعدة الميسور أيضا وسنتكلّم فيه إن شاء الله تعالى.
والحاصل : أنّ خطاب لا تنقض اليقين بالشكّ وإن كان تشخيص موضوعه بنظر العرف ، ولكن فيما يكون للعرف طريق إلى التشخيص ، لا فيما ليس لهم طريق إلى ذلك.
هذا ، مضافا إلى أنّ العرف أيضا ربما لا يرى الوحدة بين الفاقد للقيد والواجد له ، حتّى فيما إذا كان المركّب من الأمور العرفيّة ، فالاستصحاب بهذا الوجه لا يفي بجميع الموارد.
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ القيد المتعذّر لو كان من قبيل الشرط أو المانع ، فيحتمل أن يكون بنظر العرف من قبيل الواسطة في الثبوت ، لا الواسطة في العروض ، فيكون ما هو الموضوع في القضيّتين بنظره واحدا.
وأمّا إذا كان من قبيل الأجزاء فلا يمكن ذلك ، إذ لا شكّ في أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب ينبسط على جميع الأجزاء ، فكلّ جزء من الأجزاء يقع تحت الأمر المتعلّق بالمجموع ، فلا يكون من قبيل الواسطة في الثبوت ، بل هو بنفسه معروض ، ولا شكّ في انتفاء المركّب بانتفاء جزئه ، وأيضا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، فلا يبقى شكّ في بقاء الحكم عقلا ، وإن فرضنا وحدة الموضوع عرفا.
نعم بناء على هذا البيان يأتي وجه آخر للاستصحاب الشخصي ، سنذكره إن شاء الله تعالى.
لا يقال : فلا يجري الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة بناء على ما ذكر ، للقطع بانتفاء الحكم بعد تغيّر الموضوع ، وبدونه لا شكّ إلاّ من قبل احتمال النسخ.
وذلك من جهة أنّه هناك من المحتمل أن يكون القيد المنفي من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، وهذا الاحتمال موجب للشكّ في بقاء الحكم. بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الجزء المتعذّر ها هنا ليس واسطة في الثبوت قطعا ، بل هو يكون بنفسه معروضا ـ كما بيّنّاه ـ فالفرق بين المقامين في كمال الوضوح.
الثالث : أنّه لا شكّ في أنّ الباقي بعد تعذّر بعض الأجزاء كان واجبا نفسيّا في ضمن المجموع المركّب منه وممّا تعذّر ، والجامع بين هذا الوجوب النفسي الضمني والوجوب النفسي المستقلّ المتعلّق بالمجموع كان موجودا يقينا ، وبعد انتفاء أحد فرديه ـ وهو الوجوب النفسي المتعلّق بالمجموع ـ يحتمل بقاؤه في ضمن الفرد الآخر ، وهو الوجوب المتعلّق بما عدا المتعذّر.
غاية الأمر وجوب الباقي بعد ما كان ضمنيّا ينقلب استقلاليّا ، ولا إشكال فيه ، لأنّ الاستقلاليّة مفهوم ينتزع من أمر وجودي وهو وجوب الباقي ، وأمر عدمي وهو عدم وجوب الجزء المتعذّر. أمّا الثاني فهو المفروض ، وأمّا الأوّل فيثبت بالاستصحاب.
وفيه : أنّ إثبات وجوب الباقي باستصحاب الجامع مثبت.
ويمكن تقرير هذا الوجه بشكل آخر ، وهو أنّ الجامع بين الوجوب النفسي الاستقلالي للمجموع مع الوجوب النفسي الاستقلالي للباقي بعد تعذّر بعض الأجزاء كان موجودا يقينا في ضمن وجوب المجموع ، وبعد تعذّر بعض الأجزاء وإن كان انعدم وجوب المجموع ، ولكنّه حيث أنّه من المحتمل حدوث وجوب نفسي استقلالي للباقي ، فوجود الجامع محتمل البقاء ، فيستصحب.
وفيه أوّلا : أنّه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي الذي قلنا بعدم جريانه.
وثانيا : إثبات وجوب الباقي باستصحاب الجامع مثبت.
أمّا إنّه من القسم الثالث من أقسام الكلّي ، لأنّ الجامع الموجود يقينا كان وجوده في ضمن الوجوب المتعلّق بالكلّ ، وقد انعدم قطعا ، واحتمال بقائه من جهة احتمال حدوث فرد آخر من مصاديق ذلك الجامع حال انعدمه ـ وهو وجوب النفسي الاستقلالي للباقي ـ عين القسم الثالث من استصحاب الكلّي.
وأمّا إنّه مثبت ، فمن جهة أنّ الجامع في المفروض له فردان : وجوب الكلّ ، ووجوب الباقي ، وبعد انعدام أحد الفردين وهو وجوب الكلّ فلو فرضنا بقاء الجامع كما هو مفاد الاستصحاب ، فلا بدّ وأن يكون في ضمن الفرد الآخر وهو وجوب الباقي ، وهذا لازم عقلي لوجود الجامع وبقائه ، وليس عينه.
الرابع : استصحاب الجامع بين الوجوب النفسي الضمني الذي كان لغير المتعذّر من الأجزاء قبل حدوث التعذّر ، والوجوب النفسي الاستقلالي المحتمل حدوثه للباقي بعد حدوث التعذّر ، ولا شكّ في أنّ هذا الجامع كان موجودا يقينا في ضمن الوجوب النفسي الضمني للباقي قبل حدوث التعذّر ويشكّ في بقائه بعد حدوث التعذّر لاحتمال حدوث الوجوب النفسي الاستقلالي للباقي بعد التعذر.
وفيه : أنّ هذا أيضا أوّلا من القسم الثالث من أقسام الكلّي ، وثانيا أنّه مثبت. ومن كثرة وضوحه لا يحتاج إلى البيان.
الخامس : وهو الذي اعتمد عليه وسليم عن هذه الإشكالات ، وإن ذكرته في كتابنا « منتهى الأصول » بصورة الاحتمال.
وتوضيحه ببيان مقدّمة : وهي أنّ الإرادة إذا تعلّقت بمركّب ، فكلّ جزء من أجزاء ذلك المركّب يقع تحت قطعة من تلك الإرادة ، وليست الإرادة ، وليست الإرادة أمرا بسيطا متعلّقا بالمجموع بحيث يكون وجودها وجودا واحدا غير قابل للانحلال، بل تنبسط على جميع الأجزاء نحو انبساط البياض ـ مثلا ـ على الجسم المعروض له.
ولأجل هذه الجهة قلنا إنّ المقدّمات الداخليّة ـ أي الأجزاء ـ ليست واجبة بالوجوب الغيري ، بل واجبة بالوجوب النفسي الضمني ، وأيضا لهذه الجهة قلنا بالانحلال في باب العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر ، فإنّ الأقلّ معلوم تفصيلا وجوبه النفسي وكونه تحت الإرادة ، ويبقى كون الزائد تحت الإرادة مشكوكا ، فيكون مجرى البراءة.
وأمّا كون وجوب الأقلّ مردّدا بين أن يكون ضمنيّا أو استقلاليّا ، فأوّلا : لا دخل له بالمقام ، وثانيا : قلنا إنّ الاستقلاليّة مفهوم ينتزع عن وجوبه وعدم وجوب غيره معه ، ولا فرق في كونه واجبا ومتعلّقا للإرادة بين أن يكون معه غيره أو لا يكون.
إذا عرفت هذا فنقول : فما عدى الجزء المتعذّر قطعا كان قبل حدوث التعذّر واجبا وكان تحت الإرادة ، وبعد حدوث التعذّر بالنسبة إلى بعض الأجزاء يشكّ في بقاء تلك القطعة التي كانت متعلّقة بما عدا الجزء المتعذّر ، إذ من المحتمل ارتفاع خصوص تلك القطعة المتعلّقة بخصوص الجزء المتعذّر ـ من باب أنّه تكليف بالمحال إذا كان ذلك الجزء متعذّرا ، أو من باب أنّ التكليف به مناف مع كون الشريعة سمحة وسهلة إذا كان إيجاد ذلك الجزء متعسّرا ـ لا ارتفاع الإرادة بالمرّة.
ومعلوم أنّ الإرادة بعد التمكّن من إيجاد متعلّقها تابعة للملاك وجودا وعدما ، فيتمّ أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشكّ اللاحق ، وهذا الاستصحاب شخصي وليس بكلّي.
ثمَّ لا يخفى أنّ الرجوع إلى الاستصحاب يكون بعد عدم دليل لفظي على لزوم الإتيان بالميسور ، أو أمارة لبيّة كالإجماع ، وإلاّ لو كان إطلاق دليل أو رواية معتبرة أو إجماع على لزوم الإتيان بما عدا الجزء المتعذّر أو عدم لزومه ، فلا تصل النوبة إلى هذا الاستصحاب.
[ الأمر ] الثالث : الإجماع والاتّفاق على أنّ الأمر المتعلّق بمركّب لا يسقط بصرف تعذّر بعض أجزائه أو تعسّره ، بل يكون ما عدا ذلك الجزء المتعذّر باق على مطلوبيّته ووجوبه.
والإنصاف : أنّ الإجماع على هذا العنوان العامّ وإن لم نتحقّقه ، ولكن لا سبيل إلى إنكاره بالنسبة إلى بعض مصاديقه وصغرياته ، خصوصا في مثل الحجّ والصلاة في غير الأجزاء الركنيّة لهما ، ومع ذلك لا يصحّ الاعتماد على مثل هذه الإجماعات التي يمكن أن يكون اتّفاقهم مستندا إلى بعض هذه الأدلّة التي أقيمت في هذا المقام.
[ الأمر ] الرابع : الروايات الواردة في هذه القاعدة :
منها : قوله صلى الله عليه واله في خطبته في الحجّ : « أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا » فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه واله حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله : « لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » ثمَّ قال صلى الله عليه واله : « ذروني ما تركتم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » (1).
منها : ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (2).
منها : أيضا عنه عليه السلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (3).
وهذه الروايات الثلاث لكثرة اشتهارها بين الفقهاء وعملهم بها لا يحتاج إلى التكلّم عن سندها ، أو الإشكال عليه بالضعف.
وعمدة الكلام هو التكلّم في دلالتها :
فنقول :
أمّا الحديث الأوّل المرويّ عن النبيّ صلى الله عليه واله ، فتقريب الاستدلال به على هذه القاعدة هو أنّه لا شكّ في أنّ مرجع الضمير في كلمة « منه » هو الشيء المأمور به ، فتكون كلمة « من » ظاهرة في التبعيض ، لأنّ الشيء المأمور به له بالنسبة إلى قدرة المكلّف حالات ثلاث : فتارة يكون تمامه مقدورا ، وأخرى تمامه غير مقدور ، وثالثة يكون بعضه مقدورا وبعضه غير مقدور.
أمّا على الأوّلين فحاله معلوم ، فيجب إتيان تمامه على الأوّل ، ولا يجب عليه شيء على الثاني.
وأمّا على الثالث فثلاث صور : الأوّل إتيان تمامه ، وهذا لا يجب قطعا ، لأنّه تكليف بما لا يطاق. الثاني : عدم إتيان تمامه. الثالث : التبعيض بوجوب الإتيان بالمقدور منه فقط.
وهذا الأخير هو مفاد القاعدة ، وقوله صلى الله عليه واله : « فأتوا منه ما استطعتم » ظاهر في هذا الأخير.
وذلك من جهة أنّ كلمة « من » وإن كانت قد تأتي لبيان ما قبلها وأنّه من أيّ جنس ، كقولهم : خاتم من فضة ، لكنّه فيما نحن فيه لا يمكن ذلك ، لأنّ مدخول « من » ضمير راجع إلى نفس الشيء ، فلا يمكن أن يكون مفسّرا ومبيّنا له ، كما هو شأن « من » البيانيّة.
وأمّا كونها بمعنى الباء وإن كان ممكنا كي يكون المعنى كذلك : إذا أمرتكم بشيء فأتوا بذلك الشيء ما دام استطاعتكم ، ولكن هذا المعنى مع أنّه لا ينطبق على المورد ـ لأنّ السائل يسأل عن تعدّد الإتيان في كلّ عام بعد الفراغ عن القدرة على الإتيان في العام الأوّل. وإن شئت قلت : بعد الفراغ عن القدرة على إتيان صرف الوجود ـ يكون ذكر هذا القيد ركيكا ، من جهة أنّ اشتراط التكليف ووجوب الإتيان بالقدرة عقليّ وأمر واضح معلوم ، فلا بدّ وأن تكون كلمة « من » للتبعيض ، كما هو الظاهر والغالب من استعمالات هذه الكلمة ، فيكون المعنى هكذا : إذا أمرتكم بشيء فأتوا بعضه الذي تحت قدرتكم واستطاعتكم.
وتكون الماء موصولة ، لا مصدريّة ولا ظرفيّة ، فيكون مفاد الحديث الشريف عين القاعدة.
نعم ها هنا إشكال : وهو أنّ الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة مبنيّ على أن يكون المراد من « الشيء » في قوله صلى الله عليه واله : « إذا أمرتكم بشيء » هو الكلّ والمركّب من عدّة أجزاء ، وأمّا لو كان المراد به الكلّي والطبيعة المنطبقة على الأفراد والمصاديق المتعدّدة من دون ملاحظة خصوصيّات المشخّصة لها فيكون المعنى هكذا : إذا أمرتكم بطبيعة كلّية ذات أفراد ومصاديق متعدّدة فأتوا بعض تلك الأفراد والمصاديق الذي تحت استطاعتكم وقدرتكم ، فيكون الحديث الشريف أجنبيّا عمّا نحن بصدده ، ويكون تامّ الانطباق على المورد ، لأنّ سؤال ذلك الصحابي كان عن لزوم تكرار الطبيعة وإيجادها في كلّ عام ، أو الاكتفاء بصرف الوجود منها ، والمتعيّن هو هذا الاحتمال وإلاّ يلزم عدم انطباقه على المورد وهو في غاية الركاكة.
ولا يمكن أن يقال بأنّ المراد من الشيء كلا الأمرين : الكلّ والكلّي ، فيشمل المورد والقاعدة جميعا ، وذلك لتنافي اللحاظين ، فلا يمكن جمعهما في استعمال واحد.
وفيه : أنّ إرادة الكلّ بهذا العنوان ـ أي الواحد المركّب من الأجزاء ـ والكلّي أيضا بهذا العنوان ـ أي الطبيعة الكلّية القابلة للانطباق على كثيرين ـ وإن كان لا يمكن جمعهما في استعمال واحد ، لما ذكرت من تنافي اللحاظين ، إلاّ أنّه لا مانع من إرادة الجامع بينهما ، إذ ليس بناء على هذا إلاّ لحاظ واحد ، وهو لحاظ الجامع بين الكلّ والكلّي ، لا لحاظ الكلّ والكلّي بخصوصيّتهما كي يكون من الجمع بين اللحاظين المتنافيين في استعمال واحد.
وأمّا ما أفاده شيخنا الأستاذ من عدم إمكان أن يراد من « الشيء » الأعمّ من الكلّ والكلّي كي يكون المعنى كما ذكرنا ، لعدم الجامع بينهما ، لأنّ لحاظ الأفراد يباين لحاظ الأجزاء.
فقد عرفت ما فيه ، لأنّ لحاظ الجامع بمكان من الإمكان ، إذ الشيء من المفاهيم العامّة ، ومصدر مبنيّ للمفعول وبمعنى المشي وجوده ، ويكون مساوقا للوجود ولمفهوم الموجود في الممكنات ، فكلّ ممكن شيء وجوده فهو موجود ، لعدم تخلّف الإرادة التكوينيّة عن المراد ، وأمّا ما ليس بممكن ، أو كان ولكن لم يشأ وجوده كالعنقاء مثلا فهو معدوم ، وليس بشيء.
وأمّا واجب الوجود فهو شيء لا كسائر الأشياء أي ما شيء وجوده ، لأنّ الوجود عين ذاته تعالى.
فبناء على هذا المركّب من الأجزاء الذي شيء وجوده شيء ، وكذلك الكلّي والطبيعة التي شيء وجودها شيء ، فوجود الجامع بين الكلّ والكلّي من أوضح الواضحات.
وأمّا ما أفاده أخيرا من عدم صحّة استعمال كلمة « من » في الأعمّ من الأفراد والأجزاء ، وإن صحّ استعمال « الشيء » في الأعمّ من الكلّ والكلّي.
ففيه : أنّ كلمة « من » استعملت في الربط والنسبة التبعيضية بين الفعل ـ أي فأتوا ـ ومفعوله ـ أي الشيء ـ كما تقول : ملأت الكوز من النهر ، فالمراد أنّ ما ملأ الكوز بعض ماء النهر ، وليس كلمة « من » في هذا المثال مستعملة في بعض ماء النهر، بل استعملت في الربط التبعيضيّة الذي بين قوله « ملأت » و « ماء النهر » وهكذا الأمر في المقام ، فكلمة « من » استعملت في الربط الكذائي بين الإتيان والشيء ، وإذا كان المراد من الشيء باعتبار كونه مصداقا للجامع بين الكلّ والكلّي هو الكلّ ، فيكون مصداق تلك النسبة هي الربط التبعيضية في الأجزاء ، وإذا كان المراد بذلك الاعتبار هو الكلّي فيكون المصداق هو الربط المذكور في المصاديق والأفراد ، وإن كان المراد هو الجامع فيشمل كلا الأمرين كما فيما نحن فيه.
والإنصاف : أنّه لو لم يكن المورد من قبيل الكلّي والأفراد لكان مقتضى فهم العرفي ـ الذي هو الميزان في استظهار المعاني من الأحاديث والروايات ، بل الآيات أيضا وعليه مدار الفقاهة ـ هو أنّ المراد من « الشيء » الكلّ ، بقرينة كلمة « من » الظاهرة في التبعيض.
ولكن حيث أنّ المورد ليس من قبيل الكلّ والأجزاء ، فلا بدّ وأن نقول بأنّ المراد منه هو الأعمّ من الكلّ والكلّي لكي يندرج فيه المورد ويخرج من الركاكة.
هذا مع أنّه لو قلنا بمقالة صاحب الكفاية في المعاني الحرفيّة ـ من أنّ الموضوع له في الحروف والأسماء واحد كلّ لمرادفه ، (4) فيكون في المقام كلمة « من » بمعنى البعض الذي هو مفهوم اسميّ أيضا ـ لا يرد شيء على ما استظهرنا من الحديث من أنّ مفاده اعتبار هذه القاعدة.
وذلك من جهة أنّ لفظ « البعض » أيضا مفهومه مشترك بين بعض الأجزاء وبعض الأفراد ، فلو كانت ألفاظ الحديث هكذا : إذا أمرتكم بمركّب ذي أجزاء أو بطبيعة ذات أفراد فأتوا بعضهما الذي تحت استطاعتكم وقدرتكم. والمفروض أنّ ذلك المركّب المأمور به ليس تمام أجزائه تحت قدرة المكلّف واستطاعته ، ولا تمامها خارج عن تحت قدرته ، بل يقدر على إتيان البعض دون البعض الآخر ، وكذلك في الطبيعة المأمور بها قادر على إتيان بعض الأفراد دون بعضها ، فهل يشكّ أحد في أنّ المراد به إتيان أجزاء المقدورة من ذلك المركّب والأفراد المقدورة من تلك الطبيعة؟
هذا تمام الكلام في الحديث الأوّل.
وأمّا الثاني : أي الحديث المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو قوله عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (5) فهو في دلالته على المطلوب أوضح ، لأنّ ظاهر هذا الكلام أنّ الميسور من كلّ ما أمر به الشارع الأقدس لا يسقط بواسطة سقوط المعسور من ذلك الشيء ، فإذا أمر بالصلاة أو بعبادة أخرى ، فكان بعض أجزاء تلك العبادة معسورا وسقط التكليف عنه بواسطة تعسّره أو تعذّره ، فلا يوجب سقوط هذا البعض سقوط البعض الميسور من تلك العبادة. وهذا عين مفاد هذه القاعدة ، وليس ها هنا مورد مثل الحديث النبويّ صلى الله عليه واله كي يأتي الإشكال المذكور فيه ، فيحتاج إلى الأجوبة التي تقدّمت ، أو إلى غيرها.
نعم يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » أعمّ من الأجزاء والأفراد ، فباعتبار كونه الميسور من المركّب يكون الأجزاء غير المتعذّرة أو غير المتعسّرة ميسورة ، وباعتبار إضافته إلى الطبيعة الكليّة يكون ميسورها هو الأفراد غير المتعذّرة ، فيشمل كلا الأمرين ، ولا وجه لتخصيصه بأحدهما.
فكما أنّ الصلاة ـ مثلا ـ لو تعذّر إتيان بعض أجزائها دون البعض الآخر يشملها هذا الحديث ، فكذلك لو قال : أكرم السادات أو العلماء ، والمكلّف متمكّن من إكرام بعض دون بعض ، فلا يسقط وجوب إكرام الأفراد الميسور إكرامهم بواسطة تعذّر إكرام الآخرين أو تعسّره.
ثمَّ إنّ هذه الرواية تشمل المستحبّات كما تشمل الواجبات ، فلو كان في صلاة الليل ـ مثلا ـ بعض أذكارها المستحبّة ميسور له دون البعض الآخر ، فبتعذّر ذلك البعض لا يسقط البعض الميسور عن موضوعيّته للاستحباب.
وحيث أنّ السقوط عبارة عن ارتفاع حكم المعسور ، إذ لا معنى لارتفاع نفس المعسور ، فنفي السقوط عبارة عن عدم ارتفاع حكم الميسور ـ أي ثبوت حكمه ـ لأنّ النفي في النفي إثبات ، فيكون معنى الرواية أنّ حكم الميسور من كلّ شيء باق ، ولا يسقط بسقوط حكم المعسور ، فإن كان حكمه الاستحباب فاستحبابه باق ، وإن كان الوجوب فوجوبه باق.
وأمّا ما قيل : من أنّ المنفي إن كان هو اللزوم فلا تشمل الرواية المستحبّات ، لأنّ الأجزاء الميسورة من المستحبّات لا لزوم لها كي يحكم الشارع بعدم ارتفاعها ، فتكون الرواية مختصّة بالواجبات ، وإن كان المنفي هو مطلق المطلوبيّة والرجحان ، فلا يثبت بها لزوم الإتيان بالميسور ، ويدلّ على أنّ الإتيان به راجح فقط.
وهذا خلاف ما يراد من الرواية ، لأنّ المقصود إثبات وجوب الباقي بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب إن كان واجبا ، وبناء على التعميم استحباب الباقي بعد تعذّر البعض إن كان المركّب مستحبّا فلا بدّ وأن نقول بأنّ المنفي هو ارتفاع الوجوب عن الباقي بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب ، فتكون الرواية مختصّة بالواجبات ولا تشمل المستحبّات.
ففيه : أنّ المنفي هو سقوط موضوعيّة الميسور لحكمه السابق قبل حدوث التعذّر ، أو موضوعيّته لحكمه على تقدير عدم تعذّر بعض الأجزاء ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك الحكم على تقدير عدم تعذّر بعض الأجزاء هو الاستحباب أو الوجوب. وقد بيّنّا في كتابنا « المنتهى » أنّ الموضوعيّة للحكم الشرعي من الأحكام الوضعيّة القابلة للجعل التشريعي ، فيكون أمر وضعها ورفعها بيد الشارع.
ومن الواضح الجليّ أنّ قوله عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ليس إخبارا عن أمر خارجي ، بل هو في مقام التشريع يحكم ببقاء موضوعيّة الميسور من كلّ مركّب كان موضوعا لحكم شرعي على ما كان ، وعدم سقوط موضوعيّته بتعذّر بعض أجزائه ، سواء كان حكمه السابق هو الوجوب ، أو كان هو الاستحباب.
وأمّا ما قيل : من أنّ حكمه السابق هو كان الوجوب النفسي الضمني ، وهو في ضمن وجوب الكلّ ، فإذا ارتفع الوجوب عن الكلّ لتعذّر بعض أجزائه فيرتفع ذلك الوجوب الضمني عن الباقي قهرا ، ولو كان هناك بعد ذلك وجوب فهو الوجوب النفسي الاستقلالي ، وهو غير ذلك الوجوب الضمني ، فموضوعيّته ارتفع قهرا ولا معنى لعدم سقوطه ، ولو فرضنا أنّه كان له مثل الحكم السابق ، فهذا حكم جديد وموضوعيّة جديدة.
ففيه : ما قلنا في بعض صور جريان الاستصحاب في هذه المسألة ، أنّه على تقدير وجوب الباقي بعد تعذّر بعض الأجزاء فليس هذا وجوبا آخر ، بل هو عين الوجوب السابق.
وأمّا كونه ضمنيّا في السابق واستقلاليّا بعد حدوث تعذّر بعض الأجزاء لا يوجب تغيّرا في وجوب الباقي. والضمنيّة والاستقلاليّة مفهومان ينتزعان عن وجوب ما عدا الباقي وعدم وجوبه ، وبهذا الوجه أجرينا الاستصحاب الشخصي ، واعتمدنا عليه ودفعنا جميع الإشكالات.
ثمَّ إنّه بعد ما ظهر لك دلالة هذه الرواية على مفاد هذه القاعدة ، وشمولها للمركّب الواجب والمستحبّ ، أقول : إنّه يعتبر في مقام إجراء هذه القاعدة كسائر القواعد إحراز موضوعها ، وتشخيص أنّ الباقي بعد تعذّر البعض ميسور ذلك المركّب الكلّ ، لأنّ موضوع الحكم بعدم السقوط هو كون الباقي المتمكّن منه ميسورا لذلك المركّب ، فلا بدّ وأن يكون من مراتب ذلك المركّب ، غاية الأمر ولو كان إحدى مراتب النازلة منه كي يصدق عليها أنّها ميسورة.
وهذا فيما إذا كان المراد من الميسور هو الميسور من نفس المركّب ، مثلا الميسور من الوضوء أو الغسل بعد تعذّر بعض أجزائهما هو مرتبة منهما دون المرتبة الكاملة.
مثلا يمكن أن يقال : إنّ الوضوء أو الغسل مع المسح على الجبيرة في بعض أعضائهما مرتبة نازلة من الوضوء أو الغسل دون المرتبة الكاملة منهما ، التي في الوضوء عبارة عن غسل تمام بشرة الوجه واليدين من المرفق إلى رؤوس الأصابع ومسح الرأس والرجلين ، وفي الغسل عبارة عن إحاطة الماء على تمام بشرة البدن ، فالميسور من مركّب هو وجود مرتبة من ذلك المركّب وإلاّ إن لم يصدق عليه عنوان ذلك المركّب وكان أمرا مباينا له ، فلا يصدق عليه أنّه ميسورة.
إذا عرفت هذا فيرد ها هنا إشكال : وهو أنّ تشخيص هذا المعنى في الموضوعات العرفيّة ممكن غالبا ، لأنّ مفاهيم المركّبات العرفيّة غالبا معلوم عند العرف ، وأنّ الجزء المتعذّر هل له دخل في التسمية بحيث أنّه مع عدمه ينعدم المركّب ولا يصدق على الباقي عنوان ذلك المركّب ، أم ليس كذلك وليس له دخل في التسمية ، بل الجزء الفاقد يوجب سلب الكمال لا سلب أصل الحقيقة ، فإذا كان من القسم الأوّل فليس من ميسور المركّب ولا يشمله القاعدة ، بخلاف القسم الثاني فيصدق عليه أنّه ميسورة.
وأمّا إذا كان المركّب الكلّ من الموضوعات الشرعيّة ، كالصلاة والصوم والحجّ ، بل وكالوضوء والغسل والتيمم ، فإذا تعذّر إيجاد بعض أجزاء هذه المذكورات ، أو بعض شرائطها ، أو تعذّر ترك بعض موانعها ، فإطلاق الميسور على الباقي المتمكّن منها لا يخلو من إشكال.
وذلك من جهة عدم طريق للعرف إلى معرفة أنّ هذا الجزء أو الشرط المتعذّر وجودهما ، أو أنّ هذا المانع المتعذّر تركه هل له دخل في تحقّق ماهيّة هذا المركّب ، بحيث لو لم يكن في مورد تعذّر الجزء والشرط أو كان في مورد تعذّر ترك المانع لا يوجد ماهيّة هذا المركّب ولو مرتبة ضعيفة منها ، ولا يصدق عنوان هذا المركّب الكلّ على الباقي المتمكّن منه.
وذلك من جهة أنّ دخل الجزء أو الشرط الكذائي في تأثير المركّب في الأثر المطلوب منه بحيث لو لم يكن لا أثر له أصلا لا يعرف إلاّ من بيان نفس الشارع ، فلا طريق إلى معرفة أنّه بعد بعض الأجزاء أو بعض الشرائط وجودا ، أو تعذّر بعض الموانع عدما إلاّ من طرف نفس الشارع الذي هو جاعله للوصول إلى الغرض المطلوب منه ، فلو لم يكن بيان من قبل الشارع لما كان يعرف العرف أنّ الحاجّ الذي يتحمّل المشاقّ ويأتي بجميع أعمال الحجّ من الإحرام والسعي والطواف وصلاته وأعمال منى جميعا ، ولكن لم يقف في وادي العرفات ولا في المشعر ، فهذا لم يحصل له الحجّ أصلا.
وكذلك من أتى بجميع أجزاء الصلاة وشرائطها وترك موانعها ، إلاّ أنّه ترك شرطا واحدا وهو أنّه أتى بها مثلا خمس دقائق قبل الوقت لا صلاة له ولو كانت مرتبة ضعيفة منها.
وحاصل الكلام : أنّ معرفة الأجزاء الركنيّة وكذلك شرائطها لا طريق إليها إلاّ من طرف بيان الشارع ، فبناء على هذا لا يمكن إحراز موضوع قاعدة الميسور في الموضوعات والمهيّات المخترعة من قبل الشارع ، فلا يمكن إجرائها فيها.
نعم أجزاء تلك العبادات ربما تكون من الموضوعات العرفيّة ، كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ، وغسل البشرة في الوضوء أو الغسل ، والوقوف والسعي في الحجّ ، وأمثال ذلك ، فيمكن إجراء القاعدة في نفس هذا الجزء.
مثلا القيام أو الركوع لكلّ واحد منهما مراتب عند العرف ، فإذا لم يتمكّن من المرتبة العليا منهما فلا يسقطان بالمرّة ، بل على المكلّف أن يأتي بالمرتبة النازلة منهما التي يتمكّن منها. وهكذا الأمر في سائر الأجزاء والشرائط ، فلا نطيل الكلام أزيد من هذا.
ولكن كلّ ما ذكرنا ـ بالنسبة إلى عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في المهيّات المخترعة عن قبل الشارع ـ كان فيما إذا كان المراد من كلمة « الميسور » في الرواية المذكورة الميسور من المركّب المأمور به. وأمّا إذا كان المراد منه الميسور من أجزائه لا نفس المركّب ، فلا يأتي هذا الإشكال ، لأنّ الميسور من الأجزاء أمر عرفي يفهمه كلّ أحد ، فالمركّب عن عدّة أمور لو تعذّر بعض أجزائه ، فالباقي من الأجزاء الذي تحت قدرته وهو متمكّن من إتيانه يصدق عليه أنّه الميسور من أجزاء ذلك المركّب ، سواء صدق عليه عنوان ذلك المركّب أو لم يصدق.
نعم يبقى الكلام في أنّ المراد من الميسور في مقام الإثبات هل هو ميسور المركّب أو الميسور من الأجزاء؟
والإنصاف أنّ لفظ « الميسور » وإن كان مطلقا من هذه الجهة ، لأنّ كلّ واحد منهما يصدق عليه الميسور ، ولكن إرادة الميسور من الأجزاء منه بعيد جدّا ، لأنّ الميسور من الأجزاء يصدق على جزء واحد من المركّب الذي يكون أجزائه عشرين مثلا وتعذّر تسعة عشر منها وبقي واحد منها تحت التمكّن ، فيقال وجوب هذا الواحد لا يسقط بتعذّر باقي الأجزاء ، فهذا في غاية البعد من ظاهر هذا الكلام.
وأمّا الثالث : أي قوله عليه السلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كله » فدلالته على هذه القاعدة في غاية الوضوح ، لأنّ ظاهر هذا الكلام أنّ الشيء الذي لا يمكن الإتيان بجميعه لا يجوز ترك جميعه ، بل يجب الإتيان بالمقدار الذي يمكنه أن يدركه ويكون تحت قدرته. وأمّا احتمال أن يكون المراد من الموصول خصوص الكلّي ـ باعتبار أفراده المتعدّدة كي يكون المعنى :
أنّ من لا يمكنه إدراك جميع أفراد الطبيعة التي أمر بها لا يجوز له ترك جميع تلك الأفراد ، بل يجب عليه أن يأتي بالمقدار المقدور منها ـ لا وجه له أصلا ، لأنّ ظهور جملة « ما لا يدرك كلّه » في الكلّ أقوى من ظهورها في خصوص الكلّي. وهذا واضح جدّا.
نعم لا بأس بأن يقال إطلاق لفظ الكلّ في الجملتين يشمل كلّ أجزاء المركّب المأمور به ، وكلّ أفراد الكلّي الذي أمر به ، وأمّا تخصيصه بكلّ أفراد الكلّي يكون بلا مخصّص وليس له وجه ظاهر.
فظهر ممّا ذكرنا أنّه إن كان إشكال في دلالة قوله عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » على هذه القاعدة لما ذكرنا ، لكن لا إشكال في دلالة الروايتين الأولى والثالثة عليها ، وفيهما غنى وكفاية.
فنقول : موارد تطبيقها في المسائل الفقهيّة كثيرة واستقصائها لا مجال له في هذا المختصر ، ولكن نذكر جملة منها.
ولا يخفى أنّ أغلب موارد تطبيق هذا القاعدة ممّا نذكرها ها هنا ـ أو ممّا لم نذكرها ـ وردت أدلّة خاصّة على لزوم الإتيان بالباقي الميسور في الواجبات ، وعلى استحبابه في المستحبّات.
فمنها : ما إذا تعذّر تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول ـ بناء على لزوم التثنية في البول فيما إذا غسل بالماء القليل ـ وهو متمكّن من غسله مرّة واحدة ، فهل يجب لأثر تخفيف النجاسة أم لا؟ الظاهر جريان القاعدة.
ومنها : إذا كان الإناء ولغ فيه الكلب والخنزير ولا يقدر على التعفير ، فهل يجب غسله بالماء القراح وحده بهذه القاعدة أم لا؟
الظاهر جريان القاعدة ولزوم الإتيان بالمقدار الميسور.
ولكن يمكن أن يقال في هذين الموردين أنّ الشارع جعل سبب التطهير هو التعدّد في البول والغسل مع التعفير في الولوغ ، فإذا لم يوجد السبب لا يوجد المسبّب ، ويبقى الإناء على نجاسته في مسألة الولوغ ، والثوب المتنجّس على نجاسته في مسألة المتنجّس بالبول.
وحيث أنّ وجوب الغسل في المسألتين مقدّميّ ، وتحصيل طهارة الثوب وطهارة الإناء ليستعمل فيما هو مشروط بالطهارة ، فإذا علم بعدم حصول الطهارة بدون التعدّد في البول وبدون التعفير في الولوغ ، فيكون الغسل الواحد في الأوّل وبدون التعفير في الثاني لغوا وبلا فائدة ، فلا معنى لأن يكونا واجبين بالوجوب المقدّمي.
اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّهما يوجبان التخفيف في النجاسة ويرفعان مرتبة منها ، ولا يبعد ذلك.
ومنها : إذا تعذّر مقدار الذي عيّن الشارع من الدلاء في نزح البئر لوقوع النجاسات فيها ، ولكن يمكن له نزح بعض ذلك المقدار ، فهل تجري قاعدة الميسور لوجوب نزح مقدار الممكن إن قلنا بوجوب النزح ، أو لاستحبابه بناء على القول باستحبابه وبناء على القول بجريانها في المستحبّات ، كما هو المختار عندنا.
الظاهر جريانها إلاّ على الإشكال المتقدّم من كون وجوب النزح وجوبا مقدّميّا ، ومع عدم حصول ذي المقدمة يكون لغوا.
والجواب عن هذا الإشكال هو الجواب المتقدّم ، فلا نعيد.
والإنصاف : أنّ قاعدة الميسور على تقدير شمولها للمستحبّات تجري في الواجبات والمستحبّات النفسيّة ، وأمّا جريانها في الواجبات المقدّميّة مع العلم بأنّ هذا المقدار الميسور من المقدّمة لا تأثير له في إيجاد ذي المقدّمة مشكل جدّا ، بل في بعض الموارد يكون من المضحكات.
ومنها : أنّه لو تعذّر السدر والكافور في غسل الميّت ، فهل يجب الغسل بالماء القراح باعتبار أنّه الميسور من الغسل مع الخليط بأحدها ، أم لا؟
والظاهر جريان القاعدة ها هنا بدون إشكال في البين ، لأنّ هذا الغسل واجب نفسيّ ، فلا مانع من أن يكون الواجب والمطلوب أغسال ثلاثة بالماء القراح ، أحدها هو المشروع الأوّلي بجعله كذلك ، واثنان منها بقاعدة الميسور.
ومنها : في باب الكفّارات لو تعذّر عتق الرقبة المؤمنة ، ولكنّه متمكّن من عتق غير المؤمنة ، فهل يجب بقاعدة الميسور ، أم لا؟
الظاهر جريانها ووجوب عتق الرقبة غير المؤمنة ، بناء على جريانها في الواجب المقيّد بقيد فيما إذا تعذّر قيده.
وربما يقال بأنّ المقيّد بقيد إذا تعلّق به الوجوب ـ كما في المثال المذكور ـ ففاقد ذلك القيد يباين الواجد له ، فليس بميسورة كي تشمله قاعدة الميسور ، كما أنّ ظاهر قوله صلى الله عليه واله : « إذا أمرتكم بشيء فأتو منه ما استطعتم » (6) هو أن يكون المستطاع بعضا خارجيّا لذلك الشيء الذي أمر به الشارع.
وكذلك الأمر في قوله عليه السلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (7) ويكون مفاده لزوم الإتيان بالبعض الخارجي لذلك الكلّ المأمور به ، وفاقد القيد ليس بعضا خارجيّا لواجد القيد ، بل هو بعض تحليلي له ، وذلك من جهة أنّ القيد مع ذات المقيّد لهما وجود واحد ، لا أنّ لكلّ واحد منهما وجود حتّى يكون من قبيل المركّب الخارجي والكلّ وجزئه.
فلا يشمله أدلّة قاعدة الميسور ، إذ ليس مجموع القيد والمقيّد كلاّ خارجيّا بالنسبة إلى ذات المقيّد وحدها ، ولا أنّ ذات المقيّد جزء خارجي للمجموع ، ولا أنّه ميسورة.
ولذلك قالوا في بيع الجارية المغنّية بالبطلان وعدم كونه من باب تبعّض الصفقة ، كلّ ذلك من جهة أنّ ذات المقيّد مع قيده موجودان بوجود واحد في الخارج ، لا أنّ لكلّ واحد منهما وجود يخصّه ، فالتركيب بينهما اتّحادي لا انضمامي.
وفيه : أنّ القيود ليست على نسق واحد ، فتارة : يكون القيد من قبيل الفصل ، وذات المقيّد من قبيل الجنس. كما إذا أمره أن يأتي بحيوان ناطق ، وهو لا يقدر على الإتيان بهذا القيد ، ويقدر على إتيان الحيوان غير الناطق. ولا شكّ في أنّ في هذا القسم من القيد والمقيّد لا تجري قاعدة الميسور ، لعين ما ذكره هذا القائل.
ولا شكّ في أنّ التركيب بين القيد والمقيّد في هذا القسم اتّحادي.
وأخرى : يكون من قبيل المعرّف لموضوع الحكم وإن كان عرضيّا ، كالجارية الروميّة ، فالقيد في هذا القسم وإن لم يكن منوّعا لذات المقيّد عقلا ، بل أضافه عرضيّة لها ، ولكن ليس أيضا عند العرف عرضا منضما إليها ، وإن كان بحسب الدقّة العقليّة كذلك.
ففي هذا القسم أيضا لا تجري قاعدة الميسور ، فإذا قال المولى : أعتق جارية روميّة ، وهو لا يقدر على ذلك ولكن يقدر على عتق جارية حبشيّة ، فالعرف يرى هذا الأخير مباينا للمأمور به ، فلا تجري هذه القاعدة ها هنا ، وذلك من جهة أنّ الجارية الحبشيّة ليست ميسور الجارية الروميّة عنده. والمناط في تشخيص المفاهيم هو فهم العرف.
وثالثة : عند العرف وبحسب متفاهمهم أيضا يكون وجود القيد خصوصيّة زائدة على وجود ذات المقيّد ، كما في الرقبة المؤمنة. ففي مثل هذا القسم الظاهر جريان هذه القاعدة ، فإذا أمر المولى بالصلاة الجهريّة وهو لا يقدر على إتيانها جهرا لجهة من الجهات ، فهل ترضى من نفسك بأن تقول بعدم كون الصلاة الغير الجهريّة ميسور الصلاة الجهريّة ، ولا يجب عليه شيء حتّى مع قطع النظر عن الأدلّة الخارجيّة وأنّها لا تترك بحال.
والسر في ذلك : هو أنّ العرف يرى الصلاة شيئا ، وكونا جهرا شيئا خارجيّا زائدا على ذات الصلاة ومن الصفات العارضة عليها ، ويرى التركيب بينهما انضماميّا ، وإن كان العرض يتّحد مع الذات بعد أخذه لا بشرط وجعله بصورة المشتقّ لا بصورة مبدأ الاشتقاق.
وأمّا عدم كون بيع الجارية المغنّية من قبيل تبعّض الصفقة ، فليس من جهة عدم كون وصف الغناء أمرا زائدا على الذات ، بل من جهة عدم الانحلال عند العرف إلى كون الذات مبيعا والوصف مبيعا آخر ، بل العرف يرى الذات المتّصفة بهذا الوصف مبيعا واحدا ، كما أنّ الجارية مع أنّه لها أجزاء يقينا ، من الرأس واليد والرجل وغيرها من سائر الأعضاء ، ومع ذلك لا ينحلّ إلى بيوع متعدّدة بعدد الأعضاء ، وذلك كلّه لأنّ العرف والعقلاء يرون المجموع مبيعا واحدا غير قابل للانحلال.
نعم باعتبار كسور المشاع يرونها بيوعا متعدّدة ، فلو ظهر أنّ نصف هذه الجارية ملك لغير البائع أو حرّ ـ إن قلنا بإمكان ذلك وعدم السراية ـ فينحلّ إلى بيعين ، ويكون من باب تبعّض الصفقة.
فظهر أنّه لو تعلّق الوجوب بذات متّصفة بصفة عرضيّة ، وكانت تلك الصفة من الأعراض الخارجيّة المحمولات بالضمائم ، وتعذّر تلك الصفة ، ولم تكن تلك الصفة عنوانا معرفة لذلك الشيء ، ولم يكن منوّعا له عند العرف ، فبتعذّرها لا يسقط الوجوب أو الاستحباب عن ذلك الذات ، وتجري فيها قاعدة الميسور.
ومنها : أيضا في باب الكفّارات في عدد الأيّام في الصوم الذي جعل كفارة ، فلو لم يقدر على تمام العدد ولكن قدر على بعضها ، فهل تجري قاعدة الميسور ويحكم بوجوب المقدار المقدور منه ، أم لا فيسقط وجوب الباقي؟
الظاهر أنّها تجري ويحكم بوجوب الباقي.
وهذا فيما إذا لم يكن للصوم عدل لا تخييرا ولا ترتيبا واضح ، لأدلّة القاعدة.
وأمّا إن كان له عدل بأحد الوجهين ، فإن كان تخييرا كما فيما إذا أفطر في نهار شهر رمضان متعمّدا بلا عذر بالحلال ، فبعد تعذّر إحدى الخصال الثلاث بتعيّن الآخران ، ولا تصل النوبة إلى إجراء قاعدة الميسور بالنسبة إلى الباقي. وهذا أيضا واضح.
وأمّا إذا كان العدل ترتيبا ، كما في كفّارة الظهار ، فإنّ إطعام ستّين مسكين جعل عدلا لصيام شهرين متتابعين بعد عدم استطاعة الصيام والعجز عنه ، لقوله تعالى : {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] .
ففي هذا القسم يمكن أن يقال : إنّ وصول النوبة إلى العدل بعد العجز عن تمام مراتب السابقة لا العجز عن خصوص المرتبة التامّة.
ولكن الظاهر أنّ الترتيب بين المرتبة التامّة وما رتّب عليها ، لا تمام مراتب السابقة.
ومنها : ما ورد في بعض المستحبّات من قراءة السور المتعدّدة ، كما ورد في عمل أمّ داود ، أو السورة الواحدة مرّات كثيرة محدودة بحدّ كعشرة أو مائة أو ألف سورة التوحيد ـ مثلا ـ كما ورد في أعمال ليلة القدر ، أو بعض ليالي الآخر من شهر رمضان المبارك ، أو ليلة النصف من شعبان أو الأذكار الواردة في صلاة الليل من الاستغفار وغيره ، أو مائة مرّة « السلام على الحسين وأصحابه وأولاده » في زيارة عاشوراء ، فلو لم يقدر على إتيان الجميع في الجميع ، ولكن قدر على إتيان البعض في جميع ما ذكرنا وغير ما ذكرنا من المستحبّات الكثيرة المشتملة على الأذكار المتعدّدة ، فهل تجري قاعدة الميسور، أم لا بناء على ما اخترناه من تعميم القاعدة ، وشمولها للواجبات والمستحبّات؟
والظاهر جريانها ، فتعذّر البعض لا يوجب سقوط الاستحباب عن الجميع. فبناء على هذا لو تعذّر عليه الاستغفار سبعين مرّة في صلاة الليل مثلا ويقدر على ثلاثين مثلا فليأت به استحبابا.
والفروع لهذه القاعدة كثيرة لا يمكن استقصاؤها في هذا المختصر.
والحمد لله أوّلا وآخرا ، وظاهرا وباطنا.
__________________
(*) « عوائد الأيّام » ص 88 ، « عناوين الأصول » عنوان 19 ، « مناط الأحكام » ص 25 ، « اصطلاحات الأصول » ص 201 ، « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنّة » ص 118 ، « القواعد » ص 297 ، « قواعد فقهي » ص 291 ، « القواعد الفقهيّة » ( مكارم الشيرازي ) ج 1 ، ص 539.
(1) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 975 ، ح 1337 ، كتاب الحج ، ح 412 ، (73) باب فرض الحج مرة في العمر ، « سنن النسائي » ج 5 ، ص 110 ، باب وجوب الحج.
(2) « عوالي اللئالي » ج 4 ، ص 58 ، ح 205.
(3) « عوالي اللئالي » ج 4 ، ص 58 ، ح 207.
(4) « كفاية الأصول » ص 11 ـ 12.
(5) « عوالي اللئالي » ج 4 ، ص 58 ، ح 205.
(6) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 975 ، ح 1337 ، كتاب الحجّ ، ح 412 (73) باب فرض الحج مرة في العمر ، « سنن النسائي » ج 5 ، ص 110 ، باب وجوب الحجّ.
(7) « عوالي اللئالي » ج 4 ، ص 58 ، ح 207.



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
جمعية العميد تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع العلمية والبحثية
|
|
|