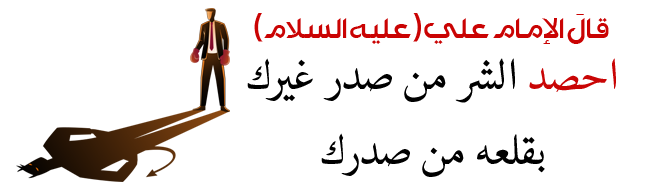
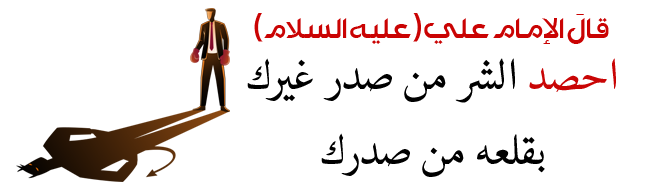

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-08-2015
التاريخ: 20-11-2014
التاريخ: 20-11-2014
التاريخ: 20-11-2014
|
(إن) الدليل على أنّه تعالى قادر على القبيح، هو ما ثبت أنّه قادر على عقوبة العاصي والكافر، ومعلوم أنّ اقتداره على ذلك لم يتجدّد عند وقوع الكفر أو المعصية من المكلّف، بل كان قادرا على ذلك قبله، وعقوبته قبل ذلك قبيح.
وأيضا فانّه تعالى قادر على تعذيب الأطفال،
وتعذيبهم ظلم قبيح، وبعد فانّه قادر على أن يخبر عن «العالم ليس قديما» بأن يقول:
«العالم ليس قديما» فيمكنه أن يقول: «العالم قديم» باسقاط كلمة «ليس» لأنّ لفظة
«قديم» لا يحتاج إلى لفظة «ليس»، ولا لفظة «العالم» محتاج إليه، والقول بأنّ
العالم قديم قبيح، لأنّه كذب.
ويمكن أن يعترض على هذا الوجه بأن يقال:
قوله: «العالم قديم»، إنّما يقبح، إذ أخبر به عن قدم العالم. فأمّا إذا لم يقصد به
الإخبار عن قدم العالم، لم يكن خبرا عنه، فلم يكن كذبا ولا قبيحا. فمن أين إنّه
يقدر على أن يقصد به الإخبار عن قدم العالم؟ وهل النزاع إلّا فيه؟ لأنّ القصد إلى
هذا الإخبار قبيح.
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال:
إذا لم يقصد تبارك وتعالى بهذا القول إلى الإخبار عن قدم العالم، فأمّا أن لا يقصد
به شيئا من المعاني، أو يقصد به إلى معنى آخر. فإن كان الأوّل، يلزم عليه قبح هذا
القول بأن يكون عبثا قبيحا، وقد حصل المقصود، وهو اقتداره على القبيح؛ وإن قصد به
معنى آخر ولم يفرق إليه شيئا آخر يدلّ عليه كان ذلك إلغازا وتعمية، فيكون قبيحا
أيضا. فعلى الوجوه كلّها تبيّن اقتداره على القبيح.
ولو صوّرت هذه الدلالة في الإخبار عن أنّ
زيدا ليس في الدار، بأن يقول:
زيد ليس في الدار، إذا لم يكن فيها، فإنّ
هذا ممّا يقدر تبارك وتعالى عليه أيضا لأنّه صدق، وإذا حصل فيه غرض حسن فيقدّر على
أنّ يسقط «ليس» فيقول:
«زيد
في الدار» وإذا قال كذلك كان كذبا قبيحا، لكان أولى، لأنه مهما أورد على هذه
الصورة ما اورد على الصورة الأولى من أنّ قوله: «زيد في الدار» إنّما يكون كذبا
بأن يقصد إلى الإخبار عن كونه فيها، فمن أين إنّه يقدر على هذا القصد يمكننا أن
نجيب عنه بأن نقول: لا خلاف في أنّه يقدر على هذا القصد، ألا ترى أن زيدا لو كان
في الدار، لصحّ منه تبارك وتعالى الإخبار عن كونه في الدار فبخروج زيد عن الدار
يزول اقتداره تعالى على هذا القصد.
ولئن
كان كذلك لوجب ان يخرجنا أيضا عن كوننا قادرين عليه، والمعلوم خلافه.
ولو قلت: إنّه تعالى يقدر على أن يقول: «زيد
في الدار» قاصدا عن الإخبار عن ذلك إذا كان زيد في الدار، وحصل في هذا الإخبار غرض
المثل، لأنّه يكون حسنا، فيجب أن يكون قادرا عليه، وإن لم يكن زيد في الدار، لأنّ
خروج زيد عن الدار لا يخرجه عمّا كان عليه، إذ لو أخرجه عن الاقتدار على ذلك،
لأخرجنا أيضا لكان أقرب وأوضح.
واعلم أنّ المخالف في هذه المسألة رجلان:
أحدهما يقول: القبيح إنّما يقبح للنهي واللّه تعالى ليس بمنهي، فلا يقبح منه شيء،
ويستحيل اتصاف أفعاله تعالى بالقبيح، فهو غير قادر على هذا القبيح من هذا الوجه،
وهو الأشعريّ ومن وافقه في الامتناع من التحسين والتقبيح النقلي. و
الآخر هو النظّام، يقول: لو قدر على القبيح، للزم أن
يكون إمّا جاهلا أو محتاجا، لأنّه إذا كان قادرا على القبيح، صحّ منه وقوعه، والقبيح
صحّ منه وقوعه، والقبيح يدلّ على جهل فاعله أو احتياجه، فيكون ذلك مصيرا إلى أنّه
يصحّ وجود ما يدلّ على كونه جاهلا أو محتاجا وهذا يقتضي كونه إما جاهلا أو محتاجا،
لأنّ الدلالة كالعلم في تعلّقه بالشيء على ما هو به ألا ترى انّه لا يصحّ إقامة
دليل على كون زيد في الدار إلّا وهو في الدار، كما لا يصحّ أن يعلم أنّه في الدّار
إلّا وهو في الدار.
ونبيّن ذلك بأن نقول: إذا قدر على القبيح وصحّ
وقوعه منه، أ رأيتم لو وقع منه، ذلك، لكان يكون دليلا على الجهل أو الحاجة أو لا
يكون دليلا ولا واسطة، لتردّد هذا التقسيم بين النفي والإثبات، فإن قلتم يدلّ، كان
ذلك قولا بصحّة دليل قيام على جهله أو حاجته، وذلك يقتضي كونه في الحال على أحد
الوصفين، كما ذكرته، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا، وإن قلتم لا يدلّ، بطل دلالتكم على
انفتاح أنّه لا يفعل القبيح، لأنّ الدليل الذي يجب طرده، فإذا تصوّر ثبوت مثل
الدليل ولا مدلول، انتقض كونه دلالة، فكيف يمكنكم أن تستدلّوا على أنّه تعالى لا
يفعل القبيح.
أمّا الرّد على الأوّل فهو أنّ نقول: لو كان
القبيح إنّما يقبح للنهي، لوجب فيمن لا يعرف النهي ولا الناهي أن لا يعرف شيئا من
القبائح. وهذا يوجب في البراهمة المنكرين للنبوّات أن لا يعلموا قبح الظلم والكذب
العاري من نفع أو دفع ضرر والعبث والمفسدة، كما لا يعرفون قبح القبائح الشرعيّة، والمعلوم
خلافه.
فإن قيل: هم لا يعلمون قبح هذه القبائح، وإنّما
اعتقدوا قبحها، لمخالطتهم لأهل الشرائع.
قلنا: فكيف لم يعتقدوا قبح الزنا والربا وشرب
الخمر لهذه المخالطة. وبعد فإنّ المقرّ بالنبوّة وبالشّرعيّات لو دخلت عليه شبهة
في النبوّة فإنّه يضطرب عنده قبح القبائح الشّرعيّة التي عددناها، ولا يشكّ في قبح
الظّلم وإخوانه ممّا عددناه ثمّ ولو كان القبيح يقبح للنهي لوجب أن يكون الحسن
يحسن للأمر، فيلزم عليه أن لا يوصف أفعاله تعالى بالحسن أيضا، لأنّه كما لم ينه عن
شيء، لم يؤمر بشيء.
فإن قالوا: الحسن يحسن للأمر ولانتفاء النهي
عنه، فالقديم تعالى وإن لم يؤمر بشيء لم ينه من شيء، فيحسن فعله لانتفاء النهي.
قلنا: فقولوا: إنّ القبيح أيضا إنّما يقبح
للنّهي ولانتفاء الأمر، واللّه تعالى وإن لم ينه عن شيء لم يؤمر بشيء، فيجب أن
يقع فعله لانتفاء الأمر.
أمّا الرد على النظّام، فقد اختلف مسلك
العلماء فيه، فذكر بعضهم «أنّه لو وقع منه تعالى القبيح، لخرج من أن يكون دليلا
على الجهل أو الحاجة. وذلك لأنّه إنّما يدلّ من حيث علمنا أنّه لا يقع من العالم
الغنيّ، فإذا فرضنا وقوعه ممّن يعلم قبحه واستغناءه عنه خرج عن كونه دليلا».
وقد اعترض هذا بأن قيل: ففي هذا صحّة وجود
القبيح غير دالّ على الجهل أو الحاجة، لأنّه صحّ وقوعه منه تعالى، لاقتداره عليه.
وإذا صحّ وجود الدلالة مع فقد مدلولها بطل كونه دلالة.
وقال أبو عليّ وأبو هاشم وقوع القبيح منه
تعالى صحيح، إلّا أنه لو وقع منه تعالى القبيح لم نقل بأنّه كان يدلّ على جهله أو
حاجته، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا، ولا نقول بأنّه كان لا يدلّ فاتفقا على الامتناع
من الجواب بالنفي والإثبات عن هذا التقدير، واختلفا في التعليل.
فقال أبو عليّ: «إنّما لا يصحّ الجواب
بالنفي والإثبات، لأنّ كلّ جواب نذكره ينقض أصلا من الأصول المقرّرة بالدليل ويبطله،
وما هذا حاله لا يجوز القول به وبيانه: أنّه لو قلنا: «يدلّ على الجهل أو الحاجة»،
كنّا قد أبطلنا ما قد علمناه من كونه تعالى عالما بقبح القبائح وبأنّه مستغني
عنها، ولو قلنا بأنّه لا يدلّ، كنّا قد أبطلنا ما قد علمناه من كون القبيح دالّا
على جهل فاعله أو صاحبه. وإن هربنا من القولين إلى القول بأنّه لا يقدر على
القبيح، كنّا قد أبطلنا ما علمناه بالدليل أيضا من كونه قادرا على القبيح، فلا
نقدّر هذا التقدير. وإذا قدّره مقدّر فلا نجيب عنه. وذلك لأنّ التقدير إنّما يورد
لينكشف به الأصول المحقّقة، فلا يجاب عن تقدير أو يؤدّي إلى إبطال الأصول المقررة
المحقّقة بالدليل».
وقال أبو هاشم: «إنّما امتنع من الجواب
بالنفي والإثبات، لأنّ كلّ جواب أقوله يكون تعليقا للصحيح بالمحال، وتعليق الصحيح
بالمحال غير جائز.
وبيانه: أنّه لو قلنا «يدلّ»، لكنّا قد
علّقنا الصحيح الذي هو وقوع القبيح منه تعالى لاقتداره عليه بالمحال الذي هو كونه
جاهلا محتاجا ولو قلنا كان لا يدل لكنّا قد علّقنا الصحيح الذي هو وقوع القبيح
مسند بالمحال الذي هو خروج القبيح عن كونه دلالة.
قال: وإنّما قلنا: «تعليق الصحيح بالمحال
غير جائز» من حيث انّ تعليق الشيء بغيره يقتضي أن يوجد المعلّق إذا أوجده المعلّق
به، كقول القائل: «لو دخل زيد داري لأكرمته وأعطيته». فإنّ هذا يقتضي أنّه مهما
حصل دخول زيد حصل منه جهة القائل الإكرام والعطيّة وهذا في تعليق الصحيح بالمحال
غير جائز، وذلك لأنّ المحال يستحيل وقوعه، وجد الصحيح أو لم يوجد، ألا ترى أنّ
القائل لو قال: «لو دخل زيد الدار لاجتمع الضدّان في المحلّ»، كان ذلك قولا محالا،
من حيث أن اجتماع الضدّين محال، دخل زيد الدار أو لم يدخل.
وقد اعترض أبو الحسين قولهم هذا بأن قال:
كون الظلم دلالة أو لا يدلّ قسمان متقابلان دائران بين النفي والإثبات وبضرورة
العقل معلوم استحالة خلوّ الشيء عن النفي والإثبات المتقابلين، فهب أنّكم لا
تقولون في ذلك قولا فيخلوا الظلم في نفسه من أن يكون دليلا أو لا يكون دليلا، ولئن
جاز ذلك، لجاز أن يخلو زيد من أن يكون في الدار، وأن لا يكون في الدار، وعن أن
يكون قادرا وأن لا يكون قادرا.
ولمّا اعترض هذا القول، قال: فالواجب أنّ
يقال للنظّام: إنّ وقوع القبيح منه تعالى محال، وإن قدر عليه، فإذا فرضنا وقوعه
منه، كنّا قد فرضنا محالا، فلا يمتنع أن يلزم عليه محال، وهو كونه جاهلا أو
محتاجا.
فإذا قيل له: كيف تحكم باستحالة وقوع القبيح
منه، مع كونه تعالى قادرا عليه؟
يقول في الجواب: إنّ القادر لا يصحّ منه
وقوع ما قدر عليه إلّا إذا كان له إليه داع، ومن دون الداعي لا يصحّ أن يفعل.
وبيانه أنّ ما قدر عليه القادر وقوعه ولا
وقوعه بالنسبة إلى القادر على حدّ سواء، وكلاهما جائزان من دون ترجّح. وكذلك وقوع
كلّ واحد ممّا قدر عليه من مقدوراته المختلفة المتضادّة جائز على حدّ سواء. وبقضيّة
العقل معلوم أنّ بعض الجائزات لا يقع دون البعض ولا يترجّح البعض على البعض إلّا
بمرجح والمرجّح في حقّ القادر إنّما هو الداعي، فلا يصحّ أن يقع منه إلّا ما له
إليه داع.
وإذا كان كذلك وقد علمنا أنّه لا داعي له
تبارك وتعالى إلى القبيح استحال منه وقوعه. ثمّ وإذا انضاف إلى عدم الداعي ثبوت
الصارف، وهو علمه بقبحه وباستغنائه عنه، كان استحالته آكد، وليس من قضيّة القادر
أن يصحّ منه وقوع ما قدر عليه على جميع الأحوال، بل إذا صحّ قوعه منه على وجه ما
كفى في كونه قادرا عليه، ألا ترى أنّ الممنوع قادر على الفعل وإن استحال وقوع
الفعل منه مع المانع، لما صحّ أن يقع بتقدير زوال المنع. وكذلك فإنّه تعالى قادر
فيما لم يزل، وإن استحال وجود الفعل الأزليّ، لما صحّ أن يفعل فيما لا يزال، فكذلك
لا يمتنع أن يكون قادرا على القبيح، على معنى أنّه لو تصوّر أن يكون له إليه داع،
لصحّ منه وقوعه.
فإن قيل: كما أنّ القبيح يدلّ على جهل فاعله
أو حاجته ، كذلك الخبر الصدق عن كونه جاهلا أو محتاجا، يدل على ذلك فلو جاز أن
يقدر تعالى على القبيح لجاز أن يقدر على الخبر الصدق عن كونه جاهلا أو محتاجا واذا
لم يجز أن يوصف بالقدرة على الخبر الصدق عن كونه جاهلا أو محتاجا، وجب أن لا يجوز
وصفه بالقدرة على القبيح، والّا فما الفرق؟
قلنا: هذه مغالطة، وذلك لأنّ الخبر الصدق عن
كونه جاهلا أو محتاجا، ليس دليلا على كونه على أحد الوصفين، بل كونه كذلك داخل في
معنى كون الخبر عن ذلك صدقا، إذ الخبر الصدق يفهم منه الإخبار عن الشيء، وأنّ
الشيء على ما تناوله.
فكون المخبر على ما تناوله داخل في معنى
كونه صدقا، فكيف يكون دليلا عليه، مع ما قد علمنا من أنّ شأن الدليل أن يكون
مغايرا أو في حكم المغاير للمدلول فلو وصفناه تعالى بالاقتدار على الخبر الصدق عن
كونه جاهلا أو محتاجا، لكنّا قد وصفناه بأنّه يقدر على أن يجعل نفسه جاهلا ومحتاجا،
أو أنّ غيره يقدر على أن يجعله كذلك، وذلك محال.
وإنما قلنا إنّ وصفه بالقدرة على الخبر
الصدق عن كونه جاهلا أو محتاجا، من حيث ان كون الخبر عن ذلك صدقا يقتضي كونه مخبره
مطابقا لما تناوله.
وذلك لا يكون إلّا باقتداره تعالى أو
باقتدار غيره على أن يجعله كذلك. وليس كذلك القبيح، لأنّه دليل على كون فاعله
جاهلا أو محتاجا، ولا يدخل كون فاعله جاهلا أو محتاجا في معنى القبيح. ألا ترى أنّ
معناه الفعل الذي له مدخل في استحقاق الذمّ عليه، واقتداره تعالى عليه لا يدخل في
ضمنه ومعناه اقتداره أو اقتدار غيره على تصيّره جاهلا أو محتاجا فافترقا من هذا
الوجه.
وإذا فرغنا من القول في أنّه تعالى قادر على
القبيح، فلنشرع في أنّه لا يفعله ولا يخلّ بالواجب عليه في حكمته.



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|