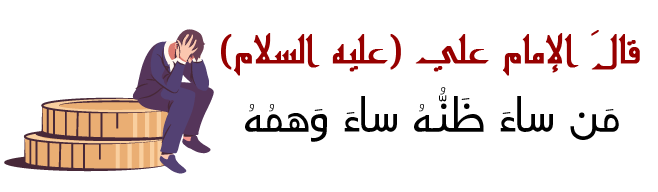
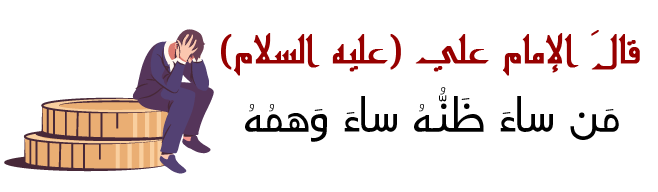

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-2-2019
التاريخ: 21-2-2019
التاريخ: 21-2-2019
التاريخ: 21-2-2019
|
النبر:
سبق لنا أن شرحنا بنية المقاطع العربية وبينَّا أن هذه المقاطع ستة تختلف من حيث الكمية والصورة, ونود الآن أن نبدأ في شرح نظام النبر الذي لا يمكن شرحه إلّا بمعونة البنية المقطعية في نظام الصرف من جهة, وفي الكلام العربي من جهة أخرى؛ فالفرق ما بين النبر في الصرف والنبر في الكلام هو فرق ما بين مقررات القاعدة ومطالب السياق. وبهذا يصبح النبر في الكلام هو الظاهرة الموقعية؛ لأنه نبر الجمل المستعملة فعلًا, وهي ميدان الظواهر الموقعية, أما النبر في نظام الصرف فهو نبر الكلمة المفردة أو الصيغة المفردة على الأصح, وهو نبر صامت صمت القاعدة نفسها وصمت اللغة من بعدها. والنبر بحكم التعريف ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية ما حوله من أجزائها, وما دام النبر بحسب هذا التعريف وضوحًا سمعيًّا, فإن نسبته إلى الكلمات والصيغ خارج السياق نسبة إلى نظام الصرف اقتضاها التحليل؛ حيث لا يمكن ادّعاء وضوح سمعي في كلمات
ص170
وصيغ صامتة. ومرجع هذا الوضوح السمعي إلى عنصرين يرتبط أحدهما بظاهرة علوِّ الصوت وانخفاضه, وهي ترتبط بدورها بحركة الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من هواء, فتؤدي زيادة كمية الهواء إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصوتية فيكون من ذلك علوّ الصوت. ويرتبط العنصر الآخر بتوتر التَّمَاس بين أعضاء النطق في مخرج الصوت, أو بعبارة أخرى: يأتي النبر من التوتر والعلوّ في الصوت اللذين يتَّصف بهما موقع معين من مواقع الكلام.
وقد رأينا من قبل أثناء الكلام في النظام الصرفي للغة أن طبيعة الصياغة العربية للكلمات قد مكَّنت الصرفيين العرب من أن يعبروا تعبيرًا ذكيًّا عن قواعد هذه الصياغة, فأوجدوا للكلمات العربية صيغًا صرفية وموازين صرفية, فتتفق صيغة الكلمة وميزانها أحيانًا كما في "ضَرْب", وتختلف الصيغة عن الميزان أحيانًا أخرى كما في "استقامة", ولكنهما يقفان من اللفظ دائمًا موقف الشبح من الجسم, أو القالب من العجينة التي تصب فيه, ولهذا السبب بالذات أصبح من الممكن في دراسة اللغة العربية -دون غيرها من اللغات على ما يبدو- أن نتكلم عن نبر الصيغ الصرفية, ونكتفي به عن دراسة نبر الكلمات أي الأمثلة. ومن هنا يكون النبر على مستوى الصيغة والكلمة ذا وظيفة صرفية هي تقديم القيم الخلافية التي تفرق مع الكمية بين معنًى صرفي ومعنًى صرفي آخر, ويمكن بواسطتهما مثلًا أن نفرق بين طوائف من الصيغ مثل فَعِلَ - فَعَّل - فاعل - فعيل؛ حيث يفرق بين الكلمات الأربع بالكمية, وبين الثلاث الأولى وبين الرابعة بالنبر, فيقع النبر في الكلمات الثلاث الأولى على المقطع الأول, وفي الرابعة على الثاني.
ومع ذلك يحسن في دراسة النبر الأبنية على نظام الصيغ, وأن نعدل عن ذلك إلى بنائه على ترتيب المقاطع في الصيغ؛ لأن عدد المقاطع -وهي ستة كما رأينا- أقل بكثير جدًّا من عدد الصيغ الصرفية, فيؤدي استعمال المقاطع في تحديد قواعد النبر إلى أن يكون عدد القواعد قليلًا, وأن يكون الكلام فيها مختصرًا, وقلة القواعد وسهولة ضبطها مرغوب فيهما على أي حال.
ص171
عرفنا إذًا أن ثمة نوعين من النبر:
1- نبر القاعدة أو نبر النظام الصرفي الذي نسبناه إلى الصيغة الصرفية المفردة والكلمة التي تأتي على مثال هذه الصيغة, وهذا النبر صامت.
2- نبر الاستعمال أو نبر الكلام والجمل المنطوقة, وهذا النبر أثر سمعي يرجع إلى أسباب عضوية محددة وقد شرحناها في بداية الكلام عن النبر.
وسنحاول أن نشرح نبر النظام الصرفي, أو بعبارة أخرى: قاعدة النبر في البداية, ثم نحاول عند الكلام عن الظواهر الموقعية بعد ذلك أن نذكر الفروق بين قاعدة النبر وبين النبر في السياق المتحرك, مع فهم أن قاعدة النبر فيما عدا هذه الفروق متفقة مع نبر الاستعمال.
وينقسم النبر بحسب "القاعدة" من حيث القوة والضعف إلى قسمين:
1- النبر الأولي: ويكون في الكلمات والصيغ جميعًا لا تخلو منه واحدة منها.
2- النبر الثانوي: وهو يكون في الكلمة أو الصيغة الطويلة نسبيًّا؛ بحيث يمكن لهذه الكلمة أن تبدو للأذن كما لو كانت كلمتين, أو بعبارة أكثر دقة: عندما تشتمل الكلمة على عدد من المقاطع يمكن أن يتكون منه وزن كلمتين عربيتين, فكلمة "مستحيل" مثلًا يمكن في مقاطعها أن نكون وزن كلمتين عربيتين هما "بعد, ميل" ومن ثَمَّ تشتمل على نبر أولي على المقطع الأخير, ونبر ثانوي على المقطع الأول منها, ويبقى المقطع الأوسط وهو ما يقابل الدال المفتوحة دون نبر.
ولكلٍّ من النبر الأولي والنبر الثانوي قواعده الخاصة به التي تنسجم مع وظيفته الإيقاعية في حدود الصيغة أو الكلمة, وفيما يلي قواعد النبر الأولي:
القاعدة الأولى: يقع النبر على القطع الأخير في الكلمة أو الصيغة إذا كان هذا المقطع طويلًا "أي: على صورة ص م ص أو ص ح ص ص"
ص172
نحو: "استقال" و"استقلّ", فإذا كانت الكلمة ذات مقطع وحيد وقع عليه النبر أيًّا كانت كميته مثل: "ق" و"قم" و"ما" و"قال" و"قلَّ".
القاعدة الثانية: يقع النبر على المقطع الذي قبل الآخر في الحالات الآتية:
1- إذا كان ما قبل الآخر متوسطًا والمقطع الأخير
أ- قصيرًا نحو: أخرجت - حذار - استاق.
ب- متوسطًا نحو: علم - قاتل - معلم - مقاتل -استوثق "بسكون الآخر".
2- إذا كان ما قبل الآخر قصيرًا في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- بدئت به الكلمة نحو: كتب - حسب - صور - قفا.
ب- سبقه المقطع الأقصر ذو الحرف الوحيد الساكن الذي يتوصّل إلى النطق به بهمزة الوصل نحو: انحبس - انطلق - ارعو - اخرجي - ابتغ - امضيا.
3- إذا كان ما قبل الآخر طويلًا اغتفر فيه التقاء الساكنين, ولم يكن الأخير طويلًا آخر نحو: أتحاجوني - دوبية.
القاعدة الثالثة: يقع النبر على المقطع الثالث من الآخر إذا كان:
1- قصيرًا متلوًّا بقصيرين:
نحو: علمك - لن يصيل - أكرمك.
2- قصيرًا متلوًّا بقصير ومتوسط
نحو: علمك -لم يصل - أكرمك.
3- متوسطًا متلوًّا بقصيرين
نحو: بيتك -لم ينته - أُخْرِجَ.
4- متوسطًا متلوًّا بقصير ومتوسط
نحو: بينكم - مصطفى - أُخْرِجُوا - مُفَكِّرٌ -نَظْرَةٌ - ابْتِسَامَةٌ.
ص173
القاعدة الرابعة: يقع النبر على المقطع الرابع من الآخر إذا كان الأخير متوسطًا والرابع من الآخر قصيرًا وبينهما قصيران نحو: بَقَرَةٌ - عِجْلَةٌ - وَرَثَةٌ - كَلِمَةٌ - يرثني - يَعِدُهم - وَسِعَهُ - ضربها - نَكِرَهُم.
ويغلب في المقطع الأخير في هذه الحالة أن يكون تنوينًا أو إضمارًا أو إشباعًا.
ولا يقع النبر على مقطع يسبق هذا الرابع من الآخر.
وكما احتسبنا النبر الأولي من نهاية الكلمة متجهين بقواعد صوب بدايتها سيكون حسابنا للنبر الثانوي من النقطة التي وقع عليها النبر الأولي, متجهين الاتجاه نفسه إلى بداية الكلمة في اتجاه معاكس لمجرى ترتيب الكلمة في الحالتين, وفيما يلي قواعد النبر الثانوي.
القاعدة الأولى: يقع النبر الثانوي على المقطع السابق للنبر الأولي مباشرة إذا كان هذا المقطع السابق طويلًا "ص م ص أو ص ح ص ص" نحو: الصافات - الضالين - أتحاجوني.
القاعدة الثانية: يقع النبر الثانوي على المقطع الثاني قبل النبر الأولي إذا كان هذا المقطع والذي يليه فيقع بينه وبين النبر الأولي, يكونان أحد النماذج الآتية:
1- متوسط + متوسط
نحو: مُسْتَبْقِين - يَسْتَخْفُون -عَاشَرْنَاهم.
2- متوسط + قصير
نحو: مُسْتَقِيم - مُسْتَعِدَّة - قَاتِلُوهُمْ.
3- طويل + قصير
نحو: مُدْهَامَّتَانْ.
القاعدة الثالثة: يقع النبر على المقطع الثالث قبل النبر الأولي إذا كان هذا المقطع المذكور يكون مع اللذين يليانه, فقعان بينه وبين النبر الأولي أحد النماذج الآتية:
ص174
1- متوسط + قصير + متوسط
نحو: يَسْتَقِيمُون- مُسْتَجِيبُون - مُسْتَطِيلَانْ.
2- متوسط + قصير + قصير
نحو: مُنْطَلِقُونَ - يَسْتَبِقُونَ -مُحْتَرَمُونْ.
3- قصير + قصير + قصير
نحو: بَقَرَتَان -كَلِمَتَان -ضَرَبْتَاهْ.
ولا يقع النبر على سابق على ما ذكرنا.
ص175
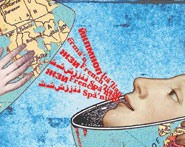
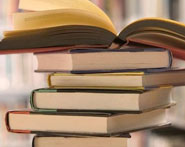

|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|