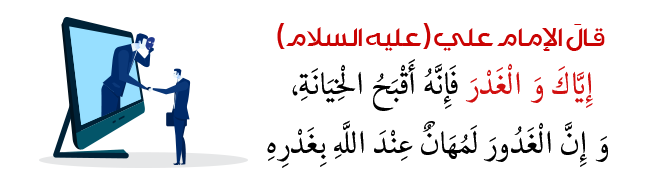
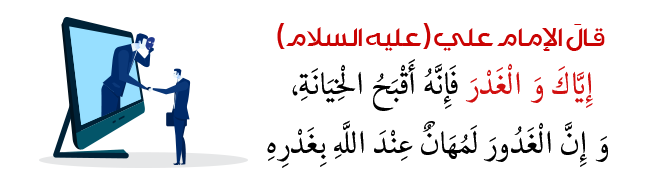

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكامقال تعالى : {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى : 1 - 19] .
تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآيات (1) :
{سبح اسم ربك الأعلى} أي قل سبحان ربي الأعلى عن ابن عباس وقتادة وقيل معناه نزه ربك عن كل ما لا يليق به من الصفات المذمومة والأفعال القبيحة لأن التسبيح هو التنزيه لله عما لا يليق به يجوز أن تقول لا إله إلا هو فتنفي ما لا يجوز في صفته من شريك في عبادته مع الإقرار بأنه الواحد في إلهيته وأراد بالاسم المسمى وقيل إنه ذكر الاسم والمراد به تعظيم المسمى كما قال لبيد : ((إلى الحول ثم اسم السلام عليكما)) ويحسن بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أن يقول ((سبحان ربي الأعلى)) وإن كان في الصلاة قال الباقر (عليه السلام) إذا قرأت {سبح اسم ربك الأعلى} فقل سبحان ربي الأعلى وإن كان فيما بينك وبين نفسك والأعلى معناه القادر الذي لا قادر أقدر منه القاهر لكل أحد وقيل الأعلى صفة الاسم والمعنى سبح الله بذكر اسمه الأعلى وأسماؤه الحسنى كلها أعلى وقيل معناه صل باسم ربك الأعلى عن ابن عباس .
{الذي خلق} الخلق {فسوى} بينهم في باب الأحكام والإتقان وقيل خلق كل ذي روح فسوى يديه وعينيه ورجليه عن الكلبي وقيل خلق الإنسان فعدل قامته عن الزجاج يعني أنه لم يجعله منكوسا كالبهائم والدواب وقيل خلق الأشياء على موجب إرادته وحكمته فسوى صنعها لتشهد على وحدانيته {والذي قدر فهدى} أي قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيئات وأجرى لهم أسباب معايشهم من الأرزاق والأقوات ثم هداهم إلى دينه بمعرفة توحيده بإظهار الدلالات والبينات وقيل معناه قدر أقواتهم وهداهم لطلبها وقيل قدرهم على ما اقتضته حكمته فهدى أي أرشد كل حيوان إلى ما فيه منفعته ومضرته حتى أنه سبحانه هدى الطفل إلى ثدي أمه وهدى الفرخ حتى طلب الزق (2) من أبيه وأمه والدواب والطيور حتى فزع كل منهم إلى أمه وطلب الميمنة من جهته سبحانه وتعالى وقيل قدرهم ذكورا وإناثا وهدى الذكر كيف يأتي الأنثى عن مقاتل والكلبي وقيل هدى إلى سبيل الخير والشر عن مجاهد وقيل قدر الولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثر وهدى للخروج منه للتمام عن السدي وقيل قدر المنافع في الأشياء وهدي الإنسان لاستخراجها منه فجعل بعضها غذاء وبعضها دواء وبعضها سما وهدى إلى ما يحتاج إلى استخراجها من الجبال والمعادن كيف تستخرج وكيف تستعمل .
{والذي أخرج المرعى} أي أنبت الحشيش من الأرض لمنافع جميع الحيوان وأقواتهم {فجعله} بعد الخضرة {غثاء} أي هشيما جافا كالغثاء الذي تراه فوق السيل {أحوى} أي أسود بعد الخضرة وذلك أن الكلأ إذا يبس اسود وقيل معناه أخرج العشب وما ترعاه النعم أحوى أي شديد الخضرة يضرب إلى السواد من شدة خضرته فجعله غثاء أي يابسا بعد ما كان رطبا وهو قوت البهائم في الحالين فسبحان من دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وقيل إنه مثل ضربه الله تعالى لذهاب الدنيا بعد نضارتها {سنقرئك فلا تنسى} أي سنأخذ عليك قراءة القرآن فلا تنسى ذلك وقيل معناه سيقرأ عليك جبريل القرآن بأمرنا فتحفظه ولا تنساه قال ابن عباس كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) إذا نزل عليه جبرائيل (عليه السلام) بالوحي يقرأه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبرائيل (عليه السلام) من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئا .
{إلا ما شاء الله} أن ينسيكه بنسخه من رفع حكمه وتلاوته عن الحسن وقتادة وعلى هذا فالإنشاء نوع من النسخ وقد مر بيانه في سورة البقرة عند قوله ما ننسخ من آية أو ننسها الآية وقيل معناه إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله عليك فلا تقرأه وقيل إلا ما شاء الله كالاستثناء في الإيمان وإن لم يقع منه مشيئة النسيان قال الفراء لم يشأ الله أن ينسي عليه السلم شيئا فهو كقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ولا يشاء وكقول القائل لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت وإلا أن أشاء أن أمنعك والنية أن لا يمنعه ومثله الاستثناء في الإيمان ففي الآية بيان لفضيلة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وإخبار أنه مع كونه (صلى الله عليه وآله وسلّم) أميا كان يحفظ القرآن وإن جبرائيل (عليه السلام) كان يقرأ عليه سورة طويلة فيحفظه بمرة واحدة ثم لا ينساه وهذه دلالة على الإعجاز الدال على نبوته .
{إنه يعلم الجهر وما يخفى} معناه إن الله سبحانه يعلم العلانية والسر .
والجهر رفع الصوت ونقيضه الهمس والمعنى أنه سبحانه يحفظ عليك ما جهرت به وما أخفيته مما تريد أن تعيه {ونيسرك لليسرى} اليسرى هي الفعلى من اليسر وهو سهولة عمل الخير والمعنى نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية ونهون عليك الوحي ونسهله حتى تحفظه ولا تنساه وتعمل به ولا تخالفه وقيل معناه نسهل لك من الألطاف والتأييد ما يثبتك على أمرك ويسهل عليك المستصعب من تبليغ الرسالة والصبر عليه عن أبي مسلم وهذا أحسن ما قيل فيه فإنه يتصل بقوله {سنقرئك فلا تنسى} فكأنه سبحانه أمره بالتبليغ ووعده النصر وأمره بالصبر وقيل إن اليسرى عبادة عن الجنة فهي اليسرى الكبرى أي نيسر لك دخول الجنة عن الجبائي {فذكر} أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يذكر الخلق ويعظهم .
{إن نفعت الذكرى} وإنما قال ذلك وذكراه تنفع لا محالة في عمل الإيمان والامتناع من العصيان لأنه ليس بشرط حقيقة وإنما هو إخبار عن أنه ينفع لا محالة في زيادة الطاعة والانتهاء عن المعصية كما يقال سله إن نفع السؤال وقيل معناه عظهم إن نفعت الموعظة أولم تنفع لأنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) بعث للإعذار والإنذار فعليه التذكير في كل حال نفع أولم ينفع ولم يذكر الحالة الثانية كقوله سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وقد نبه الله سبحانه على تفصيل الحالتين بقوله {سيذكر من يخشى} أي سيتعظ بالقرآن من يخشى الله تعالى ويخاف عقابه {ويتجنبها} أي يتجنب الذكرى والموعظة {الأشقى} أي أشقى العصاة فإن للعاصين درجات في الشقاوة فأعظمهم درجة فيها الذي كفر بالله وتوحيده وعبد غيره وقيل الأشقى من الاثنين من يخشى ومن يتجنب عن أبي مسلم .
{الذي يصلى النار الكبرى} أي يلزم أكبر النيران وهي نار جهنم والنار الصغرى نار الدنيا عن الحسن وقيل إن النار الكبرى هي الطبقة السفلى من جهنم عن الفراء {ثم لا يموت فيها} فيستريح {ولا يحيى} حياة ينتفع بها بل صارت حياته وبالا عليه يتمنى زوالها لما هو معها من فنون العقاب وألوان العذاب وقيل ولا يحيى أي ولا يجد روح الحياة {قد أفلح من تزكى} أي قد فاز من تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله عن عطاء وعكرمة وقيل معناه قد ظفر بالبغية من صار زاكيا بالأعمال الصالحة والورع عن ابن عباس والحسن وقتادة وقيل زكى أي أعطى زكاة ماله عن ابن مسعود وكان يقول قد رحم الله امرأ تصدق ثم صلى ويقرأ هذه الآية وقيل أراد صدقة الفطرة وصلاة العيد عن أبي عمرو وأبي العالية وعكرمة وابن سيرين وروي ذلك مرفوعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومتى قيل على هذا القول كيف يصح ذلك والسورة مكية ولم يكن هناك صلاة عيد ولا زكاة ولا فطرة قلنا يحتمل إن يكون نزلت أوائلها بمكة وختمت بالمدينة .
{وذكر اسم ربه فصلى} أي وحد الله عن ابن عباس وقيل ذكر الله بقلبه عند صلاته فرجا ثوابه وخاف عقابه فإن الخشوع في الصلاة بحسب الخوف والرجاء وقيل ذكر اسم ربه بلسانه عند دخوله في الصلاة فصلى بذلك الاسم أي قال الله أكبر لأن الصلاة لا تنعقد إلا به وقيل هو أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم ويصلي الصلوات الخمس المكتوبة .
ثم قال سبحانه مخاطبا للكفار {بل تؤثرون} أي تختارون {الحياة الدنيا} على الآخرة فتعملون لها وتعمرونها ولا تتفكرون في أمر الآخرة وقيل هو عام في المؤمن والكافر بناء على الأعم الأغلب في أمر الناس قال عبد الله بن مسعود إن الدنيا اخضرت لنا وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذتها وبهجتها وإن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل ثم رغب سبحانه في الآخرة فقال {والآخرة} أي والدار الآخرة وهي الجنة {خير} أي أفضل {وأبقى} وأدوم من الدنيا وفي الحديث من أحب آخرته أضر بدنياه ومن أحب دنياه أضر ب آخرته {إن هذا لفي الصحف الأولى} يعني أن هذا الذي ذكر من قوله {قد أفلح} إلى أربع آيات لفي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المصلي والمتزكي وإيثار الخلق الدنيا على الآخرة وإن الآخرة خير وقيل معناه أن من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فهو ممدوح في الصحف الأولى كما هو ممدوح في القرآن .
ثم بين سبحانه أن الصحف الأولى ما هي فقال {صحف إبراهيم وموسى} وفي هذا دلالة على أن إبراهيم كان قد أنزل عليه الكتاب خلافا لمن يزعم أنه لم ينزل عليه كتاب وواحدة الصحف صحيفة وروي عن أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء فقال مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفا قلت يا رسول الله كم المرسلون منهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر وبقيتهم أنبياء قلت كان آدم (عليه السلام) نبيا قال نعم كلمة الله وخلقه بيده يا أبا ذر أربعة الأنبياء عرب هود وصالح وشعيب ونبيك قلت يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب قال مائة وأربعة كتب أنزل الله منها على آدم (عليه السلام) عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة وهو أول من خط بالقلم وعلى إبراهيم عشر صحائف والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وفي الحديث أنه كان في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه وقيل إن كتب الله كلها أنزلت في شهر رمضان .
______________________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج10 ، ص328-332 .
2- الزق : اطعام الطائر فرخه بمنقاره .
تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنية في تفسير هذه الآيات (1) :
{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} . الخطاب خاص بالرسول (صلى الله عليه واله وسلم) والتكليف يعم الجميع ، والمعنى نزه اللَّه عن الشريك والصاحبة والولد ، وكل ما لا يليق بعظمته وجلاله ، ولا شيء أدل على تنزيه الخالق من كلمة {لا إله إلا اللَّه} وانما أمر سبحانه بتسبيح الاسم دون الذات لأن مبلغ جهد الإنسان ان يعرف اللَّه بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى ، أما الذات فلا تقع عليها العقول والافهام {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} . خلق ما خلق فأقام حده ، وصوّر ما صوّر فأحسن صورته {والَّذِي قَدَّرَ فَهَدى} . جعل لكل شيء غاية ويسره إليها ، وخير تفسير لهذه الآية قول الإمام علي (عليه السلام) : قدر ما خلق فأحكم تقديره ، ودبره فألطف تدبيره ، ووجهه لوجهته فلم يتعد حدود منزلته ، ويقصر دون الانتهاء لغايته {والَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى} متاعا للأنام ، ورزقا للأنعام {فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى} . الغثاء الجاف اليابس ، والأحوى يميل لونه إلى السواد ، وبديهة ان النبات ينتفع به غضا طريا ، وأيضا ينتفع به هشيما باليا حيث يكون علفا للحيوانات . . وفيه إيماء إلى ان كل حي إلى زوال .
{سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى} . هذه بشرى من اللَّه لنبيه الكريم بأن القرآن سينزل على قلبه ويرسخ فيه ، ولا يفوته منه حرف واحد . وتقدم مثله في الآية 17 من سورة القيامة {إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ} . قال بعض المفسرين : معناه ان اللَّه لا ينسي نبيه شيئا من القرآن إلا الآية التي ينسخها . ونحن مع الذين قالوا : ان الغرض من الاستثناء هو التنبيه على ان الحفظ وعدم النسيان هو تفضل وتكرم من اللَّه على نبيه ، وليس بالأمر الحتم والواجب ، ولو أراد سبحانه أن ينسي النبي لفعل ، ولم يعجزه شيء ، ومثله {خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ والأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ} [هود- 107] أي ان الخلود ه وبمشيئة اللَّه وإرادته ولو أراد إخراجهم من جهنم لا يمنعه من ذلك مانع .
{إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وما يَخْفى} . ليس من شك ان اللَّه بكل شيء عليم ، وأشار سبحانه هنا إلى ذلك بعد ذكر النسيان ليقول لنبيه الكريم : نحن نعلم ما في نفسك وانك كنت تخاف أن يفوتك شيء من القرآن . . كلا ، لن يفوتك شيء ، كن في أمان واطمئنان {ونُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى} . المراد باليسرى الشريعة السهلة السمحة ، والمعنى ان اللَّه سبحانه يسهل لك يا محمد سبيل الوحي بآياته وأحكامه حتى تحفظها وتبلغها وتعمل بها كما أراد اللَّه .
{فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى} . ليس من شك ان التذكير واجب حتى مع العلم بأنه لا يجدي نفعا لالقاء الحجة وقطع المعذرة والا امتنع الحساب والعقاب ، قال تعالى : {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} 165 النساء . وعليه تكون {ان} هنا بعيدة كل البعد عن معنى الشرط والقيد ، وان المراد بها بيان الواقع أي ان الذكرى ينتفع بها من يبتغي الهداية ، أما من يصر على الضلال فلا ينتفع بشيء ، ويدل على إرادة هذا المعنى قوله تعالى بلا فاصل : {سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى ويَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى} . فالذكرى تنفع لا محالة من يوقظه الخوف من اللَّه ، ولا يعرض عنها إلا شقي أعمت الشهوات بصيرته ، وغلبت عليه شقوته {الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى} بشدائدها وأهوالها {ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها ولا يَحْيى} . ونفسره بقوله تعالى : {والَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ولا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها} [فاطر- 36 ] ج 6 ص 293 .
وقال الشيخ محمد عبده وهو يفسر {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى} : إياك ان تنخدع بما يقوله أولئك الذين يلبسون لباس العلماء ، ويزعمون مزاعم السفهاء من انه لا يجب عليهم التذكير لأنه لا ينفع ، ويحتجون بقوله تعالى : {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى} فإن ذلك منهم ضلال وتضليل ، ولو صدق قولهم لما وجب التذكير في وقت من الأوقات لأنه لا يخلو زمان من معاندين ، ولا يسلم قائل من جاحدين ، وقد يعرف بعضهم انه ينطق عن الهوى ولكنه يدافع عن جبنه ، ويحتج لكسله ، ويحب ان يزين نفسه في أعين الناس ، وان أوقعها في سخط اللَّه} .
{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} . المراد بالفلاح هنا النجاة من غضب اللَّه وعذابه ، وبالتزكية التطهير من الذنوب والآثام {وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} . المراد بالذكر هنا ما يقرّب من الخير ، ويبعد عن الشر ، أما حركة اللسان من حيث هي فليست غاية في نفسها . . ولا شيء من أمر اللَّه ونهيه إلا وهو وسيلة لفعل الخير والبعد عن الشر ، وكفى دليلا على هذه الحقيقة قول الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) : انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، وقوله تعالى : {وما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ} [الأنبياء -108] أما الصلاة فالمراد بها الصلوات الخمس لأنها عمود الدين .
{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا} . هنا يكمن السر الأول والأخير لإعراض من أعرض عن الحق عامدا متعمدا . . ملكته الدنيا ملك السيد لعبده ، وأقبل عليها إقبال الطفل على ثدي أمه ، فذهبت به عن اللَّه والحق والإنسانية {والآخِرَةُ خَيْرٌ وأَبْقى} بل لا خير في الدنيا إطلاقا إلا ما كان وسيلة لخير الآخرة ، لأن عمار الدنيا إلى خراب ، وسلطانها إلى زوال ، ومالها إلى نفاد . وفي نهج البلاغة : كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه ، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه .
واعلموا ان ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا .
{إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الأُولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ ومُوسى} . هذا إشارة إلى قوله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} والمعنى ان دعوة الرسل من ناحية العقيدة واحدة لأن الذي أرسلهم واحد ، وقوله واحد لا تهافت فيه ولا تناقض ، وإذا كان هناك اختلاف فهو في بعض الفروع التي يستدعيها تطور الزمن وتغير المجتمع ، وما دام الأمر كذلك فعلى من يؤمن بإبراهيم كالعرب وبموسى كاليهود أن يؤمنوا أيضا بمحمد (صلى الله عليه واله وسلم) وإلا كانوا من الذين يؤمنون بالمبدأ الواحد ويكفرون به في آن واحد .
______________________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7 ، ص551-554 .
تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآيات (1) :
أمر بتوحيده تعالى على ما يليق بساحته المقدسة وتنزيه ذاته المتعالية من أن يذكر مع اسمه اسم غيره أو يسند إلى غيره ما يجب أن يسند إليه كالخلق والتدبير والرزق ووعد له (صلى الله عليه وآله وسلم) بتأييده بالعلم والحفظ وتمكينه من الطريقة التي هي أسهل وأيسر للتبليغ وأنسب للدعوة .
وسياق الآيات في صدر السورة سياق مكي وأما ذيلها أعني قوله : {قد أفلح من تزكى} إلخ فقد ورد من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وكذا من طريق أهل السنة أن المراد به زكاة الفطرة وصلاة العيد ومن المعلوم أن الصوم وما يتبعه من زكاة الفطرة وصلاة العيد إنما شرعت بالمدينة بعد الهجرة فتكون آيات الذيل نازلة بالمدينة .
فالسورة صدرها مكي وذيلها مدني ، ولا ينافي ذلك ما جاء في الآثار أن السورة مكية فإنه لا يأبى الحمل على صدر السورة .
قوله تعالى : {سبح اسم ربك الأعلى} أمر بتنزيه اسمه تعالى وتقديسه ، وإذ علق التنزيه على الاسم - وظاهر اللفظ الدال على المسمى - والاسم إنما يقع في القول فتنزيهه أن لا يذكر معه ما هو تعالى منزه عنه كذكر الآلهة والشركاء والشفعاء ونسبة الربوبية إليهم وكذكر بعض ما يختص به تعالى كالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة ونحوها ونسبته إلى غيره تعالى أو كذكر بعض ما لا يليق بساحة قدسه تعالى من الأفعال كالعجز والجهل والظلم والغفلة وما يشبهها من صفات النقص والشين ونسبته إليه تعالى .
وبالجملة تنزيه اسمه تعالى أن يجرد القول عن ذكر ما لا يناسب ذكره ذكر اسمه تعالى وهو تنزيهه تعالى في مرحلة القول الموافق لتنزيهه في مرحلة الفعل .
وهو يلازم التوحيد الكامل بنفي الشرك الجلي كما في قوله : {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} [الزمر : 45] وقوله : {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا } [الإسراء : 46] .
وفي إضافة الاسم إلى الرب والرب إلى ضمير الخطاب تأييد لما قدمناه فإن المعنى سبح اسم ربك الذي اتخذته ربا وأنت تدعو إلى أنه الرب الإله فلا يقعن في كلامك مع ذكر اسمه بالربوبية ذكر من غيره بحيث ينافي تسميه بالربوبية على ما عرف نفسه لك .
وقوله : {الأعلى} وهو الذي يعلو كل عال ويقهر كل شيء صفة {ربك} دون الاسم ويعلل بمعناه الحكم أي سبح اسمه لأنه أعلى .
وقيل : معنى {سبح اسم ربك الأعلى} قل : سبحان ربي الأعلى كما عن ابن عباس ونسب إليه أيضا أن المعنى صل .
وقيل : المراد بالاسم المسمى والمعنى نزهه تعالى عن كل ما لا يليق بساحة قدسه من الصفات والأفعال .
وقيل : إنه ذكر الاسم والمراد به تعظيم المسمى واستشهد عليه بقول لبيد ، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما .
فالمعنى سبح ربك الأعلى .
وقيل : المراد تنزيه أسمائه تعالى عما لا يليق بأن لا يئول مما ورد منها اسم من غير مقتض ، ولا يبقى على ظاهره إذا كان ما وضع له لا يصح له تعالى ، ولا يطلقه على غيره تعالى إذا كان مختصا كاسم الجلالة ولا يتلفظ به في محل لا يناسبه كبيت الخلاء ، وعلى هذا القياس وما قدمناه من المعنى أوسع وأشمل وأنسب لسياق قوله الآتي {سنقرئك فلا تنسى} {ونيسرك لليسرى فذكر} فإن السياق سياق البعث إلى التذكرة والتبليغ فبدأ أولا بإصلاح كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) وتجريده عن كل ما يشعر بجلي الشرك وخفيه بأمره بتنزيه اسم ربه ، ووعد ثانيا بإقرائه بحيث لا ينسى شيئا مما أوحي إليه وتسهيل طريقة التبليغ عليه ثم أمر بالتذكير والتبليغ فافهم .
قوله تعالى : {الذي خلق فسوى} خلق الشيء جمع أجزائه ، وتسويته جعلها متساوية بحيث يوضع كل في موضعه الذي يليق به ويعطى حقه كوضع كل عضو من أعضاء الإنسان فيما يناسبه من الموضع .
والخلق والتسوية وإن كانا مطلقين لكنهما إنما يشملان ما فيه تركيب أو شائبة تركيب من المخلوقات .
والآية إلى تمام أربع آيات تصف التدبير الإلهي وهي برهان على ربوبيته تعالى المطلقة .
قوله تعالى : {والذي قدر فهدى} أي جعل الأشياء التي خلقها على مقادير مخصوصة وحدود معينة في ذواتها وصفاتها وأفعالها لا تتعداها وجهزها بما يناسب ما قدر لها فهداها إلى ما قدر فكل يسلك نحو ما قدر له بهداية ربانية تكوينية كالطفل يهتدي إلى ثدي أمه والفرخ إلى زق أمه وأبيه ، والذكر إلى الأنثى وذي النفع إلى نفعه وعلى هذا القياس .
قال تعالى : { وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ } [الحجر : 21] ، وقال : { ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ} [عبس : 20] وقال : {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة : 148] .
قوله تعالى : {والذي أخرج المرعى} المرعى ما ترعاه الدواب فالله تعالى هو الذي أخرجها أي أنبتها .
قوله تعالى : {فجعله غثاء أحوى} الغثاء ما يقذفه السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات ، والمراد هنا - كما قيل - اليابس من النبات ، والأحوى الأسود .
وإخراج المرعى لتغذي الحيوان ثم جعله غثاء أحوى من مصاديق التدبير الربوبي ودلائله كما أن الخلق والتسوية والتقدير والهداية كذلك .
قوله تعالى : {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى} قال في المفردات ، : والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل ، وليس يقال ذلك لكل جمع لا يقال : قرأت القوم إذا جمعتهم ، ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة ، انتهى ، وقال في المجمع ، : والإقراء أخذ القراءة على القارىء بالاستماع لتقويم الزلل ، والقارئ التالي ، انتهى .
وليس إقراؤه تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) القرآن مثل إقراء بعضنا بعضا باستماع المقري لما يقرؤه القارىء وإصلاح ما لا يحسنه أو يغلط فيه فلم يعهد من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقرأ شيئا من القرآن فلا يحسنه أو يغلط فيه عن نسيان للوحي ثم يقرأ فيصلح بل المراد تمكينه من قراءة القرآن كما أنزل من غير أن يغيره بزيادة أو نقص أو تحريف بسبب النسيان .
فقوله : {سنقرئك فلا تنسى} وعد منه لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يمكنه من العلم بالقرآن وحفظه على ما أنزل بحيث يرتفع عنه النسيان فيقرؤه كما أنزل وهو الملاك في تبليغ الوحي كما أوحي إليه .
وقوله : {إلا ما شاء الله} استثناء مفيد لبقاء القدرة الإلهية على إطلاقها وأن هذه العطية وهي الإقراء بحيث لا تنسى لا ينقطع عنه سبحانه بالإعطاء بحيث لا يقدر بعد على إنسائك بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء إنساءك متى شاء وإن كان لا يشاء ذلك فهو نظير الاستثناء الذي في قوله : {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ } [هود : 108] وقد تقدم توضيحه .
وليس المراد بالاستثناء إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي والمعنى سنقرئك فلا تنسى شيئا إلا ما شاء الله أن تنساه وذلك أن كل إنسان على هذه الحال يحفظ أشياء وينسى أشياء فلا معنى لاختصاصه بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلحن الامتنان مع كونه مشتركا بينه وبين غيره فالوجه ما قدمناه .
والآية بسياقها لا تخلو من تأييد لما قيل : إنه كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا نزل عليه جبريل بالوحي يقرؤه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبريل من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعده شيئا .
ويقرب من الاعتبار أن تكون هذه الآية أعني قوله : {سنقرئك فلا تنسى} نازلة أولا ثم قوله : {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } [القيامة : 16 - 19] ثم قوله : { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه : 114] .
وقوله : {إنه يعلم الجهر وما يخفى} الجهر كمال ظهور الشيء لحاسة البصر كقوله .
{فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً } [النساء : 153] ، أو لحاسة السمع كقوله : {إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ } [الأنبياء : 110] ، والمراد بالجهر الظاهر للإدراك بقرينة مقابلته لقوله : {وما يخفى} من غير تقييده بسمع أو بصر .
والجملة في مقام التعليل لقوله .
{سنقرئك فلا تنسى} والمعنى سنصلح لك بالك في تلقي الوحي وحفظه لأنا نعلم ظاهر الأشياء وباطنها فنعلم ظاهر حالك وباطنها وما أنت عليه من الاهتمام بأمر الوحي والحرص على طاعته فيما أمر به .
وفي قوله : {إلا ما شاء الله إنه يعلم} إلخ التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة والنكتة فيه الإشارة إلى حجة الاستثناء فإفاضة العلم والحفظ للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما لا يسلب القدرة على خلافه ولا يحدها منه تعالى لأنه الله المستجمع لجميع صفات الكمال ومنها القدرة المطلقة ثم جرى الالتفات في قوله : {إنه يعلم} إلخ لمثل النكتة .
قوله تعالى : {ونيسرك لليسرى} اليسرى - مؤنث أيسر – وهو وصف قائم مقام موصوفة المحذوف أي الطريقة اليسرى والتيسير التسهيل أي ونجعلك بحيث تتخذ دائما أسهل الطرق للدعوة والتبليغ قولا وفعلا فتهدي قوما وتتم الحجة على آخرين وتصبر على أذاهم .
وكان مقتضى الظاهر أن يقال : ونيسر لك اليسرى كما قال : {وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي} [طه : 26] وإنما عدل عن ذلك إلى قوله : {ونيسرك لليسرى} لأن الكلام في تجهيزه تعالى نفس النبي الشريفة وجعله إياها صالحة لتأدية الرسالة ونشر الدعوة .
على ما في نيسر اليسرى من إيهام تحصيل الحاصل .
فالمراد جعله (صلى الله عليه وآله وسلم) صافي الفطرة حقيقا على اختيار الطريقة اليسرى التي هي طريقة الفطرة فالآية في معنى قوله حكاية عن موسى : {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} [الأعراف : 105] .
قوله تعالى : {فذكر إن نفعت الذكرى} تفريع على ما تقدم من أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بتنزيه اسم ربه ووعده إقراء الوحي بحيث لا ينسى وتيسيره لليسرى وهي الشرائط الضرورية التي يتوقف عليها نجاح الدعوة الدينية .
والمعنى إذ تم لك الأمر بامتثال ما أمرناك به وإقرائك فلا تنسى وتيسيرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى .
وقد اشترط في الأمر بالتذكرة أن تكون نافعة وهو شرط على حقيقته فإنها إذا لم تنفع كانت لغوا وهو تعالى يجل عن أن يأمر باللغو فالتذكرة لمن يخشى لأول مرة تفيد ميلا من نفسه إلى الحق وهو نفعها وكذا التذكرة بعد التذكرة كما قال : {سيذكر من يخشى} والتذكرة للأشقى الذي لا خشية في قلبه لأول مرة تفيد تمام الحجة عليه وهو نفعها ويلازمها تجنبه وتوليه عن الحق كما قال : {ويتجنبها الأشقى} والتذكرة بعد التذكرة له لا تنفع شيئا ولذا أمر بالإعراض عن ذلك قال تعالى : {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } [النجم : 29] .
وقيل : الشرط شرط صوري غير حقيقي وإنما هو إخبار عن أن الذكرى نافعة لا محالة في زيادة الطاعة والانتهاء عن المعصية كما يقال : سله إن نفع السؤال ولذا قال بعضهم {إن} {إن} في الآية بمعنى قد ، وقال آخرون : إنها بمعنى إذ .
وفيه أن كون الذكرى نافعة مفيدة دائما حتى فيمن يعاند الحق - وقد تمت عليه الحجة - ممنوع كيف؟ وقد قيل فيهم : { سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة : 6 ، 7] .
وقيل : إن في الكلام إيجازا بالحذف ، والتقدير فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع وذلك لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأس للتذكرة والإعذار فعليه أن يذكر نفع أولم ينفع فالآية من قبيل قوله : { وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل : 81] أي والبرد .
وفيه أن وجوب التذكرة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى فيما لا يترتب عليها أثرا أصلا ممنوع .
وقيل : إن الشرط مسوق للإشارة إلى استبعاد النفع في تذكرة هؤلاء المذكورين نعيا عليهم كأنه قيل : افعل ما أمرت به لتوجر وإن لم ينتفعوا به .
وفيه أنه يرده قوله تعالى بعده بلا فصل : {سيذكر من يخشى} .
قوله تعالى : {سيذكر من يخشى} أي سيتذكر ويتعظ بالقرآن من في قلبه شيء من خشية الله وخوف عقابه .
قوله تعالى : {ويتجنبها الأشقى} الضمير للذكرى والمراد بالأشقى بقرينة المقابلة من ليس في قلبه شيء من خشية الله تعالى ، وتجنب الشيء التباعد عنه ، والمعنى وسيتباعد عن الذكرى من لا يخشى الله .
قوله تعالى : {الذي يصلى النار الكبرى} الظاهر أن المراد بالنار الكبرى نار جهنم وهي نار كبرى بالقياس إلى نار الدنيا ، وقيل : المراد بها أسفل دركات جهنم وهي أشدها عذابا .
قوله تعالى : {ثم لا يموت فيها ولا يحيى} ثم للتراخي بحسب رتبة الكلام ، والمراد من نفي الموت والحياة عنه معا نفي النجاة نفيا مؤبدا فإن النجاة بمعنى انقطاع العذاب بأحد أمرين إما بالموت حتى ينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده وإما يتبدل صفة الحياة من الشقاء إلى السعادة ومن العذاب إلى الراحة فالمراد بالحياة في الآية الحياة الطيبة على حد قولهم في الحرض : لا حي فيرجى ولا ميت فينسى .
قوله تعالى : {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} التزكي هو التطهر والمراد به التطهر من ألواث التعلقات الدنيوية الصارفة عن الآخرة بدليل قوله بعد {بل تؤثرون الحياة الدنيا} إلخ ، والرجوع إلى الله بالتوجه إليه تطهر من الإخلاد إلى الأرض ، والإنفاق في سبيل الله تطهر من لوث التعلق المالي حتى أن وضوء الصلاة تمثيل للتطهر عما كسبته الوجوه والأيدي والأقدام .
وقوله : {وذكر اسم ربه فصلى} الظاهر أن المراد بالذكر الذكر اللفظي ، وبالصلاة التوجه الخاص المشروع في الإسلام .
والآيتان بحسب ظاهر مدلولهما على العموم لكن ورد في المأثور عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنهما نزلتا في زكاة الفطر وصلاة العيد وكذا من طرق أهل السنة .
قوله تعالى : {بل تؤثرون الحياة الدنيا} إضراب بالخطاب لعامة الناس على ما يدعو إليه طبعهم البشري من التعلق التام بالدنيا والاشتغال بتعميرها ، والإيثار الاختيار ، وقيل : الخطاب للكفار ، والكلام على أي حال مسوق للعتاب والالتفات لتأكيده .
قوله تعالى : {والآخرة خير وأبقى} عد الآخرة أبقى بالنسبة إلى الدنيا مع أنها باقية أبدية في نفسها لأن المقام مقام الترجيح بين الدنيا والآخرة ويكفي في الترجيح مجرد كون الآخرة خيرا وأبقى بالنسبة إلى الدنيا وإن قطع النظر عن كونها باقية أبدية .
قوله تعالى : {إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى} الإشارة بهذا إلى ما بين في قوله : {قد أفلح من تزكى} إلى تمام أربع آيات ، وقيل : هذا إشارة إلى مضمون قوله : {والآخرة خير وأبقى} .
قيل : وفي إبهام الصحف ووصفها بالتقدم أولا ثم بيانها وتفسيرها بصحف إبراهيم وموسى ثانيا ما لا يخفى من تفخيم شأنها وتعظيم أمرها .
___________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج20 ، ص237-243 .
تفسير الامثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآيات (1) :
تسبيح اللّه :
تبدأ السّورة بخلاصة دعوة الأنبياء (عليهم السلام) ، حيث التسبيح والتقديس أبداً للّه الواحد الأحد ، فتخاطب النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقول : {سبح اسم ربّك الأعلى} .
يذهب جمع من المفسّرين إلى أنّ المراد بالـ «اسم» هنا هو (المسمى) ، في حين قال آخرون هو (اسم اللّه) سبحانه وتعالى .
وليس ثمّة فرق كبير بين القولين ، فالاسم يدّل على المسمى .
وعلى أيّة حال ، فمراد الآية أن لا يوضع اسمه جلّ شأنه في مصاف أسماء الأصنام ، ويجب تنزيه ذاته المقدسة من كلّ عيب ونقص ، ومن كلّ صفات المخلوق وعوارض الجسم ، أي أن لا يحد .
فينبغي على المؤمنين ألاّ يتعاملوا مع اسمه الجليل كتعامل عبدة الاصنام ، بأن يضعوا اسمه تعالى مع أسماء أصنامهم ، ولا يفعلوا كما يفعل المجسمة ، ممن وقعوا في خطأ كبير وفاحش حينما نسبوا إلى الباري جلّ جلاله الصفات الجسمية .
(الأعلى) : أي الاعلى من كلّ : أحد ، تصوّر ، تخيّل ، قياس ، ظن ، وهم ، ومن أي شرك بشقيه الجلي والخفي .
(ربّك) : إشارة إلى أنّه غير ذلك الرّب الذي يعتقد به عبدة الأصنام .
وبعد ذكر هاتين الصفتين (الربّ والأعلى) ، تذكر الآيات التالية خمس صفات تبيّن ربوبية اللّه العليا . . : (الذي خلق فسوّى)
(سوّى) : من (التسوية) ، وهي الترتيب والتنظيم ، ويضم هذا المفهوم بين جناحيه كلّ أنظمة الوجود ، مثل : النظام السماوي بنجومه وكواكبه ، والأنظمة الحاكمة على المخلوقات في الأرض ، ولا سيما الإنسان من حيث الروح والبدن .
أمّا ما قيل ، من كونها إشارة إلى نظام اليد أو العين أو اعتدال القامة ، فهذا في واقعه لا يتعدى أن يكون إلاّ بيان لمصداق محدود من مصاديق هذا المفهوم الواسع .
وعلى أيّة حال ، فنظام عالم الخليقة ، بدءاً من أبسط الأشياء ، كبصمات الأصابع التي أشارت إليها الآية (4) من سورة القيامة {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة : 4] ، وانتهاءً بأكبر منظومة سماوية ، كلها شواهد ناطقة على ربوبية اللّه سبحانه وتعالى ، وأدلة إثبات قاطعة على وجوده عزّوجلّ .
وبعد ذكر موضوعي الخلق والتنظيم ، تنتقل بنا الآية التالية إلى حركة الموجودات نحو الكمال : {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} [الأعلى : 3] .
والمراد بـ (قدّر) ، هو : وضع البرامج ، وتقدير مقادير الاُمور اللازمة للحركة باتجاه الأهداف المرسومة التي ما خلقت الموجودات إلاّ لأجلها .
والمراد بـ (هدى) هنا ، هي : الهداية الكونية ، على شكل غرائز وسنن طبيعية حاكمة على كل موجود (ولا فرق في الغرائز والدوافع سواء كانت داخلية أم خارجية) .
فمثلاً ، إنّ اللّه خلق ثدي المرأة وجعل في اللبن لتغذية الطفل ، وفي ذات الوقت جعل عاطفة الاُمومة شديدة عند المرأة ، ومن الطرف الآخر جعل في الطفل ميلاً غريزياً نحو ثدي اُمّه ، فكلّ هذه الإستعدادات والدوافع وشدّة العلاقة الموجودة بين الاُم والابن والثدي مقدّر بشكل دقيق ، كي تكون عملية السير نحو الهدف المطلوب طبيعية وصحيحة .
وهذا التقدير الحكيم ما نشاهده بوضوح في جميع الكائنات .
وبنظرة ممعنة لبناء كلّ موجود ، وما يطويه في فترة عمره من خطوات في مشوار الحياة ، تظهر لنا بوضوح الحقيقة التالية : (ثمّة برنامج وتخطيط دقيق يحيط بكل موجود ، وثمّة يد مقتدرة تهديه وتعينه على السير على ضوء ما رسم له) ، وهذه بحد ذاتها علامة جليّة لربوبية اللّه جلّ وعلا .
وقد اختص الإنسان بهداية تشريعية إضافة للهداية التكوينية يتلقاها عن طريق الوحي وإرسال الأنبياء عليهم السلام ، لتكتمل أمامه معالم الطريق من كافة جوانبه .
وتوصلنا الآية (50) من سورة طه لهذا المعنى ، وذلك لمّا نقلت لنا سؤال فرعون إلى موسى (عليه السلام) بقوله : {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} [طه : 49] ، فأجابه (عليه السلام) : {ربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى} .
وقد فُهم قول موسى (عليه السلام) بشكل مجمل في زمانه ، وحتى في زمان نزول الآية المباركة في صدر الدعوة الإسلامية ، ولكنّ . . مع دوران عجلة الأيّام ، وتقدم العلوم البشرية ، توصل الإنسان إلى معارف كثيرة ومنها ما يختص بمعرفة أنواع أحوال الموجودات الحيّة ، فتوضح قول موسى (عليه السلام) أكثر فأكثر ، حتى كتبت الآف الكتب في موضوع (التقدير) و (الهداية التكوينية) ، ومع ما توصل إليه العلماء من معلومات باهرة ، إلاّ إنّهم يؤكّدون على أنّ ما بقي خافي عليهم ، هو أكثر بكثير ممّا توصلوا لمعرفته!
وتشير الآية التالية إلى النباتات ، وما يخصّ غذاء الحيوانات منها : {والذي أخرج المرعى} .
واستعمال كلمة (أخرج) فيه وصف جميل لعملية تكوّن النباتات ، حيث إنّه يتضمّن وجودها داخل الأرض فأخرجها الباري منها .
وممّا لا شك فيه إنّ التغذية الحيوانية هي مقدمة لتغذية الإنسان ، وبالنتيجة فإنّ فائدة عملية تغذية الحيوان تعود إلى الإنسان .
ثمّ : {فجعله غُثاء أحوى} .
«الغثاء» : هوما يطفح ويتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجاري ، ويطلق أيضاً على ما يطفح على سطح القدر عند الطبخ ، ويستعمل كناية عن : كلّ ضائع ومفقود ، وجاء في الآية بمعنى : النبات اليابس المتراكم .
«أحوى» : من (الحوة) ـ على زنة قوّة ـ وهي شدّة الخضرة ، أو شدّة السواد ، وكلاهما من أصل واحد ، لأنّ الخضرة لو اشتدّت قربت من السواد ، وجاء في الآية بمعنى : تجمع النبات اليابس وتراكمه حتّى يتحول لونه تدريجياً إلى السواد .
ويمكن أن يكون اختيار هذا التعبير في مقام بيان النعم الإلهية ، لأحد أسباب ثلاث :
الأوّل : إنّ حال هذه النباتات يشير بشكل غير مباشر إلى فناء الدنيا ، لتكون دوماً درساً وعبرة للإنسان ، فهي بعد أن تنمو وتخضر في الربيع ، شيئاً فشيئاً ستيبس وتموت بعد مرور الأيّام عليها ، حتى يتحول جمالها الزاهي في فصل الربيع إلى سواد قاتم ، ولسان حالها يقول بعدم دوام الدنيا وانقضائها السريع .
الثّاني : إنّ النباتات اليابسة عندما تتراكم ، فستتحول بمرور الوقت إلى سماد طبيعي ، ليعطي الأرض القدرة اللازمة لإخراج نباتات جديدة اُخرى الثّالث : إنّ الآية تشير إلى تكوّن الفحم الحجري من النباتات والأشجار .
فكما هو معلوم ، إنّ الفحم الحجري ، والذي يعتبر من المصادر المهمّة للطاقة ، قد تكوّن من النباتات والأشجار التي يبست منذ ملايين السنين ، ودفنت في الأرض حتى تحجرت واسود لونها بمرور الزمان .
ويعتقد بعض العلماء ، بأنّ مناجم الفحم الحجري قد تكوّنت من جراء النباتات اليابسة المدفونة في داخل الأرض منذ (250) مليون سنة تقريباً!
ولو أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستهلاك الفعلي للفحم الحجري في العالم ، لوجدنا أنّها تؤمن احتياج النّاس لأكثر من (4000) سنة .
وتفسير الآية بالمعنى الأخير دون غيره بعيد حسب الظاهر ، ولا يستبعد أن تكون الآية قد أرادت كل ما جاء في المعاني الثلاث أعلاه .
وعلى أيّة حال ، فللغثاء الأحوى منافع كثيرة . . فهو غذاء جيد للحيوانات في الشتاء ، ويستعمل كسماد طبيعي للأرض ، وكذا يستعمله الإنسان كوقود .
فما ذكرته الآيات من صفات : الربوبية ، الأعلى ، الخلق ، التسوية ، التقدير ، الهداية وإخراج المرعى ، توصلنا إلى الربوبية الحقّة للّه جلّ وعلا ، وبقليل من التأمل يتمكن أيّ إنسان من إدراك هذا المعنى ، ليصل نور الإيمان إلى قلبه ، فيشكر المنعم على ما أعطى .
وقوله تعالى : {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى (6) إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَنُيَسِّرُكَ لَليُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى (11) الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الكُبْرَى (12) ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى}
التوفيق الرّباني :
فيما كان الحديث في الآيات السابقة عن ربوبية اللّه وتوحيده جلّ شأنه ، والهداية العامّة للموجودات ، وكذا عن تسبيح الرّب الأعلى . . تأتي الآيات أعلاه لتتحدث عن : القرآن والنّبوّة ، وهداية الإنسان ، وكذا البيان القرآني للتسبيح .
فتقول الآية الاُولى مخاطبة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : {سنقرئك فلا تنسى} .
فلا تتعجل نزول القرآن ، ولا تخف من نسيان آياته ، فالذي أرسلك بهذه الآيات لهداية البشرية كفيل بحفظها ، ويخطها على قلبك الطاهر بما لا يمكن لآفة النسيان من قرض ولو حرف واحد منها أبداً .
وتدخل الآية في سياق الآية (114) من سورة طه : { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } [طه : 114] ، وكذا الآية (16) من سورة القيامة : {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة : 16 ، 17] تدخل في سياقهما .
ولإثبات قدرته سبحانه وتعالى ، وأنّ كلّ خير منه ، تقول الآية : {إلاّ ما شاء اللّه إنّه يعلم الجهر وما يخفى} .
ولا يعني هذا الاستثناء بأنّ النسيان قد أخذ من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وطراً ، وإنّما هو لبيان أنّ قدرة حفظ الآيات هي موهبة منه سبحانه وتعالى ، ومشيئته هي الغالبة أبداً ، وإلاّ لتزعزعت الثقة في قول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وبعبارة اُخرى ، إنّما جاء الاستثناء لتبيان الفرق بين علم اللّه تعالى الذاتي ، وعلم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) المعطى له من بارئه .
والآية تشبه إلى حد ما ما جاء في الآية (108) من سورة هود ، بخصوص خلود أهل الجنّة : { وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ } [هود : 108] .
فـ (خالدين فيها) دليل على عدم خروج أهل الجنّة منها أبداً ، فإذن . . عبارة {إلاّ ما شاء ربّك} تكون إشارة إلى حاكمية الإرادة والقدرة الإلهية ، وارتباط كلّ شيء بمشيئته جلّ وعلا ، سواءً في بداية الوجود أم في البقاء .
وممّا يشهد على ذلك أيضاً . . أنّ حفظ بعض الاُمور ونسيان اُخرى تعتبر حالة طبيعية بين بني آدم ، ولكنّ اللّه تعالى ميزّ حبيبه المصطفى بأن جعل فيه ملكة حفظ جميع آيات القرآن ، والأحكام والمعارف الإسلامية ، حينما خاطبه بـ : {سنقرئك فلا تنسى} .
وقيل : اُريد بهذا الإستثناء تلك الآيات التي نسخ محتواها ونسخت تلاوتها أيضاً .
ولكن لعدم ثبوت وجود هكذا آيات ، فلا يمكننا الإعتماد على هذا القول الآنف أعلاه .
وقيل أيضاً : إنّ الإستثناء يختص بقراءة بعض الآيات ، فعلى هذا يكون مفهوم الآية هو : إنّنا سنقرئك آيات القرآن إلاّ بعض الآيات التي أراد اللّه عزّوجلّ أن تبقى في مخزون علمه . . ولا يتوافق هذا القول مع سياق الآية .
أمّا جملة : {إنّه يعلم الجهر وما يخفى} فلبيان علّة أمر تضمّنته جملة (سنقرئك) ، أي : إنّ العليم جلّ اسمه عالم بجميع حقائق الوجود ، أمّا ما يوحيه إليك ، فهوما يحتاج إليه البشر ، ويصلك بالكامل دون أن ينقص منه شيء .
وقيل أيضاً : إنّ مراد الآية هو : على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا يتعجل في أخذ الوحي ، وأنّ لا يخشى نسيانه ، فاللّه الذي يعلم الاُمور ما خفي منها وما ظهر ، سوف لا يتركه وقد تعهد له بالحفظ .
وعلى أيّة حال ، فمن معاجز النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قابليته على حفظ الآيات والسور الطوال بعد تلاوة واحدة من جبرائيل (عليه السلام) ، دون أنّ ينسى منها شيئاً أبداً .
وتخاطب الآية التالية النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) مسلية له : {ونيسّرك لليسرى} . (2)
أي ، إخبار النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بصعوبة الطريق في كافة محطاته ، من تلقي الوحي وحفظه حتى البلاغ والنشر والتعليم والعمل به ، وتطمئنه بالرعاية والعناية الربانية ، بتذليل صعابه من خلال تيسيرها له (صلى الله عليه وآله وسلم) .
ويمكن كذلك أن تكون إشارة الآية إلى أن طبيعة الرسالة الإسلامية والتكاليف التي تضمّنتها ، طبيعة سهلة وسمحة ، خالية من الحرج والمشقّة .
وهذا المعنى يعطي شمولية أكثر لمفهوم الآية ، بالرغم من أنّ أكثر المفسّرين قد حددوا الآية ببعد واحد من أبعاد مفهومها .
وحقّاً ، فلولا توفيق اللّه وتيسيره للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أمكنه من التغلب على كل تلك المشاكل والصعاب التي واجهته في حياته الرسالية ، وحياته الشريفة تنطق بذلك .
فنراه بسيطاً في لباسه ، قنوعاً في طعامه ، متواضعاً في ركوبه ، وتارة ينام على الفراش واُخرى على التراب بل وعلى رمال الصحراء أيضاً .
فليس في حياته الشريفة أيّ تكلف ، ولا أدنى تشريف من التشريفات الزائفة الواهية المحيطة بزعماء ورؤساء أيّ قوم أواُمّه .
وبعد أن تبيّن الآيات العناية الرّبانية للنّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، تنتقل إلى بيان مهمته الرئيسية : {فذكّر إن نفعت الذكرى} .
قيل : الإشارة هنا إلى أنّ التذكير بحدّ ذاته نافع ، وقليل اُولئك من الذين لا ينتفعون به ، والحد الأدنى للتذكير هو إتمام الحجّة على المنكرين ، وهذا بنفسه نفع عظيم . (3)
ولكن ثمّة من يعتقد أنّ في الآية محذوف ، والتقدير : {فذكّر إن نفعت الذكرى أولم تنفع} ، وهذا يشبه ما جاء في الآية (18) من سورة النحل : {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل : 81] ، فذكر «الحر» وأضمر (البرد) لوضوحه بقرينة المقابلة .
وهناك مَن يؤكّد على أنّ الجملة الشرطية في الآية ، لها مفهوم ، والمراد : أنّه يجب عليك التذكير إذا كان نافعاً ، فإن لم يكن نافعاً فلا يجب .
وقيل : «إن» : ـ في الآية ـ ليست شرطية ، وجاءت بمعنى (قد) للتأكيد والتحقيق ، فيكون مراد الآية : (ذكر فإنّ الذكرى مفيدة ونافعة) .
ويبدو لنا أنّ التّفسير الأوّل مرجح على بقية التّفاسير الثّلاث ، بقرينة سلوك النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في نشره الإسلام ، تبليغه الحق ، فإنّه كان يعظ وينذر الجميع .
وتقسم الآيات التالية النّاس إلى قسمين ، من خلال مواقفهم تجاه الوعظ والإنذار ، الذي مارسه النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . . . : {سيذّكر من يخشى}
نعم ، فإذا ما فقد الإنسان روح «الخشية» ، والخوف ممّا ينبغي أن يخاف منه ، وإذا لم تكن فيه روحية طلب الحق ـ والتي هي من مراتب التقوى ـ فسوف لا تنفع معه المواعظ الإلهية ، ولا حتّى تذكيرات الأنبياء ستنفعه ، على هذا الأساس كان القرآن «هدىً للمتقين» .
وتذكر الآية التالية القسم الثّاني ، بقولها : {ويتجنبها الأشقى} (4) .
وجاء عن ابن عباس ، إنّ الآية السابقة : (سيذّكر من يخشى) نزلت في (عبد اللّه بن اُم مكتوم) (5) ، ذلك البصير المؤمن الذي جاء إلى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طلباً للحق والتبصر به .
وروي ، إنّ الآية : (ويتجنبها الأشقى) نزلت في (الوليد بن المغيرة) و (عتبة بن ربيعة) من رؤوس الشرك والكفر (6) .
وقيل : يراد بالأشقى ، المعاندين للحق بعداء ، فالنّاس على ثلاثة أقسام : إمّا عارف وعالم ، وإمّا متوقف شاك ، أو معاند ، وأفراد الطائفة الاُولى والثّانية ينتفعون من التذكير طبيعياً ، فيما لا ينفع القسم الثّالث منهم ، وليس للتذكير من أثر عليه سوى إتمام الحجّة .
ويُفهم من سياق الآية ، أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ينذر ويعظ حتى المعاندين ، لكنّهم كانوا يتجنبونه ويهربون منه .
يبدو من خلال الآيتين الآنفتي الذكر أنّ «الشقاء» يقابل «الخشية» في حين أنّ (السعادة) هي التي تقابله ، ولعل هذا التقابل يستبطن حقيقة كون أساس سعادة الإنسان مبنية على إحساسه بالمسؤولية وخشيته .
ويعرض لنا القرآن عاقبة القسم الثّاني : {الذي يصلى النّار الكبرى} . . {ثمّ لا يموت فيها ولا يحيى} .
أيّ ، لا يموت ليخلص من العذاب ، ولا يعيش حياةً خالية من العذاب ، فهو أبداً يتقلقل بالعذاب بين الموت والحياة!
ولكن ما هي «النّار الكبرى»؟
قيل : إنّها أسفل طبقة في جهنم ، وأسفل السافلين ، ولِمَ لا يكون ذلك وهم أشقى النّاس وأشدّهم عناداً للحق .
وقيل أيضاً : إنّ وصف تلك النّار بـ «الكبرى» مقابل (النّار الصغرى) في الحياة الدنيا .
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، أنّه قال : «إنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّم ، وقد اُطفئت سبعين مرّة بالماء ثمّ التهبت ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها» (7) .
وفي وصف نسبة بلاء الدنيا إلى بلاء الآخرة ، يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ، في دعاء كميل : «على أنّ ذلك بلاء مكروه قليل مكثه ، يسير بقاؤه ، قصير مدّته . . .» .
وقوله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَيَوةَ الدُّنْيَا (16) وَالأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىْ (17) إِنَّ هَذا لَفِي الصُّحُفِ الاْولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى}
اُسس دعوة الأنبياء جميعاً (عليهم السلام) :
بعد أن عرضت الآيات السابقة صورة العذاب ومعاناة أهله ، يأتي الحديث عن الذين نفعتهم الذكرى ، ممن استمعوا إلى دعوة الهدى فطهروا أنفسهم من المعاصي والآثام ، وخشعت قلوبهم لذكر اللّه . . ويقول القرآن : {قد أفلح مَن تزكّى} .
{وذكر اسم ربّه فصلى} .
فأساس الفلاح بالنجاة من العذاب والفوز بالنعيم الخالد ، يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية : «التزكية» ، «ذكر اسم اللّه» و«الصلاة» .
وقيل في معنى «التزكية» عدّة أقوال :
الاول : تطهير الروح وتزكيتها من الشرك ، بقرينة الآيات السابقة ، وباعتبار أن التطهير من الذنوب وعبادة اللّه ، يعتمد بالأساس على التطهير من الشرك ، فهو مقدمته اللازمة .
الثّاني : تطهير القلب من الرذائل الأخلاقية ، والقيام بالأعمال الصالحة ، بدلالة آيات الفلاح الواردة في كتاب اللّه الكريم ، كالآيات الاُولى من سورة المؤمن التي ذكرت أعمالاً صالحة بعد أن قالت : (قد أفلح المؤمنون) ، وكذا الآية (9) من سورة الشمس التي قالت ، بعد ذكر مسألة التقوى والفجور : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس : 9] .
الثّالث : «زكاة الفطرة» التي تؤدى يوم عيد الفطر ، لأنّها تدفع أوّلاً ثمّ يصلى صلاة العيد ، وهذا المعنى قد ورد في جملة رّوايات ، رويت عن الإمام الصادق (عليه السلام) (8) ، كما وروي في كتب أهل السنة ما يؤيد هذا المعنى نقلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (9) .
ويواجه القول الثّالث بالإشكال التالي : إنّ سورة الأعلى مكيّة ، في حين أن تشريع زكاة الفطرة وصوم شهر رمضان وصلاة العيد قد نزل في المدينة .
فأجاب البعض : لا مانع من اعتبار أوائل آيات السّورة مكّية وأواخرها مدنية ، فتكون الآيات المبحوثة مدنية .
ويحتمل أن يكون التّفسير المذكور من قبيل بيان مصداق واضح للآية ، وليس مطلق مراد الآية .
الرّابع : يراد بـ «التزكية» في الآية بمعنى : إعطاء الصدقة .
المهم أن «التزكية» ذات مداليل واسعة تشمل : تطهير الروح من الشرك ، تطهير الأخلاق من الرذائل ، تطهير الأعمال من المحرمات والرياء ، تطهير الأموال والأبدان بإعطاء الزكاة والصدقات في سبيل اللّه ، {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} .
وبهذا تجمع كلّ الأقوال المذكورة لتدخل في مفهوم التزكية الواسع المداليل .
والجدير بالذكر أنّ الآيات محل البحث تتحدث عن التزكيّة أولاً ، ثمّ ذكر اللّه ثمّ الصلاة .
وقد أشار بعض المفسّرين إلى هذه المراتب ، بعد أن جدولها بالمراحل العملية الثلاثة للمكلف :
الاولى : إزالة العقائد الفاسدة من القلب .
الثّانية : حضور معرفة اللّه وصفاته وأسمائه في القلب .
الثّالثة : الاشتغال بخدمته وفي سبيله جلّ وعلا .
ويمكن القول : إنّ الصلاة فرع لذكر اللّه ، فإذا لم يذكر الإنسان ربّه ، لم يسطع نور الإيمان في قلبه ، وعندها فسوف لن يقوى على الوقوف للصلاة ، والصلاة الحقّة هي تلك التي يصاحبها التوجّه الكامل والحضور التام بين يديه عزّوجلّ وهذان التوجّه والحضور إنّما يحصلان من ذكره سبحانه وتعالى .
أمّا ما ذكره البعض ، من أنّ ذكر اللّه هو قول «اللّه أكبر» أو «بسم اللّه الرحمن الرّحيم» في بداية الصلاة ، فإنّما هو بيان لأحد مصاديق الذكر ليس إلاّ .
ويشير البيان القرآني إلى العامل الأساس في عملية الإنحراف عن جادة الفلاح : {بل تؤثرون الحياة الدنيا} . . {والآخرة خير وأبقى} .
ونقل الحديث النّبوي الشريف هذا المعنى ، بقوله : «حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة» . (10)
فالإنسان العاقل لا يجيز لنفسه أن يبيع الدار الباقية بأمتعة فانية ، ولا أن يستبدل اللذائذ المحدودة والمحفوفة بألوان الآلآم بالنعم الخالدة والنقية الخالصة .
وتختم السّورة بـ : (إنّ هذا لفي الصحف الاُولى) . . (صحف إبراهيم وموسى) . (11)
ولكن ، ما المشار إليه بـ «هذا» ؟
فبعض قال : إنّه إشارة إلى الأمر بالتزكية وذكر اسم اللّه والصلاة وعدم إيثار الحياة الدنيا على الآخرة .
وذلك من أهم تعاليم جميع الأنبياء (عليهم السلام) ، كما وورد هذا الأمر في جميع الكتب السماوية .
واعتبره آخرون : إنّه إشارة لجميع ما جاء في السّورة ، حيث أنّها ابتدأت بالتوحيد مروراً بالنبوة حتى ختمت بالأعمال .
وعلى أيّة حال ، فهذا التعبير يبيّن أهميّة محتوى السّورة ، أو خصوص الآيات الأخيرة منها ، حيث اعتبرها من الاُصول الأساسية للأديان ، وممّا حمله جميع الأنبياء (عليهم السلام) إلى البشرية كافة .
«الصحف» : جمع و (صحيفة) ، وهي اللوح الذي يكتب عليه .
ونستدل بالآية الأخيرة بأنّ لإبراهيم وموسى (عليهما السلام) كتباً سماوية .
وروي عن أبي ذر (رضي الله عنه) ، إنّه قال : قلت يارسول اللّه ، كم الأنبياء ؟
فقال : «مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفاً» .
قلت : يارسول اللّه ، كم المرسلون منهم ؟
قال : «ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وبقيتهم أنبياء» .
قلت : كان آدم (عليه السلام) نبيّاً؟
قال : «نعم ، كلمة اللّه وخلقه بيده . . يا أباذر ، أربعة من الأنبياء عرب : هود وصالح وشعيب ونبيّك» . قلت : يارسول اللّه ، كم أنزل اللّه من كتاب ؟
قال : «مائة واربعة كتب ، أنزل اللّه منها على آدم (عليه السلام) عشر صحف ، وعلى شيث خمسين صحيفة ، وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة ، وهو أوّل من خط بالقلم ، وعلى إبراهيم عشر صحائف ، والتوراة والإنجيل والزّبور والفرقان» (12) . (اُنزلت على موسى وعيسى وداود ومحمّد على نبيّنا وآله وعليهم السلام) .
و«الصحف الاُولى» : مقابل «الصحف الأخيرة» التي اُنزلت على المسيح (عليه السلام) وعلى النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) .
___________________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج15 ، ص253-267 .
2 ـ قال بعض المفسّرين : إنّ مفهوم الآية هو : «نيسّر اليسرى لك» ، وإنّما حصل فيها التقديم والتأخير للتأكيد ، وهذا على أن لا تكون «نيسرك» بمعنى (نوفقك) ، وإلاّ لم تكن هناك حاجة للتقديم والتأخير .
3 ـ وما في الآية بخلاف ما جاء في الآية (6) من سورة البقرة : {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } [البقرة : 6] ، لأنّها تختص بفئة قليلة من النّاس ، وإلاّ فأكثر النّاس يتأثرون بالبلاغ المبين ، وإن كانوا بدرجات متفاوتة ، وعليه . . فالجملة الشرطية في الآية المبحوثة من قبيل القيد بالغالب الأعم .
4 ـ يعود ضمير «يتجنبها» على «الذكرى» الواردة في الآيات السابقة .
5 ـ تفسير القرطبي ، ج10 ، ص7110 .
6 ـ تفسير الكشّاف; روح المعاني (في ذيل الآيات المبحوثة) .
7 ـ بحار الانوار ، ج8 : ص288 ، الحديث 21 .
8 ـ نور الثقلين ، ج5 ، ص556 ، الحديثين (19 و20) .
9 ـ روح المعاني ، ج30 ، ص110 ، وتفسير الكشّاف ، ج4 ، ص740 .
10 ـ وروي الحديث بصور عدّة عن الإمام الصادق (عليه السلام) والإمام السجاد (عليه السلام) ، وورد معنى الحديث عن الأنبياء (عليهم السلام) أيضاً ، ممّا يشير إلى أهميته البالغة .
11 ـ يمكن أن تكون «صحف إبراهيم وموسى» توضيحاً للصحف الاُولى ، كما ويمكن أن تكون إشارة لأحد مصاديق الصحف ، وإلاّ فهي تشمل جميع كتب الأنبياء السابقين .
12 ـ مجمع البيان ، ج10 ، ص746 .

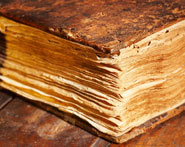
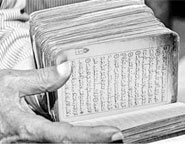
|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|