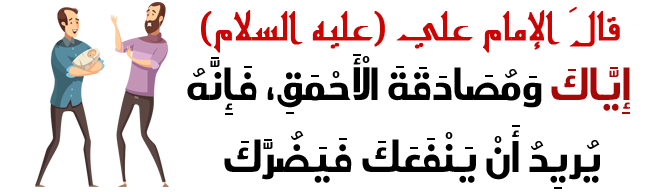
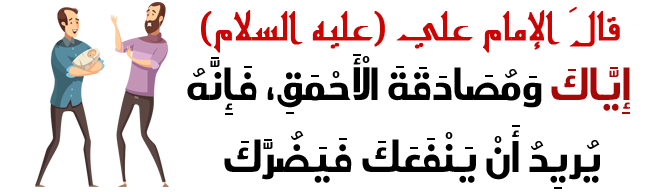

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-11-2014
التاريخ: 19-09-2014
التاريخ: 5-11-2014
التاريخ: 5-11-2014
|
هو عند الجمهور : التعبير عنه بطريق من الطرق الثلاثة ( التكلّم والخطاب والغيبة ) بعد التعبير عنه بطريق آخر منها ، وعمّمه السكاكي إلى كل تعبير وقع فيما حقّه التعبير بغيره ، حسب ظاهر السياق ، كالتعبير بالماضي في موضع كان حقّه الاستقبال أو الحال ، أو وضع المضمر موضع المظهر أو العكس ، ونحو ذلك ممّا يتحوّل وجه الكلام فجأةً على خلاف السياق (1) .
وفائدته العامّة هي تطرية نشاط السامع وصيانته عن المَلل والسآمة ؛ لِما جُبلت النفوس على حبّ الانتقال وتصريف الأحوال ، فتملّ من الاستمرار على منوال واحد من وجه الكلام ... هذه هي فائدته العامّة السارية في جميع موارده ، وتختصّ مواضعه ، كلّ بنكتة وظريفة زائدة ، يحلو بها البيان وتهشّ إليها النفوس وتستلذّها .
قال الزمخشري : وذلك على عادة افتنان العرب في كلامهم وتصرّفهم فيه ؛ ولأنّ الكلام إذا نُقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ، وإيقاظاً للإصغاء إليه ، من إجرائه على أسلوب واحد ، وقد تختصّ مواقعه بفوائد (2) .
وتنظّر ابن الأثير في هذا التبرير ، قال : لأنّ الانتقال في الكلام إذا كان لأجل تطرية نشاط السامع فإنّ ذلك يدلّ على أنّه يملّ من أسلوبه فيضطرّ إلى الانتقال إلى غيره ليجد نشاطاً للاستماع . وهذا قدح في الكلام لا وصف له ؛ إذ لو كان حسناً لَما مُلّ ، على أن هذا لو سُلّم لكان في مطنب مطولّ ، لا في مثل الالتفاتات الواقعة في تعابير موجزة وآيات قصيرة من الذكر الحكيم .
فلعلّ المقصود : هو مجرّد الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ، ليكون نفس هذا هو المطلوب لا الانتقال إلى الأحسن ، الأمر الذي ليس يذهب على مثل الزمخشري العارف بفنون الفصاحة والبلاغة .
قال : والوجه عندي أنّ الانتقال لا يكون إلاّ لفائدة اقتضته ، وتلك الفائدة أمرٌ وراء الانتقال ، وهي لا تُحدّ بحدّ ، ولا تُضبط بضابط ، لكن يُشار إلى مواضع منها ، ليُقاس عليها غيرها ، فإنّا قد رأينا الانتقال من الغَيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطب ، ثمّ رأينا ذلك بعينه ـ وهو ضدّ الأَوّل ـ قد استعمل في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ، فعلمنا أنّ الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة ، وإنّما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود ، وذلك المعنى يتشعّب شُعباً كثيرةً لا تنحصر ، وإنّما يُؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه (3) .
ثمّ جعل يوضّح حقيقة ما في هذا الباب بضرب الأمثلة التالية :
فأمّا الرجوع من الغيبة إلى الخطاب فكقوله تعالى ـ في سورة الفاتحة ـ : { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } [الفاتحة : 5 - 7].
هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب ، وممّا يختصّ به هذا الكلام من الفوائد قوله : ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) بعد قوله : ( اَلْحَمْدُ للّهِِ رَبّ الْعالَمِينَ ) ، فإنّه إنّما عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب لأنّ الحمد دون العبادة ، ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده ! فلمّا كانت الحال كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسّطه مع الغيبة في الخبر ، فقال : ( اَلْحَمْدُ للّهِِ ) ، ولم يقل : الحمد لك ، ولمّا صار إلى العبادة ـ التي هي أقصى الطاعات ـ قال : ( إِيّاكَ نَعْبُدُ ) فخاطب بالعبادة إصراحاً بها ، وتقرّباً منه عزّ اسمه بالانتهاء إلى محدود منها .
وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة ، فقال : ( صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) فأصرح موضع التقرّب من الله بذكر نِعمه ، فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضب ، فأسند النعمة إليه لفظاً ، وزوى عنه لفظ الغضب تحنّناً ولطفاً .
فانظر إلى هذا الموضع وتناسب هذه المعاني الشريفة التي الأقدام لا تكاد تطأها ، والأفهام مع قُربها صافحة عنها .
وهذه السورة قد انتقل في أَوّلها من الغيبة إلى الخطاب لتعظيم شأن المخاطب .
ثمّ انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغيبة لتلك العلّة بعينها ، وهي تعظيم شأن المخاطب أيضاً ؛ لأنّ مخاطبة المولى تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيمٌ لخطابه ، وكذلك ترك مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيمٌ لخطابه .
فينبغي أن يكون صاحب هذا الفنّ من الفصاحة والبلاغة عالماً بوضع أنواعه في مواضعها على اشتباهها .
ومن هذا الضرب قوله تعالى : {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا} [مريم : 88، 89](4).
وإنّما قيل : ( لّقَدْ جِئْتُمْ ) وهو خطاب للحاضر ، بعد قوله : ( وَقَالُوا ... ) وهو خطاب للغائب ، لفائدة لطيفة ، وهي زيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله سبحانه ، والتعرّض لسخطه ، وتنبيه لهم على عظم ما قالوه ، كأنّه يُخاطب قوماً حاضرين بين يديه صاغرين منكراً عليهم وموبخاً لهم .
ومن هذا الباب قوله تعالى : {أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ } [الأنعام : 6] ، فبدأ بالغيبة ( أَلَمْ يَرَوْا ... ) وختم بالخطاب ( نُمَكّن لَكُمْ ) ، قيل : لنكتة هي : حثّ السامع وبعثه على الاستماع ، حيث أقبل المتكلّم عليه ، وأعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواجهة .
ومنه أيضاً قوله تعالى : {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً} [الإنسان : 21، 22] ، فهو تشريفٌ لمقامهم بالحضور لديه ، وتفخيمٌ لشأنهم .
ومنه : {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب : 50].
وهذا الالتفات هنا كان لأجل تخصيص الحكم بشخصه ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلا يعمّ المسلمين ، فيما لو توهّم متوهّم أنّ ذكره كان للتمثيل لا للتخصيص .
وهذا نظير ما قالوه بشأن آية الإسراء (5) من أنّ الوجه في العدول من الغيبة إلى خطاب النفس كان ؛ لتخصيص القدرة ، وأنّه غير مستطاع لغيره تعالى ، وهكذا هنا ، إرادة لتخصيص هذا الحكم بالنبي ( صلّى الله عليه وآله ) دون غيره .
وممّا جاء من الالتفات مراراً على قصر متنه وتقارب طرفيه قوله تعالى : ( سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ ) .
فقال أولاً : ( سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى ) بلفظ الواحد ، ثمّ قال : ( الّذِي بَارَكْنَا ) بلفظ الجمع ، ثمّ قال : ( إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ ) وهو خطاب غائب ، ولو جاء الكلام على مساق الأَوّل لكان : سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته إنه هو السميع البصير ، وهذا جميعه يكون معطوفاً على ( أسرى ) ، فلمّا خولف بين المعطوف والمعطوف عليه في الانتقال من صيغة إلى صيغة كان ذلك اتّساعاً وتفنّناً في أساليب الكلام ، ولمقصد آخر معنوي هو أعلى وأبلغ .
وقد أسهب أبن الأثير الكلام هنا وأبدع وأجاد ، فالنتتبّع مقاله :
قال : وسأذكر ما سنح لي في هذه الآية الكريمة :
لمّا بدأ الكلام بـ ( سبحان ) ردفه بقوله : ( الذي أسرى ) ؛ إذ لا يجوز أن يقال : الذي أسرينا . فلمّا جاء بلفظ الواحد ـ والله تعالى أعظم العظماء ، وهو أَولى بخطاب العظيم في نفسه الذي هو بلفظ الجمع ـ استدرك الأَول بالثاني ، فقال : ( باركنا ) ، ثمّ قال : ( إنّه هو ) عطفاً على ( أسرى ) ، وذلك موضع متوسّط الصفة ؛ لأنّ السمع والبصر صفتان يشاركه فيهما غيره ، وتلك حال متوسطة ، فخرج بهما عن خطاب العظيم في نفس إلى خطاب غائب .
فانظر إلى هذه الالتفاتات المترادفة في هذه الآية الواحدة ، التي جاءت لمعانٍ اختصّت بها ، يعرفها ممَن يعرفها ، ويجهلها مَن يجهلها (6) .
وممّا ينخرط في هذا السلك ، الرجوع من خطاب الغيبة إلى خطاب النفس ، كقوله تعالى : {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } [فصلت : 11-12] .
والفائدة في هذا العدول : أنّ طائفة من الناس غير المتشرعين كانوا يعتقدون أنّ النجوم ليست في سماء الدنيا ، وأنّها ليست حفظاً ورجوماً ، فلمّا صار الكلام إلى هنا عدل إلى خطاب النفس ؛ لأنّه مهمّ من المهمّات ، فناسبه التعزيز بالاستناد إلى النفس ـ وهو القادر الحكيم ـ ومِن ثَمّ عاد إلى الوصف بالعزّة والعلم توكيداً .
وأيضاً ممّا ينخرط في هذا السلك العدول من خطاب النفس إلى خطاب الجماعة ، كقوله تعالى : {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس : 22] .
وإنّما صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى خطابهم ؛ لأنّه أبرز الكلام لهم في معرض المناصحة وهو يريد مناصحتهم ليتلطّف بهم ويداريهم ؛ لأنّ ذلك أدخل في إمحاض النصح ، حيث لا يريد لهم إلاّ ما يريد لنفسه ، فقد وضع ( وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ ... ) مكان : وما لكم لا تعبدون الذي فطركم . بدليل ( وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) ، ولولا ذلك لقال : وإليه أرجع ، وقد ساق الكلام ذلك المساق البديع إلى أن قال : {إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ} [يس : 25] .
فانظر أيّها المتأمّل إلى هذه النكت الدقيقة التي تمرّ عليها في آيات الذكر الحكيم ، وأنت تظنّ أنّك فهمت فحواها ، واستنبطت مغزاها .
وعلى هذا الأُسلوب يجري الحكم في الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد كقوله تعالى : {حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [الدخان : 1 - 6] .
وفائدة العدول في قوله ( رَحْمَةً مِن رَبّكَ ) هو تخصيص النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بالذكر ، وأنّه المقصود بالذات من هذا النزول .
قال (7) : وإذا تأمّلت مطاوي القرآن الكريم وجدت فيه مِن هذا وأمثاله الشيء الكثير ، وإنّما اقتصرنا على هذه الأمثلة المختصرة ليقاس عليها ما يجري على أُسلوبها ، فيتدبّر المتدبّرون .
وأمّا الرجوع من الخطاب إلى الغيبة ، فكقوله تعالى : {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [يونس : 22، 23].
انظر إلى هذا الكرّ والفرّ ، والاستطراد والرجوع ، والمداورة العجيبة في الكلام ، فقد بدأ الحديث بخطاب الجمع ، وعاد إلى الغيبة في فصل طويل ، ورجع أخيراً إلى ما بدأ به أَولاً ، ولكن في صورة أعمّ وأشمل ، فكأنّما الناس جميعاً هم الحضور المخاطبون بهذا الكلام العام .
قال ابن الأثير : إنّما صرف الكلام هاهنا من الخطاب إلى الغيبة بهذا الشكل البديع لفائدة كبرى ، هي : أنّه ذكر لغيرهم حالهم ؛ ليعجّبهم منها كالمخبر لهم ، ويستدعي منهم الإنكار عليهم ، ولو قال : حتى إذا كنتم في الفلك وجَرين بكم ... الخ ، وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها خطاب الغيبة ، وليس ذلك بخافٍ على نَقَدة الكلام (8) .
وممّا ينحو هذا النحو قوله تعالى : ( إِنّ هذِهِ أُمّتُكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ) ويستمرّ الحديث عنهم بخطاب الغيبة ، وينتهي إلى قوله : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} [الأنبياء : 98] .
الأصل في ( تقطّعوا ) تقطّعتم ، إلاّ أنّه صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات ، كأنّه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين ، ويقبّح عنهم ما فعلوه ، ويقول لهم : أَلا تَرون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله ، فجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً ! وذلك تمثيل لحالة اختلافهم في الدين ، وتباينهم في معرفة الصلاح من الفساد ، ثمّ توعّدهم أخيراً بأنّ المرجع إليه ، وسوف يجازيهم على أعمالهم ، وهو شديد العقاب .
وممّا يجري هذا المجرى قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [الأعراف : 158] .
فإنّه إنّما قال : ( فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ... ) ولم يقل : فآمنوا بالله و بي ... لكي يمكن إجراء الصفات عليه ؛ تنبيهاً على أنّ الذي يجب اتّباعه هو هذا الإنسان المتّصف بهكذا صفات تؤهّله للإمامة وحمل رسالة الله إلى الناس ... إظهاراً للنَّصفة ، وبُعداً من تهمة التعصّب للنفس ... فقرّر أولاً في صدر الآية أنّه رسول الله إلى الناس .
ثمّ أخرج كلامه من الخطاب إلى معرض الغيبة لغرضين ، الأول : إمكان إجراء تلك الصفات عليه .
الثاني : الخروج من تهمة حبّ الذات ؛ لئلاّ يكون ممَّن يجرّ النار إلى قرصه ، وهذا من لطيف البيان في المداراة مع العامّة .
ونوع آخر من الالتفات ، ما يكون الانتقال فيه من الفعل المستقبل أو الماضي إلى فعل الأمر ، وهذا يدخل في الحدّ الذي ذكره السكاكي : كل تعبير وقع على خلاف مقتضى السياق إذا كان لنكتة بيانية .
قال ابن الأثير : وهذا القسم كالذي قبله في أنّه ليس العدول فيه من صيغة إلى أُخرى طلباً للتوسّع ولمجرّد التفنّن في أساليب الكلام فقط ، بل لأمرٍ وراء ذلك ، وسرٍّ كامنٍ خلفه ، فقد يقصد ذلك تعظيماً لشأن مَن أجرى عليه الفعل المستقبل وتفخيماً لأمره ، وبالضدّ من ذلك في أجرى عليه فعل الأمر .
فممّا جاء منه قوله تعالى : {قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ } [هود : 53-54] .
لم يقل : اشهد الله وأُشهدكم ، وإنّما عدل إلى صيغة الأمر ؛ تهاوناً بهم ، فلا يتوازنوا مع الله في شهادة صدق على البراءة .
ومنه العدول عن الماضي إلى الاستقبال أو العكس ، كقوله تعالى : {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ} [فاطر : 9] ، فقوله : ( تثير ) مسبوق وملحوق بالفعل الماضي ؛ اهتماماً بشأنه ، إرادة لاستحضار تلك الصورة البديعة الدالّة على القدرة الباهرة ، وهي حكاية الحال التي يقع فيها إثارة الرياح للسحب ، وهكذا يفعل بكلّ أمر فيه ميزة واختصاص ، كحال تُستَغرب أو تُهِمّ المخاطب أو غير ذلك .
قال ابن الأثير : العدول عن صيغة إلى أُخرى لا يكون إلاّ لنوع خصوصية اقتضت ذلك ، ولا يتوخّاه إلاّ العارف برموز الفصاحة وأسرار البلاغة ، وليس يوجد ذلك في كل كلام ، فإنّه من أشكل ضروب علم البيان وأدقّها فهماً وأغمضها طريقاً (9) .
ونظير الآية قوله : {فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج : 31] فهو لاستحضار صورة خطف الطير إيّاه أو هويّ الريح به ، وللآية تصوير فنّيّ رائع تكلّمنا عنه .
وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الحج : 25] لم يقل : وصدّوا... ؛ لأنّ كفرهم كان سابقاً ، وإنّما المتجدّد هو الصدّ عن سبيل الله ، ولا يزال مستمراً .
ومثلها قوله : {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج : 63] ؛ لأنّ نزول المطر ينقطع أمّا الاخضرار فيبقى مدّة .
وقد عكس ذلك في قوله : {وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ } [النمل : 87] فالعدول إلى الماضي للدلالة على التحقّق وأنّه كائن لا محالة ، ومثلها قوله : {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف : 47] .
وبجري هذا المجرى الإخبار عن المستقبل باسم المفعول ، كما في قوله تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ} [هود : 103] .
لأنّ اسم المفعول يتضمّن معنى الفعل الماضي الدالّ على التحقّق والوقوع لا محالة ، فإنّه إنّما آثر اسم المفعول الذي هو ( مجموعٌ ) على الفعل المستقبل الذي هو ( يجمع ) ؛ لِما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم ، وأنّه الموصوف بهذه الصفة ، قال ابن الأثير : وان شئت فوازِنْ بينه وبين قوله تعالى : {يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ} [التغابن : 9] فإنّك تعثر على صحّة ما قلت (10) .
ونوع آخر من الالتفات ، هو أشبه بباب ( الاستطراد ) بان يشرع المتكلّم في نوع من الكلام ويستمرّ عليه ، ثمّ يخرج إلى غيره ، وأخيراً يعود إلى ما كان عليه .
فلنسمّيه ( مداورة الكلام ) ، وهو من لطيف التفنّن في التعبير ، كمَن يطارد صيداً فيعنّ له آخر فيطرده ، ثمّ يرجع إلى الأسبق وهكذا ، وقد ذكره بعضهم باسم ( الاعتراض ) و( الاستدراك ) . وعلى أيّة حال فإنّه من تداخل الفنون الجميلة ومجمع أنحاء الجمال .
ومثّلوا له بقوله تعالى : {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ} [البقرة : 24].
فقوله : ( وَلَنْ تَفْعَلُوا ) استدراكٌ جميل ، وتيئيسٌ لطيف ، وتبكيتٌ قاطع ، فلله درّه من التفات بديع .
قال قدامة بن جعفر الكاتب (11) : أراد تعالى أن يُضمّن آية التحدّي ضرباً آخر من الإعجاز بأخباره عن عجز مطبق عن إمكان معارضته مع الأبد ، ليكون جريان هذا الخبر الصادق على لسانه نبيّه ، حتى إذا وقع كان عَلَماً على صدقه ، فردّ المكذّبين ، وثبّت المؤمنين ، فقال : ( وَلَنْ تَفْعَلُوا ) قبل أن يتمّ الكلام الأَوّل . وكان يمكنه تأخير هذه الجملة ... لكن لهذا التقديم تأثير بليغ في النظم ، يجعل له في القلوب من الجلالة والتفخيم والرونق ما لا يعبّر عنه ، ولا يُعرف لذلك سبب ظاهر إلاّ وقوع تجنيس الازدواج بقوله : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ) نظير قوله : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ } [البقرة : 194] ، لكنّه في المعنى كان لهذا التقديم سبب أقوى ، هي زيادة عَلَم من أعلام النبوّة ، كانت مراعاة على الموعظة بقوله : { فَاتَّقُوا النَّارَ} [البقرة : 24] (12) .
ونظيره قوله تعالى : {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ } [الأعراف : 26].
فقوله : ( وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ) جملة معترضة أفادت تذكيراً بملازمة التقوى التي هي خير لباس الصلاح ، ثمّ يعود الكلام إلى ما قبله .
قال قدامة بن جعفر : لمّا امتنّ سبحانه على البشر بما أنزل عليهم من اللباس وسهّل عليهم أمره ـ في سياق قصة أبيهم آدم ( عليه السلام ) ـ أراد تذكيرهم بملازمة لباس التقوى ، وكان يمكنه التأخير ، لكن ليحصل نوع من محاسن البديع ، كما في قول الشاعر :
قالوا اقترح شيئاً نَجدْ لكَ طبخَه قلتُ اطبخوا لي جُبّةً وقميصا
ففيه ( المشاكلة ) و( التجنيس ) بكلا قسميه ( جناس المزاوجة ) و( جناس المناسبة ) على ما شرحه القوم (13) .
قال ابن أبي الإصبع : وجاء في الكتاب العزيز من الالتفات قسم غريب جداً ـ لم أظفر في سائر الكلام له بمثال ، هداني الله إلى العثور عليه ـ وهو : أن يُقدّم المتكلم في كلامه حديثاً عن أمرين يتعاقبان ، ثمّ يُخبر عن الأَوّل منهما بشيء ، وينصرف عنه إلى الإخبار عن الثاني ، ثمّ يعود إلى الإخبار عن الأوّل ، كقوله تعالى : ( إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) . انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربّه تعالى ، ثمّ انصرف عنه وأخبر عن الإنسان ثانياً {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات : 8] قال : وهذا يَحسن أن يُسمّى ( التفات الضمائر ) (14) .
قلت : هذا من مداورة الكلام وردّ العجز على الصدر أيضاً ، الأمر الذي يحصل به بين أطراف الكلام ملاءمة وتلاحم وائتلاف ، وهو من لطيف الكلام .
والآية إنّما تصلح مثالاً لذلك ، بناءً على عود الضمير في ( إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) على ( ربّه ) وهو أحد القولين (15) .
ذكر التنوخي (16) وغيره : أنّ من الالتفات نقل الخطاب من الواحد إلى الاثنين أو الجمع والعكس ، كقوله تعالى : {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ} [يونس : 78] ، ولا شكّ أنّ الخطاب كان مع موسى ( عليه السلام ) ولكن هارون كان عضده ووزيره فكان المتّهم في الاستحواذ على سلطة البلاد ـ في نظرهم ـ هما معاً .
وقوله : {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} [طه : 117] ، وقد مرّ أنّ العدول إلى الإفراد كان لأجل ؛ مراعاة الفاصلة أَوّلاً ، وثانياً لأنّ الذي يقع في المشقّة من الزوجين هو الزوج بالذات .
وقوله : {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} [يونس : 87] كان المخاطب والمسؤول الأَوّل بهذا التكليف هو موسى وهارون ( عليهما السلام ) غير أنّ الذي يجب عليه استقبال البيوت في الصلاة هم بنو إسرائيل كافة ومِن ثَمّ هذا العدول .
وأمثال هذه الدقائق ـ في كتاب الله العزيز الحميد ـ كثير ، وإنّما يبلغها العرّافون من أهل النظر والتحقيق ، وقليلٌ مّا هم .
_______________________
(1) أنوار الربيع : ج 1 ص 362 ، والمثل السائر لابن الأثير ج 2 ص 171 .
(2) تفسير الكشّاف : ج 1 ص 14 .
(3) المَثل السائر : ج 2 ص 173 .
(4) والإدّ : الأَمر المنكر المثير للجلبة ، من قولهم : أدّت الناقة إذا رجّعت حنينها ترجيعاً شديداً ، والأديد : الجَلبة .
(5) قوله : ( سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ـ إلى قوله ـ لِنُرِيَهُ ... ) انتقالاً من الغيبة إلى التكلّم عن النفس .
(6) المَثل السائر : ج2 ص176 .
(7) ابن الأثير في المثل السائر : ج2 ص178 .
(8) المَثل السائر : ج2 ص181 .
(9) المَثل السائر : ج2 ص184 .
(10) المَثل السائر : ج2 ص191 .
(11) تُوفي سنة 337 كان يُضرب به المثل في البلاغة .
(12) بديع القرآن : ص43 .
(13) بديع القرآن : ص37 و44 . وراجع المطوّل للتفتازاني : ص422 .
(14) بديع القرآن : ص45 . مع تصرف وصحّحناه على معترك الأقران : ج1 ص383 .
(15) راجع الكشّاف : ج4 ص788 .
(16) هو القاضي أبو القاسم علي بن محمّد الأنطاكي ( 278 ـ 342 ) كان من أعيان فضلاء عصره عظيماً واسع الأدب حسن الفصاحة ، وكانوا يعدّونه ريحانة الندماء وتاريخ الظرفاء .



|
|
|
|
دواء جديد يعطي الأمل لمرضى الانزلاق الغضروفي
|
|
|
|
|
|
|
آلة زمن للمستقبل.."ميتا" تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز
|
|
|
|
|
|
|
العلاقات العامّة والمجمع العلمي يقيمان محفلًا للمدارس القرآنية من محافظتي النجف والمثنى
|
|
|