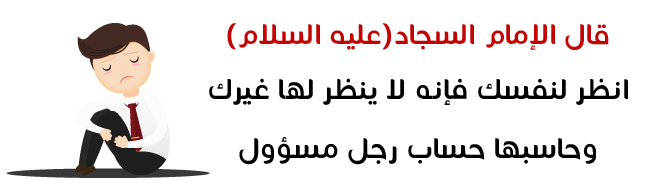
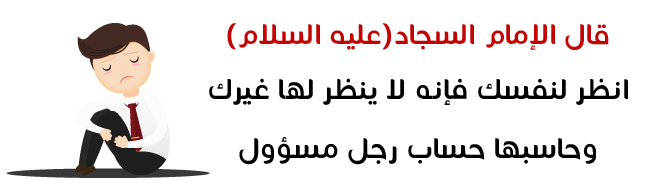

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-19
التاريخ: 2024-09-21
التاريخ: 2024-09-07
التاريخ: 2024-09-08
|
المدرسة الوظيفية: على الرغم من اختلاف المدرسة الوظيفية عن المدرسة البنيوية في كثير من القضايا فإنها مثلها في ذلك مثل المدرسة التوليدية تمثل اتجاها متفرعا عن البنيوية ولذا فإن بعض اللسانيين يرون أن البنيوية هي الإطار العام الذي يشمل معظم - إن لم يكن كل - الاتجاهات التي ظهرت في القرن العشرين. وتتميز المدرسة الوظيفية من غيرها من المدارس اللسانية باعتقادها أن البني الصباتية والقواعدية والدلالية محكومة بالوظائف التي تؤديها في المجتمعات التي تعمل فيها (1) وفي ذلك خروج عن المبدأ الواضح الذي أرساه دو سوسور وتبعه في ذلك البنيويون من أن البنى اللغوية ينبغي أن تدرس في حد ذاتها بغض النظر عن العناصر الخارجة عن اللغة بوصفها نظاما مجردا مستقلا، وتتلخص وجهة النظر الوظيفية في صعوبة الفصل بين البنية اللغوية والسياق الذي تعمل فيه والوظيفة التي تؤديها تلك البنية في السياق.وتعد مدرسة براغ Prague School أفضل من يمثل الاتجاه الوظيفي في دراسة اللغة، وقد نشأت هذه المدرسة في أحضان حلقة براغ اللسانية Prague Linguistic Circle التي أسسها اللساني التشيكي فاليم ماثيوس )Vilem Mathesius 1882 – 1945) . ولم تقتصر المدرسة الوظيفية في عضويتها على اللسانيين المقيمين في براغ فقط بل شملت أيضا غيرهم ممن يقيمون في بقاع أخرى، وكانوا يشاركون المدرسة أصولها وأفكارها الأساسية. وبعد وفاة ماثيوس قام لسانيون آخرون أبرزهم بيتر سغال Petr gall ، وإيفا ماجيكوفا Eva Hajicova اللذان حافظا على مدرسة براغ في أحلك الظروف التي مرت بها إبان الحكم الشيوعي، وقد نجحا في إحياء حلقة براغ اللسانية رسميا في نوفمبر 1992 بعد سقوط الشيوعية بثلاث سنوات(2)اشتهر مؤسس المدرسة ماثيوس بما يعرف بالنظرة الوظيفية للجملة، وهي التي سنناقشها في الفقرة التالية.
1.3.2.3- النظرة الوظيفية للجملة:
تعد النظرة الوظيفية للجملة...امتداد للمناقشة التقليدية الحامية التي كانت تحدث في نهاية القرن التاسع عشر حول ثنائية الموضوع .....والمحمول .........وكان لأستاذ الفلسفة في براغ أنتون مارتي.......الذي كانت أفكاره مؤثرة في نشأة مدرسة براغ نشاط بارز في هذه المناقشة وقد عبر ماثيوس عن أفكاره في شكل ثنائيات متمايزة تتعلق بالطرفين الأساسيين للجملة وتأثير كيفية ترتيبهما في الوظيفة التي تؤديها الجملة وهذه الثنائيات هي ثنائية الموضوع.........والتعليق .....أو البؤرة ......وثنائية المتقدم ........والمتأخر .........وثنائية المسلمة ......والاضافة .......فالمتقدم هو الشيء المتحدث عنه الذي يفترض المتكلم معرفة المخاطب له والمتأخر هو الجزء المتمم للجملة الذي يضيف الى معلومات المخاطب السابقة معلومات جديدة تتصل بالمتقدم والمسلمة هي ما يقدمه المتكلم من معلومات يدركها السامع من مصدر ما في المحيط ( أي المقام أو النص السابق) والاضافة ما يقدمه المتكلم من معلومات لايدركها السامع من مصادر أخرى (3) ففي الجملتين : 1- مؤسس الدولة الاموية هو معاوية بن أبي سفيان 2- معاوية بن أبي سفيان هو مؤسس الدولة الاموية نجد أن المعنى الاسنادي ( أو النسبة الخارجية كما يقول المناطقة والبلاغون) واحد فيهما إذ كلاهما يفيد أن تأسيس الدولة الاموية كان على يد معاوية بن أبي سفيان وبناء على ذلك فهما مترادفان تقريبا ولكن من الواضح أنهما يستعملان في سياقيين مختلفين واختلاف السياقين يفسر بما يعتقده المتكلم بشأن ما يعرفه المخاطب حول موضوع الجملتين، فكل جملة من الجملتين تفترض أن أحد الطرفين يعرفه المخاطب، وهو معاوية بن أبي سفيان في الجملة الأولى، وتأسيس الدولة الأموية في الثانية، وأن الطرف الثاني غير معروف، وهو من أسس الدولة الأموية في الجملة الأولى؟، ومن هو معاوية بن أبي سفيان في الجملة الثانية؟ فالمعلومات التي يفترض المتكلم أن المخاطب يعرفها تسمى مسلمة given information والمعلومات التي يضيفها تسمى إضافة، أو معلومة جديدة new information. وكما هو واضح فإن بنية كل جملة من الجملتين السابقتين محكوم بالوظيفة التي يريد المتكلم أن يؤديها خطابه، ففي كانت الوظيفة (أي الغرض الإبلاغي) هي الإعلام بمن أسس الدولة الأموية، وفي كانت الوظيفة . التعريف بمعاوية بن أبي سفيان إن الفرق الأساسي في معالجة البنيويين والوظيفيين لهذه الجملة يتمثل في أن البنيويين يصفونها كما . في حين أن الوظيفيين يتساءلون عن هي سبب كونها كذلك ؛ أي إن البنيويين يحاولون الإجابة عن كيف، أو ماذا وأن الوظيفيين يحاولون الإجابة عن لماذا. وتختلف اللغات في مدى حرية المتكلم في ترتيب المسند إليه، والمسند، فبينما تتيح العربية مثلا احتمالات مختلفة بسبب وجود قرينة الإعراب التي بها نستطيع أن نميز المعلومات المسلمة من المعلومات الجديدة، تعد الإنجليزية من اللغات التي تكون فيها الرتبة مقيدة إلى حد كبير؛ ولذا فهي تلجأ إلى قرينة التنغيم أكثر من غيرها في تحديد المعلومات المسلمة والمعلومات الجديدة، وقد تلجأ أيضا إلى استخدام صيغة المجهول الذي تتضمن الأداة by كما في. The rat was eaten by the catوهو الأسلوب الذي يترجم خطا في العربية بـ الجرد أكل من قبل القط، وترجمته الصحيحة هي الجرذ أكله القط لأن هذه الترجمة تؤدي الوظيفة أو الغرض البلاغي) التي يقصدها المتكلم، وهي إظهار العناية بالجرذ، وليس بالقط لأنه هو موضوع الحديث، وفي الوقت ذاته تحافظ على البنية المألوفة في العربية دون اللجوء الى بنية غربية مستوردة ( وهي من قبل في السياق المذكور). وإضافة الى الاعراب تؤدي قرينة المطابقة في اللغة العربية وكذلك اللغة التشيكية مهمة التمييز بين الفاعل والمفعول وهو مايتيح للمتكلم اختيار من يقدم أولا الفاعل أو المفعول حتى عند غياب قرينة الاعراب وذلك كما في المثال الآتي: ضربت عيسى يسرى ومن العناصر اللغوية الاخرى التي تحدد القديم من الجديد من المعلومات أداة التعريفة ( كـ ال في العربية و thc في الانجليزية ) حيث يشير العنصر المرتبط بها الى شيء يعرفه المخاطب أما غيابها أوجود أداة التنكير( كالتنوين في العربية و a في الانجليزية ) فيفيد أن العنصر المرتبط بها لايعرفه المخاطب ومن الامثلة التي يمكن ذكرها هنا قوله تعالى : {ولقد أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول} .(القرآن الكريم المزمل 16: 73) . فقد أشارت كلمة رسولا الخالية من أداة التعريف الى مرجع غير معروف في حين كان دخول ال على كلمة رسول الثانية سببا في تحديد المقصود بالرسول. ويرى اللسانيون الوظيفيون أن المخاطب هو الذي يقرر أي من المعلومات ينبغي أن يعد من المسلمات وأيها ينغي أن يعد جديدا وقد أكد هاليدي Haliday هذه الحقيقة عندما ذهب الى القول بأن الذي يحدد وضع المعلومة ليس بنية الخطاب بل المتكلم (4) ومن الوسائل المعينة لمعرفة المعلومة المسلمة من المعلومة الجديدة في قوله ما هو أن نجعل القولة جوابا لسؤال نسأله بعد النظر في محتواها الدلالي انظر كيف يمكن أن نعرف المعلومة الجديدة من خلال طرح الاسئلة في القولات الاتية (5)
س1- ماذا فعل القط ؟ ج 1- لقد أكل الجرذ س2- ماذا حدث للجرذ؟ ج2- لقد أكله القط . س3- هل الكلب أكل الجرذ؟ ج3- لا بل القط هو الذي اكل الجرذ س4- هل القط أكل الجرذ ؟ ج4- لا بل الجرذ هو الذي اكله القط . لاحظ أن المعلومة المسلمة يشار اليها بالضمير كما في الجواب رقم (1) حيث أشير الى القط بالضمير المستتر في أكل . ويقسم الوظيفيون ما تعورف عليه بالمتقدم ثلاثة أقسام المتقدم الموضوعي ...........والمتقدم الشخصي................والمتقدم النصي..............(6) فمثال المتقدم الموضوعي القط في نحو القط أكل الجرذ ومثال المتقدم الشخصي بصراحة في نحو بصراحة أداؤك لا يعجبني ومثال المتقدم النصي على أية حال في نحو على أية حال حاول أن تعيد النظر في أدائك وسترى. 2.3.2.3 الدراسات الصيانية والصرفية : كان للوظيفين اهتمام كبير بدراسة الأصوات فاق أي اهتمام آخر وكان لهم الفضل في التمييز بين علم الأصوات، وعلم الصيانة، وهذا التركيز على الدراسات الصياتية لم يقتصر على أتباع مدرسة براغ بل ينطبق أيضا على مدرسة فيرث، ولاسيما في مراحلها المبكرة (7) . ولعل من الجدير بالذكر هنا أنه باستثناء الإسهامات التي قامت بها مدرسة براغ في مجالي النظرة الوظيفية للجملة، ونظرية الموضوع والتعليق المشار إليهما سابقا فإن أفكارهم النحوية والدلالية تجاوزتها التطورات التي قام بها اللسانيون الأمريكيون، أما إسهاماتهم في الصيانة فلا تزال مؤثرة في اللسانيات الأمريكية المعاصرة. ويعود تطوير النظرية الصياتية إلى رومان ياكبسون (Roman Jakobson 1896 1982) الذي صاغ فكرة العموميات universals تلك الفكرة التي استفاد منها التوليديون في علم الصيانة التوليدي generative phonology . وفي صوغه الفكرة العموميات يعارض ياكبسون دو سوسور وبواس في زعمهما بوجود نسبية بين اللغات وأن كل لغة لها نظامها الخاص، فقد ذهب إلى القول بوجود اثنتي عشرة سمة مميزة موجودة في جميع اللغات وسترى في الحديث عن المدرسة التوليدية أن إنكار النسبية والقول بالعموميات يوافق الأمس التي تقول بها المدرسة التوليدية.وتحدث ياكبسون أيضا عن ضوابط عامة منتظمة تتصل بكيفية اكتساب الطفل بعض الأصوات وكيفية فقدها عند الإصابة بمرض الحبسة aphasia الذي يؤدي إلى العجز عن نطق الأصوات ومن بين ما يذكره ياكبسون في هذا المجال أن التمييز بين الصوامت الانفجارية واللثوية (b / وt، مثلا) يسبق التمييز بين الصوامت ،اللهوية واللثوية (K/وt مثلا)، وهو ما يفسر المشكلة التي يعاني منها الطفل في نطق الكاف /K/ حين يحرفه إلى تاء /t/ . ويتعلم الأطفال الصفات الانفجارية قبل الاحتكاكية أما آخر الصوامت التي يميز بينها الطفل فهما الراء /T/ واللام/I/ . وعندما يفقد الإنسان القدرة على النطق على نحو تدريجي تكون التمييزات الأخيرة في تدرج النمو اللغوي عند الطفل أول ما يفقده، فإذا استعاد قدرته على النطق مرة أخرى كان ترتيب استعادة النطق معاكسا لترتيب الفقدان، وموافقا للطريقة التي يكتسب بها الطفل القدرة على التمييز بين الأصوات ابتداء )8(وربما كان من أهم إنجازات مدرسة براغ في مجال الدراسات الصيائية ما يسميه اللساني الروسي نيكولاي تروبيسكوي Nikolai Trubetzkoy (1890 - 1938) بالسمات المميزة distinctive features وعلى الرغم من أن تروبتسكوي، وأتباعه في مدرسة براغ طبقوها على التحليل الصياني phonological analysis فقد طبقها جاكبسون على علم الصرف، وأفاد منها النحاة التوليديون، والتحويليون إلى حد كبير، كما أفاد منها علماء الدلالة، ولاسيما في نظرية الحقول الدلالية semantic fields .كان تروبتسكوي عضوا في حلقة براغ اللسانية، وعد كتابه مبادئ الصيانة Principles of Phonology الذي أكمله قبل وفاته بقليل المصدر الأساسي لإيضاح منهجه الوظيفي في دراسة الأصوات.أولى تروبتسكوي اهتماما كبيرا بالعلاقات الاستبدالية بين الصينات فوازن بينها معتمدا في تمييز بعضها من بعض على السمات التي تميز إحداها من الأخرى. وأشار إلى أنواع من التقابلات التي تقع بين الصينات نذكرمنها :(1) التقابل الخاص private opposition وذلك حين يكون المميز بين الصيتتين سمة واحدة كما في التقابل بين التاء والدال اللذين نقول في التمييز بينهما أن الدال / د مجهورة والتاء /ت/ مهموسة (2) التقابل التدرجي gradual opposition ، وذلك حين يكون الاختلاف بین الصينات ناشئا عن سمة التدرج كما في الفرق بين الصينة القصيرة الكسرة العربية، ومقابلتها الأطول ياء المد.(3) التقابل المتكافئ equivalent opposition وذلك حين يكون للصينة سمة مميزة ليست في الصينات الأخرى، كما في التاء ات ، والكاف /ك/ لم تكن الوظيفة التمييزية distinctive function الوظيفة الوحيدة التي اكتشفها ترويتسكوي ،وأتباعه، بل ثمة أيضا الوظيفة المحددة demarcative function التي تبين الحدود بين مبني لغوي، وآخر في السلسلة الكلامية وتعزز التماسك في المبنى اللغوي الواحد كي يبدو موحدا. وإذا كانت الوظيفة التمييزية تنشأ عن مقابلة الصينات بعضها ببعض، فإن الوظيفة المحددة تنشأ عن استخدام السمات فوق المقطعية suprasegmental features التي تتعلق بسلسلة صياتية مكونة من صيتتين فأكثر، وذلك كالنبر stress ، والنغمة tone والطول (length (9) . . فالنبر مثلا يميز بين صيغة الاسم في الكلمة الإنجليزية import وصيغتها الفعلية import (حيث يكون النبر في الاسم على المقطع الأول، وفي الفعل على المقطع الثاني). وهناك سببان لاعتبار هذه السمة فوق مقطعية، أو عروضية prosodic) كما يحلو للبعض أن يسميها): أولا: أن النبر مسألة تتعلق بطغيان أو إبراز ل) مقطع على المقاطع الأخرى التي تشترك معه في المبنى نفسه، أو في المباني المصاحبة له. وثانيا: أن التحقق الصوتي للنبر لا يمكن أن يوصف بأنه سابق، أو لاحق من الناحية الزمانية للمتحقق الصوتي لما يحاذيه من عناصر صياتية أخرى وفي هذا يختلف عن السمات المقطعية التي يمكن أن نقول فيها ذلك(10)ومن القواعد فوق المقطعية في العربية التي يمكن أن تذكر هنا أن المقطع لا يبدأ إلا بصامت، وأنه لا يبدأ بصامتين متواليين وأن النبر يقع على نهاية المقطع في الكلمات المكونة من مقطع واحد وعلى نهاية المقطع الثاني في الكلمات المكونة من مقطعين(11( وإذا كان التقابل بين الصيتات يعبر عن اختلافها، واختلاف معاني الكلمات بناء على ذلك، فإن التقابل بين بعض التنوعات الصوتية allophones للصينة الواحدة قد يكون له وظيفة تعبيرية expressive function . فكلما ضاقت فتحة الصائتين /au/ في لهجة لندن عبر ذلك عن تدني مكانة المتكلم الاجتماعية(12) وكذا فإن نطق الضاد دالا عند النساء في مصر (كما في كلمة تفضل) يعبر عن جنس المتكلم.3.3.2.3 – نظرية فيرث: في أثناء الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين ظهر تحد قوي لبلومفيلد من فيرث J. R. Firth وأتباعه في جامعة لندن. كانت عناية فيرث وأتباعه منصبة على علمي الصيانة والدلالة ولم يول النحو والصرف العناية التي يستحقانها(13) . وبرزت في هذا الشأن نظرية التحليل العروضي prosodic analysis التي كانت جزءا من نظريته السياقية في اللغة The contextual theory of language ويبدو أن هذا الاقتصار على الاهتمام بالأصوات كان تقليدا سائدا في بريطانيا منذ سويت Sweet، ودانيال جونز D Jones في بداية القرن العشرين. يمكن تلخيص نظرية فيرث في كونها تنظر إلى المعنى على أنه وظيفة في سياق، وهو ما عد تحولا النظر إلى المعنى بعد أن كان يوصف بأنه. علاقة بين اللفظ، وما يحيل عليه في الخارج، أو في الذهن من حقائق وأحداث تلك النظرة التي كانت سائدة في الفلسفة الغربية التقليدية بعد انحدارها من الفلسفة اليونانية. وربما كان القارئ للفكر الفلسفي والمنطقي والأصولي في تراث العربية قد ألف هذه النظرة العقلية للمعنى(14)وهي النظرة نفسها التي شرحها أوجدن Ogden، وريتشاردز Richardsفي كتابهما معنى المعنى the meaning of meaning وطوراها فيما عرف بالمثلث الدلالي. ويعد ما فعله فيرث في هذا الشأن نقلة إبستمولوجية أنطولوجية كبيرة في حقل اللسانيات؛ لأنها دعمت الموقف السلوكي في ذهابه إلى صعوبة البحث الدلالي المعتمد على المنطق والتصورات الوجودية المختلفة التي كانت سائدة في الفلسفة الإغريقية كما فتحت الباب واسعا نحو نهج جديد في دراسة المعنى على نحو يراعي الاستخدامات الفعلية للغة.يرى فيرث أن الوقت قد حان للتخلي عن البحث في المعنى بوصفه عمليات ذهنية كامنة والنظر إليه على أنه مركب من العلاقات السياقية : (15) وذهب إلى أن الوظيفة الدلالية لا تتأتى إلا بعد أن تتجسد القولة في موقف فعلي معين(16) أي بعد أن تخرج من خانة الوجود الكامن إلى حيز الوجود الاستعمالي الفعلي، وهو أمر لا يتحقق - حسب رأيه - إلا في سياق الموقف. وقد اقتبس هذه النظرية؛ أعني نظرية
سياق الموقف theory of context of situation من الإناسي anthropologist مالينوفسكي B. Malinowski وهكذا بدلا من الحديث عن العلاقة الثنائية بين اللفظ والمعنى صار الحديث في المدرسة السياقية عن مركب من اللفظ والمعنى في علاقته بغيره من المركبات التي يمكن أن تحل محله في نفس السياق. وبرز ما يسميه فيرث بالتوزيع السياقي contextual distribution المحكوم بمنهج الإبدال method of substitution الذي يقتضي أن الكلمة مثلا ما هي إلا مقابل إبدال معجمي lexical substitution كلمات أخرى يمكن أن تحل محلها في ذات السياق، ويتحدد معناها بمقدار ما يحدثه هذا المعنى من تغيير وعلى المستوى الصياتي تجاوز فيرث النظرة النفسية للصينة phoneme التي صاغها بودان دي كورتيني Baudouin De Courtenay (1845 - 1929) وكان ينظر بمقتضاها إلى الصيتة على أنها صورة عقلية" أو صوت مفرد مجرد (17) ، وأصبحت الصيتة تتحدد بدراسة الصوت في علاقته بالسياقات الأصواتية التي يظهر فيها، وفي علاقته بالأصوات الأخرى التي يمكن أن. تحل محله في تلك السياقات(18) استفاد فيرث من تراث دو سوسور لاسيما في مجال العلاقات الاستبدالية، والائتلافية التي وظفها في منهج الإبدال حيث تدخل العناصر اللغوية في علاقات عمودية بين العنصر المذكور، وغيره مما يمكن أن يحل محله، وعلاقات أفقية بين العناصر المتجاورة. وعلى الرغم من أهمية التغيير الذي جاء به فيرث في البحث اللساني عامة، وفي تفسير المعنى خاصة؛ فإن مشكلة فيرث هي أنه لم يعرض نظريته عرضا كاملا وشاملا يبرز فيه الأسس الفلسفية والمعرفية لأفكاره السياقية إذ لم يتجاوز ما كتبه عن هذه النظرية ما يبلغ حجم كتاب كما يذكر روبینز(19) ولعل هذا ما أغرى هاليدي في بداية الستينيات ليقدم شرحا، وتفسيرا مفصلين لنظرية فيرث ويضمنها أبعاداً جديدة بحيث لم تعد قاصرة على مستوى الجملة بل تجاوزتها إلى ما هو أكبر منها حتى غدا النص - وليس الجملة - الوحدة الصغرى للتحليل أخذ هاليدي مستويات التحليل اللغوي الثلاثة من فيرث بعد وفاته وكان منهجه إجمالا امتدادا، وتكملة، وتطويرا لمنهج فيرث(20) وبغض النظر عن مدى النجاح الذي حققه هاليدي فإن مما لا ريب فيه أنه فتح آفاقا جديدة للبحث النصي، وأعطى أهمية كبيرة في الدراسات اللسانية الاسيما فيما عرف بلسانيات فيرث الجديدة neoFirthian linguistics) لعنصر السياق، والأبعاد الوظيفية للغة، ومهد السبيل للتوسع في الدراسات التخاطبية. وعلى أية حال، فسيبقى الفضل محفوظا لفيرث في إعادة اعتبار المعنى في الدراسات اللسانية، وهو أمر - وإن لم يكن رائقا لمعاصريه ـ فقد انعكس في عدد من الدراسات الحديثة مثل تلك التي تعنى بدراسة المحادثة conversation وأفعال الكلام spooch acts والافتراضات presupposition، ومناسبة الكلام للسياق relevance (21) وهنا ينبغي أن تؤكد بشدة على أن الوظيفيين عموما لم يقصروا وظيفة اللغة على التعبير عن أفكار متكلميها كما كان سائدا في التقاليد الفلسفية الغربية السابقة لظهورهم، بل أصروا على تعدد وظائف اللغة سواء منها الإبلاغية informative أو التعبيرية cxpressive، أو الاجتماعية social، أو الطلبية .conative. وقد تجاوز اهتمام مدرسة براغ حدود الدراسات اللغوية المحضة فخاضوا في الدراسات الأدبية والجمالية حتى إنهم اتهموا أحيانا بغياب المنهجية واخراجهم البحث اللساني عن طابع العلمية وهي حقيقة أكدها سامسون في كتابه مدارس اللسانيات (22) وعلى وجه الاجمال يمكن القول ان ما يميز الوظيفين ممن سبقهم من البنيويين لاسيما دو سوسور وأتباعه عدم الفصل بين المبنى اللغوية ووظائفها وعدم امكان عزل اللغة عن نسيجها الاجتماعي واغفال الفرق بين اللغة والكلام والتشديد على التفاعل بين النظام ( أو البنية) والسياق وإعطاء الوظيفة أهمية أكبر من البنية نفسها ورفض النسبية والقول بالعموميات التي تنطبق على كل اللغات وعدم الالتزام بالتفريق الحازم بين الدراسات التعاقبية والتزامية كما رسمه دو سوسور. 4.2.3- المدرسة التوليدية : يقصد بالمدرسة التوليدية .......مجموعة النظريات اللسانية التي وضعها وطورها اللساني الامريكي المشهور ناعوم تشومسكي ..............(المولود سنة 1928) وأتباعه منذ أواخر الخمسينيات وقد امتد تأثير ليشمل ( إضافة الى حقل اللسانيات ) مجالات أخرى كالفلسفة وعلم النفس وتعتمد هذه المدرسة في مناهجها على استخدام ما يعرف بالقواعد التوليدية وبلغ تأثيرها في النظريات النحوية حدا يمكن معه القول بأن النحو التوليدي هو النحو السائد في الدراسات اللسانية إبان الاربعين سنة الاخيرة وقد لا تبالغ إذا قلنا ان الاعتقاد السائد بين معظم اللسانيين في العقود الثلاثة الماضية هو أن جودة نظرية نحوية ماتقاس بمدى التزامها بالأصول التي ابتدعها التوليدين . لقد شاع وصف سنة 1957 ( وهي السنة التي نشر فيها البنى النحوية Syntactic Structures لتشومسكي بأنها نقطة تحول في لسانيات القرن أنه العشرين، غير من العدل أن نقول: إن بعض اللسانيين يرون أن سنة هي السنة الأكثر أهمية، وذلك عندما رفض تشومسكي - في مراجعة لاذعة - النهج السلوكي في استخدام اللغة بوصفه نتاجا غير مقبول للتجريبية الصارمة في المدرسة السلوكية البلومفيلدية. فقد تحدى تشومسكي الأساس الفلسفي لما عرف بالقانون البلومفيلدي Bloomfieldian canon ، ومنذ 1957 كادت التطويرات اللسانية جميعها تكون نتيجة لإعادة النظر أو للتعديلات في آراء تشومسكي ليس أقلها تغييراته الخاصة في نظريته اللسانية. وهكذا يمكن أن يعد النصف الثاني من القرن العشرين عصر النحو التوليدي التحويلي (23)إن الفكرة الأساسية التي توجه المنهج التوليدي هي . صمة الإنتاجية في اللغة التي بمقتضاها يستطيع المتكلم أن يؤلف ويفهم جملا جديدة غير متناهية لم يسبق له أن سمعها من قبل وهي السمة التي تميز الإنسان من الآلات والحيوانات فإذا كان الأطفال قادرين على استخدام جمل جديدة بعدها الكبار سليمة في صبوغها well-formed فذلك يعني أن هناك شيئا آخر يتجاوز مجرد محاكاة الجمل التي سمعوها من الكبار وهو أنهم يولدون بقدرة لغوية تمكنهم من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ندرس تلك القدرة التي تمكن المتكلم من إحداث جمل جديدة، وفهمها، بدلا من أن نوجه اهتمامنا إلى المادة اللغوية من أفواه المتكلمين لأنه مهما توسعنا في جمع المادة اللغوية فإننا نعجز عن تغطية كل المادة التي نحتاجها، بل ربما حتى القدر الكافي منها. وبقدر ما تنجح في اكتشاف القواعد التي يعتمد عليها المتكلمون في صوغ التراكيب فإننا نتمكن من تقديم تفسير مرض علميا لخصيصة الإنتاجية اللغة (24)
1.4.2.3 - النحو التوليدي: يطلق مصطلح النحو التوليدي generative grammar على طائفة من القواعد التي تحدد أنواعا مختلفة من أنظمة اللغة وبعبارة اصطلاحية أدق هو طائفة من القواعد التي تطبق على معجم محدود من الوحدات فتولد مجموعة (إما محدودة أو غير محدودة من الائتلافات المكونة من عدد محدود من الوحدات بحيث يمكن بهذه القواعد أن نصف كل ائتلاف بأنه سليم في صوغه well-formed في اللغة التي يصفها النحو .(25). ولكي نوضح هذه النقطة أقول: إن ما يحدث عند صوغ الجملة رقم (1) هو أنه لدينا مجموعة من الوحدات اللغوية منها ما هو قواعدي مثل (ال) في (المثابرون)، وصيغة فَعَل في (فاز)، ومنها ما هو معجمي مثل (ث ب ر) التي تكون المعنى المعجمي لكلمة (المثابرون)، و(ف) و (ز) المكونة للمعنى المعجمي لكلمة (فاز). ونظرا إلى كوننا قادرين على صوغ جمل عربية بحكم معرفتنا بقواعدها، فقد طبقنا مجموعة من القواعد الصياتية والصرفية، والنحوية لتوليد الجملة (1). (1) فاز المثابرون ومن القواعد الصياتية والصرفية التي طبقناها على هذه الجملة: 1 - أن وضع الوحدة المعجمية (ف و ز) في صيغة فعل للدلالة على أن الفعل حدث في الزمن الماضي يتطلب أن تحذف الواو؛ لأنها وقعت بين فتحتين (ف) : و : ز ) ، ثم توالت الفتحتان بدون فاصل بينهما، فكونتا الألف.
2 - إن وضع الوحدة المعجمية (ث ب ر) في صيغة فاعل للدلالة على من وقع منه الفعل لم يترتب عليه إبدال صياتي.3 - أن تعريف الفاعل بدلا من (تنكيره ترتب عليه إلصاق السابقة (ال) في بداية كلمة (المثابرون) دون وضعها في أي مكان آخر، وعدم إدغام اللام في الميم التي تليها؛ لأن (ال) هنا شمسية، وليست قمرية.ومن القواعد الصرفية النحوية التي طبقت لتوليد هذه الجملة عدم إلحاق ضمير الجماعة بالفعل فاز في مثل هذا التركيب، وضرورة استخدام اللاحقة (ون) للدلالة على الجمع والفاعلية وإثبات النون لعدم وجود مضاف إليه. وبعد تطبيق هذه الطائفة من القواعد على هذا المعجم المحدود من الوحدات (وهو مجموع الوحدة المعجمية (ف و ز) ، وصيغة الفعل (فعل)، و(ال)، والوحدة المعجمية (ث) ب ر وصيغة فاعل، واللاحقة (ون)) تولدت مجموعة من الائتلافات منها مثلا ،(فاز)، و(مثابر)، و(المثابر) و(المثابرون)، و(فاز المثابرون). ولكي نتأكد من سلامة صوغ كل ائتلاف من هذه الائتلافات، ونسمح لأنفسنا بالحكم بصحة ما قلناه فعلينا . أن نعود إلى القواعد الصياتية والصرفية والنحوية المذكورة سابقا، وهي قواعد تنتمي إلى النحو العربي لأننا نصف جملة من جمل العربية. يتولى النحو التوليدي أيضا تخصيص وصف بنيوي structural discription مناسب لكل ائتلاف من هذه الائتلافات وكل اختلاف في بنية الائتلاف المدروس ينبغي أن يظهر على شكل اختلاف في الوصف البنيوي المرتبط بتلك البنية. ومن المهم أن ننبه هنا على أن التوليديين لا يصفون جملا مدونة من المادة اللغوية التي استخدمها المتكلمون بالفعل بل يصوغون جملا مفترضة باتباع منهج التوليد ثم ينظرون في واقع اللغة (بالرجوع إلى حدس اللغوي عادة) ويتساءلون عما إذا كانت الجملة المولدة بمنهج رياضي مطابقة لقواعد
اللغة بالفعل أي هل كان صوغها سليما؟ ومن هنا يأتي مصطلح السلامة اللغوية well-formedness . وهكذا فإنهم يعاملون اللغة الطبيعية معاملة اللغات الصورية formal languages المخترعة، وهو أمر لا يوافق عليه كثير من اللسانيين(26)وقد ترتب على هذا المنهج التجريدي في دراسة اللغة استخدام مصطلحات مثل المتحدث المثالي ideal speaker bearer الذي ليس له وجود في الواقع اللغوي، بل يفترضه اللساني اعتمادا على حدسه intuition، وكفايته اللغوية linguistic competence أي معرفته بقواعد لغته، ومعجمها. وفي . البداية. النحو التحويلي التوليدي transformational-generative سمي grammar قواعد التحويلات (Trules لتحديد الجمل الأكثر قبولا من الناحية القواعدية في لغة ما. وفي كتاب تشومسكي البنى النحوية أخذ النحو شكلين: التحويلات الإجبارية مثل الإلصاق affix hopping الذي يولد به المبنى السليم للجملة والتحويلات الاختيارية لتحويل جمل مثبتة مثلا إلى جمل منفية، أو استفهامية. وفي العقود الأربعة اللاحقة بدأ تطوير دور التحويلات بإقحام فكرة البنية العميقة، الأمر الذي أدى تدريجيا إلى شيوع مصطلح النحو التوليدي بدلا من النحو التحويلي إلى أن اختفى المصطلح الثاني، وصارت النظرية التشومسكية تعرف باللسانيات التوليدية(27)
2.4.2.3 - افتراض بنية عميقة :
درج النحاة التوليديون على افتراض بني عميقة deep structures للائتلافات اللغوية يحكمها منطق اللغة الذي يفترضون أن كل متكلمي اللغة يرثونه من آبائهم، ففي كل لغة يمكن افتراض بنية تعبر عن وقوع فعل ما من فاعل ما يقع على مفعول به ومن الممكن منطقيا أن يعبر عن هذه الفكرة المنطقية بمناويل لغوية مختلفة اذ يمكن للمتكلمين تجسيد هذه الفكرة المنطقية في صورة ( فاعل – فعل – مفعول به ) أو ( فاعل – مفعول به – فعل ) أو ( فعل – مفعول به ) أو ( فعل- مفعول به – فاعل ) أو ( مفعول به – فعل – فاعل) أو (مفعول به –فاعل –فعل) غير أن هذه الاحتمالات الممكنة منطقيا ليست موجودة كلها في واقع اللغات بل كل لغة تضع قيودا تمنع وقوع بعض(أو ربما أغلب) هذه الاحتمالات وبذلك فان النحاة التوليديين ينطلقون من منطلق أن الأصل في تكوين الائتلافات اللغوية الإباحة ما لم تمنعه قواعد اللغة فاذا حاولنا أن نعبر عن الفكرة المنطقية السابقة باللغة العربية فسنجد أنه من الممكن أن نقول:
1- خالد ضرب سعيدا ممكن
2- خالد سعيدا ضرب (28) غير ممكن
3- ضرب خالد سعيدا ممكن
4- ضرب سعيدا خالد ممكن
5- سعيدا ضرب خالد ممكن
6- سعيدا خالد ضرب ممكن
وما نلاحظه عن الجمل السابقة أن اختيار خالد ليكون الفاعل المنطقي وسعيد ليكون المفعول به أتاح أكبر احتمالات ممكنة فاذا غيرنا ذلك الى عيسى ( ليكون الفاعل المنطقي) وموسى ( ليكون المفعول به) فالاحتمالات ستقل
1- عيسى ضرب موسى ممكن
2- عيسى موسى ضرب غير ممكن
7- ضرب عيسى موسى ممكن
8- ضرب موسى عيسى غير ممكن
9-موسى ضرب عيسى غير ممكن
10- موسى عيسى ضرب غير ممكن
ومن المهم هنا أن ندرك أن عملية التوليد وتقليب الاحتمالات لا تمثل مايقوم به المتحدث عندما يتكلم بل هي عملية رياضية دقيقة يقوم بها اللساني عند ممارسته النحو التوليدي. 3.4.2.3- اختلاف البنية العميقة عن البنية السطحية : عندما ننظر في كثير من الجمل تبدو لنا مختلفة ولكن اذا نظرنا في بناها العميقة نجد أنها واحدة ولعل الصورة المثلى في كل اللغات أن تتفق بناها العملية مع بناها السطحية ولكن هذا لا يكاد يحدث في الواقع اللغوي تأمل الأمثلة الآتية :
1- أفضل ثوب الحرير
2- أفضل كتاب الاستاذ
3- أفضل نوم الليل
4- البيت سرق
5- البيت اشتريته
6- البيت نمت فيه
7- البيت بعت أثاثه
8- قام زيد
9- مات زيد
عند التأمل في الأمثلة (1)و(2) و(3) نلاحظ أنها مشتركة في بنياتها النحوية الخارجية لكونها جميعا تتألف من فعل وفاعل ومفعول به ومضاف اليه ولكن عندما نوازن بين علاقة المضاف بالمضاف اليه في كل منها نجد أن المعنى مختلف ففي المثال الأول نجد أن الاضافة بمعنى من أي إن المقصود الثوب الذي من حرير وفي المثال الثاني نجد أن الاضافة بمعنى اللام فيكون المراد حينئذ الكتاب الذي للأستاذ وفي المثال الثالث تفسر بكونها بمعنى في ويكون المقصود بناء على ذلك النوم الذي في الليل . أما في المجموعة الثانية وهي الجمل من (4) الى (7) فان كلمة البيت تعرب مبتدأ ولكنها محولة في الواقع من بنى عميقة تظهر عند ارجاعها الى مواقعها الأصلية : 4- سرق البيت 5- اشتريت البيت 6- نمت في البيت 7- بعت أثاث البيت . وأما المثالان (8) و(9) فيظهر كيف أن اتفاق الشكل الخارجي المتمثل في وقوع كلمة (زيد) فاعلا فيهما لا يعني أن بنيتها العميقة واحدة لان معنى الأول فعل زيد القيام في حين أن الثاني حل الموت بزيد وكما تتفق البنى السطحية مع اختلاف البنى العميقة قد تتفق البنى العميقة وتختلف البنى السطحية كما في المثالين الآتيين : (10) لست بناجح. (11) لست ناجحا (29)
4.4.2.3 ـ البنية المكونة :
سوف تمهد للتحليل التوليدي للنحو، وأنواع القواعد المستخدمة فيه بشرح موجز لفكرة البنية المكونة constituent structure السائدة في أصول التوزيعيين distributionalists التي شاعت في منهج ما بعد اللسانيات البلومفيلدية post-Bloomfieldian linguistics. وعلى الرغم من أن فكرة البنية المكونة هي فكرة من أفكار التوزيعيين بيد أن الفرق الجوهري بين التوزيعيين والتوليديين أن التوزيعيين تعاملوا مع نحو المسارد graramar of lists" الذي يعنى بتحديد الوحدات اللغوية وتصنيفها، أما تشومسكي فقد عني بـ نحو القواعد grammar of rules " المعني بترتيب تلك القواعد ترتيبا منهجيا systematically لكي يمكن من الناحية المثالية وليس الواقعية) توليد ما هو مقبول فقط من كل الجمل في لغة ما : (30) .وينبغي أن نذكر هنا أن علم ، القواعد grammar قسم في فترة ما بعد اللسانيات البلومفيلدية إلى صرف morphology يُعنى بالبنية الداخلية لمباني الكلمة، ونحو syntax يتناول توزيع مباني الكلمة على الجمل السليمة الصياغة لغة ما، ولكنهم عدلوا عن . في ذلك في أغلب الأحوال فتخلوا عن التمييز بين المجالين وترتب على ذلك توسيع تعريف النحو ليشمل النحو، والصرف معا، وهكذا أصبح النحو يدرس توزيع المصرفات، وبدأ ينظر إلى مباني الكلمات لا على أنها وحدات ،دلالية بل بوصفها وحدات قد تؤدي وظيفة قولات ،صغرى وبوصفها - في بعض اللغات - مجالا لبعض السمات الصيانية فوق المقطعية وهذا هو المفهوم الذي تبنته القواعد التوليدية التشومسكية باعتبارها جزءا من إرث ما بعد اللسانيات البلومفيلدية (31) . تتألف كلمة مثل unfriendliness انعدام (الصداقة) وفقا لتحليل البنية المكونة من أربعة مصرّفات هي .un-friend-ly-ness ويمكن تمثيل بنية هذه الكلمة الهرمية hierarchical structure في أحد شكلين: التقويس bracketing ؛ أي الفصل بين أجزائها بأقواس معكوفة (كما في الشكل (1) والتشجير أي وضعها في شكل شجرة tree-diagram (كما في الشكل (2))(32). [[un-[friend-ly]]-ness] الشكل (1)
الشكل (2)
ومن الجوانب التي يهتم بها التوزيعيون والتوليديون هو تصنيف العناصر اللغوية التي تفرع أو تشجر في الأشكال السابقة، ويرتبون على ذلك بعض القواعد فكلمة unfriendliness تصنف بأنها اسم مجرد، ويرمز لها برمز ،معین وليكن مثلا (س) .م) ويصاغ الكثير من هذه الأسماء في الإنجليزية بإضافة اللاحقة ness على الصفات adjectives وكذلك، فإن الصاق un بصيغة الصفة (ص) هي . عملية صرفية منتجة في الإنجليزية أما الصاق un بصيغ الأسماء فليست عملية منتجة. وتصاغ هذه القواعد في شكل رموز كأن نستعمل الرمز (مق) لتلك الطائفة من المباني (مثل unfriendliness) الناشئة عن الصاقy 1بالصفات من الأسماء مثل (unfriend) التي يمكن أن ترمز لها ب (سص) وبذلك يمكن أن نعبر عما قيل سابقا بالقاعدة رقم (1) الآتية :(1)سص +y1—مق أي إن زيادةy 1 على الصفات المصاغة الأسماء من ينتج عنه صيغة من النوع unfriendiy . وتفيدنا هذه القاعدة أن كل الكلمات من النوع (سص) يمكن استبدال بعضها ببعض على الأقل في السياقات التي تعبر عنها القاعدة رقم (1). وتستلزم هذه القاعدة أن كل الكلمات من النوع (مق) يمكن استبدال بعضها ببعض في السياقات التي تعبر عنها قواعد أخرى مثل (2) مق + ness ← س م أي إن إلحاق ness بصيغة من نوع unfriendly ينشأ عنه اسم مجرد مثل. Unfriendliness (3) un+ مق ... ← مق أي أن إلحاق un بصيغة من نوع unfriendly ينشأ عنه صيغة أخرى من نوع'ununfriendly
unfriendly وهي وكما تطبق فكرة البنية المكونة على المستوى الصرفي تطبق أيضا على المستوى النحوي أي على مستوى العلاقة بين الكلمات. ففي التركيب الإنجليزي on the wooden table الذي يسمى بتركيب الجار والمجرور prepositional phrase نجد أنه يتكون من حرف الجر (on)، والتركيب الاسمي the wooden table) noun phrase) الذي يتألف من أداة التعريف (the)، والتركيب (wooden (table) المكون من الصفة (wooden)، والاسم (table).
(on(thelwoodentabIe)))
الشكل (3)
والخطوة التالية هي تحويل التويس السابق والمشجر الى رموز مختصرة بالتصنيف أو الوسم able1 وسنختار الرمز(تر س) للتركيب الاسمي و( ح ج ) لحرف الجرو(ج م) لتركيب الجار والمجرور و(ص) للصفة و (أ ت ) لأداة التعريف (33) .
[[[[the] [ [ wooden ] [ table أت ]onl ح ج م ]
الشكل (5)
الشكل (6)
-5.4.2.3
ب - أنواع القواعد في النحو التوليدي :
من القواعد التي قدمها التشومسكيون، واشتهرت بينهم ثلاثة أنواع: - قواعد المراحل المحدودة finite state grammars، وهي قواعد قادرة على توليد عدد غير متناه من الجمل تنتج عن تكرار تطبيق عدد متناه من قواعد نحوية متناهية العدد، وهذه القواعد أضعف من النوع الثاني. 2 - قواعد بنية التركيب phrase structure grammars، وهي القواعد التي تسمح لنا بتوليد عدد كبير من الجمل بتطبيق عدد قليل من القواعد ويستخدم فيها نوع آخر من الأشكال التوضيحية عوضا عن المشجرات،
خلافا للإنجليزية من اليمين الى اليسار .
الجملة – تركيب اسمي تركيب فعلي
وتقرأ هذه القاعدة كالآتي : تتألف هذه الجملة من تركيب اسمي وتركيب فعلي . ويصاحب هذه القواعد النحوية معجمية تترجم فيها التصنيفات النحوية الى كلمات تنطبق عليها تلك الأصناف النحوية: اسم (34) – {رجل ، امرأة ، أسد ، باب، شجاعة} ويمكن لنا أن نضع طائفة سهلة من قواعد بنية التركيب التي يمكن أن تستخدم لتوليد عدد كبير من الجمل: من قواعد بنية التركيب الجملة- تركيب اسمي تركيب فعلي تركيب اسمي – أداة تعريف – اسم ( صفة ) اسم علم تركيب فعلي – فعل تركيب اسمي ( تركيب جار ومجرور ) (صفة ) تركيب جار ومجرور – حرف جر تركيب اسمي اسم – {ولد ، بنت، منظار ، كلب} اسم علم – { علي ، فاطمة } أداة التعريف – {ال} الصفة – {صغير ، غريب} الفعل – {رأى ، تبع ، ساعد} حرف الجر – {ب ، عن} الظرف – { أمس ، مؤخرا } ونستطيع بهذه القواعد أن نولد الجمل من (1) الى (7) ولكننا لا نستطيع أن نوضح بها الجمل غير السليمة في بنائها القواعدي.
1- البنت تبعت الولد
2- الولد ساعد الكلب
3- الكلب رأى بنتا
4- فاطمة ساعدت عليا مؤخرا
5- علي رأى كلبا أمس
6- كلب صغير تبع فاطمة
7- الولد الصغير رأى عليا بمنظار غريب مؤخرا .
8- ولد الفاطمة رأى
9- ساعد بنتا
10- طفل صغير بمنظار.
لاتنحصر قواعد بنية التركيب في هذه البنى البسيطة بل قد تتعقد الجمل بإقحام ما يعرف بالاعادة ..........حيث تعاد بعض العناصر اللغوية لتطويل الجملة وتعقيدها ومن أمثلته إدخال الفعل ( ظن) على جملة ( خالد ساعد سعيدا) بحيث تصبح ( ظن أحمد أن خالدا ساعد سعيدا) ويمكن أن نطيلها أكثر فنقول :(يوسف قال: ظن أحمد أن خالدا ساعد سعيدا ) وهكذا (35)
3- القواعد التحويلية ...............مع تطور النحو التوليدي لاحظ اللسانيون الحاجة الى معالجة العناصر اللغوية المنقولة عن مواقعها فابتدعوا مجموعة من القواعد التحويلية لتوضيح التغيير والنقل الذي يحدث في البنى المستمدة من قواعد بنية التركيب وبيان علاقة الجمل بعضها ببعض لاسيما العلاقة بين الجمل المبنية للمعلوم والجمل المبنية للمجهول وكذلك الجمل الخبرية والجمل الاستفهامية وكل مايقوم به النحاة في معالجة مثل هذه الحالات هو نقل فرع من الشجرة في الشكل المشجر والحاقه بجزء مختلف انظر المشجرين الآتيين المرسومين لتوضيح كيف انتقل تقدم الظرف (آمس) عن موقعه السابق في الجملتين الآتيين (36) 1- علي ساعد فاطمة أمس 2- أمس علي ساعد فاطمة
وإضافة إلى الأنواع الثلاثة السابقة قدم النحاة التوليديون نظريات أخرى في الثمانينيات منها القواعد الوظيفية المعجمية lexical functional grammar وقواعد بنية التركيب المعممة generalized phrase structure grammar . وتتميز هاتان النظريتان الأخيرتان بالتخلص من القواعد التحويلية واعتماد الأولى منهما على الخصائص المعجمية، والثانية على الخصائص المنطقية لشرح العلاقات بين أنواع الجمل المختلفة وعدلت نظرية قواعد بنية التركيب المعممة عن اعتقاد تشومسكي السابق باستقلالية النحو عن المعنى، وحاولت اكتشاف الارتباط بين مباني الجمل، ومعانيها في حين أيدت نظرية القواعد الوظيفية المعجمية فكرة الحقيقة النفسية التي قال بها تشومسكي، وهي الفكرة التي ترى أن النظرية النحوية لا تكون صحيحة إلا إذا وصفت نظام اللغة الذي يملكه المتكلم في ذهنه (وليس ذلك المستخلص من المادة اللغوية المجموعة).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Lyons, 1981: 224.
(2) Seuren, 1998: 158.
M. A. K. Halliday & R. Hasan, Cohesion In English -3
(London: Longma (91)
(4) براون ج ب و ج يول تحليل الخطاب ترجمة محمد الزليطني ومنير التريكي ( الرياض : جامعة الملك سعود 1997) ص 225
D. Nunan, Introducing Discourse Analysis (London: (5) Penguin English, 1993)
(6) Nunan 1993 : 46-7 P. 45
(7) Robins, 1997:238.
(8) سامسون 1996: 126 - 2
See Lyons, 1981:2245.(9)
See Lyons, 1981:94,(10)
(11) انظر قدور، أحمد محمد مبادئ اللسانيات دمشق: دار الفكر،
1996) ص 117 - 118.
(12) سامسون، 1996: 113
oSee Robins. 1997: 246.(13
(14) ينظر على سبيل المثال : أبو حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق (بيروت: دار الأندلس، 46، 1983) ص46 - 47.
الشريف الجرجاني، أبو الحسن علي التعريفات (تونس: الدار التونسية للنشر، 1971) ص 116.
- حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة (بیروت: دار الغرب الإسلامي، ط3، 1986) ص 19.
- جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة ،وأنواعها تحقيق محمد جاد المولى وعلي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت: دار الجيل، (د - ت) 1 : 42
J. R. Firth., Papers in Linguistics 1934-1951 (London: Oxford University (15)
Press, 1957) p. 19.
(16 ) John Lyons, J., Firth's Theory of Meaning, In Bazell, C. E. et al. (Eds), In Memory of J. R. Firth, (Longman 1970) p. 296.
University Press, 1976) p. 213. D. Jones, The Phoneme(17)
its Nature and Use. Cambridge: Cambridge
Firth, 1957:20-1. (18)
(19) Robins, 1997:246.
(20) See Robins, 1997:246.
(21) See Robins, 1997:253.
(22) سامسون 1996. 115
(23) See Robins, 1997:260.
(24) 1 Lyons, 1981: 231.
(25) Lyons, 1981: 124-5.
(26) Lyons, 1981: 125-6.
(27) See Robins, 1997: 261.
(28) النجيمة تشير الى أن الجملة غير سلمية الصوغ ill-formed
(29) للتوسع في هذه الأمثلة وما يشبهها انظر دراستي السابقة يونس علي 1993 ): 280 - 83
(30) See Robins: 1997: 264,
(31) Lyons, 1981: 118.
Lyons, 1981: 119. (32)
(33) Lyons1981- 121-2
(34) السهم يعني يتألف من القواعد المعجمية
Yule 1996 .106-7 (35)
SeeYnle 1996 .106-7 (36)
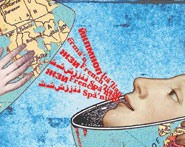
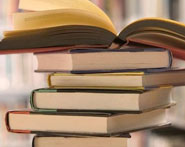

|
|
|
|
حقن الذهب في العين.. تقنية جديدة للحفاظ على البصر ؟!
|
|
|
|
|
|
|
"عراب الذكاء الاصطناعي" يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية ؟
|
|
|
|
|
|
|
جمعية العميد تعقد اجتماعها الأسبوعي لمناقشة مشاريعها البحثية والعلمية المستقبلية
|
|
|