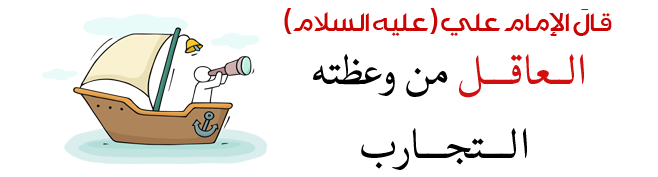
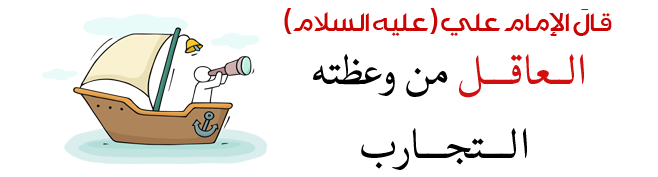

 التاريخ والحضارة
التاريخ والحضارة
 اقوام وادي الرافدين
اقوام وادي الرافدين 
 العصور الحجرية
العصور الحجرية 
 الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق 
 العهود الاجنبية القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق 
 احوال العرب قبل الاسلام
احوال العرب قبل الاسلام 
 مدن عربية قديمة
مدن عربية قديمة
 التاريخ الاسلامي
التاريخ الاسلامي 
 السيرة النبوية
السيرة النبوية 
 الخلفاء الاربعة
الخلفاء الاربعة
 علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
 الدولة الاموية
الدولة الاموية 
 الدولة الاموية في الشام
الدولة الاموية في الشام
 الدولة الاموية في الاندلس
الدولة الاموية في الاندلس
 الدولة العباسية
الدولة العباسية 
 خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
 خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
 عصر سيطرة العسكريين الترك
عصر سيطرة العسكريين الترك
 عصر السيطرة البويهية العسكرية
عصر السيطرة البويهية العسكرية
 عصر سيطرة السلاجقة
عصر سيطرة السلاجقة
 التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر
 التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
 تاريخ الحضارة الأوربية
تاريخ الحضارة الأوربية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-25
التاريخ: 2025-01-25
التاريخ: 2025-01-16
التاريخ: 2024-05-07
|
تحدثنا عن مدى اختلاط المصريين ببلاد النوبة وما كان لمصر من سلطان في بلاد النوبة السفلى حتى «الشلال الثاني» وما بعده بقليل، وكذلك تحدثنا عن ثقافة مجموعة C وما كان لها من أثر في هذه الجهات منذ أن ابتدأت تظهر في نهاية الأسرة السادسة، وقد بَقِيَتْ مستمرة حتى بداية الدولة الحديثة كما سنرى بعد، على أنه في الوقت الذي كانت تسود فيه ثقافة مجموعة C بلاد النوبة السفلى كانت تزدهر في بلاد النوبة العليا ثقافة أخرى وذلك أن الأستاذ «ريزنر» قد عثر في بلدة «كرمة» الواقعة شمالِي «جزيرة أرقو» مباشرة وعلى مسافة بعيدة من حصن «سمنة» الذي كان يعد الحد السياسي لمصر في عهد الدولة الوسطى على جبانة وطنية عظيمة وعلى آثار مستودع تجاري. وقد وصف السياح والكتاب المحدثون بلدة «كرمة» ولكن أشملهم وأوفاهم وصفًا هو ما كتبه الأثري «لبسيوس» وقد زار بعث «لبسيوس» «كرمة» في يونيو/حزيران سنة 1844.
والمكان المعروف باسم «كرمة» أخذ اسمه من الإقليم الذي يقع على الشاطئ الشرقي للنيل بين «أرقو» و«تومبوس» ويسكنه الآن نوبيو «دنقلة» أو البرابرة. والميزة الظاهرة لهذه البقعة خرابتان مؤلَّفتان من المباني المقامة من الطوب التي تُدْعَى بلغة أهل «دنقلة» «كرمان دفوفة»، وكلمة «دفوفة» يحتمل أن تعني قرية وخرائب «كرمان دفوفة» يمكن رؤيتها من بعد، وقد لاحظها كل السياح الذين مروا بهذه الجهات. وتنقسم «كرمان دفوفة» في نظر الأهالي قسمين «دفوفة العليا» و«دفوفة السفلى» وتشمل «كرمة» حاليًّا عدة مجاميع من البيوت المقامة من الطين بالقرب من النهر.
وأهل ثقافة «كرمة» الذين وُجِدُوا في الجبانات العظيمة التي عُثِرَ عليها في هذه البقعة في المقابر التي يرجع تاريخها إلى نهاية الأسرة الثانية عشرة وبداية الدولة الحديثة يُنْسَبُونَ إلى السكان الأصليين على حسب رأي الأستاذ «ريزنر» حيث يقول: «وإذا وزنَّا الأمور بميزان الإمكانيات التي ترتكز على البراهين التي في متناولنا فإني أستنبط أنه عندما أُسِّسَتْ مستعمرة «إنبو أمنمحات (جدار أمنمحات)» التجارية كانت مديرية «دنقلة» مسكونة بسلالة أصلية لا تُنْسَبُ إلى زنوج أواسط أفريقيا بل إلى مجموعة سكان شمالِي أفريقيا، ويحتمل أن اللوبيين كانوا فرعًا منهم. وهذا الجنس كما يُشَاهَدُ في الصور المصرية الخاصة باللوبيين يَتَّسِمُ بأنف مفرطح ويميز بتقاطيع بارزة تعادل الميزات الزنجية الخاصة بالهياكل العظمية النوبية. ويُلَاحَظُ في المقابر النوبية المتأخرة العهد أن السكان أصبحوا مختلطي الجنس، وقد أظهر الفحص الذي قام به الدكتور «دري» أنه توجد في مقابر هذا العصر المتأخر هياكل بشرية من أجناس مختلفة بعضها مصري صميم وبعضها يدل على أنه من أهل مجموعة ثقافة C ويظهر فيه الدم الزنجي، وأخيرًا نجد أن بعض الأجسام من أصل زنجي صريح.
وعلى ذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى سكان «كرمة» في نهاية الدولة الوسطى وبداية الدولة الحديثة، كما ينظر على وجه التقريب إلى سكان بلدة «أم درمان» الحالية حيث يجد فيها الإنسان الآن كل الأجناس التي تسكن أعالي وادي النيل.
ومما يُؤْسَفُ له جد الأسف أن ثقافة «كرمة» ليس لها وثائق مكتوبة قط، وما عثر عليه من نقوش هيروغليفية ليس له أية علاقة بهذه الثقافة.
ولا نعلم من الآثار التي عُثِرَ عليها قبل الكشف الذي قام به الأستاذ «ريزنر» في مصر وبلاد النوبة السفلى؛ أي عن نشاط للمصريين في هذه الجهة إلا في لوحة عثر عليها في بلدة «إدفو»، من نص صعب الفهم، ويمكن أن نستخلص منه أن رجلًا يُدعى «خع عنخف» يقرر أنه كان مصريًّا، ويحتمل أنه كان صاحب نشاط في «كرمة»، ولكن يمكن أن نفهم من المتن جليًّا أنه كان هو وزوجه وأولاده قد عادوا إلى «أسوان» من «كرمة» أو أنهم وصلوا إلى هذا المكان في ثلاثة عشر يومًا. ويذكر لنا فضلًا عن ذلك صاحب هذه اللوحة الذهب الذي أحضره، وكذلك يقول إنه جلب معه عبدًا أو عبيدًا، وسنتحدث عن هذه اللوحة فيما بعد. ولعمري إن أهم ما كانت تتجه إليه أنظار المصري في كل عصور تاريخه حتى عصرنا الحالي إلى زمن قريب هو الحصول على الذهب والعبيد، والكل يعلم أن تجارة الرقيق كانت منتشرة إلى زمن قريب جدًّا أُبْطِلَتْ بعده.
غير أن ما جاء في هذه اللوحة لا يؤكد لنا بصورة قاطعة نشاط مصر في الجنوب. وعلى ذلك فإن كل اعتمادنا على صلة مصر بهذه الجهة ينحصر فيما عُثِرَ عليه في «كرمة». والواقع أن معلوماتنا عن ثقافة «كرمة» في تلك الفترة مستقاة من مقابر جبانات شاسعة الأرجاء تبعُد حوالي أربعة كيلو مترات ونصف كيلو متر من شاطئ النيل.
ففي هذه البقعة يوجد غير مزارين كبيرين عدة مقابر ومدافن في هيئة أكوام دُفِنَ فيها أفراد من عامة الشعب، وعدد مهم من المقابر الضخمة يدل ظاهرها على أنها كانت لأسر أمراء أقام كل منهم لنفسه جبانة منفردة. وهذه المقابر في صورة تل مستدير الشكل يحيط بها لوحات من الحجر الرملي ويوجد في داخلها مبنى مؤلَّف من جدران من اللبنات، مثال ذلك المؤسسة التي على هيئة تل رقم (3) وهي المقبرة التي دفن فيها على ما يقال «زفاي حعبي» (انظر اللوحة رقم 2) ويبلغ قطرها حوالي 90 مترًا وتشغل مساحة قدرها 6385 مترًا مربعًا، ويبلغ ارتفاع الجدران المبنية باللبنات من الداخل حوالي 2٫11 مترًا، وهذه الجدران كانت أعلى من ذلك فيما مضى، وقد أقيم في وسط هذا المدفن دهليز يمتد من الشرق إلى الغرب جدرانُه من اللبنات ويبلغ عرضه حوالي مترين، ومن هذا الدهليز يتفرع شمالًا وجنوبًا حتى محيط دائرة هذه الجبانة عدة جدران متوازية تقطعها جدران أخرى في نقط متعددة مرتبط بعضها ببعض ومن ذلك يتكون في كل من الجزء الشمالِي والجزء الجنوبي عدة حجرات صغيرة تعرَّف عليها الأستاذ «ريزنر» بأنها مقابر.
وفي وسط هذا الدهليز نجد بابًا لحجرة أمامية تبلغ مساحتها 2٫35 × 2 مترًا مسقفة بسقف مقبب وهي أكبر حجرة في كل هذه المؤسسة وقد وُجِدَتْ منهوبة فلا يمكننا أن نتحدث عن حالتها الأصلية على وجه التأكيد، ولكن يمكن وصفها بطريق الحدس بالموازنة بينها وبين ما وُجِدَ في حجرات الدفن الأخرى المماثلة لها في المؤسسات الأخرى المجاورة. ولا نزاع في أن الشخص الذي دُفِنَ في هذه الحجرة أمير وهو الرئيس المسيطر على هذه الجهة في عصره، وبجانب هذا الأمير كانت تضطجع زوجه على سرير من الخشب، وعلى رقعة الحجرة وُجِدَ رجال مضطجعون ونساء مضطجعات، ويُحْتَمَلُ أنهم أقرب الناس إلى صاحب المقبرة وزوجه. والظاهر أنهم قد دفنوا أنفسهم أحياء طوعًا أو كرهًا مع الأمير وزوجه، ويبلغ عدد الذين دَفَنُوا أنفسهم بهذه الكيفية حوالي مئة شخص (هذا ونجد مدفونًا في دهليز المقبرة المستديرة رقم 4 عددًا يتراوح بين 110–130 شخصًا) وكل هذه الأجسام قد وُجِدَتْ في أوضاع مفزعة مخيفة مما يدل على أن هؤلاء الرجال والنساء قد لَاقَوْا حتفهم في وقت واحد. وهؤلاء الموتى ضحايا قرابتهم للمُتَوَفَّى. وقد سَمَّى هذه العادة الأستاذُ «ريزنر» دفن «ساتي». حيث يقول: «إنه على حسب كل ما وصل إلينا من معلومات لا توجد إلا عادة واحدة على حسبها تذهب كل الأسرة أو جزء منها إلى عالم الآخرة مع رئيسهم، وهذه هي العادة المسماة «ساتي» التي تُسْتَعْمَلُ كثيرًا، ولكنها معروفة معرفة جديدة عند الهنود باسم «ساتي» أو «سوتي» وبمقتضاها تُلقي نساء الرجل الْمُتَوَفَّى أنفسَهن (أو يُلْقَيْنَ) في النار التي يُحْرَقُ فيها الْمُتَوَفَّى، ومثل هذه العادة تفسِّر لنا تمامًا ما نجده من حقائق في مقابر «كرمة» إلخ»، والواقع أن هذا النوع من الدفن يقابل ما كان متبعًا في عصور ما قبل التاريخ عند دفن الملوك أو الأفراد من الأسرة المالكية في «سومر» ببلدة «أور»، وكذلك في أفريقيا نجد هذه العادة، وذلك أنه عند موت رئيس كانت زوجه أو بعض أقاربه يُدْفَنُونَ معه طوعًا أو على كره منهم، فكانوا بذلك يُضَحُّونَ بأنفسهم من أجله أو يُدْفَنُونَ معه أحياء. وهذه العادة متبعة حتى الآن، ولا يوجد من يحيد عنها إلا النادر، والظاهر أن أصل هذا المدفن الكومي الشكل هو أن يقام أولًا السور المصنوع من الحجر ثم يُبْنَى بعد ذلك البناء المصنوع من اللبِنات وكان يضطجع في حجرة دفن الأمير أقرباؤه الأدنون، وكانوا في هذه الحالة يُدفنون أحياء، وفي خارج هذه الحجرة كان يُدْفَنُ الخدم والأتباع في الدهليز الطويل الممتد بقطر المؤسسة ثم يُهال عليهم التراب حيث كانوا ينامون في أوضاع محزنة مفزعة، أما الماشية التي كانت تُقَدَّمُ قربانًا في خلال حفل الدفن، وبخاصة الثيران، فكانت تُدفن في الجهة الجنوبية من المقبرة، وبعد ذلك كانت تُمْلَأُ الطرق المجاورة بالرمال والحصى بما يبلغ سمكه حوالي خمسين سنتيمترًا ثم يُغَطَّى ذلك بطبقة من اللبنات التي تعلوها طبقة من الملاط وفوق ذلك توضع طبقة رفيعة من الحصى، وكان يُقام فوق هذا المدفن الذي على شكل كومة لوحة مخروطية الشكل توضع في وسطه وهي مصنوعة من حجر الكوارتسيت، ومن المحتمَل أنه كان يوضع فوقها القربان.
وبعد ذلك يُقام في صلب هذه الكومة في خلال عدة أجيال مقابر ثانوية كانت تُحْفَرُ في الحصى حتى طبقة الطين أو أعمق من ذلك. وكان يُوْضَعُ صاحب القبر غالبًا مع زوجه على سرير ويلف كل منهما في جلد حيوان، وهنا كذلك نجد فردًا أو عدة أفراد مدفونين على الأرض مباشرة، ومن المحتمل أنهم أقارب صاحب المقبرة أو خدمه، وهؤلاء كانوا بمثابة قربان له كالخرفان التي كانت تُدْفَنُ معه قربانًا.
هذا وتُقَدِّمُ لنا الأشياء التي كانت توضع مع المتوفى في قبره لاستعماله اليومي في عالم الآخرة في «كرمة» لمحة عن ثقافة بلاد النوبة العليا في العهد النوبي المتوسط، والواقع أن هذه الثقافة تُنْسَبُ إلى العهد النيوليتي المتأخر مثل ثقافة مجموعة C؛ ففي حين نجد أن جزءًا من محتويات القبر قد صُنِعَ في نفس بلاد النوبة العليا بدون شك، فإنه قد عُثِرَ على قطع أخرى من أثاث القبر قد تأثرت كثيرًا في صنعها بالطابع المصري حتى إنه كان في كثير من الأحيان يصعب على الإنسان أن يميز بين الأشياء المورَّدة من مصر والأشياء المصنوعة محليًّا، ومن المحتمل أنها كانت من صنع مصريين هاجروا إلى بلاد السودان واستوطنوها، ويميل غالبًا إلى هذا الرأي الأخير الأستاذ «ريزنر».
ومعظم الأشياء التي وُجِدَتْ في هذه القبور مصنوعة من الفخار وبخاصة الأباريق والطسوت وأطباق الأكل والشرب والزيوت والمسوح وهي مصنوعة في مصانع فخار يدوي؛ ويقول «ريزنر» إن أشكال الأواني التي وُجِدَتْ في «كرمة» تؤلف مجموعة منقطعة النظير في كل من مصر وبلاد النوبة فنجد حوالي 15٫5٪ من الأواني التي ذكرت من أصل مصري في حين نجد أن 8٫5٪ قد صنع من الفخار الخشن المصنوع باليد، وهو من مادة نوبية لا شك فيها ويشبه كثيرًا أشكال فخار مجموعة ثقافة C في بلاد النوبة السفلى، أما الستة والسبعون في المئة الباقية فهي أوانٍ جميلة الصنع عدا بعض كئوس بسيطة لا يمكن وجودها في كل من مصر وبلاد النوبة. وهذه الأواني الجميلة الصنع هي خليط نوبي بها أجزاء سوداء ولكنها صُنِعَتْ بعجلة الفخار بمهارة وبحسن اختيار للشكل لا مثيل له في الفخار النوبي بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا. ويقول «ستيندورف» إن «ريزنر» مَيَّزَ ثمانية عشر نوعًا مختلفًا من الأواني الفخارية قسمها ثلاثة أقسام:
(1) أوانٍ وطنية.
(2) أوانٍ مصرية أو متحضرة.
(3) أوانٍ وطنية خشنة الصنع.
فالمجموعة الأولى تحتوي على79٫5 ٪ من مجموع الأواني التي عُثِرَ عليها في هذه الجهة. ويظن «ريزنر» أنها عُمِلَتْ على حسب الصناعة المصرية على عجلة صانع الفخار، ومن الْمُحْتَمَلِ أن ذلك كان على نسق فخار مجلوب من مصر حيث نجد من الفخار القديم الفخار الأحمر المصقول والأواني ذات الحافة السوداء. وكذلك نجد أن أشكال وخواص هذه الأواني التي توحي بأنها كانت مخصصة للشرب على جانب عظيم من الجمال، ومن هذه بوجه خاص الأواني والأقداح الرشيقة المنظر. ويتبع هذه الأواني الأكواب الرشيقة الشكل والأباريق ذات الحافة الجميلة والأقداح ذات البزابيز والأباريق التي تشبه أباريق الشاي. كل هذه قد وجدت في مصانع «كرمة»، ولكن أصولها منقولة من مصر إلى بلاد النوبة السفلى، وقد عثر عليها في مقابر هذه الجهات التي أقيمت على شكل قعب (مستديرة)، ومن الفخار الخاص بعهد «كرمة» القعب الطويل الأسود والطويل ذو الجدار العمودي المسنن ولدينا مثال من ذلك.
والمجموعة الثانية تحتوي على 11٫5٪ من مجموع فخار «كرمة» وهي من حيث الشكل والمادة والصناعة موحدة مع أوانٍ مصرية معروفة أو على الأقل قريبة الاتصال بها وهي كما قلنا من قبل إما مجلوبة من مصر أو عُمِلَتْ تقليدًا لأوانٍ مصرية.
أما المجموعة الثالثة فتحتوي على 8٫5٪ من مجموع فخار «كرمة» وكلها صناعة محلية وتشتمل مثل أواني مجموعة ثقافة C، على أوانٍ فخارية ساذجة الصنع، وهذه الأواني رخيصة وفقيرة في صنعها، وكانت تستعمل في وادي النيل النوبي للأعمال اليومية المعتادة في المنازل ومن الجائز أن النساء كُنَّ يصنعنها بأيديهنَّ.
ولدينا كذلك من الصناعات الوطنية النوبية بوجه خاص الأثاث المصنوع من النجارة الدقيقة كالأسرة والكراسي والمخدات والتوابيت، وقد صُنِعَ كثير من هذه الأشياء وفق نماذج مصرية، يضاف إلى ذلك الأشياء المصنوعة من الجلد منها الأحزمة والمبدعات الجميلة للسيدات العذارى، والأحذية، وأغطية وأربطة للأسرة والكراسي والشبابيك وعلاقات للأواني الفخارية.
أما المصنوعات المعدنية فنجد أن الصائغ كان يصوغ أدوات الزينة الجميلة التي وُجِدَ منها الكثير ونخص بالذكر الأساور والأقراط وقطع الحلي الأخرى والنحاس الذي كانت مادته في نفس البلاد، فكان يصنع منه أنواع الآلات مثل السكاكين والموسيات. ولا نعلم تمام العلم إذا كانت الخناجر العدة وهي السلاح الوحيد الذي وُجِدَ في كل المقابر النوبية في هذه الجهة من المحاصيل المحلية أو جلبت من مصر كما يظن ذلك «ستيندورف».
وتمتاز مصنوعات «كرمة» بما تنتجه من الزخارف المصنوعة من الميكا. وهذه المادة قد وُجِدَتْ في مصر منذ عصر ما قبل التاريخ. وقد وُجِدَتْ مرايا من الميكا من العهد العتيق في بلاد النوبة.
وأهم ما يلفت النظر في استعمال هذه المادة في «كرمة» هو استعمالها زينة في صنع القبعات المصنوعة من الجلد التي خِيطَ فيها قطع من هذه المادة ذات أشكال مختلفة تُمَثِّلُ الزراف والطيور والأزهار الصغيرة وأشكالًا هندسية أخرى منوعة، ونجد مثل هذه الأشكال مصنوعة من سِنِّ الفيل في صور حيوانات مثل الثعلب والنعام والصقور مطعمة في خشب الْأَسِرَّةِ. ولا نزاع في أن جزءًا عظيمًا من الخرز والتعاويذ التي وُجِدَتْ في هذه الجهة هي من شغل «كرمة»، وكذلك لا بد أن نعلم أن الكثير منها قد أحضره معه صناع من مصر إلى بلاد النوبة.
ومن الأشياء التي جُلِبَتْ من مصر على ما يظهر الأواني المصنوعة من الفخار المطلي؛ وقد وُجِدَ منها قطع عديدة ويرى الأستاذ «ينكر» أن صناعًا مصريين كانوا يديرون المصانع التي تَصنع الأواني الخزفية المطلية التي توجد على مقربة من «دفوفة كرمة». غير أن «ستيندورف» لا يعتقد في ذلك ويظن أن هذه الأشياء قد أُحْضِرَتْ من مصر، وكذلك التماثيل التي عُثِرَ عليها في «كرمة» فإنها أُحْضِرَتْ من مصر ويظن «ينكر» أنها قد صُنِعَتْ في «كرمة» وقام بعملها صناع مصريون.
هذا ولدينا فضلًا عن ذلك جزء من القواعد المصنوعة من الخزف المطلي، والتطعيم والخرز والتعاويذ والأشكال المطلية وغير ذلك قد صُنِعَتْ في مصانع نوبية وطنية. وقد بقي من كل ذلك آثار تدل على وجود مصنع في هذه الجهة.
هذا ويدل ما وجد في المقابر من الأشياء الكمالية التي عُمِلَتْ في أشكال مصرية كالمرايا والآلات المصنوعة من النحاس وحِقَاقِ الزيت المصنوعة من المرمر وغير ذلك على أنها من أصل مصري وأن الصناع المصريين قد أَتَوْا إلى بلاد النوبة العليا وزاولوا صناعاتهم فيها.
وإذا ألقينا نظرة عامة إلى مجموع ما عرفناه عن ثقافة «كرمة» حتى الآن أمكننا أن نقرر بحق أن الثقافة قد تأثرت تأثرًا عظيمًا بالثقافة الأفريقية أكثر من الأثر الذي نجده في أختها ثقافة مجموعة C التي ظهرت في بلاد النوبة السفلى. حقًّا إن كلًّا من حملة هاتين الثقافتين بينهما رابطة جنسية تربطهما بعضهما ببعض، هذا فضلًا عن أن كلًّا من الفريقين كان يفلح الأرض ويرعى الماشية، كما نجد كذلك تشابهًا بينهما من حيث الملبس وبخاصة الأحزمة المزينة بالخرز، وكذلك من جهة المحاصيل اليدوية فهي مشاعة بينهما، ومن جهة أخرى نجد فروقًا ضخمة وبخاصة في مؤسسات المقابر التي تتشابه جميعًا في الظاهر، إذ نجدها كلها على هيئة كومة مستديرة، وكذلك تختلف في عادة الدفن إذ نجد العادة في «كرمة» أن يُدْفَنَ مع الرئيس عدد عظيم من الناس المذبوحين ومعهم أدوات زينة خاصة، ولكن في ثقافة مجموعة C كان صاحب المقبرة يُدْفَنُ وحده.
ويلاحظ أنه لم توجد قطع فنية كالتماثيل وغيرها من الصناعة النوبية الوطنية بل كادت تكون معدومة في «كرمة»، هذا إذا غَضَضْنَا الطرف عن بعض التماثيل الصغيرة المصنوعة من الحجر المطلي في«كرمة» مثل الأسود والثعابين والكباش والصقور.
أما في مجموعة ثقافة C فلدينا جَمٌّ غفير من التماثيل الصغيرة للرجال والحيوان.
أما الصور التي في المناظر فنجد في «كرمة» (خلافًا لبعض الرسوم التي نجدها على الجص في مزارين وهي التي نلحظ فيها على ما يظهر التأثير المصري) أحيانًا صورًا فخمة مطعمة بسن الفيل والميكا والخشب والجلد، ولدينا في مجموعة C صور أخرى مختلفة عن السابقة من حيث الأسلوب اختلافًا تامًّا رسمت على أوانٍ من الفخار، صورًا محفورة لرجال وحيوانات وهي تذكرنا بالصور التي كانت تُرْسَمُ على جدران الأواني المصرية في عصر ما قبل التاريخ أو الصور التي رُسِمَتْ على جدران «هيراكنپوليس» (الكاب). يُضاف إلى ذلك بعض الاختلافات في الملبس إذ نجد في «كرمة» القوم يلبسون القبعة المصنوعة من الجلد والمزينة بقطع من الميكا عليها صور مختلفة. هذا ولا نجد في «كرمة» ما نجده من خواص عصر ثقافة C المتأخر، وأعنى بذلك الأقراط وأسورة السواعد المصنوعة من أصداف البحر،54 وكذلك نجد هذه الاختلافات في كثير من المحاصيل الهامة من الصناعات اليدوية.
ومما سبق نجد أن لدينا ثقافتين منفصلة إحداهما عن الأخرى انفصالًا بَيِّنًا، ففي بلاد النوبة السفلى لدينا ثقافة مجموعة C وفي بلاد النوبة العليا لدينا ثقافة «كرمة». وكلاهما يُنْسَبُ إلى عصر النحاس المتأخر، وهما متفرعتان من الثقافة الإفريقية. وقد انفصل بعضهما عن بعض في العصور الأولى ونمت كل منهما على حدة، وبقيت كل منهما فيما بعدُ لا تؤثر على الأخرى كما يقول «ستيندورف»، ولكن الأستاذ «ينكر» يقول إن ثقافة مجموعة C قد تأثرت تأثرًا عظيمًا بثقافة «كرمة» وقد ظهر ذلك جليًّا في المزارات المبنية باللبنات في مقابر مجموعة ثقافة C فإنها مأخوذة عن ثقافة «كرمة».
وخلاصة القول أن مجموعة الأشياء التي أنتجتها حفائر «كرمة» تؤلف مجموعة أثرية لها علاقة ظاهرة جلية من جهة بمجموعة الدولة الوسطى المصرية، ومن جهة أخرى لها علاقة أقل ارتباطًا بمجموعة بلاد النوبة الأثرية التي من نفس العهد، غير أن مجموعة ثقافة «كرمة» في حدِّ ذاتها تعد نسيج وحدها فالصبغة الخاصة بالمحاصيل الفنية والصناعية التي وُجِدَتْ في المقابر تُفَسِّرُ بطبيعة الحال وبكل بساطة صيغة الموقع الجغرافي الذي يسكن فيه القوم. والواقع أن هذا المكان كان يُعَدُّ مستعمرة تجارية مسلحة أسسها فرعون مصر لتحافظ على سلامة الطرق الجنوبية، وكانت في الأصل تحتوي على أهل بيت أول نائب ملك وموظفيه ويُحْتَمَلُ أنه كان الأمير «زفاي حعبي» حاكم «أسيوط». وجماعة حاشية بيت «زفاي حعبي» هذا كانت تتألف من طائفة من الموظفين قائمين بأنفسهم ويشملون عمالًا وصناعًا كافين لسدِّ الحاجات الضرورية اللازمة لمثل هذا المجتمع كما كانت الحال في حاشية بيت صاحب الإقطاع العظيم في مصر في تلك الفترة. والواقع أن الصناع المصريين الذين كانوا قد جُلِبُوا إلى تلك الجهة كان المفروض فيهم أنهم عمال مدربون مهرة وأنهم قد أُبْعِدُوا عن المواد الأولية التي كانوا يُنْتِجُونَ صناعاتهم منها؛ ولذلك كانوا يبحثون بكل ما لديهم من عزم عن المواد التي كانت لازمة لصناعاتهم في موطنهم الجديد، ولا بد أنهم قد بحثوا عن المواد والطرق ومنتجات العمال المحليين تمهيدًا للبدء في عملهم. ولا نزاع في أن الصناعات المحلية كانت بطبيعة الحال بدائية جدًّا بالنسبة لما كان يوجد في مصر، ولكن لا بد أن الفخار ذا القمة السوداء والفخار الأحمر المصقول وهما اللذان يُؤَلِّفَانِ أهمَّ صفة للمجموعة الفخارية الأثرية النوبية، قد احتل مكانه في الذوق المصري، ويظهر أنه قد ترك أثرًا في أعمال المصريين هناك أكثر من أي عنصر آخر من عناصر الصناعات المحلية المجاورة. والواقع أن الصناع المصريين الذين استوطنوا هذه الجهة قد أخذوا هذه الصناعة المحلية واستعملوا في صنعها عجلة صنع الفخار، هذا بالإضافة إلى المهارة المصرية، ومن ذلك أوجدوا مجموعة من الفخار لا مثيل لها في العهود القديمة قبل استعمال الإغريق العجينة اللطيفة في صناعة الفخار. وكذلك قد أخذ المصريون عن أهل هذه الجهات حرفة أخرى أو حرفتين وأعنى بذلك صناعة الجلود والتطعيم بحجر الميكا، غير أن هاتين الصناعتين لم تتقدما تقدمًا يُذْكَرُ إذا استثنينا تطبيق الأشكال المصرية في الحليات التي عُمِلَتْ من الميكا. وعلى الرغم من أن الصناعات المصرية كانت متمسكة بكل قوة بالتقاليد المصرية فإنها قد تأثرت بالمواد الجديدة التي كان يستعملها العمال المصريون. هذا بالإضافة إلى الالتزامات الجديدة التي كانت تتطلبها البيئة الجديدة، وهذه الالتزامات الجديدة كانت ترجع أولًا: إلى إدخال عادات دفن جديدة مثل وضع الْمُتَوَفَّى على سرير، وثانيًا: أحوال الجو الجديدة كعمل صهاريج ماء وأوانٍ للشرب وأحذية، وثالثا: حاجيات التجارة الجنوبية، وبخاصة الخرز المطلي وغيره مما كان يحتاج إليه أهل هذه الجهة.



|
|
|
|
العمل من المنزل أو المكتب؟.. دراسة تكشف أيهما الأفضل لصحتك
|
|
|
|
|
|
|
عناكب المريخ.. ناسا ترصد ظاهرة غريبة
|
|
|
|
|
|
|
إحياءً لليوم الوطني للقرآن الكريم.. المجمع العلمي يواصل برنامجه التطويري الربيعي لطلبة حفظ القرآن الكريم
|
|
|