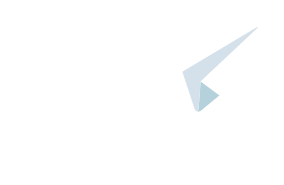تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
النصّ والقارئ والسياق
المؤلف:
خلود عموش
المصدر:
الخطاب القرآني
الجزء والصفحة:
ص66-68.
2-03-2015
3188
" إنّ القصيدة تقع في مكان ما بين الكاتب والقارئ ". إليوت يبرز دور المتلقّي أو السامع واضحا في
كتابات البلاغيّين العرب، فالخطيب يجب أن يعرف الأحوال النفسيّة للسامعين حتى يجعل
خطبته مؤثّرة فيهم. وكأنّهم يوجبون على الخطيب المعرفة الدقيقة بعلم النفس، حتى يستطيع
المطابقة بينهم وبين كلامه والموضوع الذي يتحدّث فيه. وقد فاق اهتمامهم بالمخاطب
أيّ اهتمام آخر؛ فالمتكلّم مثلا لم يظفر بمثل هذا الاهتمام باعتبار أنّ البلاغة
مراعاة لمقتضى الحال.
والحال عندهم هي حال المخاطب لا المتكلّم،
لأن ليس من المتصوّر عقلا ودينا أن يتناول هؤلاء المنظّرون القرآن باعتبار مصدره ولذا
اتّجهت مباحثهم إلى ناحية المتلقّي، ومحاولة ربط الأسلوب بظروفه الاجتماعيّة والدينيّة،
ومن هذا المنطلق رفض القدماء كثيرا من المطالع الشعريّة لأنّها لم تتوافق مع طبيعة
المتلقّي ومن ذلك قول الأخطل لعبد الملك بن مروان :
خفّ القطين فراحوا منك أو بكروا فقال له عبد الملك : بل منك، وتطيّر من قوله
فغيّرها الأخطل وقال : (خفّ القطين فراحوا اليوم أو بكروا). «1» وعلّق على ذلك ابن الأثير بقوله : " وذلك لأنّ مقابلة
الممدوح بهذا الخطاب يجلب كراهيته" «2».
وابن رشيق في دراسته للنسيب في مطلع القصيدة
الشعريّة يحاول تعليله بما يربطه بمتلقّي الشعر لا بقائله،" وللشعراء مذاهب
في افتتاح القصائد بالنسيب، لما فيه من عطف القلوب، واستدعاء القبول بحسب ما في
الطباع من حبّ الغزل والميل إلى اللهو بالنساء" «3».
وبالمثل أيضا درسوا خاتمة القصيدة الشعريّة
من خلال توافقها مع المتلقّي، فيرى العلوي أنّ من الواجب تضمّن هذا الختام معنى
تامّا يؤذن السامع بأنّه الغاية والمقصد والنهاية. «4»
وعبد القاهر الجرجاني في تحليله للعلاقات
النحويّة يميل إلى ربطها بالمتلقي، بل يجعل مهمّة الناظم هادفة إلى توصيل المعنى
إلى السامع باعتبار تواجده في عمليّة النظم تواجدا بيّنا يقول : " وليت شعري
هل يتصوّر وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى، ومعنى
القصد إلى معنى الكلم أن تعلم السامع بها شيئا لا يعلمه، ومعلوم أنّك أيّها
المتكلّم لست تقصد أن يعلم السامع معاني الكلم المفردة التي تكلّم بها، فلا تقول
خرج زيد لتعلمه معنى (خرج في اللغة) ومعنى (زيد) كيف، ومحال أن تكلّمه بألفاظ لا
يعرف هو معانيها كما تعرف". «5»
ويمكن تأكيد هذا المفهوم لدى عبد القاهر
الجرجاني إذا ما رأيناه يربط الصياغة بالمتلقي، ويجعل تغيّر هذه الصياغة مرهونا
بالحالة الإدراكيّة له، ويستشهد على ذلك بالحوار الذي دار بين أبي العبّاس والكندي
الذي قال : إني لأجد في كلام العرب حشوا، فقال له أبو العبّاس : في
أيّ موضع وجدت ذلك؟ فقال : أجد العرب يقولون : عبد اللّه قائم، ثمّ
يقولون إنّ عبد اللّه قائم، ثمّ يقولون : إنّ عبد اللّه لقائم، فالألفاظ
متكرّرة والمعنى واحد. فقال أبو العبّاس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ،
فقولهم : عبد اللّه قائم إخبار عن قيامه، وقولهم : إنّ عبد اللّه قائم، جواب
عن سؤال سائل، وقولهم : إنّ عبد اللّه لقائم : جواب على إنكار منكر
قيامه، فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعاني. «6»
ونجد السكّاكي يحدّد المعاني تحديدا قائما
على اعتبار المتلقّي العنصر الأساسي في العمليّة الإبداعيّة. فالمخاطب إمّا أن
يكون خالي الذهن، وإمّا أن يكون متردّدا في الحكم وإمّا منكرا له، وقد يخرج الكلام
على خلاف مقتضى الظاهر فيجعل غير السائل وهو خالي الذهن كالسائل، وقد يجعل غير
المنكر للمنكر وقد يجعل المنكر كغير المنكر «7». فذهن المتلقّي وطبيعته واردة في
جلّ مجالات الدراسة البلاغيّة من خلال هذا الإطار الإدراكي المشترك بينه وبين
المبدع، وفي كلّ حالة من الحالات يراعي المبدع ذلك، من خلال استخدام أدوات لغويّة
معيّنة تناسب هذا المتلقّي، كأدوات التوكيد مثلا مراعاة لمقتضى الحال، ومناسبة
للمخاطب. ويتأثّر الأسلوب تبعا لهذا، كما ورد في عبارة السكّاكي الماثلة في مطلع
هذا الموضوع،" فمقام التشكّر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام
التعزية ... ومقام المدح يباين مقام الذمّ، ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب،
ومقام الجدّ يباين مقام الهزل، وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء
على الاستخبار ... ولكلّ ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر" «8».
ويمتدّ هذا المقام- عند البلاغيّين- عبر
جزيئات الصياغة بحيث يكون لكلّ كلمة مع صاحبتها مقام، ولكلّ حدّ ينتهي إليه الكلام
مقام، ونحن نلحظ دقّة السكاكي عند ما عرض لأداء المعنى الواحد بطرق متعدّدة، فقد
لاحظ أنّ تغيّر الصياغة لا بدّ أن يتبعه تغيّر في المعنى العام بالزيادة أو
النقصان، أو بالوضوح والخفاء بل إنّ اتفاق الجملتين المختلفين تركيبا في الدلالة
أمر ممتنع عقلا، حتى بالدلالات الوضعيّة فضلا عن الدلالات العقليّة، وهو في ذلك
يطبّق مقولة الحال والمقام على مستوى الموقف الاجتماعي، أو على مستوى الصياغة وما
بين جزئياتها من علاقات.
ويعدّ مبحث الالتفات من المباحث التي تصل
بين المخاطب والمخاطب، وله صلة بتنويع الأسلوب بحسب السياق، فهذا الزمخشري يلحظ
أنّ العدول من أسلوب إلى أسلوب في الالتفات فيه " إيقاظ للسامع وتطرية له
بنقله من خطاب إلى خطاب تنشيطا له في الاستماع" «9».
______________________
(1) ابن الأثير، المثل السائر، 2/ 88.
(2) نفسه.
(3) ابن رشيق القيرواني/ العمدة/ ج 1/ ص
150.
(4) العلوي/ الطراز/ ج 3/ ص 185.
(5) دلائل الإعجاز ، ص 73.
(6) دلائل الإعجاز ، ص 375.
(7) السكّاكي ، مفتاح العلوم، ص 7.
(8) نفسه ، ص 2.
 الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)