السعادة: وهم المظهر وحقيقة الداخل بين القيم الأصيلة والضجيج الاستهلاكي
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
1/1/2026
السعادة سؤالٌ قديمٌ يتردّد في كل عصر، كأنّه محاولة بشرية دائمة لالتقاط معنى يتفلّت من اليد كلما ظنّ الإنسان أنّه أمسك به. فهي ليست فكرة ساكنة ولا حقيقة جامدة، بل تجربة متحوّلة، تتبدّل بتبدّل الوعي، وتتلوّن بتغيّر الظروف. لذلك ظلّ مفهوم السعادة من أكثر المفاهيم مراوغة في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، لا لأنّه غامض في ذاته فحسب، بل لأنّه وليد شبكة معقّدة من العوامل الداخلية والخارجية، تجعلها أقرب إلى حالة وجودية منها إلى تعريف نظري، وأقرب إلى ترجمة داخلية منها إلى مؤشّر خارجي.
فالإنسان الذي يعيش في واقع مضطرب قد يرى السعادة في الأمن والاستقرار، بينما يراها آخر يعيش في وفرة مادية في معنى أو قيمة أو علاقة إنسانية صادقة. وهناك من يجدها في إنجازٍ متواضع، أو لحظة صفاء، أو قدرة على تجاوز خوفٍ قديم، أو في استعادة جزء من الذات التي أنهكها الصراع. ولهذا لا تبدو السعادة جوهرًا ثابتًا، بل نقطة التقاء بين نقائض متجاورة: بين الألم والصبر، بين الخسارة والتعلّم، بين الواقع والطموح، وبين ما نعتقد أنّنا نستحقّه وما نملك فعليًا القدرة على تحقيقه.
وهنا يلتقي هذا التصوّر مع الرؤية القرآنية للإنسان، بوصفه كائنًا يعيش الامتحان لا الاكتمال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَد﴾
فالكبد هنا ليس نقيض السعادة، بل شرطها الوجودي؛ إذ لا معنى للرضا دون مجاهدة، ولا قيمة للطمأنينة دون اضطراب سابق.
وإذا قرأنا مفهوم السعادة قراءة فلسفية، سنلاحظ أن المدارس الكبرى لا تكاد تتفق إلا على حقيقة واحدة: أنّ السعادة ليست معزولة عن تصوّر الإنسان لذاته وللعالم. فالإغريق رأوا فيها ثمرة العيش وفق الفضيلة، والرواقيون اعتبروها تحرّرًا من الاستعباد للانفعال، والأبيقوريون جعلوها فنًّا لتقليل الألم لا مطاردة اللذة. أمّا الفلسفة الحديثة، فقد نقلت السعادة من كونها غاية أخلاقية جماعية إلى حقّ فردي، ومن حكمة عيش إلى مشروع شخصي، يتداخل فيه الاقتصاد والسياسة والإعلام وصناعة الرغبات.
غير أنّ هذا التحوّل، رغم ما حققه من تحرير ظاهري للفرد، أوقع الإنسان المعاصر في مفارقة قاسية: كثرة الوسائل وقلّة الرضا. وهنا يستدعي فكر الإمام عليّ عليه السلام بعمقه الأخلاقي والإنساني، حين يقول:
«الغِنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة»
فالسعادة لا تُقاس بالمكان ولا بالامتلاك، بل بحالة الاكتفاء الداخلي، وبقدرة الإنسان على أن يسكن نفسه قبل أن يسكن العالم.
وحين ننتقل إلى علم النفس الحديث، نجد أنّ السعادة تحوّلت إلى موضوع قياس وتجريب، تُقاس بالاستبيانات والمؤشرات. غير أنّ هذه المقاييس، مهما بلغت دقّتها، تعجز عن الإحاطة بتجربة شديدة الخصوصية، لأن السعادة ليست نبضًا يُرصد، بل صورة داخلية يعكسها وعي الإنسان بذاته، وبقدرته على إدارة رغباته، والتصالح مع إخفاقاته. ففي مجتمعات تعيش ضغط البقاء، تصبح السعادة فعل مقاومة، وفي مجتمعات أكثر استقرارًا تنزلق إلى مستوى الرفاه والاعتياد، فتفقد حدّتها الشعورية.
ولما كانت السعادة في جوهرها حالة داخلية يعيشها الإنسان في عمق وعيه، لا صورةً خارجية تُلتقط من مظهره أو نمط حياته، فإن ذلك يُسقط تلقائيًا حقّ أيّ إنسان أو سلطة أو خطاب اجتماعي في أن ينصّب نفسه قاضيًا على سعادة الآخرين أو تعاستهم. فالحكم على سعادة شخص من ضحكته، أو حضوره، أو اندماجه الظاهري، ليس إلا قراءة سطحية للظاهر، تتجاهل ما يختبره الداخل من صراع أو قلق مكتوم. وقد يبدو الإنسان في هيئة الابتهاج، بينما يرزح داخليًا تحت ثقل لا يُرى، وقد يبدو صامتًا أو متعبًا، بينما يعيش قدرًا عميقًا من الرضا والتصالح مع الذات.
ومن هنا تتجلّى خطورة تحويل السعادة إلى معيار اجتماعي جاهز، يُكافَأ من ينسجم معه، ويُتَّهَم من يخرج عنه بالكآبة أو الجحود. فالسعادة، حين تُختزل في إشارات خارجية، تفقد حقيقتها، وتتحوّل من تجربة شخصية صادقة إلى أداء اجتماعي قسري، يُجبر فيه الإنسان على تمثيل الفرح بدل أن يعيشه.
وفي السياق ذاته، يبرز الإشكال المعاصر في ربط السعادة بالترفيه المنظَّم، وبما تروّج له بعض الدول من مهرجانات وفعاليات تُقدَّم بوصفها وصفة جاهزة للفرح الجمعي. فهذه الممارسات، مهما اتسع حضورها الإعلامي، لا تضمن بالضرورة سعادة حقيقية للمجتمعات، بل قد تُسهم — على العكس — في إبعاد الإنسان عنها، حين تفصله عن قيمه المجتمعية الأصيلة، وتعيد تشكيل وعيه وفق أنماط استهلاكية وقيم دخيلة لا تنبع من تاريخه ولا من بنيته الثقافية.
إنّ تحويل السعادة إلى منتج ترفيهي يُستهلك في لحظة، قد يمنح نشوة عابرة، لكنه لا يبني إنسانًا متوازنًا، ولا مجتمعًا متماسكًا. فالسعادة التي تُفصل عن القيم، وعن المعنى، وعن الإحساس بالانتماء والمسؤولية، سرعان ما تتحوّل إلى فراغٍ مقنّع، وإلى محاولة للهروب من الأسئلة الكبرى بدل مواجهتها.
وهنا يبرز البعد الديني بوصفه عامل توازن، لا وعدًا بالراحة المطلقة، بل إطارًا يمنح المعنى للألم. يقول تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَة﴾
والحياة الطيبة هنا ليست خلوًّا من الشدائد، بل حياة ذات معنى، يُفهم فيها الألم ولا يُنكر، ويُحتوى دون أن يُقدّس.
ولعلّ من أخطر أوهام العصر الحديث التعامل مع السعادة كهدفٍ نهائي، بينما هي في حقيقتها أثر جانبي لطريقة العيش. فمَن يطاردها مباشرةً قد يقع في قلقٍ دائم، بينما تتجلّى غالبًا لمن ينشغل بمعنى، أو رسالة، أو علاقة صادقة. وهذا ما عبّر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: «ارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس».
ومن زاوية وجودية أعمق، يمكن النظر إلى السعادة بوصفها إجابة غير مباشرة عن سؤال المعنى. فكلما اقترب الإنسان من معنى يرضيه، خفّ ثقل الألم عليه. ولهذا قد نجد من يعيش شقاءً ظاهريًا، لكنه ممتلئ بالرضا، وآخر يعيش رفاهًا لكنه غارق في فراغ قاتل. وقد لخّص الإمام عليّ عليه السلام هذه المفارقة بقوله: «إنّ النفس إن لم تُشغَل بالحق شُغلت بالباطل».
وفي هذا السياق، يقدّم القرآن تصورًا بالغ العمق للسعادة، لا بوصفها غيابًا للألم، بل بوصفها طمأنينة نابعة من انتظام الداخل: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب﴾.
فالذكر هنا ليس ترديدًا لفظيًا، بل استعادة لمعنى يتجاوز اللحظة، ويحرّر الإنسان من الارتهان الكامل لما يتغيّر من حوله.
وتبقى المفارقة الكبرى أنّ السعادة تستمدّ قيمتها من نقائضها؛ فبلا تعب تفقد معناها، وبلا فقدان تصبح عادة، وبلا ألم تغدو سطحية. لذلك لا تُقاس السعادة بالمقارنة مع الآخرين، بل بالمقارنة بين الإنسان ونفسه عبر الزمن: ما كانه، وما تجاوزه، وما تعلّمه.
وفي المحصّلة، تبقى السعادة سؤالًا مفتوحًا، لا لأن الإجابة مستحيلة، بل لأن الإنسان نفسه كائن مفتوح على التحوّل. وكل محاولة لإغلاق هذا السؤال بتعريف نهائي تُفرغه من معناه. وربما كانت الحكمة في أن تظلّ السعادة سؤالًا، لأن السؤال — بخلاف الجواب — يُبقي الإنسان حيًّا، يقظًا، وقادرًا على إعادة ترتيب علاقته بذاته وبالعالم كلما تغيّرت ملامح الطريق.
إنها ليست نهاية الرحلة، بل ما يجعل الرحلة محتملة… وربما جديرة بأن تُعاش.

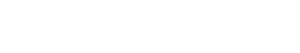




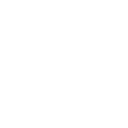














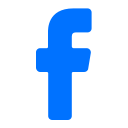

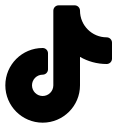








.png) حنين ضياء عبدالوهاب الربيعي
حنين ضياء عبدالوهاب الربيعي .png) منذ 3 ايام
منذ 3 ايام 
















 الفقرُ الثّقافيّ
الفقرُ الثّقافيّ مقبرة الأعياد
مقبرة الأعياد قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة EN
EN