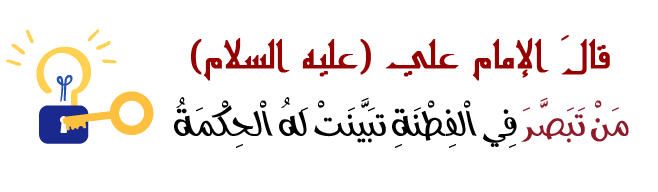
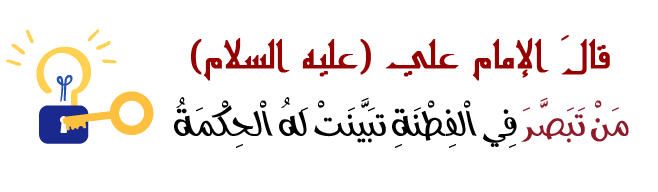

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-11-2017
التاريخ: 5-11-2017
التاريخ: 14-6-2021
التاريخ: 4-11-2017
|
قال تعالى : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نبأ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأنعام : 33 - 37].
قال تعالى : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نبأ الْمُرْسَلِينَ} [الأنعام : 33 - 34].
سلى سبحانه نبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) على تكذيبهم إياه ، بعد إقامة الحجة عليهم ، فقال : {قَدْ نَعْلَمُ} نحن يا محمد {إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ} أي : ما يقولون إنك شاعر ، أو مجنون ، وأشباه ذلك {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ} : دخلت الفاء في إنهم لأن الكلام الأول يقتضيه ، كأنه قيل : إذا كان قد يحزنك قولهم ، فاعلم أنهم لا يكذبونك .
واختلف في معناه على وجوه أحدها : إن معناه لا يكذبونك بقلوبهم اعتقادا ، وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عنادا ، وهو قول أكثر المفسرين ، عن أبي صالح ، وقتادة ، والسدي ، وغيرهم ، قالوا : يريد أنهم يعلمون أنك رسول الله ، . ولكن يجحدون بعد المعرفة ، ويشهد لهذا الوجه ما روى سلام بن مسكين ، عن أبي يزيد المدني ، أن رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) لقي أبا جهل ، فصافحه أبو جهل ، فقيل له في ذلك ، فقال : والله إني لأعلم أنه صادق ، ولكنا متى كنا تبعا لعبد مناف فأنزل الله هذه الآية .
وقال السدي : التقى أخنس بن شريق ، وأبو جهل بن هشام ، فقال له : يا أبا الحكم ! أخبرني عن محمد ، أصادق هو أم كاذب ، فإنه ليس ههنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل . ويحك ! والله إن محمدا لصادق ، وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء ، والحجابة ، والسقاية ، والندوة ، والنبوة ، فماذا يكون لسائر قريش ؟ وثانيها : إن المعنى : لا يكذبونك بحجة ، ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان ، ويدل عليه ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقرأ : {لَا يُكَذِّبُونَكَ} ويقول : إن المراد بها إنهم لا يأتون بحق هو أحق من حقك وثالثها إن المراد لا يصادفونك كاذبا ، تقول العرب قاتلناكم فما أجبناكم أي : ما أصبناكم جبناء ، قال الأعشى :
أثوى وقصر ليلة ليزودا فمضى ، وأحلف من قتيلة موعدا (2)
أراد : صادف منها خلف الوعد ، وقال ذو الرمة :
تريك بياض لبتها ، ووجها كقرن الشمس أفتق ثم زالا (3)
أي : وجد فتقا من السحاب . ولا يختص هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف دون التشديد ، لأن أفعلت وفعلت يجوزان في هذا الموضع ، وأفعلت هو الأصل فيه ، ثم يشدد تأكيدا مثل : أكرمت وكرمت ، وأعظمت وعظمت ، إلا أن التخفيف أشبه بهذا الوجه . ورابعها : إن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به ، لأنك كنت عندهم أمينا صدوقا ، وإنما يدفعون ما أتيت به ، ويقصدون التكذيب بآيات الله .
ويقوي هذا الوجه قوله : {وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} قوله : {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ} [الأنعام : 66] ولم يقل وكذبك قومك وما روي أن أبا جهل قال للنبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ما نتهمك ولا نكذبك ، ولكنا نتهم الذي جئت به ونكذبه . وخامسها : إن المراد أنهم لا يكذبونك بل يكذبونني ، فإن تكذيبك راجع إلي ، ولست مختصا به ، لأنك رسول الله ، فمن رد عليك فقد رد علي ، ومن كذبك فقد كذبني ، وذلك تسلية منه سبحانه للنبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) .
وقوله : {وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} أي بالقرآن والمعجزات يجحدون بغير حجة ، سفها وجهلا ، وعنادا . ودخلت الباء في {بِآيَاتِ اللَّهِ} والجحد يتعدى بغير الجار والمجرور ، لأن معناه هنا التكذيب أي : يكذبون بآيات الله .
وقال أبو علي : الباء تتعلق بالظالمين ، والمعنى : ولكن الظالمين برد آيات الله ، أو إنكار آيات الله يجحدون ما عرفوه من صدقك وأمانتك ، ومثله قوله سبحانه :
{وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} [الإسراء : 59] أي ظلموا بردها ، أو الكفر بها ، ثم زاد سبحانه في تسلية نبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) بقوله : {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا} أي : صبروا على ما نالهم منهم من التكذيب والأذى في أداء الرسالة .
{حَتَّى أَتَاهُمْ} : جاءهم . {نَصْرُنَا} إياهم على المكذبين . وهذا أ مر منه سبحانه ، لنبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) بالصبر على كفار قومه ، إلى أن يأتيه النصر ، كما صبرت الأنبياء {وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} معناه : لا أحد يقدر على تكذيب خبر الله على الحقيقة ، ولا على إخلاف وعده ، وإن ما أخبر الله به أن يفعل بالكفار ، فلا بد من كونه لا محالة ، وما وعدك به من نصره ، فلا بد من حصوله ، لأنه لا يجوز الكذب في اخباره ، ولا الخلف في وعده .
وقال الكلبي وعكرمة : يعني بكلمات الله : الآيات التي وعد فيها نصر الأنبياء ، نحو قوله : {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} [المجادلة : 21] وقوله : {إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ} [الصافات : 172] . {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} أي : خبرهم في القران كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم . قال الأخفش : (من) هاهنا صلة مزيدة ، كما تقول : أصابنا من مطر أي : مطر . وقال غيره من النحويين : لا يجوز ذلك ، لأن (من) لا تزاد في الإيجاب ، وإنما تزاد في النفي ، و (من) هنا للتبعيض ، وفاعل جاء مضمر ، يدل المذكور عليه ، وتقديره : ولقد جاءك من نبأ المرسلين نبأ ، فيكون المعنى أنه أخبره عليه وآله السلام ، ببعض أخبارهم ، على حسب ما علم من المصالح ، ويؤيد ذلك قوله : {وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} [غافر : 78] .
- {وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ * إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ * وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأنعام : 35 - 37] .
ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون ، فقال مخاطبا لنبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) : {وَإِنْ كَانَ كَبُرَ} أي : عظم واشتد {عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ} وانصرافهم عن الإيمان ، وقبول دينك ، وامتناعهم من اتباعك وتصديقك {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ} أي :
قدرت وتهيأ لك {أَنْ تَبْتَغِيَ} أي : تطلب وتتخذ {نَفَقًا فِي الْأَرْضِ} أي : سربا ومسكنا في جوف الأرض {أَوْ سُلَّمًا} أي : مصعدا {فِي السَّمَاءِ} . ودرجا {تَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ} أي : حجة تلجئهم إلى الإيمان ، وتجمعهم على ترك الكفر ، فافعل ذلك .
وقيل : فتأتيهم بآية أفضل مما اتيناهم به فافعل ، عن ابن عباس . يريد لا اية أفضل وأظهر من ذلك .
{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى} بالإلجاء وإنما أخبر ، عز اسمه ، عن كمال قدرته ، وأنه لو شاء لألجأهم إلى الإيمان ، ولم يفعل ذلك ، لأنه ينافي التكليف ، ويسقط استحقاق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف ، وليس في الآية أنه سبحانه لا يشاء منهم أن يؤمنوا مختارين ، أو لا يشاء أن يفعل ما يؤمنون عنده مختارين ، وإنما نفى المشيئة لما يلجئهم إلى الإيمان ، ليتبين أن الكفار لم يغلبوه بكفرهم ، فإنه لو أراد أن يحول بينهم وبين الكفر لفعل ، لكنه يريد أن يكون إيمانهم على الوجه الذي يستحق به الثواب ، ولا ينافي التكليف .
{فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} قيل : معناه فلا تجزع في مواطن الصبر فيقارب حالك حال الجاهلين بأن تسلك سبيلهم ، عن الجبائي . إن هذا نفي للجهل عنه ، أي : لا تكن جاهلا بعد أن أتاك العلم بأحوالهم ، وأنهم لا يؤمنون . والمراد : فلا تجزع ، ولا تتحسر لكفرهم وإعراضهم عن الإيمان ، وغلظ الخطاب تبعيدا وزجرا عن هذه الحال .
ثم بين سبحانه الوجه الذي لأجله لا يجتمع هؤلاء الكفار على الايمان فقال :
{إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} ومعناه : إنما يستجيب إلى الإيمان بالله وما أنزل إليك من يسمع كلامك ، ويصغي إليك ، وإلى ما تقرأه عليه من القرآن ، ويتفكر في آياتك ، فإن من لم يتفكر ولم يستدل بالآيات ، بمنزلة من لم يسمع كما قيل :
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
وقال الآخر " أصم عما ساءه سميع " {وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ} يريد : إن الذين لا يصغون إليك من هؤلاء الكفار ، ولا يتدبرون فيما تقرأه عليهم ، وتبينه لهم من الآيات والحجج ، بمنزلة الموتى ، فكما أيست أن تسمع الموتى كلامك إلى أن يبعثهم الله ، فكذلك فآيس من هؤلاء أن يستجيبوا لك ، وتقديره : إنما يستجيب المؤمن السامع للحق ، فأما الكافر فهو بمنزلة الميت ، فلا يجيب إلى أن يبعثه الله يوم القيامة ، فيلجئه إلى الإيمان ، وقيل : معناه إنما يستجيب من كان قلبه حيا ، فأما من كان قلبه ميتا فلا . ثم وصف الموتى بأنه يبعثهم ، ويحكم فيهم {ثُمَّ إِلَيْهِ} أي : إلى حكمه {يُرْجَعُونَ} وقيل : معناه يبعثهم الله من القبور ، ثم يرجعون إلى موقف الحساب .
ثم عاد سبحانه إلى حكاية أقوال الكفار ، فقال عاطفا على ما تقدم {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ} هذا إخبار عن رؤساء قريش لما عجزوا من معارضته فيما أتى به من القرآن ، اقترحوا عليه مثل آيات الأولين ، كعصا موسى ، وناقة ثمود ، فقال سبحانه في موضع آخر {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ} [العنكبوت : 51] وقال ههنا : {قل} يا محمد {إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً} أي : آية تجمعهم على هدى ، عن الزجاج ، وقيل : آية كما يسألونها .
{وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} ما في إنزالها من وجوب الاستئصال لهم إذا لم يؤمنوا عند نزولها ، وما في الاقتصار بهم على ما أوتوه من الآيات من المصلحة .
وقيل : معناه ولكن أكثرهم لا يعلمون أن فيما أنزلنا من الآيات مقنعا وكفاية لمن نظر وتدبر .
وقد اعترضت الملحدة على المسلمين بهذه الآية فقالوا : إنها تدل على أن الله تعالى لم ينزل على محمد آية ، إذ لو نزلها لذكرها عند سؤال المشركين إياها ! فيقال لهم : قد بينا أنهم التمسوا آية مخصوصة ، وتلك لم يؤتوها ، لأن المصلحة منعت عن ايتائها ، وقد أنزل الآيات الدالة على نبوته من القرآن ، وآتاهم من المعجزات الباهرة التي شاهدوها ، ما لو نظروا فيها ، أو في بعضها ، حق النظر ، لعرفوا صدقه ، وصحة نبوته وقد بين في آية أخرى ، أنه لو أنزل عليهم ما التمسوه ، لم يؤمنوا فقال : {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ} [الأنعام : 111] إلى قوله : {مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا} [الأنعام : 111] ، وفي موضع آخر {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ} [العنكبوت : 50] يعني في قدرة الله ، ينزل منها ما يشاء ، ويسقط ما اعترضوا به .
____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 42-47 .
2 . أثوى بالمكان : أقام ، وقتيلة : امرأة . وقوله : فمضى الضمير فيه يعود إلى العاشق . وفي اللسان (فمضت) أي : مضت الليلة .
3 . اللبة : موضع القلادة من الصدر . وقرن الشمس : أول ما يبدو منها .
{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ} . الخطاب للنبي (صلَّ الله عليه وآله) ، وقد للتحقيق ، ونعلم بمعنى علمنا ، وضمير يقولون راجع إلى الذين كذبوا النبي (صلَّ الله عليه وآله) ، أما الذي يقولون ، بل قالوه بالفعل فهو ما أشار إليه سبحانه في الآية 14 من الدخان : {ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} . والآية 2 من يونس : {قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ} إلى غير ذلك من الآيات .
{فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ ولكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} . كل من حارب محقا ، لأنه على حق فقد حارب الحق بالذات ، وكل من استخف برسول ، لأنه يحمل رسالة المرسل فقد استخف بمن أرسله ، لا بشخص الرسول . . وكان مشركو مكة يسمون محمدا (صلَّ الله عليه وآله) الصادق الأمين قبل الرسالة ، ولما جاءهم برسالة اللَّه ، وأقام عليهم الحجة تصدوا لحربه ، وقالوا : ساحر مجنون . . فتكذيبهم له ، والحال هذه ، تكذيب لرسالة اللَّه وآياته ، ولا شيء أدل على ذلك من قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهً يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح - 10] .
{ولَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا} . يقول سبحانه لنبيه : ان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ، وأوذوا في سبيل رسالته ، فصبروا على الإيذاء ، حتى أتاهم النصر ، فاصبر أنت كما صبروا ، واللَّه ينصرك كما نصرهم . .
هذا هو المحور الذي تدور عليه الحياة ، صراع بين الخير والشر ، والحق والباطل ، ومحال أن يناصر الحق مناصر ، ولا يلقى الأذى من أعداء الحق . .
وأيضا لا ينتصر الحق إلا إذا وجد أنصارا يصبرون على الجهاد في سبيله ، ويدفعون ثمنه من أنفسهم وأهلهم وأموالهم ، سنة اللَّه ، ولن تجد لسنة اللَّه تبديلا ، وهذا هو معنى قوله تعالى : {ولا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ} .
ولا أعرف عصرا بلغ فيه المبطلون من القوة كهذا العصر الذي نعيش فيه ، فقد أقاموا في كل بقعة قواعد للحرب ، وأوكارا للتخريب ، وتسلحوا بأشد الأسلحة فتكا ، وأكثرها دمارا ، وسيطروا على مقدرات الشعوب المستضعفة ، والبنوك والمصارف ، والصحف والمطابع ، ودور النشر والتوزيع إلا ما ندر ، حتى وجد المخلص الأمين نفسه معزولا منبوذا لا يستطيع أن ينشر مقالا حرا ، أو يذيع من وسائل الإذاعة كلمة حق ، أما الخائن فأين اتجه يجد الترحيب والإكبار .
{ولَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَأ الْمُرْسَلِينَ} . أي لقد قصصنا عليك من قبل ما لاقى الأنبياء من أقوامهم ، وكيف صبروا على التكذيب والأذى ، وان النصر في النهاية كان لهم على المكذبين ، وهذه السنة تجري عليك ، تماما كما جرت عليهم . .
ولا مبدل لكلمات اللَّه .
{وإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ} . هذه الآية نظير قوله تعالى مخاطبا نبيه الأكرم : {فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهً عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ} [فاطر - 8] ، كل منهما تصور الحرقة والألم الذي كان الرسول الأعظم يعانيه من اعراض المشركين عن دعوته ، وكل منهما يهدف إلى التخفيف والتسرية عنه صلى اللَّه عليه وآله . .
لاقى النبي من قومه ما يذهب بحلم الحليم ، فصبر واحتسب ، ولم يدع عليهم ، بل دعا لهم ، وقال : اللهم اغفر لقومي ، انهم لا يعلمون ومع ذلك كان يتألم ويتوجع لكفرهم ، فخاطبه اللَّه بهذه الآية ليخفف عنه ، وييأس منهم ، ويصرف النظر عنهم ، ثم ينتظر قليلا ليرى كيف تكون عاقبة المكذبين .
{ولَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى} . قال الرازي : يدل هذا على انه تعالى لا يريد الايمان من الكافر ، بل يريد إبقاءه على الكفر .
ويلاحظ بأن هذا هو الظلم بعينه ، واللَّه سبحانه ليس بظلام للعبيد ، والصحيح في معنى هذه الجملة ان اللَّه سبحانه لا يريد أن يلجئ أحدا إلى الايمان به ، بل يدع الخيار له بعد أن يقيم الحجة عليه بالدلائل والبينات ، ولو أراد الايمان من عباده بإرادة كُنْ فَيَكُونُ ما كفر واحد منهم ، ولكن شاءت حكمته تعالى أن يتدخل في شؤون الناس كآمر وناصح ، لا كخالق وقاهر . وسبق التفصيل والتوضيح عند تفسير الآية 26 من سورة البقرة ، فقرة التكوين والتشريع ح 1 ص 72 .
{فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ} . وكيف يكون الرسول الأعظم من الجاهلين ، وأخلاقه أخلاق القرآن ؟ . وإنما ساغ هذا الخطاب لأشرف الخلق ، لأنه من خالق الخلق ، لا من النظير والمثيل {إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ والْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} . هذه الآية نظير قوله تعالى : {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} [النّمل - 80] ، والمعنى ان الذين تحرص على هداهم يا محمد لا يسمعون منك سماع فهم وتدبر ، لأن حب الدنيا جعلهم كالموتى . . والموتى لا ينبغي أن يخاطبوا بشيء ، بل يتركوا وشأنهم إلى يوم القيامة ، حيث يرون العذاب الذي لا يجدون عنه مهربا .
{وقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ} .
وتسأل : كيف قالوا هذا ، مع ان اللَّه قد أنزل على محمد (صلَّ الله عليه وآله) العديد من الآيات والبينات ؟ .
الجواب : ان المراد بالآية هنا المعجزة التي اقترحوها ، وجعلوها شرطا لإيمانهم بمحمد (صلَّ الله عليه وآله) ، ولم يريدوا آية تقنع طالب الحق لوجه الحق ، ولو أرادوها لكانوا في غنى عن قولهم : لو لا نزل عليه آية {قُلْ إِنَّ اللَّهً قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً} من النوع الذي اقترحوه ، ولكنه تعالى لا ينزلها تلبية للشهوات والأهواء ، وانما ينزل الآيات على ما تقتضيه حكمته جل وعلا {ولكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} ان اللَّه ينزل الآية حسب حكمته ، لا حسب أهواء الناس .
____________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 181-184 .
تسلية للنبي (صلَّ الله عليه وآله) عن هفوات المشركين في أمر دعوته ، وتطييب لنفسه بوعد النصر الحتمي ، وبيان أن الدعوة الدينية إنما ظرفها الاختيار الإنساني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالقدرة والمشية الإلهية الحاتمتان لا تداخلان ذلك حتى تجبراهم على القبول ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى .
قوله تعالى : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ} إلى آخر الآية ، (قد) حرف تحقيق في الماضي ، وتفيد في المضارع التقليل وربما استعملت فيه أيضا للتحقيق ، وهو المراد في الآية ، وحزنه كذا وأحزنه بمعنى واحد ، وقد قرئ بكلا الوجهين .
وقوله : {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ} قرئ بالتشديد من باب التفعيل ، وبالتخفيف ، والظاهر أن الفاء في قوله : {فَإِنَّهُمْ} للتفريع وكأن المعنى قد نعلم أن قولهم ليحزنك لكن لا ينبغي أن يحزنك ذلك فإنه ليس يعود تكذيبهم إليك لأنك لا تدعو إلا إلينا وليس لك فيه إلا الرسالة بل هم يظلمون بذلك آياتنا ويجحدونها .
فما في هذه الآية مع قوله في آخر الآيات : {ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} في معنى قوله تعالى : {وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ} [لقمان : 23] وقوله : {فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ} [يس : 76] وغير ذلك من الآيات النازلة في تسليته(صلَّ الله عليه وآله)، هذا على قراءة التشديد .
وأما على قراءة التخفيف فالمعنى : لا تحزن فإنهم لا يظهرون عليك بإثبات كذبك فيما تدعو إليه ، ولا يبطلون حجتك بحجة وإنما يظلمون آيات الله بجحدها وإليه مرجعهم .
وقوله : {وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ} كان ظاهر السياق أن يقال : ولكنهم ، فالعدول إلى الظاهر للدلالة على أن الجحد منهم إنما هو عن ظلم منهم لا عن قصور وجهل وغير ذلك فليس إلا عتوا وبغيا وطغيانا وسيبعثهم الله ثم إليه يرجعون .
ولذلك وقع الالتفات في الكلام من التكلم إلى الغيبة فقيل : {بِآياتِ اللهِ} ولم يقل : بآياتنا ، للدلالة على أن ذلك منهم معارضة مع مقام الألوهية واستعلاء عليه وهو المقام الذي لا يقوم له شيء .
وقد قيل في تفسير معنى الآية وجوه أخرى :
أحدها : ما عن الأكثر أن المعنى : لا يكذبونك بقلوبهم اعتقادا ، وإنما يظهرون التكذيب بأفواههم عنادا .
وثانيها : أنهم لا يكذبونك وإنما يكذبونني فإن تكذيبك راجع إلي ولست مختصا به ، وهذا الوجه غير ما قدمناه من الوجه وإن كان قريبا منه ، والوجهان جميعا على قراءة التشديد .
وثالثها : أنهم لا يصادفونك كاذبا تقول العرب : قاتلناهم فما أجبناهم أي ما صادفناهم جبناء ، والوجه ما تقدم .
قوله تعالى : {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا} إلى آخر الآية . هداية له(صلَّ الله عليه وآله)إلى سبيل من تقدمه من الأنبياء ، وهو سبيل الصبر في ذات الله ، وقد قال تعالى : {أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ} [ الأنعام : 90 ] .
وقوله : {حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا} بيان غاية حسنة لصبرهم ، وإشارة إلى الوعد الإلهي بالنصر ، وفي قوله : {وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ} تأكيد لما يشير إليه الكلام السابق من الوعد وحتم له ، وإشارة إلى ما ذكره بقوله : {كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} [المجادلة : 21] ، وقوله : {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ} [الصافات : 172] .
ووقوع المبدل في قوله : {وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ} في سياق النفي ينفي أي مبدل مفروض سواء كان من ناحيته تعالى بأن يتبدل مشيته في خصوص كلمة بأن يمحوها بعد إثباتها أو ينقضها بعد إبرامها أو كان من ناحية غيره تعالى بأن يظهر عليه ويقهره على خلاف ما شاء فيبدل ما أحكم ويغيره بوجه من الوجوه .
ومن هنا يظهر أن هذه الكلمات التي أنبأ سبحانه عن كونها لا تقبل التبديل أمور خارجة عن لوح المحو والإثبات ، فكلمة الله وقوله وكذا وعده في عرف القرآن هو القضاء الحتم الذي لا مطمع في تغييره وتبديله ، قال تعالى : {قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ} [ص : 84] وقال تعالى : {وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ} [الأحزاب : 4] وقال تعالى : {أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ} [يونس : 55] وقال تعالى : {لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ} [الزمر : 20] وقد مر البحث المستوفى في معنى كلمات الله تعالى وما يرادفها من الألفاظ في عرف القرآن في ذيل قوله تعالى : {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ} [البقرة : 253] .
وقوله في ذيل الآية : {وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} تثبيت واستشهاد لقوله :
{وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} إلخ ، ويمكن أن يستفاد منه أن هذه السورة نزلت بعد بعض السور المكية التي تقص قصص الأنبياء كسورة الشعراء ومريم وأمثالهما ، وهذه السور نزلت بعد أمثال سورة العلق والمدثر قطعا فتقع سورة الأنعام على هذا في الطبقة الثالثة من السور النازلة بمكة قبل الهجرة ، والله أعلم .
قوله تعالى : {وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ ـ إلى قوله ـ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ} قال الراغب : النفق الطريق النافذ والسرب في الأرض النافذ فيه قال : {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ} ، ومنه نافقاء اليربوع ، وقد نافق اليربوع ونفق ، ومنه النفاق وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب ، وعلى ذلك نبه بقوله : {إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ} أي الخارجون من الشرع ، وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال : {إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} ، ونيفق السراويل معروف ، انتهى .
وقال : السلم ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسما لكل ما يتوصل به إلى شيء رفيع كالسبب قال تعالى : {أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ} ، وقال : {أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ} ، وقال الشاعر : ولو نال أسباب السماء بسلم ، . انتهى .
وجواب الشرط في الآية محذوف للعلم به ، والتقدير كما قيل : وإن استطعت أن تبتغي كذا وكذا فافعل .
والمراد بالآية في قوله تعالى : {فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ} الآية التي تضطرهم إلى الإيمان فإن الخطاب عنى قوله : {وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ} إلخ ، إنما ألقي إلى النبي (صلَّ الله عليه وآله) من طريق القرآن الذي هو أفضل آية إلهية تدل على حقية دعوته ، ويقرب إعجازه من فهمهم وهم بلغاء عقلاء فالمراد أنه لا ينبغي أن يكبر ويشق عليك إعراضهم فإن الدار دار الاختيار ، والدعوة إلى الحق وقبولها جاريان على مجرى الاختيار ، وأنك لا تقدر على الحصول على آية توجب عليهم الإيمان وتلزمهم على ذلك فإن الله سبحانه لم يرد منهم الإيمان إلا على اختيار منهم فلم يخلق آية تجبر الناس على الإيمان والطاعة ، ولو شاء الله لآمن الناس جميعا فالتحق هؤلاء الكافرون بالمؤمنين بك فلا تبتئس ولا تجزع بإعراضهم فتكون من الجاهلين بالمعارف الإلهية .
وأما ما احتمله بعضهم : أن المراد : فتأتيهم بآية هي أفضل من الآية التي أرسلناك بها أي القرآن فلا تلائمه سياق الآية وخاصة قوله {وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى} فإنه ظاهر في الاضطرار .
ومن هنا يظهر أن المراد بالمشية أن يشاء الله منهم الاهتداء إلى الإيمان فيضطروا إلى القبول فيبطل بذلك اختيارهم هذا ما يقتضيه ظاهر السياق من الآية الشريفة .
لكنه سبحانه فيما يشابه الآية من كلامه لم يبن عدم مشيته ذلك على لزوم الاضطرار كقوله تعالى : {وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها ، وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [السجدة : 13] يشير تعالى بذلك إلى نحو قوله : {قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص : 85] فبين تعالى أن عدم تحقق مشيته لهداهم جميعا إنما هو لقضائه ما قضى تجاه ما أقسم عليه إبليس أنه سيغويهم أجمعين إلا عباده منهم المخلصين .
وقد أسند القضاء في موضع آخر إلى غوايتهم قال تعالى في قصة آدم وإبليس : {قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ، إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر : 43] وقد نسب ذلك إليهم إبليس أيضا فيما حكى الله سبحانه من كلامه لهم يوم القيامة : {وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ـ إلى أن قال ـ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ} [إبراهيم : 22] .
فالآيات تبين أن المعاصي ومنها الشرك تنتهي إلى غواية الإنسان والغواية تنتهي إلى نفس الإنسان ، ولا ينافي ذلك ما يظهر من آيات أخر أن الإنسان ليس له أن يشاء إلا أن يشاء الله منه المشية كقوله تعالى : {إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً ، وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ} [ الإنسان : 30 ] ، وقال تعالى : {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ ، لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ، وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ} [التكوير : 29] .
فمشية الإنسان في تحققها وإن توقفت على مشية الله سبحانه إلا أن الله سبحانه لا يشاء منه المشية إلا إذا استعد لذلك بحسن سريرته ، وتعرض منه لرحمته ، قال تعالى : {وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ} [الرعد : 27] أي انعطف ورجع إليه ، وأما الفاسق الزائغ قلبه المخلد إلى الأرض المائل إلى الغواية فإن الله لا يشاء هدايته ولا يغشاه برحمته كما قال : {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ} [البقرة : 26] وقال : {فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف : 5] وقال : {وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ} [الأعراف : 176] .
وبالجملة فالدعوة الدينية لا تسلك إلا سبيل الاختيار ، والآيات الإلهية لا تنزل إلا مع مراعاة الاختيار ، ولا يهدي الله سبحانه إليه إلا من تعرض لرحمته واستعد لهدايته من طريق الاختيار .
وبهذا تنحل شبهة أخرى لا تخلو عن إعضال ، وهي أنا سلمنا أن إنزاله تعالى آية تجبرهم على الإيمان وتضطرهم إلى قبول الدعوة الدينية ينافي أساس الاختيار الذي تبتني عليه بنية الدعوة الدينية لكن لم لا يجوز أن يشاء الله إيمان الناس جميعا على حد مشيته إيمان من آمن منهم بأن يشاء من الجميع أن يشاءوا كما شاء من المؤمنين خاصة أن يشاءوا ثم ينزل آية تسوقهم إلى الهدى ، وتلبسهم الإيمان من غير أن يبطل بذلك اختيارهم وحريتهم في العمل .
وذلك أنه وإن أمكن ذلك بالنظر إلى نفسه لكنه ينافي الناموس العام في عالم الأسباب ، ونظام الاستعداد والإفاضة فالهدى إنما يفاض على من اتقى الله وزكى نفسه وقد أفلح من زكاها ولا يصيب الضلال إلا من أعرض من ذكر ربه ودس نفسه وقد خاب من دساها ، وأصابه الضلال هو أن يمنع الإنسان الهدى قال تعالى : {مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً ، وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ، كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً} [الإسراء : 20] أي ممنوعا فالله سبحانه يمد كل نفس من عطائه بما يستحقه فإن أراد الخير أوتيه وإن أراد الشر أوتيه أي منع من الخير ، ولو شاء الله لكل نفس صالحة أو طالحة أن تشاء الخير وتنكب على الإيمان والتقوى من طريق الاختيار كان في ذلك إبطال النظام العام وإفساد أمر الأسباب .
وتؤيد ما ذكر الآية التالية أعني قوله تعالى : {إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} إلى آخر الآية على ما سيجيء من معناها .
قوله تعالى : {إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} الآية كالبيان لقوله : {وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ} إلى آخر الآية فإن ملخصه أنك لا تستطيع صرفهم عن هذا الإعراض ، والحصول على آية تسوقهم إلى الإيمان ، فبين في هذه الآية أنهم بمنزلة الموتى لا شعور لهم ولا سمع حتى يشعروا بمعنى الدعوة الدينية ويسمعوا دعوة الداعي وهو النبي ص .
فهذه الهياكل المتراءات من الناس صنفان : صنف منهم أحياء يسمعون ، وإنما يستجيب الذين يسمعون ، وصنف منهم أموات لا يسمعون وإن كانوا ظاهرا في صور الأحياء وهؤلاء يتوقف سمعهم الكلام على أن يبعثهم الله ، وسوف يبعثهم فيسمعون ما لم يستطيعوا سمعه في الدنيا كما حكاه الله عنهم بقوله : {وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ} [السجدة : 12] .
فالكلام مسوق سوق الكناية ، والمراد بالذين يسمعون المؤمنون وبالموتى المعرضون عن استجابة الدعوة من المشركين وغيرهم ، وقد تكرر في كلامه تعالى وصف المؤمنين بالحياة والسمع ، ووصف الكفار بالموت والصمم كما قال تعالى : {أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها} [الأنعام : 122] وقال تعالى : {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ} [النمل : 81] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة .
وقد تكرر في بعض الأبحاث السابقة معنى آخر لهذه الأوصاف التي حملها الجمهور من المفسرين على الكناية والتشبيه ، وأن لها معنى من الحقيقة فليراجع .
وفي الآية دلالة على أن الكفار والمشركين سيفهمهم الله الحق ويسمعهم دعوته في الآخرة كما فهم المؤمنين وأسمعهم في الدنيا ، فالإنسان مؤمنا كان أو كافرا لا مناص له عن فهم الحق عاجلا أو آجلا .
قوله تعالى : {وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ} إلى آخر الآية ، تحضيض منهم على تنزيل الآية بداعي تعجيز النبي(صلَّ الله عليه وآله)، ولما صدر هذا القول منهم وبين أيديهم أفضل الآيات أعني القرآن الكريم الذي كان ينزل عليهم سورة سورة وآية آية ، ويتلى عليهم حينا بعد حين تعين أن الآية التي كانوا يقترحونها بقولهم : {لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ} هي آية غير القرآن ، وأنهم كانوا لا يعدونه آية تقنعهم وترتضيه نفوسهم بما لها من المجازفات والتهوسات .
وقد حملهم التعصب لآلهتهم أن ينقطعوا عن الله سبحانه كأنه ليس بربهم ، فقالوا : {لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ} ولم يقولوا : من ربنا أو من الله ونحوهما إزراء بأمره وتأكيدا في تعجيزه أي لو كان ما يدعيه ويدعو إليه حقا فليغر له ربه الذي يدعو إليه ولينصره ولينزل عليه آية تدل على حقية دعواه .
والذي بعثهم إلى هذا الاقتراح جهلهم بأمرين : أحدهما : أن الوثنية يرون لآلهتهم استقلالا في الأمور المرجوعة إليهم في الكون مع ما يدعون لهم من مقام الشفاعة فإله الحرب أو السلم له ما يدبره من الأمر من غير أن يختل تدبيره من ناحية غيره ، وكذلك إله البر وإله البحر وإله الحب وإله البغض وسائر الآلهة ، فلا يبقى لله سبحانه شأن يتصرف فيه فقد قسم الأمر بين أعضاده وإن كان هؤلاء شفعاءه وهو رب الأرباب ، فليس يسعه تعالى أن يبطل أمر آلهتهم بإنزال آية تدل على نفي ألوهيتها .
وكان يحضهم على هذه المزعمة ويؤيد هذا الاعتقاد في قلوبهم ما كانوا يتلقونه من يهود الحجاز أن يد الله مغلولة لا سبيل له إلى تغيير شيء من النظام الجاري ، وخرق العادة المألوفة في عالم الأسباب .
وثانيهما : أن الآيات النازلة من عند الله سبحانه إذا كانت مما خص الله به رسولا من رسله من غير أن يقترحه الناس فإنما هي بينات تدل على صحة دعوى الرسول من غير أن يستتبع محذورا للناس المدعوين كالعصا واليد البيضاء لموسى وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير لعيسى ، والقرآن الكريم لمحمد ص .
لكن الآية لو كانت مما اقترحها الناس فإن سنة الله جرت على القضاء بينهم بنزولها فإن آمنوا بها وإلا نزل عليهم العذاب ولم ينظروا بعد ذلك كآيات نوح وهود وصالح وغير ذلك ، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على ذلك ، كقوله تعالى : {وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ} [الأنعام : 8] وقوله : {وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها} [الإسراء : 59] .
وقد أشير في الآية الكريمة أعني قوله : {وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} ، إلى الجهتين جميعا .
فذكر أن الله قادر على أن ينزل أي آية شاء ، وكيف يمكن أن يفرض من هو مسمى باسم (الله) ولا تكون له القدرة المطلقة ، وقد بدل في الجواب لفظة (الرب) إلى اسم (الله) للدلالة على برهان الحكم ، فإن الألوهية المطلقة تجمع كل كمال من غير أن تحد بحد أو تقيد بقيد فلها القدرة المطلقة ، والجهل بالمقام الألوهي هو الذي بعثهم إلى اقتراح الآية بداعي التعجيز .
على أنهم جهلوا أن نزول ما اقترحوه من الآية لا يوافق مصلحتهم ، وأن اجتراءهم
على اقتراحها تعرض منهم لهلاك جمعهم وقطع دابرهم ، والدليل على أن هذا المعنى منظور إليه بوجه في الكلام قوله تعالى في ذيل هذه الاحتجاجات : {قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ} [الأنعام : 58] .
وفي قوله تعالى : {نُزِّلَ} و {يُنَزِّلَ} مشددين من التفعيل دلالة على أنهم اقترحوا آية تدريجية أو آيات كثيرة تنزل واحدة بعد واحدة كما يدل عليه ما حكي من اقتراحهم في موضع آخر من كلامه تعالى كقوله : {وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ ـ إلى أن قال ـ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ} الآيات : [ الإسراء : 93 ] وقوله : {وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا} [الفرقان : 21] وقوله : {وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً} [الفرقان : 32] .
وروي عن ابن كثير أنه قرأ بالتخفيف .
__________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 52-61 .
قال تعالى : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} [الانعام : 33-34] .
المصلحون يواجهون الصعاب دائما :
لا شك أنّ رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) في نقاشاته المنطقية ومحاوراته الفكرية مع المشركين المعاندين المتصلبين ، كان يواجه منهم المعاندة واللجاجة والتصلب والتعنت ، بل كانوا يرشقونه بتهمهم ، ولذلك كله كان النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) يشعر بالغم والحزن ، والله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن يواسي النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ويصبّره على ذلك ، لكي يواصل مسيرته بقلب أقوى وجأش أربط ، كما جاء في هذه الآية : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ} ، فاعلم أنّهم لا ينكرونك أنت ، بل هم ينكرون آيات الله ، ولا يكذبونك بل يكذبون الله : {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ} .
ومثل هذا القول شائع بيننا ، فقد يرى «رئيس» أنّ «مبعوثه» إلى بعض الناس عاد غاضبا ، فيقول له : «هوّن عليك ، فان ما قالوه لك إنّما كان موجها إليّ ، وإذا حصلت مشكلة فأنّا المقصود بها ، لا أنت» وبهذا يسعى إلى مواساة صاحبه والتهوين عليه .
ثمّة مفسّرون يرون للآية تفسيرا آخر ، لكن ظاهر الآية هو هذا الذي قلناه ، ولكن لا بأس من معرفة هذا الاحتمال القائل بأن معنى الآية هو : إنّ الذين يعارضونك هم في الحقيقة مؤمنون بصدقك ولا يشكون في صحة دعوتك ، ولكن الخوف من تعرض مصالحهم للخطر هو الذي يمنعهم من الرضوخ للحق ، أو أنّ الذي يحول بينهم وبين التسليم هو التعصب والعناد .
يتبيّن من كتب السيرة أنّ الجاهليين ـ بما فيهم أشدّ المعارضين للدّعوة ـ كانوا يعتقدون في أعماقهم بصدق الدعوة ، ومن ذلك ما روي أنّ رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) لقي أبا جهل فصافحه أبو جهل ، فقيل له في ذلك ، فقال : والله إني لأعلم أنّه صادق ، ولكنا متى كنّا تبعا لعبد مناف ! (أي أنّ قبول دعوته سيضطرنا إلى اتباع قبيلته).
وورد في كتب السيرة أنّ أبا جهل جاء في ليلة متخفيا يستمع قراءة النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، كما جاء في الوقت نفسه أبو سفيان والأخنس بن شريق ، ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوا إلى الصباح ، فلمّا فضحهم الصبح تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقال كل منهم للآخر ما جاء به ، ثمّ تعاهدوا أن لا يعودوا ، لما يخافون من علم شبان قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيئهم ، فلمّا كانت الليلة الثّانية جاء كل منهم ظانا أنّ صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود ، فلمّا أصبحوا جمعتهم الطريق مرّة ثانية فتلاوموا ، ثمّ تعاهدوا أن لا يعودوا ، فلمّا كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضا ، فلما أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودا لمثلها ، ثمّ تفرقوا فلمّا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثمّ خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : اخبرني ـ يا أبا حنظلة ـ عن رأيك فيما سمعت من محمّد؟
قال : يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ، ما عرفت معناها ولا ما يراد بها .
قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به .
ثمّ خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمّد ؟
قال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد المناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا (أي أعطوا الناس ما يركبونه) فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنّا كفرسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ، ولا نصدقه ، فقام عنه الأخنس وتركه .
وروي أنّه التقى أخنس بن شريق ، وأبو جهل بن هشام فقال له : يا أبا الحكم ، اخبرني عن محمّد أصادق هو أم كاذب ، فإنّه ليس هاهنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا ، فقال أبو جهل : ويحك والله إنّ محمّدا لصادق وما كذب قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والندوة والنّبوة فما ذا يكون لسائر قريش ؟! (2) .
يتبيّن من هذه الرّوايات وأمثالها أنّ كثيرا من أعداء رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) الألداء كانوا في باطنهم يعترفون بصدق ما يقول ، إلّا أنّ التنافس القبلي وما إلى ذلك ، لم يكن يسمح لهم بإعلان ما يعتقدون ، أو لم تكن لديهم الشجاعة على ذلك .
إنّنا نعلم أنّ مثل هذا الإعتقاد الباطني ما لم يصاحبه التسليم ، لن يكون له أي أثر ، ولا يدخل الإنسان في زمرة المؤمنين الصادقين .
الآية الثّانية تستأنف مواساة الرّسول (صلَّ الله عليه وآله وسلم) وتبيّن له حال من سبقه من الأنبياء ، وتؤكّد له أنّ هذا ليس مقتصرا عليه وحده ، فالأنبياء قبله نالهم من قومهم مثل ذلك أيضا : {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} .
ولكنّهم صبروا وتحملوا حتى انتصروا بعون الله : {فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا} وهذه سنة إلهية لا قدرة لأحد على تغييرها : {وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ} .
وعليه ، فلا تجزع ولا تبتئس إذا ما كذبك قومك وآذوك ، بل اصبر على معاندة الأعداء وتحمل أذاهم ، واعلم أنّ الإمدادات والألطاف الإلهية ستنزل بساحتك بموجب هذه السنة ، فتنتصر في النهاية عليهم جميعا ، وإنّ ما وصلك من أخبار الأنبياء السابقين عن مواجهتهم الشدائد والمصاعب وعن ثباتهم وصبرهم وانتصارهم في النهاية ، لهو شهادة بيّنة لك : {وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} .
تشير هذه الآية ـ في الواقع ـ إلى مبدأ عام هو أنّ قادة المجتمع الصالحين الذين يسعون لهداية الشعوب عن طريق الدعوة إلى مبادئ وتعاليم بناءة ، وبمحاربة الأفكار المنحطة والخرافات السائدة والقوانين المغلوطة في المجتمع ، يواجهون معارضة شديدة من جانب فريق الانتهازيين الذين يرون في انتشار تلك التعاليم والمبادئ البناءة خطرا يتهدد مصالحهم ، فلا يتركون وسيلة إلّا استخدموها لترويج أهدافهم المشؤومة ، ولا يتورعون حتى عن التوسل بالتكذيب والاتهام ، والحصار الاجتماعي ، والإيذاء والتعذيب ، والسلب والنهب ، والقتل ، وبكل ما يخطر لهم من سلاح لمحاربة أولئك المصلحين .
إلّا أنّ الحقيقة ، بما فيها من قوة الجاذبية والعمق ، وبموجب السنة الإلهية ، تعمل عملها وتزيل من الطريق كل تلك الأشواك ، إلّا أنّ شرط هذا الإنتصار هو الصبر والمقاومة والثبات .
تعبر هذه الآية عن السنن بعبارة «كلمات الله» ، لأنّ الكلم والكلام في الأصل التأثير المدرك بإحدى الحاستين ، السمع أو البصر ، فالكلام مدرك بحاسة السمع ، والكلم بحاسة البصر ، وكلمته : جرحته جراحة بان تأثيرها ، ثمّ كان توسع في إطلاق «الكلمة» على الألفاظ والمعاني وحتى على العقيدة والسلوك والسنة والتعاليم .
{وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ * إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [الانعام : 35-36] .
الأموات المتحركون :
هاتان الآيتان استمرار لمواساة النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) التي بدأت في الآيات السابقة لقد كان رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) يشعر بالحزن العميق لضلال المشركين وعنادهم ، وكان يود لو أنّه استطاع أن يهديهم جميعا إلى طريق الإيمان بأية وسيلة كانت .
فيقول الله تعالى : {وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ} (3) . أي إذا كان إعراض هؤلاء المشركين يصعب ويثقل عليك ، فشق أعماق الأرض أو ضع سلّما يوصلك إلى السماء للبحث عن آية ـ إن استطعت ـ ولكن اعلم أنّهم مع ذلك لن يؤمنوا بك .
«النفق» في الأصل «النقب» وهو الطريق النافذ ، والسرب في الأرض النافذ فيها ، ومنه النفاق ، وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب ، أي أنّ للمنافق سلوكا ظاهرا وآخر خفيا .
في هذه الآية يخبر الله نبيّه بأن ليس في تعليماتك ودعوتك وسعيك أي نقص ، بل النقص فيهم لأنّهم هم الذين رفضوا قبول الحقّ ، لذلك فانّ أي مسعى من جانبك لن يكون له أثر فلا تقلق .
ولكن لكيلا يظن أحد أنّ الله غير قادر على حملهم على التسليم يقول : {وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى} أي لو أراد حملهم على الاستسلام والرضوخ لدعوتك والإيمان بالله لكان على ذلك قديرا .
غير أنّ الإيمان الإجباري لا طائل تحته ، إنّ خلق البشر للتكامل مبني على أساس حرية الإختيار والإرادة ، ففي حالة حرية الإختيار وحدها يمكن تمييز «المؤمن» من «الكافر» ، و «الصالح» من «غير الصالح» و «المخلص» من «الخائن» و «الصادق» من «الكاذب» . أمّا في الإيمان الإجباري فلن يكن ثمّة اختلاف بين الطيب والخبيث ، وعلى صعيد الإجبار تفقد كل هذه المفاهيم معانيها تماما .
ثمّ يقول سبحانه لنبيّه : {فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ} ، أي لقد قلت هذا لئلا تكون من الجاهلين ، أي لا تفقد صبرك ولا تجزع ، ولا يأخذك القلق بسبب كفرهم وشركهم .
وما من شك أنّ النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) كان يعلم هذه الحقائق ولكن الله ذكرها له من باب التطمين وتهدئة الروع ، تماما كالذي نقوله نحن لمن فقد ابنه : لا تحزن فالدنيا فانية ، سنموت جميعا ، وأنت ما تزال شابا ولسوف ترزق بابن آخر ، فلا تجزع كثيرا .
فلا ريب أنّ فناء دار الدنيا ، أو كون المصاب شابا ليسا مجهولين عنده ، ولكنها أمور تقال للتذكير .
على الرّغم من أنّ هذه الآية من الآيات التي تنفي الإجبار والإكراه ، فإنّ بعض المفسّرين كالرّازي ، يعتبرها من الأدلة على «الجبر» ويستند إلى {وَلَوْ شاءَ . . .} ويقول : يتّضح من هذه الآية أنّ الله لا يريد للكفار أن يؤمنوا! ولكنّه غفل عن أنّ الإرادة والمشيئة في هذه الآية هما الإجباريتان ، أي أنّ الله لا يريد الناس أن يؤمنوا بالإجبار والإكراه ، بل يريدهم أن يؤمنوا باختيارهم وإرادتهم ، وعليه فانّ هذه الآية دليل قاطع يدحض مقوله «الجبريين» .
في الآية التي تليها استكمال لما سبق ومزيد من المواساة للرسول الكريم (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، فتقول الآية {إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} .
أمّا الذين هم في الواقع أشبه بالأموات فأنّهم لا يؤمنون حتى يبعثهم الله يوم القيامة : {وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} (4) .
يومئذ ، وبعد أن يروا مشاهد يوم القيامة يؤمنون ، إلّا أنّ إيمانهم ذاك لا ينفعهم شيئا ، لأنّ رؤية مناظر يوم القيامة العظيمة تحمّل كل مشاهد على الإيمان فيكون نوعا من الإيمان الاضطراري .
ومن نافلة القول أنّ «الموتى» في هذه الآية لا تشير إلى الموت الجسماني في الأفراد ، بل الموت المعنوي ، فالحياة والموت نوعان : حياة وموت عضويان ، وحياة وموت معنويان ، كذلك أيضا السمع والبصر ، عضويان ومعنويان فكثير ما نصف المبصرين السامعين الأحياء الذين لا يدركون الحقائق بأنّهم عمي أو صم أو حتى أموات ، إذ إنّ رد الفعل الذي يصدر عادة من الإنسان الحي البصير السامع إزاء الحقائق لا يصدر من هؤلاء .
أمثال هذه التعبيرات كثيرة في القرآن ، ولها عذوبة ، وجاذبية خاصّة ، بل إنّ القرآن لا يعير أهمية كبيرة للحياة المادية البايلوجية التي تتمثل في «الأكل والنوم والتنفس» وإنّما يعني أشد العناية بالحياة الإنسانية المعنوية التي تتمثل في تحمل التكاليف والمسؤولية والإحساس واليقظة والوعي .
لا بدّ من القول أيضا : إنّ المعنوي من العمى والصمم والموت ينشأ من ذات الأفراد ، لأنّهم ـ لاستمرارهم في الإثم وإصرارهم عليه وعنادهم ـ يصلون إلى تلك الحالة .
إنّ من يغمض عينيه طويلا يصل إلى حالة يفقد فيها تدريجيا قوة البصر ، وقد يبلغ به الأمر إلى العمى التام ، كذلك الذي يغمض عين روحه عن رؤية الحقائق طويلا يفقد بصيرته المعنوية شيئا فشيئا .
{وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [الانعام : 37] .
تشير هذه الآية إلى واحد من الأعذار التي يتذرع بها المشركون ، فقد جاء في بعض الرّوايات أنّه عند ما عجز بعض رؤساء قريش عن معارضة القرآن ومقابلته ، قالوا لرسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) : كل هذا الذي تقوله لا فائدة فيه ، إذا كنت صادقا فيما تقول : فأتنا بمعجزات كعصا موسى وناقة صالح ، يقول القرآن بهذا الشأن : {وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ} .
من الواضح أنّ أولئك لم يكونوا جادين في بحثهم عن الحقيقة ، لأنّ الرّسول (صلَّ الله عليه وآله وسلم) كان قد جاء لهم من المعاجز بما يكفي ، وحتى لو لم يأت بمعجز سوى القرآن الذي تحداهم في عدة آيات منه ودعاهم بصراحة إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ، لكان فيه الكفاية لإثبات نبوته ، غير أنّ هؤلاء المزيفين كانوا يبحثون عن عذر يتيح لهم إهانة القرآن من جهة ، والتملص من قبول دعوة الرّسول (صلَّ الله عليه وآله وسلم) من جهة أخرى ، لذلك كانوا لا يفتأون يطالبونه بالمعجزات ، ولو أنّ رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) استجاب لمطاليبهم لأنكروا كل ذلك بقولهم {هذا سِحْرٌ مُبِينٌ} ، كما جاء في آيات أخرى من القرآن ، لذلك يأمر الله رسوله أنّ : {قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً} إلّا أنّ في ذلك أمرا أنتم عنه غافلون ، وهو أنّه إذا حقق الله مطاليبكم التي يدفعكم إليها عنادكم ، ثمّ بقيتم على عنادكم ولم تؤمنوا بعد مشاهدتكم للمعاجز ، فسوف يقع عقاب الله عليكم جميعا ، وتفنون عن آخركم ، لأنّ ذلك سيكون منتهى الاستهتار بمقام الألوهية المقدس وبمبعوثه وآياته ومعجزاته ، ولهذا تنتهي الآية بالقول : {وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} .
إشكال :
يتبيّن من تفسير «مجمع البيان» أنّ بعض مناوئي الإسلام قد اتّخذوا من هذه الآية ـ منذ قرون عديدة ـ دليلا يستندون إليه في الزعم بأنّه لم تكن لرسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أية معجزة ، لأنّه كلما طلبوا منه معجزة كان يكتفي بالقول : إنّ الله قادر على ذلك ، ولكن أكثركم لا تعلمون ، وهذا ما نهجه بعض الكتاب المتأخرين فأحيوا هذه الفكرة البالية مرّة أخرى .
الجواب :
أوّلا : يبدو أنّ هؤلاء لم يمعنوا النظر في الآيات السابقة والتّالية لهذه الآية ، وإلّا لأدركوا أنّ الكلام يدور مع المعاندين الذين لا يستسلمون للحق مطلقا ، وإنّ موقف هؤلاء هو الذي منع رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) من إجابة طلبهم ، فهل نجد في القرآن أنّ طلاب الحقيقة سألوا الرّسول (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن يحقق لهم معجزة فامتنع ؟ الآية (111) من هذه السورة نفسها تتحدث عن أمثال هؤلاء فتقول : {وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا} .
ثانيا : تفيد الرّوايات أنّ هذا الطلب تقدم به بعض رؤساء قريش ، وكان هدفهم من ذلك إهانة القرآن والإعراض عنه ، فمن الطبيعي أن لا يستجيب رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) لطلب يكون دافعه بهذا الشكل .
ثالثا : إنّ أصحاب هذا الإشكال قد أغفلوا سائر آيات القرآن الأخرى التي تصرّح بأنّ القرآن نفسه معجزة خالدة ، وكثيرا ما دعت المخالفين إلى معارضته ، وأثبتت ضعفهم وعجزهم عن ذلك ، كما أنّهم نسوا الآية الأولى من سورة الإسراء التي تقول بكل وضوح : إنّ الله أسرى بنبيّه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة .
رابعا : ليس من المعقول أن يكون القرآن مليئا بذكر معاجز الأنبياء وخوارق عاداتهم ويدّعي النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) إنّه خاتم الأنبياء وأرفعهم منزلة ، وأنّ دينه أكمل من أديانهم ثمّ ينكص عن إظهار معجزة استجابة لطلب الباحثين عن الحقّ والحقيقة ، أفلا يكون هذا نقطة غامضة في دعوته في نظر المحايدين وطلاب الحقيقة ؟
فلو لم تكن له أية معجزة ، لكان عليه أن يسكت عن ذكر معاجز الأنبياء الآخرين لكي يتمكن من تمرير خطّته ويغلق طريق الاعتراض والانتقاد عليه ، ولكنّه لا يفتأ يتحدث عن إعجاز الآخرين ويعدد خوارق العادات عند موسى بن عمران وعيسى بن مريم وإبراهيم وصالح ونوح عليهم السلام ، وهذا دليل بيّن على ثقته التامّة بمعاجزه ، إنّ كتب التّأريخ الإسلامي والرّوايات المعتبرة ونهج البلاغة تشير بما يشبه التواتر إلى خوارق عادات رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) .
________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 55-64 .
2. الرّوايات المذكورة مستفادة من تفسير «المنار» و «مجمع البيان» في ذيل الآية المذكورة .
3. جملة {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ . . .} جملة شرطية جوابها محذوف ، تقديره «إن استطعت . . فافعل ولكنّهم لا يؤمنون» .
4. من حيث الاعراب «الموتى» مبتدأ ، و «يبعثهم الله» خبر ، ومعنى ذلك هو أنّ هؤلاء لا يطرأ على حالهم أي تغيير حتى يبعثهم الله يوم القيامة فيرون الحقائق .



|
|
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|