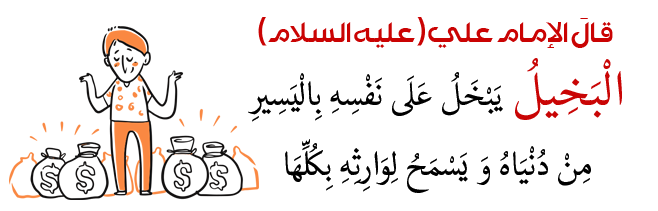
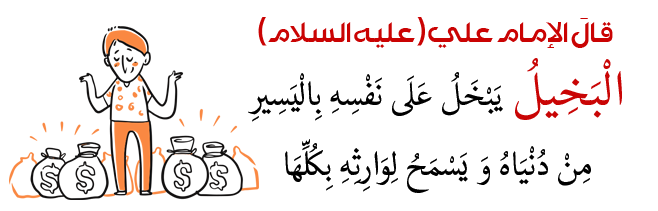

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-2-2020
التاريخ: 13-11-2016
التاريخ: 9-2-2020
التاريخ: 13-11-2016
|
[نص الشبهة]
قالوا: إن الأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله خص أبا بكر وعمر يوم بدر بالكون معه في العريش، وصانهما عن البذل في الحرب، وأشفق على حياتهما عن ضرب السيوف، وفزع إليهما في الرأي والتدبير، وهذا أمر أبين فضلا وأجل منقبة، فقولوا في ذلك ما عندكم في معناه.
[جواب الشبهة]
قيل لهم: ما أراكم تعتمدون في الفضائل إلا على الرذائل، ولا تصلون المناقب إلا بذكر المثالب، وذلك دليل خذلانكم وخزيكم في الدين وضلالكم.
أما كون أبي بكر وعمر مع رسول صلى الله عليه وآله في العريش ببدر فلسنا ننكره، لكنه لغير ما ظننتموه، والأمر فيه أوضح من أن يلتبس بما توهمتموه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما علم من جبنهما عن الحروب، وخوفهما من البراز للحتوف، وجزعهما من لقاء الأبطال، وضعف بصيرتهما، وعدم ثباتهما في القتال بما أوجب في الحكمة والدين والتدبير، حبسهما في ذلك المكان، ومنعهما من التعرض إلى القتال، والاحتياط عليهما، لأن لا يوقعا في تدبيره الفساد.
ولو علم صلى الله عليه وآله منهما قوة في الجهاد، وبصيرة في حرب أهل العناد، ونية في الاصلاح والسداد، لما حال بينهما وبين اكتساب الثواب، ولا منعهما من التعرض لنيل المنازل العالية بجهاد الأعداء، ولا اقتصر بهما على منازل القاعدين، ولا أدخلهما في حكم المفضولين، بما نطق به الذكر الحكيم حيث يقول سبحانه: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا } [النساء: 95].
ويؤكد ذلك أن الله تعالى أخبر عباده في كتابه بأنه: { اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 111].
فلا يخلو أن يكونا في جملة المؤمنين الذين نعتهم الله وأخبر عنهم بما ضمنه القرآن، أو أن يكونوا من غيرهم بخلاف صفاتهم التي جاء بها التنزيل، فلو كانوا من جملة المؤمنين لما منعهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الوفاء بشرط الله عليهم في القتال، ولا حال بينهم وبين التوصل بالجهاد إلى ما وعد الله عليه أهل الإيمان من عظيم الثواب، في محل النعيم والأجر الكبير، الذي من ظفر به كان من الفائزين، لأنه صلى الله عليه وآله إنما بعث بالحث على أعمال الخيرات، والاجتهاد في القرب والطاعات، والترغيب في بذل النفوس في جهاد الأعداء، وإقامة المفترضات.
ولما وجدناه قد منع هذين الرجلين من الجهاد، وحبسهما عما ندب إليه خيار العباد، دل على أنهما بخلاف صفات من اشترى الله تعالى نفسه بالجنة من أهل الإيمان، وهذا واضح لذوي العقول والأذهان.
ويزيد ذلك بيانا انهزامهما مع المنهزمين في يوم أحد، وفرارهما من مرحب يوم خيبر، وكونهما من جملة المولين الأدبار في يوم الخندق، وأنهما لم يثبتا لقرن قط، ولا بارزا بطلا، ولا أراقا في نصرة الإسلام دما، ولا احتملا في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله ألما، وكل ذلك يؤكد ما ذكرناه في معناه، ويزيل عن ذوي الاعتبار الشبهات فيما ذكره أهل الضلالات.
وأما قولهم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صانهما عن البذل في الحرب، وأشفق عليهما من ضرب السيف، فهو أوهن كلام وأضعفه، وذلك أنه صلى الله وآله عرض في ذلك اليوم عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله للحرب، وبذل إليها أخاه وابن عمه وصهره وأحب الخلق إليه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام، وابن عمه عبيدة بن لحارث بن عبد المطلب رحمة الله عليه، وأحباءه من الأخيار، وخلصاءه من أهل الإيمان .
فكان عليه السلام يقدم كل من عظمت منزلته عنده للجهاد، معرضا له بذلك إلى أجل منازل الثواب، ويرى أن تأخره عن ذلك حط له عن شئ من المقام، إلا أن يكون بصفة من ذكرناه من المرتابين في الإيمان والشاكين في نعيم الجنان.
ولم يك عليه السلام من أبناء الدنيا والداعين إليها، وإلى التمسك بأعمال أهلها والترغيب عن حطامها، فيتصور بما ذكره الجاهلون من الاشفاق على أحبته من الشهادة، والمنع لهم ما يعقب لهم من الراحة ويحصل به الفضيلة، ولو كان بهذه الصفة لخرج عن النبوة ولحق بأهل الكبر والجبرية، وحاشاه صلى الله عليه وآله من ذلك.
على أنه يقال لهم: لو كان الأمر على ما ظننتموه في منع الرجلين من الجهاد كان سببه المحبة والاشفاق، لأشفق عليهما من ذلك في خيبر، ولم يعرضهما له حتى افتضحا بالهزيمة بين المسلمين، وأبان عليه السلام ذلك لأمته أجمعين عن حالهما في الظاهر، وما كانا عليه في السر والباطن، وسماهما فرارين، وأخرجهما عن محبة الله تعالى حيث يقول عند فرارهما: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه ". وقد بينا ما يقتضيه فيهما من فحوى هذا الكلام فيما تقدم، ولا حاجة لنا إلى تكراره.
وأما قولهم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حبسهما عن القتال لحاجة منه إلى رأيهما في التدبير. فإنه نظير ما سلف من جهلهم، بل أفحش منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله كان معصوما وكانا بالاتفاق غير معصومين، وكان صلى الله عليه وآله مؤيدا بالملائكة ولم يكونا مؤيدين.
وقد ثبت أن العاقل لا يستمد الرأي إلا ممن يعتقد فضله عليه منه، ومتى استمد ممن يساويه أو يقاربه في معناه فلجواز عدوله عن صوابه بالغلط عن طريقه، وما يلحقه من الآفات في النظر، ويحول بينه وبين الحق فيه من الشبهات.
وإذا فسد القول بفضل أبي بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وآله في الرأي، بل في كل شئ من الأشياء، وبطل مساواتهما له ومقاربتهما إياه مع ما يبطل من جواز الغلط عليه، ولحوق الآفات به لعصمته صلى الله عليه وآله، استحال مقال من زعم أنه كان محتاجا إليهما في الرأي.
على أنه لو كان ممن يجوز عليه الخطأ في الدين والغلط في التدبير، لكان ما يقع منه مستدركا بجبرئيل وميكائيل وأمثالهما من الملائكة عليهم السلام، ولم يكله الله تعالى في شئ منه إلى رعيته، ولا أحوجه فيه إلى أحد من أمته، لما تقتضيه الحكمة في تولى حراسته وتهدئته، وغناه بذلك عمن أحوجه الله سبحانه إليه من جميع بريته.
ولو جاز أن يلجئه الله تعالى إلى أحد من أمته في الرأي، لجاز أن يضطر إليه في جميع معرفة الأحكام، ولجعله تابعا لهم فيما يدركونه بالاجتهاد والقياس، وهذا ما لا يذهب إليه مسلم، فثبت ما بيناه من الغرض في حبس الرجلين عن القتال، فإنه كما شرحناه، وبينا وجهه وأوضحناه، دون ما ظنه الجاهلون، والحمد لله.
ثم يقال لهم: خبرونا عن حبس رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر وعمر عن القتال في يوم بدر لحاجة إلى مشورتهما عليه، وتدبيرهما الأمر معه، أقلتم ذلك ظنا أو حدسا، أم قلتموه واعتمدتم فيه على اليقين؟ فإن زعموا أنهم قالوا ذلك بالظن والحدس والترجيم فكفاهم بذلك خزيا في مقالهم وشناعة وقبحا، وإن ادعوا العلم به والحجة فيه طولبوا بوجه البرهان عليه، وهل ذلك من وجه العقل أدركوه أم وجوه السمع والتوقيف، فلا يجدون شيئا يتعلقون به من الوجهين جميعا.
ثم يقال لهم: أما العريش فكان من رأي الأنصار بلا اختلاف، ولم يكن لأبي بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين مقال، وأما المشورة فلم تكن فيه، وإنما أشار في الأسرى بعد القتال، واختلفا عند المشورة في الرأي.
وعدل رسول الله صلى الله عليه وآله إذ ذاك عن رأي عمر بن الخطاب، لمعرفته أنه صدر عن تراث بينه وبين القوم، وقصد الشناعة على النبي صلى الله عليه وآله، وشفاء غيظ بني عبد مناف، ولم يرد بما قال وجه الله تعالى، وصار إلى رأي أبي بكر لما أراد الله تعالى من المحنة لذلك.
فنزل القرآن بتخطئة صاحبكم، وجاء الخبر عن علام الغيوب بخيانته في الدين، وركونه إلى الدنيا، وإرادته لحطامها، وضعف بصيرته في الجهاد، وأظهر منه ما كان يخفيه، وكشف عن ضميره، وفضحه الوحي بما ورد فيه، حيث يقول الله سبحانه: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [الأنفال: 67، 68].
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله حينما استشارهما لم يكن لفقر منه في الرأي والتدبير إليهما، وإنما كان لاستبراء أحوالهما والإظهار لباطنهما في النصيحة له أو ضدها، كما أخبره الله سبحانه بتعريفه ذلك عند نطقهما في الأمور وكلامهما وغيرهما من أضرابهما، فقال تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد: 30].
وإذا كان الأمر على ما وصفناه بطل ما ادعوه في العريش، وكانت المشورة بعده من أوضح البرهان على نقص الرجلين دون فضلهما على ما قدمناه(1).
______________
(1) للتوسع راجع الفصول المختارة 1: 14 و 15، الشافي 4: 417، الغدير 7: 207.



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|