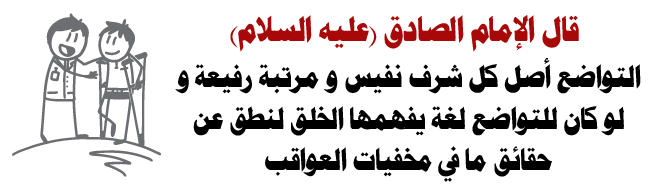
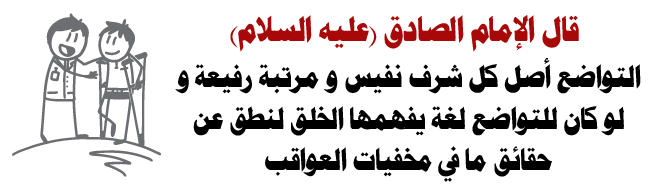

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
التاريخ: 10-8-2016
التاريخ: 4-9-2016
التاريخ: 2-9-2016
|
الكلام في الطهارات الثلاث وقد اشتهر فيها الإشكال من ثلاثة جوانب:
الأوّل: أنّها تعدّ من العبادات ويترتّب عليها الثواب، فكيف يجتمع مع القول بعدم ترتّب الثواب على المقدّمة؟
الثاني: أنّه يشترط فيها قصد التقرّب مع عدم إمكان التقرّب بالأمر الغيري المقدّمي.
الثالث: أنّ عباديّة هذه الطهارات متوقّفة على قصد أمرها الغيري مع أنّ قصد الأمر فيها أيضاً متوقّف على عباديتها، لأنّ قصد الأمر متفرّع على تعلّق أمر بالمقدّمة بما هي مقدّمة، والمقدّمة في المقام هي الطهارات الثلاث بوصف أنّها عبادة، فيلزم الدور.
وقد اُجيب عنها بوجوه :
الوجه الأوّل: ما هو المختار في الجواب عن الأوّل والثاني من إمكان التقرّب بالمقدّمة وترتّب الثواب عليها إذا أتى بها بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة.
وأمّا الإشكال الثالث، أي إشكال الدور.
ففيه: إنّا نسلّم كون عباديّة الطهارات متوقّفة على قصد الأمر، ولكن توقّف قصد الأمر على عباديّة الطهارات إنّما يوجب الدور فيما إذا كان المتوقّف عليه عباديتها في الرتبة السابقة على الأمر أو المقارنة معه، مع أنّه عبارة عن اجتماع شرائط العبادة حين الامتثال، أي إن تعلّق أمر المولى بها لا يحتاج إلى كونها عبادة حين الأمر بل إنّه يأمر بها لاجتماع شرائط العبادة فيها حين الامتثال، وذلك نظير توقّف الأمر على قدرة المكلّف على الفعل، فإنّه ليس معناه لزوم القدرة على الفعل حين الأمر بل تكفي قدرته حين الامتثال، فلو كان العاجز ممّن يقدر على العمل بعد أمر المولى وحين الامتثال كان للمولى أن يأمره. ولذلك قد يقال: إنّ القدرة شرط للإمتثال لا للتكليف.
هذا كلّه بناءً على شرطيّة قصد الأمر في عباديّة العبادة، وأمّا بناءً على ما مرّ في مبحث التعبّدي والتوصّلي من أنّها ليست منوطة بقصد الأمر فالأمر أوضح وأسهل.
الوجه الثاني: ما أفاده الشّيخ الأعظم(رحمه الله) وتبعه المحقّق الخراساني(رحمه الله) وكثير من الأعاظم (وهو جيّد لا غبار عليه) وحاصله: أنّ الطهارات عبادات في أنفسها مستحبّات في حدّ ذاتها، فعباديتها لم تنشأ من ناحية الأمر حتّى يلزم الدور.
ولكن قد أورد عليه بوجوه أهمّها وجهان:
الأوّل: أنّ هذا تامّ في الوضوء وقد يقال به في الغسل أيضاً، وأمّا التيمّم فلم يقل أحد باستحبابه النفسي.
ويمكن الجواب عنه: بأنّه بعد أن لم يكن إجماع على عدم مطلوبيّة التيمّم ذاتاً يكفي في إثباتها له ما ورد في الرّوايات من «أنّ التراب أحد الطهورين» إذا انضمّ إلى ما يستفاد من إطلاقات الباب من أنّ المستحبّ إنّما هو الكون على الطهارة في نفسه.
توضيح ذلك: أنّه قد ذكرنا في محلّه في الفقه من أنّ معنى كون الوضوء مستحبّاً نفسيّاً ليس هو مطلوبيّة الغسلتان والمسحتان فيه، بل المطلوب ذاتاً إنّما هو الكون على الطهارة الذي يترتّب على الغسلتان والمسحتان، ويعدّ غاية للوضوء، وأنّه هو المقدّمة والشرط للصّلاة في الحديث المعروف «لا صلاة إلاّ بطهور»، ولا إشكال في أنّ مقتضى قوله (عليه السلام)«إنّ التراب أحد الطهورين» أنّ وزان التيمّم هو وزان الوضوء وأنّ كلّ ما يترتّب على الوضوء يترتّب على التيمّم أيضاً، ومن الغايات المترتّبة على الوضوء هو الكون على الطهارة، فيترتّب هو على التيمّم أيضاً ونتيجته كون التيمّم أيضاً، مستحبّاً نفسيّاً بنفس المعنى في الوضوء.
الثاني: أنّ الأمر النفسي الاستحبابي المتعلّق بها كثيراً مّا يكون مغفولا عنه ولا سيّما للعامي، بل ربّما يكون الشخص معتقداً عدمه بإجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك، ومع هذا يكون الإتيان بها بداعي التوصّل بأمرها الغيري صحيحاً، فلو كان منشأ عباديتها ذلك الأمر النفسي لم تقع صحيحة.
واُجيب عنه: بأنّ الاكتفاء بقصد أمرها الغيري إنّما هو لأجل أنّه لا يدعو إلاّ إلى ما هو عبادة في نفسه، فإنّها المقدّمة والمتعلّق للأمر الغيري، فإذا أتى بالطهارات بداعي أمرها الغيري فقد قصد في الحقيقة إتيان ما هو عبادة في نفسه إجمالا فيكون قصد الأمر الغيري عنواناً إجمالياً ومرآتاً واقعياً لقصد ما هو العبادة في نفسه.
الوجه الثالث: أنّ اعتبار قصد القربة في الطهارات ليس لأجل أنّ الأمر المقدّمي ممّا يقتضي التعبّديّة (أي عدم حصول الغرض منه إلاّ إذا أتى بالفعل بداعي القربة) بل لأجل أنّ ذوات تلك الحركات الخاصّة في الوضوء والغسل والتيمّم ليست مقدّمة للصّلاة بل هي بعنوان خاصّ تكون مقدّمة لها، وحيث لا نعلم تفصيل ذلك العنوان المأخوذ فيها فنأتي بتلك الحركات بداعي أمرها الغيري كي يكون إشارة إلى ذاك العنوان، فإنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه، فإذا أتينا بتلك الحركات بداعي وجوبها الغيري فقد أتينا بها بعنوانها الخاصّ المأخوذ فيها، والحاصل أنّ قصد الأمر هنا إنّما هو لتحصيل العنوان القصدي لا للحصول على القربة الذي يتمكّن منها بقصد الطاعة.
ولكن يرد عليه إشكالات عديدة:
منها: أنّ لازمه كفاية تحقّق مجرّد العنوان في تحقّق الامتثال وعدم اعتبار عباديّته مع أنّ عباديّة الطهارات إجماعيّة.
وإن شئت قلت: أنّه لو كان وجه اعتبار قصد الأمر في الطهارات الثلاث هو الإشارة إلى العنوان الخاصّ المأخوذ فيها لجازت الإشارة إليه بقصد الأمر وصفاً أيضاً بأن كان أصل الداعي لإتيانه شيئاً آخر غير قربى فيقول مثلا: إنّي آت بالوضوء الواجب لأجل التبريد أو التنظيف ونحوهما من الدواعي النفسانيّة، فيكون قصد الأمر حينئذ بنحو التوصيف كافياً كالغائي كما إذا قال مثلا: إنّي آت بالوضوء لوجوبه شرعاً، بل قصد الأمر بنحو التوصيف يكون أظهر في الإشارة إلى العنوان الخاصّ المأخوذ فيها من قصده غاية، مع أنّه لا يكفي مثل هذا القصد قطعاً.
منها: أنّ هذا غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها كما لا يخفى.
الوجه الرابع: ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله) وحاصله: أنّه لا وجه لحصر منشأ عباديّة الطهارات الثلاث في الأمر الغيري والأمر النفسي الاستحبابي ليرد الإشكال على كلّ منهما، بل هناك منشأ ثالث وهو قصد الأمر النفسي الضمني الذي نشأ من جانب الأمر النفسي على ذي المقدّمة، لأنّ الأمر النفسي المتعلّق بالصّلاة مثلا كما ينحلّ إلى أجزائها كذلك ينحلّ إلى شرائطها وقيودها.
ثمّ أورد على نفسه بأنّ لازم ذلك هو القول بعباديّة الشرائط مطلقاً من دون فرق بين الطهارات الثلاث وغيرها لفرض أنّ الأمر النفسي تعلّق بالجميع على نحو واحد.
وأجاب عن ذلك بأنّ الفارق بينهما هو أنّ الغرض من الطهارات الثلاث (وهو رفع الحدث) لا يحصل إلاّ إذا أتى المكلّف بها بقصد القربة دون غيرها من الشرائط، ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الناحية بل لا مانع من اختلاف الأجزاء أيضاً بالعباديّة وعدمها في مرحلة الثبوت وإن لم يتّفق ذلك في مرحلة الإثبات (أي أنّ أمر اعتبار قصد القربة وعدمه بيد المولى الآمر، فله أن يلغى اعتباره حتّى عن بعض الأجزاء فضلا عن الشرائط)(1).
أقول: يرد عليه ما ذكرنا سابقاً من أنّ الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة مثلا إنّما تعلّق بأجزائها وتقيّدها بالشرائط، وأمّا نفس الشرائط فهي خارجة عن ذات المأمور به، (كما قيل: التقيّد جزء والقيد خارجي) فلا يمكن حلّ المشكل من هذا الطريق لأنّه يعود إلى الأمر المقدّمي لا محالة.
فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا في هذا المجال أنّ لتصحيح عباديّة الطهارات الثلاث طرق ثلاثة:
أحدها قصد الأمر الغيري.
ثانيها قصد الأمر النفسي الاستحبابي.
ثالثها قصد الأمر النفسي الضمني، والطريق الأوّل بنفسه يتصوّر على صورتين:
الصورة الاُولى: قصد الأمر الغيري بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة.
الصورة الثانيّة: قصده لتحصيل عناوين الطهارات الثلاث، فصارت الطرق أربعة، وقد ناقشنا في اثنين منها ووافقنا على اثنين منها:
أحدهما: قصد الأمر الغيري لما مرّ من كفايته في العباديّة.
ثانيهما: قصد الأمر النفسي الاستحبابي.
نكتتان:
النكتة الاُولى: أنّه قد إتّضح ممّا ذكرنا أنّه لا إشكال في صحّة الوضوء مثلا إذا أتى به قبل الوقت بداعي أمره النفسي الاستحبابي أو بداعي أمره الغيري للتوصّل إلى ذي المقدّمة (أي بعض الغايات الاُخر غير الصّلاة التي لم يدخل وقتها بعد) وهكذا بداعي الأمر النفسي الضمني بناءً على مختار المحقّق النائيني(رحمه الله) وإن مرّ الإشكال فيه، وكذلك لا إشكال في الإتيان به بعد الوقت بداعي أمره الغيري للتوصّل إلى ذي المقدّمة أي الصّلاة.
إنّما الإشكال في جواز إتيانه بعد الوقت بداعي أمره النفسي الاستحبابي، فقد يتوهّم أنّ الوضوء بعد اتّصافه بالوجوب الغيري بعد دخول الوقت خرج عن استحبابه النفسي لوجود المضادّة بين الأحكام الخمسة، فلا يمكن اجتماع وصف الاستحباب والوجوب في زمان واحد.
وقد اُجيب عن هذا الإشكال بأنّه لا مانع من اجتماعهما في ما نحن فيه بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد من جهتين: لأنّ الجهات في المقام متعدّدة، فإنّ جهة الوجوب الغيري وهي المقدّميّة غير جهة الاستحباب النفسي الموجودة فيه.
والأولى في الجواب أن يقال : إنّ ملاك الاستحباب وهو المحبوبيّة الذاتيّة للطهارات لا يزول بعد دخول الوقت وبعد تعلّق الأمر الوجوبي الغيري بها بل هو باق على حاله، وذلك نظير أكل الفاكهة مثلا فإنّه مطلوب في نفسه، وهذه المطلوبيّة لا تزول بعد أمر الطبيب بأكلها بل هي باقية على حالها، نعم أنّه يرتفع حدّها الاستحبابي أي الترخيص في الترك، إذن فإن أتى المكلّف بها بقصد هذه المحبوبيّة ولو بعد دخول الوقت حصلت العبادة بلا إشكال.
النكتة الثانيّة: إذا أتى المكلّف بالطهارات الثلاث بداعي التوصّل إلى الواجب النفسي وكان غافلا عن محبوبيّتها النفسيّة، ثمّ بدا له في الإتيان بذلك الواجب أو نسيه أو مضى وقته، فهل تقع الطهارات حينئذ عبادة حتّى يمكن له إتيان ذلك الواجب بعد الوقت أو إتيان سائر الغايات المترتّبة على الطهارات، أو لا؟
يختلف الجواب باختلاف المباني في المقدّمة، فإن قلنا بأنّ الواجب من المقدّمة إنّما هو المقدّمة الموصلة إلى ذي المقدّمة، فلا إشكال في بطلان الطهارة حينئذ لعدم تحقّق شرط المقدّمة وهو الإيصال، وإن قلنا بكفاية قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة وأنّه لا يضرّ عدم الإيصال الفعلي إلى ذي المقدّمة لوجود مانع فلا إشكال أيضاً في صحّة الطهارة ووقوعها عبادة عند وجود المانع، وحينئذ يمكن إتيان سائر الغايات، وهكذا إن قلنا بأنّ الواجب هو المقدّمة مطلقاً كما لا يخفى.
هذا كلّه بناءً على اشتراط قصد الأمر في تحقّق العبادة.
وأمّا بناءً على عدم اعتباره وكفاية الحسن الذاتي (وهو كون الفعل قريباً وحسناً ذاتاً) مع الحسن الفاعلي (أي كون الفاعل قاصداً للتقرّب به إلى الله) كما هو الحقّ عندنا في محلّه فلا إشكال في صحّة الطهارة ووقوعها عبادة، فيصحّ الإتيان بسائر الغايات، ومن هنا يظهر الحال فيما إذا اغتسل الجنب لصلاة الصبح ثمّ تبيّن له طلوع الشمس قبل أن يصلّي.
_________________________
1. أجود التقريرات: ج1، ص175 ـ 176.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|