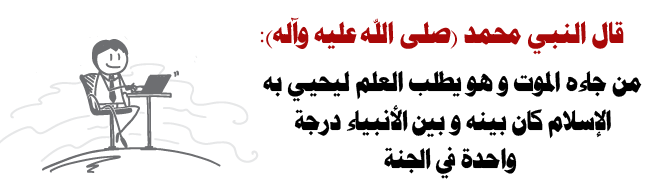
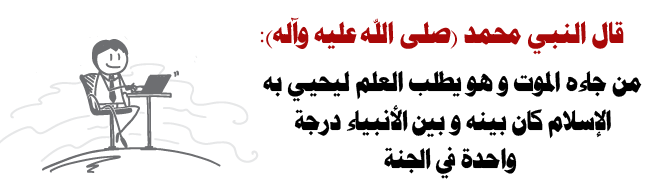

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
التاريخ: 13-6-2020
التاريخ: 31-8-2016
التاريخ: 5-8-2016
|
هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالأفراد أو الطبائع ؟
تحرير محلّ النزاع :
لا يخفى : أنّ كلماتهم في تحرير محلّ النزاع مختلفة جدّاً :
فيظهر من بعضها أنّ النزاع في تعلّقها بالفرد الخارجي الذي هو منشأ انتزاع الصور الذهنية أو بالطبائع بما هي هي ، مع قطع النظر عن الوجودين(1) .
ويردّه : أنّ الضرورة تقضي بامتناع كون الفرد الخارجي معروضاً للوجوب ; لأنّه ظرف السقوط بوجه لا العروض ، فبعيد جدّاً أن يقع النزاع في شيء أحد شقّيه باطل بالضرورة .
كما يظهر من بعض آخر : أنّ المسألة لغوية ، والنزاع في مفاد مادّة الأمر والنهي ، وأنّها وضعت للعناوين الكلّية أو لأفرادها ، وتشبّث في ذلك بالتبادر(2) .
وفيه : أنّ ذلك إعادة بلا عائدة ; إذ البحث عنه قد تقدّم مستوفى في فصل المشتقّ(3) ، على أ نّه نقل عن السكّاكي الإجماع على أنّ المصادر الخالية عن اللام والتنوين موضوعة للطبيعة اللابشرط(4) .
والعجب من بعضهم ; حيث أبدى قولاً ثالثاً فقال : إنّ النزاع مبني على النزاع المعروف في الفلسفة بأنّ الأصيل هو الوجود أو الماهية ، أو على نزاع آخر ; وهو أنّ الطبيعي هل له وجود في الخارج أو لا ، فالمسألة عقلية محضة أو مبتنية عليها(5) .
وفيه : أنّ البحث في المقام إنّما هو في الأوامر المتوجّهة إلى العرف ، المستبعدين عن المعارف والتحقيقات العلمية ، فابتناء البحث العرفي على المسائل الدقيقة بمراحل عن الواقع .
وهناك رأي رابع ; وهو أنّ البحث في سراية الإرادة إلى الخصوصيات اللاحقة بالطبيعة في الخارج وعدمها ; معلّلاً بأنّ الطبيعة في الخارج تلحقه قيود وتتعيّن بحدود لا مناص لها عنها ، فالبحث إنّما هو في أنّ الواجب هل هو نفس الطبيعة ، أو هي مع كلّيات القيود ; من الزمان والمكان(6) .
وفيه : أنّ هناك ليس ميزاناً يعيّن ذلك ; إذ لو كان الغرض قائماً بنفس الطبيعة فلا وجه لتعلّق الأمر بقيودها ، وإن كان قائماً بإضافتها إلى الحدود الفردية فلا محالة تسرّي الإرادة إليها ، ويتعلّق الأمر بها .
ثمّ إنّ محطّ البحث ليس في تعلّقها بالكلّي الطبيعي أو أفراده بما هو المصطلح في المنطق ; فإنّ الماهيات الاعتبارية ـ كالصلاة والحجّ ـ ليست من الكلّيات الطبيعية ولا مصاديقها مصاديق الكلّي الطبيعي ; فإنّ الماهيات المخترعة وكذا أفرادها ليست موجودة في الخارج ; لأنّ المركّب الاختراعي ـ كالصلاة والحجّ ـ لم يكن تحت مقولة واحدة ، ولا يكون لمجموع الاُمور وجود حقيقي حتّى يكون مصداقاً لكلّي طبيعي . بل المراد من الطبيعي هنا هو العنوان الكلّي ; سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا .
ولا يختصّ البحث بصيغة الأمر والنهي ، بل يعمّ متعلّق مطلق الطلب والزجر بأيّ دالّ ; ولو بالإشارة أو بالجملة الإخبارية في مقام الإنشاء .
والذي يصلح لأن يقع محطّ البحث ، ويظهره النظر في كثير من مقالاتهم : هو أنّ الأمر إذا تعلّق بماهية بالمعنى المتقدّم هل يسري إلى الأفراد والمصاديق المتصوّرة بنحو الإجمال منها ; بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلّقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الإجمال ، لا بقيد كون الأفراد ملحوظة ومتصوّرة ، بل نفس ذات الأفراد ، كما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ .
فيكون معنى «صلّ» أوجد فرد الصلاة ومصداقها ، لا بمعنى أنّ الواجب هو الفرد الخارجي أو الذهني بما هو كذلك ، بل ذات الفرد المتصوّر إجمالاً ; فإنّ الأفراد قابلة للتصوّر إجمالاً قبل وجودها ، كما أنّ الطبيعة قابلة للتصوّر كذلك .
إذا عرفت ذلك فنقول : الحقّ أنّ متعلّق الحكم ـ بعثاً كان أو زجراً ـ هو نفس الكلّي والعنوان بما هو هو ، مع قطع النظر عن الوجودين والنشأتين ، لا مقيّداً بالوجود الذهني ـ كما هو واضح ـ ولا بلحاظ اتّحاده مع المعنون في الخارج ـ كما جنح إليه بعض محقّقي العصر ـ رحمه الله ـ (7) إذ لحاظ الاتّحاد مرتبة حصول وجود المأمور به وحصول الغرض ، فلا معنى للحاظه عند البعث ، بل المأمور به هو نفس الكلّي وذات العنوان الذي إذا وجد في الخارج يصير منشأً للآثار .
والوجه في ذلك : أنّ البعث الحقيقي لا يمكن أن يتعلّق بما هو أوسع أو أضيق ممّا هو دخيل في الغرض ; للزوم تعلّق الإرادة والشوق بغير المقصود أو به مع الزيادة جزافاً .
فإذا لم يكن للخصوصيات الفردية دخالة في غرض الآمر فلا يعقل البعث نحوها ـ ولو إلى العنوان الكلّي من الخصوصيات ـ لأنّ البعث تابع للإرادة التشريعيـة التابعة للمصالح ، وتعلّقها بما لا دخل له في تحصيلها ممتنع ، كتعلّقها ابتداءً بأمر بلا غاية .
وتوهّم تعلّقها بها تبعاً لما هو من ملازمات المراد باطل ; لأ نّه مع خروجه من محطّ البحث ـ لأنّ الكلام ليس في استلزام إرادة لإرادة اُخرى كباب المقدّمة ، بل في متعلّق الأمر ـ قد فرغنا من بطلانه(8) .
فإن قلت : إنّ الطبيعة بما هي هي غير محبوبة ولا مبغوضة ولا متعلّقة للأمر والنهي ; إذ ليست إلاّ هي من حيث إنّها هي ، كما هو المراد من التعبير المعروف بتأخير قيد الحيثية عن السلب ، فكيف يتعلّق به الطلب ويعرض عليها الوجوب ؟ إن هذا إلاّ شيء عجاب .
قلت : معنى الكلمة الدارجة بين الأكابر هو أنّ الوجود والعدم والحبّ والبغض وغيرها ليس عين الطبيعي ولا جزئه ، بل هو في حدّ الذات خال عن هاتيك القيود عامّة ، وهذا لا ينافي أن يعرض عليها الوجود والعدم ، ويتعلّق بها الأمر والنهي .
وإن شئت قلت : إنّ سلب هذه المفاهيم عنها سلب بالحمل الأوّلي ; فإنّ مرتبة الماهية مرتبة حدّ الشيء ، ولا يعقل في هذه المرتبة أن يوجد فيها الوجود والعدم ، وإلاّ يصير الوجود أو العدم جزء المفهوم أو عينه ، ويكون واجب الوجود أو ممتنعه بالذات ; إذ البحث عن ذاتيات الشيء وما به الشيء هو هو ، ولا يعقل أن يكون الوجود جزء ماهية الممكن أو عينه ، وإلاّ لزم الانقلاب . نعم يعرضها الوجود والعدم ، وينطبق كلّ واحد عليها انطباقاً بالحمل الشائع العرضي . وقس عليهما إمكان تعلّق الأمر والنهي .
ولا يلزم من تعلّقهما عليها أن تكون هي منشأ للآثار ومحبوبة ومبغوضة ، بل المولى لمّا رأى أنّ الطبيعة في الوجود الخارجي منشأ للأثر المطلوب فلا محالة يبعث العبد إليها حتّى ينبعث ويوجدها خارجاً بالأمر ، فالأمر متعلّق بالطبيعة ; لغرض انبعاث العبد وصيرورتها من الليس إلى الأيس ، فتعلّق الأمر بالطبيعة طريق إلى حصول المطلوب والمحبوب ، وسيأتي توضيحه .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ الطبيعة ـ أيّة طبيعة كانت ـ لا يعقل أن تكون مرآة لشيء من الخصوصيات الفردية اللاحقة لها في الخارج ، وقد تقدّم أنّ مجرّد اتّحادها معها لا يوجب الكشف والدلالة ، فلا تكون نفس تصوّر الماهية كافية في تصوّر الخصوصيات ، فلابدّ للآمر أن يتصوّرها مستقلاًّ بعنوانها أو بعنوان غير عنوان الطبيعي ; ولو بالانتقال من الطبيعي إليها ، ثمّ ينقدح إرادة اُخرى متعلّقة بها مستقلاًّ غير الإرادة المتعلّقة بنفس الطبيعة ، أو يتّسع الإرادة الاُولى من جهة المتعلّق ، وتتعلّق بوحدتها على الطبيعة مع الخصوصيات الفردية . ولكن الإرادة الثانية أو توسّع الإرادة الاُولى جزاف محض ; لأنّ الغرض قائم بنفس العنوان لا مع قيوده ، فتدبّر .
وبتقريب آخر : أنّ تصوّر الأفراد غير تصوّر الطبيعة ; لأنّ القوّة التي تدرك الأفراد غير القوّة التي تدرك الطبيعي ; لأنّ تصوّر الخاصّ الجزئي من شؤون القوى النازلة للنفس ، وتعقّل الطبيعة من شؤون القوى العاقلة ، بعد تجريد الخصوصيات . فربّما يتصوّر الأفراد مع الغفلة عن نفس الطبيعة وبالعكس .
فالآمر إذا أراد أن يوجّه الأمر إلى الطبيعة فلابدّ من لحاظها في نفسها ، وإذا أراد الأمر بالأفراد لابدّ من لحاظها إمّا بعنوان عامّ إجمالي ; وهو مباين لعنوان الطبيعة في العقل ، وإمّا بلحاظ الأفراد تفصيلاً لو أمكن إحضار الأفراد الكثيرة تفصيلاً في الذهن ، ولكن لحاظها تفصيلاً غير لحاظ الطبيعة أيضاً .
وحينئذ لو فرض أنّ ذات الطبيعة يترتّب عليها الأثر في الوجود الخارجي فلابدّ للآمر من تصوّرها وتصوّر البعث إليها وإرادته ، ففي هذا اللحاظ لا يكون الأفراد ملحوظة ; لا إجمالاً ولا تفصيلاً ولا ملازمة بين اللحاظين ، وصرف اتّحاد الخصوصيات الخارجية مع الطبيعة خارجاً لا يوجب الملازمة العقلية ، فلابدّ في تعلّق الأمر بها من لحاظ مستأنف وإرادة مستأنفة ، ولكن مع ذلك يكون كلّ من البعث والإرادة جزافياً بلا غاية ، فتدبّر .
تنبيه : فيما وضعت له هيئة البعث :
لا شكّ في أنّ الغرض من البعث إلى الطبيعة هو إيجادها وجعلها من الأعيان الخارجية ; ضرورة أنّ الطبيعة لا تسمن ولا تغني ، بل لا تكون طبيعة حقيقة مالم تتلبّس بالوجود .
ولكن الكلام إنّما هو في أنّ هيئة البعث هل وضعت لطلب الإيجاد والوجود ، أو أ نّها وضعت لنفس البعث إلى الطبيعة ؟ إلاّ أنّ البعث إليها لمّا كان ممّا لا محصّل له قدّر فيه الوجود أو الإيجاد ، أو أنّ البعث إليها يلزمه عرفاً تحصيلها وإيجادها ، من دون تشبّث بإدخال الوجود فيه بنحو الوضع له ، أو تقديره في المستعمل فيه ، وجوه : أقواها الأخير .
والسرّ فيه : هو أنّ العرف لمّا أدرك أنّ الطبيعة لا يمكن نيلها وتحصيلها بنفسها ; عارية عن لباس الوجود يتوجّه من ذلك إلى أنّ البعث إليها بعث إلى إيجادها حقيقة .
وإن شئت قلت : إنّ الطبيعة لا تكون طبيعة حقيقة بالحمل الشائع إلاّ بإيجادها خارجاً ; لأنّ الطبيعة بما هي هي ليست بشيء وفي الوجود الذهني ليست نفس الطبيعي بما هي هي . وحينئذ ينتقل بارتكازه إلى أنّ إطاعة التحريك والبعث نحوها لا تحصل إلاّ بإيجادها خارجاً ، هذا كلّه ثبوتاً .
وأمّا في مقام الإثبات : فلما قدّمنا من تعيين مفاد الأمر هيئة ومادّة ، وأنّ الثانية موضوعة لنفس الطبيعة والاُولى موضوعة للبعث إليها بحكم التبادر .
ويشهد بذلك : أ نّه لا يفهم من مثل «أوجد الصلاة» إيجاد وجود الصلاة ، بل يفهم منه البعث إلى الإيجاد ، فتدبّر .
بحث وتفصيل : في كيفية تعلّق الأمر بالطبيعة
هل يتعلّق الأمر بنفس الماهية أو بما هي ملحوظة مرآة للخارج باللحاظ التصوّري وإن كان اللاحظ يقطع بخلافه بالنظر التصديقي ؟
قد يقال : إنّ محطّ البحث في تعلّق الأمر بالطبيعة هي الطبيعة على النحو الثاني ، وأمّا نفس الطبيعة فلا يعقل تعلّق الأمر بها ; لأنّها من حيث هي ليست إلاّ هي ; لا تكون مطلوبة ولا مأموراً بها ، فلابدّ أن تؤخذ الطبيعة بما هي مرآة للخارج باللحاظ التصوّري حتّى يمكن تعلّق الأمر بها(9) ، انتهى .
ولكن هذا ناش من الغفلة عن معنى قولهم : الماهية من حيث هي ليست إلاّ هي ; ولهذا زعم أنّ الماهية لا يمكن أن يتعلّق بها أمر .
وتوضيح ذلك : أنّ الماهية مرتبة ذات الشيء ، والأشياء كلّها ـ عدا ذات الشيء ـ منتفية عن مرتبة ذاته ، ولا يكون شيء منها عيناً لها ولا جزءً مقوّماً منها ; و إن كان كلّ ما ذكر يلحق بها ، ولكنّه خارج من ذاتها وذاتياتها ، وهذا لا ينافي لحوق شيء بها .
فالماهية وإن كانت من حيث هي ليست إلاّ هي ـ أي في مرتبة ذاتها لا تكون إلاّ نفس ذاتها ـ لكن تلحقها الوحدة والكثرة والوجود وغيرها من خارج ذاتها ، وكلّ ما يلحقها ليس عين ذاتها ولا ذاتياً لها بالمعنى المصطلح في باب إيساغوجي .
فالأمر إنّما يتعلّق بنفس الطبيعة من غير لحاظها متّحدة مع الخارج ، بل لمّا رأى المولى أنّ الماهية في الخارج منشأ الآثار ، من غير توجّه نوعاً إلى كون الآثار لوجودها أو لنفسها في الخارج فلا محالة يبعث المأمور إلى إيجادها وجعلها خارجية ، والمولى يرى أ نّها معدومة ويريد بالأمر إخراجها من العدم إلى الوجود بوسيلة المكلّف .
فلحاظ الاتّحاد التصوّري مع القطع بالخلاف تصديقاً ـ مع كونه لا محصّل له في نفسه ـ لا يفيد شيئاً . ومع الغفلة عن القطع بالخلاف مناف لتعلّق الأمر وتحريك المأمور نحو الإيجاد ; لأنّ لحاظ الاتّحاد التصوّري ظرف حصول المأمور به عند المولى ، فلا معنى لأن يتعلّق الأمر في هذا اللحاظ ، بل التحقيق المساعد للوجدان : أنّ الأمر متعلّق بنفس الطبيعة حين توجّه الآمر إلى معدوميتها ، والمولى يريد بالأمر سدّ باب أعدامها وإخراجها إلى الوجود بتوسّط المكلّف . على أنّ ما قدّمناه مراراً(10) من امتناع مرآتية الماهية للأفراد كاف في دفعه ، فتدبّر .
نقد وتحصيل : في المراد من وجود الطبيعي خارجاً:
إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا تعرف : أنّ تخيير المكلّف في إيجاد الطبيعة في ضمن أيّ فرد شاء تخيير عقلي لا شرعي ، كيف وقد عرفت أنّ انفهام الإيجاد من الأمر ليس لدلالة اللفظ عليه ، بل لانتقال العرف بعقله وفكره إلى أنّ الطبيعة لا تتحقّق إلاّ بالوجود ، من دون تنصيص من المولى عليه ، ومعه كيف يكون التخيير بين الإيجادات شرعياً ؟
وبالجملة : أنّ ما تعلّق به الطلب هو نفس الطبيعة ، ولكن العقل يدرك أنّ تفويض الطبيعة إليه لا يمكن إلاّ بالتمسّك بذيل الوجود ، ويرى أنّ كلّ فرد منها واف بغرضه ، فلا محالة يحكم بالتخيير بين الأفراد . وأمّا المولى فليس الصادر منه سوى البعث إلى الطبيعة تعييناً ، لا تخييراً.
نعم ، يظهر عن بعض محقّقي العصر ـ رحمه الله ـ كون التخيير شرعياً بين الحصص ، وحاصل ما أفاده بطوله : هو أ نّه إذا تعلّق الأمر بعنوان على نحو صرف الوجود فهل يسري إلى أفراده تبادلاً ، فتكون الأفراد بخصوصياتها تحت الطلب ، أو لا ؟
وعلى الثاني فهل يسري إلى الحصص المقارنة للأفراد ـ كما في الطبيعة السارية ـ أولا ، بل الطلب يقف على نفس الطبيعة ؟
قال : توضيح المراد يحتاج إلى مقدّمة ; وهي أنّ الطبيعي يتحصّص حسب أفراده ، وكلّ فرد منه مشتمل على حصّة منه مغايرة للحصّة الاُخرى باعتبار محدوديتها بالمشخّصات الفردية ، ولا ينافي ذلك اتّحاد تلك الحصص بحسب الذات ، وهذا معنى قولهم(11) : إنّ نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأولاد ، وإنّ مع كلّ فرد حصّة من الطبيعي غير الآخر ، ويكون الآباء مع اختلافها بحسب المرتبة متّحدة ذاتاً .
ثمّ قال : التحقيق يقتضي وقوف الطلب على نفس الطبيعة ، وأقام عليه دليلين .
ثمّ قال : إنّ عدم سراية الطلب إلى الحصص إنّما هو بالقياس إلى الحيثية التي بها تمتاز الحصص الفردية بعضها عن البعض الآخر المشترك معه في الحقيقة النوعية .
وأمّا بالنسبة إلى الحيثية الاُخرى التي بها تشترك تلك الحصص وتمتاز بها عن أفراد النوع الآخر المشاركة لها في الجنس القريب ; وهي الحيثية التي بها قوام نوعيتها فلا بأس بدعوى السراية إليها ، بل لعلّه لا محيص عنها ; من جهة أنّ الحصص بالقياس إلى تلك الحيثية واشتمالها على مقوّمها العالي ليست إلاّ عين الطبيعي . ونتيجة ذلك كون التخيير بين الحصص شرعياً لا عقلياً .
إن قلت : إنّ الطلب تعلّق بالعناوين والصور الذهنية لا المعنونات الخارجية ، فيستحيل سرايته إلى الحصص الفردية ; حيث إنّها تباين الطبيعي ذهناً ; وإن كان كلّ من الحصص والطبيعي ملحوظاً بنحو المرآتية .
قلت : إنّ المدّعى هو تعلّق الطلب بالطبيعي بما هو مرآة للخارج ، ولا ريب في أنّ وجود الطبيعي في الخارج لا يمتاز عن وجود الحصص ، بل هو الجهة المشتركة الجامعة بين الحصص ، والمرئي بالطبيعي الملحوظ مرآة للخارج ليس إلاّ تلك الجهة الجامعة بين الحصص ، وهذا مرادنا من سراية الطلب من الطبيعي إلى حصصه . بل التعبير بها مسامحي ; إذ بالنظر الدقّي يكون الطلب المتعلّق بالطبيعي الملحوظ مرآة للخارج متوجّهاً إلى الجهة الجامعة بين الحصص ، فمتعلّق الطلب في الحقيقة هي تلك الجهة الجامعة بعينها(12) ، انتهى .
أقول : الظاهر أ نّه أشار في تحقيق الكلّي الطبيعي إلى ما اشتهر بين تلامذته ـ قدس سره ـ ; نقلاً عنه من أنّ الحصص بالنسبة إلى الأفراد كالآباء والأولاد ، والطبيعي هو أب الآباء ، وهو الجهة المشتركة بين الحصص ، ويكون الطبيعي مرآة لهذه الجهة المشتركة الخارجية .
وزعم : أنّ المراد من قول بعض أهل المعقول : إنّ الطبيعي بالنسبـة إلى الأفراد كالآباء بالنسبة إلى الأولاد ، هو الحصص ، وأنّ هنا آباء ; هـي الحصص ، وأب الآباء ; وهو القدر المشترك بينها ، الذي يكون الطبيعي مرآة له ، غفلةً عـن أنّ ما ذكروا من أنّ نسبة الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء إنّما هـو لأجل الفرار عن الأب الواحد الذي التزم به الرجل الهمداني ، الذي صادفه الشيخ في مدينـة همدان(13) ، وهذا المحقّق جمع بين الالتزام بمقالة الرجل الهمداني وبين ما هـو المشهور في ردّه(14) ; غفلةً عن حقيقة الحال .
ولمّا كان ذلك منشأ للخلط والاشتباه في مواضع كثيرة فلا بأس بالإشارة إلى ما هو المحقّق في محلّه :
فنقول : إنّ الطبيعي من الشيء هو حدّ الشيء وذاتية ومقوّمه ; بحيث يوضع بوضعه ويرتفع برفعه ، وهو حدّ الشيء بما هو حدّه ، لا معدوم ولا موجود ولا واحد ولا كثير ، بل هو في مرتبة فوق هذه الأوصاف والعوارض .
نعم ، قد يقع في مرتبة دونها مجالياً لهذه الأوصاف ، فيصير موجوداً وكثيراً ، لكن كلّ ذلك في مرتبة متأخّرة عن رتبة الطبيعي وذاته .
وبعبارة اُخرى : إنّ مأخذ الطبيعي والماهية المؤلّفة من الجنس والفصل هو الموجودات الخارجية بما أ نّها واقعة في صراط التكامل ومدارج الكمال ، والموجود إذا وقع في بعض المدارج يدرك منه مفهوم عامّ ، كالجسم يندرج تحته عدّة من الأشياء المشتركة مع هذا الموجود في هذا المفهوم ، ثمّ يدرك منه مفهوم آخر يميّز ذلك الموجود عن بقية الأشياء ، وهذان المفهومان بما هما أمران مفصّلان حدّ تفصيلي لذلك الموجود ، ويعبّر عنهما بالجنس والفصل ، والمفهوم البسيط الإجمالي المنتزع من هذين يسمّى نوعاً .
ثمّ إذا أدركه الكمال الآخر ودخل في مرتبة اُخرى وصار جسماً نامياً يدرك له جنس وفصل آخر ، فكلّما زاد الشيء في تكامله ومدارجه ينتزع في كلّ مرتبة مفهوم من ذاته ، مغاير مع ما كان ينتزع قبل الوصول إليها .
ثمّ إذا فرضنا موجوداً آخر مثل ذلك ; بحيث دخل في المدارج التي دخل فيها الموجود السابق ينتزع منه في كلّ مرتبة مثل ما ينتزع من الآخر ، وهكذا في الثالث والرابع . فحينئذ فالمراد من الطبيعي هو المفاهيم المنتزعة عن الشيء باعتبار درجاته ومراتبه . وعليه يتعدّد الطبيعي بتعدّد أفراده ; إذ ينال العقل من كلّ فرد مفهوماً مغايراً مع ما يناله من الآخر ، ولكن تغايراً بالعدد .
فإن قلت : يلزم على هذا أن يكون الطبيعي نفس الصور المنتزعة القائمة بالذهن ، ومع التقيّد بالوجود الذهني كيف يكون حدّاً للشيء الموجود في الخارج ؟
قلت : التعبير بالانتزاع وما أشبهه لأجل تقريب المطلب ، وإلاّ فهو بما أ نّه أمر منتزع موجود في وعاء الذهن من مراتب الوجود ، ولا يعقل أن يكون حدّاً للموجود ، بل الماهية هي الشيء الذي يراه الإنسان تارة موجوداً في الذهن ، واُخرى موجوداً في الخارج ، وثالثة غير موجود فيهما ، ولكن العلم لا يتعلّق بالماهية المجرّدة إلاّ بلحاظها في الذهن وتجريدها عن سائر الخصوصيات ، ومع ذلك لا تكون ماهية مجرّدة ، بل مختلطة بالوجود الذهني .
وبذلك يظهر : أنّ الماهية المحضة بلا شيء معه لا ينالها الإنسان ; إذ الطريق إليها إنّما هو التصوّر والإدراك الذهني ، وكلّما تصوّرتها فهو ينصبغ بالوجود ، وكلّما جرّدتها فقد أخليتها .
وأمّا جعلها حـدّاً للشيء فإنّما هـو لأجل الغفلة عـن الوجـود الذهني وتحصّله فيه . فحينئذ إذا كان معنى الطبيعي هو المفهوم الذي ينتزعه الذهن من الشيء بحسب مواقفـه أو ما يراه النفس موجـوداً في الخارج تارة وفي الذهن اُخـرى ، فلا محالـة لـو فرض حصول مصداق ـ كزيد مثلاً ـ لهـذا الطبيعي في الخارج فقد وجد الطبيعي فيه بتمام شؤونه ، ولو فرض حصول مصداق ثان ـ كخالد ـ فقد وجد فيه الطبيعي بتمام أجزائه أيضاً ، وهكذا لو فرض ثالث .
فهاهنا أفراد وإنسانات بحسب عدد الأفراد ويتكثّر بتكثّرها ; فزيد إنسان تامّ ، وخالد إنسان تامّ آخر ، وهكذا الثالث ، لا أ نّه حصّة من الإنسان أو جزء منه حتّى يصير كلّ واحد من الأفراد ناقصاً في الإنسانية ، ويكون الإنسان التامّ شيئاً قائماً مع هذه الأفراد ، كما زعمه الرجل الهمداني .
نعم ، إنسانية زيد غير إنسانية خالد في الخارج ، وطبيعي الأوّل غير طبيعي الثاني ; تغايراً بالعدد ، ولكن العقل إذا جرّد إنسانية هذا وذاك عن العوارض المفردة ينال من الجميع شيئاً واحداً بالنوع ; لارتفاع الميز ، وهذا لا ينافي تعدّده وتكثّره في الخارج ، وسيجيء نصّ الشيخ الرئيس على ما ذكرنا(15) .
وإن شئت قلت : إنّ الطبيعي موجود في الخارج لا بنعت الوحدة النوعية ولا بوصف الجامعية ، بل العموم والاشتراك لاحقٌ به في موطن الذهن ، والجهة المشتركة ليس لها موطن إلاّ العقل ، والخارج موطن الكثرة ، والطبيعي موجود في الخارج بوجودات متكثّرة ، وهو متكثّر حسب تكثّر الأفراد والوجودات ، لا بمعنى تحصّصه بحصص ; فإنّه لا محصّل له ، بل بمعنى أنّ كلّ فرد متّحد في الخارج مع الطبيعي بتمام ذاته ; لأنّ ذاته غير مرهونة بالوحدة والكثرة ، فهو مع الكثير كثير .
فزيد إنسان لا حصّة منه ، وعمرو إنسان آخر لا حصّة اُخرى منه وهكذا ، وإلاّ لزم كون زيد بعض الإنسان وعمرو كذلك ، وهو ضروري الفساد .
ومنه يتّضح : أنّ الجهة المشتركة بنعت الاشتراك ليست موجودة في الخارج ، وإلاّ لزم أن يكون موجوداً بنعت الوحدة ; لأنّ الوجود مساوق للوحدة ، فيلزم إمّا وحدة جميع الأفراد وجوداً وماهية أو كون الواحد كثيراً ، وكون كلّ فرد موجوداً بوجودين : أحدهما بحيثية الجهة المشتركة ، فيكون كلّ الأفراد واحداً في الوجود الخارجي من هذه الحيثية ، وثانيهما وجوده بالحيثية الممتازة مع قُرنائه .
وهذا ـ أي كون الإنسان غير موجود بنعت الوحدة والاشتراك ، بل بنعت الكثرة المحضة ـ مراد من قال : إنّ الطبيعي مع الأفراد كالآباء مع الأولاد ، لا الأب مع الأبناء ، وهذا خلاصة ما عليه الأكابر .
وأمّا الرجل الهمداني فزعم : أنّ معنى وجود الطبيعي في الأعيان هو أنّ ذاتاً واحدة بعينها مقارنة لكلّ واحد من المقارنات المختلفة ، موجودة بنعت الوحدة في الخارج ، وأنّ ما به الاشتراك الذاتي بين الأفراد متحقّق خارجاً .
وكأنّه توهّم من قولهم : إنّ الأشخاص مشترك في حقيقة واحدة ; وهي الطبيعي ، ومن قولهم : إنّ الكلّي الطبيعي موجود في الخارج أنّ مقصود القوم هو موجودية الجهة المشتركة بما هي كذلك في الخارج ; قائلاً : هل بلغ من عقل الإنسان أن يظنّ أنّ هذا موضع خلاف بين الحكماء؟
وما ذكره هذا الرجل هو معنى كون الطبيعي كأب واحد بالنسبة إلى الأبناء ; أي يكون الطبيعي بنعت الوحـدة والاشتراك موجـوداً في الخارج ، وفي مقابله مقالـة المحقّقين من أنّ نسبـة الطبيعي إلى الأفـراد كالآباء إلى الأولاد ، وأنّ الطبيعـي موجـود في الخارج بنعت الكثرة المحضة ، وأنّ الوحدة والاشتراك تعرضان عليه في موطن الذهن ، والجهة المشتركة لا موطن لها إلاّ العقل ، وأنّ الخارج موطن الكثرة ، والطبيعي موجـود في الخارج متكثّر بتكثّر الأفـراد ، لا بمعنى تحصّصه بحصص ، وأنّ الموجود مع كلّ فرد حصّة منه لا نفسه ; فإنّه لا يرجع إلى محصّل ، بل بمعنى أنّ كلّ فرد في الخارج هو الطبيعي بتمام ذاته ; لأنّ ذاته غير مرهونة بالوحدة والكثرة ، فهو مع الكثير كثير ، ومع الواحد واحد .
فزيد إنسان لا حصّة منه ، وعمرو إنسان آخر لا حصّة اُخرى ، ففي الخارج اُناس كثيرة حسب كثرة الأفراد لا إنسان واحد معها ، وإلاّ لزم أن تكون الجهة المشتركة موجودة بنعت الوحدة ; لأنّ الوجود يساوق الوحدة ، فلزم وحدة جميع الأفراد خارجاً ; وجوداً وماهية بالوحدة الشخصية العينية .
وهذا المحقّق الاُصولي لمّا لم يصل إلى مغزى مرام المحقّقين جمع بين الآباء والأب ، فجعل للأفراد آباء وجدّاً ; وهو أب الآباء . ولهذا تراه صرّح ـ في جواب إن قلت ـ بأنّ وجود الطبيعي في الخارج هو الجهة المشتركة ، وأنّ المرئي بالطبيعي الملحوظ مرآة للخارج ليس إلاّ تلك الجهة الجامعة بين الحصص . وهذا بعينه قول الرجل الهمداني الذي أفرد شيخ المشائيين رسالة لردّه وقد نقل بعض الأكابر نصّ الشيخ بأنّ الإنسانية الموجودة كثيرة بالعدد ، وليست ذاتاً واحدة ، وكذلك الحيوانية ، لا أ نّها كثيرة باعتبار إضافات مختلفة ، بل ذات الإنسانية المقارنة لخواصّ زيد هي غير ذات الإنسانية المقارنة لخواصّ عمرو ، فيهما إنسانيتان : إنسانية قارنت خواصّ زيد ، وإنسانية قارنت خواصّ عمرو ، لا غيرية باعتبار المقارنة حتّى تكون حيوانية واحدة تقارن المتقابلات من الفصول . وهذه العبارة ـ كما ترى ـ نصّ على خلاف ما زعمه ذلك المحقّق ، مع أنّ البرهان قائم على خلافه .
ثمّ إنّه ربّما يؤيّد مذهب الرجل الهمداني بوجهين ، وربّما يتمسّك بهما المحقّق المزبور ، وقدّمنا كلمة منه ـ رحمه الله ـ في مبحث الوضع :
الأوّل : أ نّه يمتنع انتزاع مفهوم واحد من الأفراد بلا جامع اشتراكي في الخارج ; إذ الكثير بما هو كثير لا يمكن أن يقع منشأً لانتزاع الواحد ، فلابدّ من جهة جامعة خارجية بنعت الوحدة حتّى يكون الطبيعي مرآة لها ومنتزعاً منها .
وفيه : أنّ وحدة الطبيعي ليست وحدة عددية بل وحدة نوعية ، وظرف عروضها إنّما هو الذهن ; إذ النفس بواسطة القوى النازلة ينال من كلّ فرد إنسانية مغايرة لما يناله من الآخر ، ولكن إذا جرّدها عن الخصوصيات الفردية ينعدم التعدّد قهراً بانعدام ميزهما ، فيصير مفهوماً واحداً . والمتوهّم تخيّل : أنّ الذهن ينال المفهوم الواحد من الخارج ، وصار بصدد تصحيح منشئه .
أضف إليه : أنّ الطبيعي ليس من الانتزاعيات ، بل من الماهيات المتأصّلة الموجودة في الخارج تبعاً للوجود تحقّقاً وتكثّراً ، وأنّ معنى موجوديتها موجوديتها ذاتاً تبعاً للوجود ، لا موجودية منشأ انتزاعها ، وأنّ كثرة الوجود منشأ تكثّرها خارجاً ; لأنّها بذاتها لا كثيرة ولا واحدة .
فالكثرة تعرضها خارجاً بمعنى صيرورة ذاتها كثيرة بتبع الوجود خارجاً ، والوحدة تعرضها في العقل عند تجريدها عن كافّة اللواحق . وما سبق منّا من التعبير بلفظ الانتزاع فلأجل التسهيل .
والحاصل : أنّ الانتزاع هنا ـ على فرض صحّته ـ ليس إلاّ عبارة عن إدراك النفس من كلّ فرد بعد تجريده عن المميّزات ما تدرك من فرد آخر ، فإذا جرّدت النفس خصوصيات زيد تدرك منه معنى الإنسان ـ أي طبيعية ـ من غير اتّصافه بنعت الوحدة المشتركة النوعية ، وكذا إذا جرّدت خصوصيات عمرو تنال منه ما تنال من زيد بلا تفاوت .
ثمّ إذا لاحظت أنّ ما أدركته مكرّراً مشترك بين الأفراد تحكم بأ نّه الجهة المشتركة . فالوحدة تعرضه في العقل عند التحليل والتجزئة . ولكن لا يغرّنك لفظ العروض بمعناه المعهود ، والتحقيق موكول إلى مظانّه .
الثاني : أنّا نرى كثيراً في الفواعل الطبيعية من استناد الواحد إلى الكثير ، كتأثير بندقتين في قتل شخص ، وتأثير النار والشمس في حرارة الماء ، وتأثير قوى أشخاص في تحريك حجر عظيم، وغير ذلك من الأمثلة ، فإمّا أن يستند المعلول إلى كلّ واحد مستقلاّ ، لزم صدور الواحد عن الكثير ، أو إلى المجموع ; وهو ليس موجوداً عدا وجود الأفراد ، فلا مناص ـ حفظاً لانخرام قاعدة الواحد المبرهن عليها في محلّها(16) ـ من القول بوجود جامع في الخارج بنعت الوحدة، وهو الذي يؤثّر في إيجاد هذه المعاليل .
والجواب : أنّ التمسّك بقاعدة الواحد في هذا المقام غفلة عن مغزى القاعدة ; إذ قاعدة الواحد لو تمّت لكان مجراها ـ كما هو مقتضى برهانها ـ هو الواحد البحت البسيط الذي ليس فيه تركيب ولا شائبته ، دون غيره ممّا فيه التركيب والأثنينية ، وما ذكر من الأمثلة خارج من مصبّ القاعدة .
على أنّ فيها ليس أمر واحد حتّى نتطلّب علّته ; إذ الموت ليس إلاّ خروج الروح البخاري من البدن من المنافذ غير الطبيعية ، وكلّما قلّت البندقة قلّت المنافذ ، وكلّما كثرت كثرت المنافذ .
فحينئذ : طول المدّة في نزع الروح الصوري وقلّتها يدور مدار إخراج الدم ، وهو ليس أمراً واحداً بسيطاً ، بل أمر يقبل التجزئة والتكثّر .
وقس عليه الحرارة ; فإنّ حاملها ذو أجزاء وأوضاع ، ولا مانع من انفعال بعضها من الشمس ، والبعض الآخر من النار ، ويكون كلّ واحد مؤثّراً فيه بعض الأثر . فلا إشكال في تأثّر مثل هذا الواحد الطبيعي القابل للتجزئة والتركيب من علّتين ; إذ أثر كلّ علّة غير أثر الاُخرى ، وتأثّر الماء من كلّ غير تأثّره من آخر .
وهكذا الأمر في اجتماع أشخاص على رفع حجر ; فإنّ كلّ واحد يؤثّر فيه أثره الخاصّ ; حتّى يحدث في الحجر بواسطة القواسر العديدة ما يغلب على ثقله الطبيعي أو على جاذبة الأرض .
أضف إلى ذلك : أنّ قياس العلل الطبيعي بالفواعل الإلهي من عجائب الأوهام ، والقول بتأثير الجامع في العلّة الإلهية مثل الطبيعي أمر غير معقول ، إذ المعلول الإلهي ربط محض بعلّته ، ويكون بتمام هويته متعلّقاً بها ، بل حقيقته عين الربط لا شيء له الربط ، ولا يمكن أن يكون له حيثية غير مربوطة بها ، وإلاّ لزم الاستغناء الذاتي ، وهو ينافي الإمكان .
وحينئذ : فما حاله وذاته ذلك لا يعقل في حقّه أن يستند إلى علّته الخاصّة عند الانفراد وإلى الجامع عند الاجتماع ; إذ هويته التدلّي بعلّته ، فكيف يمكن أن يفسخ ذاته ويفوّضها إلى الجامع ؟ إن هذا إلاّ الانقلاب .
وبالجملة : فالعلّة البسيطة الإلهية لا يمكن أن يجتمع على معلولها علّتان حتّى نبحث في كيفيته ، ولا يعقل تفويض الفاعل الإلهي أثره إلى غيره ، أو تعلّق المعلول بالذات إلى غير علّته الخاصّة به ، فلا يعقل ربط المعلول البسيط تارة بهذه العلّة واُخرى بتلك وثالثة بالجامع بينهما ; للزوم الانقلاب الذاتي في البسيط .
وأظنّك إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا ، وكنت أهلاً لهذه المطالب تقدر على تشخيص الزيف من المقبول ، وهو غاية المأمول .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ ما ذكره ـ قدس سره ـ من أنّ عدم السراية إنّما هو إلى الحيثية التي تمتاز بها الحصص الفردية بعضها عن بعض ، وأمّا بالنسبة إلى الحيثية الاُخرى التي بها تشترك تلك الحصص وتمتاز بها عن أفراد النوع الآخر فلا بأس بدعوى السراية إليها(17) ، لا يخلو من إجمال ; لأنّ مراده من قوله تشترك تلك الحصص وتمتاز بها عن أفراد النوع الآخر . . . إلى آخره إن كان هو الفصول المميّزة ففيه : أنّ ذلك عين الطبيعي ومقوّمها ، ومرجعه إلى أنّ الحكم على الطبيعي يسري إلى الطبيعي ، وإن أراد ما يمتاز به حصص نوع عن حصص نوع آخر ففيه : أنّ الطبيعي لا يمكن أن يتحصّص بنفس ذاته ، بل التحصّص يحصل بتقييده بقيود عقلية ، مثل «الإنسان الأبيض» و «الفرس الأسود» .
فحينئذ لا يمكن أن يكون الحصص نفس الطبيعي في اللحاظ العقلي ، وأمّا الاتّحاد الخارجي فكما يكون بين الحصص والطبيعي يكون بين الأفراد والطبيعي ، ولكنّه لا يوجب سراية الأمر في كلا القسمين .
وبالجملة : أنّ الامتياز بين حصص نوع مع حصص نوع آخر ليس بالفصل المقوّم فقط ، بل به وبالتقييدات الحاصلة من القيود اللاحقة المحصّلة للحصص ، والامتياز بالفصل المقوّم فقط إنّما يكون بين نوع ونوع آخر ، لا حصصهما .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعي لا يمكن أن يسري إلى الأفراد ، ولا إلى الحصص التي تخيّلت للطبيعي ،...
____________
1 ـ الفصول الغروية : 109 / السطر6 ، اُنظر كفاية الاُصول : 172 .
2 ـ قوانين الاُصول 1 : 121 / السطر19 ، الفصول الغروية : 107 / السطر37 .
3 ـ تقدّم في الصفحة 173 ـ 176 .
4 ـ مفتاح العلوم : 93 .
5 ـ نهاية الدراية 2 : 253 ـ 255 .
6 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 417 .
7 ـ نهايـة الأفكـار 1 : 380 ـ 381 ، بدائـع الأفكـار (تقريـرات المحقّـق العـراقي) الآملـي 1 : 404 و409 .
8 ـ تقدّم في الصفحة 283 ـ 284 .
9 ـ نهاية الأفكار 1 : 380 .
10 ـ تقدّم في الصفحة 25 و 431 و 491 .
11 ـ الحكمة المتعالية 2 : 8 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 99 .
12 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 407 ـ 410 .
13 ـ راجع رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام ، ضمن رسائل ابن سينا : 463 ـ 479 ، الحكمة المتعالية 1 : 272 ـ 274 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 99 .
14 ـ راجع رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام ، ضمن رسائل ابن سينا : 463 ، الحكمة المتعالية 1 : 273 و 2 : 7 ـ 8 .
15 ـ يأتي في الصفحة 502 .
16 ـ شرح الإشارات 3 : 122 ـ 127 ، الحكمة المتعالية 2 : 204 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 132 .
17 ـ نهاية الأفكار 1 : 386 ،بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 408 ـ 409



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تدعو جامعة ديالى للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|