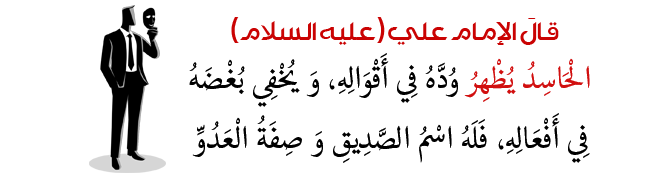
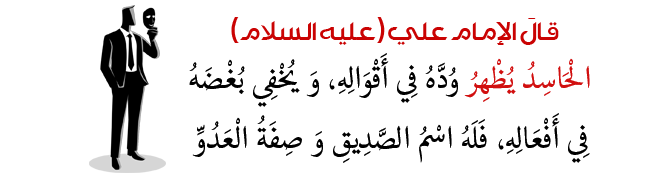

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-10-2014
التاريخ: 16-8-2020
التاريخ: 15-10-2014
التاريخ: 23-12-2014
|
باب التقديم والتأخير
الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر سنذكرها، وأما ما يجوز تقديمه فكل(1) ما عمل فيه فعلٌ متصرفٌ أو كان خبرًا لمبتدأ سوى ما استثنيناه، فالثلاثة العشر التي لا يجوز تقديمها: الصلة على الموصول والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على شريطة التفسير(2) والصفة وما اتصل بها على الموصوف وجميع توابع الاسم حكمها كحكم(3) الصفة، والمضافُ إليه وما اتصل به على المضاف، وما عمل فيه حرف أو اتصل به حرفٌ(4) زائدٌ لا يقدم على الحرف وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعه على منصوبه، والفاعل لا يقدم على الفعل والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها(5)، والصفات المشبهة بأسماءِ(6) الفاعلين، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه، والحروف التي لها صدر الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها، وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه، ولا يقدم التمييز وما عمل فيه معنى الفعل (7), وما بعد إلا, وحروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها ولا يقدم مرفوعه على منصوبه(8)، ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشيءٍ لم يعمل فيه الفعل(9).
شرح الأول من ذلك: وهو الصلة:
لا يجوز أن تقدم على الموصول؛ لأنها كبعضه وذلك نحو صلة "الذي" وأَنْ فالذي توصل بأربعة أشياء؛ بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وجوابه والظرف ولا بدّ من أن تكون في صلتها ما يرجع إليها، والألف واللام إذا كانت بمنزلة "الذي" فصلتها(10) كصلة "الذي" إلا أنكَ تنقل الفعلَ إلى اسم الفاعلِ في "الذي" فتقول في "الذي قامَ": القائمُ, وتقول في "الذي ضَربَ زيدًا": الضاربُ زيدًا, فتصير الألف واللام اسمًا يحتاج إلى صلة، وأنْ تكون في صلته ما يرجع إلى الألف واللام, فلو قلتَ: "الذي ضَربَ زيدًا عمرٌو" فأردت أن تقدم زيدًا على "الذي" لم يجزْ ولا يصلح أن تقدم شيئًا في الصلة ظرفًا كان أو غيره على "الذي" ألبتة، فأما قوله: وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (11) فلا يجوز أن تجعلَ "فيه" في الصلة. وقد كان بعضُ مشايخ(12) البصريين يقول: إنَّ الألف واللام ههنا ليستا في معنى "الذي" وإنَّهما دخلتا كما تدخلان على الأسماء للتعريف، وأَجاز أن يقدم عليها إذا كانت بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى لم يجزْ أن يعمل ما دخلت عليه في شيءٍ فيحتاج فيه إلى عامل فيها, قال أبو بكر (13): وأنا أظن أنهُ مذهبُ أَبي العباسِ يعني أنَّ الألفَ واللامَ للتعريفِ (14) والذي عندي فيه: أنَّ التأويل "وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين" فحذف "زاهدينَ" وبينَهُ بقولِه (15) :مِنَ الزاهدينَ وهو قول الكسائي, ولكنه لم يفسر هذا التفسيرَ وكان هو والفراءُ لا يجيزانِه إلا في(16) صفتين في "مِن وفي" فيقولان: "أَنتَ فينا مِنَ الراغبينَ(17)، وما أَنت فينا من الزاهدينَ" وأما "أَنْ" فنحو قولكَ: "أَن تقيمَ الصلاةَ خيرٌ لكَ" لا يجوز أن تقول: "الصلاةُ أنْ(18) تقيمَ خيرٌ لكَ" ولا تقدمُ "تقيمُ" على "أَنْ" وكذلك لو قلت: "أنْ تقيمَ الصلاةَ الساعةَ خيرٌ لكَ" لم يجزْ تقديمُ "الساعةَ" على "أَنْ" وكذلك إذا قلت: "أَأَنْ تلد ناقتكم(19) ذكرًا أَحبُّ إليكم(20) أَمْ أُنثى" لم يجز أن تقول: أَذكرًا أَأنْ(21) تلدُ ناقتكُم أَحبُّ إليكم أم أُنثى؛ لأن "ذكرًا" العاملُ فيهِ "تلدُ" وتلدُ في صلة "أَنْ" وكذلك المصادر التي في معنى "أَن نفعلَ"(22) لا يجوز أن يتقدم ما في صلتها عليها, لو قلت: أَولادةُ ناقتكم(23) ذكرًا أَحبُّ إليكم(24) أم ولادتُها أُنثى، ما جاز أَن تقدم "ذكرًا" على "ولادةٍ"، وكل(25) ما كان(26) في صلة شيءٍ من اسمٍ أو فعلٍ مما لا يتمُّ إلا به فلا يجوز أن نفصلَ بينَهُ وبين صلته بشيءٍ غريب منه، لو قلت: "زيدٌ نفسهُ راغبٌ فيكم"(27) لم يجزْ أن تؤخر "نفسَهُ" فتجعلهُ بين "راغبٍ" و"فيكم"(28) فتقول: زيدٌ راغبٌ نفسهُ فيكم، فإن جعلتَ "نفسَهُ" تأكيدًا لما في "راغبٍ" جاز.
شرح الثاني : توابع الأسماء.
وهي الصفةُ والبدلُ والعطفُ، لا يجوز أن تقدم الصفة على الموصوف، ولا أن تُعملَ الصفة فيما قبل الموصوف، ولا تقدم شيئًا بصيغة المجهول(29) مما يتصل بالصفة على الموصوف(30)، وكذلك البدل إذا قلت: مررتُ برجلٍ ضاربٍ "زيدًا" لم يجز أن تقدم "زيدًا" على "رجل", وكذلك إذا قلت: "هذا رجلٌ يضربُ زيدًا" لم يجز أن تقول: "هذا زيدًا رجلٌ يضربُ" لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء الواحد، وكذلك كل ما اتصل بها، فإذا قلت: "عبد الله رجلٌ يأكلُ طعامَكَ" لم يجز أن تقدم "طعامَك" قبل "عبد الله" ولا قبل "رجل". والكوفيون يجيزون إلغاء "رجلٍ" فيجعلونه بمنزلة ما ليس في الكلام فيقولون: "طعامَكَ عبد اللهِ رجلٌ يأكلُ" لا يعتدون "برجلٍ" وتقديره عندهم: "طعامكَ عبد الله يأكلُ" وإلغاء هذا غيرُ معروف، وللإِلغاء حقوق سنذكرها إن شاءَ الله, ولكن هذه المسألة تجوز على غير ما قدروا وهو أنْ تجعل "رجلًا" بدلًا من "عبد الله" ترفعهُ(31) بالابتداء وتجعلُ "يأكلُ" خبرًا، فحينئذٍ يصلحُ تقديم "طعامَك"، وأما(32) البدلُ فلا يتقدم على المبدلِ منه، وكذلك ما اتصل به لا يتقدم على الاسم المبدلِ منه. وأما العطفُ فهو كذلك لا يجوز أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه، وكذلك ما اتصل به، والذين أجازوا من ذلك شيئًا أجازوه في الشعر, ولو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولًا لزال الكلام عن جهته, فقدموا حرف النسق مع المنسوق به على ما نُسقَ به عليه وقالوا: إذا لم يكن شيءٌ يرفعُ لم يجزْ تقديم الواو, والبيتُ الذي أنشدوه:
عليكِ ورحمةُ اللهِ السلامُ(33)
فإنما جاز عندهم؛ لأن الرافع في مذهبهم "عليك" وقد تقدم، ولا يجيزونَ للشاعر إذا اضطر أن يقول: "إنَّ وزيدًا عمرًا قائمان" لأن "إنّ" أداةٌ وكل شيءٍ لم يكن يرفع لم يجز أن تليه الواو عندهم على كل حالٍ, فهذا شاذ لا يقاسُ عليه(34)، وليس شيءٌ منصوب مما(35) بعد حرف النسق يجوز تقديمه إلا شيئًا أجازهُ الكوفيونَ فقط, وذلك قولهم: زيدًا قمتُ فَضَربتُ, وزيدًا أَقبلَ عبد اللهِ فشتمَ. وقالوا: الإِقبالُ والقيام هُنا لغوٌ.
شرح الثالث: وهو المضاف إليه:
لا يجوز أن تقدم على المضاف ولا ما اتصل به، ولا يجوز أن تقدم عليه نفسه ما اتصل به فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه إذا قلت: "هذا يومُ تضربُ زيدًا" لَمْ يجزْ أن تقول: "هذا زيدًا يومُ تضربُ"، ولا هذا يومُ زيدًا "تضربُ", وكذلك(36): هذا يومُ ضربِكَ زيدًا، لا يجوز أن تقدم "زيدًا"(37) على "يومٍ" ولا على(38) "ضربِكَ" وأما قولُ الشاعر(39):
للِه دَرُّ اليومَ مَنْ لاَمَهَا
وقوله:
كَما خُطَّ الكِتَابُ بِكَفِّ يومًا ... [يهوديٍّ يُقارِبُ أو يُزِيلُ] (40)
فزعموا(41): أن هذا لما اضطر فصل بالظرف؛ لأنَّ الظروف(42) تقع مواقعَ لا تكون فيها غيرها، وأجازوا: "أَنا طعامَكَ غيرُ آكلٍ" وكان شيخنا يقول: حملته على "لا" إذ كانت "لا" تقعُ موقعَ "غير". قال أبو بكر (43):
والحق في ذا عندي أنْ يكون طعامُكَ منصوبًا بغيرِ "آكلٍ" هذا، ولكن تقدر ناصبًا يفسره "هذا" كأنك قلت(44): أنا لا آكلُ طعامَك، واستغنيت "بغيرِ آكلٍ" ومثل هذا في العربية كثيرٌ مما يضمرُ إذا أتى بما يدل عليه.
شرح الرابع: الفاعل:
لا يجوزُ أن يقدم على الفعل؛ إذا قلت: "قامَ زيدٌ" لا يجوز أن تقدم الفاعل فتقول: زيدٌ قامَ فترفع "زيدًا" بقامَ ويكون "قامَ" فارغًا، ولو جاز هذا لجاز أن تقول: "الزيدانِ قامَ، والزيدونَ قامَ" تريد: "قام الزيدانِ، وقامَ الزيدونَ" وما قام مقام الفاعل مما لم يُسم فاعلهُ, فحكمه حكم الفاعل إذا قلت: "ضُرِبَ زيدٌ" لم يجز أن تقدم "زيدًا" فتقول: "زيدٌ ضُرِبَ" وترفع زيدًا "بضُرِبَ" ولو جاز ذلك لجاز: "الزيدانِ ضُرِبَ, والزيدونَ ضُرِبَ", فأما تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل(45) إذا كان الفعل متصرفًا فجائزٌ, وأعني بمتصرفٍ أن يقال: منه(46) فَعَلَ يفعلُ فهو فاعلٌ، كضَرَبَ يضربُ وهو ضاربٌ, وكذلك اسم الفاعل الذي يعملُ عملَ الفعل حكمهُ حكمُ الفعلِ.
الخامس: الأفعال التي لا تتصرف:
لا يجوز أن يقدم عليها شيءٌ مما عملتْ فيه وهي نحو: نِعْمَ وبِئْسَ وفِعلُ التعجب و"ليسَ" تجري عندي ذلك المجرى؛ لأنها غير متصرفةٍ، ومَه وصَه وعليكَ, وما أشبهَ هذا أبعد في التقديم والتأخير.
السادس: ما أعمل من الصفات تشبيهًا بأسماء الفاعلين وعمل عمل الفعل:
وذلك نحو "حَسَنٌ وشديدٌ وكريمٌ" إذا قلتَ: هو كريمٌ حَسبَ الأبِ, وهو حَسَن وجهًا، لم يجز أن تقول: هُوَ وجهًا حَسَنٌ، ولا هُوَ حَسَب الأبِ كريمٌ، وما كان من الصفات لا يشبه أسماء الفاعلين فهو أَبعدُ لهُ من العمل والتقديم، وكل ما كان فيه معنى فعل وليسَ بفعلٍ ولا اسم(47) فاعلٍ، فلا يجوزُ أن يتقدم ما عَمِلَ فيهِ عليهِ.
السابع: التمييز:
اعلم: أن الأسماء التي تنتصب انتصاب التمييز لا يجوز أن تقدم على ما عمل فيها، وذلك قولك: "عشرونَ درهمًا" لا يجوزُ: "درهمًا عشرونَ" وكذلك: له عندي رطلٌ زيتًا, لا يجوز: "زيتًا رطلٌ" وكذلك إذا قلت: "هو خيرٌ عبدًا" لا يجوز: "هُو عبدًا خَيرٌ" فإن كان العامل في التمييز فعلًا، فالناس(48) على ترك إجازة تقديمه سوى المازني، ومن قال بقوله وذلكَ قولكَ: "تفقأتُ سمنًا" فالمازني يجيز: "سمنًا تفقأتُ"(49)وقياس بابه أن لا يجوز؛ لأنه فاعل في الحقيقة وهو مخالف للمفعولات، ألا ترى أنهُ إذا قال: "تفقأتُ شحمًا" فالشحمُ هو المفقأ، كما أنه إذا قال: "هو خيرٌ عبدًا" فالعبدُ هو خيرٌ، ولا يجوز تعريفهُ فبابه أولى به، وإن كان العاملُ فيه فعلًا، وفي الجملة أن المفسر إنَّما "ينبغي أن"(50) يكون بعد المفسر، واختلف النحويون في: بطرتِ القريةُ معيشتَها، وسفه زيدٌ رأيَه, فقال بعضهم: نصبُه كنصبِ التفسير، والمعنى: "سَفِهَ رأي زيد" ثم حول السفهُ إلى زيدٍ فخرج الرأي مفسرًا فكأن حكمه أن يكون: "سفَه زيدٌ رأيًا" فترك على إضافته ونُصبَ كنصبِ النكرة، قالوا: وكما(51) لا يجوز تقديم ما نصب على التفسير لا يجوز تقديم هذا، وأجاز(52) بعض التقديم وهو عندي القياس؛ لأن المفسر لا يكون إلا نكرةً، وإنما يجري هذا -والله أعلم- على: جَهِلَ زيدٌ رأيهُ، وضيّعَ زيدٌ رأيهُ, وما أشبه هذا. وكذلك: بطرتْ معيشَتها, كأنه: كرهت معيشتها وأحسبُ البطر أنه كراهيةُ الشيءِ من غير أنْ يستحق أن يكره, وكان شيخنا(53) -رحمه الله- لا يجيز: "وجعَ عبد اللهِ رأسَهُ" في تقديمٍ ولا تأخيرٍ؛ لأن "وجعَ" لا تكون متعدية وهي جائزةٌ في قول الكسائي والفراء.
الثامن: العوامل (54) في الأسماء، والحروف التي تدخل على الأفعال:
الأول (55) من ذلك: ما يدخلُ على الأسماء ويعمل فيها, فمن ذلك: حروف الجر، لا يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه، ولا يجوز أن يفرق بينها وبين ما تعملُ(56) فيه، ولا يجوز أن يفصل بين الجار والمجرور حشو إلا ما جاء في ضرورة الشعر، لا يجوز أن تقول: "زيدٌ في اليوم الدارِ" تريدُ: "في الدار اليومَ" ولا ما أشبه ذلك، وقد أجاز قومٌ: "لستَ زيدًا بضاربٍ" لأن الباء تسقط، والقياس يوجب أن تضمر فعلًا ينصب "زيدًا" تفسرهُ(57)
"بضاربٍ" ومن ذلك "إنَّ وأخواتها" لا يجوز أن يقدم عليهن ما عَملن فيه، ولا يجوز أن تفرقَ بينهن وبين ما عَملن فيه بفعلٍ، ولا تقدمُ أخبارهن على أسمائِهن إلا أن تكون الأخبارُ ظروفًا، فإن كان الخبرُ ظرفًا قلت: إنَّ في الدار زيدًا، وإنَّ خلفكَ عمرًا، والظروف يتسع فيهن خاصة، ولكن لا يجوز أن تقدم الظرف على "إنَّ"، ومن الحروف التي لا يقدم عليها ما يليها: "إلا" وجميع ما يستثنى به؛ لأنَّ ما بعد حرف الاستثناء نظيرُ ما بعد "لا" إذا كانت عاطفةً، وقد فسرنا(58) هذا فيما تقدم(59).
وأما الحروف التي تدخلُ على الأفعال فلا تتقدم فيها الأسماء, وهي(60) على ضربين: حروفٌ عواملُ، وحروفٌ غير عواملَ، فالحروفُ العوامل في الأفعالِ الناصبةِ نحو: "جئتكَ كي زيدٌ يقولَ ذاكَ"، لا يجوز(61): "ولا خفتُ أن زيدٌ يقول ذاكَ"(62)، ومنها الحروف الجوازم وهي: لَمْ ولمَّا ولا التي تجزمُ في النهي واللام التي تجزم في الأمر(63)، لا يجوزُ أن تقولَ: "لَمْ زيد يأتِكَ" لأن الجزمَ نظير الجر, ولا يجوز لك أن تفصل بينها وبين الفعلِ بحشو، كما لا يجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشوٍ إلا في ضرورة شعرٍ، ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصب كراهية أن تشبه بما يعمل في الأسماء؛ لأن الاسم ليس كالفعل كذلك(64) "ما يشبههُ"(65)، ألا ترى كثرة ما يعمل في الاسم وقلة ما يعملُ في الفعلِ، وحروف الجزاء يقبحُ(66) أن يقدم(67) الاسمُ معها على(68) الأفعال, شبهوها بالجوازم التي لا تخلو من الجزم إلا أنَّ حروف الجزاءِ "فقط"(69) جاز ذلك فيها في الشعر؛ لأن حروف الجزاء يدخلها "فَعَلَ ويفعلُ" ويكون فيها الاستفهام، ويجوز في الكلام أن يلي "إن" الاسم إذا لم تجزم نحو قوله:
عَاودْ هراةَ وإنْ معمورُها خرِبا(70)
وإن جزمت فلا يجوز إلا في الشعر؛ لأنها تشبهُ "بلَم"، وإنما جازَ هذا في "إنْ" لأنها أم الجزاء لا تفارقه كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا: "إنْ خيرًا فخيرٌ وإنْ شرًّا فشرٌّ" وهي على كل حالٍ إنْ لَم يلها فِعلٌ في اللفظ فهو مقدر في الضمير. وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيها ضعيفٌ, ومما جاء في الشعر مجزومًا في غير "إنْ" قول عَدي بن زيدٍ(71):
فَمَتَى وَاغِلٌ يَنُبْهُم يُحيُّو ... هُ وتُعْطَفْ عليهِ كَأْسُ السَّاقي(72)
وقال الحسامُ:
صَعْدَةٌ نَابِتَةٌ في حَائِرٍ ... أيْنَمَا الرِّيحُ تُمَيِّلْهَا تَمِلْ(73)
وإذا قالوا في الشعر: "إنْ زيدٌ يأتكَ يكن كَذا" إنما ارتفع(74) على فعل هذا تفسيره، وهذا يبين في باب ما يضمر من الفعل, ويظهر إن شاء الله.
الضرب الثاني منه (75) الحروف التي لا تعمل فمنها (76):
"قَدْ" وهي جواب لقوله: "أَفعلُ" كما كانت "ما فعلَ" جوابًا لِهَلْ "فَعَلَ" إذا أخبرت أنه لم يقع، ولما يفعلْ وقد فَعلَ, إنما هُما لقومٍ ينتظرون شيئًا، فمن ثم أشبهت "قَد" لما في أنها لا يفصل بينها وبين الفعلِ، ومن هذه الحروف "سوفَ يفعلُ" لا يجوز أن تفصل بين "سوفَ" وبين "يفعلُ" لأنها بمنزلة "السين" في "سيفعلُ" وهي إثبات لقوله: "لَنْ يفعلَ" ومما شبهَ(77) بهذه الحروف "رُبَّمَا، وقَلما، وأشباههما" جعلوا "رُبَّ" مع "مَا" بمنزلة كلمة واحدة ليذكر بعدها الفعلُ، ومثل ذلك "هَلاَّ ولولا وألا, ألزموهن لا" وجعلوا كل واحدة مع "لا" بمنزلة حرف واحد، وأخلصوهن للفعلِ حيثُ دخل فيهن معنى التحضيض، وقد يجوز في الشعر تقديمُ الاسم، قال الشاعر:
صَدَدْتِ فأَطْوَلْتِ الصُّدُودَ وقَلَّما ... وِصَالٌ على طُولِ الصُّدودِ يَدُومُ(78)
وهذا لفظُ سيبويه(79).
التاسع: الحروف التي تكون صدور (80) الكلام:
هذه الحروف عاملة كانت أو غير عاملةٍ, فلا يجوز أن يقدم ما بعدها على ما قبلها وذلك نحو ألف الاستفهام, و"ما" التي للنفي، ولامُ الابتداء, لا يجوز أن تقول: "طعامَكَ أَزيد آكلٌ" ولا "طعامَكَ لزيدٌ آكلٌ" وإنَّما أَجزنا: إنَّ زيدًا طعامَك لآكلٌ؛ لأن تقدير اللام أنْ يكون قبل "إنَّ" وقد بينا هذا فيما تقدم, هذه اللام التي تكسر "إنَّ" هي لام الابتداء، وإنما فُرقَ بينهما لأن معناهما في التأكيد واحدٌ, فلما أُزيلت عن المبتدأ وقعت(81) على خبره, وهي لا يجوز أن تقع إلا على اسم "إنَّ" أو يكون بعدها خبره، فالاسم نحو قولك: "إنَّ خلفَك لزيدًا" والخبرُ نحو: "إنَّ زيدًا لآكلٌ طعامَكَ" فإن قلت: "إنَّ زيدًا آكلٌ لطعامكَ" لم يجز؛ لأنها لم تقع على الاسم ولا الخبر. ومن ذلك "ما" النافية، تقول: "ما(82) زيدٌ آكلًا طعامَك"، ولا(83) يجوزُ أن تقدم "طعامَكَ" فتقول: "طعامَكَ ما زيدٌ آكلًا" ولا يجوز عندي تقديمهُ وإن رفعت الخبر, وأما الكوفيون(84) فيجيزون: "طعامَكَ ما زيد آكلًا" يشبهونها "بلَم" و"لنْ" وأَباهُ البصريون(85)، وحجة البصريين أنهم لا يوقعون المفعول إلا حيثُ يصلحُ لناصبه أن يقعه، فلما لم يجزْ أن يتقدم الفعلُ على ما لم يجز أن يتقدم ما عَمِلَ فيه الفعل, والفرق بين "مَا" وبين "لَمْ ولَنْ": أنَّ "لَنْ ولَمْ لا يليهما إلا الفعلُ, فصارتا مع الفعلِ بمنزلة حروف الفعل"(86). وأجازَ البصريون(87): "ما طعامَكَ آكلٌ إلاّ زيدٌ" وأحالها الكوفيونَ إلا أحمد بن يحيى(88).
ومن ذلك "لا" التي تعمل في النكرة النصب وتُبنى معها لا تكون إلا صدرًا ولا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها وهي مشبهة(89) "بإنَّ"، وإنما يقع بعدها المبتدأُ والخبرُ، فكما لا يجوز أن تقدم ما بعد "إنَّ" عليها كذلك هي، والتقديم فيها أَبعدُ لأن "إنَّ" أشبهُ بالفعل منها، فأما "لا" إذا كانت تلي الأسماء والأفعال، وتصرفت في ذلك ولم تُشبه "بليسَ" فلك التقديم والتأخير؛ تقول: "أَنتَ زيدًا(90) لا ضاربٌ ولا مكرمٌ" وما أشبه ذلك, ومن ذلك "إنْ" التي للجزاء لا تكون إلا صدرًا، ولا بُدَّ من شرط(91) وجوابٍ، فالجزاء مشبه بالمبتدأ والخبر إذ كان لا يستغني أحدهما عن الآخر ولا يتم الكلام إلا بالجميع(92) فلا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها، لا يجوز أن تقول: "زيدًا إنْ تضربْ أَضربْ" بأي الفعلين نصبته فهو غير جائزٍ؛ لأنه إذا لم يجز(93) أن يتقدم العاملُ لم يجز أن يتقدم المعمولُ عليه(94) وأجاز الكسائي أن تنصبهُ بالفعل الأول(95)، ولم يجزها أحدٌ من النحويين, وأجاز هو والفراءُ أن يكون منصوبًا بالفعل الثاني. قال الفراء: إنما أَجزتُ أن يكونَ منصوبًا بالفعل الثاني وإنْ كان مجزومًا؛ لأنهُ يصلحُ فيه الرفعُ وأن يكون مقدمًا فإذا قلت: "إنْ زيدًا تضربْ آتِكَ" فليس بينهم خلاف "وتضربْ جَزمٌ" إلا أنهم يختلفون في نصب "زيدٍ"، فأَهل البصرة يضمرونَ فعلًا ينصبُ وبعضهم ينصبه بالذي بعدهُ, وهو قولُ الكوفيينَ وأجازوا: "إنْ تأتني زيدًا أضربْ" إلا أنَّ البصريينَ يقولونَ بجزمِ الفعلِ بعد "زيدٍ" وأبى(96) الكوفيونَ جزمَهُ، وكان الكسائي يجيزُ الجزمَ إذا فرق بين الفعلين بصفةٍ, نحو قولك: "إنْ تأتني إليك أَقصدْ" فإذا(97) فرق بينهما بشيءٍ من سبب الفعل الأول فكلهم(98) يجزم الفعل الثاني.
العاشر: أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سبب, وهو غريب منه:
وقد(99) بينا أنَّ(100) العوامل على ضربين: فعل وحرف، وقد شرحنا أمر الحرف فأما الفعل الذي لا يجوز أن يفرق بينه وبينَ ما عَمِلَ(101) فيه(102) فنحو قولك: "كانت زيدًا الحمى تأخذ" هذا لا يجوز(103)؛ لأنك فرقتَ بين "كانَ" واسمها بما هو غريبٌ منها؛ لأن "زيدًا" ليس بخبرٍ لها ولا اسم, ولا يجوز: "زيدٌ فيكَ وعمرٌو رغبَ" إذا أردت: " [زيدٌ] (104) فيكَ رَغِبَ وعمرٌو" لأنك فرقتَ بين "فيكَ" ورغب بما ليس منهُ. وإذا قلت: "زيدٌ راغبٌ نفسه فيكَ" فجعلتَ "نفسَهُ" تأكيدًا "لزيدٍ" لم يجزْ؛ لأنك فرقت بينَ "راغبٍ وفيكَ" بما هو غريب منه, فإنْ جعلتَ "نفسَهُ" تأكيدًا لما(105)في "راغبٍ" جازَ، وكذلك الموصولاتُ لا يجوز أن يفرقَ(106) بين بعض صلاتها وبعضٍ بشيءٍ غريب منها، تقول: "ضربي زيدًا قائمًا" تريد: إذا كان قائمًا، "فقائمًا" حالٌ لزيدٍ، وقد سدت(107) مسدَّ الخبر؛ لأن "ضربي" مبتدأ، فإن قدمت "قائمًا" على زيدٍ، لم يجزْ لأن "زيدًا" في صلة "ضربي" و"قائمًا" بمنزلة الخبر، فكما لا يجوزُ: "ضَرْبي حَسَنٌ زيدًا" تريد: "ضربي زيدًا حَسَنٌ" كذلك لا يجوز هذا، وكذلك جميع الصلات.
الحادي عشر: تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى:
أما تقديم المضمر على الظاهر الذي يجوز في اللفظ فهو أن يكون مقدمًا في اللفظ مؤخرًا في معناهُ ومرتبته، وذلك نحو قولك: "ضَربَ غلامَه زيدٌ" كان الأصل: ضَرَبَ زيدٌ غلامَهُ, فقدمتَ ونيتُكَ التأخير، ومرتبةُ المفعول أن يكون بعد الفاعل, فإذا قلت: "ضَربَ زيدًا غلامُه" كان الأصل: "ضَرَبَ غلامُ زيد زيدًا" فلما قدمتَ "زيدًا" المفعول فقلت: ضَربَ زيدًا, قلت: غلامهُ وكان الأصل: "غلامُ زيدٍ" فاستغنيت عن إظهارهِ لتقدمِه، قال الله عز وجل: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} (108) وهذه المسألة في جميع أحوالها لم تقدم(109) فيها مضمر(110) على مظهرٍ, إنما جئتَ بالمضمر بعدَ المظهرِ إذا استغنيتَ عن إعادته، فلو(111) قدمتَ فقلت: "ضَربَ غلامهُ زيدًا" تريدُ: ضربَ زيدًا غلامهُ لم يجزْ؛ لأنك قدمتَ المضمرَ على الظاهر في اللفظ [والمرتبةِ] (112) لأن حق الفاعل أن يكون قبل المفعول، فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه، إنما تنوي بما كان في غير موضعهِ موضعَه(113) فافهم هذا, فإنَّ هذا(114) الباب عليه يدور. فإذا قلت:
"في بيتهِ يؤتى الحكمُ"، جازَ(115)؛ لأن التقدير "يؤتى الحكمُ في بيتهِ"، فالذي قامَ مقامَ الفاعلِ ظاهرٌ وهو "الحكمُ" ولم تقدم ضميرًا على ظاهرٍ(116)مرتبتُه أنْ يكون قبل الظاهر، فإن قلت: "في بيتِ الحكمِ يؤتى الحكمُ" جاز أن تقول: "يؤتى" وتضمر استغناءً عن إظهاره إذ كان قد ذكره كما تقول إذا ذكر إنسانٌ زيدًا: قامَ وفعلَ، وكذلك إذا ذكر اثنين قلت: "قاماَ وفَعلا" فتضمر اسم من لم تذكر استغناءً بأنَّ ذاكرًا قد ذكره, فإنْ لم تقدره هذا التقدير لم يجز, فإن قدمت فقلت: "يؤتيانِ في بيتِ الحكمينِ" تريد: "في بيتِ الحكمينِ يؤتيانِ" لم يجز, ومن هذا: زيدًا أبوهُ ضَربَ, أو يضربُ، أو ضاربٌ، فحقهُ(117) أن تقول: "زيدًا أبو زيدٍ ضَرَبَ" واختلفوا في قولهم: "ما أَرادَ أَخَذ زيدٌ" فأجازهُ البصريون, ورفعوا زيدًا "بأَخذَ" وفي "أَرادَ" ذكرٌ من زيدٍ، وأبى(118) ذلك الكوفيون ففرقوا(119) بينهُ وبين "غلامَهُ ضَربَ زيدٌ" بأن الهاءَ من نفس الاسم بمنزلة التنوين فصار بمنزلة: غلامًا ضَربَ زيدٌ, ويقولُ قومٌ من النحويين: إذا كان المخفوض ليس في نية نصب فلا يقدم مكنيهُ تقول: "في داره ضربتُ زيدًا" ولا يجوز عندهم: "في داره قيامُ زيدٍ" وهذا الذي لم يجيزوهُ هو كما قالوا مِنْ قبل: إني إذا قلت: "قيامُ زيدٍ" فقيام مبتدأ، ويجوز أن يسقط "زيدٌ" فيتم الاسم, فهو بمنزلة ما ليس في الكلام لأنَّهُ من حشو الاسم وليسَ بالاسم، وإنما أجزت: "قيام زيدٍ في دارهِ"، استغناءً بذكرِ "زيدٍ" ولو قلت: قيام زيدٍ في دارٍ, تمَّ الكلام ولم يُضطر فيه إلى إضمار، فإذا جاءَ الضمير والكلام غير مضطر إليه كان بمنزلة ما لم يذكر، فإذا كان الضمير مؤخرًا بهذه الصفة فهو في التقديم أَبعدُ. واختلفوا في قولهم: "لبستُ مِنَ الثياب أَلينَها" فمنهم من يجيزها كما يجيز: درهَمهُ أَعطيتُ زيدًا، ومن أَباهُ قال:
الفعلُ واقعٌ على "أَلينَ" دون الثيابِ, وأَجازوا جميعًا: "أَخذَ ما أرَادَ زيدٌ"، "وأحبَّ ما أَعجبَهُ زيدٌ" "وخَرجَ راكبًا زيدٌ" لم يختلفوا إذا قدموا الفعلَ, وأهل البصرة أجازوا(120): "راكبًا خَرجَ زيدٌ" ولم يجزها الفراءُ والكسائي وقالا(121): فيها ذكر من الاسم فلا يقدم على الظاهرِ، ولو كان لا يقدمُ ضمير ألبتة على ظاهرٍ لوجبَ ما قالا(122) ولكن المضمر(123) يقدمُ على الظاهر إذا كان في غير موضعه بالصفة التي ذكرت لك، وأجمعوا على قولهم: "أَحرز زيدًا أَجلُه" وفي القرآن: {لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} (124) لأنه ليس في ذا تقديمُ مضمرٍ على ظاهرٍ، وأجمعوا على: "أَحرزَ زيدًا أَجلُه" وعلى: "زيدًا أحرزَ أَجلهُ" فإن قالوا: "زيدًا أَجلهُ أَحرزَ" فأكثر النحويين المتقدمين وغيرهم يحيلُها إلاّ هِشامًا(125) وهي تجوز لأن المعنى: "أَجلُ زيدٍ أحرزَ زيدًا" فلما قلت: "زيدًا أَجلُ زيدٍ أحرزَ" لم تحتج إلى إظهار زيدٍ مع الأجلِ، واختلفوا في: "ثوبِ أَخويكَ يلبسانِ" وهي عندي جائزةٌ؛ لأن المعنى: "ثوبُ أَخويكَ يلبسُ أَخواكَ" فاستغنى عن إعادة الأخوين بذكرهما فأُضمرا.
وأجاز الفراء: دارُ قومِكَ يهدمُ هُم "ويهدمونَ هُم" وتقول: "حينَ يقومُ زيدٌ يغضبُ" لأنكَ تريد: "حينَ يقومُ زيدٌ يغضبُ زيدٌ" فلو أظهرتهُ لجاز واستغنى عن إضماره(126) بذكرِ زيدٍ، ولو أظهرتهُ لظن أنه زيدٌ آخرُ، وهو على إلباسه يجوزُ، ولَيس هذا مثل: "زيدًا ضَربَ" إذا أردتَ: "ضَربَ نفسهُ"
لأن هذا إنما امتنع؛ لأنه فاعل مفعولٍ، وقد جعلت المفعولَ [لا بدّ منهُ] (127)، وحقُّ الفاعل أن يكون غير المفعول إلا في الظن وأخواته، فإذا أردت هذا المعنى قلت: "ضَربَ زيدًا نفسُهُ" "وضَربَ زيدٌ نفسَهُ" وقالوا: فإن لم تجئ بالنفس فلا بدّ من إظهار المكني ليقوم مقامَ ما هو منفصلٌ من الفعل؛ لأن الضميرَ المنفصل بمنزلة الأجنبي، فتقول: "ضَربَ زيدًا هُوَ" و"ضَربَ زيدٌ إيَّاهُ" واحتجوا بقوله عز وجل(128): {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} (129) كأنه في التقدير: "وما يَعلمُ جنودَ ربِّكَ إلاّ ربُّكَ" ولو جاز أن تقولَ: ضربتني وضربتُكَ فأوقعتَ(130) فعلَكَ على نفسِكَ ومَنْ تخاطِبهُ للزمكَ(131) أن(132) تقول: "ضَربهُ" للغائبِ، فتوقع فِعْلَ الغائب على نفسه بالكناية فلا يعلم لمن الهاء فإذا قلت: "ضَربَ نفسَهُ" بان لكَ ذلكَ, وأما الذي يجوز فيه تعدي فعلِ الفاعل إلى نفسهِ فقولك: "ظننتني قائمًا وخلتني جالسًا" فإنَّ هذا وما أشبههُ يتعدى فيه فعلُ المضمر إلى المضمر ولا يتعدى فعلُ المضمر إلى الظاهر؛ لأنَّهُ يصيرُ فيه المفعولُ الذي هو فضلةٌ لا بدَّ منهُ وإلا بطلَ الكلام. وهذه مسألةٌ شرحها أبو العباس وذكر قول أصحابه ثم قولهُ، قالَ: قال سيبويه: "أزيدًا(133) ضربَهُ أبوهُ" لأن ما كانَ من سببهِ موقعٌ به الفِعلَ كما يوقعه ما ليس من سببه ولا أقول: "أزيدًا ضربَ" فيكون الضمير في "ضربَ" هو الفاعلُ، وزيدٌ مفعولًا, فيكون هو الضاربُ نفسَهُ وأضع الضمير في موضع أبيه حيث كان فاعلًا، قيلَ لهُ: لِمَ(134) لا يجوزُ هذا وما(135) الفصلُ بينَهُ وبينَ أبيه, وقد رأينا ما كانَ من سببه يحلُّ محلَّهُ في أَبوابٍ؟ فالجوابُ في ذلك: أنَ المفعولَ منفصلٌ مستغنٍ عنهُ بمنزلةِ ما ليس في الكلامِ، وإنما ينبغي أن يصححَ الكلامُ بغير مفعولٍ ثم يؤتى بالمفعول فضلةً, وأنت إذا قلت: "أزيدًا ضَربَ" فَلو حذفتَ المفعول بطلَ الكلامُ، فصار المفعولُ لا يستغنى عنه، وإنما الذي لا بدّ منه مع الفعلِ الفاعلُ. وكذلك(136) لا تقول: "أَزيدًا ظنهُ منطلقًا" لأن الفاعلَ إذا مَثُلَ بطلَ فصرتَ إنْ قدمتهُ لتضعهُ في موضعه، صار "ظَنَّ زيدًا منطلقًا" فأضمرتَ قبلَ الذكرِ، ولكن لو قلت: "ظنهُ زيدٌ قائمًا" وإياهُ ظُن زيدٌ أَخًا, كان أجود كلامٍ؛ لأنَّ فِعلَ زيدٍ يتعدى(137) إليه في باب "ظننتُ وعلمتُ وأَخواتهما" ولا يتعدى إليه في "ضَربَ" ونحوه، ألا ترى أنكَ تقول: "غلامُ هندٍ ضَربَها" فترد الضمير إليها لأنها(138) مستغنٍ عنها؛ لأنكِ لو قلت: "غلامُ هندٍ ضَربَ" لم تحتج إلى المفعول، فلما كانت في ذكرك رددتَ إليها وحلتْ محل الأجنبي, ولو قلتَ: "غلامُ هندٍ ضربتَ" تجعل ضمير هندٍ الفاعل لكان غلطًا عند بعضهم لأن هندًا من تمام الغلام, والغلامُ مفعولٌ, فقد جعلت المفعول الذي هو فضلة لا بدّ منه ليرجع الضمير الذي هو الفاعلُ إليه, فإن قلت: فما بالي أقول: "غلامُ هندٍ ضاربتهُ هي" فيجوز واجعل هِيَ إنْ شئت إظهارَ الفاعل وهو "لهند"(139)، وإنْ شئت ابتداءً وخبرًا، فالجواب فيه أنه إنما جازَ هنا لأن الغلام مبتدأٌ و"ضاربتهُ" على هذا التقدير مبتدأٌ والفاعلُ يسدُّ مسدَّ الخبرِ, فهو منفصلٌ بمنزلةِ الأجنبي, ألا ترى أنَّكَ لو وضعتَ مكانَ "هي" جاريتَكَ أو غيرها استقامَ، والفاعلُ المتصلُ لا يحل محلَّهُ غيرهُ، فإن قلت أَفتجيزُ: "غلامُ هندٍ ضاربتُه هي" تجعلُ "هي" إن شئتَ ابتداءً مؤخرًا وإن شئتَ جعلت "ضاربتُه"(140) ابتداءً، و"هي" فاعلٌ يسدُّ مسد الخبر فكل هذا جيد لأن "هي" منفصلٌ بمنزلة الأجنبي، ولو قلت: "غلامَ هندٍ ضربتْ أمُّها" كان جيدًا؛ لأن الأم منفصلة وإنَّما أضفتها إلى هند لما تقدم من ذكرها, فهندٌ ههنا وغيرها سواءٌ ألا ترى أني(141) لو قلتُ: غلامُ هندٍ ضربتْ أمُّ هندٍ كانَ بتلك المنزلةِ، إلا أن الإِضمار أحسن لما تقدم الذكر، والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل(142) المذكور إلا على معناه وتقديره، وإنما هذا كقولك: "زيدًا ضَربَ أَبُوه" لأنَّ الأب ظاهرٌ ولو حذفت ما أضفت إليه صَلُحَ فقلت: أبٌ وغلامٌ ونحوهما والأول بمنزلة: "زيدًا ضَربَ" الذي لا يحل محله ظاهرٌ؛ فلذلك استحالَ.
قال أبو العباس: وأنا أرى أنه يجوز: "غُلامَ هندٍ ضَرَبتْ" وباب جوازه أنَّك أضمرتَ "هندًا" لذكركَ إياها، وكان التقدير: غُلامَ هندٍ "ضَربَتْ هِندٌ" فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها، وكان الوجه "غلامَها ضَربَتْ هندٌ" ويجوز الإِظهار على قولك: "ضَربَ أبَا زيدٍ زيدٌ" ولو قلت: "أَباهُ" كان أحسن فإنما أَضمرتَها في موضع ذكرها الظاهر، ولكن لا يجوز بوجهٍ من الوجوه: "زيدًا ضَربَ" إذا جعلت ضمير زيدٍ ناصبًا لظاهره لعلتين: إحداهما: أنَّ فعلَهُ لا يتعدى إليه في هذا الباب, لا تقول: "زيدٌ ضربَهُ" إذا رددتَ الضمير إلى "زيدٍ"، ولا تقول: ضربتني إذا كنتَ الفاعلَ والمفعولَ وقد بينَ هذا, والعلة الأخرى: ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلةٌ يصيرُ لازمًا؛ لأنَّ الفاعل الذي لا بدّ منه معلق به؛ ولهذا لم يجز: زيدًا ظَنَّ منطلقًا، إذا أضمرتَ "زيدًا" في "ظَنَّ" وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو: "ظننتني أَخاكَ" ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرتُ لكَ، وأما(143) "غُلامَ هندٍ ضَرَبَتْ" فجاز، لأن هندًا غيرُ الغلامِ وإن كانت بالإِضافة قد صارت من تمامه، ألا ترى أنك تقول: "غلامُ هندٍ ضَربهَا" ولا تقول: "زيدٌ ضربهُ" فهذا بَينٌ جدًّا واختلفوا في: "ضربني وضربت زيدًا"، فرواهُ سيبويه وذكر أنهم أضمروا الفاعلَ قبلَ ذكره على شريطة التفسير(144)، وزعم الفراء أنه لا يجيزُ نصبَ "زيدٍ" وأجاز الكسائي على أن "ضربَ" لا شيء فيها وحذفَ "زيدًا" وقال بعضُ علمائنا "رحمه الله"(145): والذي قال الفراء, لولا السماعُ لكانَ قياسًا. وأما "عبد اللهِ زيدٌ ضاربٌ أباهُ" فالبصريونَ يجيزون: "أَباهُ عبد اللهِ زيدٌ ضاربٌ"(146), وغيرهم لا يجيزها وهو عندي قبيحٌ؛ لبعدِ العاملِ من الذي عَمِلَ فيه. وطعامَكَ زيدٌ يأكلُ أبوه، لا يجيزها الفراء ولا يجيزُ: "آكلٌ" أيضًا ويجيزها الكسائي إذا قال: "طعامَكَ زيدٌ آكلٌ أبوهُ" لأن زيدًا ارتفع عنده "بآكلٍ" فأجاز تقديم الطعام, ولما كان يرتفع بما عاد عليه من الذكر لم يجزه, وقال الفراء: هو في الدائم(147) غيرُ جائزٍ؛ لأنه لا يخلو من أن أقدرَهُ تقديرَ الأفعال، فيكون بمنزلة الماضي والمستقبل إذا قَدَرهُ تقديرَ الأسماءِ, فلا يجوزُ أنْ أُقدم مفعول الأسماء, ولكني أجيزهُ في الصفات ويعني بالصفات "الظروف"(148). وهذه المسألةُ لم يقدم فيها مضمرٌ على ظاهرٍ، والمضمرُ في موضعه إلا أن "أَبوهُ" فاعلُ "يأكلُ" وطعامكَ مفعولٌ، وقد بعد ما بينهما، وفرقت بين الفاعل والمفعول [بهِ] (149) "بزيدٍ" وليسَ لهُ في الفعل نصيبٌ, ولكن يجوز أن تقولهُ من حيث قلت: "طعامَكَ زيدٌ يأكلُ" فالفاعلُ(150) مضمرٌ فقامَ "أَبوهُ" مقامَ ذلك المضمرِ.
الثاني عشر: التقديم إذا ألبس (151) على السامع أنه مقدم:
وذلك نحو قولكَ: "ضربَ عيسى موسى" إذا كان "عيسى" الفاعل لم يجز أن يقدم "موسى" عليه؛ لأنه ملبس لا يبين(152) فيه إعرابٌ، وكذلك: "ضرَبَ العَصا الرحى" لا يجوز التقديم والتأخير، فإن قلت: "كسر(153) الرحى العصا" وكانت الرحى هي الفاعل وقد عُلِمَ أنَّ العَصا لا تكسرُ الرحى جاز التقديم والتأخير، ومن ذلك قولك: "ضربتُ زيدًا قائمًا" إذا كان السامع لا يعلم من القائم, الفاعلُ أم المفعولُ, لم يجز أن تكون الحال مِن صاحبها إلا في وضع الصفة ولم يجز أن تقدم على صاحبها، فإن كنت أنتَ القائم قلت: "ضربتُ قائمًا زيدًا" وإن كان زيدٌ القائمَ قلت: ضربتُ زيدًا قائمًا، فإن لم يُلبس(154) جاز التقديمُ والتأخير, وكذلك إذا قلت: "لقيتُ مصعدًا زيدًا منحدرًا"(155) لا يجوز أن يكون المصعدُ إلا أنتَ، والمنحدرُ إلا "زيدًا" لأنك إن قدمت وأخرتَ التبسَ، ولو قلت: "ضربَ هَذا هَذا" تريدُ تقديمًا وتأخيرًا لم يجز, فإذا قلت: "ضربَ هَذا هذهِ" جازَ التقديمُ والتأخيرُ فقلت: "ضربَ هَذه هَذا" لأنه غيرُ ملبسٍ(156)، ولو قلتَ: "ضَرَب الذي في الدار الذي في البيت" لم يجز التقديمُ والتأخيرُ لإِلباسه(157), ومن ذلك إذا قلت: "أعطيتُ زيدًا عمرًا" لم يجز أن تقدم "عمرًا" على "زيدٍ" وعمرو هو المأخوذ؛ لأنه ملبس(158) إذا كان كل واحدٍ منهما يجوز أن يكون الآخذَ، فإذا(159) قلت: "أعطيتُ زيدًا درهمًا" جازَ التقديم والتأخير(160) فقلت: "أعطيتُ درهمًا زيدًا" لأنه غير ملبسٍ(161)، والدرهم لا يكون إلا مأخوذًا.
الثالث عشر: إذا كان العامل معنى الفعل (162) ولم يكن فعلًا:
لا يجوز أن يقدم ما عمل فيه عليه، إلا أن يكون ظرفًا وذلك قولك: "فيها زيد قائمًا" لا يجوز أن تقدم "قائمًا" على فيها؛ لأنه ليس هنا فعلٌ، وإنما أعملتَ "فيها" في الحال لما تدل عليه من الاستقرار، وكذلك إذا قلت: "هذا زيدٌ منطلقًا" لا يجوز أن تقدم "منطلقًا" على "هذا" لأن العامل هنا دلَّ على (163) ما دل عليه "هذا" وهو التنبيه وليس بفعلٍ ظاهر، ومن(164) ذلك: "هُو عبد الله حقا" لا يجوز أن تقدم "حقًّا" على "هُوَ" لأن العامل هو المعنى(165)، وإنما نصبت "حقا" لأنك لما قلت: هُو عبد الله، دَلَّكَ على "أحق ذَلكَ" فقلت "حقا" فأما الظرف(166) الذي يقدم إذا كان العامل فيه معنى فنحو(167) قولك: "أكلُّ يومٍ لَكَ ثوبٌ" العامل في "كُلّ" معنى "لَكَ" وهو الملك.
ذكر ما يعرض من الإِضمار والإِظهار:
اعلم: أنَّ الكلام يجيء على ثلاثة أضربٍ: ظاهر لا يحسنُ إضمارهُ, ومضمر مستعمل إظهارهُ, ومضمر متروك إظهاره.
الأول: الذي لا يحسنُ إضمارهُ: ما ليس عليه دليل من لفظٍ ولا حال مشاهدةٍ، لو قلت: زيدًا، وأنت تريدُ: "كَلِّمْ زيدًا" فأضمرت ولم يتقدم ما يدل على "كَلِّمْ" ولم يكن إنسان مستعدًّا للكلام لم يجز, وكذلك غيره من جميع الأفعال.
الثاني: المضمرُ المستعملُ إظهارهُ: هذا الباب إنما يجوز إذا علمت(168) أنَّ الرجل مستغنٍ عن لفظكَ بما تضمره, فمن ذلك ما يجري في الأمر والنهي، وهو أن يكون الرجل في حال ضربٍ فتقول: زيدًا(169) ورأسَهُ وما أشبه ذلك تريد: اضربْ رأسَهُ, وتقول في النهي: الأسدَ الأسدَ، نهيتهُ أنْ يقربَ الأسد، وهذا الإِضمار أجمع في الأمر والنهي، وإنما يجوز مع المخاطب ولا يجوز مع الغائب، ولا يجوز إضمار حرف الجر، ومن ذلك أن ترى رجلًا يسدد سهمًا فتقول: "القرطاس واللهِ" أي: يصيبُ القرطاسَ, أو رأيتهُ في حال رجلٍ قد أوقعَ فِعْلًا أو أخبرت عنهُ بفعلٍ فقلتَ: "القرطاسَ واللهِ" أي: أصاب القرطاسَ، وجاز أن تضمر الفعلَ للغائبِ؛ لأنه غير مأمورٍ ولا منهيٍّ، وإنما الكلامُ خبرٌ فلا لبسَ فيه كما(170) يقع في الأمر, وقالوا: "الناسُ مجزيونَ بأعمالهم" إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرًّا فشرٌّ، يراد إن كانَ خيرًا.
ومن العرب من يقول: "إنْ خيرًا فخيرًا"(171 )كأنه قال: "إنْ كان ما فَعلَ خيرًا جُزي خيرًا"(172) والرفع في الآخر أكثر؛ لأن ما بعد الفاء حقه الاستئناف ويجوز: "إن خيرٌ فخيرٌ" على أن تضمر "كانَ" التي لها خبر وتضمر خبرها، وإن شئت أضمرت "كانَ" التي بمعنى "وقَع" ومثل ذلك: قد مررتُ برجلٍ إنْ طويلًا وإنْ قصيرًا, ولا يجوز في هذا إلا النصب(173), وزعم يونس: أنَّ من العرب من يقول: "إنْ لا صالحٌ فطالحٌ"، على: إنْ لا أكن مررتُ بصالحٍ فطالحٍ(174) وقال سيبويه: هذا ضعيفٌ قبيحٌ, قال: ولا يجوزُ أن تقول: عبد الله المقتولُ(175) وأنت تريد "كن عبد اللهِ" لأنه ليس فعلًا يصلُ من الشيء إلى الشيء(176) ومن ذلك: "أو فرقًا خيرًا مِنْ حُبٍّ" ولو رفع جاز، كأنه قال(177): "أو امرئٍ فرقٌ"، وألا طعامَ ولو تمرًا أي: "ولو كانَ الطعامُ تمرًا" ويجوز: "ولو تمرٌ" أي: ولو كان تمرٌ(178)، ومن هذا الباب: "خيرَ مقدمٍ" أي: قدمتَ، وإن شئتَ قلتَ: "خيرُ مقدمٍ" فجميع ما يرفع إنما تضمرُ في نفسك ما تظهرُ، وجميع ما ينصبُ إنما تضمر في نفسكَ غير ما تظهرُ [فافْهم هذا, فإنَّ عليه يجري هذا البابُ، ألا ترى أنكَ إذا قلت: خيرَ مقدمٍ فالمعنى: قدمتَ, فقدمتَ فعْلٌ، وخيرَ مقدم اسمٌ, والاسمُ غيرُ الفعلِ فانتصبَ بالفعل, فإذا رفعتَ فكأنَّك قلت: قدومُكَ خيرُ مقدم] (179) فإنما تضمر، قدومك خيرُ مقدمٍ, فقدومكَ "هو خيرُ مقدمٍ"، وخبرُ المبتدأ هو المبتدأُ وإذا قلت: "خير مقدمٍ" فالذي أضمرت "قدمت" وهو فعلٌ وفاعلٌ, والفعل والفاعل غير المفعول, فافهم هذا فإن عليه يجري هذا الباب, ومن هذا الباب قولهم: "ضربت وضربني زيدٌ" تريد: "ضربتُ زيدًا وضربني" إلا أن هذا الباب أضمرت ما عَمِلَ فيه الفعلُ, وذلك أضمرت الفعل نفسهُ, وكذلك كلُّ فعلين يعطفُ أحدهما على الآخر فيكون الفاعل فيهما هو المفعول, فلك أن تضمره مع الفعل وتعمل المجاور له, فتقول على هذا: متى ظننتُ أو قلتُ: زيدٌ منطلقٌ؛ لأنَّ ما بعد القول محكي, وتقول: "متى قلتَ أو ظننتَ زيدًا منطلقًا" فإذا قلت: "ضربني وضربتُ زيدًا" ثنيت فقلت: "ضرباني وضربتُ الزيدينِ" فأضمرت قبل الذكر؛ لأنَّ الفعلَ لا بد لهُ من فاعل, ولولا أنَّ هذا مسموعٌ من العرب لم يجز، وإنما حَسُنَ هذا لأنكَ إذا قلت: ضربتُ وضربني زيدٌ, وضربني وضربتُ زيدًا, فالتأويل: تضاربنا, فكل واحدٍ فاعلٌ مفعولٌ في المعنى فسُومِحَ في اللفظ لذلك. ومن ذلك: "ما منهم يقومُ" فحذفَ المبتدأُ، كأنهُ قال: "أحدٌ منهم يقومُ" ومن ذلك قوله عز وجل: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} (180), أي: "أَمرى صبرٌ جميلٌ".
الثالث: المضمرُ المتروك إظهارهُ: المستولي على هذا الباب الأمر وما جرى مجراه، وقد يجوز فيه غيره، فمن ذلك ما جرى على الأمر والتحذير, نحو قولهم: "إياكَ" إذا حذرته، والمعنى: "باعدْ إياكَ" ولكن لا يجوز إظهاره، وإياك والأسدَ وإياك الشرَّ, كأنه قال: إيايَ لأتقينَّ وإياكَ فاتقينَّ, فصارت "إياكَ" بدلًا من اللفظ بالفعلِ، ومن ذلك: "رأسَهُ والحائطَ, وشأنك والحجَّ, وامرأً ونفسَهُ" فجميع هذا المعطوفِ إنما يكون بمنزلة "إياكَ" لا يظهر فيه الفعلُ ما دام معطوفًا, فإن أفردتَ جازَ الإِظهار والواو ههنا بمعنى "مَع". ومما جُعلَ بدلًا من الفعل: "الحذرَ الحذرَ, والنجاءَ النجاءَ, وضربًا ضربًا" انتصب على "الزم"(181) ولكنهم حذفوا لأنه صار بمعنى "افعل" ودخولُ "الزم" على "افعلْ" محالٌ, وتقول: "إياكَ أنت نفسُكَ أنْ تفعلَ" ونفسك إنْ وصفتَ المضمر الفاعل رفعت [وإنْ أضفتَ إياكَ نصبتَ وذلك] (182) لأنَّ "إياكَ" بدلٌ من فِعْلٍ وذلك الفعلُ لا بُدَّ لَهُ من ضمير الفاعل المأمور وإنْ وصفت "إياكَ" نصبتَ وتقول: "إياكَ أنتَ وزيدٌ, وزيدًا"(183) بحسب ما تقدر، ولا يجوز: "إياكَ زيدًا" بغير واوٍ، وكذلك: "إياكَ أن تفعلَ" إن أردتَ: "إياك والفعلَ" وإنْ(184) أردت: إياكَ أعِظُ مخافةَ أَنْ تفعلَ(185), جازَ. وزعموا أن ابن أبي إسحاق(186) أجازَ:
إيَّاكَ إيَّاكَ المِرَاءَ فإنَّهُ ... إلى الشَّرِّ دعاءٌ ولِلخَيْرِ زَاجِرُ(187)
كأنهُ قال: "إياكَ" ثم أضمر بعد "إياك" فعلًا آخر, فقال: اتقِ المراءَ(188).
وقال الخليل: لو أنَّ رجلًا قالَ: إياكَ نفسَكَ لم أُعنفْهُ(189)، يريدُ أن "الكافَ" اسمٌ وموضعها خفضٌ، قال سيبويه: وحدثني منْ لا أتهم(190) عن الخليلِ أنهُ سمعَ أعرابيا يقول: "إذا بلغَ الستينَ فإيَّاهُ وإيا الشواب(191)" ومن ذلك: "ما شأنُكَ وزيدًا" كأنهُ قال: "وما شأنكَ وملابسَة زيدًا"(192)، وإنما فعلوا ذلك فرارًا من العطف على المضمر المخفوض وحكوا: ما أنتَ وزيدًا، وما شأنُ عبد الله وزيدًا كأنه قال ما كان(193). فأما: ويلَهُ وأَخاهُ فانتصب بالفعل الذي نصبَ ويلَهُ, كأنَّكَ قلت: ألزمهُ الله ويلَهُ. وإن قلت: ويلٌ لَهُ وأَخاهُ نصبت؛ لأنَّ فيه ذلك المعنى، ومن ذلك: سقيًا ورعيًا وخيبةً ودفرًا وجدعًا وعَقْرًا وبؤسًا وأفةً وتفةً [لهُ] (194) وبُعدًا وسحقًا وتعْسًا وتَبًّا وبَهْرًا، وجميع هذا بدل من الفعلِ كأنه قال: سقاكَ الله ورعاكَ، وأما ذكرهم "لَكَ" بعد "سقيًا" فليبينوا المعنى بالدعاء وليس بمبني على الأول(195)، ومنه: "تُربًا" و"جَنْدَلًا" أي: ألزمكَ الله وقالوا: فاهًا لفيك يريدون: الداهية، ومنه هنيئا مَرِيا ومنها ويْلَكَ وويْحَكَ وويْسكَ وويبَكَ وعَوْلكَ لا يتكلمُ به مفردًا ولا يكون إلا بعد "ويلكَ"(196). ومن ذلك سبحان الله ومعاذَ الله وريحانهُ, وعمْرِكَ الله إلا فعلتَ, وقعدك الله إلا فعلت بمنزلة: نشدتُكَ الله, وزعمَ الخليلُ: أنهُ تمثيلٌ لا يتكلمُ به(197)، ومنه قولهم: كَرَمًا وصَلَفًَا وفيه معنى التعجب كأنه قال: "أَلزمكَ الله"(198) وصار بدلًا من أكرمْ به وأصْلِفْ بهِ, ومنه: لبيكَ وسعديكَ وحنانيكَ وهذا مثنى، وجميعُ ذا(199) الباب إنما يعرف بالسماع ولا يقاسُ, وفيما ذكرنا ما يدلُّكَ على الشيءِ المحذوف إذا سمعته, ومن ذلك قولهم: "مررتُ به فإذا لَهُ صوتٌ صوت حمارٍ" لأنَّ معنى "لَهُ صوتٌ" هو يصوتُ، فصار لهُ صوتٌ بدلًا منهُ, ومن هذا: "أَزيدًا ضربتَهُ" تريد: أضَرَبْتَ زيدًا ضربتَهُ فاستغنى(200) "بضربتَهُ" وأُضمر فِعْلٌ يلي حرف الاستفهام، وكذلك يحسنُ في كل موضعٍ هو بالفعل أولى، كالأمر والنهي والجزاء، تقول: "زيدًا اضربهُ" وعمرًا لا يقطع الله يدهُ، وبكرًا لا تضربْهُ، وإنْ زيدًا ترهُ تضربهُ، وكذلك إذا عطفت جملةً على جملةٍ فكانت الجملة الأولى فيها الاسم مبني على الفعل، كان الأحسنُ في الجملة الثانية أن تشاكلَ الأولى، وذلك نحو: "ضربتُ زيدًا وعمرًا كلمتهُ" والتقدير: ضربتُ زيدًا وكلمتُ عمرًا فأضمرت فعلًا يفسرهُ(201) "كلمتهُ" وكذلك إن اتصلَ الفعل(202) بشيءٍ من سبب الأول تقول: "لقيتُ زيدًا وعمرًا ضربتُ أَبَاهُ" كأنك قلت: "لقيتُ زيدًا وأهنتُ عمرًا وضربتُ أبَاهُ" فتضمر ما يليق بما ظهر، فإن كان في الكلام الأول المعطوف عليه جملتان متداخلتان كنت بالخيار, وذلك نحو قولك: "زيدٌ ضربتُه وعمرٌو كلمتهُ" إن عطفت على الجملة الأولى التي هي الابتداءُ والخبرُ رفعتَ وإنْ عطفت على الثانية (203) التي هي فِعْلٌ وفاعلٌ وذلك قولك: ضربتُه، نصبتَ، ومن ذلك قولهم: أمَّا سمينًا فسمينٌ، وأما عالِمًا فعالمٌ, ومنه(204) قولهم: "لكَ الشاءُ شاةً بدرهمٍ" ومنه قولهم: "هذا ولا زعَماتِكَ" أي: لا أتوهم زَعماتِكَ (205)وكِليهما وتمرًا(206). ومن العرب من يقول: "كِلاهما وتمرًا" كأنه قال "كِلاهما لي ثابتانِ, وزدني تمرًا" ومن ذلك: " انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ (207)، ووراءكَ أوسع لك, وحسبك خيرًا لك" لأنَّك تخرجهُ منْ أمرٍ وتدخله في آخر ولا يجوزُ ينتهي خيرًا لي؛ لأنَّكَ إذا نهيتَهُ فأنتَ ترجيه إلى أمرٍ، وإذا أخبرتَ فلستَ تريد شيئًا من ذلك، ومن ذلك: "أخذتُه فصاعدًا وبدرهمٍ فزائدًا"(208). أخبرت بأدنى الثمن، فجعلتَهُ أولًا، ثم قررت شيئًا بعد شيءٍ لأثمانٍ شتى، ولا يجوز دخولُ الواو(209) هنا، ويجوز دخول "ثُمَّ" وممَّا انتصب على الفعل المتروك إظهارهُ المنادى في قولِكَ: "يا عبد الله" وقد ذكرت ذلك(210) في بابِ النداءِ(211).
قال سيبويه: ومما يدلُّكَ على أنهُ انتصبَ على الفعل قولُكَ: "يا إياَّكَ" إنما قلت: يا إياكَ أَعني, ولكنهم حذفوا(212)، وذكر أَمَّا أنت منطلقًا انطلقتُ معكَ فقال: إنها "إن" ضمت إليها "مَا"(213) وجعلت عوضًا من اللفظ بالفعل، تريد: إن كنتَ منطلقًا، قال(214): ومثل ذلك: "إمّا لا" كأنَّهُ قال: "افعلْ هذا إنْ كنتَ لا تفعلُ غيرهُ"، وإنما هي "لا" أميلت في هذا الموضع؛ لأنَّها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد, فصارت كأنها ألفٌ رابعةٌ, فأميلتْ لِذاكَ, ومن ذلك: مرحبًا وأهلًا، زعم الخليل أنه بدلٌ من: رحبت بلادكَ(215)، ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمر هو ما يظهر(216).
واعلم: أن جميع ما يحذف, فإنهم لا يحذفون شيئًا إلا وفيما أبقوا دليلٌ على ما ألقوا.
شيئًا بعد شيءٍ لأثمانٍ شتى، ولا يجوز دخولُ الواو(217) هنا، ويجوز دخول "ثُمَّ" وممَّا انتصب على الفعل المتروك إظهارهُ المنادى في قولِكَ: "يا عبد الله" وقد ذكرت ذلك(218) في بابِ النداءِ(219).
قال سيبويه: ومما يدلُّكَ على أنهُ انتصبَ على الفعل قولُكَ: "يا إياَّكَ" إنما قلت: يا إياكَ أَعني, ولكنهم حذفوا(220)، وذكر أَمَّا أنت منطلقًا انطلقتُ معكَ فقال: إنها "إن" ضمت إليها "مَا"(221) وجعلت عوضًا من اللفظ بالفعل، تريد: إن كنتَ منطلقًا، قال(222): ومثل ذلك: "إمّا لا" كأنَّهُ قال: "افعلْ هذا إنْ كنتَ لا تفعلُ غيرهُ"، وإنما هي "لا" أميلت في هذا الموضع؛ لأنَّها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد, فصارت كأنها ألفٌ رابعةٌ, فأميلتْ لِذاكَ, ومن ذلك: مرحبًا وأهلًا، زعم الخليل أنه بدلٌ من: رحبت بلادكَ(223)، ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمر هو ما يظهر(224).
واعلم: أن جميع ما يحذف, فإنهم لا يحذفون شيئًا إلا وفيما أبقوا دليلٌ على ما ألقوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- في الأصل: "وكلما".
2- الواو ساقطة في "ب".
3- في "ب" حكم.
4- زيادة من "ب".
5- الواو ساقطة في "ب".
6- "بأسماء" ساقطة في "ب".
7- زيادة من في "ب".
8- ولا يقدم مرفوعه على منصوبه, ساقط في "ب".
9- نقل السيوطي هذا الباب حرفيا من الأصول.
وانظر: الأشباه والنظائر 1/ 143.
10- في "ب" وصلتها.
11- يوسف: 20.
12- في "ب" المشايخ.
13- زيادة من "ب".
14- زيادة من "ب".
15- زيادة من "ب".
16- زيادة من "ب".
17- في "ب" من الزاهدين.
18- انظر الكتاب 1/ 457, باب الحروف التي لا يقدم فيها الأسماء الفعل.
19- في "ب" ناقتك.
20- في "ب" إليك.
21- في "ب" أن، بهمزة واحدة.
22- أي: المصادر الصريحة.
23- في "ب" ناقتك.
24- في "ب" إليك.
25- في الأصل "وكلما".
26- في "ب" من.
27- في "ب" فيك.
28- في "ب" فيك.
29- زيادة من "ب".
30- لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد.
31- في "ب" فترفعه.
32- في "ب" فأما.
33- صدر بيت للأحوص, وقد مر في الجزء الأول 373 من الأصل.
34- في "ب" ليس عليه، ولا معنى له.
35- في "ب" بما.
36- في "ب" فقولك.
37- زيدًا ساقط في "ب".
38- "على" ساقطة من "ب".
39- من شواهد سيبويه 1/ 91 على الفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة وهو عجز بيت صدره:
لما رأت ساتيدما استعبرت ... لله در.................
وساتيدما: جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبدًا, ورجح البغدادي أنه نهر قرب أرزن. واستعبرت: بكت.
والبيت لعمرو بن قميئة قاله في خروجه مع امرئ القيس إلى ملك الروم وهو الذي عناه بقوله:
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه ... وأيقن أنا لاحقان بقيصرا
وانظر: المقتضب 4/ 377، ومجالس ثعلب 152، ومعجم البلدان 3/ 168-169، وشرح السيرافي 2/ 72، وابن يعيش 3/ 30، والضرائر 43، والإنصاف 1/ 226، والخزانة 2/ 247، والديوان 2/ 62.
40- الشطر الثاني زيادة من "ب" وهو من شواهد سيبويه 1/ 91 على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف للضرورة، والأصل: بكف يهودي، وصف رسوم الدار، فشبهها بالكتابة في دقتها والاستدلال بها، وخص اليهود لأنهم أهل كتاب، وجعل الكتابة بعضها متقارب وبعضها مفترق متباين، ومعنى يزيل: يفرق ويباعد, ونسب الشاهد إلى أبي حية النميري.
وانظر: المقتضب 4/ 377، وشرح السيرافي 2/ 72، وأمالي ابن الشجري 2/ 250، وابن يعيش 1/ 103، والعيني 3/ 470، والتصريح 2/ 59.
41- في "ب" فزعم.
42- في "ب" الظرف.
43- زيادة من "ب".
44- قلت: ساقط من "ب".
45- على الفعل، ساقط في "ب".
46- زيادة من "ب".
47- تصحيح من "ب" والأصل "والاسم".
48- قال سيبويه 1/ 105: وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى المفعول ولم يقوَ قوة غيره مما قد تعدى إلى مفعول, وذلك قولك: امتلأت ماء، وتفقأت شحمًا.. ولا يقدم المفعول فيه, فتقول: ماء امتلأت.
49- انظر: المقتضب 2/ 36، والإنصاف/ 493, وشرح ابن يعيش 2/ 73.
50- ينبغي أن, ساقط في "ب".
51- في "ب" فكما.
52- في الأصل "وجاز" والتصحيح من "ب".
53-أي: أبو العباس المبرد.
54- في "ب" العاملة.
55- في "ب" فالأول.
56- في "ب" وما عملت.
57- في "ب" تفسيره.
58- في "ب" فسر.
59- شرح هذا/ 324 من الجزء الأول.
60- في "ب" فهي.
61- "لا يجوز" ساقط في "ب".
62- انظر الكتاب 1/ 456-457.
63- لما كان الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء، فكما لا يجوز الفصل بين حرف الجر ومعموله، كذلك لا يجوز الفصل بين حرف الجزم ومعموله.
64- قال سيبويه 1/ 457: ومما لا تقدم فيه الأسماء الفعل الحروف العوامل في الأفعال الجازمة وتلك: لم، ولما، ولا التي تجزم الفعل في النهي, واللام التي في الأمر.
65- "ما يشبهه" ساقطة في "ب".
66- في الأصل: يصح، ولا معنى له.
67-في "ب" الأسماء.
68- في "ب" قبل الأفعال.
69- في "ب" فقط ساقطة.
70- من شواهد الكتاب 1/ 457 على تقديم الاسم على الفعل بعد "إن" وحمله على إضمار
فعل؛ لأن حرف الشرط يقتضيه مظهرًا أو مضمرًا، وجاز تقديمه مع الفعل الماضي في "إن" لأنها أم حروف الجزاء، فقويت وتصرفت في التقديم والتأخير.
قال الأعلم: وهراة: اسم أرض، وقال ياقوت: هراة: مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان زارها سنة 607هـ، وهذا الشاهد لم ينسب لقائل معين ولم تعرف بقيته. وانظر الحماسة للمرزوقي 1/ 174.
71- في "ب" فإن.
72- من شواهد سيبويه 1/ 458، والواغل: الداخل على الشرب من غير دعوة بمنزلة الوارش في الطعام، ينبهم: ينزل بهم. ورواه البغدادي في الخزانة:
فمتى واغل يزرهم.....
وانظر المقتضب 2/ 76، وابن الشجري 2/ 332، والإنصاف/ 617، وابن يعيش 9/ 10, والخزانة 1/ 456 و3/ 639، وحماسة البحتري/ 140.
73- من شواهد الكتاب 1/ 458 على تقديم الاسم على الفعل مع "أينما" ضرورة، والصعدة: القناة التي تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف وتعديل، والحائر: المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف، وإنما قيل له حائر؛ لأن المياه تحير فيه فتجيء وتذهب. وصف امرأة فشبه قدها بقناة وجعلها في حائر؛ لأن ذلك أنعم لها وأشد لتثنيها إذا اختلفت الريح.
ونسب البغدادي هذا البيت إلى ابن جعيل.
وانظر: المقتضب 2/ 75، وابن الشجري 1/ 332، والإنصاف 618, والعيني 4/ 434، والخزانة 1/ 457 و3/ 460.
74- في "ب" تقع.
75- زيادة من "ب".
76- في "ب" منها.
77- في "ب" يشبه.
78- من شواهد سيبويه 1/ 12 و1/ 459 على وقوع الجملة الاسمية بعد "قلما" ضرورة؛ لأن ما تكف الفعل "قل" ولا يقع بعد "قلما" إلا الجمل الفعلية. ونسبه الأعلم للمرار الفقعسي، ونسبه سيبويه لعمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه/ 494 في قسم الشعر المنسوب إليه. وأطولت: من طال، وكان عليه أن يقول: أطلت, فقد جاء تصحيح الفعل "أطول" شاذًّا قياسًا.
وانظر: المنصف 1/ 191، والمقتضب 1/ 84، وابن يعيش 7/ 116, وشرح السيرافي 4/ 13، والمحتسب 1/ 96، وشرح الرماني 3/ 163، والخصائص 1/ 143، وأمالي ابن الشجري 2/ 139.
79- انظر الكتاب 1/ 459, والتذييل والتكميل 3/ 263.
80- في "ب" صدر.
81- في "ب" أوقعت.
82- في "ب" ما زيدًا، وهو خطأ.
83- في "ب" لا بدون الواو.
84- جوز الكوفيون: ما زيد آكل؛ لأن "ما" بمنزلة لم ولن ولا، لأنها نافية، كما أنها نافية ... وانظر الإنصاف/ 101.
85- لأن "ما" معناها النفي ويليها الاسم والفعل, فأشبهت حرف الاستفهام. وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله، فكذلك "ما" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وانظر الإنصاف/ 101.
86- في "ب" حروف من الفعل.
87- في "ب" وأجازه.
88- أي: ثعلب.
89- في "ب" تشبه.
90- في "ب" زيد، بالرفع.
91- في "ب" شرك، وهو خطأ.
92-في "ب" ولا.
93- في "ب" لم يكن.
94- في "ب" فيه.
95- في الإنصاف/ 327، ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط نحو: زيدًا إن تضرب أضرب، واختلفوا في جواز نصبه بالشرط، فأجازه الكسائي ولم يجزه الفراء.
96- في الأصل: "وأبا".
97- في "ب" وإذا.
98- في الأصل: وكلهم، والتصحيح من "ب".
99- في "ب" فقد.
100- "أنّ" ساقط من "ب".
101- في "ب" أعمل.
102- فيه ساقطة في "ب".
103- قال سيبويه / 36: لو قلت: كان زيدًا الحمى تأخذ، وتأخذ الحمى، لم يجز وكان قبيحًا.
104- زيادة من "ب".
105- "في" ساقط من "ب".
106- في "ب" بينها وبين صلاتها.
107- في "ب" سد، بإسقاط التاء.
108- البقرة: 124، و"بكلمات" زيادة من "ب".
109- في "ب" يتقدم، بصيغة المبني للمفعول.
110- في "ب" مضمرًا بالنصب.
111- في "ب" لو.
112-زيادة من "ب".
113- في "ب" وموضعه، بزيادة واو.
114- في "ب" فإن ذا.
115- جاز، ساقط من "ب".
116-الحكم، ولم تقدم ضميرًا على ظاهر، ساقط في "ب".
117- في "ب" حقه، بإسقاط الفاء.
118- في الأصل: "وأبا".
119- في "ب" وفرقوا.
120- في "ب" يجيزون.
121- في الأصل "قالوا" وهذه مسألة شرحها ابن الأنباري في الإنصاف. انظر ص142-144.
122-في الأصل "قالوا".
123- في الأصل "الضمير" والتصحيح من "ب".
124- الأنعام: 158.
125- هشام: أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير من نحاة الكوفة, مات سنة 209هـ،
ترجمته في معجم الأدباء 19/ 292.
126- في "ب" إظهاره.
127- زيادة من "ب".
128- عز وجل ساقط في "ب".
129- المدثر: 31.
130- في "ب" فتوقع.
131- في "ب" للزم.
132- في "ب" كأن.
133- في "ب" زيدًا، بدون الهمزة.
134- في "ب" فلم.
135- في الأصل "وأما" والتصحيح من "ب".
136- في "ب" فكذلك.
137- في "ب" عليه.
138- في "ب" لأنه.
139- في "ب" لهند.
140- في "ب" ضاربته ضاربة.
141- في "ب" أنك.
142- زيادة من "ب".
143- في "ب" فأما.
144- انظر الكتاب 1/ 41.
145- رحمه الله، ساقط من "ب".
146- في الدائم، ساقط من "ب".
147- يقصد الكوفيون بالدائم أسماء الفاعلين، فقد قالوا: إنها أفعال دائمة عندهم فليست هي من الأسماء العاملة، ولها من قوة العمل ما للأفعال، ما يؤيد ذلك أنهم كانوا يعملونها في
الماضي والحال والاستقبال مطلقًا وبلا شرط كما تعمل الأفعال في هذه الأزمنة الثلاثة أخذًا بقول الكسائي. وتجويزه أن يعمل بمعنى الماضي، كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال سواء، وتمسك بجواز نحو: زيد معطي عمرو أمس درهمًا.
انظر: شرح الكافية 2/ 200.
148- ويعني به الكوفيون الظرف الذي يطلقه البصريون على نحو: أمام وخلف ويمين وشمال وغيرها من ظروف المكان، وعلى نحو: يوم وليلة، وقبل, وبعد من ظروف الزمان، ومجافاة الكوفيين للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا المصطلح فلم تعرف العربية كلمة الظرف في هذا المعنى؛ لأن الظرف فيها هو الوعاء، واعتبار مدلولات هذه الألفاظ أوعية للموجودات غنًى بالتأثر الفلسفي.
149- زيادة من "ب".
150- في "ب" والفاعل.
151- "ب" التبس.
152- "ب" يتبين.
153- "ب" كسرت.
154- في "ب" يلتبس.
155- انظر المقتضب 4/ 169، وابن الشجري 2/ 282، والبحر المحيط 1/ 71, وهذه المسألة مشروحة بالتفصيل.
156- في "ب" ملتبس.
157- في "ب" لالتباسه.
158- في "ب" ملتبس.
159- في "ب" وإذا.
160- زيادة من "ب".
161- في "ب" ملتبس.
162- في "ب" فعل.
163- هذه الزيادة من "ب".
164- "من" ساقطة في "ب".
165- في "ب" الابتداء بدلًا من المعنى.
166- في "ب" الظروف.
167- في الأصل: "فكنحو" والتصحيح من "ب".
168- في "ب" إذا أعملت، وهو خطأ.
169- في "ب" أو رأسه.
170- "كما" ساقط في "ب".
171- قال سيبويه 1/ 457 مستدلًّا على تقديم الفعل بعد إن الشرطية وحمله على إضمار فعل؛ لأن حرف الشرط يقتضيه مضمرًا أو مظهرًا، جاز تقديمه مع الفعل الماضي في "إن" لأنها أم حروف الجزاء، قال: ... هذا كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا: إن خيرًا فخيرًا،
وإن شرًّا فشرًّا. انظر: الكتاب 1/ 130.
172- في الأصل: أجزى، والتصحيح من "ب".
173- لأنه لا يجوز أن يحمل الطويل والقصير على غير الأول.
174- انظر الكتاب 1/ 132.
175- المقتول، ساقط في "ب".
176- انظر الكتاب 1/ 133.
177- كأنه قال، ساقط في "ب".
178- قال سيبويه 1/ 136: ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره, قولك: ألا طعام ولو تمرًا، كأنك قلت: ولو كان تمرًا.
179- ما بين القوسين زيادة من "ب".
180- يوسف: 83.
181- قال سيبويه 1/ 139: ومما جعل بدلًا من اللفظ بالفعل قولهم: الحذر الحذر, والنجاء النجاء، وضربًا ضربًا، فإنما انتصب هذا على: الزم الحذر وعليك النجاء, ولكنهم حذفوا لأنه صار بمنزلة أفعل، ودخول الزم وعليك على "أفعل" محال.
182-زيادة من "ب".
183- قال سيبويه 1/ 140: "فإن قلت: إياك أنت وزيد" فأنت بالخيار، إن شئت حملته على المنصوب, وإن شئت على المضمر المرفوع.
184- في "ب" "فإن".
185- لأنك تريد أن تضمه إلى الاسم الأول، كأنك قلت: نحِّ لمكان كذا وكذا.
186- ابن أبي إسحاق: هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، كان أعلم أهل البصرة وأعقلهم, هو الذي فرع النحو وقاسه، وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كتابًا مما أملاه, وكان رئيس الناس وواحدهم، أخذ النحو عن يحيى بن يعمر، وأخذ القراءة عنه وعن نصر بن عاصم, مات سنة 117هـ, وقال ابن تغري بردي: إنه توفي سنة 127هـ. وترجمته في طبقات الزبيدي/ 7، وإنباه الرواة 2/ 107، ومراتب النحويين/ 12، والنجوم الزاهرة 1/ 303.
187- من شواهد سيبويه 1/ 141، على نصب "المراء" بعد إياك مع إسقاط حرف العطف ضرورة، والمعروف في الكلام: إياك والمراء، ورواية سيبويه:
إلى الشر دعاء وللشر جالب.
وكذلك رواية المبرد في المقتضب, والمراء: مصدر ماريته مماراة، ومراء، أي: جادلته، ويقال: ماريته أيضًا إذا طعنت في قوله تزييفًا للقول وتصغيرًا للقائل، ولا يكون المراء اعتراضًا بخلاف الجدال، فإنه يكون ابتداء واعتراضًا.
والبيت ينسب للفضل بن عبد الرحمن القريشي, يقوله لابنه القاسم بن الفضل.
وانظر: المقتضب 3/ 213, والخصائص 3/ 112, والمعجم للمرزباني 310، وابن يعيش 2/ 25, والعيني 4/ 113, والخزانة 1/ 465.
188- انظر الكتاب 1/ 141.
189- قال سيبويه 1/ 141: قال الخليل: لو أن رجلًا قال: إياك نفسك، لم أعنفه؛ لأن هذه الكاف مجرورة.
190- لعله يعني أبا زيد الأنصاري.
191- انظر الكتاب 1/ 141, والشواب جمع شابة.
192- قال سيبويه 1/ 141: "قالوا: ما شأنك وزيدًا" أي: ما شأنك وتناولك زيدًا.
193- يريد: ما كان شأن عبد الله وزيدًا.
194 زيادة من "ب".
195- يريد: أنه ليس خبرًا له.
196- انظر الكتاب 160-166.
197- انظر الكتاب 1/ 163.
198- قال سيبويه 1/ 165: "ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره ولكنه في معنى التعجب, قوله: كرمًا وصلفًا، كأنه يقول: ألزمك الله وأدام لك كرمًا، وألزمت صلفًا، ولكنهم حذفوا الفعل ههنا، كما حذفوه في الأول لأنه صار بدلًا من قولك: أكرم به وأصلف به..".
199- في "ب" هذان بدلًا من "ذا" وهو خطأ.
200- في "ب" واستغنى.
201- في "ب" تفسيره.
202- في "ب" الفعل بالفعل شيء بشيء.
203- ما بين القوسين ساقط في "ب".
204- في "ب" ومنهم، والصحيح ما أثبتناه.
205- زيادة من "ب" وهذا مثل, أي: هذا هو الحق ولا أتوهم زعماتك ... ولا يجوز ظهور العامل الذي قبله أتوهم؛ لأنه أجرى أتوهم مثلًا، والأمثال لا تغير. وانظر الأشباه والنظائر 1/ 89.
206- انظر الكتاب 1/ 142.
207- النساء: 171, وتكملة الآية: {وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} .
208- انظر الكتاب 1/ 146-147 بعد زيد.
209- قال سيبويه 1/ 147: "فالواو لم ترد فيها هذا المعنى ولم تلزم الواو الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخر، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، لم يكن في هذا دليل على أنك: مررت بعمرو".
210- في "ب" لك.
211- مر هذا في الجزء الأول ص414.
212- انظر الكتاب 1/ 147.
213- انظر الكتاب 1/ 147.
214- في "ب" وقال، بزيادة واو.
215- انظر الكتاب 1/ 149، فإنما رأيت رجلًا قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرًا، فقلت: مرحبًا وأهلًا، أي: أدركت ذلك وأصبت, فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه، فكأنه صار بدلًا من رحبت بلادك.
216- في سيبويه 1/ 149: ما يضمر هو ما أظهر.
217- قال سيبويه 1/ 147: "فالواو لم ترد فيها هذا المعنى ولم تلزم الواو الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخر، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، لم يكن في هذا دليل على أنك: مررت بعمرو".
218-في "ب" لك.
219- مر هذا في الجزء الأول ص414.
220- انظر الكتاب 1/ 147.
221- انظر الكتاب 1/ 147.
222- في "ب" وقال، بزيادة واو.
223- انظر الكتاب 1/ 149، فإنما رأيت رجلًا قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرًا، فقلت: مرحبًا وأهلًا، أي: أدركت ذلك وأصبت, فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه، فكأنه صار بدلًا من رحبت بلادك.
224- في سيبويه 1/ 149: ما يضمر هو ما أظهر.
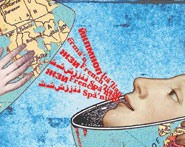
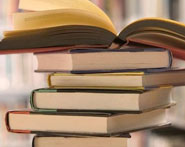

|
|
|
|
15 نوعا من الأطعمة تساعدك على ترطيب جسمك خلال موجة الحر
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تختار شركة "سبيس إكس" لـ"مهمة خاصة" في 2030
|
|
|
|
|
|
|
بالصور: بمناسبة عيد الغدير الاغر.. قراءة خطبة النبي الأكرم (ص وآله) بالمسلمين في يوم (غدير خم)
|
|
|