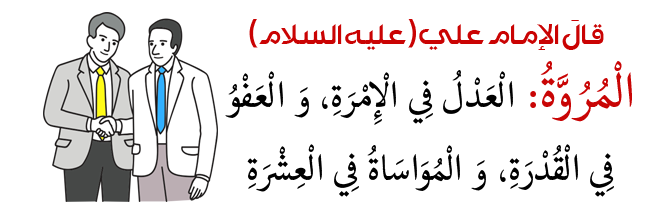
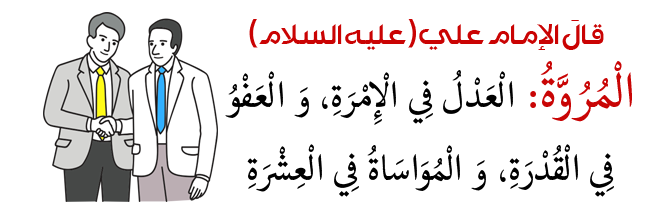

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-2-2021
التاريخ: 29-9-2016
التاريخ: 22-9-2016
التاريخ: 22-9-2016
|
أهداف الدرس:
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى معنى الهوى المذموم.
2- يتعرّف إلى الهوى المذموم في الآيات والروايات.
3- يتعرّف إلى مجامع الهوى الخمسة في القرآن.
4- يتعرّف إلى معنى طول الأمل.
تمهيد:
يحذّرنا الله تعالى في كتابه الكريم من الدنيا ومن عواقب التعلّق بها فيقول:
{فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 37 - 41] فكلّ من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة عاقبته ستكون سيئة إلى حدّ دخول نار جهنّم. وفي المقابل من يؤثر الآخرة على الدنيا، وعلامته محاربة الهوى والنفس الأمّارة، فإنّ مأواه الجنّة.
كما وقد حذّر الإمام عليّ عليه السلام من مخاطر اتّباع الهوى والنفس الأمّارة ومن طول الأمل في الدنيا لكونهما من أعظم الموبقات وأشدّ المهلكات فقال: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ" (1).
من الآية الكريمة والرواية الشريفة يمكن أن نفهم مخاطر هذه الآفّة، فمن يتجاوز الحدّ الذي حدّه الله ولا يتورّع عن ارتكب المعاصي، مفضّلاً بذلك الدنيا على الآخرة، فإنّ النار منـزله ومأواه. وأمّا من خاف الله تعالى والتزم بما يجب عليه فعله أو تركه بحسب القوانين والتشريعات الإلهية، ونهى نفسه عن الحرام الذي تهواه وتشتهيه فإنّ الجنّة مقرّه ومثواه. ولكونهما من أعظم المهلكات حذّر منهما الإمام عليّ عليه السلام، فخطرهما مؤكّد وأثرهما السلبيّ مباشر على سلوك الإنسان وقربه من الله تعالى.
معنى اتّباع الهوى:
"الهوى" في اللغة "حبّ الشيء" و"اشتهاؤه" من دون فرق في أن يكون المتعلّق أمراً حسناً ممدوحاً، أو قبيحاً مذموماً. وهوى النفس هو حبّ النفس والتعلّق بها، وميل الإنسان إلى اتّباع الأوامر الصادرة عنها سواء كانت هذه الأوامر خيراً أم شرّاً. واتّباع أوامر النفس يعدّ شركاً بالله؛ لأنّ المطاع في هذه الحالة هو أوامر النفس وليس أوامر الله تعالى.
فالأمر الصادر عن النَّفس إن كان خيراً ولم يكن في طاعة الله ولأهداف إلهية فهو مخالف لإرادة الله تعالى وبالتالي باطل، وإن كان شراً فهو صادر عن النَّفس الأمّارة بالسوء التي تأمر الإنسان بالسوء دائماً وتدفعه إلى معصية الربّ ومخالفة أمره.
الهوى المذموم في الآيات والروايات:
حذّرنا الله تعالى من اتّباع الهوى في كثير من آيات القرآن. وقد وردت هذه الآيات بصيغ مختلفة فتحدّث عن هذه الحقيقة وأشار إلى أن المتّبع لهواه في الحقيقة عابد لغير الله وهذا الغير هو النفس أو ما يعبّر عنه بالـ (الأنا)، قال: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية: 23] ففي الآية إشارة واضحة إلى أنّ الإنسان يمكن أن يهبط إلى الحدّ الذي تصبح فيه نفسه هي المعبودة والمطاعة وليس الحقّ عزَّ وجلَّ. ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} [الأعراف: 176]، {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الكهف: 28]، {فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى} [طه: 16]، {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: 50].
والمشكلة الكبرى في هذه التبعية للنفس تكمن في أنّها تضلّ الإنسان عن جادّة الحقّ والصِّراط المستقيم، كما قال عزَّ اسمه: {وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} [الأنعام: 119].
لذا كان أمر الله وحكمه واضحاً وصريحاً بضرورة تجنّب هوى النَّفس وطاعتها، لأنّها لن تورث الإنسان إلّا العذاب والضلال: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26]. والمؤمنُ الصَّادق يكفيه أن يعرف الأضرار والمساوئ الناجمة عن اتّباع الهوى وحبّ النَّفس، وما وعد الله به الذين يخافونه في الغيب من الجنان، حتّى يقلع عنه: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40، 41].
مجامع الهوى خمسة:
إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده ذكر أنّ مجامع الهوى خمسة أمور جمعها قوله سبحانه: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [الحديد: 20] ومجامع الهوى حسب الآية على الشكل الآتي:
1- اللعب: وهو عمل منظوم لغرض خياليّ كلعب الأطفال.
2- اللهو: وهو ما يشغل الانسان عمّا يهمّه.
3- الزينة: يراد بها ما يُتزيّن به وهي ضمّ شيء مرغوب فيه إلى شيء آخر ليرغب فيه بما اكتسب به من الجمال.
4- التفاخر: المباهاة بالأنساب والأحساب.
5- التكاثر: في الأموال والأولاد (2).
وبيان هذه المراحل على الشكل الآتي:
مرحلة الطفولة: والحياة في هذه المرحلة عادة مقترنة بحالة من الغفلة والجهل واللعب.
مرحلة المراهقة: حيث يأخذ اللهو مكان اللعب. وفي هذه المرحلة يكون الإنسان لاهثاً وراء الوسائل والأمور التي تلهيه وتبعده عن الأعمال الجدّية.
مرحلة الشباب: وهي مرحلة الحيوية والعشق وحبّ الزينة.
مرحلة الكهولة: وإذا ما تجاوز الإنسان مرحلة الشباب فإنّه يصل إلى المرحلة الرابعة حيث تتولّد في نفسه دوافع العلوّ والتفاخر.
مرحلة ما بعد الكهولة: وأخيراً يصل إلى المرحلة الخامسة حيث يفكّر فيها بزيادة المال والأولاد وما إلى ذلك (3).
والأمور التي تحصل منها هذه الخمسة، سبعة جمعها قوله سبحانه:
{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: 14]. وقد ردّ القرآن الكلّ إلى واحد فقال: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40، 41].
أمّا الروايات الواردة في ذمّ اتّباع الهوى فكثيرة، منها ما ورد عن الإمام عليّ عليه السلام: "والشَّقِيُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهَوَاه وغُرُورِه... ومُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَى مَنْسَاةٌ لِلإِيمَانِ ومَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ ..." (4).
وعنه عليه السلام "عِبَادَ الله لَا تَرْكَنُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ ولَا تَنْقَادُوا لأَهْوَائِكُمْ فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِه مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ ..." (5).
وقد حذّر الإمام عليّ عليه السلام من أوّل الهوى وبداياته: "إيّاكم وتمكّن الهوى منكم، فإنّ أوّله فتنة وآخره محنة"(6)، وعنه عليه السلام: "إيّاكم وغلبة الشهوات على قلوبكم، فإنّ بدايتها ملكة، ونهايتها هلكة" (7)، وعنه عليه السلام: "أوّل الشهوة طرب، وآخرها عطب" (8).
آثار اتّباع هوى النَّفس:
1- ضعف الإيمان بالآخرة: اتّباع الهوى يمكن أن يحول بين الإنسان والإيمان الصحيح بالآخرة: {إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى * فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى} [طه: 15، 16].
2- الضلال: اتّباع الهوى يورث الضلالة، فهو يخرج الإنسان عن طريق الله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص: 50].
3- انتفاء العدالة: اتّباع الهوى مانع من العدل والإنصاف: {فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 135].
4- فسادُ الكون: إنّ نظام السماء والأرض خاضع لإرادة حكيمة وعادلة، فلو دار حول محور أهواء النّاس وشهواتهم لعمّ الفساد كلّ ساحة الوجود: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 71].
5- أساس الغفلة: اتّباع الهوى يحجب عن سبيل الحقّ ويورث الغفلة: {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الكهف: 28].
6- فساد العقل: اتّباع الهوى يفسد العقل ويضعه ويمنعه من التَّمييز بين الحقّ والباطل: فعن الإمام عليّ عليه السلام قال: "طاعة الهوى تفسد العقل" (9).
7- أساس المحن: اتّباع الهوى سبب أساسيّ للمحن والبلاءات التي تصيب الإنسان في هذه الحياة، كما أخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام: "الهوى أُسُّ المحن" (10).
علاج اتّباع الهوى:
إذا عرفنا أنّ اتّباع الهوى يكون باتّباع أوامر النَّفس دون الله والانصياع التامّ لتلبية رغباتها، فإنّ العلاج الأساس يكون بمخالفة هذه الأوامر النابعة من النَّفس والاحتكام عوضاً عنها إلى أحكام الشّريعة في كافة شؤون حياتنا لأنّه {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، بالإضافة إلى تقوية رادع الإيمان والتقوى في النَّفس. فمن يشعر بوجود الله دائماً في حياته ويراه حاضراً وناظراً إلى سلوكيّاته وأفعاله، ويرى محكمة العدل الإلهيّة يوم القيامة بعين البصيرة لا يمكن أن يتجرّأ على كسر طوق الحدود الإلهيّة ويتجاوز التشريعات الدينية ويتلوّث بمفاسد الشَّهوات والرذائل. فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: "خالف نفسك تستَقِمْ، وخالط العلماء تعْلم"(11). فمخالفة النَّفس وإشغالها دائماً بالطاعات والواجبات الشرعيّة بحيث لا يعود لها منفذٌ للجري وراء تلبية الأهواء والشَّهوات، هي السبيل الوحيد للتكامل والرقيّ الإنسانيّ، كما أنَّ معاشرة الصالحين وترك صحبة رفاق السوء لها الأثر الأكبر في توجيه الإنسان نحو معالي الأخلاق وعدم التلوّث في مستنقع الرَّذائل.
معنى طول الأمل:
المراد بالأمل تعلّق النفس بحصول محبوب في المستقبل، ويرادفه الطمع والرجاء، إلاّ أنّ الأمل كثيراً ما يستعمل فيما يستبعد حصوله، والطمع فيما قرب حصوله، والرجاء بين الأمل والطمع. وطول الأمل عبارة عن توقّع أمور دنيويّة يستدعي حصولها مهلة في الأجل وفسحة من الزمان المستقبل.
طول الأمل المذموم:
الأمل في نفسه ليس مذموماً بل ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "الأمل رحمةٌ لأمّتي، ولولا الأمل ما رَضَعَت والدةٌ ولدَها، ولا غَرَس غارس شجراً" (12).
أمّا طول الأمل المذموم فهو ما أشار إليه الإمام عليّ عليه السلام في الحديث بقوله: "وأمّا طول الأمل فيُنسي الآخرة"؛ لأنّ طول الأمل عبارة عن توقّع أمور محبوبة دنيويّة، فهو يوجب دوام ملاحظتها، ودوام ملاحظتها مستلزم لإعراض النفس عن ملاحظة أحوال الآخرة، وما يمكن أن يعقب هذا الإعراض من نسيان كامل لها بعد حين.
والسبب الأساس لطول الأمل هو حبّ الدنيا. فإنّ الإنسان إذا أنس بالدنيا ولذّاتها ثقل عليه مفارقتها وأحبّ دوامها، فلا يتفكّر في الموت الذي هو سبب مفارقتها. فإنّ من أحبّ شيئاً كره الفكر فيما يُزيله ويُبطله، فلا تزال نفسه تتمنّى البقاء في الدنيا وتقدّر حصول ما تحتاج إليه من أهل ومال وأدوات وأسباب، ويصير فكره مستغرقاً في ذلك، فلا يخطر الموت ولا الآخرة بباله.
وإن خطر بخاطره الموت والتوبة والإقبال على الأعمال الأخرويّة أخّر ذلك من يوم إلى يوم، ومن شهر إلى شهر، ومن عام إلى عام، وقال: إلى أن أكتهل وتزول سنّ الشباب، فإذا اكتهل قال: إلى أن أصير شيخاً، فإذا شاخ قال: إلى أن أتمّ هذه الدار وأزوّج ولدي فلاناً، وإلى أن أعود من هذا السفر، وهكذا يسوّف التوبة، كلّما فرغ من شغل عرض له شغل آخر ـ بل أشغال ـ حتّى يختطفه الموت وهو غافل عنه غير مستعدّ له مستغرق القلب في أمور الدنيا، فتطول في الآخرة حسرته، وتكثر ندامته، وذلك هو الخسران المبين (13). جاء فيما ناجى الله تعالى النبيّ موسى عليه السلام: "يا موسى، لا تُطوِّلْ في الدنيا أمَلَك فيقسو قلبُك، والقاسي القلبْ منّي بعيد"(14).
ولمعرفة خطورة طول الأمل على الآخرة لا بدّ أن نلتفت إلى الحديث المرويّ عن الإمام الكاظم عليه السلام الذي يقول فيه: "اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً"(15). وهذا الحديث هو عنوان المؤمن الفطن حقّاً، يعمل لإصلاح الدنيا، عمل من يرى أنّ الدنيا أبديّة دائمة، فيعبّد الأرض، ويشقّ الأنهار، ويزرع الفيافي، ويعمّر البلاد، وما إلى ذلك من زينة الحياة الدنيا، وبهجة الحضارة البشرية هذا من جانب، ومن جانب آخر يعمل للآخرة، كأنه يموت غداً، فيصلّي لربه الفرائض، ويؤدّي الصدقة الواجبة، ويحجّ البيت إن استطاع إليه سبيلاً، ويــصوم الصوم الواجب، ويأمر بالمعروف ويتحلّى بالفضيلة، ويجتنب المحــرّمات والمآثم، حتّى لا يبالي أمات غداً أو بعد ألف سنة.
وهكذا إنسان هو الجامع بين خير الدنيا وخير الآخرة. أمّا الذي يؤخّر أمر الآخرة كأنّه يعيش أبداً، ويقدّم أمر الدنيا فهو الذي له (أمل خاطئ)، ومثل هذا الأمل مذموم مُهلك. إنّه يعتقد بقاءه مدّة متمادية، فيهيّئ لنفسه لوازم لهذه المدة من مال ودار وأثاث ورياش، ثمّ لا يلتفت إلى الآخرة، يرجئ الحجّ ويؤخّر الخمس، ولا يخرج عن المظالم، ولا يبادر لقضاء ما فاته من صلاة وصيام وهكذا فجأة يأتيه الموت...
المفاهيم الرئيسة:
1- "الهوى" في اللغة "حبّ الشيء" و"اشتهاؤه" من دون فرق في أن يكون المتعلّق أمراً حسناً ممدوحاً، أو قبيحاً مذموماً. وهوى النفس هو حبّ النفس والتعلّق بها، وميل الإنسان إلى اتّباع الأوامر الصادرة عنها سواء كانت هذه الأوامر خيراً أم شرّاً. واتّباع أوامر النفس يعدّ شركاً بالله لأنّ المطاع في هذه الحالة هو أوامر النفس وليس أوامر الله تعالى.
2- مجامع الهوى هي: اللعب، التكاثر، الزينة، التفاخر، اللهو.
3- من آثار اتّباع هوى النَّفس: ضعف الإيمان بالآخرة، الضلال، انتفاء العدالة، فسادُ الكون، وفساد العقل، والوقوع في الغفلة، واج لمحن والبلاءات.
4. إنّ العلاج الأساس يكون بمخالفة هذه الأوامر النابعة من النَّفس والاحتكام عوضاً عنها إلى أحكام الشّريعة في كافة شؤون حياتنا لأنّه {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، بالإضافة إلى تقوية رادع الإيمان والتقوى في النَّفس.
5- المراد بالأمل تعلّق النفس بحصول محبوب في المستقبل، ويرادفه الطمع والرجاء، وطول الأمل عبارة عن توقّع أمور دنيويّة يستدعي حصولها مهلة في الأجل وفسحة من الزمان المستقبل.
6- الأمل في نفسه ليس مذموماً بل ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "الأمل رحمةٌ لأمّتي، ولولا الأمل ما رَضَعَت والدةٌ ولدَها، ولا غَرَس غارس شجراً". أمّا طول الأمل المذموم فهو ما أشار إليه الإمام عليّ عليه السلام في الحديث بقوله: "وأمّا طول الأمل فيُنسي الآخرة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السيد الرضي، نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام، ص 72، الخطبة رقم 28.
(2) ينظر: العلامة الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج19، ص 164 (بتصرف).
(3) ينظر: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج18، ص 56 (بتصرف).
(4) السيد الرضي، نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام، ص 117، الخطبة رقم 86.
(5) المصدر نفسه، ص 152، الخطبة رقم 105.
(6) الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 101.
(7) المصدر نفسه، ص 101.
(8) المصدر نفسه، ص 112.
(9) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 434.
(10) المصدر نفسه، ص 56.
(11) المصدر نفسه، ص 364.
(12) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج74، ص 173.
(13) ينظر: حبيب الله الهاشمي الخوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج4، ص 202.
(14) الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص 329، باب القسوة، ح1.
(15:) الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، تحقيق وتصحيح علي أكبر غفاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1413 هـ، ط 2، ج3، ص 156، ح 3569.



|
|
|
|
دراسة: طريقة قيادة السيارة قد تكشف عن مرض نفسي لدى السائق
|
|
|
|
|
|
|
بتكنولوجيا خاصة.. إنتاج حرير روسي عالي الجودة
|
|
|
|
|
|
|
شاهد بالصور مراحل انجاز جديدة يدخلها مشروع صحن العقيلة زينب (ع)
|
|
|