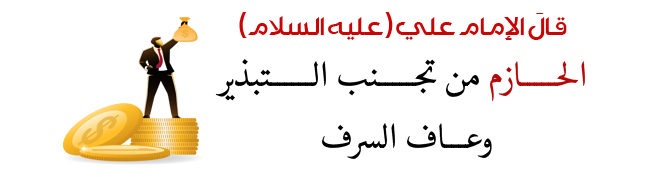
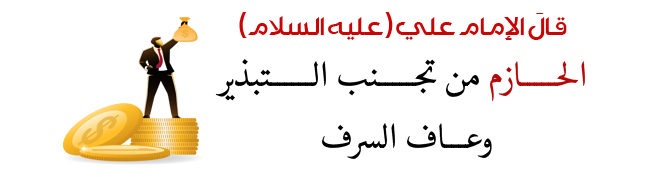
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-7-2016
التاريخ: 4-6-2017
التاريخ: 22-3-2018
التاريخ: 14-08-2015
|
هل المحاكاة تقليد، "صادق" للطبيعة، ام هي تقليد كاذب؟ وما هي علاقة الكذب، أو المبالغة بالخيال؟ وهل الشعر "صدق" كله، أو كذب كله؟ الحق ان حازماً اتى في هذه المسائل بما ينم على بصر نافذ، فقد نبه منذ البداية على ان قوام الشعر ليس الصدق أو الكذب، وانما التخييل، والشاعر قد يخيل ما هو صادق، وقد يخيل ما هو كاذب، ولا يكون شاعراً باعتبار ما خيله، وانما يكون شاعراً باعتبار قدرته على التخييل، والتخييل ينظر إلى الشيء نظرة "الفن" لا نظرة "الخلق" واذا ما اجاد تصوير الشيء لم يبال ان يكون هذا الشيء صادقاً أو كاذباً: (الرأي الصحيح في الشعر ان مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة، وليس يعد شعراً من حيث هو صدق، ولا من حيث هو كلام مخيل)(1) ولا ريب ان هذه النظرة النفاذة تنأى بالشعر عن مشكلة الكذب التي تناقض طبيعته وترجع به إلى مشكلة التخييل التي هي جوهر الشعر حقاً لأن الشاعر قد يكون صادقاً في تخييل ما هو كاذب، ويبقى شاعراً ما دام مخيلاً: (والشعر لا يناقض اليقين ما يتقوم به وهو التخييل . . . فالتخييل هو المعتبر في صناعته، لا كون الاقاويل صادقة او كاذبة)(2).
ويلوح ان حازماً
كان يتبرم بما شاع من امر الكذب في الشعر منذ ايام قدامة فأراد ان يدفع عن الشعر
ما قذف به موضحاً ان الكذب، إن كان مقبولاً، فإن الصدق اولى منه بالقبول، فهو يقول
في تعريف الشعر: (فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته، وهيئته، وقويت شهرته، أو صدقه، او
خفي كذبه، وقامت غرابته، وان كان قد يعد حذقاً للشاعر اقتداره على ترويج الكذب،
وتمويهه على النفس، واعجالها إلى التأثر له قبل، بإهمالها الروية فيما هو عليه(3)،
فهذا يرجع إلى الشاعر وشدة تخيله في ايقاع الدلة للنفس في الكلام، فأما ان يكون
ذلك شيئاً يرجع إلى ذات الكلام فلا)(4) وظاهر هنا ان حازماً يؤثر شهرة
الصدق، وخفاء الكذب، وان كان يعد الكذب من حذق الشاعر الذي يتغلغل به إلى النفوس
لأن (وضوح الكذب يزعها عن التأثير بالجملة)(5) وكأنه يربط بين الشعر والنفس ، فما افضى إلى
حسن التغلغل فيها، فهو محمود سواء أكان صادقاً أم كاذباً، ولكن لما كان خفاء الكذب
ادعى إلى هذا التأثير كان افضل من وضوحه، وطبعاً فإن الصدق اولى بالتأثير في النفس
بهذا المعيار، ومن ثم فهو غاية الشاعر التي ينبغي إلا يتركها إلا مضطراً: (ونما
يرجع الشاعر إلى القول الكاذب، حيث يعوزه الصادق والمشتهر بالنسبة إلى مقصده في
الشعر)(6)
والحق ان الناظر
في معالجة حازم لمشكلة الصدق والكذب، يشعر بالجهد الذي بذله ليدراً عن الشعر شبهة
الكذب، مبرهنا على ان الشعر يعتمد على الصدق ايضاً، فلقد عني مثلاً بإيضاح غلط من
ظن المحاكاة كذباً، فبين ان الكذب انما يتعلق بالإفراط الذي يجاوز حد الاعتدال في
التشبيه لا بأصل التشبيه: (وكثير من الناس يغلط فيظن ان التشبيه، والمحاكاة، من
جملة كذب الشعر، وليس كذلك لأن الشيء إذا اشبه الشيء، فتشبيهه به صادق لأن المشبه مخبر
ان شيئاً، وكذلك هو بلا شك. . فقد تبين ان الوصف والمحاكاة لا يقع الكذب فيهما إلا
بالإفراط وترك الاقتصاد) (7) ثم افاض في شرح قسمة الشعر، بالنسبة إلى الصدق والكذب
بين الافراط، والاختلاق والامتناع، والاحالة والصدق المحض، وهو يصرح ان دفاعه عن
الاقاويل الصادقة في الشعر انما يرجع إلى رغبته في رد قول من قال: ان الاقاويل
الشعرية كاذبة دائماً ــ ولعله يعني الفارابي الذي قال: (والكاذبة بالكل لا محالة
فهي الشعرية) (8) ــ فيكرر رأيه في ان قوام الشعر التخييل لا الصدق
والكذب ويستشهد بابن سينا في ذلك(9).
ولقد خلص حازم بعد
ان اثبت المقدمات الصادقة في الشعر، وبعد ان بين (أن افضل المواد المعنوية في
الشعر ما صدق، وكان مشتهراً)(10) إلى القول بتفضيل الصدق في الشعر على
الكذب الذي ينبغي إلا يلجأ إليه إلا على سبيل الضرورة، وكأنه لم يكتف بإثبات فضل
الصدق، حتى قدمه على الكذب الذي عاد به إلى المرتبة الثانية بعد ان ظل دهراً ينظر
إليه على انه معيار الفن الشعري: (وتبين بهذا ان قول من قال: ان مقدمات الشعر لا
تكون إلا كاذبة كاذب . . .وما مثله في قصر الشعر على الكذب مع ان الصدق انجع فيه
اذا وافق الغرض إلا مثل من منع ذي علة ما هو أشد موافقة بالنسبة إلى شكاته، واقتصر
به على ادنى ما يوافقه، مع التمكين من هذا وذاك)(11) ولسنا ندري لم
القى حازم وزر القول بكذب الشعر على المتكلمين مع ان النقاد هم الذين تولوا كبر
هذا الامر منذ قال قدامة: (ان الشاعر ليس يوصف بان يكون صادقاً)(12)
وان احسن الشعر اكذبه(13) إلى ان قال ابن رشيق ان الكذب حسن في الشعر:
(ومن فضائله ان الكذب ــ الذي اجتمع الناس على قبحه ــ حسن فيه، وحسبك ما حسن
الكذب، واغتفر له قبحه)(14) وحقاً، قد يكون حازم اعترض على قول
المتكلمين ان الاقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة، من حيث انه يحول دون اتجاه
الشعر إلى الصدق مطلقاً، وليس كذلك كلام النقاد الذي يؤثرون الكذب، دون ان ينفوا
الصدق، بيد ان الامر في النهاية يفضي إلى نتيجة واحدة، وهي ان الكذب جوهر الفن
الشعري، واذا كان حازم قد ادرك بعمق خطر هذه النتيجة على صناعة الشعر، فقد كان
ينبغي ان يهاجم كل من قال بها، سواء اكان، متكلماً ام ناقداً، ولا يقتصر على
السخرية من علم المتكلمين بالبلاغة: (وانما غلط في هذا ــ فظن ان الاقاويل الشعرية
لا تكون إلا كاذبة ــ قوم من المتكلمين، لم يكن لهم علم بالشعر، لا من جهة مزاولته
ولا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته ولا معرج على ما يقوله في الشيء من لا يعرفه،
ولا التفات إلى رأيه فيه . . . والذي يورطهم في هذا انهم يحتاجون إلى الكلام في
اعجار القرآن، فيحتاجون إلى معرفة ماهية الفصاحة، والبلاغة، من غير ان يتقدم لهم
علم بذلك)(15) ويبدو ان ها هنا تحاملاً خفياً على المتكلمين لأنهم ليسوا وحدهم الذين قالوا
بذلك، فالفارابي ــ فضلاً عن النقاد ــ يقرر ذلك بوضوح.
على ان الامر
يقتضي هنا النظر في معنى الصدق والكذب عند حازم، فأغلب الظن انه يريد بصدق
المحاكاة تطابق حدي التشبيه، على سبيل الاعتدال، وهو ما عبر عنه غيره من النقاد
يقرب التشبيه، يقول: (ما وقع من الاوصاف والمحاكاة مقتصداً فيه، غير متجاوز، فهو
قول صدق، فاذا قيل في الشيء انه كالشيء وكان فيه شبه منه فهو قول حق)(16)،
واذا كان مثل هذا القول يبدو مألوفاً، فإن ملاحظة حازم ان الصدق انما يكون مخيلاً
ايضاً مثل الكذب تضفي عليه معنى جديداً، لأنها تنبه على ان الابداع الشعري لا
يتجلى في الكذب فحسب، وانه يتجلى ايضاً في الصدق، بل قد يكون الصدق اقرب إلى الفن،
وذلك يصحح بلا ريب ما درج عليه النقد من اعتبار الكذب مجلى الفن الاول، بحيث ان
ناقداً فذا مثل عبد القاهر لم يتورع عن القول ان التخييل ضرب من الخداع(17)،
وحقاً، ظلت هذه الملاحظة جزئية لاقترابها بمفهوم التشبيه، بيد انها نمت على ادراك
جديد لقيمة الصدق ولو وجد الناقد الحاذق لأفاد منه شيئاً كثيراً، بل لو ان حازماً
نفسه تأمل فيما يعينه ربط الخيال بالصدق دونا ن يتعلق الامر بالصدق في التشبيه
فحسب، لاستطاع ان ينبه ايضاً على انطا شعرية جديدة، فضلاً عن تطوير النمط القديم.
ويبدو انه لا بد
من بسط كلام حازم في هذا المجال، كما تستبين نظرته الحقيقة، فهو يرى مثلاً ان من
الشعر صادقاً وكاذباً ومؤلفاً منهما، فأما الصادق فهو المطابق لما وقع في الوجود(18)،
وأما الذي اجتمع فيه الصدق والكذب فهو الافراط في صفة صادقة، لأن الافراط ضرب من
الكذب(19)، وأما الكاذب فهو معقد الشعر، لأنه يمثل معظمه فإذا كان الصادق،
صنفين، والمختلط صنفاً فإن الكاذب سبعة أصناف، ولا يعنينا هنا الخوض في هذه القسمة
المنطقية للشعر، وانما يعنينا ملاحظة ان حازماً، إن كان قد قدم الصدق على الكذب في
قيمته الشعرية ، فإنه حين قسم الشعر جعل معظمه كاذباً، ويبدو ان ذلك يرج إلى
تعريفه للشعر الصادق بأنه "القول المطابق للمعنى على ما وقع في الوجود"(20)،
ولما كان من العسير ان ينطبق هذا التعريف إلا على قدر ضئيل من الشعر، فقد وجد نفسه
مضطراً للقول بغلبة الكذب الشعري، بيد انه لو قال: ان الشعر الصادق هو المطابق
للمعنى على ما يمكن ان يقع في الوجود، لا على ما وقع فعلاً لاستطاع ان يخلص الشعر
من التقليد الحرفي للطبيعة، إلى التقليد الجوهري، ولكنه كان فيما يبدو خاضعاً
دائماً لمفهوم التشبيه في المحاكاة.
ويمضي حازم فيرى
ان القول الكاذب اما ان يكون اختلافاً إمكانياً، واما ان يكون اختلافاً امتناعياً،
وإلا مكاني هو ما لا سبيل إلى معرفة صدقه، سواء من داخل القول ام من خارجه، كأن
(يدعى الانسان انه محب، ويذكر محبوباً تيمه، ومنزلاً شجاه، من غير ان يكون كذلك)(21)
، والامكان هو (ان يذكر ما يمكنا ان يقع منه، ومن غيره من ابناء جنسه، وغير ذلك
مما يصفه ويذكره)(22) ، وهذا الاختلاف الإمكاني يتعلق بجهات الشعر
واغراضه (وجهات الشعر هو ما توجه الاقاويل الشعرية لوصفه ومحاكاته، مثل الحبيب،
والمنزل، والطيف في طريق النسيب، فمثل هذه الجهات يعتمد وصف ما تعلق بها من
الاحوال التي لها علقة بالأعراض الانسانية، فتكون مسانح لاقتناص المعاني بملاحظة
الخواطر، ما يتعلق بجهة جهة من ذلك، والاغراض : هي الهيئات النفسية التي ينحى
بالمعاني المنتسبة إلى تلك الجهات نحوها ويمال بهف في صفوفها، لكون الحقائق
الموجودة لتلك المعاني في الاعيان، مما يهيئ النفس بتلك الهيئات، ومما تطلبه النفس
ايضاً، أو تهرب منه، إذا تهيأت الهيآت) (23)
وظاهر اذن ان الاختلاق الإمكاني هو محاكاة ما
يمكن ان يثير في النفس الشجو بحيث يلهم الخواطر، دون ان يكون موضوع المحاكاة نفسه
صادقاً فضلاً عن المحاكي، ولا بد هنا من التريث عند مسألة الممكن هذه لما تنبئ عنه
من ملاحظة تغير من القول بأن معظم النقاد كانوا يؤثرون الواقع على الممكن ــ ومنهم
حازم نفسه ــ بيد اننا اذا انعمنا النظر، الفينا حازماً يقرن الممكن بالكذب لا
بالصدق، فكأنه يفترض ان الشاعر، اذا ما افاض في الكلام عن منزل شجاه، دون ان يكون
ثمة منزل حقاً كان لا بد كاذباً فالمعيار هنا عقلي، ولكنه أغفل ان الشاعر لا يوصف
بصدق أو كذب اذا كان يعبر عما يمكن ان
يشعر به أي انسان ازاء ما يحاكي من الاشياء ــ وهي الاشياء التي اسماها حازم بجهات
الشعر التي لها علقة بالأعراض الانسانية ــ وحسب الشاعر ان يجيد محاكاة ما يمكن ان
يكون حتى يكون صادقاً في ملاحظة التجربة الانسانية، ولعل حازماً نسى ما قاله من ان
المهم في الشعر جودة التخييل دون نظر إلى صدق أو كذب، ولا سيما اذا كان المقصود هو
الكذب الفني، وهكذا، فلعل ربط هذه الملاحظة بالكذب قد اساء إلى ما يمكن ان تفضي
إليه من توجيه الشاعر إلى محاكاة ما يمكن ان يكون، وعدم الاقتصار على ما هو كائن،
دون ان يرمى بالكذب.
على ان ثمة سبباً
آخر دفع حازماً إلى هذا الموقف المتردد، وهو نظرته إلى ما اسماه (الاختلاق
الامتناعي) الذي أنكر ان يكون وقع للعرب(24)، فقد خيل إليه ان الاساطير
اليونانية هي من قبيل خرافات العجائز التي يسامرون بها الصبيان وانها مبنية على
اختلاق اشياء لم تقع، يقيسونها على ما وقع، ويصرفون فيها القول وهو ما لم يفعله
العرب قط: (والاختلاق الامتناعي ليس يقع للعرب في جهة من جهات الشعر اصلاً، وكان
شعراء اليونانيين يختلقون اشياء يبنون عليها تخاييلهم الشعرية، ويجعلونها جهات لأقاويلهم،
ويجعلون تلك الاشياء التي لم تقع في الوجود كالأمثلة لما وقع فيه، ويبنون على ذلك
قصصاً مخترعاً نحو ما تحدث به العجائز الصبيان في اسمارهم من الامور التي يمتنع
وقوع مثلها )(25)، وواضح ان حازماً ينهج هنا منهج ابن سينا الذي ذهب
ايضاً إلى انه (لا يجب ان يوقف في اطراغوذيا واختراع الخرافات فيها على هذا النحو،
فإن هذا ليس مما يوافق جميع الطبائع، فإن الشاعر انما يجود شعره لا بمثل هذه
الاختراعات، بل انما يجود قرضه، وخرافته، اذا كان حسن المحاكاة بالمخيلات، وخصوصاً
للأفعال، وليس شرط كونه شاعراً ان يخيل لما كان فقط، بل ولما يكون، ولما مقدر
كونه، وان لم يكن بالحقيقة)(26). والحق ان هذه النظرة الخاطئة إلى
القصص اليوناني كانت عاملاً جوهرياً في الانصراف عنها، ذلك ان ما تحمله هذه النظرة
من ازدراء خفى لهذه "الخرافات" التي لا تليق إلا بالعجائز، جعل النقاد
يعرضون اعراضاً تاماً عن النظر في طبيعتها الفنية، وما يمكن ان تكشف عنه من الخلق
الانساني عندما تحاكى الفعل، أو الخلق الممكن على سبيل الضرورة او الاحتمال،
وعندما تصور الآلهة نفسها تصويراً انسانياً، وكأن النقاد العرب ظنوا ان هذا القصص
ضرب من الكذب، وعضد هذا الظن عندهم اقران هذا القصص بالخيار، واقتران الخيال
بالكذب، والغريب حقاً، انه على الرغم من ذهابهم إلى القول بعذوبة الكذب، ونسبه هذا
القول إلى اليونانيين، فقد نفروا من القصص اليوناني لهذا الامر بالذات(27)
وربما كان تعليل ذلك اعراضهم الفطري عن قصص يقتحم عالم الآلهة، وينتهك حرمته،
ويجعله عرضة للأهواء البشرية، وهو ما يصدم عقيدة التوحيد التي كانت قد استقرت في
النفوس، والحق انهم لم يكونوا بدعاً في ذلك، فأفلاطون نفسه انما نعى على شعراء
عصره ما اولعوا به من قصص يشوه صفات الآلهة، وانكر تلك "الخرافات" و
"الترهات" التي تنسب الشر إلى الآلهة، ففي "الجمهورية" يقول
افلاطون على لسان سقراط: (فأول واجب علينا هو السيطرة على ملفقي الخرافات، واختيار
اجملها، ونبذ ما سواه) وعندما يسأله "اديمنتوس" اي الخرافات يعني وما
الذي يجده فيها من الخطأ، يخبره انها روايات هوميروس، وهسيودس وان خطأها (هو تمثيل
المؤلف صفات الآلهة والابطال تمثيلاً مشوهاً فهو كالمصور الذي لا يشبه رسمه ما
صوره من الاشياء ... وكذلك القول: ان الالهة تشهر حرباً بعضها على بعض، وتكيد ،
وتتقاتل، فلا يناسب ان تقال مثل هذه الترهات في حال من الاحوال لأنها غير صحيحة .
. . وكل حروب الالهة التي رواها هوميروس يجب حظرها في دولتنا سواء صيغت في قالب
الحقيقة، أو في قالب المجاز . .. فيجب ان نبدي انكارنا تعدي هوميروس او غيره من
الشعراء: على حقوق الله بقوله . . . اما الادعاء ان الاله الصالح علة شر كائن من
الناس، فهو قول يجب ان نحاربه بما اوتينا من قوة، لأن المبدأ الذي تتضمنه اسطورة
كهذه شعراً، او نثراً، لا يقال ولا يسمع في المدينة، ولا يبيحه من يروم خير
الدولة، وارتقاءها شيخاً أو فتى، لأنها أقوال تنافي طهارة الحياة، وهي ضارة ومتناقضة)(28)
ولا ريب ان الدافع الاخلاقي التربوي يكمن وراء حملة افلاطون على القصص اليوناني،
لما يصوره من نماذج مشوهة في نفوس النشئ، وافلاطون انما ينشد الحقيقة اولاً، واذا
كنا نفهم سبب نفوره من الخرافات ــ حقيقة كانت او مجازاًــ باسم الخلق، او باسم الحقيقة،
فاننا لا نفهم سبب نفور النقاد العرب من هذه الخرافات، ما داموا يعتقدون ان اعذب
الشعر اكذبه، وما داموا لم يتحرجوا من القول: ان الشعر بمعزل عن الدين حتى ان
حازماً نفسه قال: ان الكذب، كما لا يعاب من جهة الصناعة لا يعاب من جهة الدين:
(فلم يبق إلا ان يعاب من جهة الدين، وقد رفع الحرج عن مثل هذا الكذب ايضاً في
الدين، فإن الرسول ــ صلى الله عليه[وآله] وسلم ــ كان ينشد النسيب امام المدح،
فيصغي إليه ويثيب عليه)(29) والحق ان هذا النفور كان سبباً في الغفلة
عن نماذج قصصية عربية، كان من شأنها ان تسهم في ادخال نمط شعري جديد، غير النمط
الغنائي السائد، ولقد رأينا حازماً يحدثنا عن الاختلاف الإمكاني الذي لا يقتضي
الكلام فيما وقع فحسب، ثم ينكر وقوعه للعرب، وكما قال الدكتور شكري عياد فإنه (لو
وسع حدود بحثه اكثر مما فعل، فنظر إلى النثر كما نظر إلى الشعر، وادخل في دائرة
ملاحظته مثل "رسالة الغفران" او "التوابع والزوابع" او
المقامات، لوجد في القصص الفني افسح مجال للاختلاف الإمكاني، والامتناعي ايضاً،
ولعله كان قمينا حينئذ ان يضع لهذا الفن من الادب اصولاً وقوانين تزيد بحثه غزارة
وعمقاً)(30)
على انه يلاحظ ان
سر اغفال حازم للإفادة من القصص الفني في مسألة الاختلاف الإمكاني ليس ضيق حدود
بحثه، او اقتصاره على النظر في الشعر دون النثر فحسب، وانما هو اعتقاده الراسخ ان
المحاكاة ضرب من التشبيه، والتشبيه ينصب اصلاً عل ما هو واقع فعلاً، بحيث يصعب معه
تصور ما هو ممكن، وهذا يرجع بنا ــ مرة اخرى ــ إلى قول ابن سينا ان الشعر العربي
يحاكي الشيء غالباً، بينما يحاكى الشعر اليوناني: "الفعل" لومي يكن من
السهل على أي ناقد ان يخرج على المألوف في الشعر العربي، حتى ان حازماً كان قد
ادرك تماماً ان الشعر اليوناني هو تمثيل ما لم يقع على ما وقع، وان ثمة نماذج
تشبهه عند العرب، من مثل كليلة ودمنة ، وحديث الحية عند النابغة ، وانهم عرفوا
الملحمة وهي طريقة (يذكرون فيها انتقال امور الزمان، وتصاريفه وتنقل الدول وما
تجري عليه احوال الناس، وتؤول إليه)(31) بيد لنه مع ذلك قال : ان اليونانيين
لم يكادوا يعرفون شيئاً من التشبيه ولم يتصرفوا في المعاني والمباني تصرف العرب
فيها، فقال: ان ارسطو لو ادرك ما قاله العرب لزاد في قانونه الشعري، وكأنه كان يرى
ان ارسطو، إذ لم يفض في الكلام على
التشبيه، فقد فاته شيء كثير ، لأن الاغراض اليونانية محدودة: (فأما غير هذه الطرق،
فلم يكن لهم فيها كبير نصرف، كتشبيه الاشياء بالأشياء فإن شعر اليونانيين ليس فيه
شيء منه، وانما وقع في كلامهم التشبيه في الافعال لا في ذوات الافعال، ولو وجد هذا
الحكيم ارسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم، والامثال،
والاستدلالات ، واختلاف ضروب الابداع في فنون الكلام لفظاً ومعنى، وتبحرهم في
اصناف المعاني، وحسن تصرفهم في وضعها ووضع الالفاظ بإزائها، وفي احكام مبانيها
واقتراناتها، ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم، واستطراداتهم ، وحسن مآخذهم ومنازعهم
وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شاؤوا ، لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية)(32).
وكلام حازم هنا
ينم على تقدير كبير لطريقة الشعر العربي، بحيث يبدو وكأنه يزدري الشعر اليوناني
الذي لا يعدو في نظرة اسماراً باطلة، اما المزايا التي اتمنى لو كان ارسطو قد أدركها،
فهي مزايا لفظية غالباً، ولكن الذي يلفت النظر فيها ثناؤه على تلاعبهم بالأقاويل
المخيلة كيف شاؤوا فلا ريب انه يريد بذلك التخييل الكاذب القائم على التلاعب بعلل
الاشياء حين يضع علة خيالية لأمر حقيقي(33) وهذا يرجع بنا إلى معضلة
العلاقة بين الخيال وكل من الصدق والكذب، ويذكرنا بأن حازماً لم يقرن الخيال
بالصدق قط وانما قرنه بالكذب، فضيع فرصة الافادة مما ادركه من طبيعة القصص
اليوناني الذي عده مجرد "خرافات" ولو انه ظل وفياً لمبدئه القائل: انه
لا ينظر في الشعر إلى صدق او كاذب بقدر ما ينظر إلى التخييل، لتخلص من الحكم على
ان القصص اليوناني بأنه خرافات، ما دام هذا القصص يعبر عن نوازع الانسان، ولكان
استطاع عقد مقارنة بين بذور القصص يعبر عن نوازع الانسان، ولكان استطاع عقد مقارنة
بين بذور القصص العربي الذي ذكره من مثل كليلة ودمنة أو حديث الحية، وبين القصص
اليوناني، وذلك على نحو يغني مبادئ هذا الفن الشعري الجميل ، ولكنه فيما يلوح كان
حائراً بين شعوره بأن الممكن افضل من الممتنع، وبين اعتقاده بأن الممتنع مقبول في
الشعر، وهذه الحيرة قد دفعته إلى التخبط بين انكار الاختلاق الامتناعي عند العرب،
ومن ثم انكار قصص الاغريق التي جعلها مثلاً لهذا الاختلاف من جهة، وبين اقرار
الممتنع اذا لم يبلغ حد الاحالة من جهة اخرى، فقذ ذهب في معرض كلامه على المبالغة
إلى ان العلماء متفقون على قبح الاحالة (34)، وقال ان ثمة فرقاً بين
الممكن والمحال، فالممكن مقبول لأنه يمكن ان تتصور له حقيقة، وان كانت غير واقعة،
وليس كذلك المحال لأنه لا يتصور في الذهن اصلاً، ولا يمكن ان يكون واقعاً:
(الافراط هو ان يغلو في الصفة، فيخرج بها عن حد الامكان إلى الامتناع أو
الاستحالة، وقد فرق بين الممتنع والمستحيل بأن الممتنع هو ما لا يقع في الوجود وان
كان متصوراً في الذهن، كتركيب يد اسد على رجل مثلاً، والمستحيل هو ما لا يصح وقوعه
في وجود ولا تصوره في ذهن، ككون الانسان قائماً قاعداً في حال واحدة)(35)
واذا كان حازم قد جعل هنا الامتناع والاستحالة عيباً، فقال: ( الكذب الإفراطي معيب
في صنعة الشعر، اذا خرج من حد الامكان إلى حد الامتناع، او الاستحالة)(36)
فإنه يلبث ان قبل الامتناع ، بعد ان قدم عليه الامكان (ان صناعة الشعر لها ان
تستعمل الكذب، إلا انها لا تتعدى الممكن من ذلك او الممتنع إلى المستحيل وان كان
الممتنع فيها ايضاً دون الممكن في حسن الموقع من النفوس)(37) ويبدو ان
الذي دفعه إلى قبول الممتنع هو دفاعه عن المتنبي في مبالغاته التي اخشي ان يظن
انها من قبيل الممتنع غير الممكن، فلم ير بأساً في الموافقة على الممتنع غير
المستحيل قال المتنبي يمدح سيف الدولة، وقد دخل رسول الروم حلب:
وأنى اهتدى هذا
الرسول بأرضه وما سكنت مذ سرت
فيها القساطل
ومن اي ماء كان
يسقي جيــــاده ولم تصف من مزج
الدماء المناهل
(فهذا مستساغ
مقبول من حيث يمكن ان تتصور له حقيقة، وان لم تكن واقعة اذ كانت كثرة الجيوش لا حد
لها، ومتى قدرت الزيادة في مقدار منها وان كثر امكنت فجائز ان يغزو ارض قوم من
الجيوش ما يصير حزنها سهلاً، وخيارها وعثا، حتى يصير صخرها رهجاً، وترابها اهباً،
فيثور نقعها بأقل حركة او نفس، فلا تسكن القساطل فيها مدة، فأراد المبالغة في جيش
ممدوحه فجعله بالغاً إلى هذا المقدار، وكذلك سفك الدماء، ليس له حد ينتهي إليه
ومتى قدرت الزيادة في مقدار منه، امكنت فجائز في حق ممدوحه ان يريق من دماء
اعدائه ما تكدر
منه المياه مدة، فاراد المبالغة فيما اراق هذا الممدوح من دماء الروم، فجعله
بالغاً إلى ذلك المقدار، ولا يلزم ابا الطيب ان يكون صادقاً في ذلك، لأن صناعة
الشعر لها ان تستعمل الكذب إلا انها لا تتعدى الممكن من ذلك، او الممتنع إلى
المستحيل )(38) واذا اغفلنا ما يلوح من تناقض بين ذم القصص اليوناني
لأنه من قبيل الكذب الممتنع ومدح ابيات المتنبي لأنها من قبيل الكذب الممتنع
ايضاً، فإنه يحق لنا ان نتساءل عن سر
اعراض حازم عن ذلك القصص، على الرغم من قوله ان الممتنع مقبول ما دام منصوراً في
الذهن وان كان غير واقع، فالحق ان هذا هو تعريف القصص اليوناني الذي درج النقاد
على ذمه، واقتفى فيه حازم اثر ابن سينا(39)، واذن فثمة تناقض قائم بين
ذم القصص، وقبول الكذب، وهذا التناقض انما نشأ من استخدام معيار الممتنع مرتين:
الاولى لإنكار القصص، والاخرى لإثبات الغلو في الشعر، ولو ان هذا المعيار قد
استخدم في القصص مثلما استخدم في الشعر لأفضى إلى تطور فن جديد يضاف إلى فن الشعر الغنائي.
ولا ننس ايضاً ان
حازماً انما نظر إلى الممكن من خلال الكذب، ولم يخطر بباله انه إذا كان الممكن
يخضع لتخييل المشاعر، والافكار سواء اكانت صادقة ام كاذبة، فإنه لا يخضع لصدق أو
كذب، لأن مدار الامر على جودة التخييل، أو رداءته وهو امر قاله حازم نفسه من قبل،
ويبدو ان مشكلة الصدق والكذب بما تفرضه من ثنائية صارمة، لم تكن تدع للنقاد مجالاً
للتفكير بمعزل عنها، حتى إذا ما تنبه ناقد إلى ما تثيره من حرج، عاد فخضع لها دون
ان يشعر، ولو ان حازماً قسم الشعر بحسب اصناف التخييل ــ ولا سيما انه جعله جوهر
الشعر ــ لا بحسب الصدق والكذب، لاستطاع حقاً ان يخلص النقد من قيود هذه المشكلة،
فيلفت النظر إلى اهمية الممكن، او الممتنع، او الصادق، او المستحيل من خلال القدرة
على المحاكاة، لا من خلال الكذب، سواء اكان مقبولاً، ام منكراً، وآنذاك فليس من
الضروري ان نبحث في قول المتنبي عن صدق أو كذب، ما دام قد اجاد تخييل قوة الجيش
كما يمكن ان يتصورها الخيال فضلاً عن العقل، وهذا هو في الاصل معيار حازم حين قال
في الشعر إن:
(التخييل هو
المعتبر في صناعته لا كون الاقاويل صادقة او كاذبة) (40).
__________________
(1) منهاج: ص63.
(2) المصدر نفسه:
ص70-71.
(3) كذا ولعل
الصحيح: قبل اعمالها الروية فيما هو عليه.
(4) منهاج
البلغاء: ص70-71.
(5) المصدر نفسه:
ص72.
(6) المصدر نفسه:
ص72.
(7) المصدر نفسه،
ص75.
(8) فن الشعر:
ص151.
(9) انظر منهاج
البلغاء ص81-83.
(10) المصدر نفسه:
ص82.
(11) المصدر نفسه:
ص83.
(12) نقد الشعر:
ص17.
(13) المصدر نفسه:
ص56.
(14) العمدة: 1/22
(15) منهاج
البلغاء: ص87.
(16) المصدر نفسه:
ص75.
(17) انظر: اسرار
البلاغة ص239.
(18) منهاج
البلاغة ص79.
(19) المصدر نفسه:
ص79.
(20) منهاج
البلغاء: ص79.
(21) المصدر نفسه:
ص[؟]
(22) المصدر نفسه:
ص76.
(23) المصدر نفسه:
ص77.
(24) انظر: المصدر
نفسه: ص77.
(25) المصدر نفسه:
ص77-78.
(26) فن الشعر:
ص184
(27) انظر مثلاً:
المثل السائر ص170
(28) جمهورية
افلاطون: ص52-56.
(29) منهاج
البلغاء: ص78-79
(30) كتاب الشعر:
ص270.
(31) منهاج
البلغاء: ص68.
(32) المصدر نفسه:
ص69.
(33) انظر كلام
عبد القاهر في مذاهب التخييل: اسرار البلاغة ص231 وما بعدها.
(34) انظر: منهاج
البلغاء: ص133-134
(35) المصدر نفسه:
ص76.
(36) المصدر نفسه:
ص79.
(37) المصدر نفسه:
ص136.
(38) المصدر نفسه:
ص135-136.
(39) انظر: منهاج
ص78 وفن الشعر ص184.
(40) منهاج: ص71
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|