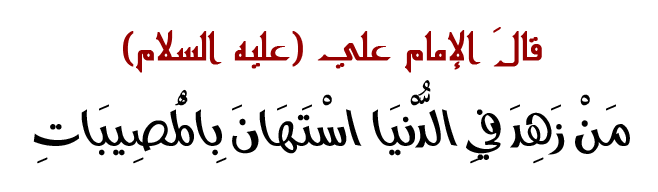
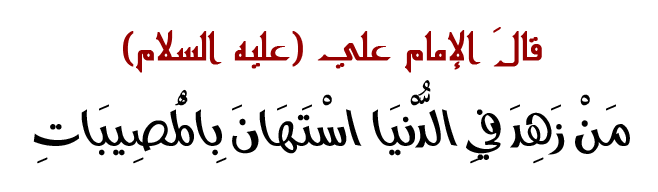

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2017
التاريخ: 24-5-2017
التاريخ: 2024-09-02
التاريخ: 10-5-2016
|
تتباين قوانين المرافعات والإجراءات المدنية فيما بينها في نصها على الشروط الواجبة لقبول الدعوى، فبعضها من يشترط المصلحة (بأوصافها شخصية ومباشرة وقائمة وقانونية لوحدها كأساس لقبول الدعوى وكما نص على ذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1968) في المادة (3) منه، وكذلك قانون أصول المحاكمات الأردني رقم (24) لسنة (1988) في المادة (3) منه أيضأ، وكذلك قانون المرافعات المدنية الكويتي رقم (38) لسنة (1980) في المادة (2) منه، في حين تشترط قوانين أخرى الصفة والمصلحة، كما في قانون الإجراءات المدنية الجزائري رقم (156) لسنة (1966) وتحديدا في نص المادة (13) منه. وأما قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1999) المعدل فإنه يشترط توافر الأهلية اللازمة الاستعمال الحقوق المتعلقة بها الدعوى وكذلك الصفة والمصلحة بأوصافها المطلوبة، وذلك في نصوص المواد (6-3 ) منه. إلا أن هذه القوانين متفقة على الشروط التي يستلزم توافرها لمباشرة إجراءات الخصومة، والمتمثلة في كل من أهلية التقاضي والصفة المباشرة للعمل القضائي.
المقصد الأول: أهلية التقاضي
تنص غالبية القوانين المدنية (1). على أن بلوغ الشخص الطبيعي سن الرشد متمتعة بقواه العقلية وغير محجور عليه فإنه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتي منها حقه في رفع دعوى بنفسه للمطالبة بالحماية القضائية للمطالبة بحقوقه؛ لذا ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه يشترط لقبول الدعوى توافر الأهلية (2) ، إلا أن الرأي الراجح الذي استقر عليه غالبية الفقه الحديث أنه لا شأن للأهلية بشروط الدعوى (3)، فالأهلية إنما تتعلق بالصلاحية للقيام بالأعمال الإجرائية المكونة للخصومة والصادرة من الخصوم (4).
وما يدل على صحة هذا الاتجاه أنه إذا فقد أحد الخصوم أهليته، فإن هذا لا يؤثر في الدعوى وإنما يؤثر في الإجراءات فقط، حيث تتقطع الخصومة بحكم القانون أو بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه(5). ولما تقدم نتناول أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص المعنوي كالآتي:
أولا- أهلية الشخص الطبيعي: لكي يكون الشخص طرفا في الخصومة ينبغي أن تتحقق فيه (أهلية الاختصام) وهي الصلاحية لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يضمن من حقوق وواجبات، وتوجد هذه الأهلية لدى كل من تتحقق فيه أهلية الوجوب، وقانونا لكل شخص سواء كان طبيعية أم معنويا ذا شخصية قانونية ويستوي أن يكون الشخص وطنية أم أجنبيا (6).
بيد أن أهلية الاختصام (أهلية الادعاء) ليست كافية للقيام بالأعمال الإجرائية في الخصومة، وإنما يجب أن تتوافر الأهلية الإجرائية (أهلية التقاضي) التي هي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي، وهي صلاحية الخصم للقيام بعمل إجرائي سواء باسمه أم في مصلحة الآخرين، بمعنى صلاحية الخصم في مباشرة الإجراءات أمام القضاء وعلى نحو صحيح، وبالتالي لا يؤدي تخلف أهلية التقاضي لدى الخصم إلى انعدام الخصومة، وإنما يؤثر في مباشرة إجراءاتها على نحو صحيح(7). وإذ أن جميع الأشخاص الذين لديهم أهلية الوجوب ليست بالضرورة لديهم أهلية الأداء فإن الأشخاص الذين لديهم أهلية الاختصام ليست بالضرورة لديهم أهلية التقاضي (8). والأهلية المطلوبة هنا هي مماثلة لأهلية التعاقد، فقد نصت المادة (93) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل(9) على أن: ((كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون علم أهليته أو يحد منها)). لذا فالصغار والمجانين والمعتوهون محجور عليهم لذاتهم، وهو ما نصت عليه المادة (94) من القانون ذاته، فأهلية الشخص الطبيعي المطلوبة في مباشرة إجراءات التقاضي هي بلوغ سن الرشد مع تمام العقل، فمن لم تتوافر فيه الأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق المتعلقة بها الدعوى، أوجب القانون أن ينوب عنه غيره في الدعوى.
ثانيا - أهلية الشخص المعنوي: أما الشخص المعنوي فإنه يتمتع بأهلية وجوب وأهلية أداء، و(أهلية الوجوب) هي الشخصية القانونية التي يتمتع بها غير أن نطاق هذه الأهلية يختلف تبعا لطبيعته(10)، والغرض الذي أنشأ من أجله (11). و (أهلية الأداء) للشخص المعنوي هي أهلية كاملة، إذ يستطيع أن يستعمل الحقوق التي يتمتع بها، إلا أن طبيعة الشخص المعنوي تتطلب أن يقوم عنه أشخاص طبيعيون بمباشرة نشاطه القانوني ويعملون لحسابه، وهو ما قررته المادة 1/48) )من القانون المدني العراقي، إذ نصت على أن: ((يكون لكل شخص معنوي ممثل عن إرادته)). وقد قضت محكمة التمييز في إحدى قراراتها أن: ((حق الخصومة عن الشركة منحصر بمديرها المفوض وليس لأحد الشركاء القيام بذلك مع وجود المدير المفوض)) (12).
المقصد الثاني:
الصفة لمباشرة العمل القضائي
اختلف الفقهاء في اعتبار (شرط الصفة) و (شرط المصلحة) كشروط لقبول الدعوى، فمنهم من يرى أن المصلحة هي الشروط الوحيد لقبول الدعوى(13)، بينما يرى آخرون (14) أن شرط الصفة وشرط المصلحة يختلطان في عدد من الصور ويتمایزان في غيرها، في حين يرى البعض (15). منهم أن شرط الصفة لازم مستقل بذاته عن شرط المصلحة، حيث لا يعني وجود المصلحة عن شرط الصفة.
إلا أنه من المسلم به فقها وقضاء أن يكون لمن يباشر إجراءات الخصومة صفة في مباشرتها. والصفة إما عادية (أصلية) أو استثنائية أو إجرائية إضافة إلى صفة الدفاع عن مصلحة عامة أو جماعية (16) وسنتناولها على النحو الآتي: أولا: مباشرة الشخص للعمل القضائي بنفسية (الصفة العادية)
من البديهي أنه لا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزا قانونية لنفسه، ولا يكفي أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك؛ لذا لا تقبل دعوى بطلان عقد من شخص ليس طرفا فيه، ولو كان لهذا الشخص مصلحة في بطلانه(17)، فعلى الرغم من وجود مصلحة له في ذلك لكنه لا يتمتع بصفة قانونية في هذه الدعوى، فالصفة القانونية تعني أن يكون للمدعي شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة عن موضوعها وابداء الدفاع فيها. وقد قضت محكمة النقض المصرية (18). بأنه: ((والأصل أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المدعي، والمدعى عليه هو الطرف السلبي في هذا الحق والمسؤول عن تجهيله)).
وكذلك قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية: ((... وجد أنه صحيح..، وذلك لأن خصومة المدعين لم تكن صحيحة عند إقامة هذه الدعوى لعدم علاقتهم بالمنشآت المشيدة على أرض المأجور موضوع الدعوى ولا يصحح هذه الخصومة تنازل المساطح عن تلك المنشآت إليهم أثناء المرافعة وهو المدعى عليه الثالث فتكون الدعوى قد أقيمت من شخص لا صفة له فيها ابتداء (المادة (6) مرافعات مدنية)) (19).
لذا يرى البعض من الفقه (20) أن الخصم القانوني الكامل هو الذي يكون طرفا في خصومة) يباشرها بنفسه لا عن طريق ممثله الإجرائي ويكون في الوقت ذاته (طرفا في الدعوى)، وفي الحق وموضوعه)، أما (الخصم الناقص) فلا تتوافر فيه كل العناصر السابقة؛ لذا فإنه لا يتمتع إلا ببعض الحقوق والواجبات المكونة لمراكز الخصم .
ثانيا: الصفة غير العادية (الاستثنائية)
يجيز القانون بشكل صريح في بعض الحالات حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى، وتسمى صفته في هذه الحالة الصفة غير العادية (الاستثنائية) (21)، ولا تقبل هذه الصفة إلا بناء على نص تشريعي يعترف بها للشخص بسبب مركز قانوني مرتبط نفاده بالمركز القانوني المدعي، ومثالها الدعوى غير المباشرة التي يجيز القانون للدائن متى توافرت شروط معينة أن يستعمل حقوق ملينه بما في ذلك رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه (22).
وكذلك ما تنص عليه قوانين العمل (23) ، ومنها نص المادة (155) من قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة (1987) والتي أضيفت بالتعديل الثاني للقانون المرقم (17) في 2000/3/13 التي تقضي بأنه: ((تمثل الأجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع أو المشاريع أو المهنة أو المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الأجهزة أن تخاصم نيابة عن العمال جماعات وفرادي - في جميع ما ينشأ عن عقد العمل الجماعي من حقوق أو خلافات دون حاجة إلى توكيل خاص)). ومن هذا النص يتبين أن النقابة التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك الحق في رفع الدعوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد باسم عضو منتمي إليها عند الإخلال بأحكام هذا العقد دون توكيل منه.
لكن يراعي في الصفة الاستثنائية (الحلول الإجرائي) أن المدعي لا يطالب بناء عليها بحق لنفسه، وإنما بحق الغيرة، وأن مباشرة صاحب هذه الصفة لإجراءات الخصومة باسمه لا تنزع عن صاحب الحق أو المركز القانوني صفته في الدعوى (24).
ثالثا: نيابة فاقد الأهلية ( التمثيل القانوني) :
وهي صلاحية الشخص المباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة إجراءاتها، وهنا يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله، مثل تمثيل الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة للقاصر والمتولي المال الوقف وتمثيل رئيس مجلس إدارة الشركة للشركة (25) وتمثيل الحارس العام لمن وضع تحت الحراسة.
23- نصت المادة (165) من قانون العمل المصري رقم (12) لعنة (2003) على أن: ( للمنظمة النقابية والمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضاءها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك لون حاجة إلى توكيل منه بذلك، ويجوز للعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها)).
والممثل القانوني هنا لا تكون له صفة (أصلية أو استثنائية في الدعوى، وانما تكون له فقط صفة في مباشرة إجراءاتها ممثلا لصاحب الصفة في الدعوى، فلا يعد طرفا في الدعوى وإنما طرفا في الخصومة (26) .
واذا تقاضي شخص كممثل إجرائي عن الخصم الأصلي - بحيث يوزع مركز الخصم بين الأصيل وممثله - يسمى الخصم في هذه الحالة الخصم المركب) كما في حالة الولي أو الوصي للقاصر، إذ يباشر الممثل الإجرائي الإجراءات بإرادته وتتخذ في مواجهته، وهو الذي يمنح المحامي توكيل الخصومة، وبذلك يتميز عن المحامي الذي لا يعد خصمة، وإنما يعمل بإرادة الموكل لتقديم معاونة فنية في الإجراءات بوصفه من أعوان القضاء (27).
فالصفة الإجرائية هي محض تمثيل قانوني، أي سلطة اتخاذ إجراءات الخصومة لعدم إمكان صاحب الحق المدعى به من مباشرة هذه الإجراءات الاستحالة مالية أو قانونية. وتبدو أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية في ما يأتي:
1- اختلاف وسيلة التمسك بتخلف الصفة، فعدم توافر الصفة في الدعوى يتمسك به عن طريق الدفع بعلم القبول، بينما تختلف الصفة الإجرائية في أنها تدفع ببطلان الإجراءات (28).
2- يؤدي زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأحد أطرافها أثناء سير الخصومة إلى أن تصبح الدعوى غير مقبولة (وذلك لأنه لم يعد له مصلحة شخصية في مباشرة الدعوى) فشروط الدعوى يجب أن تتوافر عند الحكم في موضوعها (29)، أما زوال الصفة في التقاضي أثناء السير في الخصومة فإنه يؤدي إلى انقطاعها وفقا لنص المادة (84) من قانون المرافعات المدية العراقي، شريطة أن لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها.
رابعا: الصفة للدفاع عن مصلحة عامة أو جماعية
الصفة هنا تثبت للهيئة التي كلفها القانون بالدفاع عن هذه المصلحة الجماعية أو العامة وهي تسند إلى شخصية جماعية أو عامة. والمصلحة الجماعية هي المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معينة (كمهنة الطب أو المحاماة) أو يستهدفون غرضا معينة كالدفاع عن حقوق المرأة وهي ليست تعبيرا عن مجموع المصالح الفردية لهؤلاء الأفراد وانما هي مصلحة مشتركة متميزة ومستقلة عن هذه المصالح(30).
والمصلحة العامة، فهي مصلحة المجتمع بصفة عامة وتتميز عن المصالح الخاصة لأفراده، ومن أمثلتها دعاوى النقابات للمطالبة بحقوقها الخاصة ودعاوى الجمعيات دفاعا عن المصلحة المشتركة لأعضائها أو عن الغرض الذي أنشأت من أجله مثل (جمعية السائقين أو جمعية حماية الصيد) طالما اعترف لها بالشخصية المعنوية (31).
وهناك أيضأ دعاوى الادعاء العام، وليس المقصود منها الدعاوى الجزائية فهو صاحب السلطة في رفعها، بل القصد في الدعاوى المدنية، فله التدخل في الدعوى كطرف منظم، كما أن له حيث يوجد نص - رفع الدعوى | المدنية دفاعا عن المصلحة العامة للمجتمع أي حماية النظام العام وكذلك الطعن لمصلحة القانون (32).
____________
1- المادة ( 1/46) من القانون المدني العراقي، والمادة ( 1/44) من القانون المدني المصري، والمادة 1/43 من القانون المدني الأردني
2- د. عبد الباسط جميعي، شرح قانون الإجراءات المدنية، القاهرة، 1966، ص 277.
3- د. رمزي سيف، قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للقانون الكويتي، الكويت، 1974، ص 137، بند 101.
4- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، 1977، ص 167؛ وكذلك منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، مطبعة العانی، بغداد، 1957، ص 18.
5- نصت المادة (84) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أنه: ((ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يبائر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها)، ونصت المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1998) على أنه: ((1 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر صفة الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها)، وكذلك نصت المادة (85) من قانون المرافعات المدنية الأردني رقم (24) لسنة (1988) على أنه: (3- إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى او طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانون، أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم أو صفاتهم في آخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون. 4- إذا وقعت الوفاة والدعوي جاهزة للحكم تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.)).
6- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني، ج 1، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، ص 600.
7- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي، 1978، ص 124.
8- د. فتحي والي، قانون الفضاء المدني، المرجع السابق، ص 601.
9- يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948) المادة (109)، ومن القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1979) المادة (116) منه.
10- نصت المادة (48/2) من القانون المدني العراقي رقم (41) السنة (1951) على أنه: ((ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها متلازمة لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي رسمها القانون)). وكذلك نصت المادة (53/1)من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948) على أن: ((الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متلازمة الصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي رسمها القانون)). في حين نصت المادة (51/1) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) على أن: ((الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازم لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون)).
11- نصت المادة (448) من القانون المدني العراقي رقم (11) لسنة (1951) على أنه: ((وعند أهلية الأداء وذلك في الحدود التي يبينها عند إنشائه والتي يفرضها القانون)). وكذلك نصت المادة (53/2/ب) من القانون المدني المصري المذكور على أن: ((... فيكون له أهلية في الحدود التي يعينها عند إنشاؤه أو التي يقررها القانون)). وكذلك نص المادة (51/2/ب) من القانون المدني الأردني .
12- ينظر القرار رقم (450 /مدنية أولى/ 1978) المنشور بتاريخ 1979/2/11 في مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة العاشرة، 1979، ص95.
13- د. عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، أطروحة دكتوراه، القاهرة، 1997، ص 48؛ وكذلك د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، بند 79، ص 114؛ وكذلك د. رزق الله أنطاكي، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، مطبعة الجامعة السورية، 1957، ص 134.
14-د. عبد البسط جميعي، شرح قانون الإجراءات المدنية (المرافعات)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966، ص270-271
15- د. أحمد مسلم، أصول المحاكمات والتنظيم القضائي، المرجع السابق، ص 329؛ وكذلك د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 88؛ وكذلك د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 56 .
16- أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص 162.
17- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، المرجع السابق، ص 124.
18- نقض مدني 1966/12/29 ، مجموعة الأحكام 17، ص 2016، نقلا عن وجدي راغب، المرجع السابق، نفس الصفحة.
19- رقم القرار: 3600/ إيجار عقار 1996، بتاریخ 1994/11/10 ، غير منشور، أشار إليه القاضي عباس زياد السعدي، المرجع السابق، ص (104-105).
20- د. 1980، ، ص 198. (
21- د. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 182.
22- نصت المادة (261) من القانون المدني العراقي رقم (40) لعنة (1951) على أنه ((يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بأسم مدينه حقوق هذا المدين إلا ما اتصل منها بشخصه خاصة أو ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق ملينه إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن إهماله ذلك من شأنه أن يصيب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين ولكن يجب إدخاله في الدعوى)). وكذلك نصت المادة (230) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948) على أنه: ((1 - لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بأسم ملينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. 2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق ملينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وإن علم استعمالها له من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكنت يجب إدخاله خصما في الدعوى)).
24- د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 163 .
25- نصت المادة (4) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أنه: ((يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وأن يكون محكومة أو ملزمة بشيء على تقدير ثبوت الدعوى، ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة المال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي المال الوقف، وخصومة من اعتبره القانون حصرا حتى في الأموال التي لا ينفذ فيها إقراره)).
26- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 116.
27- Giovanni Pavanini Note sulla figura ginridica del difensore Riv. Trim du. Eproc. Civ. 1957,2256-258.
28- د. إبراهيم نجيب سعد، المرجع السابق، ص 197.
29- د. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 164.
30- د. فتحي والي، المرجع السابق، ص 621.
31- د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 165.
32- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص 130-131. بالإشارة إلى نجيب بكير، نور النيابة العامة في قانون المرافعات، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة عين شمس، 1974.



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|