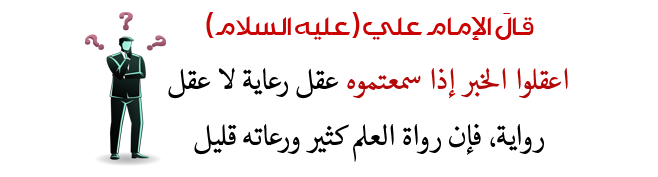
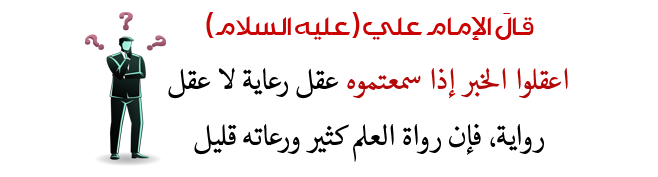

 النبي الأعظم محمد بن عبد الله
النبي الأعظم محمد بن عبد الله
 أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)
أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)
 الإمام علي بن أبي طالب
الإمام علي بن أبي طالب 
 حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله
حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله
 السيدة فاطمة الزهراء
السيدة فاطمة الزهراء
 الإمام الحسن بن علي المجتبى
الإمام الحسن بن علي المجتبى
 الإمام الحسين بن علي الشهيد
الإمام الحسين بن علي الشهيد
 الإمام علي بن الحسين السجّاد
الإمام علي بن الحسين السجّاد
 الإمام محمد بن علي الباقر
الإمام محمد بن علي الباقر
 الإمام جعفر بن محمد الصادق
الإمام جعفر بن محمد الصادق
 الإمام موسى بن جعفر الكاظم
الإمام موسى بن جعفر الكاظم
 الإمام علي بن موسى الرّضا
الإمام علي بن موسى الرّضا
 الإمام محمد بن علي الجواد
الإمام محمد بن علي الجواد
 الإمام علي بن محمد الهادي
الإمام علي بن محمد الهادي
 الإمام الحسن بن علي العسكري
الإمام الحسن بن علي العسكري
 الإمام محمد بن الحسن المهدي
الإمام محمد بن الحسن المهدي
 الغيبة الصغرى
الغيبة الصغرى
 الغيبة الكبرى
الغيبة الكبرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
التاريخ: 7-4-2016
التاريخ: 7-4-2016
التاريخ: 7-4-2016
|
تحليلان لأسباب الصلح :
التحليل الأوّل :
لقد حاول معاوية أن يظهر نفسه بأنّه رجل مسالم يدعو إلى السلام والصلح ، وذلك عبر رسائله إلى الإمام الحسن ( عليه السّلام ) التي يدعوه فيها إلى الصلح مهما كانت شروط الإمام ( عليه السّلام ) ، وقد اعتبر الباحثون أنّ الخطاب السلمي لمعاوية كان أخطر حيلة فتّت عضد الإمام ( عليه السّلام ) ، الأمر الذي أزّم ظروفه ( عليه السّلام ) ولم يكن للإمام خيار غير القبول بالصلح .
وفي هذا الصدد يقول الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء :
« . . . فوجد - أي الإمام الحسن ( عليه السّلام ) - أنّه لو رفض الصلح وأصرّ على الحرب فلا يخلو :
إمّا أن يكون هو الغالب ومعاوية المغلوب ، وهذا وإن كانت تلك الأوضاع والظروف تجعله شبه المستحيل ، ولكن فليكن بالفرض هو الواقع ، ولكن هل مغبة ذلك إلّا تظلّم الناس لبني أمية ؟ وظهورهم بأوجع مظاهر المظلومية ؟ فماذا يكون موقف الحسن إذا لو افترضناه هو الغالب ؟
أمّا لو كان هو المغلوب فأول كلمة تقال من كلّ متكلم : إنّ الحسن هو الذي ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فإنّ معاوية طلب منه الصلح الذي فيه حقن الدماء فأبى وبغى ، وعلى الباغي تدور الدوائر ، وحينئذ يتمّ لمعاوية وأبي سفيان ما أرادا من الكيد للإسلام وإرجاع الناس إلى جاهليتهم الأولى وعبادة اللّات والعزى ، ولا يبقي معاوية من أهل البيت نافخ ضرمة ، بل كان نظر الإمام الحسن ( عليه السّلام ) في قبول الصلح أدقّ من هذا وذاك ، أراد أن يفتك به ويظهر خبيئة حاله ، وما ستره في قرارة نفسه قبل أن يكون غالبا أو مغلوبا ، وبدون أن يزجّ الناس في حرب ، ويحملهم على ما يكرهون من إراقة الدماء » .
إنّ معاوية المسلم ظاهرا العدّو للإسلام حقيقة وواقعا ، كان يخدع الناس بغشاء رقيق من الدين خوفا من رغبة الناس إلى الحسن وأبيه من قبل ، فأراد الحسن أن يخلّي له الميدان ، حتى يظهر ما يبطن ، وهكذا فعل .
وفور إبرام الصلح ؛ صعد المنبر في جمع غفير من المسلمين ، وقال :
« إنّي ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلّوا . . » ! ! .
انظر ما صنع الإمام الحسن بمعاوية في صلحه ، وكيف هدّ جميع مساعيه وهدم كلّ مبانيه حتى ظهر الحقّ وزهق الباطل ، وخسر هنالك المبطلون ، فكان الصلح في تلك الظروف هو الواجب المتعيّن على الحسن ، كما أنّ الثورة على « يزيد » في تلك الظروف كان هو الواجب المتعيّن على أخيه الإمام الحسين ، كلّ ذلك للتفاوت بين الزمانين ، والاختلاف بين الرجلين ( أي : معاوية وابنه ) .
ولولا صلح الإمام الحسن - الذي فضح معاوية وشهادة الإمام الحسين ( عليه السّلام ) التي قضت على يزيد وانقرضت بها الدولة السفيانية بأسرع وقت - لذهبت جهود جدّهما بطرفة عين ، ولصار الدين دين آل أبي سفيان ، دين الغدر والفسق والفجور ، دين إبادة الصالحين واستبقاء الفجرة الفاسقين .
ولو قيل : لما ذا لم ينتهج الإمام الحسن ( عليه السّلام ) سبيل الشهادة كما فعل الإمام الحسين ( عليه السّلام ) ، فإنّ الحسين ( عليه السّلام ) أيضا كان يعلم أنّه لن يستطيع تحقيق النصر العسكري على يزيد ؟
فالجواب :
1 - إنّ معاوية كان يظهر الإسلام ، ويزيد كان يتجاهر بالفسق والفجور ، فضلا عن دهاء الأب وبلادة الابن .
2 - مثّلت خيانة الكوفيين بالنسبة إلى الحسين ( عليه السّلام ) خطوته الموفّقة في التمهيد لنجاحه المطّرد في التاريخ ، ولكنّها كانت بالنسبة إلى أخيه الحسن ( عليه السّلام ) ( يوم مسكن والمدائن ) عقبته الكؤود عن تطبيق عملية الجهاد ، فإنّ حوادث نقض بيعة الحسين كانت قد سبقت تعبئته للحرب ، فجاء جيشه الصغير يوم وقف به للقتال ، منخولا من كلّ شائبة تضيره كجيش إمام له أهدافه المثلى[1].
التحليل الثاني :
إن معاوية كان قد نشط في عهد الخليفتين الثاني والثالث بإمارته على الشام عشرين سنة ، تمكّن بها في أجهزة الدولة ، وصانع الناس فيها وأطمعهم به فكانت الخاصة في الشام كلّها من أعوانه ، وعظم خطره في الإسلام ، وعرف في سائر الأقطار بكونه من قريش أسرة النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) وأنّه من أصحابه ، حتى كان في هذه أشهر من كثير من السابقين الأولين الذين رضي اللّه عنهم ورضوا عنه ، كأبي ذرّ وعمّار والمقداد وأضرابهم .
هكذا نشأت « الأموية » مرّة أخرى ، تغالب الهاشمية باسم الهاشمية في علنها ، وتكيد لها كيدها في سرّها ، فتندفع مع انطلاق الزمن تخدع العامة بدهائها ، وتشتري الخاصة بما تغدقه عليهم من أموال الامّة ، وبما تؤثرهم به من الوظائف التي ما جعلها اللّه للخونة من أمثالهم ، تستغل مظاهر الفتح وإحراز الرضا من الخلفاء ، حتى إذا استتبّ أمر « الأموية » بدهاء معاوية ؛ انسلّت إلى أحكام الدين انسلال الشياطين ، تدسّ فيها دسّها ، وتفسد إفسادها ، راجعة بالحياة إلى جاهلية تبعث الاستهتار والزندقة وفق نهج جاهلي وخطة نفعية ترجوها « الأموية » لاستيفاء منافعها ، وتسخّرها لحفظ امتيازاتها[2].
والناس عامة لا يفطنون لشيء من هذا ، فإنّ القاعدة المعمول بها في الإسلام - أعني قولهم : الإسلام يجبّ ما قبله - ألقت على فظائع « الأموية » سترا حجبها ، ولا سيما بعد أن عفا عنها رسول اللّه وتألّفها ، وبعد أن قرّبها الخلفاء منهم ، واصطفوها بالولايات على المسلمين ، وأعطوها من الصلاحيات ما لم يعطوا غيرها من ولاتهم ، فسارت في الشام سيرتها عشرين عاما لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا ينهون .
وقد كان الخليفة الثاني عظيم المراقبة لبعض عمّاله دقيق المحاسبة لهم دون بعض ، لا يأخذه في ذلك مانع من الموانع أصلا ، تعتع بخالد بن الوليد عامله على « قنسرين » إذ بلغه أنّه أعطى الأشعث عشرة آلاف ، فأمر به فعقله « بلال الحبشي » بعمامته ، وأوقفه بين يديه على رجل واحدة مكشوف الرأس على رؤوس الأشهاد من رجال الدولة ووجوه الشعب في المسجد الجامع بحمص ، يسأله عن العشرة آلاف أهي من ماله أم من مال الامّة ؟ فإن كانت من ماله فهو الإسراف واللّه لا يحبّ المسرفين ، وإن كانت من مال الامّة فهي الخيانة واللّه لا يحب الخائنين ، ثم عزله فلم يولّه بعد حتى مات .
وكم لعمر مع بعض عمّاله من أمثال ما فعله بخالد وأبي هريرة يعرفها المتتبّعون ! لكنّ معاوية كان أثيره وخلّصه ، على ما كان من التناقض في سيرتيهما ، ما كفّ يده عن شيء ولا ناقشه الحساب في شيء ، وربّما قال له :
« لا آمرك ولا أنهاك » ، يفوّض له العمل برأيه ، فشدّة مراقبة الخليفة الثاني ودقّة محاسبته كانت من نصيب بعض عمّاله ، ولم تشمل الجميع على حدّ سواء ، إذ أنّ معاوية - وهو عامله على الشام - كان طليق اليدين يفعل ما تشاء أهواؤه وما تبغيه شهواته .
وهذا ما أطغى معاوية ، وأرهف عزمه على تنفيذ خططه « الأموية » وقد وقف الحسن والحسين من دهائه ومكره إزاء خطر فظيع ، يهدّد الإسلام باسم الإسلام ، ويطغى على نور الحقّ باسم الحقّ ، فكانا في دفع هذا الخطر أمام أمرين لا ثالث لهما : إمّا المقاومة وإمّا المسالمة ، وقد رأيا أنّ المقاومة في دور الحسن تؤدي لا محالة إلى فناء هذا الصفّ المدافع عن الدين وأهله ، والهادي إلى اللّه عزّ وجل وإلى صراطه المستقيم .
ومن هنا رأى الحسن ( عليه السّلام ) أن يترك معاوية لطغيانه ، ويمتحنه بما يصبو اليه من الملك ، لكن أخذ عليه في عقد الصلح أن لا يعدو الكتاب والسنّة في شيء من سيرته وسيرة أعوانه ، وأن لا يطلب أحدا من الشيعة بذنب أذنبه مع الأموية ، وأن يكون لهم من الكرامة وسائر الحقوق ما لغيرهم من المسلمين ، وأن ، وأن ، وأن ، إلى غير ذلك من الشروط التي كان الإمام الحسن عالما بأنّ معاوية لا يفي له بشيء منها وأنّه سيقوم بنقائضها .
هذا ما أعدّه ( عليه السّلام ) لرفع الغطاء عن الوجه « الأموي » المموّه ، ولصهر الطلاء عن مظاهر معاوية الزائغة ، ليبرز حينئذ هو وسائر أبطال « الأموية » كما هم جاهليّون لم تخفق صدورهم بروح الإسلام لحظة ، ثأريّون لم تنسهم مواهب الإسلام ومراحمه شيئا من أحقاد بدر وأحد والأحزاب .
وبالجملة : فإنّ هذه الخطّة ثورة عاصفة في سلم لم يكن منه بدّ ، أملاه ظرف الإمام الحسن ( عليه السّلام ) إذا التبس الحقّ بالباطل ، وتسنّى للطغيان فيه سيطرة مسلّحة ضارية ، ما كان الحسن ( عليه السّلام ) ببادئ هذه الخطة ولا بخاتمها ، بل أخذها فيما أخذه من إرثه ، وتركها مع ما تركه من ميراثه ، فهو كغيره من أئمة هذا البيت ( عليهم السّلام ) يسترشد الرسالة في إقدامه وإحجامه ، امتحن بهذه الخطّة فرضخ لها صابرا محتسبا وخرج منها ظافرا طاهرا .
تهيّأ للحسن ( عليه السّلام ) بهذا الصلح أن يفرش في طريق معاوية كمينا من نفسه يثور عليه من حيث لا يشعر فيرديه ، وتسنّى له أن يلغم نصر الأموية ببارود الأموية نفسها ، فيجعل نصرها جفاء وريحها هباء .
لم يطل الوقت حتى انفجرت أولى القنابل المغروسة في شروط الصلح ، انفجرت من نفس معاوية يوم نشوته بنصره ، إذ انضمّ جيش العراق إلى لوائه في النخيلة ، فقال - وقد قام خطيبا فيهم - : « يا أهل العراق ! إنّي واللّه لم أقاتلكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتزكّوا ، ولا لتحجّوا ، وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم ، وقد أعطاني اللّه ذلك وأنتم كارهون ، ألا وأنّ كلّ شيء أعطيته للحسن ابن علي جعلته تحت قدميّ هاتين »[3].
ثمّ تتابعت سياسة معاوية ، تتفجر بكلّ ما يخالف الكتاب والسنّة من كلّ منكر في الإسلام ، قتلا للأبرار وهتكا للأعراض وسلبا للأموال وسجنا للأحرار ، ختم معاوية منكراته هذه بحمل خليعه المهتوك على رقاب المسلمين ، يعيث في دينهم ودنياهم ، فكان من خليعه ما كان يوم الطفّ ، ويوم الحرّة ، ويوم مكة إذ نصب عليهم العرّادات والمجانيق .
ومهما يكن من أمر فالمهمّ أنّ الحوادث جاءت تفسّر خطّة الإمام الحسن وتجلوها ، وكان أهمّ ما يرمي اليه سلام اللّه عليه أن يرفع اللثام عن هؤلاء الطغاة ، ليحول بينهم وبين ما يبيّتون لرسالة جدّه من الكيد ، وقد تمّ له كلّ ما أراد ، حتى برح الخفاء وآذن أمر الأموية بالجلاء ، والحمد للّه رب العالمين .
وبهذا استتبّ لصنوه سيد الشهداء أن يثور ثورته التي أوضح اللّه بها الكتاب ، وجعله فيها عبرة لأولي الألباب .
وقد كانا ( عليهما السّلام ) وجهين لرسالة واحدة ، كلّ وجه منهما في موضعه منها ، وفي زمانه من مراحلها ، يكافئ الآخر في النهوض بأعبائها ويوازنه بالتضحية في سبيلها ، فالحسن ( عليه السّلام ) لم يبخل بنفسه ، ولم يكن الحسين ( عليه السّلام ) أسخى منه بها في سبيل اللّه ، وإنّما صان نفسه يجنّدها في جهاد صامت ، فلمّا حان الوقت كانت شهادة كربلاء شهادة حسنيّة قبل أن تكون حسينيّة . وكان يوم ساباط أعرق بمعاني التضحية من يوم الطفّ لدى اولي الألباب ممّن تعمّق ، لأنّ الإمام الحسن ( عليه السّلام ) أعطي من البطولة دور الصابر على احتمال المكاره في صورة مستكين قاعد ، وكانت شهادة الطفّ حسنيّة أولا وحسينيّة ثانيا ؛ لأنّ الحسن أنضج نتائجها ومهّد أسبابها .
وقد وقف الناس - بعد حادثتي ساباط والطفّ - يمعنون في الأحداث ؛ فيرون في هؤلاء الأمويين عصبة جاهلية منكرة ، بحيث لو مثلت العصبيات الجلفة النذلة الظلوم لم تكن غيرهم ، بل تكون دونهم في الخطر على الإسلام وأهله . . . [4] .
[1] صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين : 371 - 372 .
[2] ) للتعرّف على عداء معاوية وموبقاته التي تمثّلت في تعطيله الحدود الإلهية وتحريف الأحكام الشرعية وشرائه لأديان الناس وضمائرهم وخلاعته ومجونه وافتعاله للحديث وغيرها من المنكرات الفظيعة ، راجع حياة الإمام الحسن : 2 / 145 - 210 .
[3] صلح الإمام الحسن : 285 عن المدائني ، وراجع أيضا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 4 / 16 ، وتأريخ اليعقوبي : 2 / 192 .
[4] راجع مقدمة صلح الإمام الحسن للشيخ راضي آل ياسين .



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|