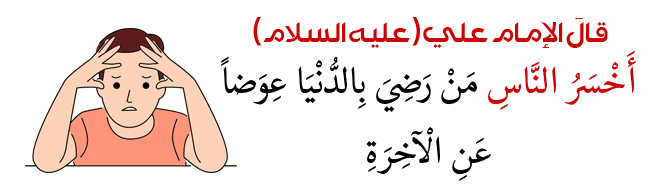
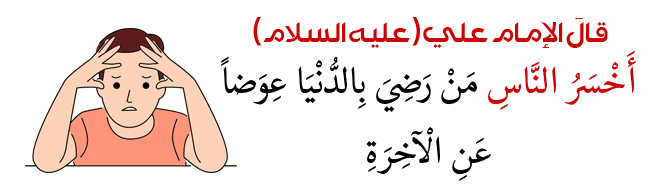

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-08-2015
التاريخ: 27-12-2018
التاريخ: 24-12-2017
التاريخ: 12-1-2019
|
إن بعثة الأنبياء ممكنة ، لكونها مقدورة وحسنة ، لاستنادها إلى حكيم منزه عن كل قبيح ، لأنه لما بعثهم وصدقهم بإظهار المعجزات مع استحالة تصديقه الكذابين ، وإظهاره المعجزات لغير التصديق ، ثبت القطع على حسنها ، وربما كانت واجبة من حيث وجب الإعلام بالمصالح والمفاسد التي لا يمكن العلم بها والاطلاع على ما وجب منها فعلا وتركا إلا ببعثتهم ، فيكون الوجه فيها ظاهرا ، وهو إرشاد المكلفين إلى ما لا سبيل لهم إلى الاسترشاد إليه إلا بهم.
واللطف في الواجب واجب ، كما أنه في الندب
ندب ، وعصمة الأنبياء مطلقة بالنسبة إلى جميع الأوقات ، وجميع ما منه العصمة واجبة
، لأنه لو جاز عليهم شيء من القبائح قدح في أدائهم وتبليغهم المقطوع على صدقهم
فيه بظهور المعجز عليهم ، فكان لا يبقى لأحد طريق إلى العلم بصدقهم الذي لولا
القطع عليه تعذر الوثوق بهم ، والقبول منهم ، وذلك مناف للغرض في بعثتهم الذي
منافاته تنافي الحكمة ، وتناقضها ، فكما وجب تنزيههم عن الكذب في الأداء والتبليغ
ليصح الرجوع إليهم والاقتداء بهم ، فكذلك وجب تنزيههم عن كل قبيح لا تسكن مع
تجويزه النفوس إليهم ، لنفورها عنهم.
ولا يثبت ذلك التنزيه التام الذي لا يبقى
للتنفر معه وجه إلا بعصمتهم على الإطلاق ،
وهو ما أردناه.
وبالعلم المعجز الظاهر على يديهم أو نص
صادق يثبت القطع على صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في
جنسه أو صفته المخصوصة ، لكونه من فعل الله تعالى ، أو جار مجرى فعله ، لأن الدعوى عليه ، فما تصديها إلا إليه خارقا
للعادة الجارية بين المبعوث إليهم ، لأن المعتاد لا إبانة به ولا دلالة فيه مطابقا
لدعوى المدعى على وجه التصديق له ، لأن المتراخي لا قطع به على ذلك ، لتجويز دخول الحيلة فيه.
فإذا حصل على هذه الشروط دل على صدق من ظهر
على يديه ، واختص به ، وسمي لذلك معجزا ، لأنه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق
المدعى عليه ، من حيث كان صادقا عليه في دعواه ، وكان غاية تصديقه منه بالقول أن
يقول : هذا صادق فيما ادعاه علي ، فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم في تصديق ادعائه مقام قوله إنه صادق فيه ، ولا
فرق في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجة به مقامه ، كما لا فرق بين أن
تكون الدعوى نبوة أو إمامة أو غيرهما من مراتب الصلاح ، إذ وجه الحكمة في وجوب
تصديق الجميع إذا تعلقت المصلحة به واحد ، فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا
وجه له.
ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضي علمه به ،
وإلا فالخبر المتواتر فيه إذ ذاك يفيد
العلم ، القطع به مع فقد مشاهدته ، ولا يتميز الخبر بكونه متواترا مفيدا ما ذكرناه ، إلا بأن يكون على شروطه التي
هي كون مخبره في الأصل مشاهدا محسوسا لا يلتبس الحال في مثله ولا يدخل فيه
الاشتباه ، وكون ناقلية بالغين في الكثرة إلى حد لا يجوز على مثلهم في العادة
التواطؤ فيه والافتعال له أو ما يجري مجراهما ، مع ارتفاع جميع الأسباب الداعية
إلى ذلك ، عنهم واستحالتها منهم وتساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به إنه
لم يكن مختصا بطبقة دون طبقة ، ولا بفريق دون فريق ، فإذا اختص الخبر بذلك أفاد
العلم وأثمر اليقين بمخبره ، وسمي لذلك متواترا وإلا فلا.
وصدق جميع أنبياء الله معلوم بإخبار الصادق
عنهم ، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع ما تضمن الكتاب العزيز من
ذكر الأنبياء المعينين فيه.
وصدق نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه
وآله وسلم معلوم بادعائه النبوة ، وظهور المعجز مطابقا لادعائه مختصا بجميع
شرائطه ، فلولا أنه صادق لم يجز ذلك.
ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وإن
كانت كثيرة إلا أن منها :
ما هو باق موجود ، وهو القرآن الكريم ،
ووجه الاستدلال به على نبوته ، أنه تحدى العرب وقرعهم بالعجز عن معارضته ، ولو لا
التحدي لم يكن لادعائه وجه ، فعجزوا عن المعارضة ، مع توفر الدواعي إليها وقوة
البواعث عليها ، ولو لا عجزهم عنها لأتوا بها ، ولو أتوا لنقلت وظهرت ، بل كان
نقلها وظهورها أعظم من ظهور القرآن ونقله ، لأنها كانت حجة لهم بمثلها بقاء جميع
ما كانوا فيه من ديانة ورئاسة وغيرهما ، فلما لم يعرف لها نقل ولا أشير إلى ذلك
بوجه ، مع تطاول المدة التي كانوا فيها بها مهتمين ، وعلى إثباتها مجتهدين متحيلين
، علم بلا شبهة عجزهم عنها ، وثبت أنه عائق لعوائدهم لأنهم مع ما كانوا فيه من الفصاحة والبلاغة
عدلوا عنها إلى ما لا مناسبة بينه وبينها في كلفة ولا مشقة ، لأن تفاوت ما بين
المعارضة بالكلام والحروب المفضية إلى المهلك
، التي لم يخطو فيها ببلوغ غرض ولا مرام ، لا يخفى عن عاقل ، فلو لا أن
عجزهم خارق العادة لم ينتهوا إلى ذلك ولا كان لانتهائهم إليه وجه، لكونه مخالفا
لعوائد العقلاء ، وذلك شاهد بصدقه وصحة نبوته من حيث صرفهم الله عن معارضته بسلبهم العلوم المخصوصة في كل وقت اهتموا فيه
بها وتطاولوا إليها ، لأنه لو لا الصرف لم يكن لوقوفهم وخرسهم عند التفرغ لها
والطمع بحصولها وجه ، إذ كان الكلام البليغ مقدورا لهم، وهم عليه مطبوعون ، وبه
متطاولون ، فما وجه اخلافه لهم وتعذره عليهم في وقت اضطرارهم وحاجتهم إليه لولا ما
ذكرناه ، فإن كانت فصاحة ما تحداهم به أو نظمه أو كلاهما ، وجب الفرق بين أفصح
كلامهم وأرتبه ، وبين أقصر سور المفصل على
وجه يشترك في العلم به كل سامع لهما من مبرز ومقصر ، لكونه فرقا بين ممكن ومعجز ،
فإن من أمحل المحالات أن يفرق بين المتقاربين من لا يفرق بين المتباعدين.
وإذا كان ظهوره على هذا الوجه أو بلوغه في
الظهور إلى هذا الحد غير حاصل ولا واقع ثبت أنه لا وجه لإعجاز القرآن إلا الصرفة ،
وهي خارجة عن مقدور كل قادر بقدرة ، لاختصاصه تعالى بالاقتدار عليها ... ومن أنه
سبحانه لا يجوز عليه تصديق من ليس بصادق وفي ذلك ثبوت صدقه وصحة نبوته صلى الله عليه
وآله وسلم.
ومنها ما ليس بباق لتقضيه ، وإنما علم
بتواتر النقل به ، وهو باقي معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ، كتسبيح الحصا
(1) وانشقاق القمر (2) ونبع الماء تارة بغرر سهمه (3) وأخرى بوضع كفه (4) ، وحنين
الجذع (5) ، وكلام الذراع (6) ومجيء الشجرة إليه وعودها إلى موضعها عند أمره لها
بذلك (7) وإشباع الجماعة الكثيرة بالطعام القليل (8) وإخباره بكثير من الغائبات
والحوادث المستقبلات (9). ويقع الخبر مطابقا لما أخبر ، وبابها متسع. فإن ما أشرنا
إليه قطرة من بحر ما له صلى الله عليه وآله وسلم منها.
ووجه الاستدلال بها أن فيها ما نطق القرآن
به ، وفيها ما علم علما لا مجال للشك فيه ، وباقيها بانضمام بعضه إلى بعض ،
واتفاقه في دلالة الإعجاز ، فلحق بالمتواتر ويفيد مفاده ، ولوقوعها على صفة المعجز
المعتبر بشرائطه لا يتقدر فيها ما ينافيه ويقدح فيه ، فأكدت ما بيناه من نبوته
وصدق دعوته ، وببقاء شريعته إلى انقضاء التكليف وتحقيق ثبوتها وجوب كونها ناسخة
لما تقدمها من الشرائع ، لأن العقل لا يمنع من جواز النسخ ، بل يشهد بحسنه ، لكونه
طريقا إلى الإعلام بتجدد المصالح التي لا يمكن استعمالها إلا به ، ولأن التعبد
بالأحكام الشرعية تابع للمصالح الدينية وبحسبها ، وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب
اختلاف الأزمان والمكلفين ، فما المانع من النسخ ، وهو سبب الإعلام بتجديدها ،
وبالوصول إلى العلم بها ، وبما تعلقت به
المصلحة منها ، فيكون المنع منه تعويلا على أنه يؤدي إلى البداء باطلا ، لأنه
يخالفه حدا وشرطا ، والفرق بينهما ظاهر ، ولو كان نسخ الشرائع بداء أو مؤديا إليه
، لزم مثله في كل ما تجدد من أفعاله تعالى ، وحصل بعد غيره ، كالموت بعد الحياة ،
والسقم بعد الصحة ، والضعف بعد القوة ، والغلاء بعد الرخص ، وهلم جرا.
وإذا لم يكن في شيء من ذلك ما يؤدي إليه ،
ولا ما يقتضيه ، فنسخ الشرائع أولى أن لا يلزم عليها ما يؤدي إليه ولا إلى غيره ،
لتعلق الجميع بداعي الحكمة التي يستحيل منافاتها ، وإذا ساغ النسخ عقلا فلا مانع
منه شرعا ، لأنه لا حجة لمانعية فيما
احتجوا به من النقل ، لكونه من أضعف رواية آحادهم التي لا سبيل لهم إلى تصحيحه ،
ولا إلى إثبات كونهم متواترين به ، للعلم الضروري بارتفاع شروط التواتر عنهم بل
استحالتها فيهم ، ولو لم يكونوا كذلك كان احتمال ما تشبثوا به من نقلهم للتأويل
ولزوم حمله عليه ، لئلا يرجع بالقدح على نبوة نبيهم ، مسقطا للاحتجاج به ومغنيا عن
النظر فيه.
__________________
(1) بحار الأنوار 17 ـ 379.
(2) نفس المصدر ص 347.
(3) الغرار: حد الرمح والسيف والسهم. لسان العرب.
(4) بحار الأنوار 17 ـ 286.
(5) نفس المصدر ص 365.
(6) نفس المصدر ص 232 و 295.
(7) نفس المصدر 297.
(8) نفس المصدر 231.
(9) نفس المصدر
18 ـ 105 باب معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم في إخباره بالمغيبات.



|
|
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|