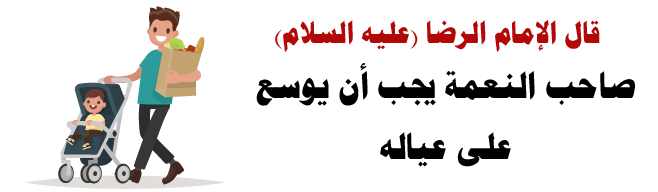
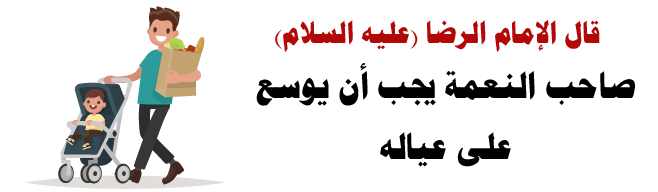

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-2-2018
التاريخ: 2-3-2019
التاريخ: 22-11-2016
التاريخ: 11-4-2017
|
[أولا] في تعريفها وبيان مطالبها:
أمّا الأوّل فهي: «رئاسة عامّة في الدين والدنيا لشخص إنساني خلافةً عن النبيّ»، فالرئاسة جنس قريب، والبعيد النسبة، وبعمومها خرجت ولاية قرية وقضاء بلد، وتعلّقها بالدين يخرج الملوكية، وبالدنيا، يخرج القضوية، وتقييد الشخص بالإنساني يخرج الملك والجنّ لو أمكن، وبقيد الخلافة تخرج النبوة لانطباق ما قبلها عليها.
وأمّا الثاني: واعلم أنّ البحث في الإمامة مبنيٌ على خمسة مطالب يُعبّر عن كلّ واحد منها بكلمة وهي: (ما) و (هل) و (لِمَ) و (كيف) و (مَن).
ف (الأوّل) قولنا: ما الإمامة؟ وهي البحث عن تفسير هذه اللفظة في الاصطلاح العلمي.
(الثاني) هل الإمام؟ أي هل يكون الإمام موجوداً دائماً أو في بعض الأوقات، وهو الذي يبحث فيه عن وجوب وجوده في زمان التكليف كلّه أو بعضه.
(الثالث): قولنا: لِمَ وجبت الإمامة؟ وهو الذي يبحث فيه عن العلّة الغائيّة لوجودها ووجهها في الحكمة.
(الرابع): قولنا: كيف الإمام؟ والبحث فيه عمّا ينبغي أن يكون عليه من الصفات.
(الخامس): قولنا: مَن الإمام؟ وهو الذي يبحث فيه عن تعيينه في كلّ زمان.
[ثانيا] في حكاية الخلاف في هذه المطالب ليوقف عليه قبل تحقيق الحقّ وتزهيق الباطل فنقول:
أمّا المطلب الأوّل فليس فيه خلاف ليحكى.
وأمّا الثاني فقال النجدات(1) بعدم وجوبها مطلقاً(2) ، وقال الأصمّ وبعض الخوارج بوجوبها في حال الاختلاف، أو استيلاء الظلمة وعدم التناصف(3) ، وهشام الفوطي(4) عكس، وقال أكثر الناس بوجوبها مطلقاً.
ثمّ اختلفوا، فقال أكثر الجمهور بوجوبها سمعاً وهم الأشاعرة وأصحاب الحديث والجبائيان(5). وقال جماعة من المعتزلة والشيعة بوجوبها عقلًا(6).
ثمّ اختلفوا فقال أبو الحسن والبلخي والبغداديّون انّها تجب على الخلق(7) وقالت الإمامية والإسماعيليّة بعدمه.
ثمّ اختلفوا فقالت الإسماعيليّة: تجب من اللَّه وقالت الإماميّة: على اللَّه(8) من حيث الحكمة.
وأمّا الثالث: فاعلم أنّ أصحاب الوجوب السمعي لم يعللوه بعلّة ظاهرة غير ما قال أصحاب الوجوب العقلي، فالموجبون على الخلق علّلوه بدفع الضرر عن أنفسهم، والموجبون على اللَّه اختلفوا، فقالت الإمامية: علّتها كونها لطفاً مقرّباً الى الطاعة، وقالت الإسماعيليّة(9): نصب الإمام لإفادة المعارف الحقّة، فإنّ النظر بدونه غير مفيد علماً ولا نجاة، ولهذا كان من جملة ألقابهم التعليميّون.
وأ مّا الرابع: فاختلفوا في مقامين:
أ- في صفاته:
فقالت الحشويّة(10): يجوز عقدها لمن استقل بالرئاسة ولو كان عبداً أو فاسقاً متغلّباً، أو بويع له ثمّ تاب، وقال الخوارج وبعض المعتزلة: هي جائزة في كلّ صنف بشرط الفضل والقيام بها وإن لم يكن قرشيّاً، وقال المحقّقون من الجمهور: يجب أن يكون مكلّفاً ذكراً حرّاً عدلًا قرشيّاً لا غير.
وهل يجب أن يكون ذا رأي في تدبير الحرب، وأنْ يكون شجاعاً ومجتهداً في اصول الدين وفروعه؟
فقال جماعة: لا يجب (بل يكفي أن يثبت من دون هذه الصفات)(11).
وقالت الزيديّة(12): يجب أن يكون فاطميّاً عالماً زاهداً شجاعاً داعياً الى نفسه وبعضهم لم يشترط كونه فاطميّاً، بل يكتفي بكونه علويّاً.
واشترط الجاروديّة(13) خاصّة كونه أفضل أهل زمانه ولم يشترط غيرهم، بل جوّز السليمانيّة(14) والصالحيّة(15) إمامة المفضول مع وجود الأفضل، وجوّزوا أيضاً انعقاد الإمامة بالبيعة ولو من اثنين من خيار الامّة.
وقالت الإسماعيليّة: يشترط عصمته على معنى أنّ فعله لا يوصف بالخطأ(16).
وقال أصحابنا الإماميّة: يجب أن يكون معصوماً في نفس الأمر، وأفضل أهل زمانه في سائر الكمالات وكذا سائر الصفات المذكورة في النبوّة(17).
ب- في طريق تعيينه:
واتّفقوا على انّه اذا حصل نصّ من اللَّه ورسوله أو إمام سابق كان كافياً في تعيينه، واختلفوا في حصوله بغير ذلك.
فقالت الراونديّة(18): تحصل بالإرث.
وقال محقّقو الجمهور: اذا بايعت الامّة مستعدّاً للإمامة أو استولى هو بشوكته على خطط الاسلام، تعيّنت إمامته.
وقال أصحابنا الإمامية(19) والكيسانيّة(20) : لا بدّ من النص.
والزيديّة والجاروديّة اكتفوا بالنصّ الخفي أو القيام والدعوى.
وأصحابنا أوجبوا النصّ الجليّ.
وأمّا الخامس: فقالت الراونديّة: إنّ الإمام بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله العبّاس ابن عبد المطّلب بالإرث، وهؤلاء انقرضوا.
وقال الجمهور: هو أبو بكر بالإجماع، ثمّ عمر بنصّ أبي بكر عليه، ثم عثمان بنصّ عمر على جماعة أجمعوا على خلافته، ثمّ عليّ بإجماع المعتبرين من الصحابة، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ثمّ وقعت منازعة بين الحسن عليه السلام ومعاوية، وصالحه الحسن، واستقرّت الخلافة عليه، ثمّ على من بعده من بني اميّة وبني مروان حتى انتقلت الى بني العباس، وأجمع أكثر أهل الحلّ والعقد عليهم وانساقت الخلافة فيهم الى عهدنا هذا، الذي جرى فيه ما جرى.
وقالت الزيديّة انّه عليّ عليه السلام بالنصّ الخفيّ عليه، وذكر فضائله، ثمّ بعده الحسنان عليهما السلام ولم يوجبوا فيهما القيام والدعوى لقوله صلى الله عليه وآله: «هما إمامان قاما أو قعدا»(21).
ويجوز خلوّ الزمان عن إمام عند بعضهم، وكذا جوّزوا قيام إمامين في بقعتين متباعدتين، ولم يقولوا بإمامة زين العابدين عليه السلام؛ لأنه لم يشهر سيفه في الدعوى الى اللَّه، وقالوا بإمامة ابنه زيد؛ لقيامه وشهر سيفه وبه لُقّبوا لمفارقتهم سائر الشيعة بإمامته، ولقّبوا باقي الشيعة بالرافضة، لرفضهم زيداً، وقالوا بعد زيد بمن اجتمعت فيه الشرائط من العترة الى زماننا هذا. وسيأتي البحث معهم.
وقالت الكيسانيّة: بإمامة محمّد بن الحنفية بعد أخيه الحسين عليه السلام، وقالوا: إنّه المنتظر، أي المهدي الذي يملأ الدنيا عدلًا، وهو الآن مستتر في جبل رضوى بقرب المدينة، وبعضهم قدّمه على علي بن الحسين عليه السلام ، وبعضهم ساق الإمامة الى ابنه هاشم، ثمّ الى غيره، ولهم فرق، والآن هم منقرضون.
وقالت الإسماعيليّة: الإمام في عهد رسول اللَّه هو علي، وبعده ابنه الحسن إماماً مستودعاً، وبعده ابنه الحسين إماماً مستقرّاً، وكذلك لم تذهب الإمامة من ذريّة الحسين عليه السلام، وبعده ابنه عليّ، ثم ابنه محمّد الباقر، ثمّ ابنه جعفر الصادق، ثمّ انتقلت الى اسماعيل وهو السابع، ولقّبوا بالإسماعيليّة لقولهم بإمامته، وبالسبعيّة لكونهم وقفوا على الأئمة السبعة، والباطنية لقولهم: كلّ ظاهر له باطن، والملاحدة لعدولهم عن ظاهر الشريعة الى باطنها.
وقالوا: إنّ الأئمة في عهد محمّد بن اسماعيل صاروا مستورين، ثم ظهر المهدي في بلاد المغرب وادّعى أنّه من أولاد إسماعيل، واتصل أولاده ابناً بعد ابن الى المستنصر.
واختلفوا بعده، فقال بعضهم بإمامة نزار ابنه، وبعضهم بإمامة المستعلي باللَّه، وبعد نزار استتر ائمّة النزاريّين واتّصلت أئمة المستعليين الى أن انقطعت في العاضد، وكان الحسن بن محمد بن عليّ الصباح المستعلي على قلعة ألَمُوت (22) من دعاة النزاريّين، ثم ادّعوا بعده أنّ الحسن الملقب ب «علي ذكره السلام» كان اماماً ظاهراً من أولاد نزار واتصل أولاده الى أن انقرضوا(23).
وقال أصحابنا الامامية: إنّه علي عليه السلام بلا فصل، للنصّ الجلي والخفي، واجتماع الشرائط التي هي العصمة والأفضلية فيه، وفي من بعده وهم: ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد الجواد، ثم ابنه عليّ الهادي، ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد المهدي القائم المنتظر، وهو حيّ باقٍ موجود يظهر ويملأ الدنيا عدلًا كما ملئت جوراً- عجّل اللَّه فرجه- وهو الثاني عشر.
وأنّه يجب الاقرار بكلّ واحدٍ منهم في كلّ زمان، ومن جحد واحداً منهم لم يكن مؤمناً (باللَّه) ، لقوله صلى الله عليه وآله: «يا علي أنت والأئمة من بعدك من أنكر واحداً منكم فقد أنكرني»(24) ولقّبوا بالاثني عشريّة، لذلك وبالإمامية ، لقولهم بوجوب الامامة مطلقاً في كلّ زمان، وينسب إليهم اختلافات شاذّة لا حقيقة لها في تعيين أئمتهم، وانقرض القائلون بها إن كانت قد وقعت، وذلك كافٍ في فسادها.
_____________
(1) الملل والنحل 1: 112 والنجدات هم من الخوارج أصحاب نجدة بن عامر الحنفي. الفرق بين الفِرق: 87.
(2) شرح المقاصد 5: 235.
(3) شرح المقاصد 5: 236. والأصم هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم فقيه معتزلي مفسّر قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطّئ علياً عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله( أعلام الزركلي 3: 323). وأ مّا الفوطي فهو هشام بن عمرو الفوطي: كان من أصحاب أبي الهذيل فانحرف عنه أيضاً فعمّ عليه المعتزلة وانحرفوا عنه... وكان داعية الى الاعتزال استجاب له جماعة من أهل الأمصار وكان هشام يقول إنّ الشيطان لا يدخل في الانسان وانّما يوسوس له من خارج...( الفهرست لابن النديم: 214).
(4) شرح المقاصد 5: 236. والأصم هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم فقيه معتزلي مفسّر قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطّئ علياً عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله( أعلام الزركلي 3: 323).
(5) كشف المراد: 362.
(6) شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي: 365.
(7) كشف المراد: 362.
(8) المصدر السابق.
(9) كشف الفوائد: 80.
(10) انظر المقالات والفرق: 6. وشرح المقاصد 5: 233.
(12،11) كتاب الأربعين في أُصول الدين( للفخر الرازي): 438، والزيديّة: هم المنسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. لم يكن له في مجال الأُصول والعقائد مذهب خاص سوى ما عليه العترة الطاهرة عليهم السلام وله عند الأئمة الأطهار عليهم السلام مكانة خاصة ومنزلة كبيرة لم تكن لسائر أئمة الزيدية.
والمذهب الزيدي تأثر بمبادئ الاعتزال كثيراً كما تأثر بفقه بعض المذاهب الأربعة( راجع بحوث في الملل والنحل للشيخ السبحاني، المجلد السابع) وللزيدية فرق كثيرة بادر المصنف إلى دراسة بعضها في الصفحة 377 وما بعدها.
(15،14،13) سيأتي عن المصنف رحمه الله دراسة هذه الفرق الثلاثة من الزيدية في الصفحة 377- 379.
(16) النجاة في القيامة: 55.
(17) كشف المراد: 364- 366.
(18) الراوندية: جماعة من الغلاة القائلة بالتناسخ والحلول، نسبة الى راوند بلدة قريبة من اصفهان ومهد الدعوة ويقال انّ رجلًا يدعى الأبلق كان أبرص تكلم بالغلو ودعا الى الراوندية... وقيل نسبة الى عبد اللَّه الراوندي وقيل نسبة الى ابي هريرة الراوندي...» معجم الفرق الاسلامية: 120 ... وقد أثبتوا إمامة العباس بعد علي عليه السلام وخصّصوها بولد العباس من بعده من بين بطون قريش.( معجم الفرق الاسلامية: 120)
(19) كشف المراد: 366.
(20) لم نعثر على هذه النسبة وسيأتي من المصنف رحمه الله في الصفحة 321 بيان عن الفرقة الكيسانية المنقرضة.
(21) بحار الأنوار 35: 266 الحديث 1 وفيه:« هذان إمامان...».
(22) ألَمُوت: قلعة تقع قرب مدينة قزوين في إيران، المورد 1: 66، مادة( ألَمُوت).
(23) ما ذكره المصنف هنا عن الفرقة الاسماعيلية أخذه عن كتاب« قواعد العقائد» للخواجة نصير الدين الطوسي المطبوع ضمن ميراث اسلامى ايران 8: 489- 490 وسيأتي منه رحمه الله زيادة بيان عن هذا المذهب عن القواعد أيضاً في الصفحة: 386- 387.
(24) بحار الأنوار 23: 97 مع اختلاف يسير.



|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|