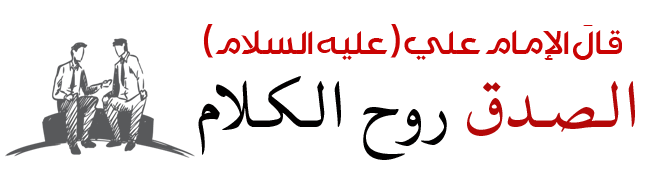
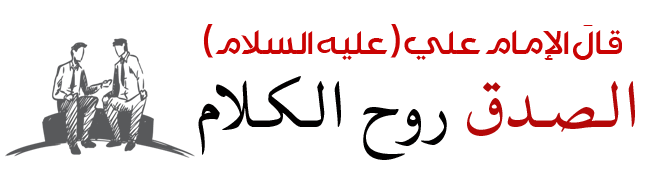

 التاريخ والحضارة
التاريخ والحضارة
 اقوام وادي الرافدين
اقوام وادي الرافدين 
 العصور الحجرية
العصور الحجرية 
 الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق 
 العهود الاجنبية القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق 
 احوال العرب قبل الاسلام
احوال العرب قبل الاسلام 
 مدن عربية قديمة
مدن عربية قديمة
 التاريخ الاسلامي
التاريخ الاسلامي 
 السيرة النبوية
السيرة النبوية 
 الخلفاء الاربعة
الخلفاء الاربعة
 علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
 الدولة الاموية
الدولة الاموية 
 الدولة الاموية في الشام
الدولة الاموية في الشام
 الدولة الاموية في الاندلس
الدولة الاموية في الاندلس
 الدولة العباسية
الدولة العباسية 
 خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
 خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
 عصر سيطرة العسكريين الترك
عصر سيطرة العسكريين الترك
 عصر السيطرة البويهية العسكرية
عصر السيطرة البويهية العسكرية
 عصر سيطرة السلاجقة
عصر سيطرة السلاجقة
 التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر
 التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
 تاريخ الحضارة الأوربية
تاريخ الحضارة الأوربية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-06
التاريخ: 2024-08-12
التاريخ: 2024-06-26
التاريخ: 2023-07-30
|
تحدثنا في الجزء الثاني من «مصر القديمة» (ص 189–195) عن الذهب وأنواعه وكيفية الحصول عليه والأماكن التي كان يوجد فيها في وادي النيل النوبي وغيره. والواقع أن الذهب النوبي هو أهم مادة بحث عنها المصريون في بلاد النوبة السفلى وقد كان أول معدن ذكر عندهم. ومناجم الذهب التي استغلها المصريون في الصحراء الشرقية من مصر وبلاد النوبة تنقسم ثلاث مجاميع، فالمجموعة الأولى تقع في أقصى الشمال من وادي النيل في «وادي حمامات» «قنا» وهو في منتصف الطريق المؤدية للبحر الأحمر. ومن هذا المكان كان يُستخرج الذهب المُسَمَّى ذهب «قفط» أو ذهب صحراء «قفط» وفي المجموعة الثانية أو الوسطى يوجد منجم ذهب «پرامية» ويصل إليه الإنسان من «إدفو». والمجموعة الأخيرة أو المنجم الجنوبي ويقع في «وادي العلاقي» «أم جرايات» و«أم ثورة»، و«بير إيجات» و«دراهيب»)، وكذلك كان يُسْتَخْرَجُ من الوديان القريبة من «وادي العلاقي» وأهمها «وادي مرا» و«سيجا» (Seiga) و«دراهيب» وتوجد بقايا بعض بيوت قديمة لا يزال فيها مغاسل وطواحين يد للطحن. وهذه المناجم لم يُحَدَّدْ زمنها على وجه التقريب، ويوجد في «بير إيجات» (Eigat) على الآبار نفسها رسوم تمثل ثيرانًا ذات قرون طويلة وإشارات هيروغليفية فجة، هذا بالإضافة إلى نقوش تركها كاتب يدعى «أمنحتب» وكذلك وُجِدَ في «دراهيب» قطعة من إناء حجري، ويقع هذا المكان في «وادي العلاقي» على مسافة بضعة أميال من جهة السودان على الحدود المصرية السودانية، وهو ضمن الإدارة المصرية.
وقد وصلت إلينا طريقة العمل في هذه المناجم في العهد الفرعوني، وقد وصفها لنا الكاتب الإغريقي «أجاتارخيدس» (Agatharchidis) يضاف إلى ذلك الاستغلال الذي كان يقوم به عدد عظيم من الناس دون أي نظام. ولا نعلم شيئًا مؤكدًا عن هذه الطرق من المصادر الفرعونية، ومن المشكوك فيه أن المصري نفسه كان يقوم بمراقبة استخراج الذهب. ومن المحتمل أن العبارة التي فاه بها «ساحتحور» كما ذكرنا من قبل وهي «لقد ابتززت الذهب الكثير بالغسل» تشير إلى أن الأمراء النوبيين كانوا هم المسئولين عن تحصيل الذهب، وأن الدخل كان يُدْفَعُ للمصريين بمثابة جزية. وتدل شواهد الأحوال على أن الذهب في هذا الوقت (كما كان في عهد الدولة الحديثة بعدُ) يمثل الجزية التي كان يدفعها الأمراء النوبيون للموظفين المصريين، ومن ثَمَّ نفهم أن المصريين أنفسهم كانوا لا يستخرجون الذهب.
النحاس: ومن الجائز أن النحاس كان يُسْتَخْرَجُ كذلك من «وادي العلاقي» وذلك على الرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق مدوَّنة عن ذلك إذا ما قرن بنقوش «وادي الهودي»؛ وذلك أنه في وادٍ جانبي متفرع من «أم قربات» نجد في مكان يُدْعَى «أبسيل» طبقة نحاسية، هذا إلى وجود مناجم قديمة.
وقد أقيم عند فم «وادي العلاقي» حصن قوي ليكون نقطة ارتكاز للمناجم يُدْعَى «باكي». والظاهر أنه أول حصن أقيم في عهد «سنوسرت الأول» وقد حل محله حصن أكبر كما حدث في «عنيبة». ويظن «إمري» و«كيروان» أنه قد أُسِّسَ في عهد «سنوسرت الثالث»، ولكن طراز بنائه يدل على أنه أقيم في عهد «سنوسرت الثاني». ويدل مظهر حصن كل من «كوبان» و«إكور» على أنهما متشابهان، هذا إلى أن حصن «إكور» لم يذكر في قائمة الحصون السالفة الذكر مما جعل الأثري «فرث» يظن أنهما بناء يكمل أحدهما الآخر، فقد استعمل حصن «كوبان» لتنظيف المعدن المستخرج من المناجم المجاورة، وبعد ذلك كان يُحْفَظُ في حصن «إكور» ومن المحتمل أن الذهب الذي أتى به «أميني» في عهد «سنوسرت الأول» بحماية كتيبة حربية، يُعَدُّ برهانًا على أنه على الرغم من احتلال البلاد احتلالًا عسكريًّا كان يحسب حساب هجمات يقوم بها الأهالي، وأن اتخاذ مثل هذه الاحتياطات كان لا بد منه. ولا نزاع في أنه كانت توجد في «كوبان» لا في «إكور» رواسب معدنية، وهذا يدل على أنه لم يوجد في هذا الحصن الأخير إلا المعدن الغفل الذي تم إعداده، هذا إلى أن موقع «إكور» على الشاطئ الغربي يوحي بأن هذا الحصن كان يقوم بنفس الوظيفة التي كانت تقوم بها «عنيبة» في عهد الدولة الحديثة، ذلك العهد الذي كان يسوده السلام والطمأنينة. هذا ويدل وقوع هذين الحصنين عند فوهة «وادي العلاقي» على مقدار ما كان لهذه المناجم من أهمية عند المصريين. ونجد في مقابر عظماء القوم من عهد الأسرة الثانية عشرة وبخاصة في جبانة مقر الملك أن الأثاث الغزير الذي كان يُصْنَعُ من مواد غير ثمينة قد أصبح يُصْنَعُ من مواد أثمن، ولا شك في أن ذلك مرتبط باستخراج الكنوز الطبيعية من بلاد النوبة، وقد لعب الذهب دورًا خاصًّا في صناعة هذا الأثاث، وقد أخذت أهمية الذهب تزداد من هذه الناحية منذ هذه اللحظة، ولا أدل على ذلك من المجوهرات التي عُثِرَ عليها في «دهشور» و«اللاهون» وهي التي تُعَدُّ من أفخر المصنوعات الذهبية التي أخرجها الصانع المصري في هذا العهد. وقد أخد الذهب يحتل مكانة عظيمة في التجارة مع البلاد الشمالية المجاورة لمصر كما يدل على ذلك الكنز الذي عُثِرَ عليه في «ببلوص» (جبيل)، يضاف إلى ذلك أن بلاد النوبة كانت تُعَدُّ طريقًا هامة للتجارة المصرية مع البقاع الجنوبية التجارية؛ ومن أجل ذلك كانت الحصون النوبية على جانب عظيم من الأهمية لحراسة الأهالي ولتأمين طرق التجارة الذاهبة إلى السودان.
ويوجد ما لا يقل عن سبعة حصون من التي ذُكِرَتْ في القائمة السالفة الذكر في منطقة «الشلال الثاني». وجميع هذه الحصون تقع في مساحة لا تزيد عن ستين كيلو مترًا، ويرجع سبب ذلك إلى خاصية هذا السهل الذي تقع فيه وما كان لهذه الحصون من مهام ضرورية تقوم بها. ففي جنوب «بهين» مباشرة تنتهي المسافة التي كان يمكن للمسافر أن يقطعها بوساطة النهر بسهولة، وبعد ذلك نجد شلالات عدة وجزرًا يصعب مع وجودها السير في النهر. وقد تجمعت هذه العقبات في مسافتين أُولاهما: ما بين «بهين» و«مرجيس داب» والأخرى ما بين «شلفك» و«سمنة».
ولا نزاع في أنه كانت توجد في العهد القديم تجارة نهرية على الرغم من كل ذلك، وقد لاحظ الأستاذ «ريزنر» في أثناء الحفر الذي قام به في هذه الحصون مدة عشرين سنة أنه كان يقوم أسطول تجاري من السفن الصغيرة من السودان ثلاث مرات في السنة من يوليو/تموز حتى يناير/كانون الثاني ويمر في الشلالات، وقد سَلَّمَ بأن قدماء المصريين كانوا يعملون مثل هذا العمل وكانوا يمرون بالحملات الحربية بخاصة في هذه الجهات، ومن المحتمل كذلك أنه كانت تقوم مبادلات تجارية بالسفن. ويؤكد ذلك الآن النقوش التي عُثِرَ عليها حديثًا في «ورنرتي» وهي مؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من عهد الفرعون «سنوسرت الثالث» وقد سبق التحدث عن ذلك، كما يؤكده ما جاء في لوحة «سمنة» الخاصة بهذا الفرعون نفسه وهي التي حَرَّمَ فيها على السودانيين تعدي الحدود بالسفن.
ويدل كذلك ذكر تعداد السفن عند «الشلال» في تنجور في عهد «تحتمس الأوَّل» على وجود هذه التجارة النهرية في مصر القديمة. وأخيرًا نجد أن فكرة وقوع «ورنرتي» على جزيرة غير مفهوم إذا أنكر الإنسان إمكانية قيام تجارة نهرية هناك كما ذكر ذلك الأثري «بورخارت». والواقع أن هذا المنبسط من الأراضي الواقع عند الشلال الثاني والذي يصعب المرور فيه كانت فيه مخابئ يستتر فيها الأهالي عند قيام اللصوص بهجمات مفاجئة على التجارة المارة هناك، كما كان صالحًا من جهة أخرى لمرور الحملات التأديبية على أهالي النوبة الثائرين، وأخيرًا تمثل هذه الجهة الممر الطبعي الذي كانت تزحف منه القبائل السودانية نحو الشمال. ومما يُؤْسَفُ له جد الأسف أن البقعة الواقعة بين «سمنة» و«كرمة» لم تُبْحَثْ بحثًا كافيًا؛ ولذلك فإننا لا نكاد نعرف شيئًا عن ثقافة الأهالي هناك.
ويرجع السبب في وجود حصون «الشلال الثاني» إلى ثلاثة أمور، أوَّلها أنها أقيمت هناك على وجه عام لمراقبة وحماية السياحة والتجارة، وثانيها حراسة السهل حتى لا تطأ قدم معادية من السكان هذه الجهة، وثالثها أنها كانت تُعَدُّ بمثابة حاجز في وجه المهاجرين من السودان إلى مصر.
ولما كانت الرابطة بين الحصون بطريق الماء ليست سهلة في بلاد النوبة العليا كما هي الحال في بلاد النوبة السفلى فإن كل حصن على وجه عام كان يعتمد على نفسه؛ ولذلك أقيمت الحصون بطريقة تجعل كل واحد منها يحتوي على حامية صغيرة تصد غائلة الهجوم المفاجئ، ولذلك كان يوضع في كل حامية عدد من الرجال للقيام بالأعمال والواجبات الأخرى التي تقتضيها ملابسات الأحوال، فإذا اتفق أن السفن الخاصة بالحملات الحربية أو الحملات التجارية عجزت عن المرور بسهولة في الجهات الجنوبية النائية بسبب الشلالات كما سبق وصف ذلك في نقش «ورنرتي» فإنه في مثل تلك الحالة يُسْنَدُ إلى بعض من رجال الحصن القيام بهذا العمل الشاق دون أن يُؤْخَذَ من حامية الحصن نفسها أحد، وعلى ذلك أصبح في الإمكان تبادل المساعدة بين حصن وآخر، وقد كان على العمال الذين يجرون السفن أن يسيروا على الساحل دون حماية حربية مما جعل من السهل الهجوم عليهم، ومن أجل ذلك كان المرور صعبًا، فكان لا بد من تقريب الحصون بعضها إلى بعض فنرى في المنطقة الجنوبية بين «سمنة» و«شلفك» أن هذه الحصون لا يبعد الواحد عن الآخر أكثر من مَدِّ البصر، وعلى العكس من ذلك نجد أنه بين «مرشد» و«مرجيس» حيث المرور أسهل، لم يُكْشَفْ عن أكثر من حصنين رديئين وقد أُصْلِحَا عدة مرات ولا يمكننا أن نؤرخهما على وجه التأكيد.
وقد بُنِيَتْ ميناء تفريغ في «بهين» وهي النقطة النهائية الطبعية للتجارة النهرية في بلاد النوبة السفلى، وقد كُشِفَ في هذا المكان عن حصن يرجع تاريخه للأسرة الثانية عشرة، والآثار التي كُشِفَ عنها فيه لا تمكننا من تأريخه على وجه التأكيد، ولكن الآثار التي عُثِرَ عليها في «بهين» وهي التي ترجع إلى عهد «سنوسرت الأول» تجعلنا نؤرخ هذا الحصن على الأرجح بزمن هذا الفرعون. وعلى الرغم من عدم وجود ميناء نهرية فإنه ممَّا لا شك فيه وجود ميناء للتفريغ في هذا المكان لكل الأراضي الجنوبية وإلا فلا نجد تفسيرًا آخر طبيعيًّا لوجود هذه المؤسسة. والواقع أن «بهين» كانت قبل كل شيء تقوم بدور عظيم بوصفها نقطة نهائية للتجارة النهرية في الأزمان الغابرة عندما كان «الشلال» بوجه عام لا يمكن عبوره. وكان لا يمكن تبادل التجارة من هنا جنوبًا أو شمالًا إلا بوساطة طريق البر فقط، ولا نعلم إلى أي حد كانت تفرغ البضائع كذلك هنا خلال الفصل الذي كان يمكن للسفن أن تمر فيه في النهر، كما لا نعلم إذا كانت هناك سفن أخرى تُسْتَعْمَلُ في مياه الشلال خلاف السفن النيلية المعتادة.
ويلحظ أنه في الجنوب عند «سمنة» حيث يكون مرور السفن في النيل أسفل لم تكن الأرض السهلة هناك صالحة بوجه خاص لإقامة ميناء تفريغ؛ ومن أجل ذلك كان على التجار الأهلي الوافد من السودان أن يسير حتى يعبر «إقن» وكان يُفَتَّشُ عليه بعدُ في الجانب الآخر من الشلال على أن تجمُّع هذه الحصون عند الحدود الجنوبية سهلت القيام بمراقبة شديدة، وكذلك كان يمكن مراقبة الأجنبي في السفر من الحدود حتى «إقن». ومما يُؤْسَفُ له أننا لا نعرف موضع «إقن» بصفة مؤكدة وكل ما نعرفه عن موقعها لا يخرج عن التخمين وقد وحَّد الأستاذ «ريزنر» بلدة «إقن» ببلدة «بهين» دون أن يقدِّم لنا البراهين على ذلك.
أما عن مراقبة التجارة بالبر فليس لدينا إلا الحصون المقامة على شاطئ النهر فالأجنبي الوافد يمكن الإعلان عنه في الوقت المناسب في «سمنة» جنوبًا، وذلك أنه كان يخترق عرض الحصن الرئيسي في «سمنة» شارع، وكانت قوافل التجارة على ما يظهر تمر فيه للتفتيش والمراقبة، وكذلك المؤسسة الصغيرة الواقعة غربي «سمنة» كانت مُقامة لأجل الإشراف على القوافل التجارية، أما أجزاء الحصون التي لم تكن ضرورية للدفاع فكان يقوم حُرَّاسُهَا بجر السفن في جهة الشلال وحراسة الأماكن التي تحيط بها الصحراء، فإذا كشفت دوريات الحراسة هجومًا معاديًا من هذه الجهة أعلنوا ذلك للحصون المجاورة ويمكنهم بالتعاون مع هؤلاء صد المغيرين، كما كان في مقدورهم بوساطة جنود الإشارة الاستنجاد بجنود من الحصون الشمالية، ومضمون لوحة «سمنة» يوحي بأن الحصون قد أقيمت أولًا لتكون سدًّا منيعًا عند الحدود في وجه كل من يريد المرور إلى داخل البلاد المصرية بدون إذن، غير أن الكشوف في «كرمة» قد برهنت على أن الفائدة العظمى التي كان يسعى وراءها المصري في السودان هي الفائدة التجارية، ومن أجلها كان لزامًا عليه أن يعمل كل ما في وسعه لتسهيل مرورها في الشلالات دون أي عائق.
ونعرف مما نستنبطه من طبيعة بلاد السودان نوعين مختلفين من طُرُزِ الحصون: النوع الأول الحصون التي كانت تُقام في الوديان، والنوع الآخر كان يُؤَسَّسُ في الجبال. والنوع الأول نجده في بلاد النوبة السفلى حيث كان يُقام الحصن على النهر ففي «فرص» يُلَاحَظُ أن النهر قد غَيَّرَ مجراه، فَبَعُدَ الحصن بعض الشيء عن النهر. ويمكن تفقد التصميم الأصلي لهذا الحصن من وجهتين، إذ يوجد في داخل المبنى على طول امتداده فضاء كبير في داخل الحصن على هيئة مربع وبجانب ذلك ميناء نهرية ليست بعيدة عن النهر ومحمية بالجدران. ومن هذين العنصرين يتألف الحصن على هيئة مستطيل أبعاده طويلة وضلعه الطويل محاذٍ للنهر، ويلاحظ أن أقوى التحصينات يقع في ضلع الحصن المطل على اليابسة؛ وذلك لأن الهجوم من جهة الماء يكون صعب المنال جدًّا، هذا إلى أن المصري كان في استطاعته دائمًا أن يسيطر على النهر بما أوتي من مهارة في قيادة السفن ودراية في فن الملاحة.
وتتجلى التحصينات المبنية التي كانت تُقام من جهة البر في الحصون التي كانت تقع في الوادي بوجه عام. فكان يُقام حول الحصن منحدر حتى لا يجد العدو أي مكان يحتمي فيه في أحجار الأرض عند هجوم مَنْ في الحصن عليه. وفي داخل هذا المنحدر كان يدور حول جدرانه حفر مجففة محفورة في سطح الأرض أو في الصخر. وتدل كسوتها التي كانت تُعمل في الغالب من طين النيل على أنها لم تكن تُملأ بالماء.
وفوق ذلك كان يقام طوار هزيل منخفض ومُقَوًّى بالأبراج الصغيرة وفي داخل هذا المبنى كانت توجد طريق ضيقة وبعد ذلك يأتي الجدار الرئيسي العالي القوي البنيان الذي كان يُحَلَّى غالبا بخارجات تشبه الأبراج وخلف هذه الخارجات يوجد أحيانًا شارع ضيق كان يمكن أن تسير فيه الجنود والمهمات بحماية الجدار الرئيسي.
وكان الغرض من هذا الطوار بلا نزاع هو أن تكون الرماية أكثر أثرًا؛ لأن الرماية من الطوار المنخفض ليست كبيرة المفعول كالرماية من الطوار العالي، وعندما يقرب المهاجمون من الحصن يكونون تحت نيران جنود البرجين أو الطوارين وتبتدئ الزاوية الميتة أو بعبارة أخرى الأرض التي لا يصيبها مرمي الذين يصوبون سهامهم من المبني الرئيسي عند الحفر الواقعة أمام الطوار ويكون في مقدور المدافعين عن الطوار أن ينسحبوا بوساطة باب الحصن عند الحاجة تحت حماية النيران المنطلقة من الجدار الرئيسي. ونجد في الحصون المقامة في منطقة الشلال فقط أن السهل كان هو العامل الفعال في تكييف صورة الحصن ففي مثل هذه الحصون كان على المهاجم أن يتسلق الجدران التي كانت ملغمة بالعقبات، كما كان عليه أن يتغلب على المرتفعات العمودية التي كانت بطبيعة الحال مُقَامَةً هناك.
أما في الحصون الجبلية التي توجد في جهة الشلال فقط فإنه على العكس يكون التل هو العامل الفاصل في تكوين الحصن وفي كيفية إقامته. وكان على المهاجم في هذا الحال لأجل أن يستغل السهل ليصل إلى سفح جدار الحصن أن يتسلق عقبات، كما كان عليه أن يصعد مرتفعات عمودية وإلا فإن الميزة الإستراتيجية للحصن تصبح على العكس لا قيمة لها. ولكن إذا كانت الأحوال تحتم على العدو أن يندفع إلى أعلى فإنه في هذه الحالة يكون في إمكان المهاجمين إيقاد نار لإغاثتهم، ومن أجل ذلك كان من الضروري بناء كل الطنف التي في الحصون المقامة على الهضاب بجدران طويلة ويمكن مشاهدة التصميم الخاص بذلك في بناء حصن «ورنرتي» حيث نجد أن الحصن يتألف من جدار واحد طويل ينقسم متفرعًا عند نقطة فرعين يقع الحصن الرئيسي في حضنهما.
وإذا كانت الأرض التي تقع خارج الحصن عظيمة الانحدار فلا توجد في هذه الحالة ضرورة لإقامة سور خارجي، إذ إن مثل هذا السور يكون ضروريًّا لتكوين زوايا ميتة للرماة في البناء الرئيسي ليكون في مقدور الرماة بما لديهم من أسلحة قديمة تصويب مرماهم بدقة وإحكام على المهاجمين خارج الحصن. ومن أجل ذلك نجد أن معظم حصون «الشلال» قد أقيمت على صخور منحدرة، فليس فيها دائمًا نظام إقامة السور المزدوج. وفي حصن «مرجيس» يوجد على جانبه الواقع تجاه البر جداران متوازيان يبعد أحدهما عن الآخر، وقد بُنِيَ كل منهما بناءً محكمًا. والآن يتساءل الإنسان عما إذا كان هذان الجداران قد بُنِيَا في عهد واحد أو في عصرين مختلفين، والواقع أنه ليس لدينا ما يثبت الرأي الأخير مما لدينا من آثار. ومن المحتمل أنه كان يوجد سور أمامي في «قمة»، ولكن يحتمل أن ما نشاهد في «مرجيس» ليس إلا تقوية للسور الرئيسي.
ومما يلفت النظر في الحصون المقامة في الصحراء كيفية الحصول على الماء، والواقع أنه كان يوجد في الحصن باب خاص يفتح على النهر مباشرة. وكان يوجد هناك ممر سري لا يراه الأعداء يبتدئ عند هذا الباب ويستمر مسافة وكان مُغَطًّى بأحجار مسطحة. ونجد مثل هذا النظام في حصن «سمنة» وفي حصني «ورنرتي» و«كوبان» والحصن الأخير يقع في الوادي ولكنه مبني في الصخر؛ وعلى ذلك لم يكن من المستطاع حفر آبار فيه.
وكان كل حصن مجهَّز بمعبد وقد وُجِدَ فعلًا في هذه الحصون مبانٍ تشبه المعبد في كثير من الأحوال وقد اتضح أنها للعبادة، وذلك بما وجد فيها من آثار تدل على ذلك، كما نشاهد ذلك في حصن «ورنرتي» بصفة قاطعة، إذ وُجِدَ في هذا الحصن بناء يحتوي على ثلاث حجرات صغيرة وردهة تحتوي على أحد عشر نموذجًا من الرغفان المصنوعة من الخشب ومن بينها رغيف نُقِشَ عليه: «السنة الثالثة والثلاثون من عهد «أمنمحات الثالث» ومما يؤسف له كثيرًا أن الحصون الواقعة في السهل في بلاد النوبة قد وُجِدَ داخلها محطمًا، ولذلك لم يكن في مقدورنا معرفة وظيفة المباني الداخلية التي تحتويها تلك الحصون.
وكان يوجد في كل حصن بصفة مستديمة غتر البيوت التي يسكنها الجنود والقواد مخزن غلال وبيت مال، فقد وُجِدَ من بين اللَّبِنَاتِ المختومة التي عُثِرَ عليها في «ورنرتي» لبنات مطبوع عليها المتن التالي: مخزن غلال حصن «خسف أونتيو». و«بروي حز» (بيتا الفضة) الخاصان بحصن «خسف أونتيو» «ورنرتي»، ومن ثَمَّ نعرف أنه كان لكل حصن إدارته الخاصة التي تتصل بمكتب الوزير وبالسلطات المصرية الأخرى مباشرة، هذا ولدينا طابع أختام هذه السلطات عُثِرَ عليه في حصن «ورنرتي» وترجع إلى بداية العصر الذي بل عهد الأسرة الثانية عشرة ولكنها بلا شك كانت متصلة بالأسرة الأخيرة على وجه التأكيد.
وقد وصل إلينا طوابع أختام على لَبِنَاتٍ لموظفين مختلفين ولأشخاص غير موظفين ولكن لا يمكننا أن نحكم على وجه التأكيد بأن هؤلاء كانوا ضمن موظفي الحصن.
ولا نزاع في أنه كان بين هذه الحصون روابط قوية يدل على ذلك تلك الآثار التي عُثِرَ عليها في «ورنرتي» وهي طوابع أختام من حصون أخرى مثل حصون «سمنة» و«شلفك» و«إقن» و«بهين» ولا غرابة في ذلك فإنه كان من الضروري أن تكون هذه الروابط موجودة بين هذه الحصون إذ إن جنودها مصريون، وكان العمل الذي يقوم به كل حصن هو نفس العمل الذي تقوم به الحصون الأخرى ولا يبعد أنها كلها كانت تحت إدارة رئيس أعلى وإدارة واحدة تربط بعضها ببعض.



|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم ورشة تطويرية ودورة قرآنية في النجف والديوانية
|
|
|