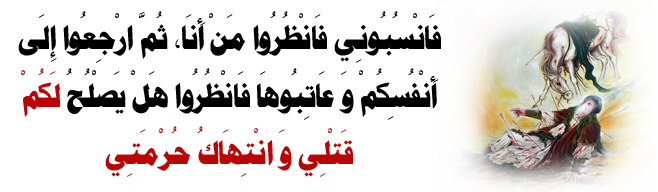
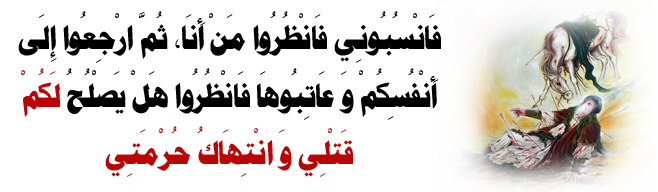

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-02
التاريخ: 17-10-2016
التاريخ: 2023-06-09
التاريخ: 2023-11-12
|
وكان من دعائه (عليه السلام) لولده:
اللَّهُمَّ وَمُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِي (1) وَبِإصْلاَحِهِمْ لِي، وَبِإمْتَاعِي بِهِمْ. (2) إلهِي أمْدُدْ لِي فِي أَعْمَارِهِمْ، وَزِدْ لِي فِي آجَالِهِمْ، وَرَبِّ لِي صَغِيرَهُمْ، وَقَوِّ لِي ضَعِيْفَهُمْ، وَأَصِحَّ لِي أَبْدَانَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَأَخْلاَقَهُمْ، وَعَافِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَفِي جَوَارِحِهِمْ، وَفِي كُلِّ مَا عُنِيْتُ بِهِ (3) مِنْ أَمْرِهِمْ وَأَدْرِرْ (4) لِي وَعَلَى يَدِي أَرْزَاقَهُمْ، وَاجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِيَاءَ بُصَراءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ، وَلأوْلِيَائِكَ مُحِبِّينَ مُنَاصِحِينَ، وَلِجَمِيْعِ أَعْدَآئِكَ مُعَانِدِينَ وَمُبْغِضِينَ، آمِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِي، وَأَقِمْ بِهِمْ أَوَدِيْ، (5) وَكَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِي، وَزَيِّنْ بِهِمْ مَحْضَرِي، وَأَحْييِ بِهِمْ ذِكْرِي، وَاكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي، وَأَعِنِّي بِهِمْ عَلَى حَاجَتِي، وَاجْعَلْهُمْ لِي مُحِبِّينَ، وَعَلَيَّ حَدِبِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لِيْ مُطِيعِينَ غَيْرَ عَاصِينَ وَلاَ عَاقِّينَ وَلا مُخَالِفِينَ وَلاَ خاطِئِينَ، وَأَعِنِّي عَلَى تَرْبِيَتِهِمْ وَتَأدِيْبِهِمْ وَبِرِّهِمْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلاداً ذُكُوراً، وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْراً لي، وَاجْعَلْهُمْ لِي عَوناً عَلَى مَا سَأَلْتُكَ، وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإنَّكَ خَلَقْتَنَا وَأَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا وَرَغّبْتَنَا فِي ثَوَابِ ما أَمَرْتَنَا، وَرَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ، وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَأَجْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائِنَا، لاَ يَغْفُلُ إنْ غَفَلْنَا، وَلاَ يَنْسَى إنْ نَسِينَا، يُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ، وَيَخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ، إنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَة شَجَّعَنَا عَلَيْهَا، وَإنْ هَمَمْنَا بِعَمَل صَالِح ثَبَّطَنَا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَيَنْصِبُ لَنَا بِالشَّبُهَاتِ، إنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَا، وَإنْ مَنَّانا (6) أَخْلَفَنَا، وَإلاّ تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا، وَإلاّ تَقِنَا خَبالَهُ (7) يَسْتَزِلَّنَا (8) اللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ، حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَكَ، فَنُصْبحَ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ بِكَ. أللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي، وَاقْضِ لِي حَوَائِجِي وَلاَ تَمْنَعْنِي الإجَابَةَ، وَقَدْ ضَمِنْتَهَا لِي، وَلا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ، وَقَدْ أَمَرْتَنِي بِهِ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِيْ فِيْ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَمَا نَسِيتُ، أَوْ أَظْهَرتُ أَوْ أَخْفَيْتُ، أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ، وَاجْعَلْنِي فِي جَمِيعِ ذلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي إيَّـاكَ، الْمُنْجِحِينَ بِالـطَّلَبِ إلَيْـكَ، غَيْـرِ الْمَمْنُوعِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، (9) الْمُعَوَّدِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ، الرَّابِحِينَ فِي التِّجَارَةِ عَلَيْـكَ، الْمُجَارِيْنَ (10) بِعِـزِّكَ، الْمُـوَسَّـعِ عَلَيْهِمُ الـرِّزْقُ الْحَـلاَلُ مِنْ فَضْلِكَ، الْوَاسِعِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، الْمُعَزِّينَ مِنَ الذُّلِّ بِكَ، وَالْمُجَارِينَ مِن الظُّلْمِ (11) بِعَدْلِكَ، وَالْمُعَافَيْنَ مِنَ الْبَلاءِ بِرَحْمَتِكَ، وَالْمُغْنَيْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاكَ، وَالْمَعْصومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالزَّلَلِ وَالْخَطَأِ بِتَقْوَاكَ، وَالْمُوَفَّقِينَ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ وَالصَّوَابِ بِطَاعَتِكَ، وَالْمُحَالِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِكَ، التَّـارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ، السَّاكِنِينَ فِي جِوَارِكَ. أللَّهُمَّ أَعْطِنَا جَمِيعَ ذلِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَأَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَأَعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَـاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي، وَلِوُلْدِي فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الآخِرَةِ، إنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، سَمِيعٌ عَلِيمٌ، عَفُوٌّ غَفُـورٌ (12) رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
(1) قوله عليه السلام: ومنّ عليّ ببقاء ولدي جميعاً
بخطّ الشهيد: «وعنّي بجميع ولدي» بالتحريك، وولدي بضمّ الواو وتسكين اللام، وولدي بكسر الواو وتسكين اللام.
في الصحاح: الولد قد يكون واحداً وجمعاً، وكذلك الولد بالضمّ، وقد يكون الولد جمع الولد، والولد بالكسر لغة في الولد (1).
(2) قوله عليه السلام: وبإمتاعي بهم
من أمتعت بالشيء، أي: تمتّعت به، والمتاع كلّ ما ينتفع به، على ما هو المستفيض عند أئمّة اللغة. وحكى المطرّزي في المغرب عن بعضهم جعل الإمتاع متعدّياً، والمتاع مصدر، أو أنّه مصدر أمتعه إمتاعاً ومتاعاً. ثمّ قال: قلت: والظاهر أنّه اسم من متع، كالسلام من سلم. ثمّ لا يبعد على أخذ الإمتاع متعدّياً جعله هاهنا بمعنى التعمير من العمر، والباء في «بهم» بمعنى «مع» أي: وبتعميري معهم كما التمتيع.
وقد يكون معناه التعمير، على ما قاله الهروي وغيره، ومنه في التنزيل الكريم: {يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا} (2) أي: يعمّركم ويعيشكم في أمن ودعة في عيشة واسعة راضية إلى أجل مسمّىً، وكذلك في قوله سبحانه: {قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا} (3) أي: لا تعمرون ولا تبقون في الدنيا إلّا إلى آجالكم.
(3) قوله عليه السلام: في كلّ ما عنيت به
على البناء المجهول، وبضمّ التاء للمتكلّم، من قولهم: هذا الأمر لا يعنيني. أي: لا يشغلني ولا يهمّني، ومنه الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (4) أي: ما لا يهمّه، يقال: عنيت بحاجتك أعني بها فأنا بها معنيّ، أي: اهتممت بها واشتغلت، وكذلك عنيت بها فأنا بها عان، ولكن الأوّل أكثر. وفي رواية «س» التاء مفتوحة للخطاب.
(4) قوله عليه السلام: وأدرر
بالقطع على أنّه من باب الإفعال من الدرّ بالفتح أو الدرّ بالكسر، وبالوصل على أنّه من قولهم الريح تدرّ السحاب وتستدرّه، أي: تستحلبه.
قالين: أي: مبغضين تأكيداً للأوّل، يقال: قلاه يقليه قلى وقلاءً إذا أبغضه.
وقال الجوهري: إذا فتحت مددت، ويقلاه لغة طيّ (5).
أو تاركين تأسيساً، وذلك أولى، وهو من قولهم: جرّب الناس فإنك إذا جرّبتهم قليتهم، أي: تركتهم، لفظ أمر معناه الخبر، أي: من جرّبهم وظهر له بواطن أسرارهم تركهم. ومنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لعلي عليه السّلام: يا علي يهلك فيك اثنان: محبّ غال، ومبغض قالٍ (6) أي: تارك فيكون من تركه عليه السلام في حكم من قد أبغضه، ولا أحبّه إلّا من قد تمسّك به.
(5) قوله عليه السلام: وأقم به أودي
في نسختي «ش» و «كف» بهم. في الأصل وبه «س».
و«أودي» بالتحريك أي: أقم لي بهم أودي، يعني ما أعوج من أمري وقامة المعوج تثقيفه، أي: تقويمه وتسويته.
والأود بالتحريك الاعوجاج، يقال: أود الشيء كفرح أي: أعوج والضمير المفرد لشدّ العضد في «اُشدد بهم عضدي».
(6) قوله عليه السلام: وإنّ منّانا
الاُمنية واحدة الأماني، ومنها يقال: تمنّيت الشيء تمنّياً، ومنيت غيري إيّاه، أي: شهيته إيّاه وجعلته يرجوه ويشتهيه ويتمنّاه ويترقّبه.
(7) قوله عليه السلام: يضلّنا ويستزلنّا
بالنصب على الجزم لجواب الشرط، أو بالرفع على أن يكون الجملة مفسّرة للجواب المحذوف المدلول عليه بالكلام، وهذا أبلغ فإنّ في الحذف فخامة وذهاباً للوهم كلّ مذهب، ويعلم منه أنّه يفعل بهم، إذ ذاك ما لا يدخل تحت الوصف.
فمغزى القوم وتقديره: وإلّا تصرف عنّا كيده تصبنا داهية كبيرة، وهي أنّه تضلّنا على عامّة التقادير وجميع الأحوال، ولا يكون لنا عن ذلك محيص أصلاً.
وهذه القاعدة أعني حذف الجواب لدلالة الكلام عليه طريقة مسلوكة للبلاغة في التنزيل الكريم، متكرّرة جدّاً، منها: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (7) ومنها: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـكِن لَّا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (8).
(8) قوله عليه السلام: وإلّا تقنا خباله
الخبال بفتح المعجمة قبل الموحّدة: الفساد في العقل، والخبل والخبل بالإسكان والتحريك الجنون، والإضافة إلى الضمير العائد الى الشيطان إضافة بتقدير "من" الابتدائية. ومن طريق مصباح المتهجّد ومنهاج الصلاح في مثل هذا الدعاء: إن وعدني كذبني، وإن منّاني قنّطني، وإلّا تصرف عنّي كيده يستنزلّني وإلّا تفلتني (9) من حبائله لصدّني، وإلّا تعصمني منه يفتني. وفي الصحيفة الكريمة حبائله مكان خبله «خ» و «كف» وهي بإهمال الحاء جمع حبالة (10) الصائد.
(9) قوله عليه السلام: غير الممنوعين بالتوكّل عليك
الباء فيه إمّا بمعنى «من» فقد تكون بمعناها على ما نصّ عليه الجوهري وغيره، ومنه قوله سبحانه في التنزيل الكريم {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّـهِ} (11) أي: منها.
وإمّا بمعنى «فى». وإمّا للتسبيب كما في قرينتيها السابقتين، أي: غير الممنوعين عن اُمنياتهم ومبتغياتهم في توكّلهم عليك، أو بسبب توكّلهم عليك.
(10) قوله عليه السلام: المجارين
معاً، أي: على جمع صيغة المفعول، إمّا بكسر الراء من أجاره يجيره فهذا مجير وذاك مجار، إذا خفره وآمنه وأدخله في جواره وأمانه وخفارته.
وبفتحها من جاراه مجاراة فهذا مجار وذاك مجاري، إذا جرى معه وماشاه مماشاة عناية به وكلاءة له ومداحاة ومداراة لضعفه، وترفّقاً وتلطّفاً وتعطّفاً، وقولهم: الدين والرهن يتجاريان مجاراة المبيع والثمن، أي: مجراهما مجراهما وسبيلهما سبيلهما.
والجري بوزن الوصي الوكيل والرسول؛ لأنّه يجري في اُمور موكّله أو يجري مجرى الموكّل، والجمع أجرياء، واستجراه في خدمته استعمله في طريقتها، ومنه سمّيت الجارية؛ لأنّها تستجري في الخدمة، استجريته وجريته: جعلته جرياً أي: وكيلاً أو رسولاً. وفي الحديث: لا يستجرينّكم الشيطان (12) جعله بعضهم استفعالاً من الجري بمعنى الوكيل والرسول، يعني: لا تتولّوا وكالة الشيطان ورسالته.
قال في أساس البلاغة: أي: لا يستتبعنّكم حتّى تكونوا منه بمنزلة الوكلاء مع الموكّل (13).
وحمله آخرون على معنى الأصل، أي: لا يحملنّكم أن تجروا في ائتماره وطاعته.
(11) قوله عليه السلام: والمجارين من الظلم
في الأصل بالراء المكسورة من الإجارة، وفي نسخة «س» بالزاء مفتوحة من المجازاة. وبخطّ «ش» قدّس الله لطيفه بالزاء معاً، على صيغتي المفعول والفاعل. أي: الذين يجازيهم على ما أصابهم من الظلم، وينتصف بهم من ظالمهم (14) عدلك، أو الذين لا يجازون من اعتدى عليهم وظلمهم إلّا بعدلك.
(12) قوله عليه السلام: عفوّ غفور
هما من أبنية المبالغة من العفو والمغفرة، ففريق من اُولي العلم يعتبرون أصل المعنى، فيجعلون العفو أبلغ، إذ أصل العفو المحو والطمس. والغفر والغفران الستر والتغطئة، فالغفور هو الذي يستر ذنوب المذنبين بستره، ويغطّيها بحلمه. والعفوّ هو الذي يطمس المعصي برأفته ويمحو السيّئات برحمته.
وفريق يقولون: العفوّ التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، والغفران تغطئة المعصية بإسبال ستر الرحمة عليها، ثمّ التفضّل على من اقترنها بالبرّ والمثوبة. فالغفور لا محالة أبلغ، ولذلك خصّت المغفرة بالله سبحانه، فلا يقال: غفر السلطان لفلان، ويقال: عفى عنه، ويقال: استغفر الله ولا يقال: استغفر السلطان.
فالله سبحانه عفوّ يتجاوز عن الذنوب بصفحه، ويترك عقاب المذنبين بعفوه، وغفور يستر الآثام، ويعامل الآثمين بالرحمة، كأنّهم لم يقاربوا خطيئة ولم يلمّوا لمماً.
فممّا أوجبته غفوريّته أنّه قد أظهر الجميل وستر القبيح، والمعاصي والآثام من جملة المعائب والمقابح التي أسبل ستره عليها في الدنيا والآخرة، فجعل المسخبثات الجسديّة والمستقبحات البدنيّة مستورة عن أعين الناظرين، مغطّاة بجمال الظاهر، وأكنّ الخواطر المذمومة، والوساوس الملوم عليها في سرّ القلب وفي كنانة الضمير.
ثمّ إنّه يغفر في النشأة الآخرة لمن مات وهو مؤمن من ذنوبه التي يستحقّ بها الفضيحة على ملأ الخلق والعقوبة على رؤوس الأشهاد، ويبدّل بفضله سيّئاته حسنات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الصحاح: 1 / 550.
2. سورة هود: 3.
3. سورة الأحزاب: 16.
4. نهاية ابن الأثير: 3 / 314.
5. الصحاح: 6 / 2467.
6. نهج البلاغة: 558.
7. سورة الفتح: 25.
8. سورة الواقعة: 83 ـ 87.
9. في «ن»: وإلا تعنني.
10. في «ن»: حبائل.
11. سورة الإنسان: 6.
12. نهاية ابن الأثير: 1 / 264.
13. أساس البلاغة: 91.
14. في «ن»: مطالمهم.



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|