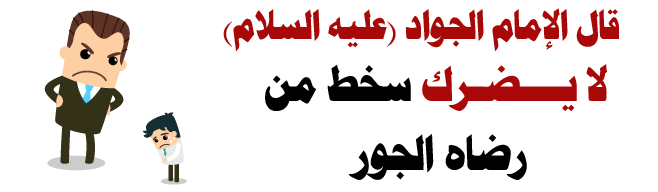
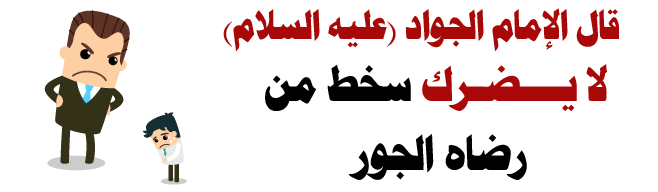

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-28
التاريخ: 2024-07-07
التاريخ: 2024-03-12
التاريخ: 2023-03-27
|
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6]
آية الوضوء:
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) تخصيصهم بالخطاب إمّا لعدم صحّة الوضوء والغسل بل الصّلاة من غيرهم ، أو لعدم إتيان غيرهم بهما ، أو لأنّ هذا بيان للحكم عند تحقق إرادتهم الصّلاة ، فناسب التخصيص بهم ، لأنهم هم المقبلون إلى الامتثال المستأهلون لهذا البيان ، وأيضا فإنّهم استحقّوا ذلك بايمانهم ، فناسب خطابهم به تشريفا لهم وتنشيطا.
(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) أي أردتم الصلاة أو أردتم القيام إليها (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الغسل مفسّر بإجراء الماء ولو بآلة ، وهو المفهوم عرفا ولم يعلم خلافه لغة ، فلا حاجة فيه إلى الدّلك خلافا لمالك ، والوجه العضو المعلوم عرفا ، وحدّ في بعض الأخبار المعتبرة بما دارت عليه الإبهام والوسطى مستديرا (1) وقيل : هذا تحديد عرضا.
وكيف كان طوله من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن ، كلّ ذلك من مستوي الخلقة لكن بعض هذا المحلّ لما كان مسطورا بشعر اللحية غالبا ، صار عرفا أعمّ من البشرة ، وممّا سترها من الشعر وأعطى ما عليها من الشعر حكمها ، كما يقال رأيت وجهه كلّه ولم ير ما تحت الشعر ، وربّما كان ذلك لوقوع المواجهة به وتسميته وجها بهذا الاعتبار (2) فافهم.
(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) المرفق مجتمع طرفي عظمي الذراع والعضد (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) في القاموس الكعب كلّ مفصل للعظام ، والعظم الناشز فوق القدم ، والناشزان من جانبيها ، وظاهره أن الأول أشهر أو أثبت ، ثمّ الثاني وحمل ما في الآية على الأوّل هو الذي ذهب إليه بعض من محقّقي أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين كابن الجنيد والعلّامة ورواه زرارة وبكير ابنا أعين في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (3).
وذهب آخرون إلى حمله على الثاني لروايات عنهم (عليهم السلام) تناسب ذلك مع الثبوت والوضوح لغة ، وانتفاء الثالث بنصّ من الأئمة (عليهم السلام) وإجماع من الأصحاب ، وإنكار ما من بعض أهل اللغة ولهذا قال به بعض من العامّة أيضا.
والأنسب في الجمع بين الروايات عنهم (عليهم السلام) قطعا للخلاف حمل الكلّ على الأوّل ، والعلامة (قدس الله سره) قد صبّ عليه عبارات الأصحاب أيضا ، وجعل اعتقاد خلاف ذلك فيها اشتباها على غير المحصّل ، لكن كلام كثير من الأصحاب في المعنى الثاني أصرح من أن يصح فيه ذلك ، والحكم به مشهور بين الأصحاب حتّى ادّعى الشهيد في الذكرى إجماعنا عليه ، وهو ظاهر جماعة أيضا. نعم الروايات يحتمل ذلك وربّما أمكن الجمع بين الروايات وعبارات الأصحاب بالحمل على أنّه العظم الناتئ على ظهر القدم عند المفصل (4) حيث يدخل تحت عظم الساق بين الظنبوبتين غالبا ، فيتّحد الإشارة إليه وإلى المفصل كما في الرواية عن الباقر (عليه السلام) (5) لكن يخالفه صريح العبارات.
وأما الثالث فقد ذهب إلى حمل ما في الآية عليه جمهور العامة إلّا محمّد بن الحسن ومن تبعه من الحنفيّة وبعض الشافعيّة واستدلّوا بما لو تمّ لدلّ على صحة إطلاقه عليه واحتجّوا أيضا بقول أبى عبيد «الكعب» هو الذي في أصل القدم ينتهى الساق إليه بمنزلة «كعاب القنى» ولا يخفى أن قوله في أصل القدم نصّ في المعنى الثاني ولهذا استدلّ به عليه بعض أصحابنا.
وفي لباب التأويل بعد نقله المسح عن ابن عباس وقتادة وأنس وعكرمة والشعبيّ أنّ الإمامية ومن قال بمسح الرجلين ، قالوا الكعب عبارة عن عظم مستدير على ظهر القدم ، ويدلّ على بطلان هذا أن الكعب لو كان ما ذكروه لكان في كلّ رجل كعب واحد فكان ينبغي أن يقول «إلى الكعاب» كما قال (إِلَى الْمَرافِقِ).
وفيه أنه كما صحّ جمع المرفق بالنظر إلى أيدي المكلّفين وتثنية الكعب بالنظر إلى كلّ رجل على تقدير صحّة إطلاق الكعب على الظنبوبتين وإرادتهما كما ذكرتم كذلك يصحّ الجمع في الكعب بالنظر إلى أرجلهم والتثنية بالنظر إلى رجلي كلّ شخص والإفراد بالنظر إلى كلّ رجل على ما قلنا ، وكذلك في المرافق ولا يمنع وقوع شيء منها في أحد الموضعين وقوع شيء آخر منها في الموضع الآخر ولا يعيّنه فيه.
على أنّ ما ذكره قياس لو قلنا به فليس هذا من مجاريه كيف والتفنّن أفيد وأبلغ ، ومعدود من المزايا ، على أنّ القياس في هذا المقام على ما ذهبتم في الكعب يقتضي خلاف ذلك ، فان لكل شخص حينئذ أربع كعاب فيكون على ضعف المرافق فكان أولى بأن يجمع ولو أريد التفنّن حينئذ لكان الأوّل عكس ما وقع فافهم ، وأيضا فإنّ قياسهم بأنّ ضرب الغاية للأرجل يدلّ على أنها مغسولة كالأيدي يقتضي لا أقل أن يكون الغايتان على وجه واحد ليتّحد الحكمان ، فالاختلاف يبطل قياسهم مع بطلانه في نفسه ، بل يقال حينئذ الاختلاف في الغاية دليل المخالفة في الحكم ، فيقتضي نقيض المطلوب على أنا نقول التثنية بعد الجمع ينبه على التخفيف ، وهو المناسب للتخفيف من الغسل إلى المسح كما قلنا.
ثمّ إذا ثبت المسح بالدلائل القطعيّة كما يأتي يعيّن خلاف ذلك في الكعب إذ لم يقل به أحد ممّن قال بالمسح كما هو صريح كلام المخالف والمؤالف.
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) إنّما لم يقل «إذا» لئلا يتوهّم العطف على (إِذا قُمْتُمْ)، بل على ما اعتبر هناك من كونهم محدثين ، كأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا كما ينبّه عليه قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) إلخ، كما سيتّضح ، وفيه دلالة على أنّ الوضوء إن لم يكونوا جنبا ، وفيه تنبيه على أن لا وضوء مع غسل الجنابة كما دلّت عليه رواياتنا ، وإنّما لم يذكر موجب الوضوء صريحا كموجب الغسل لأنّ المؤمنين في ابتداء تكليفهم بالوضوء كان حدثهم يقينا دون الجنابة ، فكأنه قيل إذا قمتم على ما أنتم عليه ، وأيضا في قوله (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) تنبيه على هذا ، ولما كان هذا المقدار كافيا في حسن هذا الخطاب ، ترك الباقي إلى البيان النبوي.
وأما الإشارة إلى موجبات الغسل جميعا كتركها كلا ، فربما نافى الإيجاز والاعجاز فوكّل على البيان ، على أنه لا يبعد أن لا يكون غيرها يوجب الغسل بعد.
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) فيشقّ عليكم الوضوء أو الغسل لمرض أبدانكم أو خلل أحوالكم وإن وجدتم الماء.
(أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) وإن لم تكونوا مرضى أو على سفر فإنه لا مانع للجمع.
ولئلا يتوهم اختصاص الغسل بوقوع التيمم بدلا منه مع العذر لوقوعه بعده جاء بذكر موجب ظاهر مناسب كثير الوقوع لكلّ من الوضوء والغسل.
وفي وقوع (لامَسْتُمُ النِّساءَ) في موقع (كُنْتُمْ جُنُباً) مع التفنّن والخروج عن ركاكة التكرار تنبيه على أنّ الأمر هنا ليس مبنيا على استيفاء الموجب في ظاهر اللفظ ، فلا يتوهّم أيضا حصر موجب الوضوء في المجيء من الغائط مع احتمال إرادة الباقي استتباعا، وعلى كلّ حال فيه تنبيه على أنّ كونهم محدثين ملحوظ في إيجاب الوضوء كما قدّمنا.
(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره بالنقل عن فضلاء اللغة ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأعرابيّ ونقله في الكشاف عن الزجاج ولم يذكر خلافه ، ويؤيده قوله تعالى (صَعِيداً زَلَقاً) أي أرضا ملساء مزلقة ، وقوله (عليه السلام) يحشر الناس يوم القيامة عراة على صعيد واحد (6) أي أرض واحدة وقوله (عليه السلام) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (7) ونحو ذلك كثير في الروايات عن الأئمة أيضا وحجة الخصم لا تفيد إلّا كون التراب صعيدا ولا منافاة ولو سلم ظاهرا فليكن للقدر المشترك حذرا من الاشتراك فافهم.
(طَيِّباً) طاهرا بل مباحا أيضا.
(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي من ذلك التيمّم أو من ذلك الصعيد المتيمّم أي مبتدئين منه ، ولعلّ التبعيض هنا ليس بلازم ، وإن كان لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلّا معنى التبعيض كما قاله في الكشاف ، فان ذلك قد يكون للغرض المعروف عندهم من التدهين والتنظيف ونحو ذلك مع إمكان المنع عند الإطلاق في قوله من التراب على أنه يمكن أن يقال أنّ «من» في الأمثلة كلها للابتداء كما هو الأصل فيها ، وأما التبعيض فإنّما جاء من لزوم تعلّق شيء من الدهن والماء باليد ، فيقع المسح به ، ونحوه التراب إن فهم ، فلا يلزم مثله في الصعيد الأعمّ من التراب والصخر.
ويؤيّده ما روى أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) نفض يديه من التراب ، لأنه تعريض لإزالته وهو عندنا في الصحيح عن الأئمة (عليهم السلام) فعلا وقولا ، وأيضا لو كان «من» هنا للتبعيض لأوهم أنّ المراد أن يؤخذ بعض الصعيد ويمسح به بعض الوجه والأيدي وهو ليس بمراد قطعا ، وإذا كان للابتداء دلّ على أنّ المراد مسح الوجه واليدين بعد مسح الصعيد أو تيممه وليس بعيدا من المراد ، وموهما خلافه.
(ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ) أي أن يجعل ، فاللام زائدة (عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) في باب الطهارة حتّى لا يرخّص في التيمم (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء كما في الكشاف ، أو أن يجعل عليكم من حرج في الدين أصلا خصوصا في باب الطهارة ، ولذلك لم يوجب على المحدث الغسل ، واكتفى عند عدم وجدان الماء من غير حرج أو حصول حرج في استعماله بالتيمم ولم يوجب فيه إيصال الصعيد إلى جميع البدن ، ولا إلى جميع أعضاء الوضوء ، ولا جميع أعضاء التيمّم ، ولكن يريد أن يطهّركم من الذنوب أو من الأحداث ، أو منهما ، أو وغيرهما بما يليق بكم ، ولا يضيق عليكم ، كما أمركم على الوجه المذكور.
قال القاضي (8) أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمّم تضييقا عليكم ، ولكن يريد ذلك لينظّفكم أو يطهّركم من الذنوب ، فان الوضوء تكفير للذنوب ، أو ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهّر بالماء ، فمفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعلّة ، قال : وقيل مزيدة أي اللّام وهو ضعيف ، لأنّ أن لا يقدّر بعد المزيدة وهو سهو منه ، فإنّه قال (9) في تفسير قوله (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) أنّ يبيّن مفعول يريد ، واللام مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة ، وهو تناقض.
وقال المحقق الرضى (قدس الله سره) : إن اللام زائدة في لا أبا لك عند سيبويه (10) وكذا اللام المقدّر بعدها «أن» بعد فعل الأمر والإرادة كقوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).
و(لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) أي ليتمّ بشرعه ما هو مطهّر لأبدانكم أو مكفّر لذنوبكم نعمته عليكم في الدين ، أو ليتمّ برخصه إنعامه عليكم بعزائمه ، وربما كان في هذا تنبيه على أن الصلاة بلا طهارة غير تامة ، فربما احتمل أن يراد بالنعمة الصلاة أو شرعها.
(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (11) نعمته أو إتمام النعمة أو هما بالعمل بما شرع لكم ، فيثيبكم ويزيدكم من فضله ، وفيه كما قيل إيماء إلى كون العبادات تقع شكرا وهو قول البلخيّ وتحقيقه في الكلام.
هذا ولنعد إلى ما بقي من الأبحاث والتنبيه على الأحكام.
فاعلم أنّ ظاهر الأمر الوجوب ، وإذا تفيد العموم عرفا ، فقد يلزم وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، لكن الحقّ أنه هنا مقيّد بالمحدثين ، لما قدّمنا ، وللإجماع والاخبار ، وقيل : كان الوضوء واجبا لكلّ صلاة أوّل ما فرض ، ثمّ نسخ وهو مع ما ضعّف به من أنّه لا يظهر له ناسخ وإطباق الجمهور على أنّ المائدة ثابتة لا نسخ فيها ، وما روي عنه (عليه السلام): «إنّ المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها» يدفعه (12) اعتبار الحدث في التيمم في الآية ، فإنّه لا يكون إلّا مع اعتباره في الوضوء كما لا يخفى.
وقيل للندب مستشهدا بما روي في استحباب الوضوء لكلّ صلاة من فعله (عليه السلام) وغيره ، ويدفعه مع ما تقدّم من اعتبار الحدث في التيمّم في الآية قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) إذ لا مجال للندب فيه مع أنّ الظاهر اتحاد الأمرين في الوجوب أو الندب ، وأيضا الوضوء على المحدثين للصلاة واجب فكيف يصحّ الندب مطلقا ولو أريد بالصلاة مطلقها فاستحباب الوضوء لكلّ صلاة سنّة أو مستحبّة للمتوضّئ غير واضح ، وكأنّ الباعث على هذين القولين الفرار من محذور العموم ، وقد عرفت أنّ التقيد بالمحدثين أوضح.
وما يقال من حمل الأمر على ما يعمّ الوجوب والندب من الرجحان المطلق (13) ويكون الندب بالنسبة إلى المتوضّئين والوجوب بالنسبة إلى المحدثين ، فيقال : إن قصد ذلك بالأمر فلا ريب أنه استعمال له في معنيي الوجوب والندب ، وهذا وإن كان مجازا جائزا مع البيان النبويّ ، لكن بدون قرينة في الكلام بعيد جدا ، وإن لم يقصد به ذلك فلا يكون المنع من الترك مطلوبا به ، وهو مع كونه خلاف الظاهر من كون الأمر للوجوب لا يناسب حمل بقية الأوامر على الوجوب ، كما لا يخفى.
وينافي سياق الآية ، فإنّ الظاهر كما يدلّ عليه عجز الآية أنّه مسوق لأمر عظيم ولذلك لم يذكر فيها إلّا ما هو واجب في الوضوء ، وبالجملة لا ريب في كون الأمر هنا للوجوب ، وأنّه مخصوص بالمحدثين ففي الآية دلالة على وجوب الوضوء بل الطهارة مطلقا للصلاة ، وأنّه شرط فيها ، لأنه مأمور بالطهارة قبل الصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، وقد يفهمه العرف أيضا فكأنّه قال لا تصلّوا إلّا بطهارة.
فإن قلنا : الصلاة على إطلاقها فيلزم من أشراطها فيها استحبابها للمستحبّة منها ، ووجوبها للواجبة منها ، ولكن لمّا كان الأمر مشروطا بإرادة منتهية إلى فعل الصلاة مع كونه للوجوب ، وجب أن يجب للصلاة عند ذلك ، فيجب للصلاة الواجبة لهذا وللاشتراط ، وللصلاة المندوبة أيضا كما قيل عند ذلك ، فيعاقب على تركه أيضا يعاقب على فعلها بمقتضى الاشتراط ، وإنّما يستحبّ لها قبل ذلك فتأمل.
وقد يستدلّ بالاشتراط على وجوب قصد إيقاعه للصلاة مستشهدا بالعرف ، وفيه نظر ، ثمّ فيها دلالة على وجوب أمور في الوضوء:
الف ـ غسل الوجه ، وأنّه أوّل أفعال الوضوء ، فلا يجوز تأخير النيّة عنه ، ولا تقديمها مع عدم بقائها عنده إلّا بدليل ، ولا يدلّ على تعيين مبدء ولا على ترتيب بين أجزاء الوجه ، نعم نقل أنّ فعلهم (عليهم السلام) كان من الأعلى إلى الأسفل (14) وهو المأنوس يسرا وعادة ، فهو الاحتياط ، لكن يكتفى بما يصدق ذلك معه عرفا ، ولا على وجوب المسّ باليد ولا الدلك ، ولا على وجوب التخليل بعد غسل الظاهر من البشرة ، أو الوجه مطلقا خفيفة كانت اللحية أو كثيفة كما دلّت عليه روايات صحيحة ، ولا على التكرار ، ولا عدمه بل حكمه ثانيا وثالثا معلوم من الاخبار.
ويدلّ على تعيين الماء للغسل للعرف ، ويكشف عنه قوله (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) ويجب ان يكون مباحا ، فان استعمال غيره غصب ، وهو منهيّ يستلزم الفساد في العبادة على أنّ الشيء الواحد عندنا لا يكون منهيّا مأمورا به كما تقرّر في الأصول.
ب ـ غسل الأيدي فالظاهر وجوب غسل اليد الزائدة ، سواء فوق المرفق أو تحته وإن تميّزت عن الأصليّة لتسميتها يدا وما لم يسمّ يدا يغسل ما كان منه تحت المرفق أو فيه على ما يأتي ، و «إلى» ههنا إمّا بمعنى «مع» فيجب غسل المرفق كما هو المشهور ، أو لانتهاء غاية المغسول لا الغسل على موضوعها اللغوي ، فإنّ إجماع الأمة على جواز الابتداء من المرفق ، فقيل إنّها تفيد الغاية مطلقا ، ودخولها في الحكم أو خروجها منه لا دلالة لها عليه ، وإنّما ذلك بدليل من خارج ، فلما كانت الأيدي متناولة لها ، حكم بدخولها احتياطا.
وقيل إلى من حيث أنها تفيد الغاية تقتضي خروجها ، وإلّا لم يكن غاية كقوله (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) لكن لمّا لم تتميّز الغاية هاهنا عن ذي الغاية ، وجب إدخالها احتياطا.
وقيل إنّ الحدّ إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل كما في الأمثلة المتقدمة وإذا كان من جنس المحدود دخل فيه كما في الآية ، وإذ لم يؤخذ في القيل الأوّل كون الأيدي متناولة لها كما في الكشاف ، كان وجها رابعا أو ثالثا (15).
ثمّ إن قلنا إنّها بمعنى «مع» أو أنّ الغاية داخلة لا من باب المقدّمة ، وجب إدخال ما يتوقف عليه غسل جميع المرفق من باب المقدّمة كما لا يخفى ، ثمّ لو لم يكن هناك مرفق واحتمل اعتبار ما لو كان له مرفق ، لكان الظاهر غسله ، واعتبار ما لو كان كذلك لكان غسله تعينا أو أنه لا يزيد عليه تعيّنا ولو إلى العضد إن كان ، أو من غير اعتبار أنه لا يزيد عليه تعيّنا لأنّه أمر بغسل اليد ، ولم يوجد له ما يخرج شيئا من يده من الحكم ، فيبقى داخلا تحت الحكم.
ويكفي في الغسل مسمّاه كما في الوجه ، ويجب تخليل الخاتم ونحوه والشعر أيضا ، وإن كثف ظاهرا ، ولا يدلّ على ترتيب بين اليدين وهو ظاهر ، وأما بالنسبة إلى الوجه فيمكن أن يفهم من الفاء ، لأنّها للتعقيب بلا فصل.
فان قيل عطف بقيّة الأعضاء على مدخول الفاء يدلّ على فعل المجموع بعد القيام ، فكأنه قيل إذا قمتم إلى الصلاة فتوضّؤا ، قلنا : بل عطف كلّ منها على مدخول الفاء يفيد التعقيب لكلّ منها ، فلما لم يكن ذلك مطلوبا شرعا ولا معلوما عرفا أكثر من الترتيب الذكري ، روعي فيه ذلك ، ويؤيده الأمر في الأخبار بمراعاة ترتيب القرآن (16) ومنه يستفاد الموالاة أيضا.
وما يقال عليه من أنّ المراد مجرّد التعقيب بلا مهلة ، وعلى تقدير ذلك فلا يفهم إلّا غسل الوجه بلا مهلة ، فمحلّ نظر.
ج ـ مسح الرأس بمسمّاه مطلقا مقبلا أو مدبرا ، قليلا أو كثيرا ، كيف كان ، نعم إجماع الأصحاب على ما نقل وفعلهم (عليهم السلام) بيانا وغير بيان خصّصه بمقدّم الرأس ببقيّة البلل لا بالماء الجديد اختيارا ، وجوّزه بعض نادر (17) لروايتين صحيحتين (18) دلّتا على عدم جواز المسح بفضلة الوضوء من الندى ، بل بالماء الجديد ، وحملتا على التقيّة لذلك ، وعلى الاضطرار ، وذهب بعض إلى وجوب مسح مقدار ثلاث أصابع ، ولا دليل عليه إلّا مفهوم بعض الاخبار ، وعموم الآية والاخبار بل خصوص كثير منها ينفيه.
د ـ مسح الرّجلين إلى الكعبين بالمسمّى كالرأس ، وهو صريح القرآن ، فإنّ قراءة الجرّ نصّ في ذلك ، لانّه عطف على (بِرُؤُسِكُمْ) لا محتمل غيره ، وهو ظاهر ، وجرّ الجوار مع ضعفه ربما يكون في الشعر لضرورته مع عدم العطف ، وأمن اللبس ، أما في غيره خصوصا مع حرف العطف والاشتباه ، بل صراحته في غيره ، فلا نحمل القرآن العزيز عليه ، مع ذلك كلّه خطأ عظيم ، ولذلك لم يذكره في الكشّاف ، ولا احتمالا لكن ذكر ما هو مثله بل أبعد وهو أنّه لما كان غسلها بصبّ الماء كان مظنّة للإسراف فعطفت على الرؤس الممسوحة لا لتمسح بل لينبّه على ترك الإسراف وقال (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قرينة على ذلك إذا لمسح لم يضرب له غاية في الشريعة.
ولا يخفى أنّ بناء هذا وسياقه على أنّ وجوب غسل الرجلين في الوضوء وكونه مرادا من الآية معلوم شرعا لا يحتمل سواه وكيف يجوز ذلك مع إطباق أهل البيت (عليهم السلام) وإجماع شيعتهم الإماميّة وجميع كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم منهم أيضا والاخبار الكثيرة المتواترة خصوصا من طرق أهل البيت (عليهم السلام) على المسح وأنّه المراد بالاية مع صراحتها فيه والاخبار من طرقهم على الغسل غير بالغ حدّ التواتر ولا تفيد علما مع عدم المعارض فكيف في هذا المقام.
ثمّ إنّه لا يتم نكتة بعد الوقوع أيضا ، فان إرادة الغسل المشابه للمسح ينافيها استحباب غسلها ثلاثا وكونها سنّة كما هو مذهبهم ، وأيضا لم يثبت إطلاق المسح بمعنى الغسل الخفيف ، وأما قول العرب تمسّحت للصلاة أو أتمسّح بمعنى الوضوء ، فان صحّ فهو إطلاق لاسم الجزء على الكلّ فإنّه إمّا مسح أو ما يشتمل عليه عادة ، فلم يطلق على خصوص الغسل الخفيف ، ثمّ لو صحّ فلا يصحّ في الآية ، فإنّه على هذا التوجيه مقابل للغسل الخفيف ، فان الإسراف في ماء الوضوء ممنوع مطلقا.
ثمّ لا ريب أنّ إرادة غسل مثل غسل الوجه واليدين على وجه لا إسراف فيه مع ذلك إلغاز وتعمية غير جائز في القرآن سيّما مع عدم القرينة على شيء من ذلك لا صارفة ولا معيّنة ولا علاقة مصحّحة ، أما قوله (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فالحقّ أنّه يقتضي خلاف ما ذكره ، لتكون الفقرتان على أبلغ النظم وأحسن النسق من التقابل والتعادل لفظا ومعنى ، كما هو المنقول عن أهل البيت (19) (عليهم السلام) فأين هذا من التنبيه على ما قال.
ثمّ لا يخفى أنّ المراد لو كان هذا المعنى ، لنقل عنه (عليه السلام) بيانا لكونه ممّا يعمّ به ، ولا استدلّ به على عدم الإسراف ، وليس شيء من ذلك ، بل هذا توجيه لم يذكره الصدر الأوّل ولا الثاني ، ولم ينقل عنهم ، وأيضا فإنّ هذا إنّما يتصوّر بأن يراد بقوله (وَامْسَحُوا) حقيقة المسح بالنسبة إلى الرؤس ، ومثل هذا المجاز بالنسبة إلى الأرجل ، ولا ريب أنه أبعد من إرادة معنيي الوجوب والندب في الأمر ، وقد قال في اغسلوا أنه إلغاز وتعمية فليتأمل.
وأما قراءة النصب (20) فلأنّه معطوف على محلّ (بِرُؤُسِكُمْ) ومثله معروف شائع كثير في القرآن وغيره ، وعطفه على وجوهكم مع تماميّة ما تقدّم وانقطاع هذا عنه بالفصل بقوله (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) والعدول عن العامل والمعطوف عليه القريبين إلى البعيدين في جملة أخرى بعيد جدّا غير معروف ولا مجوّز ، سيّما مع عدم المقتضي كما هنا.
ثمّ ظاهر الآية عدم الترتيب بينهما ، كما عليه أكثر الأصحاب ، ويؤيّده الأصل.
تنبيه : الظاهر أنّه لا يشترط في المسح عدم تحقّق أقلّ الغسل معه أي جريان الماء في إمرار اليد لصدق الاسم المذكور في الكتاب والسنّة والإجماع حينئذ لغة وعرفا وللزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان شرطا ، إذ لم يبين ، ولأنه تكليف شاقّ منفيّ خصوصا هنا ، فإيجابه بعيد ، نعم هو أحوط وقد تكون المقابلة باعتبار النيّة أو باعتبار غالب الأفراد.
وقوله (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) في حيّز (إِذا قُمْتُمْ) كما عرفت ، ونقيضه ما بعده ، فلا يلزم وجوب غسل الجنابة لنفسه ، بل هو كباقي الطهارات للصلاة ونحوها كما هو الظاهر ، ونقيضه بعض الأخبار وظاهر السياق كما قدّمنا.
وتبيّن في السنّة أنّ المراد بالمرض ما يستلزم الوضوء أو الغسل معه حرجا وعسرا في الحال أو المآل وكذلك السفر ، لكن قد يتحقّق مثل أعذار السفر في الحضر ويوجب التيمّم كما هو مبيّن في السنّة وينبّه عليه عجز الآية ، فلا يبعد دخوله تحت قوله (أَوْ عَلى سَفَرٍ) على أنّ المراد به مطلق الأحوال الّتي يشقّ معها الوضوء والغسل غير المرض ، وعدم وجدان الماء ، ولو على طريق الاستتباع منبّها على ذلك بعجز الآية معتمدا على البيان النبوّي ، مع احتمال كون غير السفر معلوما حكمه عن محض السنّة أو العجز.
وقريب من ذلك الأمر في (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) فإنّه يحتمل أن يكون المراد مطلق الحدث الأصغر ومطلق الجنابة بقرينة ما تقدّم كما نبّهنا ـ وأن يكون الغائط أو ما يخرج من السبيلين من البول والغائط بل الريح ومجامعة النساء كما قاله كثير من المفسّرين فتأمّل.
فيدلّ على أنّ الغائط أو البول بل الريح أيضا أحداث موجبة للوضوء والتيمّم وكون الجماع حدثا أكبر موجبا للغسل والتيمّم ، وعدم اشتراط حصول المني في الجنابة فيكفي غيبوبة الحشفة لصدق الملامسة.
__________________
(1) انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 38 وص 39.
(2) قال في المقاييس ج 6 ص 88 : الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة شيء لشيء والوجه مستقبل لكل شيء يقال وجه الرجل وغيره.
(3) إشارة الى الحديث المروي في التهذيب ج 1 ص 76 الرقم 191 عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى ان قالا قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق ومثله في الكافي ج 1 ص 9 باب صفة الوضوء وفيه زيادة : والكعب أسفل من ذلك وهو في المرآت ج 3 ص 15 ومثله في العياشي ج 1 ص 298 الرقم 51.
وترى الحديث في الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 3 ج 1 ص 51 ط الأميري وفي ط الإسلامية ج 1 ص 272 المسلسل 1022 وفي جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 101 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 43 والبحار ج 18 ص 65 والبرهان ج 1 ص 452 الحديث 15 والحديث في الكافي أبسط.
قال في المنتقى بعد نقله حديث الكافي في ص 118 ج 1 مع جعل رمز الحسن عليه وحديث التهذيب في ص 127 منه مع جعل رمز الصحة عليه : قلت قد مر هذا الحديث برواية الكليني من طريق حسن تام المتن والشيخ اقتصر منه على حكم المسح لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض وظاهر الحال انه كان تاما في رواية الحسين بن سعيد أيضا فليت الشيخ أبقاه بحاله لنورده هنالك في الصحيح لكنه رحمه الله كان في غنية عن الاهتمام بهذا وأمثاله لكثرة وجود كتب السلف وأصولهم وتيسر الرجوع إليها وقت الحاجة ولم يخطر بباله أن أمر الحديث يتلاشى والحال يترامى الى ان تندرس أعيان تلك الكتب عن آخرها ويكاد ان يتعدى الاندراس عن عينها إلى أثرها.
|
فكأنها برق تألق بالحمى |
|
ثم انثنى فكأنه لم يلمع |
انتهى ما في المنتقى.
وانما جعل حديث الكافي من الحسن لما في سنده إبراهيم بن هاشم ونحن قد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 128 صحة الحديث الذي هو في سنده فراجع.
(4) ولعله الأصوب انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 18 ومسالك الافهام ج 1 ص 58
(5) إشارة إلى الرواية المروية في التهذيب ج 1 ص 57 الرقم 190 عن ميسر عن ابى جعفر الى ان قال ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب وأومأ بيده الى أسفل العرقوب ثم قال هذا هو الظنبوب وهو في الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء. الحديث 9 وفي ط الإسلامية ج 1 ص 275 المسلسل 1028 وروى مثلها العياشي عن عبد الله بن سليمان عن ابى جعفر ج 1 ص 300 الرقم 56 والعرقوب على ما في اللسان العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان والظنبوب حرف الساق اليابس من قدم الإنسان وقيل الساق وقيل هو عظمه.
(6) لم أظفر على الحديث باللفظ الذي حكاه المصنف إلا في الحدائق ج 4 ص 245 وقريب منه في معالم الزلفى ص 145 الباب 22 في صفة المحشر نعم حديث الجمع في صعيد واحد رواه في البحار ج 3 ص 281 و 241 و 256 ط كمپانى عن أمالي الصدوق وأمالي الشيخ وكتابي الحسين بن سعيد ورواه من أهل السنة الهيثمي في مجمع الزوائد ج 10 ص 355 عن الطبراني في الأوسط : وحديث حشر الناس عراة حفاة مروي في تفسير المجمع ونور الثقلين والصافي عند تفسير الآية 103 من سورة الأنبياء كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وتفسير الآية 37 من سورة عبس وفي كتب أهل السنة في تفسير الدر المنثور وتفسير الخازن وابن كثير عند تفسير الآيتين المذكورتين وفي بعضها بزيادة غرلا أو غلفا وكلاهما بمعنى غير المختون جمع الأغرل والأغلف ولعل المصنف وصاحب الحدائق ومعالم الزلفى نقلوا الحديث بالمعنى ملفقا من الحديثين.
(7) انظر الفقيه ج 1 ص 155 الحديث بالرقم 724 والخصال ط مكتبة الصدوق ص 292 باب الخمسة الرقم 56 والجامع الصغير الرقم 1174 ج 1 ص 566 فيض القدير وانظر أيضا جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 219 و 220 وتعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 58.
(8) انظر البيضاوي ج 2 ص 139 ط مصطفى محمد.
(9) انظر البيضاوي ج 2 ص 80 واختلفوا في اللام في مثل هذه الموارد على ثلاثة أقوال الأول أنه قد تقام اللام مقام ان في أردت وأمرت فيقال أردت أن تذهب وأمرتك أن تقوم وأردت لتذهب وأمرتك لتقوم قال الله تعالى يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا وقال وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ وأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ يريد أمرنا أن نسلم وأمرت أن أعدل وقال الشاعر.
|
أمرت لانسى ذكرها فكأنما |
|
تمثل لي ليلى بكل سبيل |
الثاني ان في الآية وأمثالها إضمارا ومفعول يريد محذوف والتقدير يريد إنزال هذه الآيات ليبين لكم وهكذا.
الثالث ان اللام زائدة مؤكدة لمعنى مدخولها أو مؤكدة لمعنى الاستقبال في مدخولها انظر في ذلك التفاسير تفسير الآية 26 من سورة النساء والكامل للمبرد ج 3 ص 823 ط مطبعة الحلبي والمغني حرف اللام والاشمونى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج 3 ص 239 وشرح الرضى على الكافية ج 2 ص 329.
(10) لا أبا لك كلمة تستعملها العرب كثيرا في النثر والشعر قال الشاعر :
|
فمن لم يكن في بيته قهرمانة |
|
فذلك بيت لا أبا لك ضائع |
وأمثلتها كثيرة ؛ راجع المصادر التي نسردها بعيد ذلك ، فخرجت تلك الكلمة مخرج المثل ولذلك تقال لكل أحد من ذكر وأنثى أو اثنين أو جماعة وتقال لمن له أب ولمن ليس له أب ، ويراد بهذه الكلمة المدح في الأكثر معناه لا كافي لك غير نفسك وقد تذكر بمعنى جد في أمرك وشمر ، لان من له أب أتكل عليه في بعض شأنه وعاونه أبوه ومن ليس له أب جد في الأمر جد من ليس له معاون.
وقد يطلق الكلمة في الاستعمال موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من فعل أو قول ومثله لا أخا لك أى ليس لك من يكفيك ويعين عليك.
وأما كلمة لا أم لك فتستعمل في مقام الذم وهي شتم. اى ليس لك أم حرة أو أنت لقيط لا يعرف لك أم ، ويستعمل لا بك بحذف الهمزة ، ولا أباك ولا أبك ولا أب لك وفي اللسان ، وقال الفراء قولهم لا أبا لك كلمة تفصل بها العرب كلامها.
قال المحقق السيد على المدني في الحدائق الندية بحث أحكام المضاف ص 105 ط 1274 ما يعجبنا نقله بعين عبارته.
فائدة في نحو لا أبا لك ثلاثة مذاهب : أحدها أن أبا مضاف الى ما بعد اللام ، والخبر محذوف ، واللام زائدة بين المتضايفين ، تحسينا للفظ ، ورفعا لوقوع اسم لا معرفة في الظاهر والدليل على زيادتها أنها قد جاءت في قوله :
|
أبالموت الذي لا بد أنى |
|
ملاق لا أباك تخوفيني |
وهذا مذهب سيبويه والجمهور.
الثاني ان اللام غير زائدة ، وأنها وما بعدها صفة لما قبلها ، فتتعلق بكون محذوف ، وأنهم نزلوا الموصوفة منزلة المضاف لطوله ، بصفته ومشاركته للمضاف في أصل معناه ، إذ معنى أبوك وأب لك واحد ، وهذا مذهب هشام وكيسان وابن الحاجب وابن مالك.
الثالث أن الاسم مفرد وجاء على لغة القصر كقولهم «مكره أخاك لا بطل» واللام وما بعدها الخبر ، وهو مذهب الفارسي وابن يسعون وابن الطراوة انتهى ما أردنا نقله.
انظر البحث في ذلك الكتاب ج 1 ص 315 وص 345 والمغني حرف اللام والكامل للمبرد ج 4 ص 951 والاشمونى بحاشية الصبان ج 2 ص 215 واللسان والتاج ومعيار اللغة كلمة (ا ب و ـ ى) والحدائق الندية بحث الإضافة وفتح الباري ج 15 ص 336 وشرح النووي على صحيح مسلم ج 2 ص 174 وشرح الزرقاني على موطإ مالك ج 4 ص 431 والخصائص لابن جنى ج 1 من ص 342 الى ص 346.
(11) لعل وعسى موضوعان للترجى في المحبوب ، وهو الطمع في حصول أمر محبوب والإشفاق للمكروه ، وهو توقع أمر مخوف ممكن اما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ، وكون المعنى ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله حتى يدخل فيه الطمع والإشفاق ، ولما كان اعتوار المعاني على الله سبحانه محالا وكون الترجي والإشفاق فيمن يجهل العاقبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، استصعب الأمر في الكلمتين المستعملتين في القرآن فمنهم من صرف الترجي والإشفاق الى المخاطبين ، ومنهم من قال ان لعل وعسى من الله واجبة ، وقيل في لعل انها للتعليل.
والذي يحق أن يقال هو أنهما لإنشاء أمر متردد بين الوقوع وعدمه على رجحان الأول اما محبوب فيسمى رجاء واما مكروه فيسمى إشفاقا ، وذلك قد يعتبر تحققه بالفعل ، اما من جهة المتكلم أو المخاطب ، تنزيلا له منزلة المتكلم في التلبس التام بالكلام الجاري بينهما أو غيرهما كما قيل في قوله تعالى (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ) وقد يعتبر تحققه بالقوة إيذانا بأن ذلك مئنة للتوقع متصفة بصلاحيته للوقوع ، وأنه في معرض التوقع في حد ذاته من غير أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متوقع أصلا ، واستعمال الكلمتين في القرآن من هذا القبيل.
وان أبيت إلا عن كون معناهما الحقيقي التوقع بالفعل ، فاجعلهما في تلك الموارد التي يراد صلاحية المورد للتوقع لا فعليته استعارة تبعية أو أجعل الجملة من الاستعارة التمثيلية ذكر من المشبه به ما هو العمدة ، اعنى كلمة لعل وعسى أو أجعل الاستعارة بالكناية واجعل كلمة لعل وعسى من ذكر لازم المشبه به ، وعلى أى فالمراد صلاحيته المحل بالذات للتوقع لا حصوله من متوقع حتى يمتنع من الله ويحتاج إلى التأويل.
وسيشير المصنف إلى الاشكال والجواب في تفسير الآية (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا) والحق ما ذكرناه.
(12) انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 37 وص 38.
(13) وللعلامة النائيني قدسسره في بحث الأمر بيان قد تلقاه من تأخر عنه كالمرحوم أية الله المظفر طاب ثراه وسماحة الآية العلامة الخوئي مد ظله بالقبول وهو بمكان من الحسن ينحل به ما استشكل المصنف هنا وخلاصة البيان أن الأمر ظاهر في الوجوب إذا كان مجردا
وعاريا عن قرينة الاستحباب ، الا أن هذا القيد ليس قيدا للموضوع له ولا للمستعمل فيه حتى يكون ذلك مفاد الصيغة ومدلولها اللفظي ، وليس الوجوب أمرا شرعيا منشأ بإنشاء الأمر بل أمر عقلي من جهة حكم العقل بوجوب اطاعة الأمر ، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية.
فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة أو الانبعاث ما لم يرخص في تركه ، فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي ، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ، ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ، ما لم يصرح المولى بالترخيص وبإذن الترك.
فالأمر لو خلي وطبعه وبدون الترخيص شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة ، فاستفادة الوجوب على تقدير تجرد الصيغة عن القرينة على إذن الأمر بالترك ، انما هو بحكم العقل ، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى ، ومع صدور الترخيص في الترك يحمل على الاستحباب ، ولا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ ، فليس هو موضوعا للوجوب ، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب لان الوجوب والندب ليس للمعنى المستعمل فيه اللفظ من التقسيمات من استعماله في معناه الموضوع له.
وعليه فلا يلزم فيما ورد في كثير من الاخبار من الجمع بين الواجبات والمستحبات بصيغة واحدة مثل «اغتسل للجنابة والجمعة والتوبة» استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو استعمال اللفظ في مطلق الطلب حتى يلزم ما ذكروه من المحذورات ، بل الصيغة في الكل لإيقاع النسبة بداعي البعث والتحريك غاية الأمر قام الدليل في بعض الإفراد على عدم لزوم الانبعاث واجازة الترك ، ولم يقع في بعض الإفراد فيكون موردا لحكم العقل.
وعندي أن ما أفادوه بمكان من الحسن دقيق عميق فنقول في المقام أيضا الأمر بالوضوء لإيجاد البعث عليه لإقامة الصلاة ، فيجب فيما لم يرد ترخيص كما فيما إذا أراد المحدث اقامة صلاته الواجبة ولا يجب فيما أراد المحدث اقامة صلاته المسنونة أو إذا لم يكن محدثا ويجدد الوضوء للصلاة فهو مما رخص في تركه ، فيخرج من مصاديق حكم العقل بوجوب الإطاعة انظر البحث في أصول الفقه للمظفر ج 1 ص 59 و 60.
(14) فإنك ترى في كثير من أحاديث الوضوء البيانية «فأسدله على وجهه من أعلى الوجه» كما في الحديث 6 و 10 من الباب 15 من الوضوء من الوسائل المسلسل في ط الإسلامية 1025 و 1029 وفي بعض الاخبار الأمر بالغسل من الأعلى كما في الرقم 22 من الباب المسلسل 1041 وان كان التعبير في هذا الحديث بالمسح ، الا أن المراد به الغسل قطعا.
(15) وظهور اتحاد الأول والثالث على ما قرر أولا منه قدس سره.
(16) انظر الباب 37 من أبواب الوضوء من كتاب جامع أحاديث الشيعة من ص 120 الى ص 122.
(17) وهو ابن الجنيد.
(18) إشارة الى الحديث المروي في التهذيب ج 1 ص 58 الرقم 163 والاستبصار ج 1 ص 58 الرقم 173 عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيجزى الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال برأسه نعم ، والحديث المروي في التهذيب بالرقم 164 والاستبصار بالرقم 174 عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندى رأسي ، قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
وروى الأول في المنتقى ج 1 ص 126 ولم يرو الثاني لما في أحاديث أبي بصير من الكلام وفي الباب حديث آخر أيضا في التهذيب بالرقم 166 عن أبي عمارة الحارثي قال سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) أمسح رأسي ببل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا.
(19) روى زرارة في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك (عليه السلام) ثم قال : يا زرارة قال رسول الله ونزل به الكتاب من الله لان الله يقول «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ».
ثم فصل بين الكلامين فقال (امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح ببعضهما ، ثم سن ذلك رسول الله للناس فضيعوه ، منه قدسسره. أقول : انظر جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 111 الحديث بالرقم المسلسل 955 والتهذيب ج 1 ص 61 الرقم 168 والاستبصار ج 1 ص 62 الرقم 186 والفقيه ج 1 ص 56 الرقم 212 والكافي ج 1 ص 10 باب مسح الرأس والقدمين وهو في المرات ج 3 ص 19 وعلل الشرائع ج 1 ص 264 الباب 190 ط قم والعياشي ج 1 ص 299 والبحار ج 18 ص 66 وص 70 والبرهان ج 1 ص 452 والوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث 1 ج 1 ص 55 ط الأميري وهو في ط الإسلامية ج 2 ص 290 الرقم المسلسل 1073 والوافي الجزء الرابع ص 44 وهو في المنتقى ج 1 ص 125 وص 273.
(20) وزبدة المخض في المسئلة أنه اختلف انظار علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء فالامامية الاثنا عشرية ذهبوا الى تعين المسح فرضا تبعا لأئمتهم وهو مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وابى العالية وهو المروي في كتب أهل السنة عن على (عليه السلام).
وجمهور فقهاء أهل السنة على وجوب الغسل فرضا على التعيين وعليه الأئمة الأربعة منهم.
ورب قائل بالتخيير بينهما كما نقل عن الحسن البصري والطبري والجبائي وأوجب داود بن على الظاهري والناصر للحق من أئمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآية والاخبار فأوجبا الجمع.
والذي تقتضيه الآية قطعا انما هو تعين المسح كما عليه الإمامية ولتوضيح ذلك نقول أنه قد نقل القرائتان في وأرجلكم نصب اللفظ وجرة عن السبعة المدعى تواترها لم ينقل غيرهما الا شاذا كما في شواذ القرآن لابن خالويه ص 31 نقل قراءة الرفع عن الحسن ، وكذا في الكشاف ج 1 ص 611 وسنتكلم في تلك القراءة أيضا ، وعلى القراءتين المشهورتين اما ان نقول : القرائتان متواترتان وبكلتيهما نزل القرآن ونزله روح الأمين على قلب النبي كما عليه أكثر أهل السنة أو نقول ان النازل انما هو احدى القرائتين والتبس الأمر علينا ولم نعلم أيهما عين ما نزل به القرآن وانما أمرنا بمتابعة ما قرأته الناس حتى يظهر الإمام القائم (ع) ونعلم انه بأيهما نزل الروح الأمين على قلب النبي (صلى الله عليه وآله).
فلنفرض أولا كون المنزل إحديهما فلا محالة اما أن يكون الجر أو النصب أو الرفع على فرض شاذ نقل عن الحسن فان كان الجر فمقتضاه كون الأرجل معطوفة على الرؤس وكون الواجب فيهما المسح كما وجب في الرأس.
واحتمال كون الجر على الجوار مع ضعف العطف على الجوار حتى عده كثير من أهل الأدب في اللحن واشتراطه بأمن اللبس كما في جحر ضب خرب إذ لا يحتمل أحد كون الخرب نعتا للضب مضافا الى اشتراط كونه بدون حرف العطف وعدم تكلم العرب به مع العطف حكم بكون منزل القرآن عاجزا عن أن يأتي بما هو مقبول عند كل أحد ويورد الكلام بوجه مغسول مرذول لا يقبله الطبع.
ثم لنفرض ثانيا ان الذي نزل به الروح الأمين هو النصب فقط فنقول مقتضاه أيضا وجوب المسح وذلك لأنه على هذه القراءة يكون المعنى وجوب مسح الرؤس مع الأرجل وكون الواو بمعنى مع ونصب الاسم بعد واو المعية مما لا ينكره أحد من أهل الأدب ولم يشترطوا في ذلك الا تقدم الفعل وشبهه وهو موجود في الآية.
ولتحقيق البحث في واو المعية انظر الكتاب لسيبويه ج 1 من ص 150 الى ص 156 والإنصاف لابن الأنباري المسئلة 30 من مسائل الخلاف من ص 248 الى ص 250 والاشمونى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج 2 من ص 395 الى ص 430 وكذا ج 4 من ص 635 الى ص 637 والاشمونى بحاشية الصبان ج 2 من ص 134 الى ص 141 وشرح الرضى على الكافية ط اسلامبول ج 1 من ص 194 الى ص 198 والتصريح للأزهري ج 1 من ص 353 الى ص 355 والخصائص لابن جنى ج 1 ص 312 وص 313 وج 3 ص 383.
وقد ورد في التنزيل مثله أيضا وهو الآية 71 من سورة يونس عند قصة نوح (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ) على قراءة شركائكم بالنصب وعليه رسم المصاحف انظر نثر المرجان ج 3 ص 64 وقد ذكروا للنصب وجوها كثيره لا يقبلها الذوق السليم الا كونه مفعولا معه لضمير الفاعل في فاجمعوا ويكون معناه مطابقا لقراءة يعقوب وان لم يوافقه رسم المصحف فإنه قرء بالرفع عطفا على الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد بالمنفصل لوقوع الفاصلة.
وقد صرح ابن جنى بأنه كلما جاز استعمال الواو عاطفة يجوز استعمالها بمعنى مع فلا يلزم من كون الواو بمعنى مع وجوب كون مسح الرؤس مع الأرجل في زمان واحد كما توهمه الالوسى ج 6 ص 69 بل ترى هذا الجواز مصرحا في كلمات كثير من الأدباء وان أبيت فكون الأرجل في قراءة النصب معطوفا على محل برؤسكم خال عن كل خلل والعطف على المحل شائع ذائع في استعمال العرب لا نريد هنا الإطالة بذكر الأمثلة.
واما احتمال كون الأرجل على قراءة النصب عطفا على الأيدي فهو رد الكلام الى وجه مرذول مغسول يراه كل أحد في كل لغة قبيحا أترى ان قال أحد بالفارسية (زيد را بزن وبعمر إحسان نما وبكر را يعنى بزن بكر را) وكذا لو قال بالعربية اضرب زيدا وأحسن إلى عمرو وبكرا أى اضربه أيقبله أحد أو يستهزئه في هذا التعبير وينسب المتكلم الى العجز أو الجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
واما احتمال كونه مفعولا لفعل مقدر مثل علفتها تبنا وماء باردا فهو أيضا وجه لا يحتاج اليه ويعود الكلام إلى إرادة معنى لا يدل عليه أصل الكلام ولا يصدر الا عن العاجز الجاهل بكيفية إيراد الكلام.
ثم لنفرض ثالثا كون القرآن بالقرائتين منزلا على النبي فنقول حيث ان مقتضى كل من القرائتين وجوب المسح فرضا بالتعيين فكونه متعينا في هذا الفرض أيضا أوضح من ان يحتاج الى البيان.
واما ما روى شاذا من قراءة الحسن البصري وأرجلكم بالرفع فهو مبتدأ محذوف الخبر معناه كما قاله ابن خالويه «مسحه الى الكعبين» إذ هو المناسب لكونه محذوفا مقرونا بالقرينة كما احتمل في الكشاف فقال ممسوحة أو مغسولة ولا ان غسلها الكعبين مع عدم ذكر غسل لها من قبل الا مع فصل طويل ومع ذلك فالقراءة شاذة.
فثبت أن الذي عليه التنزيل هو تعين وجوب المسح فرضا واعترف به ابن حزم في المحلى ص 266 ج 1 المسئلة 200 وقال ان القرآن نزل بالمسح سواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤس اما على اللفظ واما على الموضع لا يجوز غير ذلك ثم اختار وجوب الغسل لمكان نسخ الآية بالأخبار واعترف بدلالة الآية غير واحد من أهل السنة كما يستفاد من مراجعة التفاسير والكتب الفقهية منهم.
هذا ما يستفاد من الكتاب واما السنة فنقول حيث ثبت تعين المسح فرضا لا يكون اجازة الغسل تعيينا أو تخييرا الا نسخا للقرآن ولا يكون تخصيصا أو تقييدا فلا يمكن إثباته إلا بالسنة المتواترة إذ لا يجوز نسخ الكتاب بالآحاد ولم يتواتر السنة بالغسل بل المتواتر الواصل عن أئمة الهدى الذين فيهم نزل القرآن وهم اولى بفهم القرآن تعين المسح.
سلمنا وفرضنا إمكان نسخ القرآن بالآحاد أو فرضنا اجازة الغسل تعيينا أو تخييرا تخصيصا أو تقييدا وفرضنا صحة أحاديث وردت في كتب أهل السنة لكن نقول انه كما ورد الغسل في ـ أحاديثهم فكذلك تعين المسح أيضا وارد في أحاديثهم والقاعدة في المتعارضين انما هو التساقط.
فان قال بعض أعلام الشيعة في المتعارضين بالتخيير فلأخبار لهم جعل العلاج فيها في ـ المتعارضين الأخذ بالتخيير وليس في اخبار أهل السنة ما يوجب هذا العلاج والحكم بالأخذ بالتخيير وحكم العقل في الدليلين المتعارضين المتكافئين انما هو التساقط وليس في اخبار الغسل ترجيح وان شئت ملاحظة اخبارهم فراجع ما في فهرس مصادر كتاب الوضوء في الكتاب والسنة لسماحة الآية نجم الدين العسكري مد ظله ثم راجع أصل المصادر لا نطيل الكلام وعندئذ نقول :
بعد تعارض الاخبار لا يكون المرجع الا الكتاب الكريم وليس مفاده الا تعين المسح فما عليه الإمامية هو المطابق للقرآن وبيان أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله.

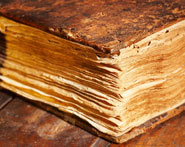
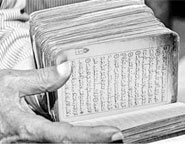
|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|