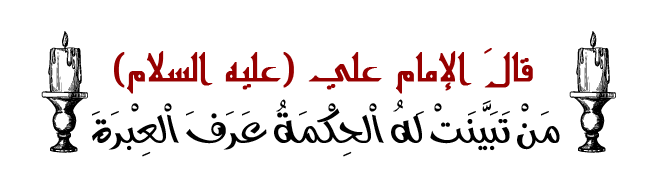
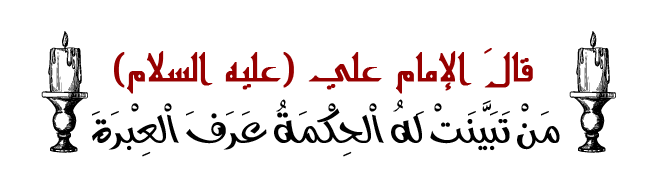

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2019
التاريخ: 8-5-2019
التاريخ: 30-4-2019
التاريخ: 8-5-2019
|
قال تعالى : {سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ولِقاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147) واتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وكانُوا ظالِمِينَ (148) ولَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ورَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا ويَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ} [الأعراف : 146-149] .
قال تعالى : {سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ولِقاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف : 146-147] .
{سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض} ذكر في معناه وجوه أحدها : إنه أراد سأصرف عن نيل الكرامة المتعلقة بآياتي ، والإعتزاز بها ، كما يناله المؤمنون في الدنيا والآخرة ، والمستكبرين في الأرض ، بغير الحق ، كما فعل بقوم موسى وفرعون ، فإن موسى كان يقتل من القبط ، وكان أحد منهم لا يجسر أن يناله بمكروه ، خوفا من الثعبان ، وعبر ببني إسرائيل البحر ، وغرق فيه فرعون وقومه ، عن أبي علي الجبائي . والآيات على هذا التأويل يحتمل أن تكون سائر الأدلة ، ويحتمل أن تكون معجزات الأنبياء وفي قوله : {ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا} بيان أن صرفهم عن الآيات مستحق بتكذيبهم .
وثانيها : إن معناه سأصرفهم عن زيادة المعجزات التي أظهرها على الأنبياء عليهم السلام بعد قيام الحجة ، بما تقدم من المعجزات التي ثبتت بها النبوة ، لأن هذا الضرب من المعجزات ، إنما يظهر ، إذا كان في المعلوم أنه يؤمن عنده من لا يؤمن بما تقدم من المعجزات ، فيكون الصرف بأن لا يظهرها جملة ، أو بأن يصرفهم عن مشاهدتها ، ويظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم ، وهذا الوجه اختاره القاضي ، لأن ما بعده يليق به من قوله {وإن يروا سبيل الرشد} إلى آخر الآية .
وثالثها : إن معناه سأمنع الكذابين والمتكبرين آياتي ومعجزاتي ، وأصرفهم عنها ، وأخص بها الأنبياء ، فلا أظهرها إلا عليهم ، وإذا صرفهم عنها ، فقد صرفهم عنهم ، وكلا اللفظين يفيد معنى واحدا ، فليس لأحد أن يقول هلا قال سأصرف آياتي عن الذين يتكبرون ، وهذا يبطل قول من قال إن الله تعالى جعل النيل في أمر فرعون ، فكان يجري بأمره ، ويقف وما شاكل ذلك .
ورابعها : أن يكون الصرف معناه المنع من إبطال الآيات والحجج ، والقدح فيها بما يخرجها عن كونها أدلة وحججا ، ويكون تقدير الآية : إني أصرف المبطلين والمكذبين عن القدح في دلالاتي بما أؤيدها وأحكمها من الحجج والبينات ، ويجري ذلك مجرى قول أحدنا : إن فلانا منع أعداءه بأفعاله الحميدة ، وأخلاقه الكريمة من ذمه وتهجينه ، وأخرس ألسنتهم عن الطعن فيه ، وإنما يريد المعنى الذي ذكرناه ويكون على هذا قوله {ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا} راجعا إلى ما قبله بلا فصل من قوله {وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا} ولا يرجع إلى قوله {سأصرف} .
وخامسها : إن المراد سأصرف عن إبطال آياتي ، والمنع من تبليغها ، هؤلاء المتكبرين بالإهلاك ، أو المنع من غير إهلاك ، فلا يقدرون على القدح فيها ، ولا على قهر مبلغيها ، ولا على منع المؤمنين من اتباعها ، والإيمان بها ، وهو نظير قوله :
{والله يعصمك من الناس} ، ويكون {الآيات} في هذا الوجه القرآن ، وما جرى مجراه ، من كتب الله ، التي تحملتها الأنبياء عليهم السلام ، ويكون قوله {ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا} على هذا متعلقا أيضا بقوله {وإن يروا سبيل الرشد} إلى ما بعده .
ومعنى قوله {الذين يتكبرون في الأرض} أي : يرون لأنفسهم فضلا على الناس ، وحقا ليس لغيرهم مثله ، فيحملهم ذلك على ترك اتباع الأنبياء أنفة من الانقياد لهم ، والقبول منهم . وقوله : {بغير الحق} تأكيد وبيان أن التكبر لا يكون إلا بغير الحق كقوله {ويقتلون النبيين بغير الحق} وقد مضى ذكر أمثاله .
{وإن يروا كل آية} أي : كل حجة ودلالة تدل على توحيد الله ، وصحة نبوة أنبيائه {لا يؤمنوا بها} هذا إخبار من الله تعالى ، عن هؤلاء بعلمه فيهم ، أنهم لا يؤمنون به ، وبكتبه ورسله ، وبيان أنه إنما صرفهم عن آياته لذلك {وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا} يعني : إن يروا طريق الهدى والحق ، لا يتخذوه طريقا لأنفسهم .
{وان يروا سبيل الغي} أي : طريق الضلال {يتخذوه سبيلا} أي : طريقا لأنفسهم ، ويميلون إليه . وقيل : الرشد ، الإيمان ، والغي الكفر . وقيل : الرشد كل أمر محمود ، والغي كل أمر قبيح مذموم . {ذلك} : إشارة إلى صرفهم عن الآيات .
وقيل : إشارة إلى اتخاذهم طريق الغي ، وترك طريق الرشد ، وتقديره أمرهم ذلك {بأنهم كذبوا بآياتنا} أي : بحججنا ، ومعجزات رسلنا .
{وكانوا عنها غافلين} أي : لا يتفكرون فيها ، ولا يتعظون بها ، والمراد بالغفلة هنا : التشبيه ، لا الحقيقة ، مثل قوله سبحانه {صم بكم عمي} وذلك أنهم لما أعرضوا عن الانتفاع بالآيات ، والتأمل فيها ، أشبهت حالهم حال من كان غافلا ساهيا عنها . ثم بين سبحانه وعيد المكذبين فقال : {والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة} يعني القيامة ، والبعث والنشور {حبطت أعمالهم} التي عملوها ، ولا يستحقون بها مدحا ، ولا ثوابا ، لأنها وقعت على خلاف الوجه المأمور به ، فصارت بمنزلة ما لم يعمل .
{هل يجزون إلا ما كانوا يعملون} صورته صورة الاستفهام ، والمراد به الانكار والتوبيخ ، ومعناه : ليس يجزون إلا ما عملوه إن خيرا فخيرا ، وإن شرا فشرا .
- {واتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وكانُوا ظالِمِينَ} [الأعراف : 148] .
ثم عاد الكلام إلى قصة بني إسرائيل ، وما أحدثوه عند خروج موسى عليه السلام ، إلى ميقات ربه ، فقال سبحانه {واتخذ قوم موسى} يعني السامري ، ومن جرى على طريقته . وقيل : يعني جميعهم ، لأن منهم من ساق العجل ، ومنهم من عبده ، ومنهم من لم ينكر ، وإنما أنكر ذلك القليل منهم ، فخرج الكلام على الغالب {من بعده} أي : من بعد خروج موسى إلى الميقات ، عن الجبائي ، وغيره {من حليهم} التي استعاروها من قوم فرعون ، وكانت بنو إسرائيل بمنزلة أهل الجزية في القبط ، وكان لهم يوم عيد يتزينون فيه ، ويستعيرون من القبط الحلي ، فوافق ذلك عيدهم ، فاستعاروا حلي القبط ، فلما أخرجهم الله من مصر ، وغرق فرعون ، بقيت تلك الحلي في أيديهم ، فاتخذ السامري منها {عجلا} وهو ولد البقرة {جسدا} أي : مجسدا لا روح فيه . وقيل : لحما ودما ، عن وهب {له خوار} أي : صوت . وروي في الشواذ عن علي عليه السلام جؤار بالجيم والهمزة ، وهو الصوت أيضا .
وفي كيفية خوار العجل ، مع أنه مصوغ من ذهب ، خلاف ، فقيل : أخذ السامري قبضة من تراب أثر فرس جبرائيل عليه السلام ، يوم قطع البحر ، فقذف ذلك التراب في فم العجل ، فتحول لحما ودما ، وكان ذلك معتادا غير خارق للعادة ، وجاز أن يفعل الله تعالى ذلك ، بمجرى العادة ، عن الحسن . وقيل : إنه احتال بإدخال الريح كما يعمل هذه الآلات التي تصوت بالحيل ، عن الزجاج ، والجبائي ، والبلخي . وإنما أضاف سبحانه الصوت إليه ، لأنه كان محله عند دخول الريح جوفه ، وكان السامري عندهم ، مهيبا مطاعا فيما بينهم ، فأرجف أن موسى عليه السلام قد مات ، لما لم يرجع على رأس الثلاثين ، فدعاهم إلى عبادة العجل ، فأطاعوه ، ولم يطيعوا هارون ، وعبدوا العجل ، وعلى ما مر ذكره في سورة البقرة .
ثم أنكر سبحانه ذلك عليهم فقال : {ألم يروا} أي : ألم يعلموا {أنه لا يكلمهم} بما يجدي عليهم نفعا ، أو يدفع عنهم ضررا . {ولا يهديهم سبيلا} أي :
لا يهديهم إلى خير ليأتوه ، ولا إلى شر ليجتنبوه ، دل سبحانه بهذا على فساد ما ذهبوا إليه ، فإن من لا يتكلم في خير وشر ، ولا يهدي إلى طريق ، فهو جماد لا ينفع ولا يضر ، فكيف يكون إلها معبودا {اتخذوه} أي : اتخذوه إلها وعبدوه {وكانوا ظالمين} باتخاذهم له إلها ، واضعين للعبادة في غير موضعها .
± {ولَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ورَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا ويَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ} [الأعراف : 149] .
ثم أخبر سبحانه أنهم ندموا على عبادة العجل ، فقال : {ولما سقط في أيديهم} أي : فلما لحقتهم الندامة {ورأوا أنهم قد ضلوا} أي : علموا ضلالهم عن الصواب ، وطريق الحق ، بعبادة العجل حين رجع إليهم موسى ، وبين لهم ذلك {قالوا لئن لم يرحمنا ربنا} بقبول توبتنا {ويغفر لنا} ما قدمناه من عبادة العجل {لنكونن من الخاسرين} باستحقاق العقاب ، قال الحسن : إن كلهم عبدوا العجل إلا هارون ، بدلالة قول موسى : {رب اغفر لي ولأخي} ، ولو كان هناك مؤمن غيرهما ، لدعا له ، وقال غيره : إنما عبده بعضهم .
_____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 356-361 .
{سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} . المتكبرون في الأرض هم الذين يعاندون الحق ، ولا يخضعون لسلطانه ، وقوله : {بِغَيْرِ الْحَقِّ} للتوضيح ، لا للاحتراز تماما مثل ويَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ . أما آيات اللَّه فيطلقها القرآن تارة على الآيات المبينة لأصول العقيدة وأحكام الشريعة ونحوها ، وتطلق تارة على الحجج والدلائل المثبتة للألوهية والنبوة ، فإن تكن الأولى هي القصد في الآية التي نفسرها فالمعنى ان اللَّه سبحانه يحفظها ويصونها من يد التحريف ، تماما كقوله : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ} [الحجر - 9] .
وان تكن الثانية أي الدلائل والبينات فالمعنى ان المعاندين بعد أن أعرضوا عنها ورفضوا الإصغاء إليها فإن اللَّه سبحانه يدعهم وشأنهم ، ولا يلجئهم إلى الإيمان بها إلجاء ، وتقدم الكلام عن ذلك مرات ، منها عند تفسير الآية 88 من سورة النساء ج 2 ص 399 فقرة الإضلال من اللَّه سلبي لا إيجابي .
{وإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وكانُوا عَنْها غافِلِينَ} .
هذا بيان لحقيقة المتكبرين ، وللسبب الموجب لتكبرهم أيضا ، أما حقيقتهم فهي انهم لا يرتدعون عن غي ، ولا يميلون إلى رشد ، أما السبب الموجب فهو ان اللَّه سبحانه قد جاءهم بالحجج والبراهين ، وطلب إليهم أن ينظروا إليها ويتدبروها ويعملوا بموجبها ، فرفضوا وأصروا على الاعراض وعدم النظر . . ولو انهم استجابوا ودرسوا تلك الدلائل لأدى بهم الدرس والنظر إلى الإيمان والاعتراف بالحق ، ولم يتكبروا ويفسدوا في الأرض .
{والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ولِقاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ} . كل من لا يؤمن باللَّه ولقاء ربه فهو من الهالكين غدا ، ويذهب ما كان يفاخر به ويكاثر سدى وهباء جزاء على كفره وعناده . . وأعجبني ما قاله هنا بعض المفسرين غفر اللَّه له ، وشمله برحمته ، ولذا أنقله بالحرف ، قال : حبوط الأعمال مأخوذ من قولهم : حبطت الناقة إذا رعت نباتا ساما ، فانتفخ بطنها ثم نفقت ، وهو وصف ملحوظ في طبيعة الباطل يصدر من المكذبين بآيات اللَّه ولقاء الآخرة ، فالمكذب ينتفخ حتى يظنه الناس من عظمة وقوة ، ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام .
{واتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ} . تقدم في الآية 142 ان موسى (عليه السلام) ذهب لميقات ربه ، وانه استخلف على قومه أخاه هارون ، وأيضا تقدم في الآية 138 أن بني إسرائيل بعد أن تجاوزوا البحر طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه ، لا لشيء إلا لأنهم رأوا عبدة الأصنام ، وما أن غاب موسى حتى اغتنموا فرصة غيابه ، فجمع السامري حلي النساء ، وصنع منها عجلا ، وجعله على هيئة بحيث يخرج منه صوت الثيران ، وقال لهم : هذا إلهكم وإله موسى ، فتهافتوا على عبادته ، ونهاهم هارون ، ولكنه لم يملك ردهم عن الضلال ، ولم يستجب له إلا قليل منهم . وتقدمت الإشارة إلى ذلك في الآية 51 من سورة البقرة ج 1 ص 102 . وأيضا يأتي الكلام عنه . .
وهذه الآية تغزز ما كررناه في المجلد الأول والثاني من ان إسرائيل لا تثبت إلا على مبدأ الشهوات والأهواء ، ان صح ان تكون الأهواء مبدأ .
{أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وكانُوا ظالِمِينَ} .
هذا هو منطق الفطرة والعقل الذي يأبى أن يعبد الإنسان إلها من صنع يده . .
ولكن ما لإسرائيل والعقل والفطرة والدين ؟ .
{ولَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ورَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا ويَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ} . هذه هي المنقبة الوحيدة والأولى والأخيرة التي سجلها القرآن لإسرائيل من حيث هي وعلى وجه العموم ، وبصرف النظر عن القلة القليلة التي آمنت منهم بموسى وثبتت معه حتى النهاية . . وقد استظهر بعض المفسرين من توبة بني إسرائيل انه كان فيهم آنذاك بقية من الاستعداد للصلاح ، ثم ذهبت هذه البقية ، ولم يبق أي أثر فيهم للاستعداد إلى الخير . وهذا الاستظهار غير بعيد ، وتومئ إليه الآية 74 من سورة البقرة : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} وهذه الآية بالذات نزلت بعد قصة ذبح البقرة ، وهذا الذبح متأخر عن عبادتهم العجل .
__________________________
1. تفسير الكاشف ، ج4 ، ص 394-395 .
قوله تعالى : {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا} [الأعراف : 146] الآية تقييد التكبر في الأرض بغير الحق مع أن التكبر فيها لا يكون إلا بغير الحق كتقييد البغي في الأرض بغير الحق للتوضيح لا للاحتراز ويراد به الدلالة على وجه الذم في العمل وأن التكبر كالبغي مذموم لكونه بغير الحق .
وأما ما قيل : إن القيد احترازي للدلالة على أن المراد هو التكبر المذموم دون التكبر الممدوح كالتكبر على أعداء الله والتكبر على المتكبر وهو تكبر بالحق ففيه أن المذكور في الآية ليس مطلق التكبر بل التكبر في الأرض ، وهو الاستعلاء على عباد الله واستذلالهم والتغلب عليهم ، وهذا لا يكون إلا بغير الحق .
وقوله : {وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا} [الأعراف : 146] عطف على قوله : ﴿يتكبرون﴾ وبيان لأحد أوصافهم وهو الإصرار على الكفر والتكذيب .
وكذا قوله : {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} [الأعراف : 146] الآية وتكرار الجملتين المثبتة والمنفية بجميع خصوصياتهما للدلالة على اعتنائهم الشديد ومراقبتهم الدقيقة على مخالفة سبيل الرشد واتباع سبيل الغي بحيث لا يعذرون بخطأ ولا يحتمل في حقهم جهل أو اشتباه .
وقوله : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} [الأعراف : 146] إلى آخر الآية تعليل لما تحقق فيهم من رذائل الصفات أي إنما جروا على ما جروا بسبب تكذيبهم لآياتنا وغفلتهم عنها ، ومن المحتمل أن يكون تعليلا لقوله تعالى : {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ} [الأعراف : 146] .
قوله تعالى : {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف : 147] معنى الآية ظاهر ويتحصل منها : أولا : أن الجزاء هو نفس العمل وقد تقدم توضيحه كرارا في أبحاثنا السابقة .
وثانيا : أن الحبط من الجزاء فإن الجزاء بالعمل وإذا كان العمل حابطاً فإحباطه هو الجزاء ، والحبط إنما يتعلق بالأعمال التي فيها جهة حسن فتكون نتيجة إحباط الحسنات ممن له حسنات وسيئات أن يجزى بسيئاته جزاء سيئا ويجزى بحسناته بإحباطها فيتمحض له الجزاء السيء .
ويمكن أن تنزل الآية على معنى آخر وهو أن يكون المراد بالجزاء ، الجزاء الحسن وقوله : {هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف : 147] كناية عن أنهم لا يثابون بشيء إذ لا عمل من الأعمال الصالحة عندهم لمكان الحبط قال تعالى : {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان : 23] ، والدليل على كون المراد بالجزاء هو الثواب أن هذا الجزاء هو جزاء الأعمال المذكورة في الآية قبلا ، والمراد بها بقرينة ذكر الحبط هي الأعمال الصالحة .
ومن هنا يظهر فساد ما استدل به بعضهم بالآية على أن تارك الواجب من غير أن يشتغل بضده لا عقاب له لأنه لم يعمل عملا حتى يعاقب عليه وقد قال تعالى : {هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف : 147] .
وجه الفساد أن المراد بالجزاء في الآية الثواب والمعنى أنهم لا ثواب لهم في الآخرة لأنهم لم يأتوا بحسنة ولم يعملوا عملا يثابون عليها .
على أن ثبوت العقاب على مجرد ترك الأوامر الإلهية مع الغض عما يشتغل به من الأعمال المضادة كالضروري من كلامه تعالى قال الله عز وجل : {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن : 23] ، إلى غير ذلك من الآيات .
قوله تعالى : {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} [الأعراف : 148] إلى آخر الآية ، الحلي على فعول جمع حلي كالثدي جمع ثدي ، وهو ما يتحلى ويتزين به من ذهب أو فضة أو نحوهما ، والعجل ولد البقرة ، والخوار صوت البقرة خاصة ، وفي قوله تعالى : {جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} - وهو بيان للعجل - دلالة على أنه كان غير ذي حياة وإنما وجدوا عنده خوارا كخوار البقر .
والآية وما بعده تذكر قصة عبادة بني إسرائيل العجل بعد ما ذهب موسى إلى ميقات ربه واستبطئوا رجوعه إليهم ، فكادهم السامري وأخذ من حليهم فصاغ لهم عجلا من ذهب له خوار كخوار العجل وذكر لهم أنه إلههم وإله موسى فسجدوا له واتخذوه إلها ، وقد فصل الله سبحانه القصة في سورة طه تفصيلا ، والذي ذكره في هذه الآيات من هذه السورة لا يستغني عما هناك ، وهو يؤيد نزول سورة طه قبل سورة الأعراف .
وكيف كان فقوله : {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا} [الأعراف : 148] معناه اتخذ قوم موسى من بعد ذهابه لميقات ربه قبل أن يرجع - فإنه سيذكر رجوعه إليهم غضبان - عجلا فعبدوه ، وكان هذا العجل الذي اتخذوه : {جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} ثم ذمهم الله سبحانه بأنهم لم يعبئوا بما هو ظاهر جلي بين عند العقل في أول نظرته أنه لو كان هو الله سبحانه لكلمهم ولهداهم السبيل فقال تعالى : {أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا} [الأعراف : 148] .
وإنما ذكر من صفاته المنافية للألوهية عدم تكليمه إياهم وعدم هدايته لهم وسكت عن سائر ما فيه كالجسمية وكونه مصنوعا ومحدودا ذا مكان وزمان وشكل إلى غير ذلك مع أن الجميع ينافي الألوهية لأن هاتين الصفتين أعني التكليم والهداية من أوضح ما تستلزمه الألوهية من الصفات عند من يتخذ شيئا إلها إذ من الواجب أن يعبده بما يرتضيه ويسلك إليه من طريق يوصل إليه ، ولا يعلم ذلك إلا من قبل الإله بوجه فهو الذي يجب أن يهديه إلى طريق عبادته بنوع من التكليم والتفهيم ، وقد رأوا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا .
على أنهم عهدوا من موسى أن الله سبحانه يكلمه ويهديه ، ويكلمهم ويهديهم بواسطته ، وقد قالوا حين أخرج السامري لهم العجل : {هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى} [طه : 88] ، فلو كان العجل هو الذي أومأ إليه السامري لكلمهم وهداهم سبيلا .
وبالجملة فقد كان من الواضح البين عند عقولهم لو عقلوا أنه ليس هو ، ولذلك أردفه بقوله : {اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ} [الأعراف : 148] كأنه قيل : فلم اتخذوه وأمره بذاك الوضوح ، فقيل : {اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ} .
قوله تعالى : {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا} [الأعراف : 149] إلى آخر الآية .
قال في المجمع ، معنى ﴿سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ وقع البلاء في أيديهم أي وجدوه وجدان من يده فيه يقال ذلك للنادم عند ما يجده مما كان خفي عليه ، ويقال : سقط في يده ، وأسقط في يده وبغير ألف أفصح ، وقيل : معناه صار الذي يضر به ملقى في يده .
وقد ذكر في مطولات التفاسير وجوه كثيرة توجه بها هذه الجملة ، جلها أو كلها لا تخلو من تعسف ، وأقرب الوجوه ما نقلناه عن المجمع ، منقولا عن بعضهم فإن ظاهر سياق الآية أن المراد بقوله : {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا} [الأعراف: 149] إنهم لما التفتوا إلى ما فعلوه وأجالوا النظر فيه دقيقا ثانيا ورأوا عند ذلك أنهم قد ضلوا قالوا : كذا وكذا فالجملة تفيد معنى التنبه لما ذهلوا عنه والتبصر بما أغفلوه كأنهم عملوا شيئا فقدموه إلى ما عملوا له فرده إليهم ورمى به نحوهم فتناولوه بأيديهم فسقط فيها فرأوا من قريب أنهم ضلوا فيما زعموا ، وأهملوا فيه أمرا ما كان لهم أن يهملوه ، وفات منهم ما فسد بفوته ما عملوه ، وعلى أي حال تجري الجملة مجرى المثل السائر .
والآية أعني قوله {وَلَمَّا سُقِطَ} بحسب المعنى مترتب على الآيات التالية فإنهم إنما تبينوا ضلالهم بعد رجوع موسى إليهم كما تفصل ذلك سورة طه لكنه سبحانه كأنه قدم الآية لأنها مشتملة على حديث ندامتهم على ما صنعوا وتحسرهم مما فات منهم ، وقد أظهروا ذلك بقولهم : {لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف : 149] والأحرى بالندامة والحسرة أن يذكرا مع ما تعلقنا به من غير فصل طويل ، ولذا لما ذكر اتخاذهم العجل في الآية الأولى وصله بندامتهم وحسرتهم في الآية الثانية .
ولأن ذيل حديث رجوع موسى في الآية التالية مشغول بدعائه لنفسه وأخيه ففصل بينه وبين هذا الذي هو صورة دعاء .
______________________________
1 . تفسير الميزان ، ج8 ، ص 252-255 .
- {سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف : 146-147] .
مصير المتكبرين :
البحث في هاتين الآيتين هو في الحقيقة نوع من عملية استنتاج من الآيات الماضية عن مصير فرعون وملئه والعصاة من بني إسرائيل ، فقد بيّن الله في هذه الآيات الحقيقة التالية وهي : إذا كان الفراعنة أو متمرّدو بني إسرائيل لم يخضعوا للحق مع مشاهدة كل تلك المعاجز والبينات ، وسماع كل تلكم الحجج والآيات الإلهية ، فذلك بسبب أنّنا نصرف المتكبرين والمعاندين للحق ـ بسبب أعمالهم ـ عن قبول الحق .
وبعبارة أخرى : إنّ الإصرار على تكذيب الآيات الإلهية قد ترك في نفوسهم وأرواحهم أثرا عجيبا ، بحيث خلق منهم أفرادا متصلبين منغلقين دون الحق ، لا يستطيع نور الهدى من النفوذ إلى قلوبهم .
ولهذا يقول أوّلا : {سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ} .
ومن هنا يتّضح أنّ الآية الحاضرة لا تنافي أبدا الأدلة العقلية حتى يقال بتأويلها كما فعل كثير من المفسّرين ـ إنّها سنة إلهية أن يسلب الله من المعاندين الألدّاء توفيق الهداية بكل أشكاله وأنواعه فهذه هي خاصية أعمالهم القبيحة أنفسهم ، ونظرا لانتساب جميع الأسباب إلى الله الذي هو علّة العلل ومسبب الأسباب في المآل نسبت إليه.
وهذا الموضوع لا هو موجب للجبر ، ولا مستلزم لأي محذور آخر ، حتى نعمد إلى توجيه الآية بشكل من الأشكال .
هذا ، ولا بدّ من الالتفات ـ ضمنيا ـ إلى أنّ ذكر عبارة {بِغَيْرِ الْحَقِ} بعد لفظة :
التكبر إنّما هو لأجل التأكيد ، لأنّ التكبر والشعور بالاستعلاء على الآخرين واحتقار عباد الله يكون دائما بغير حق ، وهذا التعبير يشبه الآية (61) من سورة البقرة ، عند ما يقول سبحانه : {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ} فقيد بغير الحق هنا قيد توضيحي ، وتوكيدي لأنّ قتل الأنبياء هو دائما بغير حق.
خاصّة أنّها أردفت بكلمة «في الأرض» الذي يأتي بمعنى التكبر والطغيان فوق الأرض ، ولا شك أنّ مثل هذا العمل يكون دائما بغير حق.
ثمّ أشار تعالى إلى ثلاثة أقسام من صفات هذا الفريق «المتكبر المتعنت» وكيفية سلب توفيق قبول الحق عنهم.
الأولى قوله تعالى : {وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها} إنّهم لا يؤمنون حتى ولو رأوا جميع المعاجز والآيات والثّانية ، {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} والثّالثة إنّهم على العكس {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً}.
بعد ذكر هذه الصفات الثلاث الحاكية برمتها عن تصلب هذا الفريق تجاه الحق ، أشار إلى عللها وأسبابها ، فقال : {ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ}.
ولا شك أنّ التكذيب لآيات الله مرّة ـ أو بضع مرات ـ لا يستوجب مثل هذه العاقبة ، فباب التوبة مفتوح في وجه مثل هذا الإنسان ، وإنّما الإصرار في هذا الطريق هو الذي يوصل الإنسان إلى نقطة لا يعود معها يميّز بين الحسن والقبيح ، والمستقيم والمعوج ، أي يسلب القدرة على التمييز بين «الرشد» و «الغي».
ثمّ تبيّن الآية اللاحقة عقوبة مثل هؤلاء الأشخاص وتقول : {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ}.
و «الحبط» يعني بطلان العمل وفقدانه للأثر والخاصية ، يعني أنّ مثل هؤلاء الأفراد حتى إذا عملوا خيرا فإنّ عملهم لن يعود عليهم بنتيجة (وللمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع راجع ما كتبناه عند تفسير الآية 217 من سورة البقرة).
وفي ختام الآية أضاف بأن هذا المصير ليس من باب الانتقام منهم ، إنما هو نتيجة أعمالهم هم ، بل هو عين أعمالهم ذاتها وقد تجسمت أمامهم {هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ}؟!
إنّ هذه الآية نموذج آخر من الآيات القرآنية الدالة على تجسّم الأعمال ، وحضور أعمال الإنسان خيرها وشرها يوم القيامة.
- {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ * وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ} [الأعراف : 148-149] .
اليهود وعبادتهم للعجل :
في هذه الآيات يقصّ القرآن الكريم إحدى الحوادث المؤسفة ، وفي نفس الوقت العجيبة التي وقعت في بني إسرائيل بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى ميقات ربّه ، وهي قصّة عبادتهم للعجل التي تمّت على يد شخص يدعى «السامري» مستعينا بحلي بني إسرائيل وما كان عندهم من آلات الزّينة.
إنّ هذه القصّة مهمّة جدّا بحيث إنّ الله تعالى أشار إليها في أربع سور ، في سورة البقرة الآية (51) و (54) و (92) و (93) ، وفي سورة النساء الآية (153) ، والأعراف الآيات المبحوثة هنا ، وفي سورة طه الآية (88) فما بعد .
على أنّ هذه الحادثة مثل بقية الظواهر الاجتماعية لم تكن لتحدث من دون مقدمة وأرضيّة ، فبنوا إسرائيل من جهة قضوا سنين مديدة في مصر وشاهدوا كيف يعبد المصريون الأبقار أو العجول. ومن جانب آخر عند ما عبروا النيل شاهدوا في الضفة الأخرى مشهدا من الوثنية ، حيث وجدوا قوما يعبدون البقر ، وكما مرّ عليك في الآيات السابقة طلبوا من موسى عليه السلام صنما كتلك الأصنام ، ولكن موسى عليه السلام وبّخهم وردّهم ، ولا مهم بشدّة.
وثالث ، تمديد مدّة ميقات موسى عليه السلام من ثلاثين إلى أربعين ، الذي تسبب في أن تشيع في بني إسرائيل شائعة وفاة موسى عليه السلام بواسطة بعض المنافقين ، كما جاء في بعض التفاسير.
والأمر الرابع ، جهل كثير من بني إسرائيل بمهارة السامريّ في تنفيذ خطته المشئومة ، كل هذه الأمور ساعدت على أن تقبل أكثرية بني إسرائيل في مدّة قصيرة على الوثنية ، ويلتفوا حول العجل الذي أوجده لهم السامريّ للعبادة.
وفي الآية الحاضرة يقول القرآن الكريم أوّلا : إنّ قوم موسى عليه السلام بعد ذهابه إلى ميقات ربّه صنعوا من حليّهم عجلا ، وكان مجرّد تمثال لا روح فيه ، ولكنّه كان له صوت كصوت البقر ، واختاروه معبودا لهم : {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ}.
ومع أنّ هذا العمل (أي صنع العجل من الحليّ) صدر من السامريّ (كما تشهد بذلك آيات سورة طه) إلّا أنّه مع ذلك نسب هذا العمل إلى بني إسرائيل لأنّ كثيرا منهم ساعد السامريّ في هذا العمل وعاضده ، وبذلك كانوا شركاء في جريمته ، في حين رضي بفعله جماعة أكبر منهم.
وظاهر هذه الآية وإن كان يفيد ـ في بدء النظر ـ أنّ جميع قوم موسى شاركوا في هذا العمل ، إلّا أنّه بالتوجه إلى الآية (159) من هذه السورة ، التي تقول : {وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} يستفاد أنّ المراد من الآية المبحوثة هنا ليس كلّهم ، بل أكثرية عظيمة منهم سلكوا هذا السبيل ، وذلك بشهادة الآيات القادمة التي تعكس عجز هارون عن مواجهتها وصرفها عن ذلك .
كيف كان للعجل الذهبي خوار ؟
و «الخوار» هو الصوت الخاص الذي يصدر من البقر أو العجل ، وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ السامري بسبب ما كان عنده من معلومات وضع أنابيب خاصّة في باطن صدر العجل الذهبي ، كان يخرج منها هواء مضغوط فيصدر صوت من فم ذلك العجل الذهبيّ شبيه بصوت البقر.
ويقول آخرون : كان العجل قد وضع في مسير الريح بحيث كان يسمع منه صوت على أثر مرور الريح على فمه الذي كان مصنوعا بهيئة هندسية خاصّة.
أمّا ما ذهب إليه جماعة من المفسّرين من أن السامريّ أخذ شيئا من تراب من موضع قدم جبرئيل وصبّه في العجل فصار كائنا حيا ، وأخذ يخور خوارا طبيعيا فلا شاهد عليه في آيات القرآن الكريم ، كما سيأتي بإذن الله في تفسير آيات سورة طه.
وكلمة «جسدا» شاهد على أن ذلك العجل لم يكن حيوانا حيا ، لأنّ القرآن يستعمل هذه اللفظة في جميع الموارد في القرآن الكريم بمعنى الجسم المجرّد من الحياة والروح (2) .
وبغض النظر عن جميع هذه الأمور يبعد أن يكون الله سبحانه قد أعطى الرجل المنافق (مثل السامريّ) مثل تلك القدرة التي يستطيع بها أن يأتي بشيء يشبه معجزة النّبي موسى عليه السلام ، ويحيي جسما ميتا ، ويأتي بعمل يوجب ضلال الناس حتما ولا يعرفون وجه بطلانه وفساده .
أمّا لو كان العجل بصورة تمثال ذهبي كانت أدلة بطلانه واضحة عندهم ، وكان من الممكن أن يكون وسيلة لاختبار الأشخاص لا شيء آخر.
والنقطة الأخرى التي يجب الانتباه إليها ، هي أنّ السامري كان يعرف أن قوم موسى عليه السلام قد عانوا سنين عديدة من الحرمان ، مضافا إلى أنّهم كانت تغلب عليهم روح المادية ـ كما هو الحال في أجيالهم في العصر الحاضر ـ ويولون الحليّ والذهب احتراما خاصّا ، لهذا صنع عجلا من ذهب حتى يستقطب إليه اهتمام بني إسرائيل من عبيد الثروة.
أمّا أن هذا الشعب الفقير المحروم من أين كان له كل ذلك الذهب والفضة ؟ فقد جاء في الرّوايات أن نساء بني إسرائيل كنّ قد استعرن من الفرعونيين كمية كبيرة من الحليّ والذهب والفضّة لإقامة أحد أعيادهن ، ثمّ حدثت مسألة الغرق وهلاك آل فرعون ، فبقيت تلك الحلي عند بني إسرائيل (3) .
ثمّ يقول القرآن الكريم معاقبا وموبّخا : ألم ير بنو إسرائيل أن هذا العجل لا يتكلم معهم ولا يهديهم لشيء ، فكيف يعبدونه؟ {أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً}.
يعني أن المعبود الحقيقي هو من يعرف ـ على الأقل ـ الحسن والقبيح ، وتكون له القدرة على هداية أتباعه ، ويتحدث إلى عبدته ويهديهم سواء السبيل ، ويعرّفهم على طريقة العبادة .
وأساسا كيف يسمح العقل البشري بأن يعبد الإنسان شيئا ميتا صنعه وسوّاه بيده ، حتى لو استطاع ـ افتراضا ـ أن يبدّل الحلّي إلى عجل واقعي فإنّه لا يليق به أن يعبده ، لأنّه عجل يضرب ببلادته المثل.
إنّهم في الحقيقة ظلموا بهذا العمل أنفسهم ، لهذا يقول في ختام الآية :
{اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ}.
بيد أنّه برجوع موسى عليه السلام إليهم ، واتضاح الأمر عرف بنو إسرائيل خطأهم ، وندموا على فعلهم ، وطلبوا من الله أن يغفر لهم ، وقالوا : إذا لم يرحمنا الله ولم يغفر لنا فإنّنا لا شك خاسرون {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ}.
وجملة {سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} أي عند ما عثروا على الحقيقة ، أو عند ما وقعت نتيجة عملهم المشؤومة بأيديهم ، أو عند ما سقطت كل الحيل من أيديهم ولم يبق بأيديهم شيء في الأدب العربي كناية عن الندامة ، لأنّه عند ما يقف الإنسان على الحقائق ، ويطلع عليها ، أو يصل إلى نتائج غير مرغوب فيها ، أو تغلق في وجهه أبواب الحيلة ، فإنّه يندم بطبيعة الحال ، ولهذا يكون الندم من لوازم مفهوم هذه الجملة.
وعلى كل حال ، فقد ندم بنو إسرائيل من عملهم ، ولكن الأمر لم ينته إلى هذا الحدّ ، كما نقرأ في الآيات اللاحقة.
_________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 509-515 .
2. راجع الآيات (8) من سورة الأنبياء ، و (34) من سورة ص .
3. راجع تفسير مجمع البيان ، ذيل الآية المبحوثة هنا .



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|