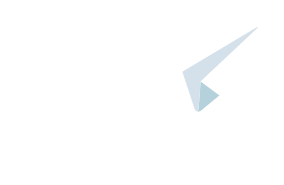تاريخ الفيزياء

علماء الفيزياء


الفيزياء الكلاسيكية

الميكانيك

الديناميكا الحرارية


الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية

المغناطيسية

الكهرومغناطيسية


علم البصريات

تاريخ علم البصريات

الضوء

مواضيع عامة في علم البصريات

الصوت


الفيزياء الحديثة


النظرية النسبية

النظرية النسبية الخاصة

النظرية النسبية العامة

مواضيع عامة في النظرية النسبية

ميكانيكا الكم

الفيزياء الذرية

الفيزياء الجزيئية


الفيزياء النووية

مواضيع عامة في الفيزياء النووية

النشاط الاشعاعي


فيزياء الحالة الصلبة

الموصلات

أشباه الموصلات

العوازل

مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة

فيزياء الجوامد


الليزر

أنواع الليزر

بعض تطبيقات الليزر

مواضيع عامة في الليزر


علم الفلك

تاريخ وعلماء علم الفلك

الثقوب السوداء


المجموعة الشمسية

الشمس

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب الأرض

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

كوكب أورانوس

كوكب نبتون

كوكب بلوتو

القمر

كواكب ومواضيع اخرى

مواضيع عامة في علم الفلك

النجوم

البلازما

الألكترونيات

خواص المادة


الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

مواضيع عامة في الطاقة البديلة

المد والجزر

فيزياء الجسيمات


الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء الكيميائية

الفيزياء الرياضية

الفيزياء الحيوية

الفيزياء العامة


مواضيع عامة في الفيزياء

تجارب فيزيائية

مصطلحات وتعاريف فيزيائية

وحدات القياس الفيزيائية

طرائف الفيزياء

مواضيع اخرى
الرياضيات الكلاسيكية
المؤلف:
رولان أومنيسا
المصدر:
فلسفة الكوانتم
الجزء والصفحة:
ص82
2025-10-13
350
منذ متى والبشر منبهرون بالأعداد والأشكال؟ منذ الأزمنة التي تسقط . من الذاكرة، ومن الناحية الفعلية اعتقدت الحضارات القديمة بأسرها أن أرقاما معينة لها خاصة سحرية أو مقدسة، تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. هل يمكن أن نتخيل الربات الإحدى عشرة للشعر والفنون ، والآلهة السبعة عشر فوق الأولمب، أو الأيام الثمانية لخلق العالم؟ ويمكن فهم واقعة مفادها أن الأرقام الصغرى سوف تبهرنا أكثر من سواها، ولكن لماذا ينبغي أن تكون الثلاثة والأربعة والسبعة والاثنا عشر أهم من الخمسة أو التسعة - وهذه الأرقام ذاتها أعلى من الستة والعشرة - بينما لا تعني الثمانية والأحد عشر أي شيء لأي شخص؟ أي أعداد تتجاوز هذا أعداد كبيرة جدا.
أما جاذبية أشكال هندسية معينة مثل الدائرة أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المربع، فيمكن تفسيرها بالتماثلات العديدة معها ولكن كيف أمكن لزعم معين مفاده أن الدائرة هي فقط المنحنى الكامل أن يكون معلما دامغا لعقول الإغريق المقدامة، حتى أنهم رفضوا كل الأشكال الأخرى، ورأوها غير جديرة بالأجرام السماوية؟ كان ثمة على الدوام شعور بكمال وقدسية ارتبط بأرقام وأشكال؛ ميل غريب نجده أحيانا في الأطفال يبدو وكأنه يوعز إلينا بأن بنيته موجودة في عقولنا.
بشكل عام، يسود الاعتقاد أن الرياضيات ولدت من رحم الخبرات العملية يمكن أن نتتبع الدائرة باستخدام خيط؛ والشكل القائم الزاوية يضمن مساحة ثابتة للحقل الذي تتميع حدوده بطمي النيل ومن أجل إقامة الزوايا القائمة الضرورية يمكن تشييد مثلث قائم الزاوية باستخدام حبل تتوزع العقد عليه تبعا لمسافات هي على التتابع 3 و 4 و 5. وفي وقت مبكر جدا اكتشف طاليس أنه يمكن استخدام أشعة الشمس المتوازية التي يمكن رؤيتها حين تخترق سماء ملبدة بالغيوم، وذلك لقياس ارتفاع شجرة بأن نقارن بين طول ظلها وطول ظل عصا. وينشأ عن هذا جميعا، كل من الشغف بالكسور ووجود تناظر وثيق بين الأشكال والأعداد.
قطع فيثاغورث خطوات أبعد، وذلك بمبرهنته الشهيرة عن المثلث القائم الزاوية، حيث يتجلى التناظر المذكور آنفا في أجلى صوره. ربما خمّن هذه المبرهنة حين رأى رسما بسيطا، لكن من المؤكد أن الرياضيات امتلكت فعلا الأدوات المنطقية الضرورية حينما أثبت ذلك الفيثاغوري المجهول أنه لا كسر يمكن أن يقيس قطر المربع. إن المنطق هو الأخ التوأم للرياضيات؛ والمنطق فقط هو الذي يجعل الإثبات ممكنا على أننا قلنا هذا من قبل.
يذكرنا اكتشاف قطر المربع أصم غير جذري بنظرية توماس كون الشهيرة ووفقا لها يسير التقدم العلمي من خلال النماذج الإرشادية [الباراديمات]، أي من خلال أمثلة لافتة جدا وموحية جدا إلى درجة أنها تستمكن مما يشبه القبول العقائدي. كان اكتشاف الأعداد الصماء نوعا من باراديم الباراديمات، لأنه يتضمن بذور علم لا متناه، ولا بد أن صاحبنا الفيثاغوري البارز قد عاش قبيل سقراط. وقد عرف أفلاطون بالفعل بعض النتائج الرياضية الجيدة، وقد اكتشف معاصره إدكسوس عددا كبيرا من المبرهنات في الهندسة ونظرية الأعداد. وسرعان ما بلغت الرياضيات أوان النضج مع أقليدس السكندري، ولا نعرف عنه إلا أنه عاش بضع سنوات بعد رحيل بعض من تلاميذ أفلاطون (رحل المعلم في العام 347 قبل ميلاد المسيح) وقبل أرشميدس (287 - 212 ق. م.).
حتى إن كان التاريخ لم يستبق إلا بضعة من الأسماء اللامعة في هذه الحقبة، فالذي لا شك فيه أن أسلوب أقليدس الرياضي ينم عن المناقشات الطويلة التي سبقت عمله، مناقشات الإغريق ذوي الطيبة والشغف. وفي هذا نجد تتبعا لأبسط الفروض وجهداً لطرح الحجة الوحيدة التي لا تقبل الدحض واستبعاد غير الضروري الذي لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لمراجعات لا تنتهي، نصل إليها عبر معارضات لا تنتهي في سباق محموم نحو الكمال. تذكرنا محاورات أفلاطون المبكرة بمثل هذه الأحاديث المفعمة بالحياة ، وتلك المحاورات تأمل عميق في هاتيك المناظرات بعض منها تحوز منتهى الشرعية، مثل تلك الخاصة بالمسلمة الشهيرة لأقليدس عن الخطين المتوازيين: لا يوجد إلا خط مستقيم واحد مواز لمستقيم معلوم ويمر بنقطة معلومة لا تقع على المستقيم المعلوم وهو يقصد بـ «التوازي» أن المستقيمين لا يلتقيان أبدا ولنتذكر أن فيثاغورث اعتقد أن النجوم مثبتة في كرة سماوية وأن آخرين اعتقدوا أنه لا يوجد فضاء بعد هذه الكرة؛ إذن نتخيل نوع المساجلة التي ربما أثارها الوجود المفترض للمتوازيين. تفترض مسلمة اقليدس بدورها أن المكان لا متناه؛ وأنه لذلك ووفقا لروح ذلك العصر، يخفي في جوفه فرضا كوزموغونيا خبيئا. وقد يقع المرء في إغواء إسقاط هذه المسلمة، ولكن في هذه الحالة ما كانت نتائج عديدة ثمينة للغاية ستظهر للوجود - مثلا أن حاصل جمع زوايا المثلث مساو لقائمتين. وجود مثل هذه المعضلات يفسر لنا حرص أقليدس على التمييز الحاسم بين أنواع الافتراضات البديهيات والمسلمات والتعريفات والفروض البديهية هي الحقيقة الواضحة بذاتها والتي لم يحدث قط أن تشكك فيها أي إغريقي خلال مناقشة ما، مثلا حين يلتقي خطان منفصلان (مستقيمان) تكون ثمة نقطة واحدة فقط مشتركة بينهما». أما المسلمة فهي قضية نفترض أنها صادقة، حتى لو كان وضعها قد أثار تساؤلات في الماضي. أجل أولئك الذين
يخوضون المباراة الرياضية يسلمون فعلا بصدق المسلمة، لأنهم يعرفون جيدا أنهم إذا أنكروها ، فسوف تفقد المباراة جانبا من روعتها. فقط في عصور لاحقة، سوف يتم هجران هذا الفصل الحذر الواعي بين البديهيات والمسلمات وبات صدق البديهيات محل نظر، تماما مثل صدق المسلمات. أما بالنسبة إلى تعريفات اقليدس، فإنها ذات أنماط عديدة. بعضها تعريفات بالغة الوضوح وصادقة، بمعنى أنها تتيح إقامة الحجة من دون أدنى غموض - مثلا تعريف الدائرة كل النقاط على مسافة متساوية من نقطة أخرى هي المركز. بعض التعريفات الأخرى تكاد تكون كلمات نتفوه بها من دون الاقتناع بها كثيرا، فهي لعبر عن شيء ما مثل «أنا لا أعرف كيف أطرح هذا لكنك بالتأكيد ترى ما اقصده - الخط المستقيم معرف بأنه ما يقع بشكل مستو على نقاطه جميعا. وأخيرا تفيد التعريفات فقط في أن تجعل الموضوعات المطروحة للمناقشة دقيقة، والسياق الذي نرد فيه محددا بدقة. تبدأ التعريفات عادة بالتعبير «افترض»: «افترض أن مثلثا منفرج الزواية.... » بانتهاء العصور القديمة، تراكمت معارف هندسية ذات اعتبار من خصائص المثلثات والمضلعات والدوائر والمخروطات الإهليلجات القطوع الناقصة والقطوع الزائدة والقطوع (المكافئة إلى خصائص المنحنيات الأخرى الناشئة عن حركات بسيطة في هذا المدى كانت المعارف معنية أساسا بالمجسمات المتعددة السطوح والكرات والأسطوانات والقطوع الناقصة للدوران. ولا ننسى حساب المثلثات المستوي والكروي وأنه كان شديد المواءمة لتنظيم الأرصاد الفلكية.
أما في ما يتعلق بالحساب، وهو علم مفيد بقدر ما هو قاحل وغير شائق، فلن نقول شيئا بخلاف لفت الأنظار إلى أنه أدى إلى ميلاد الجبر والفضل يعود إلى ديوفانطس، الذي عاش في الإسكندرية إبان القرن الثالث الميلادي. لا نعرف عنه إلا القليل وأنه قضى سدس عمره طفلا. وواحدا على اثني عشر من عمره بالغا؛ أي أنه عاش سبعة أعوام زائدة قبل أن يرزق بابنه الذي عاش نصف ما عاشه أبوه وأخيرا أن ديوفانطس عمر أكثر من ابنه لمدة تعادل سدس عمره. محصلة كل هذه الحسابات تجعل عمر ديوفانطس أربعة وثمانين عاما . ربما كان معلما هو الذي اخترع الجبر. فمن السهل أن نتخيل شخصا فقيرا يمل من ترديد الحجج التي
تؤدي إلى الحسابات نفسها، ويدرك أخيرا أن القيم المعينة للأعداد غير ملائمة، وأن كل تلك الأمور هي نموذج العمليات على هذه الأرقام. ولتكن ما تكونه فلم يتصور أحد أنه من الضروري أكسمة الجبر بدهنة الجبر( أي جعله نسقا بديهيا)، أي وضع بديهيات له على طريقة اقليدس، لأن هذا قد تم بالفعل بالنسبة إلى نظرية الأعداد، وبخلاف هذا فإن الجبر - كما يسود الاعتقاد - ليس أكثر من مجموعة من الوصفات الملائمة لتلخيص بعض العمليات الحسابية المعروفة.
تأخر تطور الجبر طويلا بفعل الأساليب المعقدة التي استخدمها الإغريق والرومان في تدوين الأرقام. وفي ما بعد أزاحت الحضارة العربية هذه العقبة فقد جرى استعمال الأرقام «العربية» التي لانزال نستعملها حتى اليوم، مثلما نستعمل اختراعهم للصفر، وهو فكرة أسطورية واردة من الهند . وتبع هذا اختراع الأعداد السالبة. وكان التدوين الجبري ملائما، ذلك أن التعبير الرمزي الذي يمثل عمليات على الأرقام باستخدام علامات، مثل + ، - ، =) كان يحرز خطى تقدمية.
لا حدود لأهمية رموز التدوين في الرياضيات. إن رموز التدوين التي جرى انتقاؤها بعناية توعز بالعمليات الصائبة وتحرر الذهن من تشتت للجهد لا طائل من ورائه، بينما الرمزية الآتية عن سوء اختيار تمثل عقبة من عقبات التفكير.. من منظور المنطق والصرامة التدوين الرمزي غير موائم بيد أن له ثقله على العلاقة بين الخيال والصورية التدوين الرمزي الكفء لا بد ملهم ذو معنى، ملائم لمخيلتنا بقدر ما هو ملائم لموضوع البحث. هل هذا هو السبب الذي جعل الجبر من نواتج الحضارة العربية، التي ترفض أي أصنام وصور صريحة وأعطت الجبر اسمه؟
عرف الأقدمون كيفية حل معادلات الدرجة الثانية والمعادلات الخطية (معادلات الدرجة الأولى) فقط. وحينما بعثت الرياضيات في أوروبا، خلال عصر النهضة، اكتشف كاردان وتارتاليا منهجا لحل معادلات من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. وفي إنجاز هذا صودفت لأول مرة الأعداد التخيلية وقد كان النموذج الأصلي لها هو الجذر التربيعي للعدد «1-». وفي بعض الحالات، حينما نعمد إلى حل معادلة تكعيبية (أو من الدرجة الثالثة) - لكي نحصل على قيمة عددية محددة للمجهول - يحتاج المرء إلى أن يطرح في عملية الحل أعدادا تخيلية، تقوم بدور يشبه دور الوسطاء ولكنها لا تظهر في المعادلة الأصلية ولا في حلها النهائي). تؤكد هذه الظاهرة الغريبة، لأول مرة، الطبيعة المنفردة لعلم الجبر، مقارنة برياضيات اقليدس المدونة جيدا مما يجعل من الصعب اعتباره حاشية لعلم الحساب.
في القرن السابع عشر، جاء دور الهندسة لتصبح علما مصقولا، وذلك بفضل ديكارت وفرما، الفكرة الأساسية هي تعريف النقطة الهندسية عن طريق إحداثياتها - الأعداد التي تحدد موقع النقطة بالنسبة إلى نظام من المحاور. حينئذ يتحدد تماما المنحنى على السطح المستوي عن طريق معادلة تستوفيها إحداثيات نقاطه. بهذه الطريقة يمكن رد مشاكل عديدة في الهندسة إلى حسابات جبرية.
وكانت هذه خطوة واسعة إلى الأمام قطعتها الهندسة، لأنها لا تستطيع أن تتخلص من الإطار المحدد الذي فرضته مناهج اقليدس، حيث لم يكن ممكنا الوصول إلى منحنيات إلا من خلال السطوح المستوية والمستقيمات والدوائر والكرات والمخروطات. وأيضا أتاح التكنيك الجديد معالجة أسهل لمنحنيات معينة ظهرت في أواخر العصور القديمة - مثلا تلك المنحنيات التي تنشأ كمسارات لحركات من قبيل المنحنى الدويري الشهير الذي يرسمه ظفر مثبت في حافة عجلة تدور. وأيضا نشأ عن تلك المناهج المستجدة بعض الصعوبات العويصة والتي ستعمل خفيا على تعديل طبيعة الرياضيات. كانت الأجزاء المهيبة التي أضيفت إلى هندسة اقليدس قائمة على الجبر وحده، ولم تعد تقوم على البديهيات ذات الطبيعة الهندسية لكن الجبر ذاته، كما رأينا، يعاني من بعض أوجه القصور. كيف يمكن حل تلك الصعوبات؟ من الناحية العملية، كانت نوعية الحلول المطروحة لتلك الصعاب والشكوك أقرب إلى أسلوب الإسكندر في حل عقدة غورديان منها إلى منطق أقليدس المتعقل المثابر كانت الحل اللائق بجيش الغزاة تجاهل العقبات وامض قدما.
ينبغي ألا نهدر وقتا، لأن ثمة الكثير من الغنائم للظفر بها. وينتهي القرن السابع عشر بفعلة باهرة اختراع حساب التكامل وقد قام بهذا نيوتن وليبنتز تقريبا في الوقت نفسه. وهو في الواقع ذروة تقدم مطرد أسهم فيه رياضيو العصر العظماء أجمعون بدرجات متفاوتة، بيد أنه حساب أيضا وبالمعنى الحرفي سيل عرمرم بدأ ينهمر فيض باذخ راح يتدفق، حاملا معه مشكلات جديدة بقدر الحلول التي يتمخض عنها : نتائج جديدة مذهلة تكفي لملء مجلدات أويلر الضخمة الثلاثة والعشرين ولاتزال ثمة وفرة لعمالقة رياضيين آخرين الإخوة برنولي ولاغرانج ودولامبير ولابلاس وفوربيه الذين واصلوا طريق الكشف والإبداع حتى مجيء القرن التاسع عشر.
كم كان المثال الإغريقي نائيا قصيا حينما لم يتردد أويلر في أن يخط بقلمه أن حاصل « 1- 1+1 - 1+1 - 1+...» هو 2/1، حتى لو كانت حواصل الجمع المتتابعة الجزئية هي فقط «1» و«صفر». ومع ذلك كانت تلك المناهج غير المعتمدة في الأعم الأغلب تحرز نجاحا يفوق كل التوقعات المعقولة. وحين بدأت تلك الدفعة تخمد وتعود إلى الوراء وتراجع ما أنجزته بدأ نفر يتساءلون: كيف تعود الرياضيات ولودا منتجة من جديد؟ وأيضا كيف لها أن تصلح ذات البين مع المنطق الذي يطلب اليقين. سوف تشغل الإجابة عن السؤال الثاني البقية الباقية من هذا الفصل. وكما سنرى في هذه الإجابة عن السؤال الثاني نجد بالمثل مفتاح حل السؤال الأول.
 الاكثر قراءة في الفيزياء الرياضية
الاكثر قراءة في الفيزياء الرياضية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)