العاطفة: حين يصبح الشعور وعيًا، وتغدو الرحمة موقفًا
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
25/1/2026
ليست العاطفة مجرّد ارتعاشٍ عابر في القلب، ولا انفعالًا طارئًا يُربك العقل ثم يزول، بل هي أحد أعمدة التجربة الإنسانية، ومن أكثر القوى الخفيّة تأثيرًا في تشكيل الوعي والسلوك والموقف. فهي اللغة الأولى التي تعلّم بها الإنسان معنى القرب والبعد، والخوف والطمأنينة، والحب والكراهية، قبل أن يتعلّم الحساب والمنطق. ولهذا، لم تكن العاطفة يومًا نقيضًا للعقل كما صُوِّر لها أحيانًا، بل كانت دومًا قرينته التي تمنحه الاتجاه، وتمنع تحوّله إلى آلة باردة لا ترى في الإنسان سوى رقم أو وظيفة.
العاطفة، في جوهرها، ليست ضعفًا، بل هشاشة واعية، والهشاشة ليست عيبًا إنسانيًا، بل شرطًا من شروط التعاطف. فالذي لا يشعر لا يفهم، والذي لا يتأثر لا يتعظ، والذي يُلغِي عاطفته بحجّة العقلانية المطلقة، سرعان ما يجد نفسه قادرًا على تبرير القسوة؛ لأن العقل إذا انفصل عن الشعور تحوّل إلى أداة تبرير لا أداة حكمة. ولهذا كانت العاطفة، حين تُدار بوعي، عنصر توازن يمنع الإنسان من الانزلاق إلى التجريد القاسي، ويُبقيه قريبًا من جوهر الإنسانية.
وفي التجربة اليومية، لا يعيش الإنسان قراراته الكبرى بعقله وحده، مهما ادّعى ذلك. فالحب، والفقد، والخوف، والغضب، والأمل، عواطف تُعيد توجيه البوصلة الداخلية، وتؤثر في اختيارات مصيرية: من نحب، ومن نثق به، ومتى نصبر، ومتى نثور. والعاطفة هنا لا تُلغِي العقل، بل تضعه أمام امتحان أخلاقي دائم: كيف أستخدم ما أعرفه دون أن أجرح ما أشعر به؟ وكيف أضبط ما أشعر به دون أن أخون ما أعرفه؟
ولعلّ أصدق تمثّل لتحوّل العاطفة من حالة فردية إلى وعي جمعي، ما شهدناه من التفاف شعبي عالمي حول مأساة غزة، حيث خرجت العاطفة من نطاق التعاطف العابر إلى فعلٍ أخلاقي عام. لم يكن ذلك الحراك مجرّد انفعال لحظي أمام صور القصف والقتل والمجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بل كان تعبيرًا عن يقظة ضمير إنساني شعر بأن الصمت نفسه صار مشاركة في الجريمة. هنا لم تعد العاطفة دمعةً تُذرف ثم تُنسى، بل تحوّلت إلى موقف، وإلى خطاب احتجاجي، وإلى ذاكرة حيّة ترفض تطبيع الوحشية أو تبريرها. وفي هذا السياق، تكشف العاطفة عن وجهها الأرقى: لا بوصفها ضعفًا أمام الألم، بل بوصفها قدرة على تحويل الإحساس بالظلم إلى وعي كوني، يفضح القتل حين يُزيَّن بلغة السياسة، ويُعيد الاعتبار للقيمة الأخلاقية للإنسان، مهما حاولت القوة طمسها.
وفي الرؤية القرآنية، لا تُلغى العاطفة ولا تُدان، بل تُهذَّب وتُوجَّه. فالقرآن يخاطب القلب كما يخاطب العقل، ويستثير الشعور لا ليُغرق الإنسان في الانفعال، بل ليوقظه من اللامبالاة. الرحمة، والخوف، والرجاء، والحزن، كلها حاضرة بوصفها عناصر تكوين لا علامات ضعف. وحين يقول تعالى:
﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾،
فإنه لا يصف علاقة مثالية مجرّدة، بل يقرّ بأن العاطفة أساس الاستقرار الإنساني، وأن المجتمع الذي تُسحَق فيه الرحمة يتحوّل سريعًا إلى فضاء قاسٍ، مهما بلغ من تنظيم أو تقدّم مادي.
وكذلك حين يُخاطَب النبي ﷺ بقوله:
﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ﴾،
تتجلّى العاطفة بوصفها قوة قيادية، لا ضعفًا في الشخصية؛ لأن القسوة لا تبني ولاءً، ولا تصنع إنسانًا.
ويمضي القرآن أبعد من ذلك، فيكّرس العاطفة والمودّة أساسًا لبناء الأسرة والمجتمع، فلا يكتفي بالدعوة إلى الرحمة بوصفها قيمة عامة، بل يُنزِلها إلى أدق تفاصيل العلاقة الإنسانية. فحين يقول تعالى:
﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾،
فإنه لا يضع توصية أخلاقية مجرّدة، بل يؤسّس لثقافة شعورية تقوم على الامتنان والرعاية والاعتراف بالفضل. ثم يضيف بعدًا أعمق حين يقول:
﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾،
حيث تتحوّل العاطفة إلى سلوك لغوي ونبرة خطاب، لا مجرد إحساس داخلي. فالقرآن لا يطالب الإنسان بأن يحبّ والديه في قلبه فحسب، بل أن يُترجم هذا الحب في كلماته وصوته وصبره، لأن العاطفة، إن لم تتحوّل إلى فعل، تبقى ناقصة الأثر.
وفي مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تأخذ العاطفة بعدًا أخلاقيًا بالغ الدقّة. لم يكن الإمام يدعو إلى قتل الشعور ولا إلى إطلاقه بلا قيد، بل إلى ضبطه بالحكمة. فالحِلم عنده ليس إنكارًا للغضب، بل سيطرة عليه، والرحمة ليست تهاونًا، بل عدلًا مشبعًا بالإنسانية. وقد عبّر عن ذلك بقوله: «أملك نفسك عند الغضب، فإنك إن لم تملكها قتلتك»، مشيرًا إلى أن العاطفة حين تنفلت لا تُدمّر الآخرين فقط، بل تُدمّر صاحبها أولًا. وقال أيضًا: «قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه»، ليؤكد أن العاطفة لا بد أن تمرّ عبر الوعي قبل أن تتحوّل إلى قول أو فعل. ولهذا جاءت وصاياه متمحورة حول التوازن: أن يكون الإنسان رحيمًا دون ضعف، وحازمًا دون قسوة؛ لأن الخطر الحقيقي ليس في أن نشعر، بل في أن نفقد القدرة على إدارة شعورنا.
ومع الأئمة الأطهار عليهم السلام، تتحوّل العاطفة إلى موقف أخلاقي واعٍ. ففي تجربة الإمام الحسين بن علي عليه السلام، لم تكن العاطفة دمعة مجرّدة، بل وعيًا حيًّا بالظلم، وحبًا عميقًا للعدل، ورفضًا لأن يتحوّل الصمت إلى خيانة. كان البكاء في كربلاء موقفًا، وكانت الرحمة التي حملها الحسين حتى لخصومه تعبيرًا عن سموّ العاطفة حين تُربط بالقيمة. وكذلك في سيرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، تتجلّى العاطفة في الصبر الطويل، لا بوصفه خنوعًا، بل بوصفه ضبطًا داخليًا يمنع الكراهية من أن تُفسد الروح. فالعاطفة هنا لا تصرخ، لكنها لا تموت، بل تتحوّل إلى قوة داخلية تحمي الإنسان من التشظّي.
وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي، تصبح العاطفة ساحة صراع حقيقية. فثمة سلطات تدرك أن تحريك الخوف أسهل من بناء الوعي، وأن إثارة الغضب الجماعي أسرع من إقناع العقل، فتستثمر العاطفة لا بوصفها قوة إنسانية، بل أداة تعبئة وتضليل. غير أن الخطورة لا تكمن في العاطفة ذاتها، بل في الخلط بينها وبين التنازل عن الحقوق. فالعاطفة لا تعني الاستسلام، ولا الرحمة تعني القبول بالظلم، كما أن التعاطف لا يساوي التفريط بالكرامة. وفي المقابل، تظهر عاطفة من نوع آخر في لحظات الألم الجماعي، كما في فلسطين وغزة، حيث يتحوّل الحزن إلى وعي، والوجع إلى ذاكرة مقاومة، والعاطفة إلى رابط إنساني لا يُفرغ الموقف من مضمونه السياسي. وكذلك في تجارب الاحتلال والقهر، كما في العراق، حيث لم تكن العاطفة وقودًا للفوضى، بل دافعًا للمطالبة بالحق. هنا تتجلّى العاطفة الناضجة بوصفها قوة أخلاقية تُعزّز الموقف، لا شعورًا يُستخدم لتبرير التراجع.
أما على المستوى الشخصي، فالعاطفة هي أكثر ما يعرّي الإنسان أمام نفسه. الحب يكشف هشاشته، والفقد يكشف عمق تعلّقه، والخذلان يكشف حجم ثقته الممنوحة. وليس كل من يشعر يعرف كيف يتعامل مع شعوره؛ فهناك من يحوّل العاطفة إلى سجن، وهناك من يجعلها معبرًا للنضج. والعاطفة الناضجة لا تُلغِي الألم، لكنها تمنع تحوّله إلى مرارة دائمة، وتمنح الإنسان القدرة على الاستمرار دون أن يتحوّل إلى نسخة قاسية من نفسه.
ولعل أخطر ما يواجه الإنسان المعاصر هو الخلط بين العاطفة والاندفاع. فالعاطفة ليست قرارًا متسرّعًا، ولا ردّ فعل أعمى، بل حالة وعي تحتاج إلى زمن للفهم. ولهذا، فإن المجتمعات التي تدرّب أبناءها على كبت المشاعر تُنتج أفرادًا قساة من الخارج، هشّين من الداخل، فيما المجتمعات التي تدرّبهم على فهم مشاعرهم تُنتج بشرًا أكثر قدرة على التعاطف والمسؤولية.
وفي الختام، لا يمكن للإنسان أن يكون إنسانيًا بلا عاطفة، ولا عادلًا بلا رحمة، ولا حكيمًا بلا قدرة على الشعور بالآخر. فالعاطفة ليست عبئًا على الوعي، بل شرطًا من شروطه، وليست ضعفًا في البناء الإنساني، بل علامة على اكتماله. وحين تُدار العاطفة بوعي، تصبح جسرًا بين العقل والقلب، وبين الفرد والعالم، وبين الإنسان وما يجب أن يكونه. هكذا، لا تعود العاطفة مجرد إحساس، بل مسؤولية أخلاقية، وامتحانًا دائمًا لمدى قدرتنا على أن نبقى بشرًا في عالم يزداد قسوة.

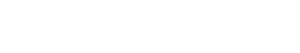




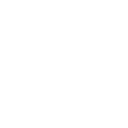














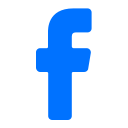

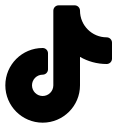








.png) د.أمل الأسدي
د.أمل الأسدي .png) منذ 6 ايام
منذ 6 ايام 









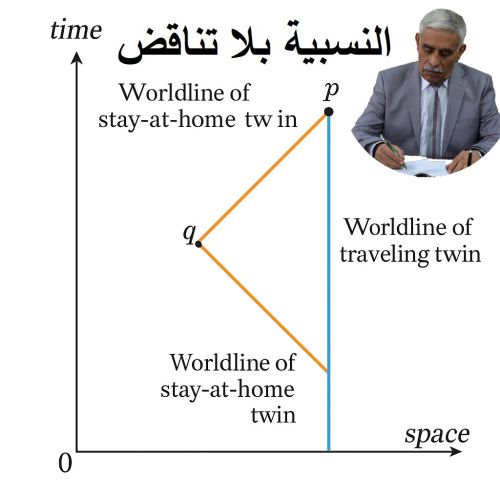






 الريفُ العراقيّ .. إضطهادٌ مستمرّ
الريفُ العراقيّ .. إضطهادٌ مستمرّ أشباه السيارت
أشباه السيارت حوار من عالم آخر مع احد الناجين من "فيروس كورونا"
حوار من عالم آخر مع احد الناجين من "فيروس كورونا" EN
EN