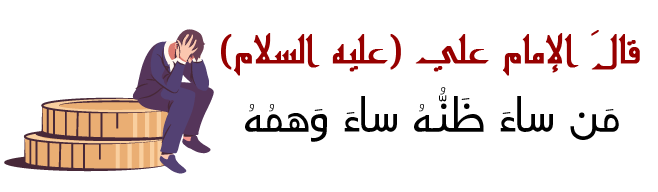
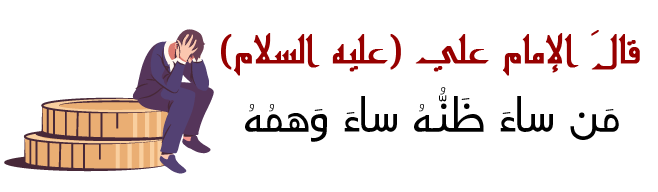

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017
التاريخ: 22-2-2017
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 13-2-2017
|
قال تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [النساء : 33] .
﴿ولكل﴾ واحد من الرجال والنساء ﴿جعلنا موالي﴾ : أي ورثة هم أولى بميراثه عن السدي . وقيل : عصبة عن ابن عباس والحسن . والأول أصح لقوله سبحانه فهب لي من لدنك وليا يرثني فجعله مولى لما يرث ووليا له لما كان أولى به من غيره ومالكا له كما يقال لمالك العبد مولاه ﴿مما ترك الوالدان﴾ : أي يرثون أو يعطون مما ترك الوالدان ﴿والأقربون﴾ : الموروثون ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾ أي ويرثون مما ترك الذين عقدت أيمانكم لأن لهم ورثة أولى بميراثهم فيكون قوله ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾ : عطفاً على قوله ﴿الوالدان والأقربون﴾ ﴿فأتوهم نصيبهم﴾ أي فأتوا كلا نصيبه من الميراث وهذا اختيار الجبائي ، وقال : الحليف لم يؤمر له بشيء أصلا . وقال أكثر المفسرين : إن قوله ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾ مقطوع من الأول فكأنه قال : والذين عاقدت أيمانكم أيضا فأتوهم نصيبهم ثم اختلفوا فيه على أقوال :
(أحدها) : أن المراد بهم الحلفاء عن قتادة وسعيد بن جبير والضحاك . وقالوا : إن الرجل في الجاهلية كان يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف وعاقد أبو بكر مولى فورثه فذلك قوله ﴿فأتوهم نصيبهم﴾ : أي أعطوهم حظهم من الميراث ثم نسخ ذلك بقوله : ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ . وقال مجاهد : معناه فأتوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفد ولا ميراث فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة ويؤيده قوله تعالى {أوفوا بالعقود} وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) في خطبة يوم فتح مكة : " ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " . وروى عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال : " شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه " (وثانيها) : أن المراد بهم قوم آخى بينهم رسول الله من المهاجرين والأنصار حين قدموا المدينة وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة ثم نسخ الله ذلك بالفرائض عن ابن عباس وابن زيد (وثالثها) : أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية ومنهم زيد مولى رسول الله فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية فذلك قوله ﴿فأتوهم نصيبهم﴾ عن سعيد بن المسيب ﴿أن الله كان على كل شيء شهيدا﴾ : أي لم يزل عالما بجميع الأشياء مطلعا عليها جليها وخفيها.
________________
1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 76-77 .
{ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} . المراد بالموالي هنا الورثة ، وقد ذكر اللَّه منهم في هذه الآية ثلاثة أصناف : الأول الوالدان ، ويشملان الأجداد والجدات . الثاني الأقربون ، ويشملون الأولاد والأخوة والأعمام والأخوال . الثالث الذي جرى بينهم وبين المورّث عقد خاص أو عام يترتب عليه الإرث ، والعقد الخاص ، كعقد الزواج وعقد الملك ، وعقد ضمان الجريرة ، والعقد العام هو الإسلام ، وكل هؤلاء يدخلون في قوله تعالى : { والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ } .
وعقد الزواج معروف ، أما عقد الملك فهو أن يملك الحر عبدا ، ثم يعتقه تقربا إلى اللَّه ، لا لقاء شيء ، أو كفارة عن شيء ، فإذا مات هذا العبد المعتق ، ولا وارث له ورثه الذي كان قد أعتقه . أما عقد ضمان الجريرة ، أي الجناية فهو أن يتفق اثنان على أن يضمن كل منهما جناية الآخر ، أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر ، دون العكس ، فإذا تم الاتفاق بينهما حسب الشروط المقررة في كتب الفقه كان على الضامن بدل الجناية ، وله لقاء ذلك ميراث المضمون إذا لم يكن له من وارث إلا الضامن ، أما عقد الإسلام فالمراد به العهد العام بين النبي (صلى الله عليه وآله) ومن آمن به ، فإذا مات المسلم ، ولا وارث له إطلاقا فميراثه للنبي (صلى الله عليه وآله) أو لمن يقوم مقامه ، فقد روي عن رسول اللَّه انه قال : « أنا وارث من لا وارث له » . وفي رواية ثانية : « أنا ولي من لا ولي له » .
وفي ثالثة : « أنا مولى من لا مولى له ، أرث ماله ، وأفك عنه » . . وكفى دليلا على ذلك قوله تعالى : { النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ - 6 الأحزاب } .
وفي كتاب وسائل الشيعة العديد من الروايات ان عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول : « إذا مات الرجل ، وترك مالا ، ولا وارث له أعطوا المال أهل بلده » . ولا يتنافى هذا مع قول الرسول (صلى الله عليه وآله) ، لأن الرسول قد وهب حقه في هذا الميراث للفقراء من أهل بلد الميت .
وتقدمت الإشارة إلى نصيب الأبوين والأخوة والزوجين في الآية 12 وما بعدها من هذه السورة ، وتفصيل أنصبة جميع الورثة في كتب الفقه .
____________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 312 – 313 .
قوله تعالى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ } الآية ، الموالي جمع مولى ، وهو الولي وإن كثر استعماله في بعض المصاديق من الولاية كالمولى لسيد العبد لولايته عليه ، والمولى للناصر لولايته على أمر المنصور ، والمولى لابن العم لولايته على نكاح بنت عمه ، ولا يبعد أن يكون في الأصل مصدرا ميميا أو اسم مكان أريد به الشخص المتلبس به بوجه كما نطلق اليوم الحكومة والمحكمة ونريد بهما الحاكم.
والعقد مقابل الحل ، واليمين مقابل اليسار ، واليمين اليد اليمنى ، واليمين الحلف وله غير ذلك من المعاني.
ووقوع الآية مع قوله قبل : { وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ } ، في سياق واحد ، واشتمالها على التوصية بإعطاء كل ذي نصيب نصيبه ، وأن الله جعل لكل موالي مما ترك الوالدان والأقربون يؤيد أن تكون الآية أعني قوله : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنا } إلخ بضميمة الآية السابقة تلخيصا للأحكام والأوامر التي في آيات الإرث ، ووصية إجمالية لما فيها من الشرائع التفصيلية كما كان قوله قبل آيات الإرث : { لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ } الآية تشريعا إجماليا كضرب القاعدة في باب الإرث تعود إليه تفاصيل أحكام الإرث .
ولازم ذلك أن ينطبق من أجمل ذكره من الوراث والمورثين على من ذكر منهم تفصيلا في آيات الإرث ، فالمراد بالموالي جميع من ذكر وارثا فيها من الأولاد والأبوين والإخوة والأخوات وغيرهم.
والمراد بالأصناف الثلاث المذكورين في الآية بقوله : { الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ } الأصناف المذكورة في آيات الإرث ، وهم ثلاثة : الوالدان والأقربون والزوجان فينطبق قوله : { الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ } على الزوج والزوجة.
فقوله : { وَلِكُلٍّ } أي ولكل واحد منكم ذكرا أو أنثى ، جعلنا موالي أي أولياء في الوراثة يرثون ما تركتم من المال ، وقوله { مِمَّا تَرَكَ } ، من فيه للابتداء متعلق بالموالي كأن الولاية نشأت من المال ، أو متعلق بمحذوف أي يرثون أو يؤتون مما ترك ، وما ترك هو المال الذي تركه الميت المورث الذي هو الوالدان والأقربون نسبا والزوج والزوجة.
وإطلاق { الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ } على الزوج والزوجة إطلاق كنائي فقد كان دأبهم في المعاقدات والمعاهدات أن يصافحوا فكأن أيمانهم التي يصافحون بها هي التي عقدت العقود ، وأبرمت العهود فالمراد : الذين أوجدتم بالعقد سببية الازدواج بينكم وبينهم.
وقوله : { فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } الضمير للموالي ، والمراد بالنصيب ما بين في آيات الإرث ، والفاء للتفريع ، والجملة متفرعة على قوله تعالى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ } ، ثم أكد حكمه بإيتاء نصيبهم بقوله : { إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً } .
وهذا الذي ذكرناه من معنى الآية أقرب المعاني التي ذكروها في تفسيرها ، وربما ذكروا أن المراد بالموالي العصبة دون الورثة الذين هم أولى بالميراث ، ولا دليل عليه من جهة اللفظ بخلاف الورثة.
وربما قيل : إن « من » في قوله { مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ } ، بيانية والمراد بما الورثة الأولياء ، والمعنى : ولكل منكم جعلنا أولياء ، يرثونه وهم الذين تركهم وخلفهم الوالدان والأقربون .
وربما قيل : إن المراد بـ { الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ } الحلفاء ، فقد كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من مال الحليف .
وعلى هذا فالجملة مقطوعة عما قبلها ، والمعنى : والحلفاء آتوهم سدسهم ، ثم نسخ ذلك بقوله : { وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ } . وقيل : إن المراد : آتوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفد ، ولا ميراث ، وعلى هذه فلا نسخ في الآية .
وربما قيل : إن المراد بهم الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة ، وكانوا يتوارثون بذلك بينهم ثم نسخ ذلك بآية الميراث .
وربما قيل : أريد بهم الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم بوصية ، وذلك قوله تعالى : { فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } .
وهذه معان لا يساعدها سياق الآية ولا لفظها على ما لا يخفى للباحث المتأمل ، ولذلك أضربنا عن الإطناب في البحث عما يرد عليها.
__________________________
1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص289-291 .
يعود القرآن مرّة أُخرى إِلى مسألة الإِرث إِذ يقول : {ولكلّ جعلنا موالي (2) ممّا ترك الوالدان والأقربون} أي لكل رجل أو امرأة جعلنا ورثة يرثون ممّا ترك الوالدان والأقربون الذي يجب أن يقسّم بينهم طبق برنامج خاص .
إنّ هذه العبارة هي ـ في الحقيقة ـ خلاصة أحكام الإرث التي مرّ ذكرها في الآيات السابقة في مجال الأقرباء، وهي مقدمة لحكم سيأتي بيانه في ما بعد .
ثمّ إنّ الله تعالى يضيف قائلا : {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} أي ادفعوا إِلى الذين عقدتم معهم عقداً نصيبهم من الإِرث .
والتعبير عن الميثاق بعقد اليمين (وهو العقد باليد اليمنى) لأجل أنّ الإِنسان غالباً ما يستفيد من يده اليمنى للقيام بأعماله ، كما أنّ الميثاق يشبه نوعاً من العقد (في مقابل الحل) .
والآن لننظر من هم الذين عقد معهم الميثاق ، الذين لابدّ أن يعطوا نصيبهم من الإِرث ؟
يحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد هو الزوج والزوجة لأنّهما عقدا في ما بينهما رابطة الزوجية .
ولكن هذا الإِحتمال يبدو مستبعداً ، لأنّ التعبير عن الزواج بعقد اليمين ونظيره في القرآن الكريم قليل جداً ، هذا مضافاً إِلى أنّه يعد تكراراً للمواضيع السابقة .
إنّ ما هو أقرب إِلى مفهوم الآية هو عقد «ضمان الجريرة» الذي كان رائجاً قبل الإِسلام، وقد عدله الإِسلام بعد أن أقرّه لما فيه من ناحية إِيجابية وهو : «أن يتعاقد شخصان فيما بينهما على أن يتعاونا فيما بينهما بشكل أخوي أن يعين أحدهما الآخر عند المشكلات ، وإِذا مات أحدهما قبل الآخر ورثه الباقي» ولقد أقر الإِسلام هذا النوع من التعاقد الأخوي الودي، ولكنّه أكد على أنّ التوارث بسبب هذا الميثاق إنّما يمكن إِذا لم يكن هناك ورثة من طبقات الأقرباء ، يعني إِذا لم يبق أحد من الأقرباء ورث ضامن الجريرة الذي وقع بينه وبين الآخر مثل هذا العقد (لمعرفة التفاصيل أكثر راجع بحث الإِرث في الكتب الفقهية) (3) .
ثمّ ختم سبحانه الآية بقوله : {إنّ الله كان على كل شيء شهيداً} أي إِذا قصرتم في إعطاء نصيب الورثة ولم تعطوهم حقوقهم كاملة ، علم الله بذلك ولم يخف عليه ما فعلتم ، لأنّه على كل شيء شهيد وبكل شيء عليم .
_________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص116-117 .
2. «الموالي» جمع مولى ، وهي في الأصل من مادة الولاية بمعنى الإِتصال والإِرتباط ، وتطلق على جميع الأفراد الذين يرتبط بعضهم ببعض بنوع من الإِرتباط ، غاية ما هناك أنّها تكون في بعض الموارد بمعنى إرتباط الولي ، مع أتباعه ، وأمّا في الآية الحاضرة فتكون بمعنى الورثة .
3. صورة عقد ضمان الجريرة هكذا «عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك» فيقول الآخر : «قبلت» .

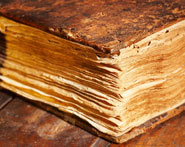
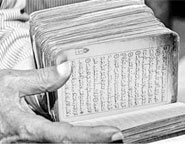
|
|
|
|
دراسة تكشف "مفاجأة" غير سارة تتعلق ببدائل السكر
|
|
|
|
|
|
|
أدوات لا تتركها أبدًا في سيارتك خلال الصيف!
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تؤكد الحاجة لفنّ الخطابة في مواجهة تأثيرات الخطابات الإعلامية المعاصرة
|
|
|