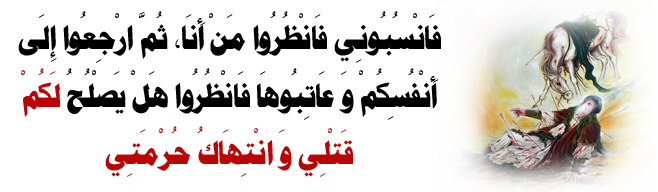
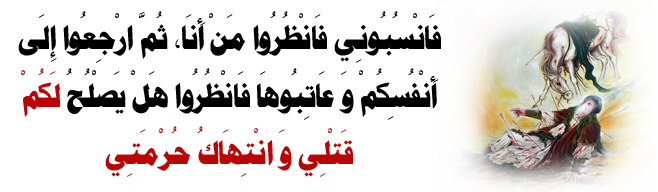

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
التاريخ: 10-8-2016
التاريخ: 4-9-2016
التاريخ: 4-9-2016
|
...[هناك فرق بين] مسألة الجبر والاختيار[ومسألة القضاء والقدر فـ] ينبغي أن نتكلّم بكلام موجز عن مسألة القضاء والقدر التي هي من أهمّ المسائل كتاباً وسنّة وعقلا لما بينهما من الصلة الوثيقة، وقد ورد الكلام في القضاء والقدر في الأخبار المأثورة عن أئمّتنا (عليهم السلام)(1).
ولا بدّ قبل بيان المختار في أصل المسألة من تقديم اُمور:
الأمر الأوّل: في أنّه ما الفرق بين المسألتين: مسألة الجبر والاختيار ومسألة القضاء والقدر؟
تفترق مسألة القضاء والقدر عن مسألة الجبر والاختيار في أمرين:
أحدهما: أنّ الاُولى أعمّ من الثانيّة من ناحية سعة شمولها لأعمال العباد وغيرهم فإنّ القضاء والقدر جاريان في جميع الكائنات بخلاف مسألة الجبر والاختيار فإنّها مطروحة في مجال أعمال الإنسان فقط.
ثانيهما: أنّ المسألة الاُولى بلحاظ انتساب الأفعال إلى الله تعالى والمسألة الثانيّة بلحاظ انتساب الأفعال إلى العباد أنفسهم كما لا يخفى. ولكن مع ذلك فإنّ بينهما قرابة شديدة وربط وثيق وإنّ أدلّة المسألتين متقاربة جدّاً.
الأمر الثاني: أنّ القضاء والقدر في لسان الفلاسفة يأتي على معنيين:
أحدهما : القضاء والقدر العلميين، بمعنى أنّ القضاء عبارة عن العلم الإجمالي للباري تعالى بجميع الموجودات وهو عين ذاته تعالى، وأمّا القدر فهو علمه التفصيلي بجميع الموجودات وهو عين ذات الموجودات نفسها.
ثانيهما: القضاء والقدر العمليين التكوينيين، بمعنى أنّ القضاء هو خلق الصادر الأوّل الذي يتضمّن جميع الموجودات واندرج فيه العالم بتمامه، والقدر عبارة عن إيجاد الموجودات المتكثّرة، ولا يخفى ما فيه من الإشكال في المباني.
الأمر الثالث: في معنى القضاء والقدر في اللّغة وفي لسان الآيات.
ففي مفردات الراغب: «القضاء فصل الأمر، قولا كان ذلك (مثل قول القاضي) أو فعلا (نحو قوله تعالى فقضاهنّ سبع سموات) وكلّ واحد منهما على وجهين: إلهي وبشري ... إلى أن قال في مقام بيان الفرق بين القضاء والقدر: والقضاء من الله أخصّ من القدر لأنّه الفصل بعد التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل بعد التقدير».
وأمّا المستفاد من موارد استعمالها في القرآن فهو أنّ القضاء هو الحكم القطعي الإلزامي تكوينياً كان أو تشريعيّاً، فالتكويني منه نظير ما جاء في قوله تعالى: {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [آل عمران: 47] والتشريعي ما جاء في قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، وأمّا القدر فهو بمعنى تعيين المقدار إمّا تكويناً نحو قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: 21] ونحو قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ} [المؤمنون: 18] ، أو تشريعاً نحو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] الذي ورد في تعيين وتحديد تكليف المعسر والموسع في متعة المطلّقات اللاتي لم يفرض لهنّ المهر.
والمختار في المقام الذي يلائم المعنى اللغوي وظواهر الآيات والرّوايات هو أنّ القضاء والقدر على نحوين: تشريعي وتكويني، والمراد من القضاء التشريعي هو مطلق الواجبات والمحرّمات التي أمر المكلّف بإتيانها أو نهى عن ارتكابها، ومن القدر التشريعي هو مقدار هذه الواجبات والمحرّمات وحدودها ومشخّصاتها، فمثلا أصل وجوب الصّلاة قضاء الله، ووجوب إتيانها سبع عشرة ركعات في الأوقات الخمسة قدره، وهكذا بالنسبة إلى الزّكاة والصّيام والحجّ وسائر التكاليف، ومن أوضح الشواهد على هذا المعنى وأتقنها ما مرّ من بيان المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما كان جالساً بالكوفة منصرفاً من صفّين وهو حديث طويل يشتمل على فوائد جمّة، وقد ورد في ذيله: «ثمّ تلا عليه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } [الإسراء: 23] ولا إشكال في أنّ المراد من القضاء في هذه الآية إنّما هو القضاء التشريعي.
وأمّا المراد من القضاء والقدر التكوينيين فهو نفس قانون العلّية وإنّ كلّ شيء يوجد في عالم الوجود وكلّ حادث يتحقّق في الخارج يحتاج إلى علّة في أصل وجوده (وهو القضاء)، وفي تقديره وتعيين خصوصّياته (وهو القدر) فمثلا إذا انكسر زجاج بحجر فأصل الانكسار هو القضاء، أي عدم تحقّقه بدون العلّة، وأمّا مقدار الانكسار المناسب لقدر الحجر وشدّة الاصابة فهو القدر.
لا يقال: «لو كان الأمر كذلك أي كانت جميع الكائنات محكومة لقانون العلّية والقضاء والقدر التكوينيين لزم أن تكون أفعال العباد أيضاً محكومة لهذا القانون ويلزم منه الجبر» لأنّه قد مرّ سابقاً أنّ من قضاء الله التكويني وقدره صدور أفعال العباد من محض اختيارهم وإرادتهم وأنّ الجزء الأخير للعلّة التامّة فيها إنّما هو اختيار الإنسان الذي قضى الله عليه وقدره في وجوده، ولذلك قلنا: أنّ إسناد الفعل إلى الإنسان حقيقي كما أنّ إسناده إلى الله تعالى في نفس الوقت حقيقي أيضاً.
والشاهد على ذلك ما هو المعروف من رواية ابن نباتة قال: إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين، تفرّ من قضاء الله؟ قال: «أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله عزّ وجلّ»(2).
فإنّه على كلا تفسيريه شاهد لما قلناه، فإن كان المراد منه القضاء والقدر التكوينيين فمعناه أنّي أفرّ من قضاء الله التكويني (وهو أصل سقوط الحائط المائل على الإنسان الموجب للجرح أو القتل) إلى قدره التكويني وهو أنّ الحائط المائل يوجب قتل الإنسان أو جرحه فيما إذا لم يعمل الإنسان اختياره ولم يفرّ منه بإرادته، فإنّ أصل إيجاب الحائط المائل بعد سقوطه قتل الإنسان من قضاء الله، ولكن هذا القضاء مقدّر ومشروط بعدم إعمال الإنسان اختياره وإرادته وبعدم عدوله وفراره منه إلى مكان آخر.
وإن كان المراد منه القضاء التكويني والقدر التشريعي فمعناه أنّ موت الإنسان بالحائط المائل وإن كان بقضاء الله وإرادته ولكنّه تعالى أمر الإنسان تشريعاً بالعدول والفرار، فكما أنّ موت الإنسان بالحائط من قضاء الله التكويني يكون فرار الإنسان منه أيضاً من قدره التشريعي.
ولا يخفى أنّ الحديث على كلا المعنيين أصدق شاهد على أنّ شمول قانون العلّية لجميع الأشياء التي منها أفعال الإنسان الاختياريّة لا ينافي اختياره وإرادته.
______________________
1. راجع بحار الأنوار: ج 5، فقد أورد فيه العلاّمة المجلسي (رحمه الله) روايات المسائل الثلاثة: مسألة الجبر والاختيار، ومسألة السعادة والشقاوة ومسألة القضاء والقدر.
2. بحار الأنوار: ج 5، ص 114، الطبع الحديث لبيروت.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|