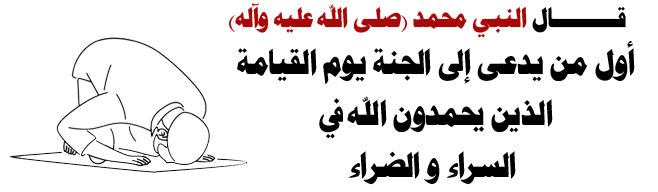
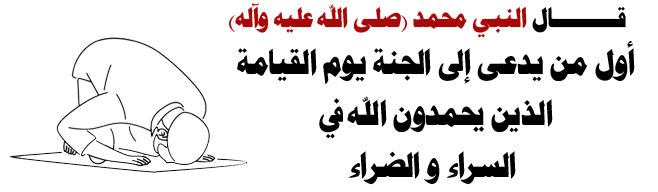

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-10-2014
التاريخ: 24-10-2014
التاريخ: 5-08-2015
التاريخ: 2-07-2015
|
الحكمة ربّما تُفسّر بالعلم بالأشياء على ما هي عليه ...
وربّما تفسّر بإصدار الأشياء وإبداعها على أكمل ما ينبغي أن يصدر ، وهذا المعنى هو المقصود في هذا المبحث ، والإنصاف أنّه أشرف من أكثر المسائل ، ومع ذلك قد تسامح فيه الكلاميون ولم يبحثوا عنه حقّ البحث .
وكيف ما كان ، والذي يدلّ على إثبات حكمته بهذا المعنى ، وأنّه لا يفعل إلاّ ما هو أكمل الوجوه الممكنة وأفضلها ، وجوه :
الأول : إنّه تعالى عالم بجميع جهات الفعل المحسّنة والمقبّحة ، وقادر على إيجاده بأيّ وجه شاء، وليس له حاجة وشهوة بشيء أصلاً ، فلا مانع ولا رادع له من إتيانه أبداً ، فإذا فُرض دوران الأمر بين إيجاد شيء على وجه أكمل وأسدّ ممكن ، وإيجاده على وجه كامل فضلاً عن ناقص ، فلا شكّ في اختياره تعالى الجانب الأَوّل بالضرورة ، أَلا ترى أنّا معاشر العقلاء في مفروض المثال ، نختار إيجاد الشيء على النحو الأكمل ، فالأكمل بطبيعة عقولنا وخميرة فطرتنا ، بلا تردد وتوقّف ، فما علمك بالواجب المتعالي عن النقصان ، المتكامل ذاتاً بكل الكمال ؟
فإن قلت : فكيف هؤلاء العقلاء الذين يختارون اللذات الآنية ، والشهوات الدنية ، ويؤثرونها على الأنعام الدائمية والآلاء العظيمة ؟ وكيف يرجّحون مقتضى الشهوية والغضبية على العاقلة؟ وغضب الخالق على رضاه ؟
قلت : المختار لهذه الأُمور حين اختياره لا محالة يرى أرجحية فعلها من تركها وإلاّ لَما فعلها ، فالجاني ـ لضعف عقله وغلبة شهوته أو غضبه ـ يعتقد في ذلك الحين أنّ جريمته أرجح من تركها ، فيرتكبها ولا دخل لمفسدتها الواقعية في اختياره هذا ، واعتقاده الأرجحية كما لا يخفى ، فهذا السؤال غير متوجّه إلى المقام ، فإنّ الإقدام على القبيح إمّا من جهة الجهل ، أو الغفلة عن حقيقة الحال ، أو من جهة مزاحمة الداعي ، ومحل الكلام فرض انتفاء الجميع ، وإن شئت فقل: إنّ اختيار الناقص بل الكامل على الأكمل في مفروض المثال ، ترجيح المرجوح على الراجح، وهو ممتنع عقلاً .
الثاني : إنّ إتقان أكثر أفعاله محرز ، وكلّ ما يزداد في رقي العلوم ويتّسع دائرتها ، يزداد في انكشاف حكمته البالغة المتحقّقة في الأشياء ، ويظهر إتقان المصنوعات وإحكامها على وجه أدق، تندهش به العقول وتضطرب الأفكار ، فيضطر الإنسان إلى الإقرار بحكمته ، وكمال خلقته ، وتمام فاعليته . فلست أن ترى: { فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ } والبصيرة كرّات: { يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ}[الملك: 3، 4] والبصيرة عاجزة وهي متحيّرة .
وعن هرشل : كلّما اتّسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدافعة القوية ، على وجود خالق أزلي لا حدّ لقدرته ولا نهاية ، فالجيولوجيون ـ علماء طبقات الأرض ـ والرياضيون والطبيعيون ، قد تعانوا وتضامنوا على تشييد صَرح العلم ، وهو صرح عظمة الله وحده . انتهى .
فالناظر لهذه الكائنات المرموزة التي تظهر كلّ يوم عجائبها ، بكراتها السامية المنظّمة الكثيرة الكبيرة ، التي تخرج عن سلطان عقولنا ، وبموجوداتها الأرضية البرية والبحرية إلى المكروبات الصغار ، وإلى حِكم أعضاء الإنسان نفسه وإلى ... وإلى ... وإلى ما لا نهاية، يتيقّن ـ يقيناً تامّاً قوياً متأكداً وأشدّ من كلّ يقين ـ أنّ فاعلها وموجِدها خلق جميع أفعاله بإحكام وإتقان ، كما إذا شاهدنا ماكنةً دقيقة ، وعلمنا إحكام جملة من أجزائها وجهلنا إتقان بعضها ، فإنّ عقلنا يحكم بإتقانه واقعاً ، ولا يجعل جهله دليلاً على عدم إتقانه ، فهذا الاستقراء وإن كان ناقصاً ؛ ضرورة عدم إحراز الحكمة في جميع أفعاله غير أنّ العقل ـ بقوة الحدس ـ يذعن بحكمته تعالى مطلقاً إذعاناً قطعياً قهرياً .
هذا ، ولكن مقتضى هذه الحجة إثبات محكمية أفعاله وإتقانها وعدم الخلل فيها ، وأمّا صدورها عنه على أكمل الوجوه الممكنة كما هو المقصود فلا يثبت بها ، فإنّا لم نحرز المقيس عليه بهذا الوصف ، بل لا يمكن للبشر العادي تحصيله ، فقد ظهر الفرق بينهما وبين الحجّة الأُولى في المفاد .
الثالث : إنّ إرادته تعالى هو علمه بالنظام الأكمل ، فكل أكمل فهو موجود لا محالة ؛ ضرورة استحالة تخلّف المعلول عن علّته ، فلو تحقّق ما ليس بأكمل وأصلح في الخارج ، فقد وُجد المعلول بلا علّة ، وهذا هو الترجّح بلا مرجّح .
أقول : وهذا أحسن الأدلة حتى من الوجه الأَوّل ، فإنّه يبطل إمكان اختيار المقابل للأكمل فضلاً عن وقوعه .
لكن يرد عليه : أَوّلاً : ما مرّ من إبطال كون العلم إرادةً ومؤثراً .
وثانياً : إنّه لا دليل على كون العلم بالأصلح هو الإرادة ، بل يمكن أن يكون العلم بالصالح إرادة فلا يثبت المقصود ، إلاّ أن يقال : إنّ اختيار الكامل وترك الأكمل ـ مع إمكانه ـ شر ، وهو ممتنع على الواجب ، فتأمّل . فإنّ العلم بالأصلح وأن لم يكن إرادةً ومؤثّراً ، لكن لا شك في أنّه مرجّح لإرادته وإحداثه ، فيتمّ به المطلوب .
الرابع : إنّ اختيار غير الأكمل مع إمكانه نقص ، وهو عليه محال ، لكنّه مزيّف بأنّ النقص في أفعاله ، هو عبارة أُخرى عن القبح الممتنع عليه من جهة حكمته ، فيكون الاستدلال دورياً .
الخامس : دلالة النقل عليه ، فقد وصف الله نفسه في كتابه بالحكيم {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} [النساء: 122]، وهكذا في السُنة .
قال الفاضل الطريحي في مجمع البحرين : المحكم في اللغة المضبوط المتقن ، الحكمة العلم الذي يرفع الإنسان عن فعل القبيح ، مستعار من المحكمة : اللجام ، وهي ما أحاط بحَنك الدابة ، يمنعها الخروج ، والحكمة فهم المعاني ، سُمّيت حكمة لأنّها مانعة عن الجهل .
ثمّ قال : ومن أسمائه : الحكيم والقاضي ، فالحكيم فعيل بمعنى فاعل ، أو هو الذي يُحكم الأشياء ويتقنها ، فهو فعيل بمعنى مفعل ، أو ذو الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم انتهى أقول : المقطوع من الكتاب والسُنة مثل قوله تعالى : {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ } [السجدة: 7] وغيره هو حكمته بمعنى إتقان فعله ، وأمّا إنّه على أكمل أنحائه الممكنة فلا، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني في المفاد .
هذا ولكنّ المعنى الأَوّل وإن ثبت شرعاً لكنّه غير قابل للتعبّد ؛ إذ حجّية الشرع موقوفة على امتناع الكذب والقبح عليه تعالى ، وهذا الامتناع موقوف على حكمته ، وعدم الفساد في أفعاله ، نعم إذا ثبت عقلاً إحكام أفعاله ، وإنّه لا يفعل القبيح الفاسد كما في الوجه الثاني ـ وهو المستفاد من الوجه الأَوّل أيضاً بالأولوية ـ أمكن التعبّد بأخباره ، بأنّه يُصدر الأشياء عنه بأكمل محتملاتها الممكنة ، ولكنّه غير واقع ، فما يصحّ به التعبّد لم يثبت شرعاً ثبوتاً قطعياً ، وما لا يصلح التعبّد به فهو ثابت كذلك . فلابدّ لنا من حمله على الإرشاد إلى حكم العقل بحكمته أو إثبات وجوده وغيره ، فتدبّر جيداً .
فالعمدة في المقام هو الوجهان الأَوّلان ، أَوّلهما برهان لمّي ، وثانيهما دليل إنّي ، والأَوّل يدلّ على أنّ الصادر عنه يكون على نحو الأكمل ، بل وعلى لزوم صدور الأكمل عنه لزوماً غير منافٍ لاختياره ، والثاني يدل على أنّ أفعاله محكمة متقنة ، فلا خلل ، ولا فساد ، ولا قبح ، ولا نقص ، في أفعاله تعالى .
في أدلّة النظام العقلي الحاضر :
بعد ما تقرّر أنّ أفعاله تعالى على أفضل ما ينبغي أن تكون ، وأكمل ما يمكن أن تصدر عنه ، بحيث لا يتصوّر مرتبة أرقى ممّا هي عليه ، فقد ظهر أنّه لا يمكن وجود نظام أحسن وأكمل من النظام الفعلي الحاضر ، فإنّه على آخر درجة من درجات الكمال ، وكأنّه ظاهر لا يحتاج إلى بيان أزيد ممّا تقدّم .
ولهذا المطلب أدلة أُخرى ذكرها الفلاسفة وغيرهم ، إلاّ أنّها بين ما يرجع إلى المختار ، وبين ما لا يتمّ على أُصولنا المبرهن عليها ، ونحن نذكر وجهين منها :
الأَوّل : ما عن الغزالي من أنّه لا يمكن أن يوجد العالم أحسن ممّا هو عليه ؛ لأنّه لو أمكن ذلك ولم يعلم الصانع المختار أنّه ممكن إيجاد ما هو أحسن ، فيتناهى علمه المحيط بالكلّيات والجزئيات ، وإن علم ولم يفعل مع القدرة عليه فهو يناقض جوده الشامل لجميع الموجودات .
واستحسنه العربي في محكي فتوحاته ، ثمّ الحكيم الشيرازي في أسفاره ، فقال في ربوبياتها: وهو كلام برهاني ، فإنّ الباري ـ جلّ شأنه ـ غير متناهي القوة ، تام الجود والفيض ، فكلّ ما لا يكون له مادّة ، ولا يحتاج إلى استعداد خاصّ ، ولا أيضاً له مضادّ ممانع ، فهو بمجرّد إمكانه الذاتي فائض عنه تعالى على وجه الإبداع ، ومجموع النظام له ماهية واحدة كلية ، وصورة نوعية وحدانية بلا مادّة ، وكل ما لا مادّة له نوعه منحصر في شخصه ... فلم يمكن أفضل من هذا النظام نوعاً ولا شخصاً . انتهى .
أقول : حديث الجود ليس بخطابي ، فإنّه واجب عليه بحسب حكمته ... نعم ليس بواجب عنه على ما سلف في بحث اختياره ، فقول الغزالي راجع إلى المختار .
وأمّا ما أتى به صاحب الأسفار فهو ضعيف ، فإنّ فرض العالم بمجموعه موجوداً واحداً غير مادي ، مجرّد خيال ينفع الشعراء ولا وزن له في المباحث العقلية ...
الثاني : ما ذكره اللاهيجي (1) ناقلاً عن الحكماء ، ومحصّله : أنّ الواجب الوجود خير محض، فإنّ الخير ليس إلاّ فعلية الوجود وكمالاته وتماميتهما ، والشر فقدان الوجود أو كمالاته ، وواجب الوجود عين الوجود ، وتامّ الوجود ، وكامل في وجوده وكمالاته ، فهو خير محض ولا موجود غيره بخير محض ، وكلّ ما هو خير محض لا يصدر عنه إلاّ الخير المحض ؛ إذ جهة صدور الشر ـ وهي العدم ـ ليس بمتحقّق فيه ..... وظاهر أنّ سبب نظام الكلّ ـ أي المجموع من حيث هو مجموع ـ ليس إلاّ الواجب الوجود ، فهو خير محض على وجه لا يمكن الأتمّ منه ؛ إذ مكان الأتمّ من هذا النظام يستلزم عدم تمامية هذا النظام ، فإذا لم يكن بتامّ لزم كونه شراً ، فيمتنع صدوره عن الخير المحض .
أقول : وللنظر فيه مواضع .
... منها : أنّ الواجب وإن كان هو المؤثّر في الكل ، غير أنّ للعقول والأفلاك أيضاً تأثيراً فيه ، فإنّها عندهم واقعة في السلسلة الفاعلية وتكون جهات مؤثّريته تعالى ، وحيث إنّ هذه الأُمور ممكنة وإمكاناتها عدمية ، والعدم شرّ ، فلا يتحقّق الخير المحض في المعاليل .
ومنها : أنّ فيه تناقضاً ، فإنّه تارةً يقول : ولا موجود غيره بخير محض ، وأُخرى يدّعي أنّ الجميع خير محض ، فتأمل ، فإنّ البرهان على قدرتنا تام ، وهو يدلّ على نفي النقص في ذاته تعالى أيضاً .
فإن قلت : كيف يكون هذا النظام على نهاية الكمال وغاية الإتقان ، والحال أنّ المصائب والبلايا محيطة بالحيوان ولا سيما الإنسان ؟
هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى ، أنّ الآثام ، والمعاصي ، والقتل ، وهتك الناموس ، والظلم وغير ذلك من الجنايات ، ما زالت مستمرّة الصدور عن نوع الإنسان ، حتى قُتل الأنبياء والأولياء ، وضعفت الديانة والإنسانية ، وأُخفيت معالم الشرع ، وقلّ الديّانون .
قلت ... وأمّا المعاصي فهي وإن كانت مبغوضاً عليها لله الحكيم سبحانه من حيثية التشريع وقبيحة في نفسها ، غير أنّ تكليف الإنسان لمّا كان ذا مصلحة هامّة في نفس الأمر ، وهو كان موقوفاً على اختيار الإنسان وتمكّنه ، وإلاّ لارتفع فائدة التشريع ، وبطل الثواب العقاب ، فجعل الله الإنسان مختاراً ثمّ كلّفه ، فهذه الجنايات مستندة إلى اختيار الإنسان ، واختياره ممّا لابدّ منه لمصلحة أهمّ من قبح هذه المفاسد ، فافهم جيداً .
في ترجيح أحد المتساويين على الآخر :
هل يحسن للمختار أن يرجّح أحد المتساويين على الآخر بمجرّد إرادته أم لا ؟ وعلى تقدير العدم هل هو جائز أو ممتنع ؟
المعروف عن الأشاعرة هو الجواز بل الوقوع (2) ، وعن العدلية ـ الإمامية والمعتزلة ـ والحكماء امتناعه (3) . والظاهر تمركز النزاع في المختار فقط ، فإنّ الموجب إذا رجّح أحد المتساويين على الآخر ـ كما إذا أحرق النار أحد المتساويين فقط ـ فقد وقع الترجّح بلا مرجّح ، لكنّه مجرّد فرض باطل .
ثمّ إنّ الأشاعرة ليس لهم دليل على قولهم سوى ذكر أمثلة ، ودعوى الضرورة على وقوع الترجيح بلا مرجّح فيها ، مع أنّ بعضهم ناقش في الأمثلة المذكورة (4) .
قال المحقّق الآشتياني : واستدلّوا عليه ـ أي الأشاعرة على الجواز ـ بالوجدان ؛ حيث إنّ العطشان والجائع والهارب من السبع ، يختار أحد القدحين والرغيفين والطريقين ، مع فرض المساواة من جميع الجهات التي لها دخل في الترجيح ، فيعلم من ذلك أنّ اختيار أحد طرفي الممكن لا يتوقّف على مرجّح خارجي . والعدلية من الإمامية والمعتزلة إلى الثاني ... لقضاء ضرورة العقل بعدم تعلّق الاختيار بأحد طرفي الممكن من دون داعٍ وسبب ، فلو وُجد لوُجد بلا سبب ، وهذا معنى رجوع الترجيح بلا مرجّح إلى الترجّح بلا مرجّح .
وأمّا ما زعمه الأشاعرة ففاسد جداً .
أمّا أَوّلاً : فلمنع تحقّق التساوي من جميع الجهات فيما مثّلوا به وأمثاله ، ومجرد الفرض لا يوجب تحقّق المفروض ، والمدار عليه لا على فرضه .
وأمّا ثانياً : فلأنّا نختار بعد التسليم عدم اختيار أحدهما ، ومجرّد دعواه لا يفيد في شيء ... إلخ أقول : هذان الجوابان اللذان نُقلا عن المعتزلة ، بل ادّعوا الضرورة على الجواب الثاني ، ممنوعان جداً ، بل الضرورة على خلافه ، وأنّ المضطرّ يختار أحدهما بلا تردّد . والإنصاف أنّهما لا يستحقان الجواب .
ويلحق بهما في الضعف ما أجاب به صاحب الأسفار (5) ، فإنّه مبني على الجبر ، وإنّ أفعال المخلوقين أفعال الله تعالى فلاحظ .
قال بعض أهل التدقيق من جامعي المعقول والمنقول (6) : تحقيق المقام أنّ الترجيح موضوعه الفعل الإرادي ، وثبوت الإرادة فيه مفروغ عنه ، وإلاّ لكان ترجّحاً بلا مرجّح ، وهو مساوق للمعلول بلا علّة ، وامتناعه بديهي لا يختلف فيه أحد ، ففي الموضوع الإرادي قالوا بقبحه تارة وبامتناعه أخرى بيانه :
إنّ الأشاعرة بنوا على خلو أفعال الله تعالى التكوينية والتشريعية ، عن الغايات الذاتية والعرضية ، وعن الحِكم والمصالح الواقعية ؛ نظراً إلى جواز الترجيح بلا مرجّح ؛ لإمكان الإرادة الجزافية تمسّكاً منهم بأمثلة جزئية ... ونفياً منهم للحسن والقبح بالكلّية ، فالفعل الإرادي الخالي عن الغرض معلول للإرادة المستندة إلى المريد ، فلا يلزم المعلول بلا علّة، وحيث لا حسن ولا قبح فلا يتّصف مثل هذا الفعل الخالي عن الغاية بكونه قبيحاً .
وأجاب الحكماء ـ بعد إثبات الحسن والقبح عقلاً في كلية أفعال الله تعالى والعباد ـ بأنّ الفعل الخالي عن الغاية والغرض قبيح من كل عاقل ، وبأنّ تجويز الإرادة الجزافية يؤول إلى تجويز الترجّح بلا مرجّح ؛ لأنّ الإرادة من الممكنات فتعلّقها بأحد الأمرين دون تعلّق إرادة أُخرى بالآخر ، إمّا بإرادة أُخرى فيدور أو يتسلسل ، وإمّا بلا إرادة ... كان معناه حدوث الإرادة بلا سبب ، وهو عين الترجّح بلا مرجّح ... فبالإضافة إلى نفس الفعل وإن كان ترجيحاً بلا مرجّح ، إلاّ أنّه بالإضافة إلى إرادته ترجّح بلا مرجّح .
فعُلم ممّا ذكرنا أنّ محلّ النزاع هو الفعل الإرادي الخالي عن مطلق الغاية والغرض ، لا الخالي عن الغرض العقلائي ، فإنّه لم يقع النزاع في إمكانه ، كما عُلم أنّ القبح بأي نظر، وأنّ الامتناع بأي لحاظ ، فإنّه قبيح بالنظر إلى خلوه عن الحكمة والمصلحة ، وممتنع بالنظر إلى حدوث الإرادة بلا موجب ، غاية الأمر أنّ الموجب في إرادته تعالى منحصرة في الحكمة والمصلحة لا مطلق الغرض .
وأمّا مسألة ترجيح المرجوح على الراجح فهي أجنبية عن مقاصد الحكماء ، والأشاعرة في تلك المسألة المتداولة ، إلاّ أنّه يمكن فرضها قبيحاً تارةً وممتنعاً أُخرى ، فبالنظر إلى خلو الفعل عن جهة مصحّحة من حكمة ومصلحة قبيح ، وبالنظر إلى حدوث الإرادة بلا سبب ممتنع .
ويزيد على الترجيح بلا مرجّح ، بأنّ ترك الراجح مع وجود غاية مصحّحة قبيح آخر ، وتخلّف الإرادة عمّا يوجبها محال آخر انتهى .
أقول : فقد ظهر أنّ استحالة الترجيح بلا مرجّح ؛ لأجل رجوعه إلى الترجّح بلا مرجّح ، وإلاّ فهو ليس بمحال ، انتهى .
وأمّا ما ذكره المحقّق اللاهيجي (7) من استحالة الترجيح المذكور في نفسه أيضاً ، بل ادّعى بداهتها عند الوجدان المستقيم ، فممّا لم نعرف له وجهاً .
والتحقيق أنّ الترجيح بلا مرجّح ربّما يصير ممتنعاً ، وربّما يكون ممكناً ، فإذا أمكن فهو تارةً يكون واجباً ولازماً فضلاً عن مجرّد كونه حسناً ، وأُخرى يكون قبيحاً .
بيان ذلك : أنّ الترجيح بمجرّد الإرادة من دون سبب ومرجّح أصلاً محال ... ولا وقع لإنكار الأشعريين وغيرهم ، وبمرجّح غير عقلائي قبيح ، كما في تقديم المفضول على الفاضل لأجل كبر السِّن مثلاً ، وهذا ممكن قبيح وليس بمحال كما هو ظاهر ، وبمرجّح عقلائي قائم بطبيعي الفعل الجامع للفردين لازم وواجب ، كما في الأمثلة المتقدّمة وغيرها ؛ وذلك لأنّ طبيعي الفعل إذا كان ذا مصلحة ملزمة أو غير ملزمة ، وكانت الأفراد بالنسبة إليه متساويةً ، حيث إنّ كلاً منها محصّل له ومحقّق إيّاه ، فلا يجوز أو لا ينبغي للعاقل أن يترك أصل الفعل المشتمل على المِلاك ؛ لأجل استواء الأفراد في المزية وتحصيل الغرض ، أَلا ترى أنّ العقلاء بأسرهم يقبّحون ، مَن ترك الأكل من أحد الإناءين المتساويين حتى مات جوعاً ، بل يضحكون على مَن اعتذر عنه بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح أو قبحه .
والسرّ في جوازه وعدم مآله إلى الترجّح ، هو أنّ المنظور إليه استقلالاً هو طبيعي الفعل وحده، وأمّا الأفراد فلا نظارة إليها إلاّ آلةً وتبعاً ، فالإرادة المتعلّقة بطبيعي الفعل المذكور تسوّغ اختيار أي من الأفراد ، ولا تؤول إلى الإرادة الجزافية الممتنعة .
وهذا الذي ذكرنا ـ مضافاً إلى عدم الدليل على امتناع ، بل الدليل على صحته كما عرفت منا ـ ضروري أيضاً كما يفهم من المثال المزبور ، فالصحيح في المسألة هو هذا التفصيل الثلاثي .
وأمّا ما ... [ذكره] المحقّق الآشتياني ، من نسبة القول بالامتناع إلى الإمامية والمعتزلة ففيه: أنّ كثيراً من المعتزلة قائلون بالجواز ، كما نقله اللاهيجي (8) .
وأمّا الإمامية فلم يثبت هذا القول منهم جلياً ، بل ذهب بعض الأجلاّء الأُصوليين (9) منهم إلى الجواز مطلقاً ، والحق ما قلنا .
__________________
(1) گوهر مراد / 224.
(2) شرح المواقف 2 / 218.
(3) حاشية المحقّق الآشتياني على رسائل الشيخ الأنصاري / 246.
(4) شرح المواقف 2 / 218.
(5) الأسفار 1 / 209.
(6) نهاية الدراية في شرح كفاية الأُصول 3 / 170.
(7) گوهر مراد / 147.
(8) گوهر مراد / 147.
(9) وهو المحقّق صاحب الكفاية قدّس سره 2 / 369 من كتابه ، ويمكن حمله على ما ذكرنا من التفصيل .



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|