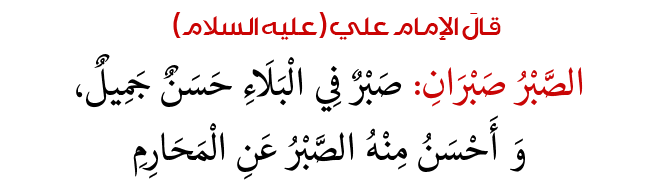
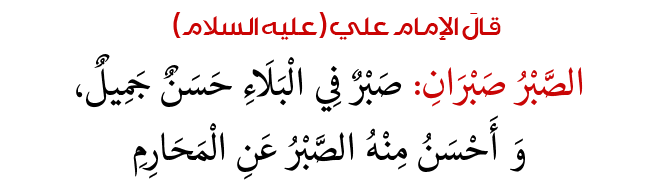

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
التاريخ: 29-8-2016
التاريخ: 25-6-2020
التاريخ: 26-8-2016
|
ويقع الكلام فيه في جهات:
الجهة الاولى في معنى الامر فنقول وبه نستعين ان الامر يطلق على معان:
منها الطلب كما يقال امره بكذا أي طلب منه كذا. ومنها الشأن ومنه شغلني امر كذا أي شأن كذا. ومنها الفعل ومنه وما امر فرعون برشيد أي فعله.
ومنها الشيء كقولك رأيت اليوم امرا عجبا.
ومنها الحادثة والغرض كقولك وقع اليوم امر كذا وجئتك لأمر كذا.
ومنها غير ذلك. ولكن التحقيق كونه حقيقة في خصوص الشيء الذي هو من الامور العامة العرضية لجميع الاشياء الشامل للفعل والشأن والحادثة والشغل ونحو ذلك فكان اطلاقه في تلك الموارد المختلفة بمعناه غايته من باب الدالين والمدلولين حيث اريد تلك الخصوصيات بدوال أخر من غير ان يكون الامر مستعمل في تلك الموارد في مفهوم الغرض والتعجب والفعل ولا في مصداقها بوجه اصلا.
نعم ذلك كله بالنسبة إلى غير المعنى الاول وهو الطلب واما بالنسبة إليه فهو وان كان ايضا امرا من الامور وشيئا من الاشياء فكان من مصاديق ذلك العنوان العام العرضي، ولكن الظاهر كونه موضوعا بإزائه بالخصوص ايضا قبالا لوضعه لذلك المعنى العام العرضي، كم ان الظاهر هو كونه من باب الاشتراك اللفظي دون الاشتراك المعنوي بملاحظة عدم جامع قريب بينهما، كما يشهد لذلك قضية اختلافهما من حيث الاشتقاق وعدمه فانه بمعنى الطلب يكون معناه اشتقاقيا فيشتق منه صيغ كثيرة من المصدر والفعل الماضي والمضارع واسمي الفاعل والمفعول كما يقال: (امر يأمر آمر مأمور) بخلافه على كونه بمعنى الشيء فانه عليه يكون من الجوامد.
وربما يشهد لذلك ايضا قضية الجمع فيهما، من مجيئه على الاول على الاوامر وان كان على غير القياس، وعلى الثاني على الامور، والجمع يرد الاشياء إلى اصولها وحينئذ فلا ينبغي الاشكال في كونه موضوعا بالخصوص للطلب ايضا.
ثم ان محل الكلام في المقام انما هو الامر بمعنى الطلب دونه بمعنى الشيء فلابد حينئذ من بيان انه هل هو موضوع للطلب الحقيقي والارادة القائمة بالنفس بحيث كان القول أو الاشارة مبرزا لها وكاشفا عنها؟ أو انه موضوع للطلب المبرز بالقول أي مفهومه المبرز بالقول أو بالأعم منه ومن الاشارة ونحوها؟ أو انه موضوع لنفس ابراز الطلب بالقول أو الاشارة ؟ حيث ان فيه وجوها، ابعدها الاول، لما يرى من عدم صدق الامر على مجرد الارادة النفسانية الغير البالغة إلى مرحلة الابراز حيث لا يصدق على من كان طالب لشيء من عبده ومريدا له منه بلا ابراز ارادته بالقول أو نحوه أنه آمر به، بل الصادق عليه انه طالب ومريد غير آمر، على ان لازم ذلك هو ان يكون استعماله دائما في غير معناه الموضوع له لان ما يجئ في الذهن عند الاستعمال لا يكون الا صورة الارادة ومفهومها لا حقيقتها وعليه فلا يكون استعماله في معناه الحقيقي الذي هو الارادة القائمة بالنفس. وحينئذ فبعد بطلان هذا المعنى يدور الامر بين كونه حقيقة في الطلب المبرز بما هو مبرز بالقول أو الاشارة بنحو خروج القيد ودخول التقيد أو كونه حقيقة في ابراز الطلب وهو القول الحاكي عنه، ولكل منهما وجه وجيه، وان كان قد يقال بتعين الاخير نظرا إلى ظهور العنوان وهو الامر في الاختيارية وكونه على الاخير اختياري بتمامه من الابراز والتقيد بالطلب، بخلافه على الاول، فانه من جهة جزئه الركني وهو الطلب غير اختياري. ولكنه توهم فاسد، فان ما ذكر مجرد استحسان لا يثبت به الوضع خصوصا مع استلزام الاخير لعدم صحة الاشتقاقات منه باعتبار عدم كون معناه حينئذ معنى حدثيا قابلا للاشتقاق، لان ما هو المبرز حينئذ انما كان هو الهيئة ومعناه لا يكون الا معنى جامديا غير حدثي بخلافه على الاول فان المعنى عليه بنفسه يكون معنا حدثي قابلا للاشتقاق منه.
وما قيل من انه على الاول ايضا يلزمه خروج الصيغ كلها عن المصداقية للأمر من جهة عدم كونها عبارة عن نفس الطلب وانما هي مبرزات عنه، مدفوع بانه لو سلم ذلك فإنما يرد هذا المحذور لو لا كونها وجوها للطلب ولو من جهة شدة حكايتها عنه و الا فبهذا الاعتبار تكون عين الطلب ويحمل عليها الطلب بالحمل الشايع.
وبالجملة نقول: بانه بعد لم يقم دليل معتد به على تعين احد الاحتمالين بالخصوص حتى يؤخذ به، وما ذكر من الوجوه تقريبات استحسانية محضة خصوصا مع عدم ترتب ثمرة في البين على كونه حقيقة في الطلب المبرز أو في ابراز الطلب، من جهة ان القائل بكونه حقيقة في ابراز الطلب انما يدعى كونه حقيقة فيه بما انه حاك عن الطلب وبما هو وجه له لا بم انه نفس الابراز ولو مع عدم الحكاية عن الطلب، وحينئذ فالأولى هو صرف الكلام عن تلك الجهة.
نعم ينبغي ان يعلم بانه على كلا التقديرين لا خصوصية لخصوص الابراز بالقول في صدق الامر بل الابراز بما انه يعم القول والاشارة ونحوها، واما ما يرى في بعض الكلمات من التعبير عنه بالطلب بالقول فإنما هو لمكان الغلبة لا من جهة خصوصية في الابراز القولي، كما هو واضح. نعم يبقى الكلام في جهة أخرى وهى ان الامر هل هو عبارة عن نفس الطلب أي المفهوم المنتزع عن حقيقته غايته بما انه يرى عين الخارج لا بما انه مفهوم ذهني ولا بما هو كما في كلية مداليل الالفاظ كي يكون لازمه عدم انطباقه على مجرد الطلب الانشائي؟ اوانه عبارة عن هذا المفهوم لكنه بما هو موقع باستعمال اللفظ فيه بقصد الايقاع المعبر عنه بالطلب الانشائي؟ حيث ان فيه وجهين اختار ثانيهما في الكفاية حيث قال: بان لفظ الامر حقيقة في الطلب الإنشائي الذي لا يكون طلبا بالحمل الشايع بل طلب انشائي سواء انشأ بمادة الامر أو بمادة الطلب، مثل آمرك واطلب منك كذا، أو بصيغة افعل. ولكن التحقيق يقتضي خلافه وانه لا يكون الامر حقيقة الا في نفس المفهوم بما هو حاك عن الطلب الحقيقي الخارجي، فما هو المستعمل فيه في مثل اطلب منك بداعي الانشاء لا يكون الانفس المعنى وصرف المفهوم، غايته ان استعماله فيه مكيف باستعمال انشائي بمعنى كونه بداعي موقعية المفهوم وموجديته، فكان حيث الانشائية من شئون نحو الاستعمال وكيفياته القائمة به لا انه مأخوذ في ناحية المستعمل فيه ولو بنحو خروج القيد ودخول التقيد، لأنه من المستحيل اخذ مثل هذه الجهة ولو تقيدا في ناحية المستعمل فيه، وهذا واضح بعد وضوح تأخر الاستعمال عن المستعمل فيه تأخر الحكم عن موضوعه. وحينئذ فلا محيص من دعوى ان المعنى انما كان عبارة عن صرف المفهوم بما انه حاك عن الطلب الحقيقي الخارجي الذي بوجه عينه دون الطلب الانشائي، على ان لازم هذا القول هو صدق الامر والطلب ولو لم يكن في البين في الواقع طلب ولا ارادة كما في الاوامرالامتحانية والاوامر المنشأة بداعي السخرية، مع انه كما ترى، إذ المتبادر من قوله: امر بكذا، انما هو البعث نحو الشيء عن ارادة جدية دون البعث بغيرها من الدواعي. واما احتمال ان المراد من الطلب المذكور في عبارته هو الطلب الموقع بالاستعمال بما هو موصوف بوصف الموجدية ولو باعتبار كاشفية المستعمل فيه اللفظ عن الارادة الجدية دون الطلب الانشائي بما هو طلب انشائي، فمدفوع بانه وان امكن هذ الحمل فيرتفع به المحاذير ويصدق عليه ايضا الطلب الانشائي باعتبار كونه موقع باستعمال اللفظ في مفهومه بعنوان مرآتيه المفهوم عن الطلب الحقيقي ويصدق عليه ايضا بهذا الاعتبار الطلب الحقيقي بنحو الحمل الشايع، ولكنه يبعده ما صرح به هو (قدس سره) بان مدلول الامر ليس هو الطلب الذي يصدق عليه الطلب بالحمل الشايع، وعليه فيتجه الاشكال المزبور من لزوم صدق الامر عند الخلو عن الارادة. فتلخص ان الامر على مسلك الكفاية (قدس سره) عبارة عن الطلب بما هو منشأ وموقع، فكان الانشاء الذي هو من شئون نحو الاستعمال ومن كيفياته مقوما لتحقق الامر، ومن هذه الجهة يكون الامر على مسلكه منتزعا عن الرتبة التي بعد الانشاء المتأخر عن الاستعمال، فيكون تأخره عن نفس مفهوم الطلب المستعمل فيه اللفظ بمرتبتين من دون دخل للإرادة الجدية ايضا في صدق الامر وتحققه.
واما على ما سلكناه فيكون الامر عبارة عن نفس الطلب أي مفهومه بما هو حاك عن الطلب الحقيقي القائم بالنفس، فبهذا الاعتبار يصدق عليه الطلب الحقيقي ويحمل عليه بالحمل الشايع.
الجهة الثانية: بعد ما عرفت من ان الامر حقيقة في الطلب المبرز أو في ابراز الطلب، فهل يعتبر فيه ايضا العلو؟ أو انه لا يعتبر فيه ذلك فيصدق الامر على مطلق الطلب الصادر ولو كان صدوره من المساوي أو السافل؟
فيه وجهان:
اقويهم الاول لصحة سلبه عن الطلب الصادر عن السافل والمساوي حيث يصح ان يقال: انه ليس بأمر حقيقة بل هو سؤال والتماس، كيف وان الامر انما هو مساوق ل (فرمان) بالفارسية، وهو يختص بما لو كان الطالب هو العالي دون السافل أو المساوي إذ لا يصدق (فرمان) على الطلب الصادر عن غير العالي.
واما ما يرى من تقبيح السافل المستعلى فيما لو امر سيده بانك لم امرت سيدك ومولاك فإنما هو على استعلائه وتنزيل نفسه عاليا الموجب لصدور الامر منه، لا ان التقبيح على امره، لصدق الامر عليه حقيقة بعد استعلائه. ومن ذلك البيان ظهر ايضا بطلان توهم كفاية احد الامرين في تحقق حقيقة الامر:
اما العلو والاستعلاء، وذلك فان غير العالي لا يكاد يصدق على طلبه الامر الذي هو مساوق (فرمان) ولو استعلى غاية الاستعلاء، كما ان العالي بمحض صدور الامر منه يصدق على طلبه وامره، الامر و(فرمان) وان لم يكن مستعليا في امره بل كان مستخفضا لجناحه. وعليه فما هو المعتبر في حقيقة الامر انما كان هو العلو خاصة، واما الاستعلاء زائدا عن جهة العلو فلا يعتبر فيه بوجه من الوجوه، كما هو واضح.
الجهة الثالثة: في ان الامر هل هو حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي؟ أو انه حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبي والاستحبابي؟ فيه وجهان: اظهر هما الثاني، لصدق الامر حقيقة على الطلب الصادر من العالي إذا كان طلبه استحبابيا حيث يقال له:
انه امر وبالفارسية (فرمان) من دون احتياج في صحة اطلاق الامر عليه إلى رعاية عناية في البين، حيث ان ذلك كاشف عن كونه حقيقة في مطلق الطلب والا لكان يحتاج في صدق الامر وصحة اطلاقه على الطلب الاستحبابي إلى رعاية عناية في البين، كما هو واضح. ومما يشهد لذلك بل يدل عليه ايضا صحة التقسيم إلى الوجوب والاستحباب في قولك: الامر اما وجوبي واما استحبابي، وهو ايضا علامة كونه حقيقة في الجامع بينهما. نعم لا اشكال في ظهوره عند اطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي بحيث لو اطلق واريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك، ومن ذلك ايضا ترى ديدن الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في الفقه في الاوامر الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الائمة (عليهم السلام) حيث كانوا يحملون الاوامر الواردة عنهم على الوجوب عند خلو المورد عن القرينة على الاستحباب والرخصة في الترك حتى انه لو ورد في رواية واحدة أوامر متعددة بعدة اشياء كقوله: اغتسل للجمعة والجنابة ومس الميت، ونحوه، فقامت القرينة المنفصلة على ارادة الاستحباب في الجميع إلا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لو تقم عليه قرينة على الاستحباب، بل وتريهم أيضا في أمر واحد كقوله: أمسح ناصيتك، حيث انهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى اصل المسح وحملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع انه امر واحد، وهكذا غير ذلك من الموارد التي يطلع عليها الفقيه، ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك الا حيث ظهور الامر في نفسه في الوجوب عند اطلاقه، وحينئذ فلا اشكال في اصل هذا الظهور. نعم انما الكلام والاشكال في منشأ هذا الظهور وانه هل هو الوضع أو هو غلبة الاطلاق أو هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة؟ فنقول: اما توهم كون المنشأ فيه هو الوضع فقد عرفت فساده وانه يكون حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الالزامي وغيره بشهادة صحة التقسيم وصحة الاطلاق على الطلب الغير الالزامي. واما ما استدل به من الآيات والاخبار الكثيرة لأثبات الوضع للوجوب، من نحو قوله: سبحانه {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } [النور: 63] وقوله عز من قائل مخاطبا لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: 12] وقوله (صلى الله عليه وآله) : (لو لا ان أشق على امتي لأمرتهم بالسواك) وقوله (صلى الله عليه وآله) ايضا لبريرة حين قال له اتأمرني يا رسول الله : (لا بل أنا شافع) من تقريب انه جعل المخالفة للأمر في الاول ملزوما لوجوب لحذر، وفى الثاني للتوبيخ، وفى الثالث للمشقة، وحيث لا يجب الحذر من مخالفة الامر الاستحبابي ولا يصح التوبيخ عليه ولا كان مشقة يترتب على الامر الاستحبابي بعد جواز الترك شرعا، فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، فان التقيد بالوجوب في تلك الاوامر خلاف ظاهر تلك الادلة من جهة قوة ظهورها في ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد منه، وحينئذ فتدل تلك الادلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابي امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه.
فنقول: بانه يرد على الجميع بابتناء صحة الاستدلال المزبور على جواز التمسك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العام عن موضوعه، إذ بعد ان كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللوازم من وجوب الحذر والتوبيخ والمشقة على الامر الاستحبابي اريد التمسك به لا ثبات عدم كون الامر الاستحبابي من المصاديق الحقيقية للامر ليكون عدم ترتب اللوازم المزبورة عليه من باب التخصص والخروج الموضوعي لا من باب التخصيص، نظير ما لو ورد خطاب على وجوب اكرام كل عالم وقد علم من الخارج بعدم وجوب اكرام زيد لكنه يشك في أنه مصداق للعالم حقيقة كي يكون خروجه عن الحكم من باب التخصيص أو انه لا يكون مصداقا للعالم كي يكون خروجه من باب التخصص، ولكنه نقول بقصور اصالة العموم والاطلاق عن افادة اثبات ذلك فان عمدة الدليل على حجيته انما كان هو السيرة وبناء العرف والعقلاء، والقدر المسلم منه إنما هو في خصوص المشكوك المرادية وهو لا يكون الا في موارد كان الشك في خروج ما هو المعلوم الفردية للعام عن حكمه، وحينئذ فلا يمكننا التمسك بالأدلة المزبورة لأثبات الوضع لخصوص الطلب الالزامي خصوصا بعد ما يرى من صدقه ايضا على الطلب الاستحبابي، كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى الوضع.
واما الغلبة فدعويها ايضا ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في الاستحباب. ومن ذلك ترى صاحب المعالم (قدس سره) فانه بعدان اختار كون الامر حقيقة في خصوص الوجوب قال: بانه يستفاد من تضاعيف احاديثنا المروية عن الائمة (عليهم السلام) ان استعمال الامر في الندب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فمن ذلك استشكل ايضا وقال: بانه يشكل التعلق في اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به منهم (عليهم السلام) .
وحينئذ فلا يبقى مجال لدعوى استناد الظهور المزبور إلى غلبة الاستعمال في خصوص الوجوب، كما هو واضح. وحينئذ فلابد وان يكون الوجه في ذلك هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة وتقريبه من وجهين:
احدهما: ان الطلب الوجوبي لما كان اكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي لما في الثاني من جهة نقص لا يقتضي المنع عن الترك، فلا جرم عند الدوران مقتضي الاطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي، إذ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد، بخلاف الطلب الوجوبي فانه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد، وحينئذ فكان مقتضى الاطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيا لا استحبابيا .
وثانيهما: ولعله ادق من الاول تقريب الاطلاق من جهة الاتمية في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أن الامر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلقة في مرحلة الخارج ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الاطاعة والامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللا اقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الاجر والثواب، وأخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو اتم بحيث يوجب سد باب عدمه حتى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتب على ايجاده من المثوبة الموعودة، وفي مثل ذلك نقول: بأن قضية اطلاق الامر يقتضي كونه على النحو الثاني من كونه بالنحو الاتم في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضي سد باب عدم العمل حتى من ناحية ترتب العقوبة على المخالفة، لان غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج ارادته إلى مؤنة بيان من وقوف اقتضائه على الدرجة الاولى الموجب لعدم ترتب العقوبة على المخالفة. وبالجملة نقول: بأن الامر بعد ان كان فيه اقتضاء التحريك للإيجاد وكان لاقتضائه مراتب، فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة أو عبوره إلى مرتبة السببية لحكم العقل بالإيجاد كان مقتضي الاطلاق كونه على النحو الاتم والاكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الايجاد فرارا عن تبعة ما يترتب على مخالفته من العقاب علاوة عما يترتب على موافقته من الاجر والثواب، فتدبر.
الجهة الرابعة: في انه هل الطلب عين الارادة أو غيرها؟ حيث انه وقع فيه الخلاف بين المعتزلة والعدلية وبين الاشاعرة، فذهبت الاشاعرة إلى المغايرة بينهما، والباقون إلى اتحادهما مستدلين لذلك: بانا لا نجد في انفسنا عند الامر بشيء وطلبه غير العلم بالمصلحة والارادة والحب والبغض صفة أخرى قائمة بالنفس نسميها بالطلب، فمن ذلك صاروا بصدد توجيه القول بالمغايرة وحملوه على وجوه يرتفع بها النزاع في البين.
منها: ما أفاده في الكفاية، حيث انه لما بنى على اتحاد الطلب والارادة مصداقا ومفهوما وجه كلام القائلين بالمغايرة، حيث قال ما ملخصه: الحق كم عليه اهله اتحاد الطلب و الارادة مفهوما وانشاء وخارجا بمعنى ان ما يسمى بالطلب بالحمل الشايع هو عين الارادة بهذا الحمل وما ينتزع عنه هذا المفهوم أي مفهوم الطلب عين ما ينتزع عنه مفهوم الارادة، وانشاء الطلب الذي هو عبارة عن استعمال اللفظ في المفهوم بقصد الايقاع هو عين انشاء الارادة، فكان الطلب والارادة متحدين في جميع تلك المراحل الثلاث، ولكنه لما كان المنصرف إليه الطلب عند اطلاقه هو الطلب الانشائي وكان في الارادة بعكس ذلك حيث كان المنصرف إليه عند اطلاقها هو الارادة الحقيقية الخارجية دون الانشائي منها كان مثل هذا الانصراف اوجب القول بالمغايرة بينهما فتوهم أن الطلب غير الارادة، ولكنه ليس من جهة ان ذلك انما كان من جهة ما يستفاد من قضية اطلاقهما حسب الانصراف ومثل ذلك مما لا ينكره القائل بالاتحاد، بل عليه يرتفع النزاع من البين رأسا لرجوع النزاع حينئذ إلى ما هو المستفاد من قضية اطلاق لفظ الطلب بان المستفاد منه هل هو عين ما يستفاد من لفظ الارادة عند اطلاقها أو ان المستفاد منه هو غيره؟. ومنها: أي من التوجيهات جعل المراد من الطلب عبارة عن الاشتياق التام الحاصل عقيب تصور الشيء والتصديق بفائدته، والارادة عبارة عن حملة النفس وهيجانها نحو المطلوب والمراد الذي يستتبع الفعل والعمل، أو العكس بجعل الطلب عبارة عن حملة النفس والارادة عن الاشتياق التام.
ومنها: جعل الطلب عبارة عما ينتزع عن مقام ابراز الارادة من البعث والايجاب والوجوب واللزوم، فيغاير حينئذ الارادة حيث كانت الارادة من الامور الحقيقية القائمة بالنفس بخلاف الطلب حيث انه كان من الامور الاعتبارية الانتزاعية عن مقام ابراز الارادة بالأمر نحو الشيء بالإيجاد. ومنها: غير ذلك من التوجيهات المذكورة في كلماتهم. اقول: ولا يخفى عليك ما في هذه المحامل والتوجيهات، إذ نقول وان كان يتضح بها المغايرة بينهما بل ويرتفع معها النزاع من البين، ولكن لا يساعد شيء منها كلام القائلين بالمغايرة حيث نقول: بأن الطلب وما يحكى عنه الامر عندهم عبارة عن معنى قابل للتعلق بالمحال وللتخلف عن المراد وللموضوعية لحكم العقل بوجوب الاطاعة والامتثال، كما يشهد عليه قضية استدلالهم بالأوامر الامتحانية الخالية عن الارادة في مواردها، كما في امر ابراهيم (عليه السلام) بذبح ولده اسمعيل (عليه السلام) واستدلالهم ايضا بتكليف الله سبحانه الكفار بالأيمان واهل الفسوق والعصيان بالعمل بالأركان فان الله سبحانه امر الكفار بالأيمان ولم يرد منهم الايمان لامتناع صدور الايمان منهم بعد علمه سبحانه بذلك، إذ حينئذ يستحيل تعلق ارادته سبحانه بالأيمان المستحيل منهم. وأيضا لازم تعلق ارادته سبحانه بذلك هو قهرية صدور الايمان منهم لأنه سبحانه إذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فيستحيل تخلف ارادته سبحانه عن المراد، وحينئذ فمن جهة عدم صدور الايمان منهما لابد وان يستكشف عن عدم تعلق ارادته الازلية بصدور الايمان منهم ومعه يثبت المطلوب من المغايرة بين الطلب والارادة. وايضا استدلالهم على كون العباد مجبورين في افعالهم على ما هو مقتضى مذهبهم وانكارهم التحسين والتقبيح العقليين بانه من الممكن امر الله سبحانه العباد بأمور ليس فيها مصلحة اصلا، حيث انه يستفاد من ادلتهم ان ما يحكى عنه الامر وهو الطلب عندهم عبارة عن معنى كان ممكن التعلق بالمحال وقابلا للتخلف عن المراد ولان يكون تابعا لمصلحة في نفسه لا في متعلقة مع كونه موضوعا أيضا لحكم العقل بوجوب الاطاعة والامتثال ويقابله الارادة عندهم فانه معنى لا يجوز تخلفها عن المراد ولا كانت قابلة للتعلق بالمحال ولا للتبعية لمصلحة في نفسها لكونها تابعة لمقدماتها التي منها التصديق بفائدة الشيء والميل والمحبة له. وكان عمدة ما دعاهم إلى المصير إلى المغايرة تلك الاشكالات الفاسدة الواردة بنظرهم بناء على القول باتحاد الطلب مع الارادة:
منها لزوم عدم تحقق العصيان من العباد لعدم جواز تخلف ارادته سبحانه عن المراد، ومنها لزوم تعلق الارادة بالمحال بناء على الاتحاد كما في موارد الامر بما انتفي شرط تحققه، ومنها ما بنوا عليه من المبنى الفاسد من انكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم الامر بالشيء مع خلوه عن المصلحة كما في الاوامر الامتحانية، ومنها غير ذلك من المباني الفاسدة، حيث انه من جهة الفرار عن تلك الاشكالات التزموا بالمغايرة بين الطلب والارادة فقالوا بان الطلب وما يحكى عنه الامر عبارة عن معنى قابل لتلك اللوازم. ومما يشهد لذلك أيضا انكار القائلين بالاتحاد عليهم بأنا لا نجد في انفسنا عند طلب شيء والامر به غير العلم بالمصلحة والارادة والحب والبغض صفة اخرى قائمة بالنفس نسميها بالطلب، وهذ هو العلامة (قدس سره) حيث انكر عليهم بانا لم نجد عند الامر بشيء امرا مغاير لإرادة الفعل حيث لا يكون المفهوم من الامر إلا ارادة الفعل من المأمور به ولو كان هناك شيء آخر لا ندركه فلا شك في كونه أمرا خفيا غاية الخفاء بحيث لا يتعقله إلا الاوحدي من الناس، ومع ذلك كيف يجوز وضع لفظ الامر المتعارف في الاستعمال بإزائه، إذ من الواضح حينئذ انه لولا إرادتهم من الطلب والامر ما ذكرن لما كان وجه لإنكار القائل بالاتحاد عليهم، كما هو واضح. وعليه نقول ايضا بانه لا يكاد يلائم شيء من التوجيهات المزبورة كلامهم بوجه أصلا، حيث ان الطلب بمعنى الانشائي منه كما هو توجيه الكفاية وان يساعد عليه اللازم الاول من قابلية تعلقه بالمحال لعدم استلزامه لإرادة الايجاد من المكلف، ولكنه لا يساعد عليه جهة موضوعيته لحكم العقل بوجوب الاطاعة والامتثال. واما كونه بمعنى حملة النفس وهيجانها نحو المطلوب فهو ايضا غير قابل للتعلق بالمحال ولا يصحح أيضا كونه لصلاح في نفسه فبقى بعد الاشكالات بحالها. وأما كونه بمعنى الاشتياق فهو وان يصحح جواز تعلقه بالمحال كما في اشتياق المريض إلى شفاء مرضه والمحبوس إلى الفرار من السجن والتخلص منه واشتياق الانسان إلى عود شبابه ويمكن ايضا وقوعه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال فيما لو احرز العبد إشتياق مولاه إلى شيء ولكنه ايضا لا يصحح كونه لصلاح في نفسه. وحينئذ فبقرينة استدلالهم بمثل الاوامر الامتحانية يعلم بعدم إرادتهم من الطلب الاشتياق نحو الشيء ولا من الارادة حملة النفس وهيجانها نحو المطلوب. واما كونه بمعنى البعث والتحريك والوجوب واللزوم ونحوها فهو ايضا غير محكي بالأمر لما عرفت من كونها أمورا انتزاعية متأخرة عن الامر يعتبرها العقل عن مقام ابراز الارادة فل يمكن ان يكون محكيا للأمر، كما هو واضح. نعم هنا معنى آخر غير المذكورات وغير العلم والارادة والحب والبغض يمكن بعيدا ان يوجه به كلام القائل بالمغايرة، وهو البناء والقصد، المعبر عنه بعقد القلب في باب الاعتقادات، حيث انه كان من جملة افعال النفس، ولذا قد يكون يؤمر به كما في البناء على وجود الشيء كالبناء في باب الاستصحاب وفى الشكوك المعتبرة في الصلوة، وقد يكون ينهى عنه كما في التشريع المحرم ويسمى بأسام مختلفة حسب اختلاف متعلقة، ويكون كالإرادة في كونه ذا اضافة وان خالفها في انها من مقولة الكيف وهذا من مقولة الفعل للنفس، فكما ان الحب قد يتعلق بأمر موجود مفروغ التحقق فيقال له العشق والشعف، وقد يتعلق بإيجاد الشيء أو ايجاد الغير اياه فيقال له الارادة، كذلك هذا البناء فانه قد يتعلق بالأول وقد يتعلق بالثاني، فيسمى بالاعتبار الاول تنزيلا كالبناء على كون الشك يقينا أو العدم وجودا وكالبناء على كون الاكثر موجودا أو الموجود هو الاكثر، وبالاعتبار الثاني قصدا، وعند تعلقه بما ليس في الشرع تشريعا ونحو ذلك ويشهد لما ذكرنا ملاحظة كلماتهم في باب التصديق المعتبر في الايمان بانه ليس مجرد العلم والمعرفة بل هو فعل جناني معبر عنه بالفارسية ب (گردن دادن) و(گرويدن) و(باور كردن) فراجع كلماتهم.
وحينئذ نقول بان مثل هذا البناء والقصد لما كان قابل للتعلق كما في بناء الغاصب على ملكية مال المغصوب في مقام البيع وكالبناء على ربوبية بعض المخلوقين وكالبناء على جزئية شيء للواجب في باب التشريع، ومن جهة اختياريته كان قابلا لان يكون لصلاح في نفسه، وامكن ايضا ان يكون محكيا للأمر موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، فلا محالة امكن توجيه كلماتهم الفاسدة بحمل الطلب في كلماتهم على مثل هذا البناء والقصد، والارادة على تلك الكيفية النفسانية بل عليه لا مجال للإنكار عليهم ايضا بانا لا نجد في انفسنا عند طلب شيء غير العلم بالمصلحة والارادة والحب والبغض لما عرفت من وجود امر آخر في النفس يكون هو البناء والقصد. وحينئذ فلو ادعى القائل بالمغايرة بان ما هو المسمى بالطلب عبارة عن مثل هذا القصد الذي هو بالضرورة غير الارادة لا يمكننا المسارعة في الرد عليهم بعدم وجدان امر وراء الارادة والعلم والحب والبغض بل ولئن سلم مبانيهم الفاسدة لا مفر عن الالتزام بمقالتهم من المغايرة بين الطلب والارادة. وحينئذ فاللازم هو إبطال اصل تلك المباني الفاسدة التي هي عبارة عن انكار التحسين والتقبيح العقليين، وعدم جواز انفكاك الارادة عن المراد، وعن شبهة الاوامر الامتحانية التي اوجب مصيرهم إلى كون الامر لصلاح في نفسه لا في متعلقه، وشبهة كون العباد مجبورين في افعالهم الموجب لعدم امكان تعلق الارادة بفعلهم. فنقول: اما الاول فأبطاله لا يحتاج إلى البرهان بعد ثبوته بالوجدان وان كان ايكال من لا وجدان له إلى الوجدان غير خال عن المصادرة لكن تفصيله موكول إلى محله، ونتيجة ابطال هذه المقدمة انما هو نفى كون الامر حاكي عن البناء والقصد كما وجهنا به كلامهم، وذلك انما هو لوضوح انه لا يرى العقل حسن العقوبة على المخالفة بمحض كون المحكي بالأمر هو البناء والقصد الخالي عن الارادة، بل في مثله عند فرض الخلو عن الارادة ترى حكم العقل بقبح العقوبة. وبالجملة فالمقصود من هذا البيان انما هو حصر موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة والامتثال وحسن العقوبة على المخالفة بنفس الارادة الواقعية بما انها مبرزة بالأمر، فعند خلو المورد حينئذ عن الارادة لا حكم للعقل بوجوب الاطاعة ولا يرى حسن العقوبة على المخالفة. واما دعويهم بانعزال العقل عن التحسين والتقبيح فغير مسموعة منهم، كما هو واضح. واما الثاني: فبطلانه ايضا واضح حيث انه قد خلط بين الارادة التشريعية والتكوينية، فان ما يستحيل تخلفه انما هو الارادة التكوينية دون الارادة التشريعية، وما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه (انما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون) انما هو الاول دون الثاني، على ان لنا ايضا المنع عن لزوم تخلف ارادته سبحانه عن المراد حتى في الارادة التشريعية، وبيانه يحتاج إلى مقدمة بها ايضا يتضح الجهة الفارقة بين الارادة التكوينية والتشريعية، وهى ان كل آمر ومريد لفعل من الغير تارة يتعلق ارادته بحفظ وجود العمل على الاطلاق بنحو تقتضي سد جميع ابواب عدمه حتى من ناحية شهوة العبد والمأمور ولو بإيجاد الارادة له تكوينا، وأخرى تتعلق بحفظ وجوده لا على نحو الاطلاق بل في الجملة ومن ناحية ما هو مبادي حكم عقله بوجوب الاطاعة والامتثال وهو طلبه وأمره. وحينئذ فإذا كانت الارادة المتعلقة بفعل العبد من قبيل الاول فلا جرم لابد لا من سد جميع ابواب عدمه المتصورة حتى من جهة شهوة العبد، واما إذا كانت من قبيل الثاني فالمقدار اللازم انما هو حفظ وجوده بمقدار تقتضيه الارادة، فإذا فرض ان المقدار الذي تعلق الارادة والغرض بالحفظ انما هو حفظ المرام من ناحية مبادي حكم عقل المأمور بالإطاعة والامتثال وما يرجع إلى نفس المولى من ابراز ارادته والبعث، فالمقدار اللازم في الحفظ حينئذ انما هو ايجاد ما هو من مبادي حكم العقل بالامتثال لا ايجاد مطلق ما كان له الدخل في الحفظ حتى مثل شهوة العبد والمأمور، كما هو واضح. وبعد ما عرفت هذه الجهة نقول بان ما كانت منها من قبيل الاول فهي المسماة بالإرادة التكوينية وهى كم ذكر يستحيل تخلفها عن المراد إذ هي بعد تعلقها بحفظ الوجود بقول مطلق حتى من ناحية الاضداد والمزاحمات فلا جرم يكون ترتب وجود المراد عليها قهريا فيستحيل تخلفها عنه والا لزم الخلف، واما ما كانت من قبيل الثاني فهي المسماة بالإرادة التشريعية، ولكن نقول بان تلك ايضا غير متخلفة عن المراد فان المفروض ان المقدار الذي تعلق الارادة بحفظه انما هو حفظ المرام في الجملة بسد باب عدمه من ناحية مبادي حكم عقل المأمور بالإطاعة والامتثال لا حفظه بقول مطلق وهو يتحقق بإبراز ارادته واظهارها بأمره وطلبه وبعثه بقوله افعل كذا، ومن المعلوم بداهة انه على هذا أيضا لا تخلف لها عن المراد من جهة انه بإبراز ارادته تحقق ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة وانسد المقدار الذي كان المولى بصدد حفظه من جهته، وحينئذ فلا يكاد يضر مخالفة الكفار واهل العصيان في الواجبات والمحرمات، إذ لا يستلزم مخالفتهم تخلف ارادته سبحانه عن مراده، كما هو واضح. وحينئذ فتمام الخلط والاشتباه نشأ عن الخلط بين الارادة التكوينية والارادة التشريعية ومقايسة احداهم بالأخرى، فحيث ان الارادة التكوينية يكون ترتب المراد عليها قهريا نظرا إلى تعلقه بحفظ وجوده بقول مطلق حتى من ناحية الاضداد والمزاحمات، تخيل ان الارادة التشريعية أيضا مثلها في عدم الانفكاك عن المراد، وحينئذ فمن جهة مخالفة الكفار وأهل العصيان استشكل عليه الامر فالتزم فرارا عن الاشكال بالمغايرة بين الطلب والارادة وان الله سبحانه وان أمر الكفار بالأيمان وطلبه منهم ولكنه لم يرد منهم الايمان. ولكنك قد عرفت وضوح الفرق بينهما وانه لا مجال لمقايسة احديهما بالأخرى، فتأمل تعرف حقيقة الحال في ارادتك صدور حمل من عبدك من حيث كونك تارة بصدد حفظ مرامك وسد جميع ابواب عدمه حتى من ناحية شهوة عبدك ولو بضربك اياه وجبره على الايجاد ولو بأخذ يده ونحو ذلك، وأخرى في مقام حفظه من ناحية امرك اياه وابراز ارادتك باعتبار قيام المصلحة بالوجود في ظرف صدوره عن العبد عن إرادته وإختياره لا مطلقا مع صحة مؤاخذتك اياه لو أمرته فخالف ولم يطع، وهذا واضح لا سترة عليه. واما صحة طلبه سبحانه الايمان والعمل بالأركان منهم حينئذ مع علمه الفعلي بعدم صدور الايمان منهم لعدم اختيارهم الايمان وارادتهم العمل بالأركان، فلأجل إعلامهم بما في الفعل من الصلاح الراجع إلى أنفسهم ولكى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له سبحانه عليهم حجة بالغة وانه سبحانه لم يكن ليظلمهم بل هم باختيارهم عدم الاطاعة يظلمون، وفى الحديث (ان اظلم الناس من يظلم على نفسه).
واما الجواب عن شبهة الجبر فلم يتعرض الاستاذ له تفصيلا خوفا على بعض الطلاب من دخول بعض الشبهات في اذهانهم القاصرة بل وانما احال الجواب إلى وقت آخر يقتضيه المقام، نعم افاد في دفع الشبهة وفسادها بنحو الاجمال محيلا ذلك إلى قضاء الوجدان بالفرق الواضح بين حركة يد المرتعش وحركة يد المختار، وهو كما افاد (دام ظله) حيث نرى ونشاهد بالوجدان والعيان كوننا مختارين فيما يصدر عنا من الافعال وفى مقام الاطاعة العصيان وان مجرد علمه سبحانه بالنظام الاكمل غير موجب لسلب قدرتنا واختيارنا فيما يصدر عنا من الافعال والاعمال كما يقول به الجبرية (خذلهم الله سبحانه) بل كنا بعد مختارين فيما يصدر عنا من الافعال وان عدم صدور العمل من في مقام الاطاعة انما هو باختيارنا وعدم ارادتنا الايجاد لترجيحنا ما نتخيل من بعض الفوائد العاجلة على ما في الاطاعة من المنافع المحققة الآجلة الأخروية من غير ان نكون مجبورين في ايجاد الفعل المأمور به أو تركه بوجه اصلا، كما لا يخفى. والى ذلك أيضا يشير بعض ما ورد من النصوص عن الائمة المهديين صلوات الله عليهم اجمعين بان كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وان كل انسان في قلبه حين ولادته نقطة بيضاء ونقطة سوداء وكان لقلبه اذنان ينفث في احدهما الملك وفى الآخر الشيطان وان لكل نفس مكانا في الجنة هو له إذا سلك سبل الخير ومكانا في النار إذا سلك سبل الشر. حيث ان افراد الانسان بأجمعها خلقت من نطفة امشاج ومن رقائق العوالم العلوية والسفلية وخمرت طينته منهما، فبعضهم باختيارهم لما لا حظ المنافع الأخروية ورجحها على ما يتراءى في نظره من اللذائذ الدنيوية الفانية فسلك من هذه الجهة سبيل التوحيد كان سلوكه لسبيل التوحيد منشأ لغلبة تلك النقطة البيضاء التي كانت في قلبه إلى ان بلغت حدا احاطت بتمامه وانعدمت النقطة السوداء، وبعضهم بالعكس فسلك سبيل الشر ترجيحا لما يتراءى في نظره من اللذائذ والمشتهيات النفسانية على المنافع الجليلة الأخروية باختيار منه فصار سلوكه مسلك الشر منشأ لغلبة تلك النقطة السوداء التي كانت في قلبه إلى ان بلغت حدا أحاطت بتمامه، فصار الاول من اهل التوحيد والايمان والثاني من اهل الفسوق والعصيان من غير ان يكون واحد منهم مجبورا في الاطاعة والمعصية بوجه اصلا، كما لا يخفى. والى ما ذكرنا ايضا لابد وان يحمل الخبر المعروف بان السعيد سعيد في بطن امه والشقي شقي في بطن امه حيث انه على فرض صدوره عن الامام (عليه السلام) وعدم كونه من الموضوعات، محمول على تقدم علم سبحانه قبل ولادة افراد الانسان بما يصيرون إليه في عاقبة امرهم بسبب سعيهم الاختياري في ترجيحات بعضهم المنافع الأخروية على الفوائد الدنيوية واللذائذ الشهوانية وترجيحات بعضهم الآخر اللذائذ الدنيوية على الفوائد الجليلة الأخروية، والا فلابد من طرحه لمخالفته لما يحكم به بداهة العقل والوجدان ولما نطق به الكتاب السنة المتواترة. وحينئذ فإذا ظهر لك عدم مجبورية العباد فيما يصدر منهم عن الافعال في مقام الاطاعة والعصيان، ظهر أيضا صحة تعلق الارادة التشريعية بالأيمان من الكفار وبالعمل بالأركان من اهل الفسوق والعصيان من دون ان يكون ذلك من الامر بالمحال وبما لا يقدر عليه العباد، من جهة ما عرفت من كون العبد بعد على ارادته واختياره في ايجاد الفعل المأمور به وان عدم صدوره منه انما هو لأجل عدم تحقق علته التي هي ارادته للإيجاد بسوء اختياره وترجيحه جانب المشتهيات النفسانية على المنافع الاخروية.
واما صحة طلبه سبحانه منه حينئذ مع علمه بعدم صدور الفعل منه من جهة عدم ارادته، فهو كما تقدم لأجل الاعلام بما في الفعل من الصلاح الراجع إلى انفسهم ولكى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولئلا يكون لهم على الله سبحانه الحجة بل كان له سبحانه عليهم حجة بالغة من جهة اعلامهم بما فيه الصلاح والفساد، فتدبر.
واما شبهة الاوامر الامتحانية فنقول في الجواب عنها:
بان الاوامر الامتحانية على قسمين: الاول ما لا يكون في متعلقه مصلحة بوجه من الوجوه لا بعنوانه الاولى ولا بعنوانه الثانوي وهذا نظير ما لو كان الامر بالإيجاد لمحض امتحان العبد وفهم انه هل كان بصدد الاطاعة والامتثال ام لا، الثاني ما يكون مصلحة في متعلقه بالعنوان الثانوي وان لم يكن فيه مصلحة بالعنوان الاولى وهذا نظير ما لو كان الغرض هو امتحان العبد فيما يصدر منه من العمل كما في امر العبد بصنع الغليان والشاي مثلا لاختباره في انه ماهر في ذلك لكى ينتفع به عند ورود الضيف عليه أو انه لا يكون له المهارة فيه فانه في هذا الفرض وان لم يكن في متعلق امره وهو الغليان مصلحة بعنوانه الاولى بل ولعله كان فيه مفسدة لما كان للمولى من وجع الصدر بنحو يضربه شرب الغليان والشاي ولكنه بالعنوان الثانوي كان فيه المصلحة وبذلك صار متعلقا لغرضه.
وبعد ذلك نقول: بان الاوامر الامتحانية ما كان منها من قبيل الثاني فنلتزم فيها بعدم انفكاكها عن ارادة العمل حيث نقول في مثلها بتعلق الارادة الحقيقية من المولى بإيجاد العمل من المأمور وانه أي المأمور يستحق العقوبة على المخالفة فيما لو خالف.
واما ما كان منها من قبيل الاول الذي فرضنا خلو المتعلق عنه المصلحة بقول مطلق حتى بالعنوان الثانوي فمثلها وان كان خاليا عن الارادة الحقيقية ولكنه نحن نمنع كونها طلبا وامر حقيقيا ايضا حيث نقول بكونها حينئذ طلبا وامرا صوريا لا حقيقيا، ومن ذلك ايضا نمنع موضوعية مثل هذه الاوامر لحكم العقل بوجوب الاطاعة والامتثال وانه لا يكاد يحكم العقل فيها بوجوب الاطاعة، ولذلك ايضا ترى ان المولى كان في كمال الجهد بان لا يطلع العبد بواقع قصده وكون امره لمحض امتحانه، واما نفس الامتحان الذي هو الغرض من هذ البعث فهو ايضا غير متوقف على الامر الحقيقي بل هو يترتب بمحض تخيل العبد كونه امر حقيقيا ناشئا عن ارادة جدية متعلقة بالعمل وان لم يكن بحسب الواقع ونفس الامر بل كان امرا صوريا، كما هو واضح. وعلى هذا فما تخلف الطلب عن الارادة في شيء من الاوامر الامتحانية كما توهمه الاشعري، فانه في مورد كان الطلب طلبا حقيقيا قد عرفت عدم انفكاكه أيضا عن الارادة الحقيقية المتعلقة بإيجاد العمل، وفي مورد لا يكون فيه ارادة حقيقية متعلقة بالعمل فلا يكون الطلب ايضا طلبا حقيقيا بل طلبا صوريا، فيبطل حينئذ دعوى الاشعري من مغايرة الطلب مع الارادة وكان التحقيق هو الذي عليه الجمهور من اتحاد الطلب والارادة.
بقى شيء: وهو ان الطلب والارادة بناء على اتحادهما كما هو التحقيق هل يمكن في مقام تعلقه بشيء ان يكون لمصلحة في نفسه ام لا بل لابد وان يكون تعلقه بالشيء لمصلحة في ذلك الشيء؟ حيث ان فيه وجهين، وربما يترتب عليه ثمرات مهمة، منها في مسألة الملازمة المعروفة بين حكم العقل والشرع، حيث انه بناء على امكان ان يكون الارادة لمصلحة في نفسها يسقط النزاع المزبور إذ حينئذ بمجرد درك العقل حسن شيء أو قبحه لا يمكننا كشف حكم الشارع فيه بالوجوب أو الحرمة، كما انه كذلك ايضا في طرف العكس فإذا حكم الشارع بوجوب شيء أو حرمته لا يمكن الكشف به عن حسن ذلك الشيء الذي امر به الشارع أو قبحه، من جهة احتمال ان يكون حكم الشارع فيه بالوجوب أو الحرمة لمصلحة في نفس حكمه وطلبه. وهذ بخلافه على الثاني من كونه لمصلحة في متعلقه، فانه حينئذ يكون كمال المجال لدعوى الملازمة خصوصا من طرف حكم الشرع، فيتم ما بنوا عليه من ان الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، إذ حينئذ بمجرد حكم الشارع في شيء بالوجوب أو الحرمة يستكشف منه لا محالة كشفا قطعيا عن حسن ذلك الشيء أو قبحه. نعم في تمامية تلك الملازمة من طرف حكم العقل فيما لو ادرك حسن شيء أو قبحه اشكال كما سيأتي ينشأ من عدم كون مجرد الصلاح في شيء علة لحكم الشارع فيه بالوجوب بل وانما غايته كونه مقتضيا لذلك فيمكن حينئذ ان يمنع عن تأثيره مانع أو مزاحم. وعلى كل حال: فالذي يقتضيه التحقيق في اصل المسألة هو الوجه الثاني وهو لزوم كون الارادة في مقام تعلقه بشيء لمصلحة في ذلك الشيء لا لمصلحة في نفسها، والعمدة في ذلك انما هي الوجدان حيث يرى الانسان بالوجدان وماله من الجبلة والارتكاز في تعلق حبه أو بغضه بشيء انه انما يكون لم يجد في ذلك الشيء من الخصوصية الموجبة لملائمة النفس وانبساطها أو الخصوصية الموجبة لمنافرة النفس واشمئزازها، وانه بدون تلك الخصوصية المستتبعة للانبساط أو الاشمئزاز لا يكاد يوجد للنفس ميل ولا محبة إلى ذلك الشيء بوجه اصلا، كيف وانه لو لا ذلك لا تجه عليه اشكال الترجيح بلا مرجح في الامرين المتساويين في جميع الخصوصيات بل في أمر واحد بانه لم صار ذلك الشيء محبوبا لا مبغوضا ؟ إذ حينئذ لا محيص الا من دعوى ان تعلق الحب والبغض بشيء انما هو لخصوصية في ذلك الشيء اوجبت تلك الخصوصية انبساط النفس فتعلق به الميل والمحبة أو اشمئزازها فتعلق به المبغوضية .
وعلى ذلك نقول بانه إذا كان ذلك شأن الحب والبغض فل جرم يتبعهما الارادة والكراهة أيضا فانهما تابعتان لمقدماتهما التي منها التصديق بفائدة الشيء والميل والمحبة له فلا تكون الارادة أيضا في تعلقها بشيء الا لصلاح في نفس ذلك الشيء لا لصلاح في نفسها. وحينئذ ففي مثل هذا الوجدان والارتكاز غنى وكفاية في اثبات لزوم كون الارادة لمصلحة في خصوص متعلقها وبطلان توهم كونها لصلاح في نفسها بلا احتياج إلى اتعاب النفس في اقامة البرهان عليه ايضا كما هو واضح. ثم ان الظاهر ان عمدة المنشأ لتوهم امكان كون الارادة لمصلحة في نفسها انما هو ملاحظة موارد الاقامة فيما لو كان قصد الاقامة لأجل ترتب حكم وجوب الصوم والتمام، حيث انه بعد ان يرى عدم ترتب حكم وجوب التمام على اقامة عشرة ايام خارجا ولا عليها مع القصد المزبور بشهادة ترتب حكم وجوب التمام بمحض تحقق قصد اقامة عشرة ايام منه في مكان مع اتيان صلاة اربع ركعات وان لم يتحقق منه في الخارج اقامة عشرة ايام بل زال قصده ونوى الخروج من محل الاقامة فخرج منه إلى مكان آخر تخيل من هذه الجهة ان ترتب حكم وجوب التمام ووجوب الصوم انما كان على مجرد قصد اقامة عشرة ايام وارادته ذلك لا على نفس الاقامة الخارجية ولا عليها والقصد المزبور، فمن تلك الجهة استظهر حينئذ انه إذا امكن في مورد تعلق الارادة والقصد لا لصلاح في ذلك الشيء بل لصلاح مترتب على نفس القصد والارادة كما في ناوى الاقامة عشرة ايام لأجل وجوب التمام فليكن كذلك في غير ذلك المورد أيضا، لان الامثال سواء فيما يجوز وفيما لا يجوز، فإذا جاز وامكن في مورد يجوز ويمكن في جميع الموارد، هذا.
ولكن نقول في دفع تلك الشبهة: بان ترتب وجوب التمام انما كان على نفس الاقامة الخارجية غايته لا على وجودها المنحفظ بقول مطلق حتى من غير ناحية القصد والارادة بل على وجودها المنحفظ من ناحية القصد المزبور فهو الذي كان موضوعا لحكم الشرع بوجوب الصوم والتمام، فإذا انحفظ وجودها من الجهة المزبورة يترتب عليها الحكم بالتمام لتحقق ما هو الموضوع للحكم المزبور، وعلى ذلك فلا يرتبط ذلك بمقام ترتب وجوب التمام على صرف القصد المزبور بوجه اصلا بل هو كم عرفت مترتب على نفس الاقامة الخارجية، وحينئذ فتعلق القصد بها من ناوى الاقامة انما هو جهة ما يرى بنظره من ترتب وجوب التمام على الاقامة، فانه بعد ان يرى ذلك يتعلق بها قصده وتتمشى منه الارادة إلى وجودها وبمجرد تعلق قصده بها يتحقق ما هو موضوع حكم الشارع بوجوب التمام. نعم غاية ما هناك انه لابد حينئذ من جزم المكلف بانحفاظ وجود الاقامة عشرة ايام خارجا من سائر الجهات لكى يتحقق منه القصد إليها ويتمشى منه الارادة إلى وجودها، والا فبدون الجزم المزبور فضلا عن الجزم بالخلاف وخروجه في الاثناء عن محل الاقامة يستحيل تمشى القصد والارادة منه إليها بوجه اصلا كما لا يخفى، وحينئذ فصح لنا ان نقول بقول مطلق: بان الارادة لا تكاد تكون الا لمصلحة في متعلقها.
بقى شيء لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من لزوم تبعية الارادة لمصلحة في متعلقها وامتناع كونه لصلاح في نفسها ليس المقصود منه هو عليه مجرد الصلاح في الشيء لتعلق الارادة به كي يلزمه انه مهما وجد صلاح في فعل أو شيء لابد ان يكون هناك ارادة أيضا متعلقة بذلك الشيء كما لعله مبنى القائل بالملازمة، بل المقصود من ذلك هو كون الصلاح في الشيء مقتضيا لتعلق الارادة بذلك الشيء على معنى مؤثرية ذلك الصلاح الكائن في الفعل في توجه الارادة الفعلية بذلك الفعل لو لا وجود المانع أو المزاحم في البين. فحينئذ فإذا كان الصلاح المزبور يتوقف تأثيره الفعلي في الارادة بعدم وجود المانع أو المزاحم نقول: بان مانعية الشيء قد تكون في اصل تأثير المصلحة في الارادة الفعلية بل وفي مباديها من الرجحان والمحبوبية أيضا وقد تكون في تأثيرها في مقام ابراز الارادة بالأمر والبعث نحو المراد لا في اصل الارادة الفعلية، ويفرض الثاني فيما لو كان القصور من طرف المولى في عدم تمكنه من ابراز مقصده إلى المكلف والمأمور خوف على نفسه أو على غيره، كما يفرض ذلك فيما لو كان عنده عدو بحيث لو ابرز إرادته لعرض عليه الحسد وقتله في الحال، ونحو ذلك من الامور المانعة عن ابراز المقاصد، كما انه من هذا القبيل مسألة الدلالة على ولي الله على ما ورد من الاخبار الكثيرة بان النبي (صلى الله عليه وآله) كان مأمورا من قبل على نصب ولي الله بالخلافة من بعده لكنه (صلى الله عليه وآله) خوفا عن خروج الناس عن دينهم لم يظهر ذلك إلى أن نزلت قوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] ..الخ. وعلى كل حال نقول: بأنه في مثل هذا الفرض لما كانت الارادة الفعلية متحققة يجب على المكلف والمأمور عند علمه بإرادة المولى وفعليته المبادرة بإتيان ما هو مطلوب المولى من جهة استقلال العقل حينئذ بلزوم الاتيان والاطاعة وعدم جواز المخالفة بمحض عدم ابراز المولى ارادته وعدم امره وبعثه نحو المراد، كما هو واضح.
فتمام المقصود من هذا الاطناب انما هو لزوم عدم الاعتناء بمثل هذا المانع وان وجوده كعدمه بنظر العقل فيما هو همه من لزوم الاطاعة وحرمة المخالفة. نعم ما كان منها أي من الموانع من قبيل الاول الذي كان مانع عن تأثير المصلحة في اصل الارادة خاصة أو فيها وفي ما هو من مباديها من الرجحان والمحبوبية، كما في مسألة الضد المبتلى بالاهم ومسألة الاجتماع بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي، حيث انه في الاول يؤثر المانع في عدم تعلق الارادة بالهم وفى الثاني في عدم الرجحان والمحبوبية الفعلية، ففيها لا مجال لوجوب الاتيان وحرمة المخالفة، من دون فرق بين ان يكون المانع راجعا إلى المكلف والمأمور كما في المثال حيث كان المانع عن توجه الارادة الفعلية نحو الضدين هو عدم قدرة المأمور على الامتثال، أو كان المانع راجعا إلى المولى.
كما لو لا حظ المولى في عدم ارادة الفعل الذي فيه صلاح مصلحة اهم كانت في نظره من مثل مصلحة التسهيل على العباد على ما ينبئ عنه مثل قوله (صلى الله عليه وآله) (لو لا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك) حيث انه يستفاد منه ان المصلحة الكائنة في السواك مصلحة ملزمة ولكنها لمزاحمتها لمصلحة التسهيل رخص الشارع في تركه وما اوجبه على المكلفين . وعلى ذلك ربما يترتب ايضا مبنى انكار قاعدة الملازمة المدعاة بين حكم العقل والشرع، إذ على هذا البيان يتوجه على القاعدة المزبورة ان مجرد درك العقل حسن الشيء أو قبحه لا يوجب كشف حكم شرعي على طبقه بالوجوب أو الحرمة من جهة احتمال مزاحمة تلك المصلحة بمصلحة اخرى في نظر الشارع اهم ولو كانت هي مصلحة التسهيل اوجبت تلك المصلحة الترخيص على خلاف ما يقتضيه مصلحة الفعل.
وحينئذ فمع هذا الاحتمال كيف يمكن كشف الحكم الشرعي من الوجوب أو الحرمة على طبق ما أدركه العقل والحكم بوجوبه وحرمته، كما هو واضح. نعم في مقام العمل امكن لنا دعوى وجوبه عملا من جهة قاعدة المقتضى والمزاحم على ما تقرر في محله: بأن العقلاء بعد احرازهم وجود المقتضى للشيء في مقام يجرون عملا على طبق ذلك المقتضى من دون إعتنائهم باحتمال وجود المانع أو المزاحم في البين ولو في مورد لم يكن هناك اصل يقتضى التعبد بعدمه كما هو واضح، فتدبر.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|