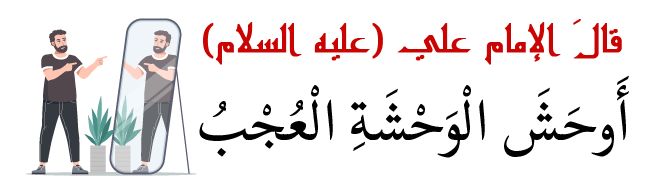
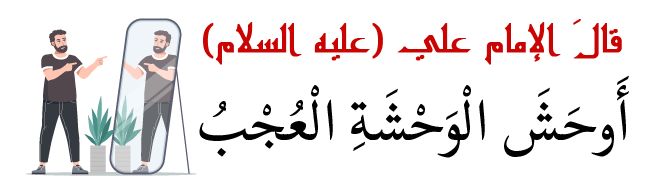

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
التاريخ: 29-8-2016
التاريخ: 30-8-2016
التاريخ: 31-8-2016
|
إمتناع التقييد بقيود تاتي من ناحية الأمر:
أنت خبير بأنّ مبنى عدم الجريان في كلا الأصلين هو امتناع التقييد بهذه القيود، وحيث انجرّ الكلام إلى هنا ينبغي التكلّم في مقامين وإن تقدّم البحث عنهما في صدر الكتاب عند تقسيم الواجب إلى التعبّدي والتوصّلي:
الأوّل: في امتناع هذا التقييد وإمكانه بحسب مقام الثبوت، ثمّ تصحيح الأمر العبادي على تقدير الامتناع.
والثاني: في تمهيد الأصل لحال الشكّ في أصل التعبّدية أو في هذا التقييد بعد الفراغ عن أصل التعبديّة.
أمّا المقام الأوّل: فاعلم أنّ ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب امتناع التقييد المذكور وجوه أربعة:
الأوّل: لزوم الدور، بيانه أنّ هذه القيود متأخّرة رتبة عن الأمر؛ فإنّ حدوثها معلول له وبتبعه، ولا شكّ أنّ المعلول متأخّر رتبة عن علّته، وموضوع الشيء متقدّم رتبة على الشيء، فيلزم من درج هذه القيود في موضوع الأمر تقدّم الشيء على النفس؛ فإنّ الموضوع المقيّد بأحدها بما هو مقيّد به متوقّف على وجود الأمر، ووجود الأمر أيضا متوقّف على هذا المقيّد لكونه موضوعه.
والجواب أنّ موضوع الأمر ليس هو الوجود الخارجي للمقيّد، بل هو الوجود التصوّري له، وإلّا يلزم طلب الحاصل، والإتيان بالفعل بداعي الأمر بحسب الخارج متوقّف على وجود الأمر، وأمّا بحسب التصوّر فلا؛ لوضوح إمكان أن يتصوّر الآمر قبل إنشاء الأمر نفس الفعل والأمر وتقييد الأوّل بالثاني، ثمّ يجعل هذا المفهوم المقيّد محلا لإنشاء الأمر، فما يتوقّف عليه الأمر تصوّر الموضوع، وما يتوقّف على الأمر خارج الموضوع، فاختلف الطرفان، فأحدهما الوجود التصوّري، والآخر الوجود الخارجي.
والثاني: لزوم الدور بوجه آخر، وبيانه: أنّ الأمر يتوقّف على قدرة المأمور على متعلّقه؛ لوضوح استحالة الأمر بغير المقدور من الحكيم، والقدرة على الفعل المقيّد بهذه القيود متوقّفة أيضا على الأمر، فإنّ المكلّف لا يتمكّن من الإتيان بالفعل في الخارج بهذه القيود إلّا بعد الأمر.
والجواب: أنّ توقّف القدرة على الأمر مسلّم، ولا نسلّم توقّف الأمر على القدرة السابقة على الأمر؛ فإنّ الممتنع عقلا هو اجتماع الأمر وعجز المكلّف في زمان الامتثال، وأمّا لو فرض تمكّنه حين الامتثال فلا امتناع وإن كان التمكّن جائيّا بالأمر ومتحقّقا من قبله لا قبله.
والثالث: أنّ التكليف بالمقيّد بهذه القيود تكليف بغير المقدور، ولا يحصل القدرة على متعلّقه حتى بعد الأمر؛ فإن القيد هو داعي الأمر المتعلّق بذات الفعل، والقدرة عليه متوقّفة على الأمر بذاته، ولا يكفي الأمر بالمقيّد منه بداعي أمره؛ فإنّ الأمر بالمقيّد ليس أمرا بالمطلق.
لا يقال: كيف لا يكون أمرا بالمطلق وهو جزء للمقيّد، والأمر المتعلّق بالكلّ متعلّق بكلّ واحد من أجزائه نفسيّا باعتبار تحقّقه في ضمن الكلّ، ومقدّميّا باعتبار نفسه مستقلا.
فإنّه يقال: نعم، المطلق جزء للمقيّد، لكنّه جزء عقلي وليس بخارجي بمعنى أنّه ليس للقيد والذات في الخارج وجودان منحازان، بل هما موجودان فيه بوجود واحد، والمطلوبيّة المقدّمية إنّما يصحّ في الجزء الخارجي، فلا يصحّ أن يقال في «أعتق رقبة مؤمنة»: إنّ مطلق الرقبة مطلوب من باب المقدّمة بعد فرض أنّ في الخارج ليس إلّا وجود واحد له ولقيده، وكذا الكلام في المطلوبيّة النفسيّة؛ فإنّها متعلّقه بالوجود في الخارج فهي إنّما تسري من الكلّ إلى الجزء الخارجي الموجود بوجود على حدة باعتبار تحقّقه في ضمن الكلّ.
والجواب أنّ المطلق وإن كان لا يسري إليه الأمر من المقيّد، ولكنّ المقسم بينهما لا نسلّم فيه ذلك، فكما أنّ الوجود يسري من المقيّد إليه، فإذا وجد زيد يصحّ نسبة الوجود حقيقة إلى الإنسان، فكذلك الوجوب، ولهذا نقول في توجيه البراءة في دوران الواجب بين المطلق والمقيّد أنّ المتيقّن وجوب الأقلّ، والزائد وجوبه غير معلوم؛ فإنّ المراد بالمتيقّن الوجوب لا يكون هو المطلق، كيف وهو طرف الترديد، فلا بدّ أن يكون هو الجامع بينهما، ولو لا سراية الوجوب من المقيّد إلى الجامع لما صحّ ذلك.
فإن قلت: هذه الإرادة المتعلّقة بالجامع غير قابل للامتثال ولا يدعو نحو متعلّقه؛ فإنّها إرادة عرضيّة ولا يدعو إلّا نحو المطلوب الأصلي أعني المقيّد، أ لا ترى أنّه لو كان المراد الأصلي عتق الرقبة المؤمنة فلا توجب الإرادة العرضيّة المتعلّقة بالرقبة المهملة تحريك المكلّف نحو المهملة في ضمن رقبة كافرة، فإتيانها غير مثمر للدعوى: فإنّها متوقّفة على أمر بذات الفعل صالح للدعوة إلى الذات.
قلت هذا إنّما هو في ما إذا لزم من الدعوة نحو المهملة المجرّدة عن القيد وجود قيد آخر مباين لما اخذ في متعلّق الأمر كما في المثال، حيث يلزم من الدعوة نحو عتق الرقبة المجرّدة عن وصف الإيمان تحقّق الكفر المباين له؛ فإنّه حينئذ لا يدعو إلى المهملة في غير هذا القيد، لكون المطلوب ناقصا وغير حاصل بتمام أجزائه، وأمّا لو فرض أنّه لو دعا نحو المهملة يتمّ المطلوب بقيده قهرا، فلا مانع من داعويته، ففي المقام المفروض تعلّق الأمر فيه بالفعل بداعي الأمر لو أتى بالفعل بداعي الأمر العرضي المتعلّق به كان هو عين المطلوب؛ فإنّ القيد قد حصل بنفس الدعوة نحو المهملة.
والرابع: وهو الوجه الذي لا مدفع له أنّ من شأن الأمر المولوي وإن كان توصليّا أن يكون صالحا للدعوة نحو متعلّقه؛ فإنّ الغرض منه صيرورته داعيا للعبد نحو المطلوب لو لم يكن في نفسه داع آخر، فإن كان المطلوب مقيّدا لا بدّ أن يكون صالحا للتحريك نحو كلّ من الذات وقيدها، والأمر المتعلّق بالفعل مقيّدا بداعي الأمر لا يمكن أن يصير داعيا إلى القيد؛ فإنّه عبارة عن داعويّة نفسه، ويمتنع أن يصير الأمر داعيا إلى داعوية نفسه نظير صيرورة العلّة علّة لعليّة نفسها.
وإذ قد تبيّن امتناع التقييد المذكور فلا بدّ من تصوير الأمر العبادي لمعلوميّة وقوعه في الشريعة المطهّرة كثيرا، فنقول: يمكن تصويره بأحد وجوه أربعة:
الأوّل: أن يكون نحو الأمر في العباديّات نحو الأمر في التوصّليات، بمعنى أنّه كان متعلّقا بذات الفعل، ولكن حيث علم المكلّف من الخارج كالإجماع ونحوه بأخصيّة الغرض وكونه متعلّقا بالفعل مع قصد القربة لا مطلقا، لزم بحكم العقل إتيان القيد أيضا، لئلا يلزم تفويت غرض المولى القبيح عقلا، فوجوب أصل الفعل جاء من قبل الأمر، ووجوب القيد من قبل أخصيّة الغرض وأضيقيته.
والثاني: التزام أمرين، أحدهما بذات العمل، والآخر بالعمل المقيّد بإتيانه بداعي الأمر المتعلّق بذاته، فداعوية الأمر الأوّل اخذت قيدا لمتعلّق الأمر الثاني، فالأمر الأوّل يحرّك إلى نفس العمل بأيّ وجه اتفق، والثاني يحرّك إلى إتيانه بقصد أمره، فإتيانه بداعي غير الأمر إطاعة للأوّل وعصيان للثاني.
والثالث: أنّ المعتبر في العبادة ليس كونها صادرة بداعي الأمر، بل المعتبر كونها مقرّبة، ولا ينحصر القرب بصورة الإتيان بداعي الأمر، بل يمكن أن يكون ذات العمل مع قطع النظر عن تعلّق الأمر به مقرّبا موجبا لقرب فاعله، فعنوان الخضوع والخشوع للّه حسن في ذاته مقرّب للعبد وإن لم يتعلّق به أمر أصلا.
فنقول الأوامر التعبّدية كلّها متعلّقة بأفعال هي في حدّ ذاتها حسن مقرّب كما في الأمر بالصلاة؛ فإنّه متعلّق بالمركّب من التكبير والحمد والثناء والتهليل والتسبيح والدعاء والخضوع والخشوع، ومن الواضح أنّ نفس صدور هذه الأفعال وإن كان بداع نفساني يكون حسنا، وبالجملة، فالأوامر التعبديّة متعلّقة بأفعال هي مقرّبة بالذات من دون حاجة إلى داعي الأمر، لا بما لا يقرّب إلّا مع هذا الداعي حتى يلزم المحذور.
والرابع: التزام الامر بالعمل مقيّدا بعدم دواع أخر من الدواعى النفسانيّة؛ فإنّه حينئذ يصير المكلّف مقهورا بالإتيان بداعي الأمر؛ لامتناع خلوّ الفعل الاختيارى عن جميع الدواعي، هذا هو الكلام في المقام الأوّل.
أمّا المقام الثانى، فاعلم أنّه لو شكّ في واجب أنّه تعبّدي أو توصّلي، أو شكّ في الواجب المعلوم تعبّديته أنّه هل يعتبر في إجزائه وقوعه بداعي الأمر أو الوجه أو التمييز أولا؟ فهل هنا إطلاق يدفع به مئونة التعبديّة أو احتمال القيد الزائد أولا؟ وأيضا هل يجري البراءة في رفعها أولا بناء على كلّ من الوجوه الأربعة في تصحيح الأمر التعبّدي.
الحقّ أن يقال: إنّ هذه الوجوه بين ثلاثة أقسام:
الأوّل: التصحيح بأضيقيّة الغرض مع عدم إمكان التقييد.
الثاني: التصحيح بتعدّد الامر.
الثالث: تدرّج القيد المحتاج إليه في العبادة في المأمور به على نحويه من كون نفس الفعل مقرّبا ومن كون القيد عدم الدواعي الأخر.
فلا إشكال على القسم الأخير؛ فإنّ الكلام في القيد المذكور على نحو القيود الأخر، فإن كان مقدّمات الإطلاق موجودة نأخذ بها، وإلّا فالمرجع الأصل العملى وهو البراءة، ونرفع بها القيد.
وكذلك لا إشكال على القسم الوسط؛ فإنّ الإطلاق وإن كان غير ممكن بناء عليه، ولكنّ البراءة جارية هنا وإن قلنا بعدم جريانها في دوران الأمر بين المطلق والمقيّد، والوجه أنّ الشكّ هنا ليس في القيد الزائد حتى يكون جريان البراءة فيه محلّا للكلام، بل في وجود أمر مستقلّ بالمقيّد غير الأمر بذات العمل وهو محلّ البراءة بلا كلام.
وأمّا على القسم الأوّل أعني أضيقيّة الغرض، فالإطلاق في كلام واحد وإن كان غير ممكن، لكن في مجموع الكلامات ممكن، بيان ذلك: أنّ للإطلاق قسمين، الأوّل:
ما كان في كلام واحد وهو الإطلاق المصطلح، والثاني: ما يستفاد من مجموع كلامات واردة في خصوص باب، ومثاله الاخبار الواردة في الأمر بغسل اليد أو الثوب عند الملاقاة بشيء خاص، فإنّ كلّ واحد واحد منها لا يمكن أخذ الإطلاق منه لرفع وجوب العصر والتعدّد؛ فإنّها واردة مورد حكم آخر وهو نجاسة الشيء الخاص، وأمّا أنّ كيفيّة الغسل من حيث العصر والتعدّد ما ذا فليست في مقام بيانها.
ولكن يمكن أن يستفاد من خلوّ جميع هذه الأخبار عن ذكر العصر والتعدّد- مع أنّه لو كانا معتبرين للزم التعرّض في واحد من هذه الأخبار- أنّه لم يكن في باب التطهير تعبّد زائد على القدر المعتبر عند العرف، وهو صبّ الماء إلى أن يزول العين، فعدم تقييد كلّ منها منفردا وإن لم يكن كافيا في الإطلاق ولكن عدم تقييد الكلّ كاف في ثبوته، بل ربّما يحصل من ذلك اليقين بعدم الاعتبار.
وكذلك الكلام في ما نحن فيه، فإنّ ملاحظة ابتلاء العامة بالصلاة في كلّ يوم وبالصوم في السنة وبغيرهما من العبادات، وملاحظة أنّ قيد داعي الأمر بمعنى عدم كفاية داعي احتماله، وكذلك داعي الوجه والتميز ممّا يغفل عنه عوام الناس ولا يلتفتون إليه قطعا، وابداء احتماله نشأ من المتكلّمين، وملاحظة خلوّ جميع ما ورد من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في باب العبادات عن ذكره والتعرّض له، يكفي في إثبات إطلاق الغرض وإن لم يمكن إثبات إطلاقه من كلام واحد، بل ربّما يحصل من ذلك القطع بعدم الاعتبار، فإنّ الشارع الذي لم يدع الأحكام الجزئيّة كأحكام التخلية إلّا بيّنها ولم يهملها، كيف يهمل مثل هذا الأمر الذي يكون من المهميّة بمكان ويجعله في سترة الخفاء.
وأمّا قوله تعالى: {فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [غافر: 65] فليس المراد بالإخلاص فيها إلّا فعل العبادة ممحّضا للّه في مقابل جعلها للصنم والنفس والشيطان، فهو نهي عن عبادة هذه وأمر بعبادته تعالى، وأمّا أنّ عبادته على أيّ نحو هي يعتبر فيها داعي الأمر أو الوجه أو التمييز فلا تعرّض في الآية له.
فتبيّن أنّ أصالة الإطلاق الاصطلاحي أعنى ما كان جاريا في كلام واحد وإن لم يمكن هنا، لكن أصالة الإطلاق، بل القطع يمكن اصطيادهما من تضاعيف الكلمات المتكثّرة الخالية عن ذكر القيد، ولو سلّمنا عدم كفاية هذا الإطلاق وبقاء الشكّ في الاعتبار معه بحاله نقول: ما الفرق بين هذا القيد المجهول والقيد المجهول في سائر المقامات في ملاك قبح العقاب بلا بيان، حيث إنّه في سائر المقامات لو عاقب عليه المولى عاقب على أمر مجهول لم ينبّه عليه ولم يتمّ الحجّة عليه، ولكن لم يلزم ذلك لو عاقبنا على هذا القيد المجهول.
فإن قيل: الفرق إمكان الأخذ في المأمور به في سائر المقامات وعدم إمكانه هنا.
نقول: إنّما كان غير الممكن هو الأخذ في المأمور به، لكن بيان القيد ببيان منفصل كان بمكان من الإمكان، فكما يحتجّ العبد في سائر المقامات على المولى بأنّه لم ما احدث القيد في المأمور به؟ يحتجّ عليه هنا بأنّه لو أردت القيد فلم ما بيّنته لى في كلام منفصل؟ وبالجملة، العقل في كلا المقامين يحكم بقبح العقاب بلا فرق أصلا.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الاحتياط في مقام الامتثال والاكتفاء بالإتيان الإجمالى خال عن الإشكال على جميع الوجوه في تصحيح العبادة، لكن هذا في ما إذا لم يكن التكرار في مورد يستلزمه الاحتياط لغوا وكان بداع عقلائى، كما لو شقّ عليه تعيين القبلة أو شقّ عليه السؤال في الشبهة الحكميّة.
وأمّا لو كان التكرار لغوا وعبثا- كما لو تمكّن في الشبهة الحكميّة مثلا عن السؤال وتعيين مورد التكليف بسهولة كما لو كان النبيّ جالسا في المجلس ومع ذلك لم يسأل عنه وأتى بأفعال عديدة- ولا يراد باللغويّة صدور الفعل بدون الداعي؛ فإنّ البحث في الفعل الاختياري الغير المنفكّ عن الداعي، والمقصود تقسيمه إلى قسمين، أحدهما ما لا يعدّونه لغوا وهو ما يكون بداع عقلائي، والآخر ما يعدّونه العرف مع وجود الداعي لغوا، وهو ما إذا كان بداع سفهائي، كما لو نصب السلّم على سقف البيت ثمّ استلم السقف بعد طيّ الدرج؛ فإنّ هذا فعل لغو مع كونه صادرا عن الداعي، فتحقّق أنّ اجتماع اللغويّة مع وجود الداعي ممكن.
ثمّ لا إشكال أنّ من يحتاط بالتكرار يكون الداعى له إلى أصل العمل أمر المولى، ضرورة أنّه لو لا الأمر لما تحمّل مشقّة، بل كان يستريح عن العمل رأسا وإنّما تحقّق منه اللغويّة بعد تحقّق هذا الداعي العقلائي منه في طريق الامتثال وكيفيته، فيقع حينئذ الكلام في الإجزاء في هذه الصورة المفروض ثبوت اللغويّة في كيفية الامتثال بعد صدور أصل العمل بداعى الأمر، والكلام في ذلك من جهتين:
الاولى: أنّ العمل يتّصف باللغويّة حتى في الفرد المصادف للواقع: والثانية أنّ اللغوية مانعة عن القرب والعباديّة، أمّا الاولى فنقول: لا إشكال أنّ من يتمكن من رفع الشبهة والاحتمال بسهولة كما لو كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا في مجلس العمل فعدم رفع الشبهة في الشبهة الحكميّة بالسؤال عنه مع كمال سهولته والإتيان بأفعال عديدة بداعي الاحتمال يعدّ سفها ولغوا عرفا.
وبعبارة اخرى: إبقاء الاحتمال وإتيان كلّ واحد من الأعمال مستندا إليه مع إمكان رفعه وإبداله بالجزم واتيان العمل عن جزم يكون عرفا من اللغو ولو في الواحد الذي مصادف للواقع، فلا يقال: إنّه مع فرض تحقّق داعي الأمر لا وجه لكون الواحد المصادف عبثا ووقوعه لغوا؛ لما عرفت من أنّ نفس إتيانه بداع الاحتمال الذي يمكن تبديله بالجزم بسهولة يجعله لغوا ولو فرض كون الواحد المصادف حاصلا في الأوّل؛ فإنّ أوليّته لا تنافي اتّصافه باللغوية، كما أنّه لو كان الاحتياط بإتيان عشرة أعمال مخلا بالنظام فالآتي بها يكون من أوّل اشتغاله بتلك الأعمال آتيا بما يخلّ بالنظام ومشتغلا بالفعل المحرّم وإن كان أوّل ما يأتي به هو الواجب واقعا.
وأمّا الثانية: وهي بيان منافاة اللغويّة للقرب والعبادية فنقول: لا إشكال أنّه يعتبر في العباديّة والمقرّبية علاوة على الحسن الفعلي وكون الفعل في حدّ نفسه فعلا حسنا ذا مصلحة أن يصير موجبا لصيرورة الفاعل أيضا بواسطة إتيانه بهذا الفعل الحسن حسنا وممدوحا، ولا شكّ أنّ الفعل اللغو والعبث وإن فرض اشتماله على الحسن الفعلي- كما في الواحد المصادف- ولكن لا يوجب الحسن الفاعلي؛ إذ الفاعل اللاغي العابث لا يتّصف بالحسن أبدا، فيمتنع أن يكون فعله عبادة، فلا يكون مجزيا.
فتحقّق من جميع ما ذكرنا أنّ ما ذكرنا من كفاية الامتثال الإجمالي- وإن كان مستلزما للتكرار وعدم لزوم تحصيل العلم التفصيلي- إنّما هو في غير ما إذا كان التكرار لغوا، كما أنّه مخصوص أيضا بغير ما إذا كان الاحتياط مخلا بالنظام، وفي هاتين الصورتين يلزم تحصيل العلم التفصيلي بمورد التكليف، لمنافاة الاحتياط مع المقرّبيّة في الاولى، وكونه حراما، فلا يتّصف بالعباديّة في الثانية، ووجه كفايته في غير هاتين الصورتين هو ما عرفت من أنّ إتيان المكلّف به على وجهه وبعنوان أنّه هذا الشيء المعيّن المتميّز عمّا عداه ليس له دخل في حصول القرب، واحتمال دخله في الغرض أيضا مرفوع بالأصل، هذا كلّه على تقدير إمكان تحصيل العلم التفصيلي.
وأمّا مع عدم إمكانه وإمكان الظنّ التفصيلى، فعلى ما ذكرنا من عدم دخل قصدي الوجه والتميز في القرب وكون احتمال دخله في الغرض مرفوعا بالأصل فالأمر دائر بين القطع بحصول العمل المكلّف به وبين الظنّ به، ولا شكّ أنّ الأوّل مقدّم.
ولا فرق في ذلك بين الظنّ الخاص أعنى: ما دلّ على اعتباره دليل شرعي، فإنّ غاية هذا الدليل هو الارفاق بالمكلّف بارتفاع مئونة الاحتياط عنه والاكتفاء منه بإتيان المظنون لا تعيين العمل به وتحريم الاحتياط، وبين الظنّ المطلق أعني: ما ثبت اعتباره بمقدّمات الانسداد؛ فإنّ غاية تلك المقدّمات الاكتفاء بالظنّ في المقام دون إيجابه؛ فإنّها عبارة عن امور:
أحدها: العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الواقع.
ثانيها: تعذّر العلم والعلمي، يعنى العلم التفصيلى والعلمي بهذا العلم بقرينة المقدمة الاولى، ثالثها: عدم وجوب الاحتياط بإتيان تمام الأطراف؛ لما فيه من العسر.
ويمكن إرجاع جميع هذه الامور الثلاثة إلى أمر واحد وهو عدم وجوب الامتثال القطعي أعمّ من القطع التفصيلي الوجدانى والشرعي الذي هو الظنّ التفصيلي الوجدانى والقطع الاجمالى.
وبالجملة، فإذا كان من جملة هذه المقدّمات عدم وجوب الاحتياط فلا يعقل تقدّم الظنّ على الاحتياط، نعم لو كان الاحتياط مخلّا بالنظام أو كان لغوا كان الظنّ التفصيلي بقسميه من الخاصّ والمطلق مقدّما عليه.
وبالجملة، بعد المصير في صورة إمكان العلم التفصيلى إلى كفاية الاحتياط في غير الصورتين، يكون الاكتفاء به في غيرهما في صورة عدم إمكانه وإمكان الظنّ التفصيلي، بل أولويّته على الظنّ واضحا.
إنّما الكلام في تقديم الظنّ على تقدير القول بتقدّم العلم التفصيلي في صورة إمكانه وعدم الاكتفاء بالاحتياط، إمّا لأنّ الإتيان بالمكلّف به على وجهه وبعنوان أنّه هذا المعيّن يكون دخيلا في القرب، أو لأنّه محتمل الدخل في الغرض، والأصل فيه الاشتغال وإن كان في غيره من دوران الأمر بين الأقلّ والاكثر هو البراءة.
فنقول: إن كان الظنّ من الظنون الخاصّة فالأمر دائر بين الامتثال المقطوع والامتثال المشكوك؛ وذلك لأنّه لو عمل بالظنّ كان مجزيا قطعا؛ لانتهائه إلى القطع بواسطة دليل اعتبار هذا الظن، ومع ذلك قد أتى بالقيد المشكوك الذي يجري فيه الاشتغال، أو المقطوع دخله في القرب؛ فإنّه يأتي بالعمل على وجه التكليف الفعلي ولو كان ظاهريا، وعلى نحو تميّز المكلّف به الفعلي ولو كان ظاهريّا، فيقطع ببراءة الذّمة، وهذا بخلاف ما لو احتاط؛ فإنّه قد أخلّ بقصد الوجه أو التميز، فلم يقطع بالبراءة والإجزاء، ولا شكّ أنّ الأوّل مقدّم.
وإن كان الظّن من الظنون المطلقة، فإن قلنا بالكشف بمعنى أنّ المقدّمات تكشف عن جعل الشارع مطلق الظن حجّة، فكذلك الكلام بعينه لوجود الحكم الشرعي الظاهري في طرف الظّن، ويمكن قصده على التعيين، ولو أراد الاحتياط يأتي بالطرف المظنون مع قصد الوجه والتميز، ويأتي مع ذلك بالطرف الموهوم برجاء كون الواقع فيه، ولا فرق في حصول هذا الاحتياط بين تقديم المظنون على الموهوم والعكس وإن كان شيخنا المرتضى قدّس سرّه جعل في ظاهر كلامه لتقديم المظنون دخلا في حصوله، ولكن لم نعلم له وجه.
و أمّا لو قلنا بالحكومة بمعنى أنّ العقل مستقلّ باعتبار الظن، فحينئذ كما لا يمكن قصد الوجه والتميز مع الاحتياط فكذلك مع الظن أيضا؛ فإنّ الوجه المقصود لو كان وجه الحكم الواقعي فالمفروض أنّه غير معلوم؛ بل مظنون، ولو كان وجه الحكم الظاهري فغير موجود؛ فإنّ العمل بالظنّ على هذا التقدير ليس إلّا عملا بالراجح من أطراف العلم الإجمالي وتقديمه على المرجوح والمتساوي الطرفين بحكم العقل، وأمّا حكم الشرع فغير موجود؛ فإنّ المقام مقام الامتثال، وهو محلّ لحكم العقل محضا وليس قابلا لحكم الشرع؛ فإنّ العقل يرى للامتثال مراتب:
الاولى: القطعي، وهو الإتيان بتمام الأطراف.
والاخرى: الظنّي، وهو الإتيان بالمظنونات.
والثالثة: المشكوك.
والرابعة: الموهوم، ولا شكّ أنّه حاكم بتعيّن الظنّي بعد رفع اليد عن القطعي، والأمر المولوي في مرحلة الامتثال غير ممكن، وهذا غير جعل المظنون بما هو مظنون حجّة كما هو مفاد المقدّمات على تقدير الكشف؛ فإنّه حكم مولوي في موضوع الظنّ لا حكم مولوي بالامتثال الظنّي.
و بالجملة، فعلى الحكومة حيث إنّ الموجود في البين هو حكم العقل المحض فالعامل بهذا الظّن أيضا كالمحتاط في أنّه لا بدّ وأن يعمل بالمظنون برجاء كونه الواقع، من دون قصد تعيين التكليف الفعلي ولو كان ظاهريا، وبعد ذلك لا وجه لتقديم الظنّ على الاحتياط، بل الثاني أولى من الأوّل؛ لاختصاصه بحصول القطع معه بحصول ذات المكلّف به، وعلى الأوّل يظنّ مع كون كليهما مشتركا في حصول الإجزاء بهما.
هذا تمام الكلام في القطع ممّا يناسب المقام، فيقع المقال في ما هو المهمّ من عقد هذا المقصد وهو بيان.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تدعو جامعة أربيل التقنية للمشاركة في الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
|
|
|