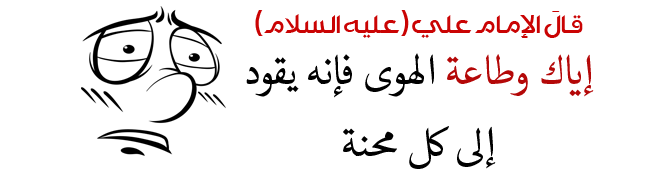
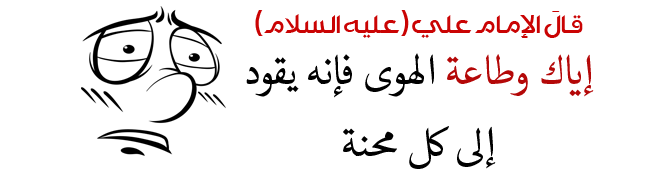

 الحياة الاسرية
الحياة الاسرية 
 المجتمع و قضاياه
المجتمع و قضاياه
 التربية والتعليم
التربية والتعليم |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-01
التاريخ: 1-11-2017
التاريخ: 2025-03-29
التاريخ: 2024-09-15
|
لو أردنا أن نتعرف عملياً على تأثير الطعام على جسد الإنسان وعقله وروحه، فلا بُدَّ أن نرجع إلى حياة الأشخاص الذين اهتموا بنوعية الغذاء وكميته.
وسنجد أن أعظم مثال لذلك هو الإمام علي (عليه السلام)، فقد كان جسده قوياً إلى درجة أنه قلع باب خيبر ـ وهو باب صخري كان يفتحه 22 رجل.
وكان بعض علماء الغرب يقول: لو أنَّ عبد الرحمان بن ملجم لم يضرب الإمام علي (عليه السلام) على رأسه لكان الإمام علي (عليه السلام) من الأحياء إلى وقتنا هذا.
وعنه (عليه السلام): ((وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان ألا وأنَّ الشجرة البرية أصلب عوداً والروائع الخضرة أرق جلوداً، والنباتات البدوية أقوى وقوداً وأبطأ خموداً))(1).
ومنهم «المهاتما غاندي»:
يُعتبر غاندي - مُحرّر الهند - من أشهر الأشخاص الذين كانوا يدعون إلى الطعام النباتي وإلى الصيام وله في ذلك تجارب عديدة ذكرها في سيرة حياته وفي ذلك يقول: ((أنا أعتقد أنَّ المرء لا يحتاج إلى المعالجة بالعقاقير إلا قليلاً، ففي تسعمائة وتسع وتسعين حالة من ألف يستطيع المرء الحصول على نتائج حسنة من طرق الغذاء المُنظّم تنظيماً حسناً، والمعالجة بالماء والتراب وأمثال ذلك....)).
ومنهم الدكتور ((جایلورد هوزر)) زعیم ((علم التغذية)) في العصر الحديث:
أصيب في صغره بسل الورك وأجريت له ست عمليات جراحية، وتولى معالجته أشهر الأطباء في أوروبا ثمَّ في أمريكا فعجزوا عن شفائه، وعاد إلى منزله يائساً، وفي إحدى الأيام رآه رجل عجوز وهو يأكل فطيرة جافة فقال له: أتظن أنَّ الأطعمة الميتة تعيد إليك الصحة؟ لكي تغذي جسماً حياً يجب أن تعطيه أطعمة حية)) فسأله: وما هي؟ فقال الرجل: كل شيء طازج ومملوء بعناصر النمو، كالخضروات والفواكه، والأعشاب وفعلاً بدأ ((هوزر)) باتباع هذا النظام، وبعد سبعة أسابيع زال الخراج من فخذه واستردّ صحته تدريجياً وشفي من مرضه.
ثم اتجه إلى التخصص بعلم التغذية فصار طبيباً ماهراً وأصبح مستشاراً للملوك والأمراء ونجوم السينما ووصلت أجرة استشارته إلى ألف دولار.
ومنهم الدكتورة ((مريم نور)):
والتي أصبحت علماً من أعلام الطب في الشرق الأوسط، فقد أصيبت الدكتورة بمرض السرطان وهي في الثلاثين من عمرها، فقرأت في علم ((الماكروبيوتيك)) وشُفيت من مرضها، ثم عكفت على دراسة علم الطب فأصبحت من الشهيرات في معالجة الأمراض، وقد أنشأت في لبنان مركزاً للعلاج وهو ((بيت النُّور))، وتقوم الدكتورة بنشر الوعي الصحي بين أبناء الوطن العربي من خلال المحاضرات والمقالات والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية.
ومنهم شعب الهونزا:
تقع ((الهونزا)) في أقصى حدود الهند في شمالي كشمير بين الأفغانستان غرباً والسينسكيان الصين شرقاً ويعيش فيها شعب حضاري من الناحية الإنسانية الصحية، ولذلك فقد صاروا محط أنظار العلماء والأطباء، وقد كتب عنهم أكثر من رحالة وطبيب وما يهمنا في هذا المجال هو طريقة عيشهم من ناحية الطعام.
((الصحة، هي ما يتعبده هذا الشعب، وهي موضع عنايته وثروته الفريدة. وفي هذا يمثل السرّ الغريب لهؤلاء البشر، الذي يحاول أن يكشف عنه مشاهير علم الطب)).
وكتب السيد ر. س. ف. شومبر، الذي كان يتردد كثيراً على بلاد الهونزا، أنَّه بالنسبة لساكن البلاد، يستطيع أحدهم أن يقوم بالسير على الأقدام لمسافة مائة كيلومتراً دون توقف، وأن يتم عمله حيث ذهب، ثمَّ أن يعود إلى بلدته، ذلك هو أمر عادي وطبيعي. ويروي المؤلف، أنَّه في فصل الشتاء، يقوم مواطن شعب الهونزا بحفر ثقبين في جليد إحدى البحيرات المجمدة، ثمَّ يغطس في أحد الثقبين ويخرج من الثقب الآخر ((كالدب القطبي)) على حد تعبير شومبر.
ويصف السير ((أوريلس ستاين)) كيف أن أحد الرُّسل، قد قطع على الأقدام، مسافة تبلغ ثلاثمائة وعشرين كيلومتراً، عبر جبالٍ بارتفاع المون بلان (القمم البيضاء في جبال الألب)، وعاد على الطريق ذاته. واستغرقت هذه الرحلة كلها سبعة أيام، عاد الرسول بعدها بنشاطه واستعداده، كما لو كان هذا السفر وأمثاله شيئاً عادياً وشأناً يومياً.
ولا يعرف هذا الشعب الهونزاني كلمة التعب كما يقول «رودي» في كتابه: «صحة شعب الهونزا».
وكتب الدكتور «مكاريزون» في 2 كانون الثاني سنة 1926 وفي مجلة (الجمعية الملكية للفنون الحرة)، كتب يقول: (إن درجة احتمال ومنعة ومقاومة هذا الشعب هي مدهشة جداً. بالنسبة لمواطن بلاد الهونزا، فإن خلع ثيابه وتعرية جسده ذي القامة الممشوقة والقياس الكلاسيكي، لكي يرمي بنفسه في مياه نهر الكلاسيكي مجلد، هو أمرٌ سهل كعادتنا إذ ندخل إلى مغطس مياه دافئة)).
إنَّ معرفة أكثر تقصيّاً لشعب الهونزا، دفعته أن يقرر بأنَّ السبب لهذه الصحة العجيبة ولهذه المنعة والمقاومة عند شعب الهونزا، يعود إلى نظام تغذيته.
إنَّ شعب (الهونزا) هو من أرباب البستنة، وزارعي خضار مشهورين، وهم يفضلون أن يرتجفوا من البرد، وأن يكتفوا بإشعال نار ضعيفة من بعض أغصان شجرة السندر الصغيرة الحجم، ومن الدغال التي تنبت على سفوح الجبال عوض أن يحرقوا السماد ذي القيمة والفائدة.
وهذا الظرف بالذات يجعلهم يتجنبون استخدام النار في إعداد ألوان طعامهم. وهكذا، فإنَّ غذاءهم الرئيسي يتألف من ثمار نية، ومن خضار، ومن ثمار عنبية تكون طازجة في الصيف، ومجففة في الشَّمس شتاء.
وهذه الحالة بالذات هي التي جعلت الدكتور «مكاريزون» يستنتج ويقرر بأن عامل الصحة لهذا الشعب يقوم في وفرة إفراطهم بتناول المواد الغذائية النيئة. ونادراً ما يستخدمون المنتوجات المستخلصة من الحليب كالجبن والزبدة وأندر من ذلك أكلهم للّحم.
وكان الدكتور «مكاريزون» يعتبر أنَّ هنالك عوامل أخرى تسهم في هذه الصحة المزدهرة لشعب الهونزا، ولكنَّه كان يقدّر أنَّ السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تغذيتهم بالمواد الغذائية النيئة.
وكان يلاحظ أيضاً أثر المنع الدِّيني لاستخدام المشروبات الكحولية. وبالرغم من أنَّ شعب الهونزا، لا يراعي تماماً وبدقة كبيرة التوصيات الدينيَّة، إلا أنَّهم من الممتنعين كلياً عن شرب الكحول.
وكان الدكتور مكاريزون» يعتبر أنَّ من بين العوامل الثانوية لازدهار صحة شعب الهونزا استمرار رضاعة الطفل من أمه لمدة طويلة: الصبيان لمدة ثلاث سنوات والبنات لمدة سنتين، الأمر الذي كان يسهم أيضاً في تمتعهم بصحة جيدة.
وكذلك فإنَّ القيام المستمر بالأعمال المنزلية، وتوغل الجبال والسير فيها، ساهمت في نموهم الجسدي. ويستطيع الشيوخ منهم، الذين بلغوا سن المائة وعشر سنوات إلى المائة وخمس وعشرين سنة، أن يقوموا برحلات ونزهات لمسافة عشرة كيلومترات عبر الجبال وبين الانهيارات المتراكمة وطرق الماعز.
إن أخلاق (الهونزا) تتميّز بدرجة رفيعة من السمو، ويمكن مقابلتها مع أفضل الأمثال قدوة في العالم. ولا يوجد عندهم تقريباً أية علاقات متهتكة بين الرجال والنساء. وقد لوحظ بكل تأكيد أنَّهم أطهار في أفكارهم وفي حياتهم، وفق ما أورده جون توبي في كتابه: (شعب الهونزا، رحلة إلى بلاد الفردوس).
وفي كتابه عن الهونزا، يذكر الدكتور برتشر رأي السيدة لوريمر، وهي تتحدث عن المميزات الجوهرية لأخلاق شعب الهونزا. فهم فرحون جداً، يحبّون الحياة يكرمون بعضهم بعضاً في علاقاتهم بين بعضهم وبين الغرباء وهم مضيافون ذوو لطف وعطف، صبورون متنبهون لمعاونة الشيوخ والأطفال ويحبونهم.
وهم على استعداد لأن يساعدوا الجميع وفي كل شيء. ويعتنون أيضاً بالحيوانات الداجنة ويعطفون عليها. ويشتغلون بحماس كبير وجد ومهارة، ويُظهرون في جميع مناسبات حياتهم فهماً وذكاءً نادراً. وفيض طاقتهم الحيّة يتجلى في انعدام شعورهم بالتعب وفي حبهم للعمل. وكُلَّما كان العمل صعباً، كُلَّما تعلّقوا به.
وكل ما كُتب ورُوي عن تحمُّس سكان بلاد الهونزا لأعمالهم، يتوافق مع أقوال الكاتب الروسي ليون تولستوي الذي يؤكد أنَّ السعادة الحقيقية يجدها الإنسان في العمل.
ويمكن القول عن شعب الهونزا أنَّهم يعملون وكأنَّهم يلعبون وكأنهم يعملون.
وهذه الأقوال الأخيرة تنطبق أيضاً على أولاد هذا الشعب.
وفي هذا المجال، فإنَّ تربية الأولاد عند شعب الهونزا ممتازة جداً، وتحصل، إذا صح القول، بشكل عفوي طبيعي. وعلى الأوروبيين والأميركيين أن يقلدوهم في هذا الحقل.
وفق عبارات السيدة لوريمر التي نقلها إلينا الدكتور برتشر (فإنَّ كل قرية من قرى بلاد (الهونزا) تشعُّ بالهدوء والسلام والسعادة، والاطمئنان إلى العيش، وحَتَّى بالغبطة التي كثيراً ما تظهر بالابتسامة المشرقة على الوجوه.
وجميع الذين راقبوا شعب (الهونزا) مدة معينة من الزمن استطاعوا أن يتبينوا انعدام الحركات العصبية عندهم، وانعدام فوضى الثرثرة والإشارات وعدم الاستقرار والتلوّن).
تدل على
وتلاحظ السيدة لوريمر بعد ذلك (أنَّ جميع المظاهر تدل على أنَّ شعب «الهونزا» يجد الاطمئنان في صراعه الجاهد للتغلب على الصعوبات التي يلاقونها في سعيهم لتوفير العيش الضروري لهم ولحيواناتهم الداجنة، وأنهم لا يتحمّلون فقط بسهولة جميع ألوان الحرمان، بل يحتفظون أيضاً، بالرغم من ذلك، بمزاجهم الفرح، ويظلون على سرورهم، ويحافظون على ارتباطهم بغبطة العيش، الأمر الذي يمكن أن نراه من ابتسامتهم الحليمة واللامبالية في الصور التي تمثلهم في هذه المرحلة من الحياة).
ولهذا السبب فإنَّ رواية المؤرخ بلوتارخوس عن الشعب السعيد الذي يعيش على حدود الهند يمكن أن ننسبها إلى شعب الهونزا.
وفي مجلة «نديليا» السوفياتية نجد في وصف رحلة «بلفاقي» هذا المقطع: (يطلق شعب الهونزا تسمية (ربيع الجوع) على الأشهر الثلاثة التي لا تنتج فيها المزروعات ثماراً). وفي هذا الباب وقع أرباب الرحلة على كشف مستغرب جداً: فطيلة هذه الأشهر الثلاثة لا يتناول شعب الهونزا طعاماً على الأقل وفق ما تعوّدناه نحن.
فمرة واحدة يومياً يتناول أفراد شعب الهونزا قدحاً مليئاً بشراب منعش يحضّرونه من ثمار ومياه الجبل. ولدى تحليل هذا الشراب أمكن تفسير الاستغراب: فلقد كان مزيجاً حقيقياً مجمعاً وحاصراً لجميع المواد الغذائية تقريباً، التي لها أهمية حيوية أكيدة. ويحضّر شعب الهونزا هذا الشراب العجيب باستخدام ثمار المشمش كعنصر أساسي فيه. فإنَّ أشجار المشمش تنحني مثقلة بثمارها منذ نهاية تموز حَتَّى منتصف آب من كل سنة وأفراد شعب الهونزا يعاملون ويحضرون بتقدير كلي جميع هذه الثمار، فهم يأكلون القسم الداخلي الطري للنواة، أو يعصرونه لاستخراج الزيت منه، ويستخدمون الخشب لنارهم، لأنَّ الوادي فقير جداً بالمواد الصالحة للحريق. طلسم حقيقي بالنسبة لهذا الشعب ... فجمال الجسد، والتمتُّع بالصحة الكاملة والقوية حَتَّى آخر العيش، والتحلي بروحية عدل وحلم ورحابة، كلُّ ذلك يعني، بالنسبة لشعب الهونزا، أن نعيش حياة جديرة بأن نحياها على وجه هذه الأرض(2).
ومنهم شعب غواراني:
يتقيد شعب (غواراني)، على غرار الهونزا، بالشروط الصحية: فيحافظ أفراده على نظافة أجسامهم وثيابهم ومنازلهم. لا يشربون إلا الماء القراح، يغتسلون غالباً، ويحبُّون الشَّمس. يعيشون حياة حضرية، ويهتمون بزراعة الحدائق وقد سجلوا نجاحاً ملموساً في هذا المضمار هم معتدلون كثيراً ومقلّون في الطعام. يعيشون بخشونة أهل أسبارطة اليونانية. غذاؤهم الرئيسي الفاكهة، وثمارهم المفضّلة الأناناس، ويستهلكون هذه الفاكهة طوال أيَّام السنة، بالإضافة إلى ثمار أخرى كاملة النضج. ويبدو العسل البري في عداد ألوان الطعام التي تشكل نظامهم الغذائي، إلى جانب الخضار الطازجة الخضراء، والبطاطا المتعددة الأنواع، والكوسى، والجوز الغني بالزيت، والنباتات عند ظهورها، والحبوب النابتة؛ الأمر الذي يجعل طعامهم غنياً بالمواد الزلالية ذات المصدر النباتي المحض، وبوجبات محدودة.
وهم لا يستهلكون الحليب ومشتقاته، ولا يأكلون الطرائد إلا نادراً. وبصورة عامة يؤلّف الطعام النيء أساساً لأكلهم اليومي. فهم لا يستعملون الملح إطلاقاً، اعتقاداً منهم بأنه يقصّر الحياة. فهم مقلُّون في الطعام، هازئون بالألم وبما من شأنه أن يثقل الفكر. يمضغون الطعام بعناية، ويلزمون الصمت التام طوال مدة الجلوس إلى المائدة. تتميز حياتهم اليومية بفرح لا يعرف الهموم. لهم خبرة مدهشة في شؤون النبات ويتمتعون بموهبة نادرة في معالجة الأمراض التي تجتاح السهول الاستوائية المنخفضة، وفي الوقاية من هذه الأمراض(3).
_______________________________
(1) طب المعصومين: ص 42.
(2) نكون أو لا نكون ص 48.
(3) المصدر السابق ص66.



|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
عوائل الشهداء: العتبة العباسية المقدسة سبّاقة في استذكار شهداء العراق عبر فعالياتها وأنشطتها المختلفة
|
|
|