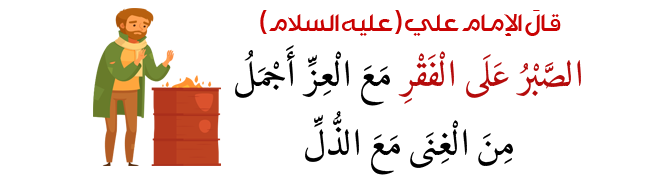
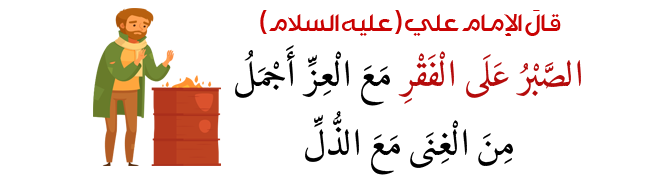

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية| شرح (أَفَتُراكَ سُبحانَكَ... وَتَطَوَّلْتَ في الإنعامِ مُتَكَرِّماً). |
|
|
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-24
التاريخ: 2023-06-21
التاريخ: 2023-07-20
التاريخ: 2023-06-24
|
(أَفَتُراكَ سُبحانَكَ يا إلٰهي وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيها صَوْتَ عَبدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ فِيها بِمُخالَفَتِهِ):
الضميران المؤنّثان راجعان إلىٰ النار.
(سُجن): أي حُبس في السجن، والباء للسببية، أي بسبب مخالفته أوامرك ونواهيك.
والمسلم من أتى بالشهادتين: شهادة التوحيد، وشهادة الرسالة.
(وَذاقَ طَعْمَ عَذِابها بِمَعْصِيَتِهِ، وَحُبِسَ بَيْنَ أطباقِها بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ):
أطباق النار: دركات الجحيم التي بعضها فوق بعض، كما أنّ درجات الجنان بعضها فوق بعض. والجريرة: الخطيئة. والضمائر الثلاثة ترجع إلىٰ العبد.
(وهو يضجُّ) ويفزع.
(إليَكَ ضَجيجَ مُؤَمِّلٍ) وراجٍ.
(لِرَحْمَتِكَ) ورأفتك.
(وَيُنادِيكَ بِلِسانِ أهلِ تَوحِيدِكَ): أي يناديك ويدعوك كما يدعوك الموحّدون الذين لا يرون في مملكة الوجود غيره تعالى ديّاراً، بل يرون في كلّ شيء ذاته وصفاته وأفعاله وشؤونه وآثاره، ولا يدعون لحوائجهم أحداً غير الواحد الأحد الصمد، المقصود في الحاجات وقاضيها...
(وَيَتَوسَّلُ إلَيكَ بِرُبوِبيَّتِك) كما في دعاء عرفة: (بك عرفتك، وأنت دللتني عليك، ولو لا أنت لم أدرِ ما أنت) (1).
ولكنّه ليس المراد هاهنا جعله تعالى وسيلة لمعرفته، بل المراد جعله وسيلة لاستخلاصه من العذاب.
الوسيلة: هي ما يتقرّب بها إلىٰ الشخص، حتّىٰ يعرض عليه حاجته.
(يا مَولايَ، فَكَيفَ يبقى في العَذابِ وهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ) ورأفتك ورحمتك. فالمراد برجاء السائل: ما سلف من حلمه تعالى أنّه في الدنيا كثيراً ما صدر عنه المعصية، وترقّب لذلك غضب الله وسخطه علىٰ نفسه، ولكن تجاوز عنه كثيراً ما: لحلمه ورأفته ورحمته بعباده، وما أخذه بالعقوبة، فاعتاد لذلك بحمله تعالى، ويرجوه عن الله في الآخرة أيضاً.
(أمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ) وتوجعه.
(وَهُوَ يَأمُلُ) ويرجو.
(فَضْلَكَ وَرَحْمَـتِكَ، أمْ كَيفَ يُحِرقُهُ لهيبُها وأنت تَسْمَعُ صَوتَهُ):
لهب النار: اتقادها واشتعالها.
(وترى مَكانَهُ) ومقامه في النار.
المكان: مقولة من المقولات التسع العرضية، وعُرّف بـ «البعد المجرّد» في اصطلاح الإشراقيين (2)، وبـ «تماس باطن الحاوي بظاهر المحوي» في اصطلاح المشّائين(3).
كأنّه يريد السائل: أنّ إبراهيم عليه السلام حين اُلقي في نار نمرود لم يستغث ولم يستصرخ، وما دعا ربّه للنجاة منها، مع أنّ جبرائيل عليهالسلام نزل إليه من ربّه الجليل وقال:) هل لك حاجة؟) قال:) بلى، أمّا إليك فلا) (4) فمع هذا ما آلمته النار وما أحرقته، بل جُعلت النار عليه برداً وسلاماً، فكيف بعبدٍ استغاثك واستصرخ إليك وأنت تسمع صوته، وترى مكانه فيها، وهي تؤلمه ويحرقه لهبها، ولا تنجيه عنها؟ حاشي بكرمك وفضلك.
(أمْ كَيفَ يَشْتَمِلُ عَليهِ زَفِيرُها):
اشتمل عليه: أي أحاط عليه.
الزفير: حسيس النار، وهو في الأصل: أول صوت الحمار، كما أنَّ الشهيق آخره.
شبّه حسيسها المفظع بزفير الحمار الذي هو كذلك.
(وَأَنتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ) وهنه وتوانيه وعدم طاقته، وقلّة بضاعته في مبانيه.
(أمْ كُيفَ يَتَغَلْغَلُ بَينَ أطباقِها):
التغلغل: هو التحرّك مع الاضطراب، إذا قصد الخروج عن تحت شيء لا طاقة له فيه. وطبقات النار: مواقفها ودركاتها.
(وأنت تعلم صدقه):
أي أنت تعلم أنّه في تغلغله وعدم تحمله إيلام وإحراقها صادقٌ لا خادع وماكر.
(أمْ كَيْفَ تَزْجُرهُ زبانِيَتُها وَهُوَ يُنادِيكَ يا رَبَّه):
(تزجره): أي تمنعه عن الخروج منها.
الزبانية: الملائكة الموكّلة عليها، واحدهم «زُبني» مأخوذ من «الزبن» وهو الدفع؛ لأنّهم يدفعون أهل النار إليها.
وفي الصحاح: «الزبانية عند العرب: الشرطة، وسمّي به بعض الملائكة؛ لدفعهم أهل النار إليها» (5).
(أمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ في عِتْقِهِ مِنْها فَتَتْرُكُهُ فِيها):
العتق: التحرير والتخليص عن القيد.
تتركه: أي تَذَرُه فيها.
(هَيْهاتَ، ما هكذا الظَنُّ بِكَ، ولا المَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ):
بل الذي هو معروف من فضلك بين عبادك بعكس ذلك...
(وَلا مُشْبِهٌ لِما عَامَلْتَ بِهِ المُوَحِّدينَ): معطوفة علىٰ ما قبلها، أي ولا هكذا مشبهٌ لمعاملتك مع الموحّدين.
(مِنْ بِرِّكَ وإحِسْانِكَ):
كلمة: (من) بيان لـ(ما).
يريد أنّك تتعامل مع موحّديك بالبرّ والإحسان، لا بالعذاب والإساءة والنيران.
(فَبِاليَقِينِ أقْطَعُ) الفاء للتفريع، والظرف متعلّق بـ(أقطع).
وجملة: (أقطع) تأكيد لما قبلها، أكّده لاقتضاء المقام.
اليقين: هو الاعتقاد الجازم الثابت، ويرادفه القطع.
ثم لمّا كان المقام أن يتوهمّ متوهّمٌ أنّ السائل في تلك الضراعة والابتهال والمسكنة وتوصيف العذاب والنكال، كأنه أساء ظنّه بربه وضعف اعتقاده بفضله وكرمه، فلدفع هذا التوهم أتى بجملة مؤكدة:
(لَوْلا ما حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جاحِدِيكَ):
كلمة: (من) بيان لـ(ما).
الجاحد : المنكر المصرّ في الإنكار ، وحكمه تعالى بتعذيب جاحديه في القرآن المجيد ، حيث قال : {وَلَوْ ترى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فأرجعنا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ * وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}.
(وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إخلادِ مُعانِدِيكَ):
(قضيت): حكمت.
المعاند والعنود والعنيد واحد، وهو: المعارض لك بالخلاف عليك.
والمراد بهم: الذين عارضوا رسول الله صلىاللهعليه وآله، وجادلوه بالباطل والخلاف، ولم يؤمنوا بالله ورسوله، وماتوا علىٰ كفرهم.
الخلود: دوام البقاء، وقضى أيضاً في كتابه الكريم، حيث قال تعالى في جواب إبليس متى قال: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ}.
(لَجَعَلْتَ النارَ كُلَّها بَرْداً وَسَلاماً): جواب (لولا).
البرد: خلاف الحرّ، كما أن الحرارة خلاف البرودة.
سلام: كناية عن الراحة وعدم الآفة والأذى، ومنه سمى الجنة: دار السلام؛ لعدم وجدان الآفة فيها، ونضارة عيش أهلها بالتنعم والالتذاذ.
(وَمَا كانَ لأحَدٍ فِيها مَقَرّاً ولا مُقاماً):
المقرّ والمقام: كلاهما اسم مكاني القرار والقيام.
(ولكنك): استدراك عمّا قبلها.
(تَقَدَّسَتْ أسْماؤُكَ): تنزّهت عن شائبة النقص والعيب.
(أقْسَمْتَ): في كتابك الحميد، حيث قلت مخاطباً لنبيّك: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) أي علىٰ ركبهم وأطراف أصابعهم، لا يستطيعون القيام علىٰ أرجلهم في حول جهنّم.
(أنْ تَمْلأها مِنَ الكافِرِينَ مِنَ الجِنَّةِ والناسِ أجمَعِينَ):
أقسام الكفر:
الكفر ثلاثة أقسام: كفر الجحود، وكفر النفاق، وكفر التهوّد. وفي جميعها بمعنى الستر والإنكار.
ولكن الأول عبارة عن إنكار ضروري من ضروريات الدين، أو إنكار جميعها، فمَن أنكر واحدها أو أنكر الجميع فهو كافر شرعاً بالكفر الجحودين، وليس لدمه وماله وعرضه حرمة ما دام باقياً عليه.
والثاني عبارة عن الإنكار في القلب والإقرار باللسان، خوفاً وطمعاً، كالمنافقين الذين أخبر عنهم قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّـهِ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّـهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً}.
والثالث عبارة عن الإنكار في ظاهر والإقرار في الباطن، كاليهود الذين علموا وأيقنوا أنَّ موسىٰ عليه السلام رسول الله ونبيّه، ولكن أنكروه بأقوالهم، وطلبوا منه المعجزات، ومع إتيانه بها لهم أصرّوا أيضاً في الإنكار القولي، حتىٰ سألوا منه رؤيته تعالى بأبصارهم الحسّية الحيوانية ...
فهذه الأقسام الثلاثة [...] (6) وحكم بها ظاهر الشريعة، وتسمى بالكفر الجلي.
وأمّا الكفر الخفي فأقسامه كثيرة، وفيه ورد أحاديث:
منها: قوله (صلى الله عليه وآله): إنّ دبيب الشرك في اُمّتي أخفى من دبيب النملة السوداء علىٰ الصخرة الصماء ـ أو الملساء ـ في الليلة الظلماء) (7).
ومنها: قوله (عليه السلام): من دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس) (8).
أي لا يزال دهره منغمساً في الضلال والعمى عن الحقّ، وعُدّ الاستبداد بالرأي والجهل والفسوق من أقسام الكفر الخفي.
وبالجملة، كلّ ما ستر الحق ولو لحظة عن فؤاد العباد فهو كفر عند أهل السلوك.
والجِنّة: جمع «جِنّ»، من: جَنَّهُ إذا سَتَرَهُ، ومنه الجنين في الرحم، إذ الجنة والأجنة مستورة عن الحواس. ثم إنَّ من الجن كافر ومنهم مؤمن، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(وأنْ تُخَلِّدَ فِيها المُعانِدِينَ، وَأنْتَ جَلَّ ثناؤُكَ): أي عظم من أن يصفه الواصفون، كما قال الشاعر:
إذا أثنى عليك المرء يوماً *** كفاه من تعرّضه الثناء
معناه: أنّه يكفي من تعرّض للثناء التعرّض فقط، وإلّا لا يمكن لأحد أن يثني لله تعالى حقّ ثناؤه، بل ثناؤه أجلّ من إحصاء البشر، كما قال سيد الكائنات: لا اُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت علىٰ نفسك) (9).
(قُلتَ مُبتَدِئاً): في ابتداء الإسلام وأول الدين، متى نزل الفرقان السماوي...
(وَتَطَوَّلْتَ في الإنعامِ مُتَكَرِّماً): التكرّم: ازدياد الكرم علىٰ البرايا، فهو تعالى متكرّم، أي مضعّف إكرامه وإنعامه علىٰ عباده، ومن فضله وإنعامه أنّه أخبر عباده علىٰ لسان نبيّه وأعلمهم في كتابه الكريم، وقال: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ}: كيف يتساوى الكفر والإيمان، والفسوق والعدالة، والنور والظلمة، والجهل والعلم، والبصارة والعمى، والهداية والغواية؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) «الإقبال» ص 335، من دعاء أبي حمزة الثمالي.
(2) انظر «شرح المقاصد» ج 2، ص 198 ـ 199.
(3) انظر «شرح المقاصد» ج 2، ص 198 ـ 199.
(4) «مجمع البيان» ج 7، ص 75.
(5) «الصحاح» ج 5، ص 2130، مادة "زبن".
(6) كلمة غير مقروءة في المخلوط.
(7) «بحار الأنوار» ج 69، ص 93، باختلاف يسير.
(8) «بحار الأنوار» ج 2، ص 299، ح 24.
(9) «مصباح الشريعة» ص 56.



|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|