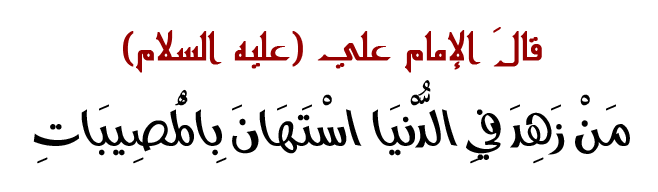
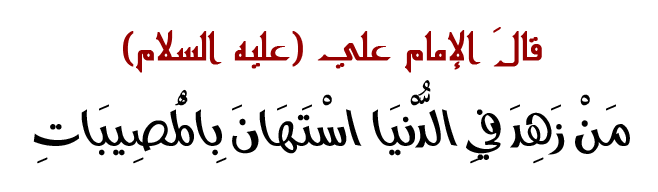

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2016
التاريخ: 3-08-2015
التاريخ: 7-08-2015
التاريخ: 22-11-2016
|
إنّ الإمام يجب أن يكون معصوما كالنبيّ ، كما هو من أصول المذهب خلافا للعامّة.
بيان ذلك : أنّ عصمة الإمام لطف أيضا ، بل لا يتحقّق كون إيجاده لطفا
بدونها ؛ لأنّ غير المعصوم لا يؤمن من الحيف والميل الموجبين لوقوع الفتن
والاختلال في أمر الدين والدنيا ، وهذا مناف للّطف.
وأيضا فإنّ الغرض من نصب الإمام حصول الاطمئنان والانقياد ، ولا يحصل ذلك
إلاّ بكونه معصوما ؛ إذ المخطئ أو العاصي لا يجب إطاعته ، بل يجب مخالفته ، مع أنّ
النائب يجب أن يكون مثل المنوب عنه في العصمة عمّا ينافي نصبه ، مضافا إلى أنّ غير
المعصوم عليه السلام تتنفّر طباع ذوي العقول في أمر المعاش والمعاد عنه كما لا
يخفى ، حيث يجوز منه الكذب والخطأ والغفلة ونحوها ، فلا يكون قابلا للرئاسة
العامّة التي يكون المقصود منها إتمام الغرض بالاستعداد للفيض الأبدي ، فيجب كونه
معصوما ؛ لئلاّ يلزم القبح على الله تعالى.
وأيضا فإنّ حفظ الشريعة وبقاءها مع عدم النبوّة ممّا لا بدّ فيه من معصوم
؛ لئلاّ يتحقّق النسيان والإهمال والإخلال والتحريف والتغيير للأغراض الفاسدة التي
تقتضي ارتفاع الشريعة مع أنّها باقية إلى يوم القيامة ، فلا بدّ في كلّ زمان من
معصوم حافظ للشريعة.
وأيضا فإنّ كلّ زمان يتحقّق فيه وقائع خاصّة لا بدّ من استنباطها من
الآيات التي لا يعلم تأويلها إلاّ الله والراسخون في العلم ، ولا بدّ من بيانها
منها أو من غيرها ، ولا يمكن ذلك لغير المعصوم ؛ لاحتمال الخطإ فيه ، وزماننا لا
يخلو عن ردع المعصوم مع أنّ المراد وجوب وجوده حتّى لو احتيج إليه رفع الاحتياج
فيما لولاه لاختلّ أمر الدين ، كما هو حال من يكون في زمان يكون زمان ظهور الإمام
عليه السلام.
فظهر ممّا ذكرنا وجوب كون الإمام عليه السلام معصوما عن الصغائر والكبائر
عمدا وسهوا بل عن الأخلاق الذميمة والعيوب والأمراض المزمنة ، وغير ذلك ممّا يوجب
تنفّر الطباع المنافي للغرض ممّا ... في النبوّة ، ووجوب اتّصافه بالكمالات والأخلاق
الحميدة وكرامة الآباء والأمّهات وعلوّ النسب وشرافة القبيلة وتفرّده في الكمالات
بل ذلك في الإمام أهمّ ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قد صار سببا لحصول
الكمالات للأمّة ، فصعب عليهم امتثال من ليس بمتفرّد في الكمالات ، بل يستقبح ذلك.
وما ذكرنا وإن لم يكن داخلا في حقيقة العصمة لكنّه يجب تحقّقه ، فلا بدّ
من حمل العصمة على معنى يشمله ، فيقال : إنّه مثل غريزة مانعة عن حدوث الذنب مطلقا
وموجبة للتنزّه عن النقائص مطلقا والاتّصاف بالكمالات كذلك. وهذا المعنى واجب
الحصول ؛ ليحصل التقريب إلى الطاعات والتبعيد عن المعاصي ، وذلك هو اللّطف الواجب
على الله.
وممّا ذكرنا يظهر وجه ما سيأتي من أنّه يجب أن يكون الإمام أفضل من غيره
؛ لئلاّ يلزم تقديم المفضول أو أحد المتساويين الذي هو قبيح ، ولا يلزم الاختلاف
وعدم قبول الطباع ، وأن يكون منصوصا من الله ورسوله ؛ لأنّ عصمته التي لا بدّ منها
أمر مخفيّ يغفل عنه غالبا ؛ للغفلة عن دليله ، فيلزم الضلالة ، فلا بدّ من إظهار
المعجزة أو تنصيص المخبر الصادق من الله ، فحيث انتفى الأوّل وجب الثاني.
والحاصل : أنّ التنصيص لطف في معرفة الإمام ، فهو واجب على الله تعالى ،
ويجب على الرسول تبليغه وإظهاره وإن خفي على بعض ؛ بسبب تقصير الأمّة وعدم إيصال
الشاهد منهم إلى الغائب ، فاندفع ما يقال من أنّه لو ورد نصّ لنقل إلينا ، ولما
تردّد الصحابة ، ولما احتاج تحقّق الخلافة إلى البيعة ؛ إذ الصحابة لم يكونوا
معصومين ، فبعضهم أنكروه لداعية الرئاسة ، وبعضهم أخفوه لتوقّعها له أو لمن ينتفع
به ، أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة الدنيويّة ، مع أنّ الدليل العقلي إذا اقتضى
وجوب التنصيص فنفيه بمثل ذلك الاحتمال ليس إلاّ من فرط التعصّب والعناد ، أو من
نقص الإدراك والاستعداد ، حرسنا الله عنه بالنبيّ وآله الأمجاد.
والحاصل : أنّ الإمام عليه السلام لا بدّ أن يكون بشرا معصوما منصوصا أو
في حكمه ، وأفضل في العلم والعمل ونحوهما ممّا له دخل في الرئاسة العامّة في أمر
الدين وإتمام الحجّة على المكلّفين ردّا على العامّة العمياء ؛ لأنّ ذلك لطف واجب
على الله تعالى.
مضافا إلى النقل كما قال الله تعالى : {لَا يَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]، وقال الله تعالى : {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى}
[يونس: 35].
وقال : {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } [القصص: 68] ، أي
يختار من يشاء للنبوّة ، والإمامة لا تكون إلاّ بالإمام الذي له الرئاسة في أمر
الدين والدنيا لا برأي الناس.
وقال الله تعالى : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
[النحل: 43] ، وقال الله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ
بَعْضٍ} [آل عمران: 33، 34].
وعن سعد بن عبد الله قال : سألت القائم في حجر أبيه فقلت : أخبرني يا
مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم ، قال : « مصلح أو مفسد؟
» قلت : مصلح قال : « هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما
يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد»؟.
قلت : بلى ، قال : « فهي العلّة أيّدتهما لك ببرهان ينقاد له عقلك؟ » ،
قلت : نعم ، فذكر اختيار موسى سبعين رجلا ظنّ أنّهم من الصالحين وقد كانوا من
المنافقين (1).
وعن الصادق عليه السلام أنّه قال : « عرج بالنبيّ صلى الله عليه وآله إلى
السماء مائة وعشرين مرّة ، ما من مرّة إلاّ وقد أوحى الله عزّ وجلّ فيها إلى
النبيّ صلى الله عليه وآله بالولاية لعليّ عليه السلام والأئمّة : أكثر ممّا أوحاه
بالفرائض » (2).
وعنه عليه السلام : « الإمام يعرّف الإمام الذي يكون من بعده » (3). إلى
غير ذلك من الأخبار.
وبالجملة فوجوب عصمة الإمام من قطعيّات مذهب الإماميّة. واحتجّ المصنّف
عليه بوجوه :
منها : ما أشار إليه بقوله : « وامتناع التسلسل يوجب عصمته » ، بمعنى أنّ
الإمام لو لم يكن معصوما يلزم التسلسل ، والتسلسل باطل ، فعدم كون الإمام معصوما
باطل.
وجه اللزوم أنّ المحوج إلى الإمام جواز الخطإ المنافي للغرض على الأمّة
في العلم والعمل ، فلو جاز الخطأ على الإمام أيضا لوجب إمام آخر وهكذا ، فيلزم
التسلسل وهو باطل ... فوجب عصمة الإمام كما هو مذهب الإماميّة والإسماعيليّة،
خلافا لسائر الفرق كالأشاعرة ؛ تمسّكا بمنع كون المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز
الخطإ على الرعيّة ، بل العمدة هو الإجماع ونحوه.
ولا يلزم منه أن يكون معصوما ، وهذا خطأ وشبهة ؛ لعدم الإجماع سيّما من
جهة واحدة ، مع أنّ نحو : {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ}
[الرعد: 7]، و {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ
لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى} [يونس: 35] ، و {لَا يَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]، كالعقل القاطع يقتضي وجوب نصب الإمام الهادي إلى
الأحكام المنزّه عن الظلم والآثام.
ومنها : ما أشار إليه بقوله : « ولأنّه حافظ للشرع » ، بمعنى أنّ الإمام
حافظ للشرع بالتمام ، وكلّ حافظ للشرع بالتمام يجب أن يكون معصوما ، فالإمام يجب
أن يكون معصوما.
أمّا الصغرى فلأنّ الشرع لا بدّ له من حافظ ؛ لئلاّ ينتفي الغرض من
الخلقة ، والحافظ إمّا العقل أو النقل ـ الكتابي والنبويّ ـ أو الإجماع أو السيرة
أو الإمام ، لا سبيل إلى الأوّل ؛ لعدم وفائه في عشر من أعشار الأحكام التفصيليّة
فضلا عن تمامها كما لا يخفى على من راجع وجدانه ، وكذا الكتاب والسنّة النبويّة ...
كما لا يخفى على المتتبّع في الكتاب والسنّة ؛ لأنّ آيات الأحكام ـ مع قلّتها
وتكرّرها ـ كثيرا ما تكون دلالتها على وجه الإجمال ، وكثيرا ما لا يستفاد منها
إلاّ بنزر يسير من الأحكام التفصيليّة وكذا السنّة النبويّة وكذا الإجماع والسيرة
؛ لكثرة الاختلاف سيّما عند أهل المذاهب الأربعة وخصوصا في الفروض الجديدة
والمسائل التي لم يتعرّضها السابقون ...
والرجوع إلى البراءة الأصليّة أو أصل البراءة ينفيه العلم بالاشتغال في
الجملة ، مع أنّه يقتضي عدم وجوب بعثة الأنبياء.
وأمّا القياس فهو ـ مع كونه موجبا للهرج والمرج والاختلال باختلاف أهله ـ
غير كاف في جميع الأحكام ، كما لا يخفى على من كان من ذوي الأفهام ، فتعيّن أن
تعيها أذن واعية ، ويكون من يتلقّى من النبيّ ، ولا تخفى عليه خافية ، ويكون هاديا
للأنام وهو الإمام.
وأمّا الكبرى فلأنّ غير المعصوم يمكن أن يكون مع العصيان أو الخطأ
والنسيان ، وجعله حافظا للشرع مناف للغرض ومستلزم للتعبّد بما يحتمل الخطأ وهو في
نفسه قبيح ، وعند إمكان التعبّد بما لا يحتمل الخطأ ترجيح للمرجوح ، فلا يكون
جائزا إلاّ إذا صار ذلك القبيح بالذات حسنا بالعرض من جهة دفع الأقبح ، كالخروج عن
الشريعة من باب جواز ارتكاب أقلّ القبيحين عقلا ـ كما في أمثال زماننا ـ مضافا إلى
أنّ عدم العصمة توجب النفرة ، وعدم إتمام الحجّة ، والترجيح للمرجوح أو من غير
مرجّح ، والأمر بطاعة من علم خطؤه في قوله تعالى : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].
وممّا ذكرنا يظهر وجه اندفاع ما ذكره الشارح القوشجي بقوله : « وأجيب
بأنّه ليس حافظا بذاته ، بل بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة واجتهاده الصحيح وإن
أخطأ في اجتهاده ، فالمجتهدون يردّون ، والآمرون بالمعروف يصدّون ، وإن لم يفعلوا
أيضا فلا نقص للشريعة القويمة » (4).
وكذا ما ذكره شارح آخر من عدم جواز الخطأ على إجماع الأمّة لقوله صلى
الله عليه وآله : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » (5) ، وقوله صلى الله عليه وآله
: « لا تجتمع أمّتي على الضلالة » (6) ، لعدم الإجماع في نحو المسائل المتجدّدة مع
الخطأ في معنى الرواية ، والعجب كلّ العجب من اهتمام العقلاء سيّما العلماء في
إفساد الدين لإصلاح أمر الظالمين ، ألا لعنة الله على الظالمين.
ومنها : ما أشار بقوله : « ولوجوب الإنكار لو أقدم على المعصية ، فيضادّ
أمر الطاعة ويفوت الغرض عن نصبه » ، بمعنى أنّ الإمام لو لم يجب كونه معصوما لجاز
إقدامه على المعصية ، ولو جاز إقدامه على المعصية لوجب إنكاره ؛ لصريح نحو قوله
تعالى : {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104] ، وهو مضادّ لوجوب
الطاعة الثابت بنحو قوله تعالى : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].
وأيضا ذلك مفوّت للغرض من نصبه ؛ لأنّ الغرض منه امتثال أوامره ،
والانزجار عمّا نهى عنه ، واتّباعه فيما يفعله ، ولا يتحقّق ذلك مع الإنكار.
وأورد عليه بأنّ وجوب الطاعة إنّما هو فيما لا يخالف الشرع ، وأمّا فيما
يخالفه فالردّ والإنكار وإن يتيسّر فسكوت عن الاضطرار.
وفيه أنّه مستلزم للتقييد في الأمر الواحد المطلق المتعلّق بالرسول وأولي
الأمر ؛ حذرا عن لزوم استعمال اللفظ الواحد في المطلق والمقيّد وكون الرسول الذي {وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]، ويكون
شارعا مبيّنا للأحكام فاعلا لما يوجب إنكاره مع اختيار الله القادر المختار
المرجوح وترك الراجح عند الأخيار والأشرار.
ومنها : ما أشار بقوله : « ولانحطاط درجته عن أقلّ العوامّ » ، بمعنى
أنّه لو أقدم على المعصية ، لكان أقلّ درجة من العوام ؛ لأنّه أعقل وأعرف بقبح
المعاصي وحسن الطاعات ، فصدور المعصية منه أقبح منه من العوامّ ، فيلزم من جعله
رئيسا ترجيح المرجوح على الراجح، مضافا إلى حصول النفرة وعدم إتمام الحجّة.
ولمّا اختلف القائلون بالعصمة في أنّ المعصوم هل يتمكّن من فعل المعصية
أم لا؟ فمنهم من زعم أنّه لا يتمكّن منه ، ومنهم من زعم أنّ المعصوم يختصّ في بدنه
أو نفسه بخاصيّة تقتضي امتناع إقدامه على المعصية ، ومنهم من قال : إنّ العصمة هي
القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية ، ومنهم من ذهب إلى تمكّنه منه وكونه
أمرا يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقرّبة إلى الطاعات التي يعلم منها
أنّه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي الأمر إلى الإلجاء ، أو ملكة نفسانيّة
لا تصدر معها عن صاحبها المعاصي ، أو لطفا يفعله الله بصاحبه لا يكون له معه داع
إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية ، بأن يكون لنفسه أو لبدنه خاصيّة تقتضي ملكة
مانعة من الفجور ، أو يكون له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.
واختار المصنّف المذهب الأخير قال : ( ولا تنافي القدرة العصمة ) بل
المعصوم قادر على فعل المعصية ، وإلاّ لما استحقّ المدح على ترك المعصية ، ولا
الثواب ، ولبطل الثواب والعقاب في حقّه ، بل كان خارجا عن التكليف ، وذلك باطل
بالضرورة ، فيجب تعريف العصمة ... بأنّها ملكة نفسانيّة إلهيّة حاصلة من كمال
المعرفة البالغة إلى مرتبة حقّ اليقين وكمال الفطانة الموجبة لإدراك الحسن والقبح
على وجههما ، وتكون مانعة عن صدور العصيان والقبح في حالتي العمد والنسيان في تمام
عمر الإنسان ، بل تكون مانعة عن صدور ما يوجب النفرة وعدم إتمام الحجّة بالنسبة
إلى نبيّنا صلى الله عليه واله والأئمّة :
__________________
(1) « كمال الدين » 2 :
461 و 462 ، ح 21.
(2) « الخصال » 2 : 601
، ح 3.
(3) « الكافي » 1 : 277 ، باب أنّ الإمام يعرّف الإمام ... ح 6.
(4) « شرح تجريد العقائد
» للقوشجي : 367.
(5) « الخصال » : 417 ،
ح 9.
(6) « سنن ابن ماجة » 2 : 1303 ، ح 3950.



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
قدم خدماتها لأكثر من (700) مستفيدة خلال شهر واحد.. مركز تابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية يختتم المبادرة المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
|
|
|