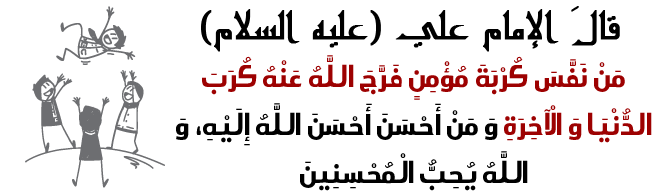
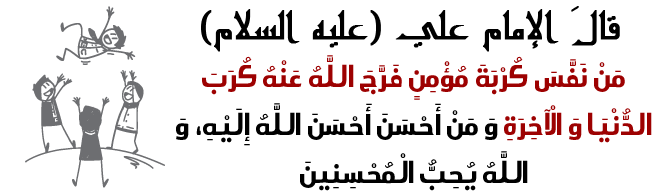

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-22
التاريخ: 27-8-2022
التاريخ: 2023-03-31
التاريخ: 2023-11-21
|
يقسم أحد الباحثين الدلالة السياقية إلى قسمين:[1]
1- الدلالة السياقية اللفظية، 2- الدلالة السياقية الحالية.
1- الدلالة السياقية اللفظية: نسق الكلام إذ ترتبط الكلمات في السياق بعلاقتها بما قبلها وما بعدها من ألفاظ سواء تقدمت أو تأخرت إذ للوحدات الدلالية المجاورة أثرٌ في تحديد المعنى[2]، وقد عرف القدماء أثر السياق في المعنى فالشريف المرتضى يصرح: (اللفظ إذا تعقبت حاله ترى أن أكثر الكلام مركب مما إذا فصلنا بعضه عن بعض أفاد ما لا يفيده المركب)[3].
وكذلك يقول ابن قيم الجوزية في أهمية السياق وضرب مثلاً {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريم}([4]) كيف نجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير)[5].
ويعطي الزركشي دوراً مهماً لدلالة السياق (فإنها ترشد إلى تبين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم)[6].
وعلى هذا فإن دلالة السياق تخلص اللفظة من اشتراك الدلالات. ولعل هذا ما قام به د. محمود البستاني في تجربته مع منهجه البنائي في التفسير [7].
ونلحظ هذه السياقات في القرآن الكريم بشكل واضح في كثير من سوره ولعل هذا ما أشار إليه الإمام الباقر (عليه السلام): (يا جابر إن للآية ظهراً وللظهر ظهراً، ولها بطن وللبطن بطناً، يا جابر إن الآية ليكون أولها في شيء، وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه)[8].
يقصد ان الآية في وحداتها السياقية الصغيرة تعطي عدة مفاهيم متنوعة ومتخالفة يربطها السياق الأكبر إذ يقوم بتصريف السياقات الصغيرة لصالحه في وجهٍ واحد.
ويرى أحد الباحثين أن السياق اللفظي يمكن أن تلحظ فيه عدة لحاظات إذ يقسمه إلى (السياق الأضيق والأوسط والأشمل)[9]:
وفي ظني أنه يقصد أن النص الأدبي المترابط والمسبوك يمكن ملاحظته بثلاث حيثيات فعلى مستوى المفردة يمكن ملاحظة سياق المفردة في الجملة الصغيرة، وعلى مستوى طول الجملة أو الكتلة المعنوية المكونة من أكثر من جملة يمكن ملاحظة السياق التركيبي لها لتنتج الدلالة المتكاملة، وهذا هو السياق الأوسط، ومراده بالأشمل الدلالة الكلية للنص من مبتدأه إلى منتهاه، وبذلك تتكامل صورة النص دلالياً. وعند ملاحظة السياقات الصغيرة (الضيقة) نجد أنها وحدات دلالية صغيرة يمكن أن تكون متنافرة للوهلة الأولى إلا إنها في السياق الأكبر أو (الأوسط) يمكن ملاحظة الوجه الجامع بين هذه المتخالفات وصولاً إلى السياق الأكبر الذي ينظم تلك السياقات في سلكه كنظام المسجة ليخلص إلى المعنى الكلي وهذا في الأصل ما كانوا يسمونه بعلم المناسبة إذا أجهد المفسرون أنفسهم على ربط الآية بما قبلها وما بعدها، والكتلة المعنوية ذات الموضوع الواحد في ثنايا السورة الواحدة بما قبلها وما بعدها، والسورة القرآنية كاملة بما قبلها وما بعدها وصولاً إلى تعيين المقاصد الموضوعية للنص كله تجد هذا واضحاً في تفاسير المجمع والكشاف ومفاتيح الغيب... الخ.
2- الدلالة السياقية الحالية: ويراد بها الأحوال والظروف والملابسات التي تصاحب صدور النص وتحيط به)[10] كأسباب النزول مثلاً وبيئة النزول (المكي والمدني) وظروف الصدور مثل ظروف صدور الرواية التي تحدد ما إذا كان العمل بها مطلقاً أو ظرفياً فإن المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام فثمة عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى، بل هي جزء من أجزاء معنى الكلام من ملابسات وظروف ذات صلة)[11]. ويسميه بعضهم السياق المقامي[12] ولعلنا نطرح سؤالاً يتبادر إلى الأذهان، هل هناك تضارب بين الدلالة اللفظية والدلالة الحالية؟
ويمكن الإجابة على هذا التساؤل، بأن بين السياق اللفظي والسياق الحالي نوع من التخصيص، والتعميم فإن السياق الحالي يقوم بمهمة التخصيص للمراد اللفظي للنص بلحاظ ظرفه وملابساته إذا كان السياق اللفظي يختزن بعداً دلالياً شاملاً مفاده تعميم المعنى لكل المصاديق المشابه وإذا أخذنا بنظر الاعتبار (السياق الحالي) فإن هذا ما يبرر لنا دخول (أسباب النزول) في التفسير الموضوعي بشرط أن يكون له صلة بموضوع البحث لا أن يكون وارداً كرواية من روايات تفسير هذه الآية. فتكون نسبة مشاركة هذا العلم في التفسير الموضوعي كضيف شرف لا كما أثبته بعض من عرف التفسير الموضوعي كركن منه.
وهناك تقسيم آخر ممكن أن يلحظ للسياق.
(هو السياق المكاني والسياق التناظري):
ونقصد بالسياق المكاني أو (المحلي): بأنه ذلك السياق الواحد المترابط في مكان واحد حيث تؤول إشاراته اللغوية إلى معنى تفسيري معين لا يحتاج فيه إلى سياقات أخرى لتغيره.
بينما السياق التناظري: حيث نتتبع النظائر في سياقاتها ثم نجمعها على أساس التماثل والتناظر ونقارن بينها لتفسر لنا الاشتراك في هذه النظائر. والى هذا أشار الدكتور عبد الأمير زاهد بقوله: (والسياق – عندي – متصل ومنفصل).
فالمتصل: ما سبق الآية وما أعقبها من نص، وما داخلها من وجهة.
والمنفصل: الآيات التي تناولت المضمون ذاته وإن وردت في موضع آخر فبالجمع بينها وبين الآية محل البحث تتضح علاقة العموم بالمخصصات، والإطلاق بالمقيدات، والإجمال بالمفصل، والغامض بالمفسر والمحكم بالمتشابه... الخ) ولعل هذا هو الأصل فيما أطلق عليه العلماء سابقاً بتفسير القرآن بالقرآن)[13] وبعضهم يسميه السياق النصي وعنه يقول اللسانيون: إن المعنى في النص خاضع لعملية التركيب سواء على مستوى الجملة أو مستويات الخطاب، وبموجب هذا يكون فهم اللاحق مستنداً إلى فهم السابق[14].
ويشخص بعضهم نوع آخر من السياق وهو (السياق الثقافي) ومفاد هذا الاصطلاح أن تأويل النصوص لا يتم إلا بجعلها تتسق مع سياق ثقافي محدد، فعلى المؤول أن يراعي الخصوصية الثقافية للنص وصاحبه)[15]. وعلى هذا فلابد إذن من الرجوع إلى الفهم الشرعي للنص القرآني والالتزام بالمصطلحات القرآنية، والارتباط بالثقافة الإسلامية.
وبعد هذه الجولة السريعة في بيان أنواع السياق يلح على الاذهان سؤال مهم وهو كيف نصل إلى السياقات المتناظرة؟
فلابد من استثمار منطق الاستقراء لكي تتكامل ثنائية (السياق والاستقراء).
[1] د. حامد كاظم عباس، الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى ص160 – 170.
[2] ظ، ن. م، ص161.
[3] الذريعة إلى أصول الشريعة: 1 / 240.
[4] الدخان / 49.
[5] ابن قيم الجوزية، روائع الفوائد: 4 / 9 – 11.
[6] الزركشي، البرهان في علوم القرآن: 2 / 200.
[7] د. محمود البستاني، المنهج البنائي في تفسير القرآن، مجلة قضايا إسلامية / العدد الثاني 1995 – ص15.
[8] تفسير العياشي: 1 / ص22.
[9] د. عبد الأمير زاهد، مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني، مجلة السدير، العدد 9 السنة الثانية سنة 2005 ص48.
[10] د. حامد كاظم عباس، الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى ص170.
[11] د. محمود السعران، علم اللغة ص288.
[12] د. محمد المتقن، في مفهومي القراءة والتأويل، العدد / 2 المجلد 33 أكتوبر – ديسمبر 2004م ص37.
[13] د. عبد الأمير زاهد، مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني، مجلة السدير العدد 9 / السنة الثانية ص54.
[14] د. محمد المتقن، مفهوم القراءة والتأويل عدد / 2 مجلد 33 2004 م ص37
[15] ن. م

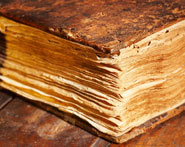
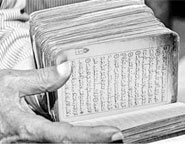
|
|
|
|
أمراض منتصف العمر.. "أعراض خطيرة" سببها نقص المغنيسيوم
|
|
|
|
|
|
|
لماذا تتناقص أعداد النحل عالميا؟
|
|
|
|
|
|
|
ممثل المرجعية العليا: العتبة الحسينية تخطط لإنشاء مراكز متخصصة للكشف المبكر عن (سرطان الثدي) بعموم العراق
|
|
|