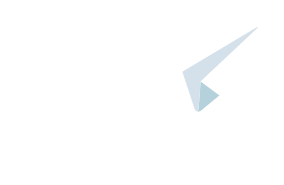تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
المستوى الوجودي في نظرية مراتب الفهم في القرآن
المؤلف:
جواد علي كسار
المصدر:
فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة السلوكية
الجزء والصفحة:
ص 239- 261 .
22-12-2014
7323
1- المستوى الوجودي
يمكن القول إنّ الاتجاه العرفاني عامّة
يعضده فريق من الحكماء جمعوا بين الكشف والبرهان ، هم طليعة من يتبنّى النظرية
الوجودية كإطار تفسيري لتفاوت درجات فهم القرآن واختلاف مراتب معانيه.
على هذا سيتمّ بيان مرتكزات النظرية من خلال
علمين اثنين ، هما ابن عربي (ت : 638 هـ) وصدر الدين الشيرازي (ت : 1050 هـ). وأهمّية
ابن عربي أنّه يمثّل رأس المدرسة ورائد هذا الاتجاه بلا منازع ، فضلا عن أنّه نظّر
لمرتكزات النظرية على نحو واف.
أمّا أهمّية صدر الدين فتعود إلى أنّه
امتداد تجديدي لابن عربي في إيران ، ليس على صعيد نظرية التفسير الوجودي لمراتب
الفهم القرآني وحسب ، بل على مستوى العناصر الأساسية في مدرسة الحكمة المتعالية
برمّتها ، من دون إهمال المائز الدقيق القائم بين العرفان وبين الحكمة المتعالية
كاتجاه فلسفي محاذ للعرفان.
والإمام الخميني ينتمي منهجيا إلى هذا
الاتجاه الذي يبرز فيه هذان العلمان ، وما يتبنّاه من مقولات على مستوى القرآن
الكريم يرجع إلى هذه المدرسة. تشهد على ذلك نصوص الإمام وتراثه القرآني وهي لا
تخفي انتماءها إلى هذين العلمين وولاءها لهما ، فضلا عن اقتباساته النصوصية
العريضة من آثارهما ومتابعتهما في الأفكار ، كما يبرز ذلك جليّا في مؤلفاته
المعنوية والعرفانية (1). إلى هذا المعنى أشارت الدكتورة فاطمة
طباطبائي ، بقولها : «لا يمكن معرفة عرفان الإمام الخميني بدون معرفة المبادئ والاصول
والجذور الأساسية لأدبياتنا العرفانية القديمة ... وإنّ الشخصية التي أن تعرّفنا
بعمق نظريات الإمام وسعتها على مستوى أقدم لحظات التاريخ العرفاني وأكثرها توغّلا
، هي شخصية الشيخ محيي الدين بن عربي» (2).
أولا : ابن عربي (560- 638 هـ)
أ- مرتكزات النظرية :
تنطلق نظرية ابن عربي من التماثل أو التناظر
الذي يقيمه بين الوجود والإنسان والقرآن. فللوجود مراتب ثمّ ما يوازيها في الإنسان
، فالإنسان جامع لحقائق الكون وهو عالم صغير مثلما أنّ الكون إنسان كبير. وللوجود
ظاهر وباطن وحدّ ومطّلع أو عوالم أربعة هي عالم الملك والشهادة ، وعالم الغيب والملكوت
، وعالم البرزخ وعالم الأسماء الإلهية ، تماما كما للإنسان وللقرآن.
العالم والإنسان كلاهما مظاهر كلمات اللّه ،
والإنسان الكامل أتمّها حيث اجتمعت فيه كلّ حقائق الوجود ، وهو الكلمة الجامعة ، والقرآن
كلمات اللّه الذي نزل على الإنسان الكامل الذي يمثّل الذروة في الفهم ، ثمّ يأتي
من يليه يأخذ منه بحسب مرتبته واستعداده الوجودي.
هذه الموازاة أو التناظر الكائن بين الوجود
والإنسان ، قائم بنفسه بين القرآن والوجود. فالعالم عند ابن عربي مصحف كبير تلاه
اللّه علينا تلاوة حال ، تماما كما أنّ القرآن عالم مطوي تلاه الحقّ علينا تلاوة
قول. وبتعبيره : «خذ الوجود كله على أنّه كتاب مسطور ، وإن قلت مرقوم فهو أبلغ» (3).
من خلال هذا التوازي الوجودي سيكون هناك
تناظر بين مراتب الإنسان ومراتب القرآن ، ينجم عنه تعدّد مراتب الفهم وترتب بعضها
على بعض.
يكتب في أصل التناظر الوجودي بين الوجود
بعوالمه العلوية والسفلية وبين الإنسان ، ما نصّه : «و معرفة أفلاك العالم الأكبر
والأصغر الذي هو الإنسان؛ فأعني به عوالم كلياته وأجناسه ، وأمراؤه الذين لهم
التأثير في غيرهم ، وجعلتها [أي أفلاك العالم الأكبر والأصغر] مقابلة ؛ هذا نسخة
من هذا» (4). ثمّ ينعطف لإعطاء أمثلة تفصيلية من
العوالم الوجودية العليا والسفلى وأفلاكها وما يناظرها من الإنسان.
يعدّ الإنسان في هذا النسق عالم صغير والعالم
إنسان كبير ، والإنسان عالم مجتمع الأجزاء والعالم إنسان متفرّق الأجزاء : «و
الإنسان الذي هو آدم عبارة عن مجموع العالم ، فإنّه الإنسان الصغير وهو المختصر من
العالم الكبير ... كذلك الإنسان وإن صغر جرمه عن جرم العالم فإنّه يجمع جميع حقائق
العالم الكبير ، ولهذا يسمّي العقلاء العالم إنسانا كبير». على ضوء هذا التناظر
الوجودي بين الإنسان والعالم ، وكون الوجود مظاهر للأسماء الإلهية ، انتهى إلى
أنّه ما من معنى أو حقيقة ظهرت في الوجود إلّا وظهرت في نظيره الذي هو الإنسان :
«لم يبق في الإمكان معنى إلّا وقد ظهر في العالم ، فقد ظهر في مختصره» (5) الذي هو الإنسان ، إذ ما من حقيقة من حقائق الوجود إلّا وتوجد فيه ، أو
في مثاله الأعلى الذي هو الإنسان الكامل.
يجد هذا الفهم الذي يقيم موازاة وجودية بين
القرآن والإنسان والوجود نصوصا مكثّفة دالّة عليه في تراث ابن عربي ، مبثوثة في
فتوحاته المكّية وغير واحد من مصنّفاته. يصف عالم الإمكان وأنّه وما فيه تعبير عن
كلمات اللّه الوجودية ، بما نصه : «اعلم أنّ الممكنات هي كلمات اللّه التي لا تنفد
، وبها يظهر سلطانها الذي لا يبعد ، وهي مركّبات لأنّها أتت للإفادة فصدرت عن
تركيب يعبّر عنه في اللسان العربي بلفظة «كن» فلا يتكوّن عنه إلّا مركّب من روح وصورة
، ثمّ تلتحم بعضها ببعض لما بينهما من المناسبات ، فتحدث المعاني بحدوث تأليفها
الوضعي». يواصل النصّ وصف الموازاة الوجودية ليفصح في الثنايا عن المعطى المعرفي
له ، متمثّلا بتعدّد مراتب الفهم بتعدّد المراتب الوجودية ، وتعدّد ظهور الحقائق
تبعا لذلك ، فيقول : «ثمّ اعلم أنّ اللّه تعالى لما أظهر من كلماته ما أظهر قدّر
لهم من المراتب ما قدّر ، فمنهم الأرواح النورية والنارية والترابية ، وهم على
مراتب مختلفة ، وكلّهم أوقفهم مع نفوسهم وأشهدهم إيّاها واحتجب لهم فيها ، ثمّ طلب
منهم أن يطلبوه ونصب لهم معارج يعرجون عليها في طلبها إيّاه ، فدخل لهم بهذه
المعارج في حكم الحدّ وجعل لهم قلوبا يعقلون بها ، ولبعضهم فكرا يتفكّرون به ...
ثمّ نصب لهم الدلالة على صدق خبره إذا أخبرهم ، فتفاضلت أفهامهم لتفاضل حقائقهم في
نشأتهم» (6).
ما دام الإنسان عند ابن عربي جامعا لحقائق
الكون كله ، والقرآن هو عالم مطو مثلما أنّ العالم هو مصحف كبير ، فسيكون للإنسان
مراتب مختلفة في فهم القرآن تبعا لمراتبه الوجودية التي تناظر المراتب الوجودية
لظهور حقائق القرآن ، على أن يكون للإنسان الكامل أو للحقيقة المحمّدية الذروة في
سلّم المراتب ، وهذا ما أشار إليه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بقوله :
«اوتيت جوامع الكلم» (7). إذا شئنا الدقّة فإنّ النبي صلّى اللّه
عليه وآله وسلّم عاش حقيقة القرآن مشاهدة ومعاينة ، بل لا حقيقة للقرآن إلّا حقيقة
النبي ، ولا حقيقة للنبي إلّا حقيقة القرآن ، وكلاهما مظهر لأسماء اللّه. على هذا
«فمن أراد أن يرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ممّن لم يدركه من أمّته
فلينظر إلى القرآن ، فإذا نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه وبين النظر إلى رسول
اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فكأنّ القرآن انتشأ صورة جسدية يقال لها محمّد
بن عبد اللّه بن عبد المطلب ، والقرآن كلام اللّه ، وهو صفته ، فكأنّ محمّد صفة
الحقّ تعالى بجملته» (8).
يترتب على هذه الموازاة الوجودية بين القرآن
والإنسان نتيجة معرفية تتمثّل في أن تكون أقصى درجات المعرفة هي تلك الموجودة عند
الإنسان الكامل أو عند النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ لأنّه عاش حقيقة القرآن
على سبيل المشاهدة والتعيّن ، حتّى صار النبي هو القرآن والقرآن هو النبي. ثمّ
يليه من يليه من أمّته على قدر سعته الوجوديّة والإدراكية ، إذ يستلهم كلّ إنسان
من القرآن ويكون له نصيبه من حقائقه «على قدر نفوذه وفهمه ، وقوّة عزمه وهمه ، واتساع
نفسه» (9).
ثمّ نصوص مكثّفة لابن عربي تبيّن أنّ النبي
يمثّل الحد الأقصى من معرفة القرآن وفهمه ، ثمّ تتوالى المراتب وتتسع من دونه
لتشمل أفراد أمته ، وذلك على خلفية قاعدة التوازي الثلاثي بين القرآن والإنسان والوجود
، منها النصّ الذي سنأتي عليه بعد قليل والذي يستخدم تعبيرا رائعا في وصف العلاقة
بين الإنسان والقرآن ، حينما يصفه بوصف النزول. أجل ، فالقرآن على ضوء هذا الفهم
الوجودي ، كما نزل على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو في عملية نزول مطّردة
على قلوب أمّته إلى يوم القيامة. يكتب : «فقوله : {الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ} [الرحمن : 1 ، 2] . نصب
القرآن. ثمّ قال : {خَلَقَ الْإِنْسَانَ(3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 3 ، 4] . فينزل عليه
القرآن ليترجم منه بما علّمه الحقّ من البيان الذي لم يقبله إلّا هذا الإنسان ، فكان
للقرآن علم التمييز فعلم أين محلّه الذي ينزل عليه من العالم ، فنزل على قلب محمد
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نزل به الروح الأمين ، ثمّ لا يزال ينزل على قلوب
أمّته إلى يوم القيامة. فنزوله في القلوب جديد لا يبلى فهو الوحي الدائم ، فللرسول-
صلوات اللّه عليه وسلامه- الأوّلية في ذلك والتبليغ إلى الأسماع من البشر والابتداء
من البشر ، فصار القرآن برزخا بين الحقّ والإنسان وظهر في قلبه على صورة لم يظهر
بها في لسانه ، فإنّ اللّه جعل لكلّ موطن حكما لا يكون لغيره فتلاه رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بلسانه أصواتا وحروفا سمعها الأعرابي بسمع أذنه في حال
ترجمته ، فالكلام للّه بلا شكّ والترجمة للمتكلّم به كان من كان ، فلا يزال كلام
اللّه من حين نزوله يتلى حروفا وأصواتا إلى أن يرفع من الصدور ويمحى من المصاحف ، فلا
يبقى مترجم يقبل نزول القرآن عليه» (10).
الارتقاء في الفهم على ضوء هذه الرؤية
الوجودية لا يتمّ على أساس آليات الإدراك وما يشهده العلم من نموّ نتيجة ذلك ، بل
هو رهين تنقية الداخل وتزكية القلب وتوسيع قدرة التلقّي من خلال التقوى وزيادة
التهيّؤ والنظافة الداخلية. بين أيدينا نص يفتتحه ابن عربي بالإشارة إلى أنّ النبي
بوصفه الإنسان الكامل لديه حقيقة القرآن ، ثمّ يغترف من القرآن كلّ بحسب استعداده
ومقدار تزكيته وتقواه ، أو بحسب تعبيره : «ولنا منه من الحظّ على قدر صفاء المحل
والتهيّؤ والتقوى» (11).
ب- النتائج المترتبة :
في ظلّ هذا التوازي الوجودي بين الإنسان والقرآن
والعالم تصير تلاوة الإنسان للقرآن استماعا لكلمات الوجود من الخارج واستماعا
لكلمات نفسه من الداخل ، فكلاهما جانبان يكشفان عن حقيقة واحدة هي كلام اللّه (12). ويكون القرآن موازيا لحقيقة الوجود ومراتبه
، كما هو مواز لحقيقة الإنسان ومراتبه ، بحيث تناظر كلّ مرتبة عند الإنسان مرتبة
تماثلها في القرآن ، لتتعدّد بذلك التلاوات وتبعا لها المعاني ومراتب الفهم. على
هذا هناك تلاوة وجودية وفهم وجودي للقرآن المبثوث في العالم (المصحف الوجودي
الكبير) كما الكائن في الوجود الإنساني ، يتفاوت فيه نصيب الإنسان بحسب حظّه واستعداده
الوجودي للتلقّي : «و لا تظن يا بني أنّ
تلاوة الحقّ عليك وعلى أبناء جنسك من هذا
القرآن العزيز خاصة. ليس هذا حظ الصوفي ، بل الوجود بأسره {وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} [الطور: 2 ، 3] تلاه عليك
سبحانه وتعالى لتعقل عنه إن كنت عالما. قال تعالى : {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43] ، ولا يحجب عن ملاحظة المختصر الشريف من هذا
المسطور الذي هو عبارة عنك ، فإنّ الحقّ تعالى تارة يتلو عليك من الكتاب العظيم
الخارج ، وتارة يتلو عليك من نفسك فاستمع وتأهّب لخطاب مولاك إليك في أي مقام كنت
، وتحفّظ من الوقر والصمم ، فالصمم آفة تمنعك من إدراك تلاوة الحقّ عليك من نفسك
المختصرة ، وهو الكتاب المعبّر عنه بالفرقان ، إذ الإنسان محلّ الجمع لما تفرق في
العالم الكبير» (13).
حين نعطف على هذه الرؤية الحقيقة التي يسجّل
فيها ابن عربي أنّ ما من شيء في الوجود إلّا وله ظاهر وباطن وحدّ ومطلع بما في
ذلك القرآن والإنسان ، فستكون الحصيلة الأولية أنّ هناك أربع مراتب رئيسية للفهم
منبثقة عن الكينونة الوجودية ذاتها ، يمكن لكلّ مرتبة فيها أن تتضمّن عددا آخر من
المراتب الفرعية.
يكتب ابن عربي : «ما من شيء إلّا وله ظاهر
وباطن وحدّ ومطّلع ، فالظاهر منه ما أعطتك صورته ، والباطن ما أعطاك ما يمسك عليه
الصورة ، والحدّ ما يميّزه عن غيره والمطّلع منه ما يعطيك الوصول إليه» (14).
مع أنّ الكلام هنا يدور حول واقع وجودي
حقيقي لا اعتباري ، إلّا أنّ ابن عربي لا يهمل المدلولات أو الثمار المعرفية لهذه
الكينونات الوجودية. فما دام لكلّ شيء ظاهر وباطن وحدّ ومطّلع ينطبق ذلك على
العالم وعلى القرآن ، فإنّ التقسيم بذاته ينطبق على الإنسان. فالرجال أربعة أصناف
تأتي متوازية مع مراتب الوجود والنصّ ، والمهمّ هي الدلالة المعرفية المترتبة على
هذا التقسيم الوجودي للإنسان ، التي تنتج أربعة مستويات لإدراك القرآن وفهمه داخل
كلّ مرتبة درجات. يكتب في تصوير هذه الرؤية الوجودية للإنسان التي ينبثق عنها
مدلول معرفي ، ما نصه :
«اعلم أنّ رجال اللّه على أربع مراتب ، رجال
لهم الظاهر ، ورجال لهم الباطن ، ورجال لهم الحدّ ورجال لهم المطّلع. فإنّ اللّه
سبحانه لما أغلق دون الخلق باب النبوّة والرسالة أبقى لهم باب الفهم عن اللّه فيما
أوحى به إلى نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كتابه العزيز ، وكان علي بن أبي
طالب رضي اللّه عنه يقول : إنّ الوحي قد انقطع بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
وسلّم ، وما بقي بأيدينا إلّا أن يرزق اللّه عبدا فهما في هذا القرآن. وقد أجمع
أصحابنا أهل الكشف على صحة خبر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال في
آي القرآن : إنّه ما من آية إلّا ولها ظاهر وباطن وحدّ ومطّلع ، ولكلّ مرتبة من
هذه المراتب رجال» (15).
يجمع النصّ إلى هنا بين المدلولين الوجودي والمعرفي
، أو أنّه على نحو أدقّ يؤسس للمدلول المعرفي الذي يفيد تفاوت درجات فهم القرآن وتوزّعها
في مراتب ، على كينونة وجودية مكينة. وهذا يكفينا لإثبات المطلوب ، لكن من المهم
استكمال الصورة بإبراز الأثر الوجودي المترتب على كلّ مرتبة من هذه المراتب في
التعامل مع القرآن ، وما تهبه لأهلها من قدرات وجودية مضافا إلى الحصيلة المعرفية
التي نحن بصددها.
يواصل ابن عربي جوانب الصورة حاكيا كلام
شيخه أبي محمد عبد اللّه الشكّاز الذي التقى به في غرناطة سنة 595 هـ : «الرجال
أربعة؛ رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه وهم رجال الظاهر ، ورجال لا تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر اللّه وهم رجال الباطن جلساء الحقّ تعالى ولهم المشورة ، ورجال
الأعراف وهم رجال الحدّ ، قال اللّه تعالى : {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ} [الأعراف : 46] أهل الشمّ والتمييز
والسراح عن الأوصاف فلا صفة لهم ... ورجال دعاهم الحقّ إليه يأتونه رجالا لسرعة
الإجابة لا يركبون {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج : 27] وهم رجال المطّلع.
فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرّف في عالم الملك والشهادة ... وأمّا رجال الباطن
فهم الذين لهم التصرّف في عالم الغيب والملكوت ... فيفتح لهؤلاء الرجال في باطن
الكتب المنزلة والصحف المطهّرة ، وكلام العالم كله ونظم الحروف والأسماء من جهة
معانيها ما لا يكون لغيرهم اختصاصا إلهيا ، وأمّا رجال الحدّ فهم الذين لهم
التصرّف في عالم الأرواح النارية عالم البرزخ والجبروت ... وأمّا رجال المطّلع فهم
الذين لهم التصرّف في الأسماء الإلهية فيستنزلون بها منها ما شاء اللّه ، وهذا ليس
لغيرهم ، ويستنزلون بها كلّ ما هو تحت تصريف الرجال الثلاثة رجال الحدّ والباطن والظاهر
، وهم أعظم الرجال» (16).
من الواضح أنّ النص يتحدّث عن مراتب وجودية
، أي عن حقيقة في مقابل حقيقة ، وليس عن فهم أو إدراك أو معرفة نظرية بإزاء حقيقة
وجودية ، وما ينسبه لهؤلاء الرجال من التصرّف الوجودي خير دليل على ما نقول. بيد
أنّ ذلك كله لا يلغي المدلول المعرفي الذي أومأ إليه النصّ الذي سبق هذا النصّ ، كما
هناك ما يدل عليه في نصوص اخرى.
على أنّ هذا التصوّر بكامل أجزائه ينسجم
تمام الانسجام مع رؤية هذا التيار التي لا تنظر إلى القرآن الكريم في حدود رسوم
الكلمات والصور اللفظية ، بل هي تعتقد أنّ وراء هذه الألفاظ حقيقة وجودية ، وما الصورة
اللفظية التي بين الدفتين إلّا التنزّل الأخير لتلك الحقيقة الوجودية.
تنوّع التلاوات وتنوّع الفهم
ينتج عن هذا التصوّر الوجودي لمراتب القرآن
ومراتب الرجال ، ما يكمّله في واقع التلاوة حيث لكلّ تلاوة معنى وجودي ومعرفي
أيضا. فليس الإنسان بإزاء تلاوة واحدة بل هو بإزاء تلاوات ، تلاوة القرآن في
الوجود ، وتلاوته من خلال النفس ، وتلاوة للنصّ من خلال الوجود الإنساني الذي
يتفاعل فيه التالي مع النصّ تبعا لحالاته بحيث يكون لكلّ عضو تلاوته الخاصة به ، بلوغا
إلى التلاوة القصوى أو السماع عن اللّه. يقول : «إنّ على اللسان تلاوة ، وعلى
الجسم بجميع أعضائه تلاوة ، وعلى النفس تلاوة ، وعلى القلب تلاوة ، وعلى الروح
تلاوة ، وعلى السرّ تلاوة ، وعلى سرّ السرّ تلاوة. فتلاوة اللسان ترتيل الكتاب على
الحدّ الذي رتب المكلّف له ، وتلاوة الجسم المعاملات على تفاصيلها في الأعضاء التي
على سطحه ، وتلاوة النفس التخلّق بالأسماء والصفات ، وتلاوة القلب الإخلاص والفكر
والتدبّر ، وتلاوة الروح التوحيد ، وتلاوة السرّ الاتحاد ، وتلاوة سرّ السرّ الأرب
وهو التنزيه الوارد عليه في الإلقاء منه جلّ وعلا. فمن قام بين يدي سيده بهذه
الأوصاف كلها ، فلم ير جزء منه إلّا مستغرقا فيه على ما يرضاه منه كان عبدا كليا ،
وقال له الحقّ إذ ذاك :
حمدني عبدي ، أو ما يقول على حسب ما ينطق به
العبد قولا أو حالا» (17).
من الواضح أنّ النص يجمع بين الجانبين أو
القراءتين الإدراكية والوجودية ، ومن ثمّ فهو يدفع الالتباس الذي يوهم أنّ العرفاء
يلغون الجانب العقلي والإدراكي.
أجل ، نصوصهم صريحة في تخطّي منطقة العقل والإدراك
، إلى ما هو أعلى منها حيث المعرفة القلبية ، بل التوحّد الوجودي مع الموضوع أي مع
حقيقة القرآن ، كلّ بحسب مرتبته ومستواه وسعته الوجودية. وتخطّي منطقة العقل والإدراك
إلى ما وراءها ، هو غير إلغاء هذه المنطقة ونفي قيمة العقل والمعرفة الإدراكية
القائمة على الفهم النظري.
هذا الاتجاه يعترف بقيمة المعرفة القائمة
على أساس الفهم النظري والإدراك العقلي ، لكنه لا يكتفي بهما وإنّما يدفع بالإنسان
صوب الارتقاء نحو ذرى جديدة تأتي ما بعد المعرفة العقلية. في نصّ مزدوج يجمع بين
الدلالتين المعرفية والوجودية وما ينطويان عليه من مراتب مختلفة في الفهم ، وفي
التوحّد مع القرآن والتخلّق بصفاته ، نقرأ لابن عربي : «و اعلم أنّ الاتباع إنّما
هو فيما حدّه لك في قوله ورسمه ، فتمشي حيث مشى بك وتقف حيث وقف بك ، وتنظر فيما
قال لك أنظر ، وتسلّم فيما قال لك سلّم ، وتعقل فيما قال لك اعقل ، وتؤمن فيما قال
لك آمن ، فإنّ الآيات الإلهية الواردة في الذّكر الحكيم وردت متنوّعة ، وتنوّع
لتنوّعها وصف المخاطب بها. فمنها آيات لقوم يتفكّرون ، وآيات لقوم يعقلون ، وآيات
لقوم يسمعون ، وآيات للمؤمنين ، وآيات للعالمين ، وآيات للمتّقين ، وآيات لأولي
النهى ، وآيات لأولي الألباب ، وآيات لأولي الأبصار.
ففصّل كما فصّل ولا تتعدّ إلى غير ما ذكر ، بل
نزّل كلّ آية وغيرها بموضعها ، وانظر فيمن خاطب بها وكن أنت المخاطب بها ، فإنّك
مجموع ما ذكر ، المنعوت بالبصر والنهي واللّب والعقل والتفكّر والعلم والإيمان والسمع
والقلب ، فاظهر بنظرك بالصفة التي نعتك بها في تلك الآية الخاصّة تكن ممّن جمع له
القرآن ، فاجتمع عليه فاستظهره فكان من أهله ، بل هو عين القرآن إذا كان على هذا
الوصف ، وهو من أهل اللّه وخاصّته» (18).
النص وافي الدلالة على تنوّع الخطاب تبعا
لتنوّع المخاطب بحيث يكون لكلّ إنسان من الفهم «على قدر نفوذه وفهمه ، وقوّة عزمه
وهمّه ، واتساع نفسه» (19) ، بالإضافة إلى دلالته الوجودية وحثّه
الإنسان كي يتحلّى بصفات القرآن ويتوحّد معها ليعيشها وجوديّا ويتذوّقها عيانا. وكلا
الطريقان مفتوحان أمام الإنسان مع فارق أنّ الثاني (الوجودي) للخاصة والأوّل ميسور
للقاعدة العريضة ، والحصيلة واحدة وهي تعدّد مراتب الفهم وجوديا كان أو معرفيا
نظريا.
تتحرّك القراءة الوجودية- كما المعرفية
أيضا- على خطّ صاعد لتتجاوز التطابق مع القرآن في المرحلة التي تكون فيها لكلّ عضو
تلاوته الخاصة به ، بلوغا إلى مرحلة السماع عن اللّه والتلقّي منه والفهم عنه.
يكتب في الباب الحادي والأربعين الخاص بمعرفة أهل الليل ، مميّزا بين ضروب التلاوة
، ومركّزا على التلاوة التي تكون من اللّه على لسان العبد : «فأنا [اللّه جلّ
جلاله] أتلو كتابي عليه بلسانه وهو يسمع ، فتلك مسامرتي ، وذلك العبد هو الملتذّ
بكلامي ، فإذا وقف مع معانيه فقد خرج عنّي بفكره وتأمّله ، فالذي ينبغي له أن يصغي
إليّ ويخلي سمعه لكلامي ، حتّى أكون أنا في تلك التلاوة كما تلوت عليه وأسمعته
أكون أنا الذي أشرح له كلامي وأترجم له عن معناه ، فتلك مسامرتي معه فيأخذ العلم
مني لا من فكره واعتباره ، فلا يبالي بذكر جنّة ولا نار ولا حساب ولا عرض ولا
دنيا ولا آخرة ، فإنّه ما نظرها بعقله ولا بحث عن الآية بفكره ، وإنّما ألقى السمع
لما أقوله له ، وهو شهيد حاضر معي ، أتولى تعليمه بنفسي فأقول له يا عبدي أردت
بهذه الآية كذا وكذا ، وبهذه الآية الاخرى كذا وكذا ، هكذا إلى أن ينصدع الفجر
فيحصل من العلوم على يقين ما لم يكن عنده ، فإنّه منّي سمع القرآن ، ومنّي سمع
شرحه وتفسير معانيه ، وما أردت بذلك الكلام وبتلك الآية والسورة» (20).
هكذا تخلص هذه الرؤية إلى أنّ السرّ في
تعدّد مراتب الفهم ، يرجع إلى كينونة القرآن ومحتواه وأنّه يتألّف من حقائق ذات
مراتب متعدّدة. وهذا النسيج يلتقي على نحو مماثل مع كينونة مماثلة للإنسان والعالم
ليؤلّف الثلاثة نسقا أو منظومة وجودية متوازية ، يكون فيها الإنسان والقرآن والعالم
تجليات للاسم الأعظم وما يقع تحته من أسماء ، لها ما يناظرها في مراتب تلك
المنظومة الوجودية.
على هذا نحن أمام منظومة وجودية متكاملة لا تفسّر
مراتب الفهم واختلافه وحسب ، بل تتخطّى ذلك إلى تقديم تفسير شامل للوجود برمّته
بما في ذلك القرآن.
تؤسّس هذه المدرسة لقاعدة معرفية مهمّة تفيد
بأنّه : «لا يمكن لأحد أن يعلم شيئا ليس فيه مثله البتة»(21). فما لم تكن حقيقة القرآن موجودة في
الإنسان ومبثوثة في الكون من حوله ، يستحيل عليه أن يتلو كتاب اللّه ويفقهه ويتعلّم
منه سواء أ كانت تلك التلاوة أنفسية أو آفاقية أو نصية. فنحن إزاء حقيقة واحدة لها
مراتب ومظاهر متعدّدة في الإنسان- والإنسان الكامل ذروته- وفي الكون ، وفي وشاح
الألفاظ وكسوتها حيث تجلّت تلك الحقيقة بين الدفتين في تنزّلها الأخير ، ماثلة في
المصحف الذي بين أيدينا.
ثانيا : صدر الدين الشيرازي (ت : 1050 هـ)
يتحرّك صدر الدين الشيرازي على هدي المنظومة
الوجودية ذاتها التي وضع ابن عربي مرتكزاتها. والأمر لا يقتصر على نظرية مراتب فهم
القرآن ، بل هو يحذو حذوه في جميع اشتغالاته الحكمية ورؤاه في المعرفة الإلهية.
أ- مرتكزات النظرية :
فبشأن مراتب الفهم يصدر الشيرازي عن التصوّر
ذاته الذي يذهب إلى الموازاة بين الوجود والقرآن والإنسان ، وأنّها جميعا تجليات
لأسماء اللّه ومجالي لها. فالإنسان والقرآن والوجود وإن كانت مظاهر لاسم اللّه
الأعظم وما تحته من أسماء ، إلّا أنّها تنطوي على مراتب ودرجات يناظر كلّ واحد
منها ما هو موجود في الآخر ويوازيه.
على أساس هذه المطابقة صحّ أن يكون بين
أيدينا قرآن تدويني وتكويني وآفاقي وأنفسي ، ونصوص الشيرازي وافية في التدليل على
هذا المعنى وإثباته ، وهي في الغالب مقاربة لنصوص ابن عربي بل مقتبسة منها في غالب
الأحيان ، تماما كما سنرى في نصوص الإمام الخميني ، ممّا يدلّ على وحدة المدرسة.
يقدّم صدر الدين نصوصا مكثّفة للتوازي
القائم بين الإنسان والعالم ، وأنّ الإنسان هو على صورة العالم يحاكيه في المراتب
الوجودية وما تنطوي عليه من درجات ، منها : «كما أنّ العالم بتمامه منقسم إلى غيب
وشهادة ، كذلك الإنسان الذي هو على صورة العالم؛ عالم صغير مشتمل على غيب وشهادة
، أي روح وجسم» (22).
هذا التوازي الوجودي بين العالم والإنسان ، له
صورة مماثلة تماما بين الإنسان والقرآن : «و بالجملة إنّ للقرآن درجات ومنازل كما
للإنسان ، وأدنى مراتب القرآن وهو ما في الجلد والغلاف كأدنى مراتب الإنسان ، وهو
ما في الإهاب البشرة» (23).
من مقتضيات الفلسفة الوجودية في الخط الذي
يتبنّاه ابن عربي وصدر الدين ومن والاه تبعا له ، وحدة حقيقة الإنسان كما القرآن ،
بيد أنّ لهذه الحقيقة أسماء ومجالي وتجليات تبعا لمراتبها الوجودية : «فكما أنّ
الإنسان حقيقة واحدة وله مراتب كثيرة وأسامي مختلفة يسمّى في كلّ عالم باسم خاص
مناسب لمقامه الخاص في الصعود ، فكذلك القرآن حقيقة واحدة وله مراتب كثيرة وأسامي
مختلفة يسمّى في كلّ عالم باسم خاص مناسب لمقامه الخاص في النزول» (24). في نص آخر يتناول صدر الدين علاقة التوازي
الوجودي بين القرآن والإنسان على نحو أكثر تفصيل ، نقرأ فيه : «اعلم أنّ القرآن
كالإنسان ينقسم إلى سرّ وعلن ، ولكلّ منها أيضا ظهر وبطن ولبطنه بطن آخر إلى أن
يعلمه اللّه ، ولا يعلم تأويله إلّا اللّه. وقد ورد أيضا في الحديث (أنّ للقرآن
ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن) ، وهو كمراتب باطن الإنسان من الطبع والنفس
والصدر والقلب والعقل والروح والسرّ والخفي» (25).
ثمّ انعطف لبيان النتيجة المعرفية المترتبة
على هذا التناظر الوجودي القائم بين القرآن والإنسان ، متمثّلة بتفاوت درجات
المعرفة واختلاف مراتب الفهم تبعا لذلك ، حيث أضاف : «أمّا ظاهر علّته فهو المصحف
المحسوس الملموس والرقم المنقوش الممسوس ، وأمّا باطن علّته فهو ما يدركه الحسّ
الباطن ويستثبته القرّاء والموجودون في خزانة مدركاتهم ومخزوناتهم كالخيال ونحوه
.. فهاتان المرتبتان من القرآن دنياويتان ممّا يدركه كلّ إنسان بشري. وأمّا باطنه
وسرّه فهما مرتبتان أخراويتان ، ولكلّ منهما مراتب ودرجات ومنازل ومقامات» (26).
يوضّح صدر الدين الرؤية ذاتها على نحو آخر
عند ما يسجّل : «إنّ العوالم بكثرتها ثلاثة ، والمدارك الإنسانية على شجونها ثلاثة
، والإنسان بحسب غلبة كلّ واحد منها يقع في عالم من هذه العوالم والنشآت ، فبالحسّ
يقع في العالم الدنياوي وبه ينال الصور الحسّية ... وبالقوّة الباطنية الجزئية يقع
في النشأة الثانية ... وبالقوّة الباطنة يقع في النشأة الثالثة ... فالناس أصناف
ثلاثة أهل الدنيا وهم أهل الحس ...
وأهل الآخرة وهم الصلحاء ... وأهل اللّه وهم
العرفاء باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»(27).
و العوالم المشار لها ليست متناظرة وجوديا وحسب
، بل هي متطابقة بالصورة أيضا : «فاللّه تعالى ما خلق شيئا في عالم الصورة إلّا وله
نظير في عالم المعنى ، وما خلق شيئا في عالم المعنى وهو الآخرة إلّا وله حقيقة في
عالم الحقّ وهو غيب
الغيب ، إذ العوالم متطابقة الأدنى مثال
الأعلى ، والأعلى حقيقة الأدنى وهكذا إلى حقيقة الحقائق» (28).
على ضوء هذا التطابق يكتسب العالم المادّي
عمقه في عالم أرقى منه وأكثر تكاملا ، بحيث يكون الأدنى مثالا للأعلى ومرقاة إليه
: «ما من شيء في هذا العالم إلّا وهو مثال لأمر روحاني من عالم الملكوت كأنّه
روحه ومعناه ، وليس هو في صورته وقالبه ، والمثال الجسماني مرقاة إلى المعنى
الروحاني»(29).
إمعانا في تركيز هذا التصوّر وعطفا له على
الإنسان ، نقرأ في نص آخر :
«فجميع ما في هذا العالم أمثلة وقوالب لما
في عالم الآخرة ، وما في الآخرة هي مثل وأشباه للحقائق والأعيان الثابتة التي هي
مظاهر أسماء اللّه تعالى ، ثمّ ما خلق في العالمين شيء إلّا وله مثال وأنموذج في
عالم الإنسان» (30). وقد مرّ علينا التناظر بين الإنسان والقرآن
، الذي لنا أن نؤكّده بنص جديد يسجّل فيه الشيرازي : «فإذا تقرّر هذا ثبت أنّ
للقرآن منازل ومراتب ، كما للإنسان درجات ومعارج» (31). كما قوله أيضا : «و بالجملة للقرآن درجات
كما مرّ ، وكذلك للإنسان بحسبها» (32).
و كذلك : «فعلم من هذا أنّ الإنسان ومراتبه
مثال مطابق للإيمان ومراتبه ، وكذا حكم القرآن» (33).
ب- النتائج المترتبة :
أوّل ما يترتب على هذا التصوّر الوجودي
لثلاثية العالم والإنسان والقرآن ، أنّ القرآن الكريم ليس ألفاظا هي هذه التي تقع
بين الدفتين وحسب ، وإنّما هو : «علم بحقائق الأشياء» (34). وما الصورة اللفظية إلّا التنزّل الأخير
لتلك الحقائق أو للحقيقة القرآنية ، فالقرآن : «نزل إلى العالم الأسفل لنجاة
المحبوسين في سجن الدنيا ... [و] تلبّس بلباس الحروف والأصوات واكتسى بكسوة
الألفاظ والعبارات رحمة من اللّه وشفقة على عباده وتأنيسا لهم ، وتقريبا إليهم وإلى
أفهامهم ومداراة معهم ومنازلة إلى أذواقهم ، وإلّا فما للتراب وربّ الأرباب» (35).
من النتائج أيضا وجود علاقة تفاعلية بين
الإنسان والقرآن والعالم ، فالإنسان يقرأ العالم من خلال المصحف ، وتتحوّل وجودات
عالم الإمكان إلى شفرات ومفاتيح لقراءة القرآن آفاقيا واستشراف حقائقه ، كما أنّه
يطل على القرآن من داخله ويتلوه أنفسيا وهكذا. يكتسب القرآن عبر شبكة التفاعل
الوجودي هذه صورة أو بعدا تكوينيا وتدوينيا وآفاقيا وأنفسيا. يكتب الشيرازي في
الإيماء إلى أحد مستويات هذه العلاقة التفاعلية : «و اعلم أنّ اختلاف صور
الموجودات وتباين صفاتها وتضادّ أحوالها ، شواهد عظيمة لمعرفة بطون القرآن وأنوار
جماله وأضواء آياته وأسرار كلماته ، ولتعلّم أسماء اللّه الحسنى وصفاته العليا ، لما
مرّت الإشارة إليه من أنّ الكتاب الفعلي الكوني بإزاء الكلام القولي العقلي ، وهو
بإزاء الأسماء والصفات الإلهية ، لكن هناك على وجه الوحدة والإجمال وهاهنا على وجه
الكثرة والتفصيل ... وكما أنّ صور الكائنات من الأرض والسماوات وما بينهما- وهي
عالم الخلق- تفصيل لما في عالم العقل وهو عالم الأمر ، فكذلك جميع ما في العالمين
الأمر والخلق كتاب تفصيلي لما في العالم الإلهي من الأسماء والصفات» (36).
يضع النصّ الكون وما فيه بإزاء النصّ
القرآني ، وذلك على النحو الذي تتحوّل به موجودات عالم الإمكان إلى مفاتيح لما
يطويه النص القرآني من بطون ومعان ، والاثنان هما مظاهر لأسماء اللّه. وهذا هو المعنى
ذاته الذي أسس له ابن عربي ، وعاد الشيرازي لتكراره وهو يقول : «فكل ما في عالم
الإمكان صورة اسم من أسماء اللّه ومظهر شأن من شئونه» (37).
أمامنا نص آخر يتحدّث عن العلاقة التفاعلية
بين القرآن والإنسان والوجود ، على النحو التالي : «فعالم الكلام والقول فيه آيات
أمرية عقلية وعلمية ، وعالم الكتاب والفعل فيه آيات خلقية كونية عملية. وما لم
يطّلع الإنسان أوّلا بمشاعر نفسه وبدنه هذه الآيات الفعلية الكتابية والآفاقية والأنفسية
، لم يترقّ بها ذاته من مقام الحسّ والنفس إلى مقام القلب والروح ، فيسمع ويفهم
تلك الآيات العقلية [القولية] الكلامية حتّى يعرف بها الحقّ الأوّل ، كما قال : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي
الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت : 53] » (38).
صحيح أنّ الإنسان في هذا التصور الفلسفي هو
كون ، بل : «هو أشرف الأكوان» (39) له في ذاته قابلية الترقّي إلى حد الكمال والتعانق مع أنوار المبدأ ،
وصحيح أيضا أنّ في القرآن سعة ورحابة في الفهم ، حيث أنّ : «العلم بكتاب اللّه
أوسع من أن يحصره حدّ معين أو يضبطه قانون مبين» (40) ؛ إلّا أنّ المقصود من الإنسان بالدرجة الاولى هو الإنسان الكامل
الذي يتحلّى بالمرتبة القصوى من معرفة القرآن ، بل هو مظهر وجودي للقرآن ، كما
القرآن مظهر نصّي له ، وكلاهما مظهران لاسم اللّه الأعظم وما يندرج تحته من
الأسماء ، ثمّ يليه من يليه بحسب سعته الوجودية. وهذه نتيجة اخرى تترتب على التصور
الصدرائي تماما كما لحظنا عند ابن عربي.
يسجّل في نص دال ومكثّف عن مكانة الإنسان
الكامل : «الإنسان الكامل كتاب جامع لآيات ربّه القدّوس ، وسجّل مطوي فيه حقائق
العقول والنفوس ، وكلمة كاملة مملوّة من فنون العلم والشجون ، ونسخة مكتوبة من
مثال {كُنْ
فَيَكُونُ}
بل أمر وارد من (الكاف والنون) لكونه مظهر اسم اللّه الأعظم الجامع لجميع الأسماء» (41). كما قوله أيضا : «إنّ الإنسان الكامل هو
الكتاب الجامع لجميع آيات الحكمة ، المشتمل على حقائق الكون كلّه حديثه وقديمه» (42). ولهذا الإنسان قوّة كلّ موجود في العالم ،
وله جميع المراتب ، لهذا : «اختصّ وحده بالخلافة الإلهية وبكونه مخلوقا على الصورة
، فجمع بين الحقائق الإلهية وهي الأسماء ، وبين المراتب الكونية وهي الأجزاء ، فيظهر
به ما لا يظهر بجزء جزء من العالم ولا بكلّ اسم من الحقائق الإلهية ، فكان الإنسان
أكمل الموجودات» (43).
وعليه يضحى هذا الإنسان العبد الحقيقي الذي
يجسّد العبودية في وجوده بأعلى ممكناتها ، بحكم ما يحظى به من معرفة ، لأنّ
العبودية فرع المعرفة : «أمّا الإنسان الكامل فهو الذي يعرف الحقّ بجميع المشاهد والمشاعر
، ويعبده في جميع المواطن والمظاهر ، فهو عبد اللّه يعبده بجميع أسمائه وصفاته ، ولهذا
سمّي بهذا الاسم أكمل أفراد الإنسان محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم» (44). على هذا : «فالكتاب إشارة إلى ذات النبي
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المعبّر عنه تارة بالقرآن ... وتارة بالفرقان» (45) وإنّ «حقيقة القرآن عند المحقّقين من العرفاء هو جوهر ذات النبي صلّى
اللّه عليه وآله وسلّم» (46).
_______________________
(1)- في
مؤلّف واحد من مصنّفات الإمام هو «شرح دعاء السحر» ذكر ابن عربي أكثر من عشر مرّات
، ثمّ جاء صدر الدين الشيرازي بالمرتبة الثانية ، هذا فضلا عن كثافة الاقتباس من
نصوصهما وأفكارهما ، بخاصّة الأوّل.
(2)- سخن عشق ، ديدگاههاى إمام خميني وابن
عربى : 131.
(3)- الفتوحات المكّية 4 : 106.
(4)- نفس المصدر : 230 فما بعد ، حيث يسوق
تطبيقات وأمثلة كثيرة على هذا التطابق.
(5)- نفس المصدر : 124.
(6)- نفس المصدر : 65- 66.
(7)- أخرجه بلفظ «اعطيت» البخاري في صحيحه ،
وكذلك مسلم والترمذي بالإضافة إلى ابن حنبل في مسنده. كما أخرجه أيضا البخاري والنسائي
بلفظ «بعثت بجوامع الكلم». راجع في توثيق المصادر : الفتوحات المكّية ، السفر
الأوّل : 499.
(8)- الفتوحات المكّية 4 : 61.
(9)- نفس المصدر 1 : 73.
(10)- نفس المصدر 3 : 108.
(11)- نفس المصدر 1 : 56.
(12)- فلسفة التأويل ، دراسة في تأويل
القرآن عند محيي الدين بن عربي : 275.
(13)- مواقع النجوم : 67- 68 ، نقلا عن :
فلسفة التأويل : 275- 276.
(14)- الفتوحات المكّية 4 : 411.
(15)- نفس المصدر 1 : 187.
(16)- نفس المصدر : 187- 188.
(17)- مواقع النجوم : 83 ، نقلا عن فلسفة
التأويل : 292- 293.
(18)- الفتوحات المكّية 4 : 105- 106.
(19)- نفس المصدر 1 : 73.
(20)- نفس المصدر : 239.
(21)- نفس المصدر 2 : 102.
(22)- تفسير القرآن الكريم 6 : 55.
(23)- الحكمة المتعالية 7 : 39.
(24)- تفسير القرآن الكريم 6 : 22- 23.
(25)- الحكمة المتعالية 7 : 36 ، وقد عقب
الشيخ هادي السبزواري المتوفى في سنة 1289 هـ - على النص في الهامش ، بقوله : «و
لعل الصدر- وهو مقام الخيال كما مرّ- زيادة من النساخ ، وإلّا لكانت المراتب
ثمانية».
(26)- نفس المصدر : 36- 37.
(27)- تفسير القرآن الكريم 4 : 101- 102.
(28)- نفس المصدر : 166.
(29)- نفس المصدر : 172.
(30)- نفس المصدر : 166.
(31)- نفس المصدر 7 : 112.
(32)- نفس المصدر : 109.
(33)- نفس المصدر : 110.
(34)- نفس المصدر : 103.
(35)- نفس المصدر 6 : 8- 9.
(36)- الحكمة المتعالية 7 : 31- 32.
(37)- تفسير القرآن الكريم 1 : 34.
(38)- تفسير القرآن الكريم 7 : 112- 113.
(39)- نفس المصدر 1 : 2.
(40)- نفس المصدر 4 : 338.
(41)- نفس المصدر : 396- 397.
(42)- نفس المصدر 1 : 188.
(43)- نفس المصدر : 190.
(44)- نفس المصدر : 41- 42.
(45)- نفس المصدر 6 : 22 عند تفسير قوله سبحانه : {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [السجدة : 2] .
(46)- نفس المصدر.
 الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)