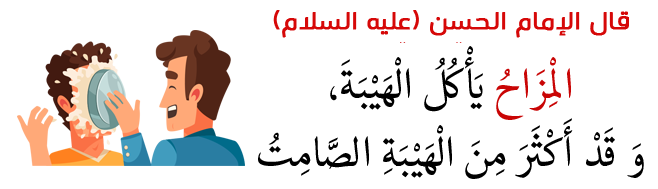
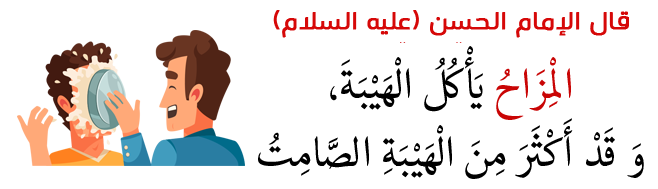

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
التاريخ: 19-09-2014
التاريخ: 19-09-2014
التاريخ: 5-11-2014
|
يمتاز القرآن على سائر الكلام بدقّته الفائقة في تعابيره ، واضعاً كل شيء موضعه اللائق به ، مراعياً كل مناسبة ـ لفظيةً كانت أم معنويةً ـ في أناقة تامّة ـ لم تفته نكتة إلاّ سجّلها ، ولم تفلت منه مزيّة إلاّ قيّدها ، في رصف بديع ونضد جميل ، جامعاً بين عذوبة اللفظ وفخامة المعنى ، متلائماً أجراس كلماته مع نوعية المراد ، متماسك الأجزاء ، متلاحم الأشلاء ، كأنما أُفرغت إفراغة واحدة ، وسُبكت في قالب فذّ رصين ، بحيث لو انتزعت لفظة من موضعها أو غُيّرت إلى غير محلّها أو أُبدلت بغيرها لأخلّ بمقصود الكلام واضطرب النظم واختلّ المرام ، ولقد كان ذلك مِن أهمّ دلائل صيانته من التحريف ، فضلاً عن كونه سند الإعجاز .
أضف إليه جانب ( لحن الأداء ) هو تناسب جرس اللفظ مع نوعية المفاد ، من وعد أو وعيد ، ترغيب أو ترهيب ، أمر أو زجر ، عظة أو حكمة ، فرض أو نفل ، مثوبة أو عقاب ، مكرمة أو عتاب ... إلى غيرها من أنواع الكلام ، كل نوع يستدعي لحناً في الخطاب يخالفه نوع آخر ، الأمر الذي راعته التعابير القرآنية بشكل بديع وأُسلوب غريب ، وكان سرّاً غامضاً من أسرار إعجازه ، ودليلاً واضحاً على كونه صنيع مَن لا يعزب عن علمه شيء ، وقد أحاط بكلّ شيء علماً .
وهذا شيء اعترفت به جهابذة الفن ، وأذعنت له علماء البيان وأُمراء الكلام ، فضلاً عن شهادة أفذاذ العرب الأقحاح .
فلنستمع الآن إلى كلماتهم المشرقة :
قال الشيخ عبد القاهر : أعجزتم مزايا ظهرت لهم في نظمه ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادي آيه ومقاطعها ، ومجاري ألفاظها ومواقعها ، وفي مضرب كل مثل ، ومساق كل خبر ، وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام ، وتذكير وترغيب وترهيب ، ومع كل حجة وبرهان ، وصفة وتبيان ، وبهرهم أنهم تأمّلوه سورة سورة ، وعشراً عشراً وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ، ولفظة يُنكر شأنها أو يُرى أنّ غيرها أصلح هناك أو أشبه ، أو أحرى أو أخلق ، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول ، وأعجز الجمهور ، ونظاماً والتئاماً ، وإتقاناً وإحكاماً ، لم يدع في نفس بليغ منهم ـ ولو حكّ بيافوخه السماء (1) موضع طمع ، حتى خرست الألسن عن أن تدّعي وتقول ، وخلدت القُروم (2) فلم تملك أن تصول (3) .
زيادة المباني تستدعي زيادة المعاني :
قاعدة كلّية مطّردة تدعمها حكمة الوضع ، على ما سلف في كلام أبي هلال العسكري ، إذ ليست الأوضاع سوى دلائل وإشارات إلى المعاني والمرادات ، ولولا اختصاص كل لفظة ـ في مادّتها وهيأتها ـ بمعنى من المعاني ، فلا تتعدّاه إلى غيره كما لا يدلّ عليه غيرها ، لانتفت فائدة الوضع ، وعاد محذور الإبهام والترديد ـ كما في الاشتراك ـ أو نقض حكمته ـ كما في المترادفات ـ بعد الاستغناء عن الوضع الثاني بالوضع الأوّل ، وهو عبث ولغو .
وعليه فكل تصريف في الكلمة أو تغيير في حركتها فإنما هو للدلالة على معنى جديد لم يكن فيما قبل ، فمثل ( ضرّ ) و( أضرّ ) لابدّ أن يختلف معناهما ، كما هو كذلك ، فالأوّل للدلالة على إيقاع الضرر به سواء قصده أم لم يقصده ، والثاني إيقاعه عن عمد وقصد ، يقال : ضرّه ، وهو بمعنى ضد نَفعه ، وأضرّه : جلب عليه الضرر ، كمَن حاول تمهيد أسباب مؤاتية للإضرار به ، كما في ( ضرّ ) و( ضارّ ) أيضاً من الفرق ، فالأوّل إضراره بالفعل ، والثاني محاولة إضراره سواء تمكّن من الإيقاع به أم لم يتمكّن ، كما في ( خَدَع ) و( خادَع ) في قوله تعالى : {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [البقرة : 9] ، أي يحاولون خداعه تعالى والمؤمنين لكنّهم فاشلون في هذه المحاولة ، سوى أنّهم يخدعون بالفعل أنفسهم وينخدعون بتصوّرهم أنّهم خدعوا الله ورسوله .
فقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : ( لا ضررَ ولا ضِرار في الإسلام ) في حديث سمرة بن جندب (4) ، المراد به : أنّ الإسلام لا يدع مجالاً لأحد في أن يضرّ غيره أو أن يُحاول الإضرار به ، كما في شأن سمرة حاول الإضرار بالأنصاري ، حيث امتنع أن يستأذن عيه في الدخول أو بيع عذقه أو مبادلتها بما ضمنه له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأبى إلاّ الدخول بلا إذن ؛ ومِن ثَمّ أمر النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بقلع عذقه ورميه في وجهه ، وقال له : ( أنت رجل مضارّ! ) أي الذي يُحاول ويَعمد إلى الإضرار بغيره .
وقال الزمخشري : وفي الرحمن مبالغة ما ليس في الرحيم ، ثم استشهد بقولهم : ( إنّ الزيادة في البناء لزيادة المعاني ) . ونُقل عن الزجّاج قوله في الغضبان : هو الممتلئ غضباً ، قال : وممّا طنّ على أُذُني من ملح العرب أنّهم يُسمّون مركباً من مراكبهم بالشُقدُف ، وهو مركب خفيف ليس في ثقل مَحامل العراق ، فقلت ـ في طريق الطائف لرجل منهم ـ : ما اسم هذا المحمل ؟ ـ أردت المَحمل العراقي ـ فقال : أليس ذاك اسمه الشُقدُف ؟ قلت : بلى . فقال : هذا الشقنداف ... فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمّى (5) .
الاشتراك والترادف في اللغة :
الاشتراك : وضع اللفظ بإزاء معنيين أو أكثر لا جامع بينهما ، وهو الاشتراك اللفظي ، في مقابل الاشتراك المعنوي ، وهو وضع اللفظ بإزاء معنى واحد جامع بين صنوف من المتبائنات والمتغائرات كلفظ الحيوان الموضوع لصاحب الحياة النامية ذات الحركة الإرادية ، الشامل لمثل الإنسان وغيره من أنواع الحيوان ، وهذا من المشترك المعنوي الخارج من موضوع بحثنا الآن ؛ لأنّه من اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد ، فلا اشتراك حقيقة ، وإنّما هو في الإطلاقات وكثرة المصاديق المتنوّعة .
أمّا المشترك اللفظي فهو اللفظ الموضوع لمعانٍ مختلفة في أوضاع متعدّدة ، كلفظ العين الموضوعة للنقد المسكوك باعتبار نضّ المال وأصله وحقيقته ، وللناظرة ، وللنابعة ، وللجاسوس ، وللربيئة ... .
وهذا على خلاف حكمة قانون الوضع ، حسبما تقدم مِن أنّه للدلالة على المعنى المراد وتمييزه عمّا عداه تمييزاً مطلقاً ، كما في الرموز والإشارات ذوات العهد الخارجي ؛ إذ لولا الاختصاص والتمييز المطلق لم تعد لها فائدة ، ولعاد محذور الإبهام والإجمال في دلالة الكلام ، أمّا الاعتماد على القرينة فهو من الدلالة العقلية ، ولا تمسّ جانب الوضع في شيء .
ولعلّ الاشتراك إنما جاء في اللغات من جرّاء ، تعدّد الواضعين وتباعد ما بينهم من آفاق واختلاف أسباب الحاجة إلى الوضع حسب تطوّر العادات والأعراف المتداولة عند كل قوم ، فلمّا تقاربت الأعراف وتوحّدت اللغات ، ولا سيّما بعد ظهور الإسلام وسلطان لغة القرآن ، وجَدوا أنفسهم تجاه أمر واقع ـ وهي الأوضاع المتفاوتة الوجبة لاشتراك بعض الألفاظ ـ أمراً لا محيص عنه .
أمّا الترادف فهو توارد لفظين أو أكثر على معنى واحد ، عكس الاشتراك ، كلفظ الإنسان والبشر ، والبعير والإبل ، والشاة والغنم ، والضرغام والضيغم والغضنفر والليث والأسد ، والصمصام والصارم والسيف والحسام والمهنّد والمشرفي ... إلى غير ذلك وهو كثير في اللغة .
وهو أيضاً على خلاف حكمة قانون الوضع ، لو أُخذ بإطلاقه وعلى ظاهره الأَوّلي : لأنّ الإشارة تكفيها الواحدة ، فتقع الأُخرى والتالية عبثاً ولغواً ، كما تقدم بيانه ... وقد عالج القوم هذا الجانب في عناية ودقّة ، فوجدوا أن لا ترادف في واقع الأمر ، وإنما هي حالات وصفات تعتور الشيء فتختلف أسماؤه ونعوته ، وهكذا وجدوا أكثر المشتركات أنّها باعتبار أحوال وأوصاف ملحوظة في المُسمّى وهي الموضوع له بالذات وليس ذات الشيء نفسه ، فهو بالاشتراك المعنوي أشبه من كونه مشتركاً لفظيّاً . هكذا عالج القوام أمر وقوع الاشتراك والترادف في اللغة على خلاف الأصل .
وإليك بعض التبيين من هذا الجانب الخطير :
لا اشتراك مع رعاية الجامع :
أكثر ما يُظنّ كونه من المشترك اللفظي ( من تعدّد الوضع ) لا تعدّد في وضعه ، وإنّما هو وضع واحد ، وكان سائر موارد استعماله بالعناية والمجاز وإن كان قد غلب استعماله حتى صار حقيقةً ثانيةً بغلبة الاستعمال ، وهو من الوضع التعيّني لا التعييني حسب المصطلح ، نظير العَلَم بالغلبة على ما هو معروف .
وهكذا أوضاع تعيّنية ( حاصلة بغلبة الاستعمال ) شايع في اللغة من غير أن يستلزم المحذور المذكور ؛ لأنه من قبيل التوسّع في الوضع الأَول بتقديره وضعاً للأعمّ من الحقيقة الذاتية ، فيكون استعماله في كلّ من المعنيين من قبيل استعمال اللفظ الموضوع لعام في آحاد مصاديقه المتنوّعة ، وهو من الاشتراك المعنوي الذي لا محذور فيه أصلاً .
فلفظ ( العين ) لم يوضع لمعان متعدّدة في وضعه الابتدائي ، وإنّما الموضوع له أَولاً هي الناظرة وكان الباقي فرعاً عليها . قال ابن فارس ـ في معجم مقاييس اللغة ـ : العين والياء والنون أصل واحد صحيح يدلّ على عضوٍ به يبصر وينظر ، ثُمّ يُشتقّ منه ، والأصل في جميعه ما ذكرنا .
قال : وفي المَثل ( صنعتُ ذاك عمد عين ) إذا تعمّدته ، والأصل فيه العين الناظرة ، أي أنّه صَنع ذلك بعينِ كلِ مَن رآه . ومن الباب العين الذي تبعثه يتجسّس الخبر ، كأنّه شيء ترى به ما يغيب عنك ، ومنه العين الجارية النابعة من عيون الماء ، وإنما سمّيت عيناً ؛ تشبيهاً لها بالعين الناظرة لصفائها ومائها ، ويقال : عانت الصخرة ، إذا كان بها صدع يخرج منه الماء ، ويقال : حَفر فأعين وأعان .
قال : ومن الباب العين للسحاب الآتي من ناحية القبلة ( الشمال ) وهذا مشبَّه بمشبَّه ؛ لأنّه شُبّه بعين الماء التي شُبّهت بعين الإنسان ، وعين الشمس أيضاً مُشبَّه بعين الإنسان ، ومن الباب أعيان القوم أي أشرافهم ، وهم قياس ما ذكرنا ، كأنّهم عيونهم التي بها ينظرون .
قال : ومن الباب العين للمال العتيد الحاضر ، يقال : هو عين غير دَين أي هو مال حاضر تراه العيون ، وعين الشيء نفسه ، تقول : خُذ درهمك بعينه (6) ، كأنّه مُعاين مشهود تشهده العيون بلا تبدّل ولا اختلاف .
وأمّا القُرء المشترك بين الطهر والحيض ـ على ما هو المشتهر بين الفقهاء ـ فقد أنكره أهل اللغة ، قال ابن الأثير : وهو من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز ، وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق .
والأصل فيه الوقت المعلوم ، فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكل منهما وقتاً .
قال ابن فارس : القاف والراء والحرف المعتلّ أصل صحيح يدلّ على جمع واجتماع ، من ذلك القرية لاجتماع الناس فيها . ويقولون : قريتُ الماء في المِقراة : جمعته ، وذلك الماء المجموع قريّ ، والمِقراة : الجفنة ؛ لاجتماع الضيف عليها أو لِما جُمع فيها من الطعام .
قال : ومن الباب القَرو ، وهو كالمعصرة . والقَرو : حوض ممدود عند الحوض الكبير ترده الإبل ، ومن الباب القَرو ، وهو كلّ شيء على طريقة واحدة ، تقول : رأيت القوم على قرو واحد ، ومن الباب القَرَى : الظهر ؛ لأنّه مجتمع العظام .
قال : وإذا همز هذا الباب كان هو والأَوّل سواء ، ومنه القرءان .
وأمّا أَقرأَتْ المرأة ( بمعنى حاضت ) فيقال : إنّها من هذا الباب أيضاً ، وذكروا أنّها تكون كذا في حال طُهرها ، كأنّها جمعتْ دمَها في جوفها فلم تُرخِه ، قالوا : والقُرء وقت ، يكون للطهر مرّة وللحيض أخرى ، قال : وجملة هذه الكلمة مشكلة (7) .
قلت : لعلّه من القَرو بمعنى الاستواء على طريقة واحدة ، كما جاء في كلامه ، وهو المُعبّر عنه بالعادة المعروفة عند النساء ، يَعتورهنّ الطمث كلّ شهر عادة مستقرة ، نظير أقراء الشعر بمعنى أوزانه وأطواره ، كما جاء في حديث إسلام أبي ذر : لقد وضُعت قوله على أقراء الشِعر فلا يلتئم على لسان أحد (8) .
ومنه قول الشاعر :
إذا ما السماءُ لم تُغِم ثم أَخلفت *** قروءُ الثريّا أنْ يكون لَها قَطرُ
أي مواقع طلوعها وهو وقت رتيب .
وقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : ( تَدع الصلاةَ أيّام أقرائها ) أيضاً شاهد على هذا المعنى .
نعم قالت عائشة : أو تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار (9) ، وهي أَول من أبدت هذا الرأي وأغربت ، وسار من خلفها لفيف من فقهاء الحجاز ، وقد صدرت روايات من أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) في هذا الجوّ السائد ، غير أنّ هناك روايات أخرى صدرت بعيدة عن الضغط الحاكم ، وفَسّرت الأقراء بثلاث حيض . روى الشيخ بإسناده الصحيح عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال ( عدّة التي تحيضُ ويستقيمُ حيضُها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض ) (10) .
وعليه فلم يثبت اشتراك هذه اللفظة بين الطهر والحيض ، كما زعمه أناس !
هذا ، وقال حاول الراغب الأصفهاني الجمع بين الأقوال ، فزعم أنّ القُرء اسم للدخول في الحيض ، قال : والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر ، ولمّا كان اسماً جامعاً للأمرين ـ الطهر والحيض ـ المتعقّب له أُطلق على كلّ واحد منهما ... وليس القرء اسماً للطهر مجرّداً ولا للحيض مجرّداً ، بدلالة أنّ الطاهر التي لم ترَ أثر الدم لا يقال لها ذات قرء ، وكذا الحائض التي استمرّ بها الدم ... وقول أهل اللغة : إنّ القرء من قرأ أي جمع ، فإنهم اعتبروا الجمع بين زمن الطهر وزمن الحيض حسبما ذكرت لاجتماع الدم في الرحم (11) .
ولم يأتِ بشاهد من اللغة على اختياره الغريب ، فهو اجتهاد مجرّد ، كما هي عادته في غير موضع ، والصحيح الذي تدعمه شواهد اللغة هو ما ذكرنا .
لا ترادف مع ملاحظة الفوارق :
قد عرفت الخمسين اسماً للماء كانت تُطلق عليه باعتبار تناوب حالاته ، والتي كانت في الحقيقة أوصافاً له باعتبار تلك الحالات عارضة عروض الصفة للموصوف ، وهكذا سائر المترادفات ، فإنّ غالبيتها أوصاف ونعوت وليست في الحقيقة أسماء .
فإنّ الأسد ـ وهو الاسم الحقيقي له ـ إنّما يقال له : الضيغم ؛ باعتبار أنّه يملأ فمه عند العضّ على فريسته ، مأخوذ من ضغم إذا عضّ من غير نهش وملأ فمه ممّا أهوى إليه ، قال ابن منظور : الضغم العضّ الشديد ، ومنه سُمّي الأسد ضيغماً .
والضرغام هو البطل الفحل المقدام في معركة القتال ، وفي حديث قسّ : والأسد الضرغام ، هو الضاري الشديد المقدام من الأسود .
والغضنفر : الجافي الغليظ المتغضّن ، وأُذن غضنفرة : غليظة كثيرة الشعر ، قال أبو عبيدة : أُذن غضنفرة وهي التي غلُظت وكثر لحمها ، ومنه سمّي الأسد غضنفراً ؛ لغلظة خلقه وتغضّنه ، والتغضّن هو تثنّي وجنات الوجه وتشنّجه ، ومنه تغضّن الشعر وهو تجعّده ، ورجل ذو غضون إذا كان في جبهته تكسّر وتشنّج .
والهزبر : الصلب الشديد ، يقال : ناقة هزبرة أي صلبة ، ورجل هزبر أي حديد وثّاب ، ومن ذلك سُمّي الأسد هزبراً .
والعبوس : الذين قطّب ما بين عينيه ، ويوم عبوس : شديد ، والعنبسي من أسماء الأسد أُخذ من العبوس وهو قُطوب الوجه .
والليث : الشدة والقوة ، ورجل مليث : شديد العارضة وقيل شديد قويّ ، وفي الحديث : هو أليث أصحابه أي أشدّهم وأجلدهم . وبه سُمّي الأسد ليثاً .
______________________
1- اليافوخ : عظم مقدم الرأس ، والمثال كناية عن الشموخ بالرأس تكبّراً .
2- القَرم : العظيم الشأن ، يقال : خلد بالمكان أي أقام به ، وخلد بالأرض : لصق بها ، كناية عن المسكنة والخمول .
3- دلائل الإعجاز : ص28 .
4- سفينة البحار : ج1 ص 654 مادة ( سمر ) .
5- الكشّاف : ج 1 ص 6 .
6- معجم المقاييس : ج 4 ص 199 ـ 203 .
7-معجم المقاييس : ج 5 ص 79 .
8- نهاية ابن الأثير : ج 4 ص 31 .
9- موطّأ مالك بشرح التنوير : ج 2 ص 96 .
10- الوسائل : ج 15 ص 425 رقم 7 .
11- المفردات : ص 402 .

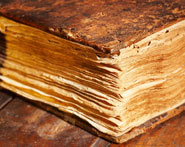
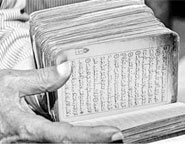
|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تشارك في انطلاق فعاليات أسبوع الولاية المُقام في قضاء الهاشمية
|
|
|