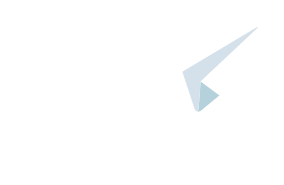النبي الأعظم محمد بن عبد الله


أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)

آبائه

زوجاته واولاده

الولادة والنشأة

حاله قبل البعثة

حاله بعد البعثة

حاله بعد الهجرة

شهادة النبي وآخر الأيام

التراث النبوي الشريف

معجزاته

قضايا عامة


الإمام علي بن أبي طالب

الولادة والنشأة

مناقب أمير المؤمنين (عليه السّلام)


حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله

حياته في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)

حياته في عهد الخلفاء الثلاثة

بيعته و ماجرى في حكمه

أولاد الامام علي (عليه السلام) و زوجاته

شهادة أمير المؤمنين والأيام الأخيرة

التراث العلوي الشريف

قضايا عامة


السيدة فاطمة الزهراء

الولادة والنشأة

مناقبها

شهادتها والأيام الأخيرة

التراث الفاطمي الشريف

قضايا عامة


الإمام الحسن بن علي المجتبى

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الحسن (عليه السّلام)

التراث الحسني الشريف

صلح الامام الحسن (عليه السّلام)

أولاد الامام الحسن (عليه السلام) و زوجاته

شهادة الإمام الحسن والأيام الأخيرة

قضايا عامة


الإمام الحسين بن علي الشهيد

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الحسين (عليه السّلام)

الأحداث ما قبل عاشوراء

استشهاد الإمام الحسين (عليه السّلام) ويوم عاشوراء

الأحداث ما بعد عاشوراء

التراث الحسينيّ الشريف

قضايا عامة


الإمام علي بن الحسين السجّاد

الولادة والنشأة

مناقب الإمام السجّاد (عليه السّلام)

شهادة الإمام السجّاد (عليه السّلام)

التراث السجّاديّ الشريف

قضايا عامة


الإمام محمد بن علي الباقر

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الباقر (عليه السلام)

شهادة الامام الباقر (عليه السلام)

التراث الباقريّ الشريف

قضايا عامة


الإمام جعفر بن محمد الصادق

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الصادق (عليه السلام)

شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)

التراث الصادقيّ الشريف

قضايا عامة


الإمام موسى بن جعفر الكاظم

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الكاظم (عليه السلام)

شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)

التراث الكاظميّ الشريف

قضايا عامة


الإمام علي بن موسى الرّضا

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الرضا (عليه السّلام)

موقفه السياسي وولاية العهد

شهادة الإمام الرضا والأيام الأخيرة

التراث الرضوي الشريف

قضايا عامة


الإمام محمد بن علي الجواد

الولادة والنشأة

مناقب الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)

شهادة الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)

التراث الجواديّ الشريف

قضايا عامة


الإمام علي بن محمد الهادي

الولادة والنشأة

مناقب الإمام علي الهادي (عليه السّلام)

شهادة الإمام علي الهادي (عليه السّلام)

التراث الهاديّ الشريف

قضايا عامة


الإمام الحسن بن علي العسكري

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)

شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)

التراث العسكري الشريف

قضايا عامة


الإمام محمد بن الحسن المهدي

الولادة والنشأة

خصائصه ومناقبه


الغيبة الصغرى

السفراء الاربعة


الغيبة الكبرى

علامات الظهور

تكاليف المؤمنين في الغيبة الكبرى

مشاهدة الإمام المهدي (ع)

الدولة المهدوية

قضايا عامة
الشروط الإلهيّة لظهور إمام الزمان "عج"
المؤلف:
حسن ملّايي
المصدر:
شروط الظهور المبارك
الجزء والصفحة:
ص39-53
2025-12-01
442
1. الإرادة الإلهيّة
من التعاليم القرآنيّة الأصيلة أنّ كلّ الحوادث التي تقع في هذا العالم إنّما تقع بإذن الله وإرادته، وما لم يشأ تعالى لن يكون من حادث في هذا الوجود، وهذا ما يسمّى بالتوحيد الأفعاليّ. في الواقع، إنّ إرادة الإنسان غير مستقلّة عن إرادة الله، ولا هي غالبة على إرادته، وإنّما يتحقّق مراد الإنسان إذا ما تعلّقت به إرادة الله [تعالى]، يقول تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (التكوير: 29).
لمّا كان الله هو ربّ العالمين، وعمّ كلّ شيء سلطانه، كانت إرادة الإنسان مقيّدة بإرادته [تعالى]؛ كما عليه الحال في سيّارات تعليم القيادة بحيث يوجد فيها آليّتان لضخّ الوقود وآليّتان للمكابح، إحداهما يتحكّم بها المتدرّب وأخرى المدرّب. في هذه السيّارة يمكن للمتدرّب أن يستعمل آليّتي ضخّ الوقود والمكابح الخاصّة به، لكن بشرط أن يريد المدرّب ذلك أيضاً، أو كما هو الحال في الصكّ المصرفيّ الذي يحتاج إلى توقيعين؛ بحيث يمكن لكلّ من صاحبي دفتر الصكوك أن يقوم بتوقيع الصكّ، لكنّ الأثر وصرف الصكّ إنّما يحصل إذا قام الآخر بالتوقيع عليه أيضاً.
والحال عينه في تحقّق ظهور وليّ العصر (عجل الله تعالى فرجه)، فحينما نتحدّث عن الظهور، لا نعني بذلك أنّ لنا إرادة مستقلّة بحيث لو تحقّقت الشروط كان لا بدّ لله تعالى من أن يأذن بالظهور، بل المراد أنّ الله تعالى قضى أن يكون تعلّق إرادة الإنسان بتحقيق شروط الظهور مؤثّراً في حصوله، بحيث تكون إرادة الإنسان في طول إرادة الله تعالى، التي من دونها ومن دون إذنه تعالى ومشيئته لا يتحقّق الظهور. وثمّة بين الآيات المهدويّة التي ذكرت الشروط الإلهيّة لظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) موارد تشير إلى هذه المسألة، منها الآية التاسعة من سورة «الصفّ» المباركة بحيث يقول تعالى:
﴿هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ﴾.
وجاء في الروايات المتواترة أنّ ظهور الإسلام سيكون في زمان ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، يقول الإمام عليّ (عليه السلام): «والذي نفسي بيده، لا تبقى قرية ولا مدينة إلّا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، صباحاً ومساءً» .
إنّ التاريخ الإسلاميّ يثبت تحقّق هذه الآية، إذ على الرغم من أنّ الأعداء لم يتوانوا عن ممارسة الاستهزاء والأذى والتعذيب، والمحاصرة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفرض الحروب، والتآمر الداخليّ من قبل المنافقين، وبثّ الفرقة بين المسلمين، وشنّ الحروب الصليبيّة، وترويج الفحشاء والمنكر، والاستعمار العسكريّ والسياسيّ؛ كان الإسلام في توسّع يوماً بعد يوم.
تشير الآية السابقة إلى أنّ الإرادة الإلهيّة هي الأصل، فقد صرّحت من خلال عبارة «هو الذي» أنّ أساس تحقّق حاكميّة دين الحقّ متوقّف على إرادة الحقّ تعالى.
وجود قائد عالميّ معصوم
من الشروط الأخرى لظهور الحقّ على العالم وحاكميّته، والتي تتحقّق بيد الله؛ وجود قائد قادر على إدارة العالم على أساس الأوامر الإلهيّة ودين الحقّ. يجدر بالذكر أنّه لا بدّ للناس من قائد، صالح كان أم طالح، وإلّا حلّ الهرج والمرج في المجتمع. يقول الإمام عليّ (عليه السلام): «لا بدّ للناس من أمير برّ كان أو فاجر» . لذلك، ينبغي أن يكون ثمّة حكم وسلطة لإنفاذ الأوامر الإلهيّة وحفظ الأحكام، والسلطة والحكم يحتاجان إلى إمام وقائد لائق.
إمّا أن يكون الدين والمذهب منسجمين مع الحاجات الداخليّة والمستجّدات الخارجيّة، متحرّكين ومتكيّفين مع متطلبات الزمن، وإمّا أن يشتملا على قوانين مرحليّة جامدة وجافّة يطويها مرور الزمن، فإن كان للمذهب إمام ذو صفات خاصّة، كان من النوع الأوّل، وإلّا كان من الثاني. من هنا، يقول الإمام الرضا (عليه السلام):
«إنّ الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ المؤمنين» .
إنّ الإمامة هي فقط التي يمكنها توفير الاحتياجات الفرديّة والاجتماعيّة والماديّة والمعنويّة لقافلة البشريّة، تماماً كما تحتاج السباحة في حوض السباحة إلى مدرّب ومنجٍ، وكما يحتاج قطع البحار إلى سفينة وربّان.
في الخلاصة: كلّ حركة ماديّة أو معنويّة تحتاج إلى أمور عدّة: الجادّة والطريق، والوسيلة، والهدف والمقصد، وأخيراً القائد والدليل، والدليل هو الأهمّ من بينها، لأنّه بغياب الدليل نضلّ عن الطريق ونحيد عن الهدف، وتمضي الوسيلة بنا على غير جهة. إنّ الإمام هو دليل المجتمع في حركته نحو الله [تعالى]. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ للإمام والقائد: أوّلاً، من أن يكون عالماً وعارفاً بجميع القوانين الإلهيّة والمقاصد والسنن الإلهيّة. ثانياً، أن يكون عادلاً لا يميل به الهوى ولا يخضع للميول النفسيّة، كي يتمكّن من إنفاذ الأحكام الإلهيّة.
والسؤال الذي يُطرح هنا هو: كيف يمكن معرفة مثل هذا الشخص وتنصيبه حاكماً على الدولة؟
إنّ الطريق الأفضل لتعيين القائد والمسؤول في مجتمعات اليوم هو الانتخابات، ولا شكّ في أنّ الانتخابات تشكّل حلّاً، لكنّها لا تمثّل دائماً طريق الحقّ. ليس ثمّة من حجّة ودليل علميّ أو عقليّ يثبت أهليّة الشخص المنتخب وصلاحيّته وحقّانيّته، على رغم أنّه من الناحية العمليّة يمثّل رأي الأكثريّة وأفضل الحلول؛ يضاف إلى ذلك أنّ الأخذ برأي الأكثريّة إنّما يكون في المسائل الاجتماعيّة. أمّا في المسائل العقديّة، فما من قيمة لرأي الأكثريّة، وإلّا لكان على الأنبياء (عليهم السلام)أن يتخلّوا عن دعوتهم ويتّبعوا رأي الأكثريّة الذين كانوا من الكفّار أو المشركين. جاء في سورة الأنعام:
﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ (الأنعام: 115).
إذاً، ليس لرأي الناس وانتخابهم دور في مسألة الإمامة الخطيرة جدّاً والحسّاسة، والتي هي من الأمور الاعتقاديّة، وتعيين الإمام إنّما هو بيد الله [تعالى]. طبعاً، تشكّل بيعة الناس للإمام الأرضيّة لإعمال حاكميّته، لكنّه لا يكون إماماً برأي الناس، ولا تنتهي إمامته بإعراضهم عنه.
حقيقة كيف يمكن للإنسان المحدود الذي لا يطّلع على الغيب، ولا علم له بمستقبل الناس وباطنهم أن يكون له رأي صائب مئة في المئة حول إنسان ما؟!
ألا تتغيّر دوافع الإنسان وحالاته وسلوكه تبعاً لاختلاف الأوضاع والظروف؟ فكيف يمكن له من خلال بعض المعلومات السطحيّة والظاهريّة أن يحدّد مصير قيادة الأمّة من خلال الانتخابات؟ نعم، يمكن أن تشكّل الانتخابات حلّاً، لكنّها ليست الطريقة الحقّة دائماً.
لذا، لمّا بات معلوماً أنّ مسألة الإمامة من أهمّ المسائل العقديّة وسبب لهداية ورشد المجتمع، وأنّه لا غنىً للمجتمع عن القائد لأنّ سقوط المجتمع وتقدّمه مرتبطان بقيادة هذا المجتمع؛ يصبح من اللازم أن يكون تعيين الإمام حصراً بيد الله [تعالى]، لأنّه لا بدّ من أن تتوفّر في الإمام شروط وخصائص لا يمكن أن يطّلع عليها إلّا الله تعالى، ومن جملتها:
1- معرفة الإمام بجميع القوانين الحاكمة على الإنسان والكون.
2- معرفة الإمام بالنتيجة الحتميّة للطريق الذي يختاره ويمضي به.
3- لا ينبغي للإمام في قيادته للمجتمع أن يلحظ منافعه الشخصيّة، أو أن تحرّكه العوامل الباطنيّة أو الخارجيّة.
4- لا بدّ للإمام من أن يتحلّى بالحدّ الأعلى من أسمى الصفات الإنسانيّة الحسنة، ونحن بغنى عن القول إنّ هذه الشروط لا نجدها بين الأشخاص العاديّين، كما أنّ الناس لا علم لهم بتوفّر هذه الشروط فيهم من عدمها.
من هنا، كانت الطريقة الحقّة في تعيين الإمام هي الطريقة نفسها في تعيين النبيّ، لأنّنا نرى أنّ الإمامة كالنبوّة، والإمام كالنبيّ والدليل على الحاجة للإمام هو نفسه الدليل على الحاجة للنبيّ، وعمل الإمام كعمل الأنبياء، أي هداية الناس والعمل على تكاملهم وإرشادهم إلى طريق سعادتهم. فإذا سلّمنا بأنّ الإمامة بالتنصيب لا بالانتخاب، لم يكن للناس اختيار في مقابل التنصيب الإلهيّ.
ومن جهة ثانية، لمّا كان سائر الناس في كلّ زمان يحتاجون إلى مثل هذا الشخص، كان ينبغي وجود شخص فيه هذه الخصوصيّات في كلّ زمان تتحقّق فيه الشروط والمقدّمات العائدة إلى الناس، وهذا الشخص في زماننا هو الإمام الحجّة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه)، والذي ينتظر بدوره الفرج وتشكيل حكومة العدل العالميّة.
بناءً على الأدلّة القرآنيّة والروائيّة والتاريخيّة، جاء إلى هذه الدنيا أحد عشر إماماً استشهدوا جميعاً، لكنّ الله تعالى شاء أن يغيّب الإمام الثاني عشر بعد ولادته عن الأنظار حتّى تقتضي المصلحة ويأتي أمر الله تعالى فيُظهره ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
2. امتلاك برنامج وقوانين جامعة للعالم
الشرط الآخر من شروط تشكيل حكومة العدل العالميّ، والذي يشكّل الأرضيّة لرشد الإنسان وتعاليه؛ هو وجود برنامج وقوانين جامعة وكاملة تضمن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو ما عبّرت عنه الآيات القرآنيّة المرتبطة بحكومة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) بـ ﴿وَدِينِ ٱلۡحَقِّ﴾ (التوبة: 33).
فمن هو الشخص أو الأشخاص الذين يمكنههم كتابة هذا البرنامج الجامع؟ وهل يمكن ذلك عن طريق العلم والعقل فقط؟
فيما يأتي الأسباب التي تحول دون الاكتفاء بالعلم والعقل البشريّين، ودون استغنائنا عن الرسل وتعاليم الوحي التي أتوا بها:
أ. محدوديّة علم الإنسان
نحن نشهد كلّ يوم زيادة في عدد الكليّات التخصّصيّة، وظهور اختراعات واكتشافات جديدة، إلّا أنّ الإنسان إن ترك علمه وعقله يصيّرانه في الحقيقة كمن يمضي في أرض وعرة حيران مضطرباً، ففهم الناس وعلمهم وفكرهم متفاوت؛ بل إنّ أكثر النزاعات والاختلافات الحادّة والخطيرة يكون مصدرها العقلاء والعلماء! العلم والعقل منشأ كلّ هذه النزاعات، وكيف للنزاعات والاختلافات أن تنتهي؟ فما يراه زيد خيراً قد لا يراه عمرو كذلك.
ب. الموانع العديدة للمعرفة
من المسائل التي تُبحث في موضوع المعرفة؛ موانع المعرفة، إنّما يعرف الإنسان الحقّ ما لم يحل مانع دون ذلك. إنّ طغيان الغرائز في الإنسان قد يفقده القدرة على معرفة الواقع على الرغم من امتلاكه العقل والفكر والقدرة على التعلّم.
مع الأسف، إنّ الألوان المتنوّعة للنظّارات التي يضعونها أمام أعيننا تسلبنا القدرة على التشخيص الصحيح! كم من باطل نراه حقّاً؟ وكم من حقّ نراه باطلاً؟ كم من عدوّ لنا نحبّه؟ وكم من صديق نعدّه في الأعداء؟ لمّا كان الإنسان محكوماً للغرائز، ولا يرى الحقائق على ما هي عليه دائماً، ويكون عمله أحياناً على خلاف ما تقتضيه المعرفة الصحيحة؛ لم يكن لديه حقّ التقنين. يقول القرآن الكريم:﴿إِنِ الحُكمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (الأنعام: 57).
ج. عدم إدراك المسائل في أوانها
أحياناً، يساهم مرور الزمن وتقدّم العلم في إدراك الإنسان للواقع، فعلى عاتق من نضع مسؤوليّة مئات السنين من التأخير؟ ثمّة العشرات من التعاليم الإسلاميّة التي كشف أسرارها مرور الزمن وتقدّم العلم، في حين عمل بها أتباع الأنبياء منذ البداية بينما أدركها العلماء الذين يتّكلون على العلم والتجربة بعد قرون من الزمن.
د. إدراك الأمور المعنويّة
إنّ سير الإنسان وحده واختياره الطريق الصحيح اعتماداً على العقل والعلم والتشاور إنّما هو ممكن في المسائل المحسوسة والماديّة، أمّا في معرفة السعادة الأبديّة والتكامل المعنويّ وتزكية الروح فيده قاصرة، وليس له من سبيل إلى ذلك سوى مدرسة الوحي وطريق الأنبياء، وهذه نماذج من القوانين التي يمكن أن يسنّها الإنسان لنفسه:
- قوانين الاستبداد الفرديّ التي تصدر وفق إرادة شخص مستبدّ، والتي يشوبها الضعف، والنقص، والفرض، والقلق الشديد، وقصر النظر و....
- قوانين الاستبداد الطبقيّ التي تضعها طبقة بعينها، ولا يخفى أنّ هذا النحو من القوانين إنّما يؤمّن مصلحة طبقة معيّنة وفئة خاصّة من الناس، وتكون خاضعة لتأثير تلك الطبقة.
- القوانين الشعبيّة التي تقوم على آراء الناس؛ سواء كانت هذه القوانين قرينة المصلحة والصحّة أم لا. إنّ العالم اليوم يعدّ هذا النوع الثالث أرقى القوانين، في حين أنّه ليس بين القوانين البشريّة ما هو جامع مانع يلحظ جميع الأبعاد الفرديّة والاجتماعيّة في حياة الإنسان. فكيف لواضعي القوانين اعتماداً على علمهم وعقلهم أن يقفوا على جميع أبعاد الإنسان ويعلموا جميع احتياجاته؟ هل كانوا واقعاً يبحثون في تقنينهم عن خير بني البشر؟ كيف يمكن لنا أن نركن إلى عدم وقوعهم في الخطأ؟ لعلّهم لحظوا مصلحة فرد أو جماعة خاصّة، فلعلّهم تبعاً لمحيطهم ونظامهم العائليّ أو القبليّ أو الاقتصاديّ حادوا عن المسار الصحيح، وأثّرت الضغوطات والمحيط في القوانين التي يصدرونها، من أين يُعلم أنّهم لم يخضعوا لتأثير الغرائز الشيطانيّة والطاغوتيّة؟ كيف لنا أن نطمئنّ إلى أنّ هذه القوانين لن تعود عاجلاً أم آجلاً بالضرر على الفرد أو المجتمع؟
خصائص المقنّن
بلحاظ ما تقدّم، نخلص إلى أنّ المشرّع لحياة البشر لا بدّ من أن تتوفّر فيه الشروط والخصائص الآتية:
1. العلم والإحاطة التامّة بجميع الاحتياجات الظاهريّة والباطنيّة للإنسان.
2. الشفقة والرحمة البالغة للإنسان.
3. العدالة التامّة وعدم ترجيح الهوى على المصلحة والواقع.
ومن الواضح أنّه ما من مشرّع تنطبق عليه هذه الصفات سوى الله تعالى، الذي يبلّغ تعاليمه وهديه وشرائعه للإنسان عن طريق الأنبياء الذين يقومون بتلقّي الوحي الإلهيّ وإبلاغه للناس.
ومن بين الأنبياء كان النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله) خاتم الأنبياء، وكان كتابه أي القرآن؛ الوصفة الإلهيّة الأخيرة والخالدة للبشريّة، والتي تشكّل المعيار والأساس الذي ستقوم عليه الحكومة المهدويّة في عصر الظهور.
جاء في الخطبة 138 من نهج البلاغة، التي أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) فيها إلى حكومة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) أنّه (عليه السلام): «يعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي».
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تعليم القرآن لعموم الناس في عصر ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) يحظى بأهمّيّة بالغة، يقول أمير المؤمنين(عليه السلام):
«إذا قام قائم آل محمّد ضرب فساطيط لمن يعلِّم الناس القرآن على ما أنزل الله جلّ جلاله» .
الإمام الموعود والقرآن لا يفترقان أبداً، ففي خطبة يوم الغدير المعروفة، وبعد أن بيّن رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس أنّ الوصيّ من بعده أمير المؤمنين وأبناؤه المعصومون (عليهم السلام)؛ ذكر أنّهم (عليهم السلام)–
ومن جملتهم الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)– والقرآن معاً لا يفترقان، فقال (صلى الله عليه وآله):
«عليّ أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي، ثمّ ابني الحسن، ثمّ ابني الحسين، ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا عليّ الحوض» .
وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «إِنَّ اَلْعِلْمَ بِكِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيَنْبُتُ فِي قَلْبِ مَهْدِيِّنَا كَمَا يَنْبُتُ اَلزَّرْعُ فِي أَحْسَنِ نَبَاتِهِ» .
إنّ السبب في هذا الاهتمام البالغ بالقرآن الكريم يعود إلى أنّ:
- القرآن كتاب هداية: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2).
- القرآن شفاء ومداو للأسقام: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنَ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحمَة لِّلمُؤمِنِينَ﴾ (الإسراء: 82).
- القرآن كتاب بشارة وإنذار: ﴿لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشرَى لِلمُحسِنِينَ﴾ (الأحقاف: 12).
- القرآن كتاب المحبّة للمحسنين: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ المُحسِنِينَ﴾ (البقرة: 195).
- القرآن كتاب الدعوة إلى المحاسن: ﴿وَبِالوَالِدَينِ إِحسَانا.. وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسنا﴾ (البقرة: 83).
- القرآن كتاب التعقّل والتفكّر: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (يوسف: 2).
- القرآن كتاب الدعوة إلى العمل: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ (سورة الصفّ: 2).
- القرآن كتاب الجهاد والقتال: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾ (الصف:4).
لقد بيّن هذا الكتاب علاقة الإنسان بالله (العبادات)، وعلاقة الإنسان بالناس (التعليم، والتعلّم، والعفو، والإنفاق، والإيثار، والتعاون، و...)، وعلاقة الإنسان بالطبيعة (التسخير والإعمار، والإحياء، والابتعاد عن الإسراف والتبذير في ما ننال منها).
وبيّن علاقة الإنسان بالمخالفين والمنافقين وأمر بدعوتهم إلى الحقّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ودعا إلى مواجهة المفسدين الذين هم كالشوك في الطريق يحولون بين عموم الناس واتّباع الحقّ، وإلى مواجهة الطغاة في المجتمع.
- القرآن كتاب سياسة وحكم: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾ (النساء: 105). إنّ لازم كلام من يقول بفصل الدين عن السياسة حذف بعض آيات القرآن!
- القرآن ميزان وملاك ومعيار ومقياس، لقد دعانا [أهل البيت (عليهم السلام)] لاتّخاذ القرآن معياراً، وأن نعرض الروايات التي نقرؤها أو نسمعها على القرآن فنأخذ ما يوافقه ونضرب ما سواه بعرض الحائط: «فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه» .
ليس الأحاديث فقط، بل لا بدّ من عرض سائر أنواع القول والكتابة، يجب عرض كلّ القيم على القرآن.
إنّ القوانين الجامعة التي تشكّل أحد شروط الظهور وتشكيل الحكومة العالميّة، والتي ينبغي أن يجعلها الله ربّ العالمين للبشريّة، هي حاضرة وموجودة.
3. الإمداد الإلهيّ والغيبيّ
إحدى المقدّمات والشروط الأخرى لتحقّق الظهور وانتصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، نزول العون الإلهيّ والمدد الغيبيّ، فمن دون عون الله وعنايته الخاصّة، لا يمكن تحقيق النصر في هذا الميدان الواسع الذي يملك فيه الأعداء كلّ أنواع المكر والتضليل، وهذا الحشد الكبير للقوى من أجل مواجهة الإمام (عجل الله تعالى فرجه) وإلحاق الهزيمة به. لذا، ذكرت العديد من الروايات المهدويّة التي تناولت أحداث الظهور مسألة نزول المدد الإلهيّ بشكل صريح وواضح.
روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) قوله: «الملائكة الذين نصروا محمّداً (صلى الله عليه وآله) في يوم بدر، هم في الأرض لم يصعدوا إلى السماء بعد، ولن يصعدوا حتّى ينصروا صاحب هذا الأمر، وهم خمسة آلاف» .
وقد بيّنت الأحاديث الأخرى أنّ هذا المدد ينزل بصور مختلفة، كالإلهام الإلهيّ لقلوب المؤمنين، وبثّ الرعب والخوف في قلوب الأعداء، وسكينة القلب في أوج المصيبة والمصاعب و.... ذلك ما جعل إحدى خصائص قائم آل محمّد (عجل الله تعالى فرجه) أنّه «منصور بالرعب». يقول الإمام الباقر (عليه السلام):
«القائم منّا منصور بالرعب، مؤيّد بالنصر، تطوى له الأرض، وتَظهر له الكنوز» .
طبعاً، إنّ نزول هذا المدد الغيبيّ لا يكون على خلاف الحكمة وكيفما اتّفق، بل هو متوقّف على تحقّق شروط ومقدّمات ذكرنا أهمّها آنفاً.
 الاكثر قراءة في علامات الظهور
الاكثر قراءة في علامات الظهور
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)