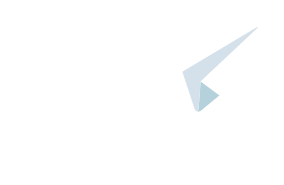الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
التعلم مدى الحياة
المؤلف:
أ. د. عبد الكريم بكَار
المصدر:
حول التربية والتعليم
الجزء والصفحة:
ص 137 ــ 144
2025-07-30
32
ليس هناك أمة من الأمم نظرت إلى العلم نظرة احترام وتقدير، كما فعلت أمة الإسلام في أيام حضارتها الزاهية؛ فهو عندها من أعظم القربات إلى الله - تعالى - ويصل التعلم في أحيان كثيرة إلى درجة الواجب الشرعي وهو في كل حين واجب حضاري. وبما أن التعبد لله - تعالى - لا يعرف أجلاً إلا بانتهاء العمر، فإن التعلم كذلك، حيث لا يعرف المؤمن الحق وقتاً يبلغ فيه درجة التشبع المعرفي؛ فالمرء يظل عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. وفي حديث: (اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً، ولا تكن الخامسة فتهلك) (1).
وسئل عبد الله بن المبارك - رحمه الله - إلى متى تكتب الحديث؟
فأجاب: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد.
وقيل لأحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟
فقال للسائل: حتى يموت (2)!
وقد جدّت في عصرنا عوامل وأسباب كثيرة، جعلت الاستمرار في التعلم وتثقيف الذات بكل وسيلة - أمراً لا خيار فيه لدى الأشخاص وكذلك الأمم التي ترفض أن تعيش على هامش الحياة. ولعلنا نذكر من تلك الأسباب ما يلي:
1- إننا بحاجة إلى التعلم المستمر والمعتمد على الجهود الشخصية لأن أمة الإسلام، تعاني من ثلاثة أنواع من الأمية: أمية القراءة والكتابة وأمية الجهل بالمصير، وأمية المثقفين.
وعلى صعيد الأول فإن متوسط الأمية في العالم الإسلامي يزيد على 45%، وتذكر بعض الإحصاءات أن الأميين من العرب (من بلغ سن 15 سنة فأكثر) بلغوا 55 مليوناً، بنسبة قدرها 59,9% أي ما يوازي 8/6من مجموع الأميين في العالم. والعدد المطلق للأميين - مع ما يبذل من جهد لمحو الأمية - في تزايد مستمر (3). ونعتقد أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في كثير من البلدان الإسلامية، ستدفع أعداداً كبيرة من الآباء إلى سحب أبنائهم من المدارس في وقت مبكر من أجل مساعدتهم على إعالة أسرهم؛ ولم لا، وهم يرون البطالة تجتاح قطاع خريجي الجامعات والثانويات أكثر من أي قطاع آخر؟!
أما على صعيد الأمية بمعرفة المصير والرسالة السامية في هذه الحياة؛ فإن مما هو واضح أن أكثر المسلمين يرزح تحت وطأة متطلبات الحياة اليومية، وكثير منهم بعيد عن الالتزام بالأوامر والنواهي والاهتمام بالمصير الشخصي في الآخرة؛ وأقل من القليل أولئك الذين يحملون هموم هذه الأمة، ويعدون تبليغ رسالة الإسلام وإصلاح أحوال البلاد والعباد أحد الشؤون التي تعنيهم وتشغلهم!
وهذا النوع من الأمية هو الأشد خطراً، والأسوأ عاقبة، حيث يسحب ذيوله على كل مناشط الحياة، ويجعلها إما تافهة، وإما غير ذات معنى!
ولكن لا ننسى أن لأهمية القراءة والكتابة أثراً كبيراً في وجود أمية المصير، حيث إن الأمية ليست مشكلة ثقافية فحسب، وإنما هي مشكلة دينية أيضاً، حيث إن فهم الإسلام بما هو بنية حضارية راقية، لا يتأتى على النحو المطلوب لمن لم يؤت حظاً من المعرفة، حيث يصبح التدين شكلياً وهامشياً، وحيث يتم إدراك مرامي الإسلام وأهدافه بطريقة سوقية مبتذلة!
النوع الثالث من أنواع الأمية، هو أمية المثقفين؛ حيث إن التقدم في أي علم يحتاج إلى التخصص والاهتمام المركّز على كل ما هو فرعي فيه، وهذا لا بد - بطبيعة الحال - من أن يستهلك جهوداً وأوقاتاً كثيرة، وليس هناك خيار آخر. والمشكل أن أوضاع البحث العلمي في معظم البلدان الإسلامية بائسة، وتدعو إلى الإحباط مع أن هناك عشرات الجامعات والمراكز العلمية، لكن النتائج متواضعة جداً!!
ومن وجه آخر فإن أكثر المثقفين المسلمين مشغولون عن الاهتمام بالشأن الإسلامي العام والشأن المحلي أيضاً فترى كثيرين منهم أشبه بالعامة عند بحث القضايا الكبرى التي تتحكم في مصير الأمة؛ حيث إنهم لم يقرؤوا أي شيء عنها. ولدى كثيرين منهم عجز واضح عن الوصول إلى وجهات نظر إحاطية، أو الوصول إلى محكات نهائية في معالجة المسائل الخطيرة المطروحة على الساحة الإسلامية. وإن غفلة هذا الفريق من المثقفين لم تحرمه من الإسهام في حل مشكلات الأمة فحسب، وإنما جعلته مؤهلاً على نحو مدهش لأن يكون أداة تكريس للأوضاع السيئة الراهنة.
وهكذا فالعلم الذي يساعد على إشاعة الحياة الكريمة، قد يستخدم أداة في تحطيمها، ودفعها نحو الخلف!
إن تجربة الأمم في هذا السياق، تدل على أن حاجة الأمم ليست إلى صفوة مستنيرة، وإنما إلى استنارة عامة تمكن المجتمع من إدراك أهدافه وملاحقة مصالحه، والمجادلة عن حقوقه ... والشعوب المتخلفة في أصقاع الأرض، لا تشكو ضعفاً ثقافياً في قمة الهرم، وإنما تشكو وهناً وجهلا وتشتتاً في قاعدته العريضة.
وعلى هذا فإن مهمة الصفوة ومسؤوليتها هي النهوض بالمستوى العام للناس، وما لم تقم بهذه المسؤولية، فإن ما يرجى من ورائها ضئيل جداً!
إن التعلم الذاتي المستمر الذي لا يعرف منتهى للإشباع، هو الذي سيقلل من الاعتماد على الصفوة، وهو الموصل إلى الاستنارة المستهدفة، والقضاء على الفقر الثقافي بكل صوره وأشكاله.
2- عصرنا هذا عصر التغيرات الحادة والمشكلات الكبرى المحيرة وللعلم - بمعناه الأشمل - الأثر الأكبر في حدوث هذه التغيرات، ونقل العالم من حال إلى حال أخرى.
ومن المألوف أنه كلما حدثت تحديات كبيرة، فإن العلم، يطلق الاستجابات المناسبة لمواجهتها، والتغلب عليها.
ومن هنا كان للعلم هذا الدور الخطير في الحياة المعاصرة (4). والتعلم المستمر هو الأداة التي تمكن الإنسان من مسايرة التغيرات، وتجعله قادراً على تقبلها والاستفادة منها.
وعن طريق التربية المستمرة، يمكن التخفيف من حدة القلق لدى الناس الشباب خاصة - الذي يولده الخوف من المستقبل، وحاجة الحياة المعاصرة إلى التنقل بين المهن المختلفة، والهجرة إلى بلدان ذات ثقافة مغايرة (5).
ويضاف إلى هذا أن الانفتاح العالمي الذي سيأخذ أبعاداً جديدة بعد سنوات قليلة - سيوجد نوعاً من المنافسة العالمية على كل الصعد؛ فاتفاقية (الجات) لن تسمح بتدفق السلع فحسب، وإنما المناهج والأفكار والمنتجات التربوية أيضاً. وهذا يعني أن العالم قادم على سباق محموم، الفوز فيه للنوعية والتميز والتفوق وإن أنصاف المهرة، وأنصاف المتعلمين، وخريجي الجامعات الذين هجروا الكتاب ... إن كل أولئك لن يجدوا لهم موطئ قدم في الساحة المزدحمة!
إن التعلم مدى الحياة هو الذي سيساعد كل واحد منا على أن يعيد تأهيل نفسه، وتحسين مستواه ليرتفع إلى المستوى المطلوب لاستيعاب المستجدات السريعة، بل قيادتها والتحكم فيها. إن عواقب الاستجابة للتحديات هي مزيد من القوة على حين أن التجاهل، ومحاولة الانعزال، قد يؤدي إلى التحلل الذاتي والخروج من حركة التاريخ!
3- التدفق الهائل للمعلومات، وتراكم منتجات البحث العلمي وتسارع التطبيقات التقنية، كل أولئك يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، والنتيجة العامة لكل ذلك هي تقادم ما بحوزتنا من معارف ومعلومات. وليس تقادم المعرفة محصوراً فيما يظهر من قصور وخطأ، وإنما يتعدى ذلك إلى قراءتها قراءة جديدة، أي إنتاجها مرة أخرى على نحو يبعدها عن مضامينها الأولى قليلاً أو كثيراً. كما أن كثافة الإنتاج المعرفي أوجدت نوعاً من التناسخ بين الجديد والقديم؛ مما أفقد كثيراً من المعلومات وظيفتها في الحياة، وصرف الناس - بالتالي عن الاهتمام بها.
إن مما هو جدير بالملاحظة أن تقادم المعلومات لدى أي شخص يؤدي إلى عدم قدرته على تطوير المهارات الجديدة المطلوبة منه، كما أنه يحول بينه وبين تطوير تلك المعلومات؛ حيث لا يمكن لمن لم يطلع على الجديد أن يعثر على الآفاق المناسبة لتطوير القديم الذي يملكه فيتحول المرء بالتدريج من رجل صاحب اختصاص إلى رجل يملك معارف عامة في الحقل الذي يعده ميدانه الرئيس!.
ارتباط مستوى الثقافة بالثورة العلمية المتصاعدة طرح مشكلة معرفية جديدة، هي أن الأمر لم يعد أن نتساءل عما تجب معرفته، بل عما لا يجوز الجهل به والذي بدونه لا يستحق المثقف هذا النعت (6).
هذا كله يعني أنه صار من المستحيل على المدارس والجامعات وجميع المؤسسات التربوية الأخرى أن تقدم على مقاعد الدراسة للمعلومات الكافية والملائمة للحاجات الثقافية والمهنية التي تتطلبها الحياة المعاصرة.
4- إن التعلم المستمر هو الحل الناجع لعلاج مشكلة (الفراغ) التي يعاني منها كثير من الناس من الواضح أن الإحساس بالوقت، والإحساس بالفراغ من جملة المنتجات الحضارية. وقد ساعد التقدم العلمي والتقني الباهر على إنجاز الأعمال الكبيرة بأيد عاملة قليلة، وأوقات قصيرة؛ أضف إلى هذا أن تنظيم أوقات العمل لدى الحكومات، وفي المصانع والشركات، أدى إلى تنظيم مساحات الفراغ في يوم كل موظف وعالم، وهذا كله لم يكن موجوداً من قبل.
الفراغ يضع الإنسان في مواجهة نفسه، وهذه حالة صعبة للغاية، كما أنه يجعل المرء، يشعر بانعدام وجود مسوغ لوجوده، وهذا دفع أعداداً كبيرة من الشباب إلى القيام بأعمال وتصرفات شائنة وضارة بهم، وبالمصالح العامة. وقد أدرك الفرنسيون قبل غيرهم خطورة ذلك. فأنشأت (الجبهة الشعبية) في فرنسا سنة 1936 وزارة أوقات الفراغ، وشغلت الثقافة منزلة فيها (7).
إن كثيراً من الأعمال الجليلة في التاريخ ما كان لها أن ترى النور لولا تمتع أصحابها بالوقت، وقلة المشاغل وهكذا فالوقت الذي هو شرط لازم لإنجاز أي شيء، يمكن في حالة انحطاط الثقافة العامة أن يكون وسيلة لتدمير حياة الصغار والكبار!
التعلم المستمر والتثقف الذاتي، يحول (الفراغ) من نقمة إلى نعمة، ومن أداة هدم إلى وسيلة بناء، لكن ذلك يحتاج إلى جو ثقافي، يحاصر ذوي الكسل الذهني والفوضويين، ويشعر أولئك الذين يبطنون نوعاً من العداء للمعرفة بتفاهتهم وقصورهم.
ما التعلم المستمر؟
التعلم المستمر عبارة عن أنشطة ذات بعدين: بعد رأسي يستغرق حياة الإنسان كلها إلى آخر لحظة، وبعد أفقي يتمثل في تنمية الكينونة الإنسانية في كل أبعادها ووظائفها في الحياة (8)؛ من أجل الدنو من الكمال المنشود، والقيام بالمسؤوليات وأداء الواجبات الشخصية والحضارية على أفضل وجه ممكن.
ويمكن أن نذكر من خصائص ومشخصات التعلم المستمر ما يلي:
1- يكوّن كل واحد منا من خلال الخبرات والتجارب الحياتية صورة عن ذاته وقدراته، وأوجه تميزه وقصوره ويساعدنا على بلورة تلك الصورة الأهل والأساتذة والزملاء، والمؤسف أن تلك الصورة كثيراً ما تكون زائفة، أو ناقصة. وكثير من الناس يتصرف على مدار حياته وفق معطيات تلك الصورة ومحدداتها. الصورة الفائقة الجودة كثيراً ما تبعث على الغرور وتدفع إلى المغامرة والتهور. والصورة الباهتة تقعد صاحبها عن بذل الجهد في سبيل الارتقاء، وتحطم طموحاته.
جوهر التعلم مدى الحياة، يقوم على إعادة تشكيل صورة كل واحد منا عن نفسه من جديد، ومحاولة التخلص من كل الصور النمطية المبكرة التي شكلها لنا الآخرون، أو توصلنا إليها نتيجة معاناة شخصية. إنه تحويل ما كنا نظنه نهائياً إلى شيء قابل للتعديل والتطوير واستكناه مستمر للذات والإمكانات والفرص وقراءات مستمرة لكل ذلك. وإن شئت إعادة إنتاج كل ذلك؛ فالصورة التي نكونها عن أنفسنا قد تكون أهم بكثير من حقيقة أنفسنا. إن العظماء والمبدعين والسباقين من الناس هم في الأصل أشخاص لا يملكون صوراً نهائية لأنفسهم، ولا يمكن أن يحاولوا ذلك، وشعارهم الدائم إن ما هو أفضل لم يولد بعد. وإن الله - تعالى - قد يهب لبعض المتأخرين ما حجبه عن بعض المتقدمين؛ ولا حاجر على فضله. فإذا لم ينجح التعلم المستمر في تطوير رؤيتنا لأنفسنا؛ فإنه قد يكون قد أخفق في تحقيق وظيفة من أخطر وظائفه.
2- لا ينبغي للتعلم المستمر أن يكون نشاطاً منفصلاً عن الأنشطة الحياتية، وليس مكملاً لها؛ فالقراءة في المساء - مثلاً - لا تستهدف ملء وقت الفراغ المتوفر بعد الانصراف من الأعمال المعيشية، كما لا ينبغي أن تستهدف إطلاع الشخص على موضوع معين، وإنما الهدف أن يتعلم الإنسان من كل مناشط الحياة حتى يطور طريق عيشه؛ إنه نمو في كل الاتجاهات فتتحسن لديه القراءة والفهم والإدراك والملاحظة والتعامل والتكيف والتعبير عن الذات، وقضاء أوقات الفراغ، وإشباع الحاجات المختلفة. وبذلك لا تقتصر مهمة التعلم المستمر على إنماء الذات فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى إضفاء الانسجام والتكامل على جميع جوانبها، وتحسين توازنها العام.
3- التعلم المستمر عبارة عن تعظيم لقدراتنا، وتحسين لنوعية استجاباتنا في مواجهة الظروف والتحديات التي نواجهها في رحلة الابتلاء.
التحديات في الأصل، هي أشكال من المحفزات للارتقاء إلى ما هو أفضل مما هو حاضر وسائد والاستجابة العليلة لها هي التي تحولها من محرض على السمو والتقدم إلى مشكلات وعقبات تحط من مستوى توازن حياتنا العامة.
التعلم المستمر يمكننا من اختيار الوسائل والأساليب المناسبة لمواجهة التحديات والتغلب عليها من خلال غمسه لنا في لجة التغيرات الاجتماعية، والمعطيات المعرفية المتلاحقة، ومن خلال مساعدتنا على تقويم طروحاتنا واستنتاجاتنا واختيارها.
المجتمعات التي لا تعطي أهمية للتعلم المستمر، هي وحدها التي تتأسن فيها التحديات، وتتفسخ فيها المشكلات بسبب ضعف الخبرة في الاستجابة الملائمة لها.
إن التعليم المتسمر هو بعبارة موجزة - الحيوية التي تمكن الفرد من أن يعيش إلى أن يموت
إضاءة: الخطة الناجحة لا تكون إلا بنتاً للمعلومة الجيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ كشف الخفاء: 2: 167.
2ـ النظم التعليمية عند المحدثين: 149.
3ـ رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي: 33.
4ـ المصدر السابق: 10.
5ـ مجلة التربية المستمرة، العدد الثاني: 7، 10.
6ـ الثقافة الفردية وثقافة الجمهور: 46.
7ـ المصدر السابق: 37.
8ـ مجلة التربية المستمرة: العدد الثاني: 12.
 الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)