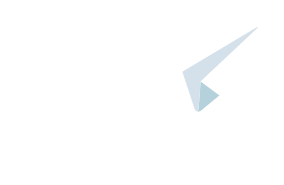اساسيات الاعلام

الاعلام

اللغة الاعلامية

اخلاقيات الاعلام

اقتصاديات الاعلام

التربية الاعلامية

الادارة والتخطيط الاعلامي

الاعلام المتخصص

الاعلام الدولي

الرأي العام

الدعاية والحرب النفسية

التصوير

المعلوماتية


الإخراج

الإخراج الاذاعي والتلفزيوني

الإخراج الصحفي

مناهج البحث الاعلامي

وسائل الاتصال الجماهيري

علم النفس الاعلامي

مصطلحات أعلامية

الإعلان


السمعية والمرئية

التلفزيون

الاذاعة

اعداد وتقديم البرامج

الاستديو

الدراما

صوت والقاء

تحرير اذاعي

تقنيات اذاعية وتلفزيونية

صحافة اذاعية

فن المقابلة

فن المراسلة

سيناريو

اعلام جديد

الخبر الاذاعي


الصحافة

الصحف

المجلات

وكالات الأنباء


التحرير الصحفي

فن الخبر

التقرير الصحفي

التحرير

تاريخ الصحافة

الصحافة الالكترونية

المقال الصحفي

التحقيقات الصحفية

صحافة عربية


العلاقات العامة

العلاقات العامة

استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها

التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة

العلاقات العامة التسويقية

العلاقات العامة الدولية

العلاقات العامة النوعية

العلاقات العامة الرقمية

الكتابة للعلاقات العامة

حملات العلاقات العامة

ادارة العلاقات العامة
مقومات المواطنة
المؤلف:
سليمان الطعاني
المصدر:
الوجيز في التربية الإعلامية
الجزء والصفحة:
ص 159-163
31-1-2023
5977
مقومات المواطنة
أن المواطنة ليست وضعية جاهزة يمكن تجليها بصورة آلية عندما تتحقق الرغبة في ذلك، وإنما هي سيرورة تاريخية وديناميكية مستمرة وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف الملائمة، وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد، وفي إطار مؤسسات وآليات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع؛ وإذا كان من الطبيعي أن تختلف نسبياً هذه المتطلبات من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر بسبب اختلاف الثقافات والحضارات والعقائد والقيم، ومستوى النضج السياسي، فإنه لا بد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية المشتركة ووجود حد أدنى من الشروط التي يتجلى من خلالها مفهوم المواطنة في الحياة اليومية للمواطنين، وفي علاقاتهم بغيرهم، وبمحيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومن أهم المقومات والشروط التي لا مجال للحديث عن المواطنة في غيابها:
1. المساواة والعدالة: فإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض توفرها بين المشتركين في الانتماء لنفس الوطن، فإنها تهتز وتختل في حالة عدم احترام مبدأ المساواة، مما يؤدي إلى تهديد الاستقرار، فلا تتحقق المواطنة إلا بتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتتاح أمام الجميع نفس الفرص دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو المعتقد الديني أو القناعات الفكرية أو الانتماء والنشاط الفكري.
2. الولاء والانتماء ويعني الرّابطة التي تجمع المواطن بوطنه لا خضوع فيها إلا لسيادة القانون والارتباط الوجداني الذي يعنى بخدمة الموطن والعمل على تنميته، وعلاقات المواطن بمؤسسات الدولة والولاء للوطن واعتبار المصالح العليا للوطن فوق كلّ اعتبار.
ولا تتبلور في الواقع صفة المواطن كفرد له حقوق وعليه واجبات، بمجرد توفر ترسانة من القوانين والمؤسسات التي تتيح للمواطن التمتع بحقوقه والدفاع عنها في مواجهة أي انتهاك واستردادها إذا سلبت منه، وإنما كذلك بتشبع هذا المواطن بقيم وثقافة القانون، التي تعني أنَّ الاحتكام إلى مقتضياته هي الوسيلة الوحيدة للتمتع بالحقوق وحمايتها من الخرق وبالتالي لا مجال لاستعمال العلاقات الخاصة مع ذوي النفوذ، أو الاحتماء بمركز الفرد في القبيلة أو العشيرة، وهي ظواهر ما زالت حاضرة في الكثير من العقليات والسلوكيات داخل مجتمعاتنا العربية.
والولاء للوطن لا ينحصر في المواطنين المقيمين داخل حدود التراب الوطني، وإنما يبقى في وجدان وضمير وسلوك المواطنين الذين تضطرهم الظروف للإقامة في الخارج، لأن مغادرة الوطن لأي سبب من الأسباب لا تعني التحلل من الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المواطنة، وتبقى لصيقة بالمواطن تجاه وطنه الأصلي، حتى ولو اكتسب الجنسية في دولة أخرى.
3. المشاركة والمسؤولية: المشاركة في الحياة العامة تعني إمكانية ولوج الجميع المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها متاحة أمام الجميع دون أي تمييز، بدءاً من استفادة الأطفال من الحق في التعليم والتكوين والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، واستفادة عموم المواطنات والمواطنين من الخدمات العامة، ومروراً بحرية المبادرة الإقتصادية، وحرية الأبداع الفكري والفني وحرية النشاط الثقافي والاجتماعي، وانتهاء بحق المشاركة في تدبير الشأن العام بشكل مباشر كتولي المناصب العامة وولوج مواقع القرار، أو بكيفية غير مباشرة كالانخراط بحرية في الأحزاب السياسية وإبداء الرأي حول السياسات المتبعة، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيلية على المستوى المحلي والوطني والمهني. فعندما تتاح الفرص المتكافئة للمشاركة أمام كل الكفاءات والطاقات يكون المجال مفتوحاً للتنافس النوعي الذي يضمن فعالية النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويضفي الحيوية على المشهد الوطني، مما يساهم في خلق واقع ينشد التطور المتواصل والارتقاء المستمر.
والمشاركة بالمفهوم الواسع المبين أعلاه، تعني توفر فرص الانخراط التلقائي في مختلف مجالات الحياة العامة وحقولها، ولا يأتي نمو استعداد المواطنين والمواطنات للمشاركة في الحياة العامة إلا في ظل حرية الفكر والتعبير وحرية الانتماء والنشاط السياسي والنقابي والجمعي، وفي إطار الديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو صاحب السيادة ومصدراً لجميع السلطات.
ولذلك فهي تختلف عن الإشراك الذي ينطوي على مفهوم المنح من سلطة عليا تحكم بأمرها، لرعايا تابعين خاضعين لنفوذها، لأن الإشراك بهذا المعنى يتناقض مع مفهوم المواطنة ويتعارض مع مقوماتها.
لعل التجارب التاريخية أفرزت معانٍ مختلفة للمواطنة فكراً وممارسة تفاوتت قربـاً وبعداً من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرخين وحتى في التاريخ المعاصر تنوعت في إفرازها لمفهوم المواطنة بحسب التيارات الفكرية السياسية والإجتماعية التي لا يمكن قراءتها وفهمها ونقدها بمعزل عن الظروف المحيطة بها أو بعيداً عن الزمان والمكان بكل أبعادها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأيديولوجية والتربوية، ومن ثم لا يمكن التأصيل السليم لمفهوم المواطنة باعتباره نتاجاً لفكر واحد مبسط وإنما باعتبار أنه نشأ ونما في ظل محاضن فكرية متعددة تنوعت نظرياتها وعقائدها بل وظروف تشكلها على المستوى المحلي والقومي والدولي. ولأن قضية المواطنة محوراً رئيساً في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة، فإن تحديد أبعادها وكيفية ممارستها ينبع من الطريقة التي يمنح بها هذا النظام أو ذاك حقوق المواطنة للجميع ومدى وعي المواطنين وحرصهم على أداء هذه الحقوق والواجبات.
إلا أنَّ المواطنة وعلى الرغم من تأثرها بالتطورات السياسية وبتعدد الثقافات المجتمعية والأيديولوجية، تبقَ بمفهومها إطاراً يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسية. فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات
والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثّقافيّة والاجتماعية والسياسية في الوطن ولا تحدث تغييراً في نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفًا للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، حيث توفر البيئة الصحيحة والخصبة لتكوين ثقافة الوطن التي تتشكل من تفاعل ثقافات أبناء الوطن، ولعلَّ مقولة أرسطو "المواطن الصالح خير من الفرد الصالح" هي أصدق تعبير عن أهمية دور المواطنة في بناء المجتمعات والدول.
 الاكثر قراءة في مصطلحات أعلامية
الاكثر قراءة في مصطلحات أعلامية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)