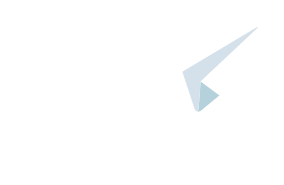التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
أثر الحضارة المصرية القديمة في الحضارة الإغريقية
المؤلف:
سليم حسن
المصدر:
موسوعة مصر القديمة
الجزء والصفحة:
ج14 ص 57 ــ 68
2025-07-12
16
من الظواهر الطبيعية العجيبة في الخلق الإنساني أنه عندما ترسخ فكرة في الأذهان البشرية بصورة قوية سواء أكانت هذه الفكرة عقلية أم خُلقية أم أدبية وتكون نشأتها ناتجة عن تقليد قديم خاص بأحوال العالم الدنيوي فإن الإنسان لا يبحث بعد السير على مقتضاها أجيالًا طويلة فيما إذا كانت هذه الفكرة منطقية أو غير منطقية، وبخاصة عندما تصبح هذه الفكرة ضمن دائرة الأفكار والآراء المرعية المسلَّم بها، ومن ثم يفرضها الإنسان على نفسه بأنه عقيدة لا محل لمناقشتها أو الشك فيها.
ولا أدل على ذلك من أن كثيرًا من رجال الفكر وأساطين العلم والفلسفة وكبار الكتَّاب المفكرين قد أعلنوا آراءً وأفكارًا عن أصول المدنية الهيلانية لا تقبل الشك أو الجدل حتى إن أخطاءهم فيها قد أدهشت عقول الذين أخذوا في درس الحضارة الإغريقية ولم يكونوا على علم بتلك الآراء الخاطئة التي وقع فيها من سبقهم ممن درسوا تلك الحضارة على ضوء الكشوف الحديثة.
ومن أفدح الأخطاء الشائعة في عصرنا هذا ما رُوِيَ عن الحضارة الإغريقية من أنها أم الحضارات الغربية وأنها لم تكن في حاجة إلى غيرها من المدنيات التي سبقتها، وأنها على ذلك لم تخضع في أصولها وفي أزمان تطورها فيما بعد على وجه التقريب لأي تأثير وفد عليها من خارج تربتها، والقول السائد الذي يردده حتى الآن السواد الأعظم من رجال العلم أن بلاد الإغريق هي تربة الشعب الذي استقى منه كل العالم جميع عجائب ما أنتجه الفن والأدب والعلم والفلسفة، ولذلك فإنها كانت تُعَدُّ نسيجَ وَحْدِها، وما نرمي إليه الآن في هذا الفصل هو أن نبرهن بصورة مختصرة على أن هذه الفكرة خاطئة من أساسها وأن بلاد الإغريق كغيرها من كثير من البلاد الأخرى كانت من حيث أصول الفلسفة بوجه خاص مدينة لمصر بدرجة عظيمة، حقًّا ستكون براهيننا على صحة هذا الرأي ناقصةً بعضَ الشيء، فلا تبلغ حد الكمال الذي كنا نأمل أن نصل إليه، ومن ثم هذا الموضوع لا يمكن حله بأكمله في هذه العجالة وقد يكون من الخير أن نوضح هنا المقدمات التي لا تعد إلا حجرًا واحدًا في البناء الذي سيقيمه عاليًا أولئك الذين سيتناولون هذا الموضوع عندما تكشف أرض مصر عما في جوفها، وبذلك يتقدم علم الآثار التقدم المأمول فيه نحو هذا الاتجاه من حيث الكشوف.
ومما لا نزاع فيه أن الشعوب التي أسهمت في تقدم المدنية البشرية منذ نشأتها هي الشعب المصري والشعب الكلداني ثم الشعب الهيلاني المبكر، وليس من شك في أن الثقافة الإغريقية الحقيقية مرتبطة بثقافة الشعبين المصري والكلداني ارتباطًا وثيقًا لا لبس فيه ولا إبهام، والواقع أن مصر قد لعبت دورًا هامًّا عظيمًا في الثقافة الهيلانية القديمة وبخاصة في ثقافة القوم الذين كانوا قبل الشعب الهيلاني، وهم الذين ورث عنهم الإغريق حضارتهم وأعني بذلك إغريق الجزر اليونانية وبلاد الإغريق الكلاسيكية، وتؤكد أعمال الحفر المثمرة التي عُمِلَت في جزيرة «كريت» وفي «البليبونيز» وفي آسيا الصغرى في موقع إقليم «طروادة» على وجود مدنيات رفيعة ترجع إلى عهد سحيق في القِدَم أي إلى الألف الثالثة والألف الثانية قبل المسيح، وهذه المدنيات المكشوفة تبرهن على تأثير بارز جاء عن البلاد المجاورة وبخاصة مصر.
وتدل شواهد الأحوال على أنه كانت هناك اتصالات غاية في النشاط بين المصريين والعالم الإيجي قبل أن يظهر الشعب الإغريقي بصورة واضحة على مسرح التاريخ، فقد كانت متصلة بمصر اتصالًا وثيقًا قد يسفر عن اشتراك في الدم، فقد وُجدت أشياء مصرية في قصور «كريت» كما وُجدت أشياء كريتية في مقابر مصرية (راجع: C. A. H. Vol. of Plates, I, 104-5.) وعلى أية حال فإنه في العصر الذي جاء بعد خلاص مصر من يد «الهكسوس» الغاشمين أي بحلول الأسرة الثامنة عشرة قد أصبحت العلاقات بين البلدين وطيدة جدًّا، وحوالي نهاية القرن الخامس عشر قبل الميلاد حلَّت بكريت كارثة طاحنة قبل أن تصل الجزيرة إلى العهد المنوي المتأخر الثاني، وقد كانت مصر و«كريت» قبل هذه الكارثة على اتصال تام، ومن الواضح أن بداية العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق نفسها وجزرها يتفق مع سقوط الحكومة المنواتية في كريت والقضاء على أهميتها السياسية والتجارية (راجع مصر القديمة الجزء الخامس( .
وقد كان المصريون يسمون سكان بحر إيجه وسكان بلاد الإغريق نفسها «أقوام الجزر التي في وسط البحر» وذلك لأنهم كانوا لا يعرفون إلا القليل عن أرض الإغريق الرئيسية وقد ظنوا أن كل الأقوام المجاورة قد أتوا من بعض الجزر وكانوا خاضعين لكريت.
وقد عُزِيَت الكارثة التي حلَّت بجزيرة «كريت» على وجه عام إلى رجال بلاد الإغريق أنفسهم وهم الذين خربوا مدنها وأحرقوها في غارة قاموا بها ويعزو السير «أرثر إيفانز» سقوط «كنوسوس» على الأقل إلى زلزال (راجع: Evans Palace of Minos, Vol. II, I, P 320) (راجع مصر القديمة الجزء الثاني عشر).
ويقول «بندلبري» إن هذه الكارثة كان سببها مجهودًا منظمًا لأنه في هذا الوقت لم يكن تبدو على كريت علامات ضعف (راجع: J. E. A. Vol. XVI, P. 90).
أما أهل البحار الذين تحدثنا عنهم كثيرًا في غير هذا المكان (راجع مصر القديمة الجزء السابع) وهم الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن «كريت» فلم يكن المصريون يعرفون عنهم شيئًا؛ فقد أتوا إلى مصر مباشرة مع أمتعتهم وكأن كريت لم تكن موجودة، وقد بقيت العلاقات بينهما في سلام لمدة قرن ونصف قرن من الزمان، ولكن في عهد الملك «مرنبتاح» هددت مصر بلاد لوبيا كما هددها حِلف من أقوام البحار (راجع مصر القديمة الجزء السابع)، وقد قضت مصر على هذه الغزوات وبقيت بعد ذلك هادئة، قد تركت هذه الغزوات أثرًا في الشعور المصري وحالته من ناحية الأجانب بدرجة لا يمكن تقديرها، وكانت من عوامل عزلتهم التي تحدث عنها الكُتاب القدامى.
حقًّا لقد ظل أقوام البحار مع مصر في سلام ورعاية لحق الجوار مدة تقرب من قرنين، ومن ثم فإن العداوة التي أظهرها أقوام «إيجه» لا يمكن تفسيرها، وكانت وبالًا عليها إلى أقصى حد؛ لأن معظم كسبهم كان من التجارة.
وبعد أن أفلتت مصر من هذا الخطر الخفي انكمشت في عقر دارها ولم تعد هناك مبادلات تجارية، وقد أغلقت مصر نتيجة لذلك موانيها لدرجة أن ظهور الأشرعة في الأفق كان نذيرًا بحملة حربية (راجع: J. E. A. XVI. 92) وتعتبر هذه الغارات نهاية عهد في تاريخ البحر الأبيض المتوسط، ولكن على الرغم من أن مصر قد نجت من خطر الفتح، فإن القوة الحربية التي كان يمتاز بها الجنود المصريون الوطنيون قد اضمحلت وأصبح كل جنودها المحاربين من الجنود المرتزقة بوجه عام، ومن ثم أخذت قوة مصر تنحط بسرعة وتتابَعَ عليها الغزو الأثيوبي فالآشوري، إلى أن جاءت «الأسرة الساوية» وأجلَتْ الأثيوبيين عن مصر ثم قضت على سلطان الآشوريين جملة وطردتهم من وادي النيل، وفي خلال العهد الساوي تمتعت مصر باستقلالها لمدة قرن ونصف قرن من الزمان، وفي خلال حكم «بسمتيك الأول» مؤسس هذه الأسرة أخذت مصر تتصل من جديد بالعالم الغربي وبخاصة بلادُ الإغريق.
ويمكن تلخيص تغيير موقف المصريين بالنسبة للإغريق حتى عهد «هردوت» في المراحل التالية:
أولًا: العداء لكل الأجانب (راجع: Strabo, 17, 1, 6, P. 792) وتجنب العادات الأجنبية (راجع: Herod. II, 41, 7, 91, 1).
ثانيًا: حاجة مصر للمساعدة في عهد الملوك الساويين؛ أي في خلال الأسرة السادسة والعشرين وقد أدى ذلك إلى السعي في التأثير على الإغريق بما للثقافة المصرية من مكانة رفيعة في العالم.
ثالثًا: ظهر اتحاد سياسي بين المصريين والإغريق كان سببه عداوتهما المشتركة للفرس.
رابعًا: السعي للبرهنة على وجود علاقات قديمة بين بلاد الإغريق ومصر أو بعبارة أخرى ما أخذه الإغريق عن مصر في ميادين العلم، وسنتحدث هنا عن هذه المراحل.
ما أخذه الإغريق عن المصريين في العصر الساوي:
(1) أما عن المرحلة الأولى فقد تحدث عنها «هردوت» في كتابه عن مصر عندما تحدث عن العادات المصرية ومناقضتها للعادات الإغريقية (راجع: Herod. VI, 35, 25 eq).
ولكن مما يجدر ملاحظته هنا أن «هردوت» قد بالغ في مواضع كثيرة عند قرنه العادات المصرية بالعادات الإغريقية؛ لأنه ارتكن أحيانًا على قول الأدِلَّاء وأقاصيصهم.
(2) كانت مصر في العهد الساوي في حاجة إلى مساعدة الإغريق، حقًّا كانت مصر مغلقة في وجه الزائرين الإغريق عدة قرون، وذلك منذ أن كانت مصر مهددة بغزو أقوام البحار لها، ولكن كانت أرض الدلتا على الأقل معروفة للعالم الإغريقي، فقد ذُكر فنار إسكندرية المستقبل في أودسي هومر (راجع: Od. IV, 355) فقد كان هناك «أمام مصر» حيث ربط «منيلاوس» Menelaos، سفينته وأجبر «بروتيوس» المصري على أن يعلن له طريقه إلى وطنه، وكذلك نجد ذكر طيبة وبوابات معبدها التي بلغت المائة، في «الإلياذة» وفي «الأوديسى» (راجع: Illiad IX, 381, Od. IV, 126) وكان يسكن هناك الفرعون «بوليبوس» Polybos، عندما غُمِرت «ألكاندرا» Alkandra زوجة «منيلاوس» بالهدايا.
وفي الأزمان التاريخية الأكثر وضوحًا نجد الميليزين الإغريق على الرغم مما بينهم وبين المصريين من خِلافات في طرق الحياة وكرههم للأجانب، فإنهم قد أفلحوا في خلال النصف الثاني من القرن السابع؛ أي في عهد الفرعون «بسمتيك الأول» في الحصول على مواطئ قدم في مصر، وهناك أسسوا محطة تجارية وهي التي تدعى «الجدار الميليزي»، ولم يمضِ طويل زمن حتى أوغلوا بسفنهم في المقاطعة «الساوية» وأسسوا هناك «نقراتيس» (نقراش) الواقعة على أحد فروع النيل الغربية (راجع مصر القديمة الجزء 12) وقد قضت الأحوال وبخاصة وجود الآشورين في مصر بأن يؤتي بجنود مرتزقة إلى مصر من بلاد الإغريق (راجع مصر القديمة الجزء 12) ومن هذا الوقت أخذت العلاقات التجارية والحربية تزداد زيادة كبيرة في عهد ملوك الأسرة السادسة والعشرين، وبخاصة في عهد الملك «أحمس الثاني» كما فصلنا القول في ذلك في مصر القديمة (راجع مصر القديمة جزء 12).
(3) وفي أثناء اختلاط الإغريق بالمصريين اختلاطًا مُحَسًّا في عهد الأسرة السادسة والعشرين بدأ الإغريق الذين وفدوا على مصر يحسون مكانتها العلمية بالنسبة لهم وقد كانت «نقراش» و«دفنة» هما المَركزان اللذان وصل منهما تأثير الثقافة المصرية إلى بلاد الإغريق، وقد كان وجود هذين البلدين يعني أن مصر كانت معروفة لا للسياح، بل كانتا سكنًا لجماعة من الإغريق من مدن مختلفة، ففي عهد الملك «أمسيس» كان كثير من الإغريق ينتقلون ذَهابًا وإيابًا بين «نقراش» ومدنهم في بلاد الإغريق، ولا بد أن تأثير هذا الاتصال كان عظيمًا، فمن ذلك ما نجده من قبل عهد الفتح الفارسي آثار مصوَّرة على أكروبول أثينا (راجع: G. Dickins, Catalgue of the Acropolis Museum, I, 167, on Nos. 144, 146).
منها صورتا كاتبين يلبسان ملابس إغريقية مقلَّدة عن اللباس المصري، وهناك نواة للحقيقة القائلة بأن الإغريق قد أخذوا فلسفتهم عن المصريين وسنتحدث عن ذلك فيما يلي.
هذا ونعلم أن «برياندر» المواطن الكورنثي قد سمى ابن أخيه وخليفته «بسمتيك» حبًّا في «بسمتيك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين، وتدل شواهد الأحوال على أن الإغريق قد وصل إليهم عن طريق «نقراش» هدايا ثمينة وبخاصة البردي الذي قُدِّم لهم مادة خفيفة رخيصة لكتابة مؤلفاتهم.
ولا يفوتنا أن نذكر أن رجال الحكمة والفلسفة في بلاد اليونان مثل «بيتاجوراس» (فيثاغور) و«صولون» قد زاروا مصر وأخذوا عن علمائها، ونرى مما كتبه «هردوت» وما تركه لنا سلفه «هيكاته» (550 ق.م) نتيجة لسياحتهما في مصر قبل الثورة الأيونية، مقدار الأثر الذي تركه المصريون في نفوس الإغريق عندما علموا مقدار إيغال تاريخ مصر في القِدَم بالنسبة لبلادهم (راجع هيكاته: Early Ionian Historians, Oxford, PP. 25 Sq. & PP. 81, on Egypt).
ولقد كان من جراء الحروب الفارسية أنها قضت على كل الاتصالات السلمية بين بلاد الإغريق وأرض الفراعنة القديمة لمدة من الزمن، وعلى إثر انتهاء هذه الحروب بالقضاء على ثورة الأمراء المصريين المحليين أخذت البلاد المصرية من جديد تفتح أبوابها للزائرين من الإغريق، فقد زار الفيلسوف «أناكزاجوراس» Anaxagoras القُطْر المصري وفحص فيضان النيل وهبوطه.
وتدل شواهد الأحوال على أن هلانيكوس Hellanikos المؤرخ الإغريقي وهو معاصر لهردوت قد زار مصر قبله على ما يظهر، (راجع: Ibid. P. 152, and Especially P. 199) ولكن يرجع الفضل الأكبر فيما كتبه المؤرخ «هردوت» (حوالي 450 ق.م) إلى معرفة مجهودات المصريين وتأثيرها في الإغريق مما جعله يثبت أن الثقافة المصرية كانت أعلى من ثقافتهم، ولكنه على الرغم من رغبته في قبول تقدير المصريين لثقافتهم هم إلا أنه بقي إغريقيًّا قُحًّا في تفسيره لمصر بعبارات تدل على العقلية الإغريقية، وعلى الرغم من أنه كان مستعدًّا لأن يعترف بأسبقية ثقافات أخرى وباعتبار الأنظمة الإغريقية مأخوذة عن المصرية، فإنه أراد أن يفسر كل ما هو أجنبي بالروح الإغريقية التي كان يعدها معيارًا للبشرية عامة في التعبير.
والواقع أن مصرِيِّي عهد «هردوت» كانوا يُظْهِرون بحق نحو الروح الإغريقية شعور التفوق على الإغريق بل الاحتقار لهم، ولا غرابة في أن يكون هذا موقفهم؛ لأن مدينتهم كانت تضرب بأعراقها إلى الماضي البعيد بالنسبة لمدنية الإغريق الحديثة التي لم تكن قد وقفت على قدميها بعد في العلوم والمعرفة، وقد كان المصريون في تلك الفترة يحلمون بماضيهم القديم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير من حيث حاصلات البلاد أو موارد نهر النيل (Herod. II, 177) ، وقد كان «هردوت» عليمًا بهذا الكبرياء المصري بالنسبة لمجد أجدادهم كما أوضح لنا ذلك خلال محادثته مع كهنة «آمون» طيبة في معبد الكرنك (Herod. Ibid. 143) فقد حدثنا كيف أنه عندما تتبع «هيكاته» الميليزي الإغريقي الذي زار مصر قبل «هردوت» نسب أجداده إلى أن وصل إلى آلِهِ في الجيل السادس عشر، قاده الكهنة إلى داخل المعبد وأطلعوه على ثلاثمائة وأربعة وأربعين تمثالًا منصوبة هناك لأفراد، وكان كل واحد منها ابنًا لما يليه في سلسلة متصلة حتى آخر واحد منها دون أن يصلوا في النهاية إلى آله، وعلى الرغم من الثلاثمائة والخمسة وأربعين جيلًا فإن الرجل الأول كان يريد أن يدلل على أنه رجل نبيل المولد وحسب، وقد عرف «هردوت» طرفًا من تفاخر المصري بماضيه وزهوه بتفوق سلالته على باقي سلالات العالم، هذا ولدينا مثال آخر في المحادثة الشهيرة التي جرت بين «صولون» وكاهن مصري مُسِنٍّ (راجع: Plato. tim. 226, Cf. Joseph, Cont. Ap. I, 7) فتحدث عن الإغريق بأنهم أطفال؛ لأنه ليس لهم ماضٍ سحيق في القِدَم، وقال: «إنكم ستظلون أطفالًا إلى الا بد؛ إذ ليس في بلاد الإغريق رجل مُسن. »
(4) والمرحلة التالية في العلاقات الإغريقية المصرية تُظْهِر تغيُّرًا ثابتًا لما هو حسن، فقد قام بين الأمتين تعاون سياسي بسبب العداوة التي كانت بينهما وبين الفُرس، وهذا التعاون يفسر الترحاب الذي أظهره المصريون للإسكندر عند دخوله مصر فاتحًا.
والواقع أن الأسرة السادسة والعشرين لم تكن إلا الأولى من عدد من الفواصل من سلسلة ملوك أجانب بدئوا منذ عام 700ق.م يسيطرون على مصر حتى جاءت الثورة الحالية التي أعادت للبلاد مجدها القديم، وقد كان عهد هذه الأسرة بمثابة ولادة جديدة، وذلك عندما قامت المدنية المصرية القديمة من رقادها الطويل وأعادت لمصر تقاليدها القديمة التي كانت تفخر بها على كل العالم، وأهم شخصية بارزة في ملوك هذه الأسرة بالنسبة لعلاقته مع الإغريق هو «أحمس الثاني» الذي اشتهر بحبه للإغريق وتوثيق روابط الألفة معهم.
وقد ظهر ذلك في منحه إياهم «نقراش»، وتكوين حرسه من «الأيونيين» و«الكاريين»، وزواجه من سيدة إغريقية من «سيرني»، وكذلك عقد معاهدة صداقة مع «بوليكراتيس» حاكم «ساموس» (راجع: Herod. II, 39-40) يضاف إلى ذلك أن قوة «أحمس» البحرية كانت هي الأساس للقوة البحرية التي جعلت مصر فيما بعد في عهد البطالمة المسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، هذا، وقد قُطعت العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق فجأة لفتح «الفرس» لمصر، وقد قيل إن «الفرس» أهانوا المعبودات المصرية في أثناء سيطرتهم على البلاد، ولكن هذا الزعم باطل كما سيظهر ذلك فيما بعد، وحتى إذا كان ذلك قد حدث في آخر عهدهم فإنه لم يحدث كما قال «هردوت» في أول أمرهم؛ ويطيب أن نذكر هنا أن الأخطاء الماسَّة بالدِّين لم يرتكب مثلها الإغريق؛ لأن الإغريق كانوا يظهرون دائمًا كما أكد ذلك «هردوت» أنهم يرون آلهتهم في الآلهة المصرية لما بين آلهة البلدين من تشابه كبير، وذلك ما فسر لنا فيما بعد النجاح العظيم الذي أحرزه الإغريق في معاملتهم مع المصريين، وقد نالت مصر استقلالها المرة الأخيرة بمساعدة الإغريق لها عندما طُرِد الفرس من مصر عام 404ق.م غير أن مصر على الرغم من قيامها بنهضة جبارة في خلال الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين بمساعدة الإغريق لها فإنه في النهاية فقدت استقلالها عام 342ق.م، ومنذ ذلك العهد لم نعرف عنها شيئًا مؤكدًا إلى أن دخلها الإسكندر الأكبر عام 332ق.م، وذلك لقلة المصادر الأكيدة.
خامسا: نجد أن بلاد الإغريق قد أخذت كثيرًا عن مصر وبخاصة العهد الساوي.
فقد ذكر لنا «هردوت» أن المصريين كانوا قومًا يحسبون زمنهم بالسنين التي تحتوي كل منها على اثني عشر شهرًا، أما في المحيط الديني فنجد أن المصريين هم أول قوم استعملوا تسميات الاثني عشر إلهًا، وهذه التسمية (اقتبسها الإغريق عنهم فيما بعد)، وكذلك عُزِيَ إلى المصريين أنهم هم أول قوم خصوا لآلهتهم العديدين مذابحهم وصورهم ومعابدهم، وأول من حفر الأشكال على الحجر (راجع: Herod. II, 4) ويقول «هردوت» إن اسم «هيراكليس» قد أتى من مصر إلى بلاد «هيلاس» وذلك لأنه كان إلهًا قديمًا في مصر وقد اعتبر واحدًا من بين الاثني عشر إلهًا وذلك منذ سبعة عشر ألف سنة قبل حكم «أحمس» (راجع: Herod. II, 43) وهذا قول مبالغ فيه.
يضاف إلى ذلك أن تعاليم ديانة «ديونيسوس» Dionysos قد أتت بطريق غير مباشرة من مصر (راجع: Herod. II, 49) والواقع أن كل أسماء الآلهة تقريبًا قد أتت إلى «هيلاس» من مصر إلا أسماء الآلهة
«بوزيدون» Poseidon و«ديوسكوري Dioscuri»، و«هيرا» Hera و«هستيا» Hestia و«تميس» Themis و«الجريس» Graces و«النريدس» Nerides (راجع: Ibid. 50).
هذا ولم يتعلم الإغريق عملية التنبؤ من الحيوانات المضحاة من مصر وحسب، بل كذلك أقاموا جمعيات مقدسة ومواكب وصلوات، والبرهان على ذلك هو أن الأحفال المصرية قديمة جدًّا في حين أن الأحفال الإغريقية من عهد غير بعيد (Ibid. 58) وفضلًا عن ذلك فإن العقيدة القائلة بأن الروح الإنسانية خالدة وأن تقمص الأرواح جاءت من صنع المصريين ثم نُقِلَت بوساطة بعض الإغريق في وقت مبكر أو متأخر إلى بلاد اليونان (Ibid. 123) وقد تعلم «بيتاجوراس» في مصر ضمن ما تعلمه تقمص الروح في كل مخلوق.
وتعلم الإغريق علم مسح الأرض من المصريين، ومنها تطور علم الهندسة الذي برع فيه الإغريق (راجع: J. E. A. Vol. XII, 1926, P. 242 f).
وقد أخذ «صولون» الأثيني قانون «أحمس» الذي يقول فيه إنه يجب على كل مصري أن يعلن سنويًّا موارده التي يعيش منها لحاكم مديريته، وإذا عجز عن ذلك أو عجز عن أن يبرهن على أنه يعيش عيشة شريفة عوقب بالموت، وقد قال «هردوت» إن هذا قانون لا غبار عليه (في هذا مغالطة تاريخية لأن «أحمس» كان ملكًا على مصر حوالي عام 569 ق.م في حين أن «صولون» كان حاكمًا على ما يُظَنُّ في أثينا حوالي عام 594-593ق.م) هذا ونعلم مما كتبه «ديودور» أن «صولون» قد أخذ بعض القوانين عن مصر (راجع: Diod, Lix, Ixxvii, xcvi, xcvii) على أن ما نسبه «هردوت» من علوم أخذ عنها الإغريق يعد في نظر العلماء الأحداث مغالاة من جانبه، وأنه كان يحقر الإغريق ويميل عليهم ميلة شديدة في نقده.
ولكن العلم المصري كان عظيم الانتشار في كل البلاد، هذا فضلًا عن طبقة الكهنة الذين احتكروا العلوم والأدب، ولا أدل على ذلك من أنه كان هناك عدد عظيم من الكُتاب يعملون موظفين في الدولة ويمثلون العنصر المثقف من الشعب، وقد كان في كل مدينة عظيمة مدرسة أو أكثر تابعة للمعبد، وكانت تؤلف كليات لاهوتية، وقد كان أعظم علماء الإغريق وفلاسفتهم يفدون إلى هذه المدن الشهيرة كما تُحَدِّثنا بذلك التقاليد، وأهم هذه المدن هي «سايس» و«بوبسطة» و«تانيس» و«هليوبوليس» و«منف» و«الأشمونين» و«أبيدوس» العرابة المدفونة» و«طيبة»، والواقع أنه كان لكلية عين شمس اللاهوتية شهرة عالمية، وأشهر كبار الهيلانيين الذين أتوا لينهلوا بعض علومها قد دلوا «إسترابون» كما يقول شمبيلون «فيجاك» على الكلية التي تعلم فيها كل من «إيدوكس» Eudoxe و«أفلاطون» في «هليوبوليس».
ويقول نفس المؤلف إن «فيثاغور» قد تعلم في مصر كل ما أمكنه تعلُّمُه في أثناء مكثه فيها، فقد عاش على ما يقال في أرض الكنانة حوالي عشرين عامًا، وكذلك تعلم كل من «صولون» و«تاليس» المليزي في مصر ونقلا كل ما تعلماه إلى بلاد الإغريق، وكذلك نعرف المعلمين المصريين الذين تلقى عليهم «أفلاطون» المقدس (راجع: Champollion-Figeac, L’Egypte Ancienne, P. 120-121).
هذا وقد ذكر لنا «شمبليون فيجاك» أسماء معلمين كثيرين من المصريين نقلًا عن بروكلوس PrOclus، والواقع أنه في عهد الأسرة السادسة والعشرين كان في مقدور الإغريق أن يزوروا وادي النيل ويقيموا فيه في أحسن حال، وحتى فيما بعد في عهد الفرس لم يكن هناك عائق يمنع السائحين والمؤرخين ورجال السياسة من أن يجوسوا خلال الديار المصرية بطمأنينة ويتعلموا عاداتهم وفنونهم ومعتقداتهم الدينية، وأكبر برهان على ذلك المؤرخ «هردوت»، والواقع أن كل الإغريق الذين أوتوا حظًّا عظيمًا من الذكاء كانوا على استعداد لأن يذهبوا إلى منبع الحكمة المصرية، وقد كان من الطبيعي أنهم أُغْرُوا على ذلك بما كان للمدنية المصرية من شهرة طبقت الآفاق.
وبعد أن أظهرنا حقيقة العلاقات العقلية بين المصريين والإغريق بقي علينا أن نحدد طبيعة هذه العلاقات، فمن المفهوم تمامًا أن ما بحثناه هنا لا شأن له إطلاقًا بوضع صلة مباشرة بين أفكار مصرية معلومة وبين تصورات الفلاسفة الإغريق الأُول؛ إذ الواقع أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن نفكر في ذلك في الحالة الراهنة للمسألة بل نريد أن نبرهن على أن الفكر المصري لا بد قد ترك بعض التأثير في الفكر الإغريقي، وعندما نقول العلم المصري والمعرفة المصرية يجب أن نفهم أن هذه التعابير لا يقصد منها إلا معنى عام جدًّا وألا نرى فيها قط ما يُقصد به من معنى لهذه التعابير في أيامنا، فلا نفهم من عبارة العلم المصري المعلومات الفنية والعلمية والرياضية والفلكية وحسب، بل كذلك مجموع آراء دينية وفلسفية مضافة إلى عقائد وتجارب سحرية، والواقع أن هؤلاء العلماء الذين حضروا إلى مصر وتعلموا فيها ترك كل منهم أثره في علوم الإغريق وعقائدهم بدرجة مُحَسَّة، فمثلًا قد استعمل الإغريق بدون شك عقائد مصرية مسلَّمًا بها خاصة بمصير الإنسان في عالم الآخرة، ويجب أن يتتبعها في حياته الدنيوية وفي موضوع نهاية العالم الذي يعيش فيه نجد الإغريق كالمصريين كانوا يعتقدون في وجود الروح المجنحة وخلودها فنشاهد على الآثار المصرية وفي المقابر أن الروح مُثِّلَت في صورة طائر برأس إنسان، وكذلك نجد الإغريق قد أخذوا فكرة حقول الإليزية (الجنة) الخاصة بالمصريين في مملكة الأموات التي كان يتربع على عرشها أوزير، والكلمة الإغريقية نفسها «إيليزة» تذكرنا بصورة غريبة بالكلمة المصرية «يالو» أو «أيلو» (حقول الجنة)، وكذلك نجد أن النيل والقنوات التي وضعها الخيال في عالم الآخرة إن هي إلا تقليد للنيل الحقيقي، والقنوات الدنيوية قد استخدمت نماذج للأنهُر النارية التي ذكرها الإغريق في أساطيرهم، والأصل المصري للكلمة الإغريقية «رادا منت» تُقابِلُ التعبير المصري «رع أم أمنت» أي الإله رع في الغرب (وكلمة أمنتي معناها الغرب أو عالم الآخرة)، وكذلك الكلمة الإغريقية «كارون» التي تعني «نواتي» الجحيم مشتقة من الكلمة المصرية «كارو» التي تعني القارب أو المرشد في اللغة المصرية، هذا إلى أن محاكمة الأموات أمام محكمة أوزير، وكذلك تمثيل المحاكمة في عالم الآخرة، قد نُقِل إلى العقائد الإغريقية المماثلة، وكذلك وزن الروح الذي كان له قيمة كبيرة في شعر «هومر» مأخوذ برمته عن العقائد المصرية (راجع: Eliade Chant VIII, vers 68–74).
ونرى مما سبق أن الإغريق قد أخذوا كثيرًا عن قدماء المصريين ثم هذبوه على طريقتهم ووضعوه في قالب جديد علمي عقلي، وقد قام بذلك سلسلة فلاسفة وعلماء جاءوا إلى مصر قبل عهد سقراط، وهؤلاء يُرتَّبون ترتيبًا تاريخيًّا ما بين القرن السابع ونهاية القرن الخامس قبل الميلاد تقريبًا، والواقع أن تاريخ الفلسفة اليونانية يحتوي على ثلاثة عهود رئيسية وهي عهد التكوين وعهد النضج ثم عهد الشيخوخة، وينقسم عهد التكوين بدوره إلى عهدين أولهما يمتد من أول الفيلسوف «تاليس» Thles حتى عهد السفسطائيين وسقراط وهذا هو عهد الفلاسفة الذي أتوا قبل سقراط، وهو العصر الذي كان فيه العلم والفلسفة موحَّدينِ تمامًا ويشغل حوالي قرنين من الزمان، والعصر الثاني شغل جميعه تعاليم «سقراط» والسفسطائيين، ويعنينا من هذين القسمين الثانويين القسم الأول فقط، وذلك لأنه يشمل طلائع الفلاسفة الذين قبل «سقراط» وهم الذين زاروا مصر للدرس والتعلم.
وفلاسفة هذه الفترة قد كونوا مدارس فلسفية وهي مدرسة «أيوني» ومدرسة «إيطاليا» ومدرسة «إلي» Elee ومدرسة «أبديري» Abdiri، ويضاف إلى هذه المدارس أولئك المفكرون الذين يُعَدُّون شبه منعزلين مثل الفيلسوف «أناجزاجوراس»، وكذلك أصحاب الأذهان ذوو النزعات المصلحة والمكونة مثل «أمبيدوكليز» الذي سعى في أن يصب في نظام واحد أصل المذاهب «الأيونية» و«الهيراكلية» و«الأيلية» و«البيثاجورية»، وفلاسفة هذه المدارس وغيرهم ممن جاء قبل سقراط قد زاروا مصر وتأثروا بتعاليم مدارسها وكهانتها ونقلوا كل ما تعلموه إلى بلاد الإغريق فتأثرت بذلك العلوم الإغريقية أيَّما تأثير، وقد أصبح من المؤكد أن فلسفة اليونان وعلومهم في عهودهم الأولى ترجع إلى أصل مصري بحت، وسنحاول هنا أن نذكر كلمة عابرة عن كلٍّ من نظريات هؤلاء الفلاسفة ومقدار تأثرهم بالعلم المصري والفلسفة المصرية، وقصدنا من ذلك إظهار الرابطة المتصلة الحلقات التي كانت بين مصر وبلاد اليونان حتى عهد الإسكندر والبطالمة.
 الاكثر قراءة في العصور القديمة في العالم
الاكثر قراءة في العصور القديمة في العالم
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)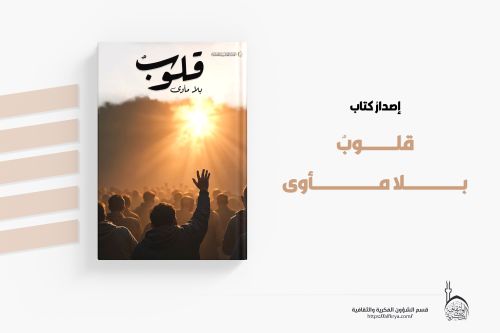 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)